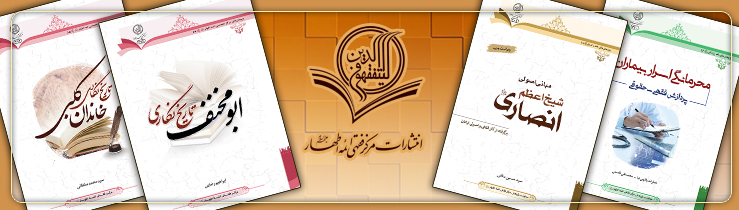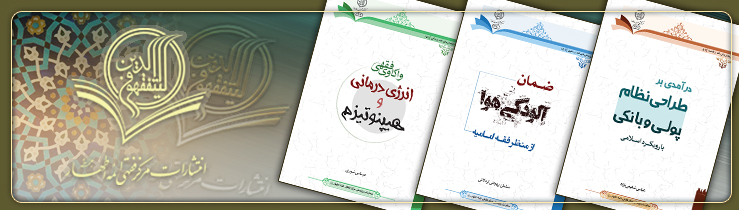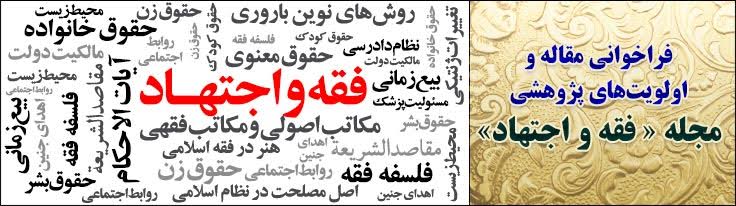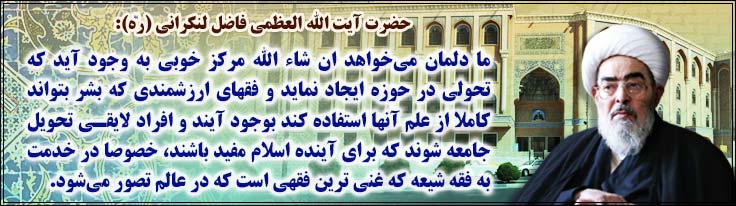(267)
كتاب الظهار
(269)
أبواب الظهار
الحديث 1303: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: الرّجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ كشعر أُمّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرِجْلِها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظّهار فهو الظّهار.
المصادر: تهذيب الأحكام 8: 10، كتاب الطلاق، ب2 باب حكم الظهار، ح4، وسائل الشيعة 22: 317، كتاب الظهار، أبواب الظهار، ب9 ح2، جامع أحاديث الشيعة 27: 329، كتاب الظهار وأبوابه، ب1 باب ما ورد في الظهار و...، ح14.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: يعني إن لم يعلّق بشيء آخر حتّى يكون قد أحلف بالظهار.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
قال في النافع: ولو قال: كشعر أمّي أو بدنها لم يقع، وقيل: يقع لرواية فيها ضعف، إنتهى.
وقال سيّد المحقّقين: الأصحّ أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقاً، وإلى هذا ذهب السيّد مدّعياً عليه الإجماع، وتبعه ابن إدريس، وابن زهرة وجمع من الأصحاب
--------------------------------------------------
1. كتاب الوافي 22: 911.
(270)
والقول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتجّ بالإجماع وبرواية سدير والإجماع ممنوع والرواية ضعيفة.[1]
الحديث 1304: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثّمالي، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحرّ من الصّوم وليس عليه كفّارة صدقة ولا عتق.
المصادر: الكافي 6: 156، كتاب الطلاق، باب الظهار، ح15، وسائل الشيعة 22: 324، كتاب الظهار، أبواب الظهار، ب12 ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 343، كتاب الظهار وأبوابه، ب8، باب أنّ المملوك إن ظاهر فليس عليه إلاّ صوم شهر، ح2.
الحديث 1305: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال: قلت لأبي الحسن[2] عليهالسلام: إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال[3]: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا، فقال[4]: لا شيء عليك ولا تعد.
المصادر: الكافي 6: 158كتاب الطلاق، باب الظهار، ح24، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي[5]، مثله في تهذيب الأحكام 8: 13، كتاب الطلاق، ب2 باب حكم الظهار، ح17، والإستبصار 3: 260، كتاب الطلاق، أبواب الظهار، ب158، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح11، وسائل الشيعة 22: 333،، كتاب الظهار، أبواب الظهار، ب16 ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 339، كتاب الظهار وأبوابه، ب4 باب أنّ الظهار ضربان...، ح11.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار13: 28 .
2. في التهذيبين: «لأبي الحسن الرضا عليهالسلام».
3 ، 4. في التهذيبين والوسائل زيادة: «لي».
5. وهو كنية سهل بن زياد الآدمي.
(271)
كتاب الإيلاء والكفّارات
(273)
أبواب الإيلاء
الحديث 1306: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قلت له: الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال: لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها.
المصادر: الكافي 6: 134، كتاب الطلاق، باب أنّه لايقع الإيلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله، ح2، وسائل الشيعة 22: 346، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الإيلاء، ب6، ح4، جامع أحاديث الشيعة 27: 363، كتاب الإيلاء وأبوابه، ب2 باب أنّ الإيلاء لايقع إلاّ بعد الدخول، ح4.
أبواب الكفّارات
الحديث 1307: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[1]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبة؟
فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدّنيا، فإنّ توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم[2]، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية، وأعتق
--------------------------------------------------
1. في الوسائل زيادة: «عن».
2. في الوسائل: «صاحبه».
(274)
نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزّ وجل.
المصادر: الكافي 7: 276، كتاب الديات، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة، ح2، وسائل الشيعة 22: 398، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، ب28 ح1 ذيل الحديث، وأورد بتمامه في ج29: 30، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، ب9 ح1، جامع أحاديث الشيعة: 27: 399، كتاب الإيلاء وأبوابه، أبواب الكفّارات، ب15 باب أنّ كفّارة قتل المؤمن عمداً عتق رقبة و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال العلاّمة رحمهالله في التحرير: تقبل توبة القاتل وإن كان عمداً فيما بينه وبين الله تعالى، وقال ابن عبّاس: لا تقبل توبته، لأنّ قوله تعالى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً»[1] إلى آخره نزلت بعد قوله: «وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ»[2] إلى قوله «إِلاَّ مَن تَابَ» بستّة أشهر، ولم يدخلها النسخ، والصحيح ما قلناه. ثمّ ذكر رحمهالله آيات التوبة والأخبار، ثمّ قال: والآية مخصوصة بمن لم يتب، أو أنّ هذا جزاء القاتل، فإن شاء الله تعالى إستوفاه، وإن شاء غفر له، والنسخ وإن لم يدخل الآية، لكن دخلها التخصيص والتأويل، ثمّ ذكر رحمهالله حديث عبد الله بن سنان وابن بكير.فقال: في هذا الحديث فوائد كثيرة:
منها: أنّ القاتل إن قتل لإيمانه فلا توبة له، لأنّه يكون قد ارتدّ، لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقد، ولا تقبل توبة المرتدّ عن فطرة.
ومنها: أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه.
ومنها: أنّ كفّارة القتل العمد هي كفّارة الجمع. إذا عرفت هذا، فالقتل يشتمل
--------------------------------------------------
1. سورة النّساء 4: 93.
2. سورة الأنعام 6: 151، وسورة الإسراء 17: 33 ويلاحظ: بأنّ الصحيح «وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ» من سورة الفرقان التي بعدها الآية «إِلاَّ مَن تَابَ» الفرقان 25: 68ـ70 .
(275)
على حقّ الله تعالى وهو يسقط بالإستغفار، وعلى حقّ الوارث وهو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه، وحقّ للمقتول وهو الآلام التي أدخلها عليه، وتلك لا ينفع فيه التوبة، بل لا بدّ من القصاص في الآخرة، ولعلّ قول إبن عباس إشارة إلى هذا.
وقال في المختلف: تصحّ التوبة من قاتل العمد، ويسقط حقّ الله تعالى دون حقّ المقتول وهي الآلام التي دخلت عليه بقتله، فإنّ ذلك لا تصحّ التوبة منها، سواء قتل مؤمناً متعمّداً على إيمانه أو للأمور الدنيويّة وهو اختيار الشيخ في المبسوط لقوله تعالى: «إِلاَّ مَن تَابَ»[1] وقوله: «يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً»[2] وقوله: «غَافِرِ الذَّنبِ»[3] ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أنّه لا تقبل توبته، ولا يختار التوبة ولا يوفّق للتوبة معتمّداً على أخبار الآحاد، فإن قصد أنّه لا تصحّ توبته مطلقاً حتّى من حقّ الله تعالى فليس بجيّد، وإن قصد أنّه لا تصحّ توبته في حقّ المقتول فحقّ.[4]
--------------------------------------------------
1. سورة مريم 19: 60، وسورة الفرقان 25: 70 .
2. سورة الزمر 39: 53.
3. سورة غافر 40: 3 .
4. مرآة العقول 24: 13ـ14، وراجع ملاذ الأخيار 16: 330 .
(277)
كتاب اللعان
(279)
أبواب اللعان
الحديث 1308: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ»[1] قال: هو القاذف الّذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ، وردّت إليه امرأته، وإن أبى إلاّ أن يمضي فيشهد[2] عليها أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين، والخامسة (يلعن فيها نفسه)[3] إن كان من الكاذبين فإن[4] أرادت أن تدفع[5] عن نفسها العذاب - و العذاب هو الرّجم - شهدت[6] أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقين، فإن لم تفعل رجمت، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة قلت: أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد فمات؟ قال[7]: ترثه أمّه، وإن[8] ماتت أمّه ورثه
--------------------------------------------------
1. سورة النور 24: 6.
2. في الاستبصار: «فليشهد» وفي الكافي 7: 211 ح5: «فشهد».
3. في التهذيب: «أنّ لعنة الله عليه» وفي الإستيصار: «فليلعن فيها نفسه»بدل«يلعن فيها نفسه»
4. في التهذيبين والوسائل: «وإن».
5. في الوسائل والتّهذيب: «تدرأ» بدل «تدفع».
6. في الاستبصار: «أن تشهد» بدل «شهدت».
7. في التهذيبين: «فقال».
8. في الوسائل: «فإن».
(280)
أخواله ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحدّ، قلت: يردّ إليه الولد إذا أقرّ به ؟قال: لا، ولا كرامة ولا يرث[1] الابن ويرثه الابن.
المصادر: الكافي 6: 162، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح3، ورواه في ج7: 211، كتاب الحدود، باب الرجل يقذف امرأته وولده، ح5 نحوه وبتفاوت يسير جداً، تهذيب الأحكام 8: 184، كتاب الطلاق، ب8 باب اللعان، ح1، الإستبصار 3: 369، كتاب الطلاق، أبواب اللّعان، ب216 باب أنّ اللعان يثبت بادّعاء الفجور و...، ح1، وسائل الشيعة 22: 410، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب1 ح7، وأورد قطعة منه في ج26: 261، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب1 ح 5، جامع أحاديث الشيعة 27: 420، كتاب اللعان وأبوابه، ب1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه، ح14.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في المسالك: إذا كذّب نفسه بعد اللعان لم يتغيّر الحكم المترتّب على اللعان من التحريم المؤبّد وانتفاء الإرث، إلاّ أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلاّ مع تصديقهم، واختلف في الحدّ هل تثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات، فذهب إلى العدم، الشيخ والمحقّق والعلاّمة في أحد قوليه، وذهب إلى الثّبوت، المفيد والعلامة في القواعد، وهو أقوى.[2]
وقال أيضاً:
قوله: وإن ماتت أمّه، أي: قبله.[3]
الحديث 1309: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[4]عليّ بن إبراهيم، عن
--------------------------------------------------
1. في الاستبصار زيادة: «الأب».
2. مرآة العقول 21: 270.
3. ملاذ الأخيار13: 357.
4. في الوسائل زيادة: «عن».
(281)
أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله.[1]
المصادر: الكافي 6: 162، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح1، تهذيب الأحكام 8: 192، كتاب الطلاق، ب8 باب اللعان، ح30، وسائل الشيعة 22: 412، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب2 ح2، جامع أحاديث الشيعة: 27:421، كتاب اللعان وأبوابه، ب2 باب أنّ اللعان لا يقع إلاّ بعد الدخول و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث موثّق. وقال في المسالك: يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد، فإنّ الولد قبل الدخول لا يتوقّف نفيه على اللعان إجماعاً، وأمّا لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه، فذهب الشيخ وأتباعه وابن الجنيد إلى الإشتراط، وذهب ابن إدريس إلى عدمه، لعموم الآية[2] وهو حسن، إلاّ أنّه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد، وعدمه للقذف جامعاً بين الأدلّة والأقوال، بحمل ما دلّ على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد، والآخر على القذف، وليس كذلك، فإنّ بعض الروايات صريح في أنّه بسبب القذف، والأقوال تابعة للأدلّة، ويظهر من المحقّق وغيره أنّ من الأصحاب من قال بعدم الإشتراط في اللعان بالسببين، وقائله غير معلوم، وهو غير موجّه لما عرفت.[3]
الحديث 1310: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[4]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادّعى ولدها بعدما ولدت، وزعم أنّه منه، قال: يردّ
--------------------------------------------------
1. في الجامع: «بأمرأته».
2. سورة النور 24: 4.
3. مرآة العقول 21: 269، وملاذ الأخيار 13: 372.
4. في الوسائل زيادة: «عن».
(282)
إليه الولد، ولا يجلد، لأنّه قد مضى التّلاعن.
المصادر: الكافي 6: 164، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح8، تهذيب الأحكام 8: 192، كتاب الطلاق، ب8 باب اللعان، ح31، ورواه أيضاً بإسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر مثله في ج10: 77، كتاب الحدود، ب6 باب الحدّ في الفرية والسبّ و...، ح61، وسائل الشيعة 22: 424، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب6 ح2، جامع أحاديث الشيعة: 27: 442، كتاب اللعان وأبوابه، ب13 باب أنّ من لاعن امرأته ثمّ ادّعى ولدها ردّ إليه الولد و...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث حسن أو موثّق. قوله عليهالسلام: «وهي حبلى» المشهور جواز لعان الحامل، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع، وقيل: يمنع اللعان.[1]
وقال أيضاً:
الحديث موثقّ. قوله عليهالسلام: «يرد إليه الولد» بأن يرث من الأب لا بأن يرث الأب منه.
وقال في المسالك: إذا كذّب نفسه بعد اللعان، لم يتغيّر الحكم المترتّب على اللعان من التحريم المؤبّد وانتفاء الإرث، إلاّ أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلاّ مع تصديقهم. واختلف في الحدّ هل يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات، فذهب إلى العدم الشيخ والمحقّق والعلاّمة في أحد قوليه، وذهب إلى الثبوت المفيد والعلاّمة في القواعد وهو أقوى، إنتهى.
ولعلّ الأوّل أقوى، وفي المسالك روي هذا الخبر وفيه مكان لا يجلد «لا يحلّ له» كما سيأتي، ثمّ قال: في الإستدلال على عدم الحدّ أنّه لو كان الحدّ باقياً لذكره
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 273 .
(283)
وإلاّ لتأخّر البيان عن وقت الخطاب.[1]
الحديث 1311: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر[3] ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنّه منه؟ قال: فقال: يردّ إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد، لأنّ اللّعان قد مضى.
المصادر: الكافي 6: 165، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح13، ورواه أيضاً نحوه في ج7: 161، كتاب المواريث، باب ميراث ابن الملاعنه، ح7، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل به زياد، عن ابن محبوب، وبتفاوت يسير جدّاً، وسائل الشيعة 22: 425، كتاب اللعان، أبواب اللعان، ب6 ح4، وأورد مثله في ج26: 263، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة و...، ب2 ح3، جامع أحاديث الشيعة 27: 443، كتاب اللعان وأبوابه، ب13 باب أنّ من لاعن امرأته ثمّ ادّعى ولدها ردّإليه الولد و...، ح3.
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: لامنافاة بين قوله عليهالسلام: «يرثه»، وقوله: «لا يرثه» لاختلاف مرجعي ضميرى البارز والمستتر في الكلمتين بالنسبة إلى الولد ومن نسب إليه.[4]
قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في المسالك: إختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية وخبر الحلبي وإن نكلت أو اعترفت لم تحدّ إلى أن تضع.[5]
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار13: 372 .
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3. في الوسائل والجامع: «وأنكر».
4. كتاب الوافي 22: 967.
5. مرآة العقول 21: 275.
(285)
كتاب العتق
(287)
أبواب العتق
الحديث 1312: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ[1]، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: لا عتق إلاّ بعد ملك.
المصادر: الكافي 6: 179، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنّه لا عتق إلاّ بعد ملك ح2، تهذيب الأحكام 8: 217، كتاب العتق والتّدبير والمكاتبة، ب1 باب العتق وأحكامه، ح7، الإستبصار 4: 5، كتاب العتق، ب3 باب أنّه لا عتق قبل الملك، ح2، وسائل الشيعة 23: 15، كتاب العتق، أبواب العتق ب5 ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 361، كتاب العتق وأبوابه، ب3 باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك...، ح1.
الحديث 1313: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذّاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السّكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.
المصادر: وسائل الشيعة 23: 43، كتاب العتق، أبواب العتق، ب21 ح3، وأورد صدره في ج18: 409، كتاب الحجر، أبواب الحجر، ب1 ح2، وكذا أورده بتمامه في ج 22: 82،
--------------------------------------------------
1. ليس في التهذيبين: «الاصم»
(288)
كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب34 ح4. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 618، رقم الحديث 1042، فراجع هناك.
الحديث 1314: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً، ثمّ مات وتركه لمن يكون ميراثه؟، قال: فقال: إن كانت الرّقبة الّتي على أبيه في ظهار، أو شكر، أو واجبة عليه، فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته، وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن كانت الرّقبة على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال، قال: ويكون الّذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الّذي اشترى الرّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فإنّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
المصادر: الكافي 7: 171، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، ح7، وسائل الشيعة: 23 73، كتاب العتق، أبواب العتق ب40 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 414 كتاب العتق وأبوابه، ب34 باب أنّ المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده...ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في الدروس: يثبت الولاء على المدبّر إجماعاً
(289)
والموصى بعتقه، وفي أمّ الولد قولان: وكذا في عتق القريب، وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط، وعلى المشتري نفسه مع الشرط، وممن تبرّع بالعتق عن الغير حيّاً أو ميتاً، قال: ولا يقع العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفّارة، صرّح به الشيخ في مواضع، وهو في صحيحة بريد بن معاوية، عن الصادق عليهالسلام وفيها: أنّ العتق الواجب لا ولاء فيه، وأنّ الولاء للمتبرّع بالعتق عن أبيه بعد موته.[1]
الحديث 1315: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.
المصادر: الكافي 7: 171، كتاب العتق، باب ولاء السائبة، ح5، وسائل الشيعة 23: 74، كتاب العتق، أبواب العتق، ب41 ذيل ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 416، كتاب العتق وأبوابه، ب35 باب أنّ المعتق واجباً سائبة إذا ضمن أحد جريرته...، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في الدروس: ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قويّ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي، نعم هو شرط في ثبوته، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في الأمر بالإشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة.[2]
الحديث 1316: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى،
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 261.
2. مرآة العقول 23: 260.
(290)
عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع قال: سئل أبوعبد الله عليهالسلام عن السّائبة فقال: هو الرّجل يعتق غلامه ثمّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.
المصادر: الكافي 7: 171، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، ح6، وسائل الشيعة 23: 78، كتاب العتق، أبواب العتق ب43 ذيل ح 2، جامع أحاديث الشيعة 24: 408، كتاب العتق وأبوابه، ب31 باب إنّ من اعتق وجعل المعتق سائبة و... ح2.
الحديث 1317: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق، وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.
المصادر: وسائل الشيعة 23: 91، كتاب العتق، أبواب العتق، ب56 ذيل ح1، وأورد مثله في ج19: 211، كتاب الوقوف والصدقات، أبواب الوقوف والصدقات، ب15 ح1، وكذا في ص362، كتاب الوصايا، أبواب الوصايا، ب44، ذيل ح4. وقد مرّ الحديث في الصفحة 41، رقم الحديث 1067، فراجع هناك.
(291)
كتاب الجعالة
(293)
أبواب الجعالة
الحديث 1318: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
المصادر: وسائل الشيعة 23: 190، كتاب الجعالة، أبواب الجعالة، ب2 ح2، وأورده في ج17: 104، كتاب التجارة، أبواب يكتسب به، ب9 ذيل ح1. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 501، رقم الحديث 912، فراجع هناك.
الحديث 1319: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي سأل[1] أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع فقال له[2]: ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدّار والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس.
المصادر: الكافي 5: 285، كتاب المعيشة، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجرالسمسار، ح4، وسائل الشيعة 23: 191، كتاب الجعالة، أبواب الجعالة، ب4 ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 110، كتاب الجعالة وأبوابها، ب1 باب جواز الجعالة على تعليم العمل و...، ح3.
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «يسأل».
2. ليس في الوسائل: «له».
(295)
كتاب الأيمان
(297)
أبواب الأيمان
الحديث 1320: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: كانت[1] من أيمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا، وأستغفر الله.
المصادر: الكافي 7: 463، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب النوادر، ح20، وسائل الشيعة 23: 198، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب1 ح4، جامع أحاديث الشيعة 24: 510، كتاب الأيمان وأبوابها، ب1 باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة...، ح9 .
قال الحرّ العاملي:
أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم انعقاد هذه اليمين[2]، ولعلّ المراد هنا: أنّه كان يقول ذلك في المقام القسم فراراً منه .[3]
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
ولعلّ المراد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحترز عن اليمين، وكان يقول مكانها: أستغفر الله.[4]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «كان».
2. الوسائل 23: 233235، كتاب الأيمان، ب15، و ص259ـ264، ب30.
3. الوسائل 23: 198، كتاب الأيمان، ب1 ذيل ح4.
4. مرآة العقول 24: 359.
(298)
الحديث 1321: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: اليمين الصّبر[1] الفاجرة تدع الدّيار بلاقع.[2]
المصادر: الكافي 7: 435، كتاب الأيمان والنذر والكفّارات، باب اليمين الكاذبة، ح2، وسائل الشيعة 23: 204، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب4 ح5، جامع أحاديث الشيعة 24: 511، كتاب الأيمان وأبوابها، ب 1 باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة...، ح17.
الحديث 1322: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: قال: لا يمين للولد[3] مع والده،ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده.
المصادر: الكافي 7: 439، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور، ح1، تهذيب الأحكام 8: 285، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب4 باب الأيمان والأقسام، ح41، وسائل الشيعة 23: 216، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب10 ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 554، كتاب الأيمان وأبوابها، ب 14 باب ماورد في أنّه لا يمين للولد مع والده و...، ح1.
الشرح: قال العلامة المجلسي:
الحديث صحيح. قوله عليهالسلام: «لا يمين لولد مع والده»، ظاهره بطلانها بدون الإذن، كما هو مختار جماعة، منهم الشهيد الثاني رحمه الله، لنفي اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحّة، لأنّه أقرب المجازات إلى نفي المهيّة.
--------------------------------------------------
1. يمين الصبر: وهو أن يحبسه السلطان على اليمين حتّى يحلف بها. (لسان العرب 4: 10، انظر مادة «صبر»).
2. بلاقع: جمع بَلْقَع وبَلْقَعَة: وهي الأرض القفر لاشيء بها، يريد أنّ الحالف بها يَفْتَقِر ويذهب ما في بيته من الرزق. (النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 153، انظر باب الباء مع اللام).
3. في التهذيب والوسائل: «لولد».
(299)
والمشهور أنّ الإذن ليس شرطاً في صحّتها، بل النهي مانع منها، ويظهر فائدة القولين فيما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحلّ، كما إذا وقع فراق الزوج، أو عتق العبد، أو موت الأب، فعلى المشهور ينعقد اليمين، وعلى مختار الشهيد الثاني رحمه الله يبطل.
وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخّرين، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب، ولا نصّ فيه في شيء منها، إلاّ الروايات الواردة بلفظ اليمين، وشموله للنذر مشكل وإن أشعر به بعض الأخبار.[1]
الحديث 1323: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له (فيه منفعة)[2] في الدّنيا والآخرة، فلا كفّارة عليه، وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرّجل والله لا أزني، والله لا أشرب (الخمر، والله لا أسرق)[3]، والله لا أخون، وأشباه هذا، ولا أعصي، ثمّ فعل، فعليه الكفّارة فيه.[4]
المصادر: الكافي 7: 447، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة، ح8، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، بالإسناد الثاني مثله في تهذيب الأحكام 8: 291، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب1 باب الأيمان والأقسام، ح67، والإستبصار 4: 41، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب24 باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفّارة وما لا تجب ح1، وسائل الشيعة: 23: 248، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب23 ح3، جامع أحاديث الشيعة 24: 577، كتاب الأيمان وأبوابها، ب26، باب أنّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام....ح3.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14:26، وراجع مرآة العقول 24: 315.
2. في الاستبصار: «منفعة فيه».
3. ليس في التهذيبين: «الخمر والله لا أسرق».
4. ليس التهذيبين: «فيه».
(300)
الحديث 1324: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة، وحدّثنا عمّن ذكره، عن ميسرة قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته فليس عليك شيء، لأنّ فعلك[1] طاعة للّه عزّ وجلّ، وما كان عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فعليك الكفّارة.
المصادر: الكافي 7: 447، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ح10، وسائل الشيعة 23: 248، كتاب الايمان، أبواب الأيمان، ب23 ح4، جامع أحاديث الشيعة 577: 24، كتاب الأيمان وأبوابها، باب أنّ اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام....ح4.
الحديث 1325: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عمّا يكفّر من الأيمان فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثمّ فعلته فليس عليك شيء، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثمّ فعلته، فعليك الكفّارة.
المصادر: الكافي 7: 447، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ح9، وسائل الشيعة 23: 251، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب24 ذيل ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح.[2]
--------------------------------------------------
1. في الوسائل: «فعالك».
2. مرآة العقول 24: 327.
(301)
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «وما لم يكن واجباً» لعلّ المراد بالواجب الراجح.[1]
الحديث 1326: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ»[3]؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن، فقل: إن شاء الله.
المصادر: الكافي 7: 448، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب الإستثناء في اليمين، ح3، تهذيب الأحكام 8: 281، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب4 باب الأيمان والأقسام، ح18، وسائل الشيعة 23: 256 كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب29 ح1، جامع أحاديث الشيعة 24: 588، كتاب الأيمان وأبوابها، ب37باب حكم استثناءمشيئة الله...ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله تعالى: «وَاذْكُرْ رَبَّكَ»[4].
أقول: قبله في الآية: «وَ لاَ تَقُولَنَّ لِشَاىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَ لِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله»[5].
وقال طبرسي: نهي من الله لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقول: إنّي أفعل شيئاً في الغد، إلاّ أن يقيّد ذلك بمشيئة الله، فيقول: انشاء الله.
«وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ»[6] الاستثناء، ثمّ تذكرّت فقل: انشاء الله، وإن كان بعد
--------------------------------------------------
1. ملاذ الاخيار 14: 37.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
3 ، 4. سورة الكهف 18: 24.
5. سورة الكهف 18: 23 و24.
6. سورة الكهف 18: 24 .
(302)
يوم أو شهر أو سنة، عن ابن عبّاس، وقد روي ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام .
ويمكن أن يكون الوجه فيه أنّه إذا استثنى بعد النسيان، فإنّه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام، وفي ابطال الحنث وسقوط الكفّارة في اليمين، وهو الأشبه بمراد ابن عبّاس، انتهى.[1]
الحديث 1327: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله عليهالسلام، قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن كان بعد أربعين صباحاً، ثمّ تلا هذه الآية: «وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ»[2].
المصادر: الكافي 7: 448، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب الإستثناء في اليمين ح 6، وسائل الشيعة 23: 257، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب29 ح4، جامع أحاديث الشيعة 24: 590 كتاب الأيمان وأبوابها، ب37 باب حكم استثناء مشيئة الله... ح11.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الإستثناء، لا في أصل اليمين كما تفطّن به الطبرسي رحمهالله، وبه أوّل كلام ابن عباس أيضاً.
و قال السيّد في شرح النافع: أطبق الأصحاب على أنّه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشيئة الله، ونصّ الشيخ والمحقّق وجماعة على أنّ الاستثناء بالمشيئة يقتضي عدم انعقاد اليمين، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني، وهي قاصرة سنداً ومتناً، ومن ثمّ فصّل العلاّمة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الإستثناء إن كان المحلوف عليه واجباً أو مندوباً وإلاّ فلا، وله وجه وجيه، لأنّ غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط،
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14: 17.
2. سورة الكهف 18: 24.
(303)
وهو تعلّق المشيئة بخلاف الواجب والمندوب، ويجب قصر الحكم أيضاً على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرّك، فإنّه لا يفيد شيئاً، وحكم جدّي في الروضة بعدم الفرق، لإطلاق النصّ والمشهور أنّ الإستثناء إنّما يقع باللفظ واستوجه العلاّمة في المختلف الإكتفاء بالنيّة، وهو جيّد، ورواية عبد الله ابن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلاً، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنيّة، وأظهر الإستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر، فإنّه عند من يعتدّ به لا يقيّد بالأربعين، ونقل عن ابن عباس أنّه كان يقول: بجواز تأخير الإستثناء مطلقاً إلى أربعين يوماً، وحكي عنه في الكشّاف أنّه جوّز الإستثناء ولو بعد سنة، ما لم يجب.[1]
الحديث 1328: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: لا أرى للرّجل أن يحلف إلاّ بالله؛[2] وقال: قول الرّجل حين يقول: (لا بل شانئك)[3] فإنّما هو من قول الجاهليّة، ولو[4] حلف النّاس بهذا وشبهه[5] ترك[6] أن يحلف بالله.
المصادر: الكافي 7: 450، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلاّ بالله عزّ وجلّ، ح3، تهذيب الأحكام 8: 278، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب4 باب الأيمان والأقسام...ح3، وسائل الشيعة 23: 261، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب30 ح5، جامع أحاديث الشيعة 24: 532، كتاب الأيمان وأبوابها، ب7 باب أنّ اليمين لا تنعقد بغير الله وأسمائه الخاصّة و...، ح15.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 24: 329.
2. في التهذيب زيادة: «تعالى».
3. في الوسائل: «لاب لشانيك».
4. في التهذيب: «فلو».
5. في التهذيب: «وأشبهه».
6. في الوسائل: «لترك».
(304)
الحديث 1329: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره[1] وقلت له: الله أحلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب.. . الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 23: 272، كتاب الأيمان، أبواب الأيمان، ب35 ح2، صدر الحديث وأورده في ج22: 38، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، ب15، ذيل ح2. وقد مرّ الحديث بتمامه في الصفحه 206، رقم الحديث 1254، فراجع هناك.
--------------------------------------------------
1. في الكافي والتهذيب والجامع: «رأسه» بدل «ظهره».
(305)
كتاب النذر والعهد
(307)
أبواب النذر والعهد
الحديث 1330: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يقول: عليّ نذر، ولم يسمّ شيئا؟ قال: ليس بشيء.
المصادر: الكافي 7: 441، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب ما لايلزم من الأيمان والنذور، ح9، وسائل الشيعة 23: 296، كتاب النذر والعهد، أبواب النذر والعهد، ب2 ح2، جامع أحاديث الشيعة 24: 605، كتاب النذر والعهد وأبوابهما، ب 2 باب أنّ من نذر وسمّى المنذور فهو عليه و... ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وعليه الفتوى، قال في النافع: لا ينعقد لو قال: للّه عليّ نذر واقتصر به.[1]
الحديث 1331: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال: إن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً، وإن شاء تصدّق برغيف.
المصادر: الكافي 7: 463، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب النوادر، ح 18، تهذيب
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 24: 317.
(308)
الأحكام، 8: 308، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، ب5 باب النذور، ح23، وسائل الشيعة 23: 296، كتاب النذر والعهد، ب2 ح3، جامع أحاديث الشيعة 24: 606، كتاب النذر والعهد وأبوابهما، ب2 باب أنّ من نذر وسمّى المنذور...، ح6.
قال الحرّ العاملي:
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسميّة إجمالاً، لا تفصيلاً[1].
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «ولم يسمّ شيئاً» لعلّ المراد أنّه لم يسمّ شيئاً مخصوصاً، ولكن سمّى قربةً وطاعةً مثلاً، كما هو المشهور. أو يحمل على الاستحباب، ليوافق الخبر السابق.
وقال في الشرائع: لو نذر أن يفعل قربة ولم يعيّنها، كان مخيّراً إن شاء صام وإن شاء تصدّق بشيء، وإن شاء صلّى ركعتين. وقيل: يجزيه ركعة، انتهى.[2]
الحديث 1332: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ الجرجانيّ، عمّن حدّثه، عن أحدهما عليهالسلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النّوائب.. . الحديث.
المصادر: وسائل الشيعة 23: 303، كتاب النذر والعهد، أبواب النذر والعهد، ب6 ح2، صدر الحديث وأورده بتمامه في ج16: 316، كتاب الأمر والنهي، أبواب فعل المعروف، ب10 ح3، وأورد صدره أيضاً في ج18: 429، كتاب الضمان، أبواب الضمان، ب7 ح7. وقد مرّ الحديث في المجلّد الثاني، رقم الصفحة 477، رقم الحديث 881، فراجع هناك.
--------------------------------------------------
1. الوسائل 23: 297.
2. ملاذ الأخيار 14: 78.
(309)
كتاب الصيد والذبائح
(311)
أبواب الصيد
الحديث 1333: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سالم، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يسرّح كلبه المعلّم ويسمّي إذا سرّحه، فقال[1]: يأكل ممّا أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلاّ فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شيء[2] مكلّب إلاّ الكلب.
المصادر: الكافي 6: 203، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، ح4، وسائل الشيعة 23: 332، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب1 ح2، صدر الحديث، وأورد ذيله في ص339، ب3 ح1، وأورد ذيله أيضاً في ص343، ب6 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 31، كتاب الصيد والذبائح والاطعمة، أبواب الصيد، ب2 باب أنّ الرجل إذا أرسل كلبه المعلّم و...، ح4.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
--------------------------------------------------
1. في الوسائل والجامع: «قال».
2. في الوسائل زيادة: «يؤكل منه» .
(312)
الحديث صحيح. وقوله عليهالسلام: «وإن وجد معه كلباً» لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم موته بجرح المعلّم كما هو ظاهر الخبر وعليه الأصحاب.
وقوله عليهالسلام: «مكلّب إلاّ الكلب» لعلّه عليهالسلام استدلّ بقوله تعالى «مُكَلِّبِينَ»[1] ردّاً على المخالفين.[2]
الحديث 1334: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل[3] يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين يذكّيه[4] بها أ يدعه[5] حتّى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزّ وجلّ: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[6] ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتل الفهد.
المصادر: الكافي 6: 204، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد ح8، تهذيب الأحكام 9: 23، كتاب الصيد والذبائح، ب 1 باب الصيد والذكاة، ح93، وسائل الشيعة 23: 344، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب6 ح2 ذيل الحديث، وأورد صدره في ص347، ب8 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 39، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب2 باب أنّ الرجل إذا أرسل كلبه المعلّم و...، ح 34.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
الحديث صحيح. وقال في الدروس: ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب حتّى يقتله، وعليها القدماء وأنكرها ابن إدريس.
--------------------------------------------------
1. سورة المائدة 5: 4 .
2. مرآة العقول 21: 337 .
3. في التهذيب: «عن رجل».
4. في التهذيب والوسائل: «فيذكيه».
5. في الوسائل: «أفيدعه».
6. سورة المائدة 5: 4.
(313)
فرع، وقال في الدروس: ويجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ: لا يجب، لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل.[1]
وقال أيضاً:
قوله: «أفيدعه» في بعض النسخ: ليدعه حتى يقتله ويأكل منه، وقال: لا بأس.
وفي الكافي هكذا: ولا يكون معه سكين يذكّيه بها أيدعه. وهو الظاهر.
وعلى ما في الكتاب فاعل«قال» هو جميل أيضاً، وعلى ما في بعض النسخ الفاعل الإمام عليهالسلام .
وقال في المسالك: إذا أرسل سلاحه من سهم وسيف وغيرهما، أو كلبه المعلّم إلى صيد فأصابه، فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيّاً حلّ، وإن أدركه حيّاً نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرّة ـ بأن كان قد قطع حلقومه أو أجافه وخرق أمعاءه فتركه حتّى مات ـ حلّ، وإن بقيت فيه حياة مستقرّة وجبت المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد، فإن أدرك ذكاته حلّ.
وإن تعذر من غير تقصير الصائد حتّى مات، فهو كما لو لم يدركه حيّاً، وإن لم يتعذّر وتركه حتّى مات فهو حرام، وكذا الحكم لو كان التعذّر بتقصير من جهته ومن هذا القبيل أن لا يكون معه مدية يذبح بها، فإن ترك استصحاب الآلة تقصير منه. وما ذكرناه من التفصيل باستقرار الحياة هو المشهور بين الأصحاب، والأخبار خالية منه، وقال الشيخ نجيب الدين: اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب.
ثمّ اعلم أنّه قال الشيخ في النهاية: إنّه إذا أدركه حيّاً ولم يكن معه آلة يترك الكلب حتّى يقتله، ثمّ ليأكل إن شاء، واختاره جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 338.
(314)
والعلاّمة في المختلف، استناداً إلى عموم الآية وخصوص صحيحة جميل.
وأجيب عن الرواية: بأنّها لا تدلّ على المطلوب، فإنّ الضمير المستكن في قوله: «فيأخذه» راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، والبارز إلى الصيد، وهذا لا يدلّ على بطلان امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع.
وفيه نظر، إذ الرواية ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات.[1]
الحديث 1335: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[2]عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: ما تقول في البازي والصّقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فَكُل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
المصادر: الكافي 6: 208، كتاب الصيد، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك، ح7، وسائل الشيعة 23: 352، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب9 ح11، جامع أحاديث الشيعة 28: 45، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب 5 باب حكم ما يصيده غير الكلب...، ح9.
الحديث 1336: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: كان أبي عليهالسلام يفتي في زمن بني أميّة: أنّ ما قتل البازي والصّقر فهو حلال، وكان يتّقيهم، وأنا لا أتّقيهم، وهو حرام ما قتل.
المصادر: الكافي 6: 208، كتاب الصيد، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ح8، وسائل الشيعة 23: 352، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب9 ح12، جامع أحاديث الشيعة
--------------------------------------------------
1. ملاذ الخيار 14: 164.
2. في الوسائل زيادة: «عن».
(315)
28: 47، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب5باب حكم ما يصيده غير الكلب...، ح14.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله عليهالسلام: «وهو» الضمير إمّا للشأن، أو من باب زيد قائم أبوه.[1]
وقال أيضاً:
قوله عليهالسلام: «وهو حرام» الضمير للشأن، أو مبهم يفسّره «ما قتل».[2]
الحديث 1337: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و[3]محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا رميت بالمعراض، فخرق فَكُل، وإن لم يخرق، واعترض فلا تأكل.
المصادر: الكافي 6: 212، كتاب الصيد، باب المعراض، ح3، وسائل الشيعة 23: 370، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب22 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 54، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب7 باب أنّ الصيد إذا قتل بالسيف والرمح و...، ح17.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي رحمهالله :
الحديث صحيح، وقد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث، وصحّحوها بالخاء والزاء المعجمتين، قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدي: «قلت يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: إنّا نرمي بالمعراض، فقال: ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل» خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرّمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق.[4]
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 21: 344.
2. ملاذ الاخيار 14: 181.
3. في الوسائل زيادة: «عن».
4. مرآة العقول 21: 351.
(316)
وقال أيضاً:
وقال في القاموس: المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.[1]
الحديث 1338: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال[2]: لا.
المصادر: الكافي 6: 213، كتاب الصيد، باب مايقتل الحجر والبندق، ح5، تهذيب الأحكام 9: 36، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح 150، وسائل الشيعة 23: 375، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب23 ح6، جامع أحاديث الشيعة 28: 54، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب7 باب أنّ الصيد إذا قتل بالسيف والرمح و...، ح 10.
الحديث 1339: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه[3] قال: نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن إتيان[4] الطّير باللّيل، وقال عليهالسلام: إنّ اللّيل أمان لها.
المصادر: الكافي 6: 216، كتاب الصيد، باب صيد الليل ح3، تهذيب الأحكام 9: 14، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح51، الاستبصار 4: 64، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب41 باب كراهية صيد الليل، ح1، وسائل الشيعة 23: 381، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب28 ح2، جامع أحاديث الشيعة 28: 67، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب18 باب حكم الصيد الطبر في أوكارها والوحش في أوطانها ليلاً و... ،ح2.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الخيار 14: 188.
2. في التهذيب والوسائل: «قال».
3. ليس في التهذيبين والوسائل: «أنّه».
4. في الوسائل: «عن بيات» بدل «عن إتيان».
(317)
الحديث 1340: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التّميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: استوصوا بالصّنينات خيراً ـ يعني: الخطّاف[1] فإنّهنّ آنس طير النّاس بالنّاس، ثمّ قال: وتدرون ما تقول الصّنينة إذا[2] مرّت وترنّمت تقول بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين حتّى قرأ أمّ الكتاب فإذا كان آخر ترنّمها قالت: ولا الضّالّين مدّ بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صوته ولا الضالّين.
المصادر: الكافي 6: 224، كتاب الصيد، باب الخطّاف، ح2، وسائل الشيعة 23: 393، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب39 ح4، جامع أحاديث الشيعة 21: 614، أبواب أحكام الدواب، ب34 باب ما ورد من الأستيصاء با لصينينات وهي الخطّاف، ح1.
الحديث 1341: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن سليمان الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن الرّضا عليهالسلام يقول: لاتقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنّها كثيرة التّسبيح، تقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد عليهمالسلام .
المصادر: الكافي 6: 225، كتاب الصيد، باب القنبرة، ح3، وسائل الشيعة 23: 396، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب41 ح3، جامع أحاديث الشيعة 28: 79، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الصيد، ب24 باب كراهة قتل القنبرة و...، ح1.
أبواب الذبائح
الحديث 1342: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، (وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر)[3]، عن يونس بن
--------------------------------------------------
1. الخطّاف: طائر، قال: ابن سيدة والخطّاف العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامّة عصفور الجنّة، وجمعه خطاطيف. (لسان العرب 2: 279، انظر مادة «خطف»).
2. في الوسائل زيادة: «هي».
3. ليس في سند التهذيب: «عليّ بن محمّد» وفيه: «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» بدل «عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر».
(318)
يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام: إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر، وإنّما ينحرون في اللّبّة[1][2] فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال عليهالسلام: «فَذَبَحُوهَا وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»[3] لا تأكل إلاّ ما ذبح.
المصادر: الكافي 6: 229، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، ح3، تهذيب الأحكام 9: 53، كتاب الصيد والذبائح، ب1، باب الصيد والذكاة، ح219، وسائل الشيعة 24: 14، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب5 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 92، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب4 باب أنّ الإبل ينحر وما سواها يذبح، ح3.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
استدلّ عليهالسلام بالآية على أنّ البقرة مذبوحة لا منحورة، لقوله تعالى «فَذَبَحُوهَا»[4]، إمّا بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين، أو بأنّ حلّ الذبيحة إنّما يكون على الوجه الذي قرّره الشارع،الذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم، فلا يجوز الاكتفاء به.[5]
وقال أيضا:
استدلّ عليهالسلام بالآية على وجوب ذبحها، حيث قال في بقرة بني إسرائيل: «فَذَبَحُوهَا»[6] وقال: «أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً»[7] ولم يذكر النحر.[8]
الحديث 1343: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الشّاة: إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة.
--------------------------------------------------
1. اللّبّةُ: وسط الصدر والمَنْحَر، والجمع لَبّاتٌ ولبابٌ. (لسان العرب 5: 468، انظر مادة «لبب»).
2. في التهذيب والوسائل زيادة: «البقر».
3 ، 4. سورة البقرة 2: 71.
5. مرآة العقول 22: 8.
6. سورة البقرة 2: 71.
7. سورة البقرة 2: 67.
8. ملاذ الأخيار 14: 222.
(319)
المصادر: الكافي 6: 233، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، ح6، تهذيب الأحكام 9: 56، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح234، وسائل الشيعة 24: 23، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب11 ح4، جامع أحاديث الشيعة28: 105، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب11 باب أنّ الذبيحة إِذا طرفت عينها...، ح6.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في الصحاح: الطرف العين، ولا يجمع، لأنّه في الأصل مصدر، وطرف بصره يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر.
وقال في المسالك: اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلّها الأمرين معا: الحركة وخروج الدم، واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين بأحد الأمرين، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها.
ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة، وفي بعضها بخروج الدم، فالأوّلون جمعوا بينها بالجمع، والمتوسّطون اعملوا كلّ واحد منفرداً، لعدم المنافاة، والباقون نظروا إلى أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الحركة أوضح سندا وهو أقوى.[1]
الحديث 1344: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها[2] تطرف عينها (أو تحرّك أذنيها)[3] أو تمصع بذنبها، فاذبحها، فإنّها لك حلال.
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14: 231.
2. في الوسائل: «فرأيتها».
3. في التهذيب: «أو تحرّك ذنيها» بدل «أو تحرّك اُذنيها».
(320)
المصادر: الكافي 6: 232، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، ح4، تهذيب الأحكام 9: 57، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح238، وسائل الشيعة 24: 23، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب11 ح5، جامع أحاديث الشيعة28: 104، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب11 باب أنّ الذبيحة إِذا طرفت عينها...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «أو تحرّك ذنبها»، في الكافي «أذنيها» وهو أصوب. وعلى ما في الكتاب فالترديد من الراوي أو أحدهما محمول على التحريك الخفيف والآخر على الشديد. وقال في القاموس: مصعت الدابّة بذنبها حرّكته وضربت به.[1]
الحديث 1345: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بنالحصين، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحوار تذكّى أمّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشّعر فكل.
المصادر: الكافي 6: 234، كتاب الذبائح، باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح، ذيل ح3، وسائل الشيعة 24: 33، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب18 ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 107، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب13 باب أنّ الجنين ذكاته ذكاة أمّه...، ذيل ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال الفيروزآبادي: الحوار ـ بالضمّ وقد يكسر ـ ولد الناقة، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمّه.[2]
الحديث 1346: روى أبو الحسين[3] الأسديّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليهالسلام أنّه قال: سألته عمّا
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14: 233، وراجع مرآة العقول 22: 14.
2. مرآة العقول 22: 18، وملاذ الأخيار 14: 237، وراجع كتاب الوافي 19: 232.
3. في الوسائل زيادة: «محمّد بن جعفر».
(321)
أهلّ لغير الله، قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم الله ذلك، كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟ فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل، فقيل له: يا رسول الله، إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحلّ لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا[1] بقلاً فشأنكم بهذا[2]، قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى قوله عزّ وجلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ»[3] قال: العادي السّارق، والباغي الّذي يبغي الصّيد بطرا ولهوا[4] لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر، قال: قلت له: فقوله تعالى: «وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[5] قال: المنخنقة: الّتي انخنقت بأخناقها حتّى تموت، (والموقوذة: الّتي مرضت، ووقذها[6] المرض حتّى لم تكن بها حركة)[7]، والمتردّية: الّتي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردّى[8] من جبل أو في بئر فتموت، والنّطيحة: الّتي تنطحها[9] بهيمة أخرى فتموت، وما أكل السّبع منه فمات، وما ذبح على
--------------------------------------------------
1. في الفقيه والجامع: «أو تحتفئوا».
2. في الفقيه: «بها» بدل «بهذا».
3. سورة البقرة 2: 173، وسورة الأنعام 6: 145، وسورة النحل 16: 115 .
4. في الفقيه: «أو لهواً».
5. المائدة 5: 3.
6. في الفقيه: «وقذفها» بدل «ووقذها».
7. ليس في الوسائل: «والموقوذه التي مرضت، ووقذها المرض حتّى لم تكن بها حركة».
8. في الوسائل والجامع: «تردّى».
9. في الوسائل: «نطحتها».
(322)
النّصب على حجر أو على[1] صنم إلاّ ما أدركت[2] ذكاته فذكّي، قلت: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرةً سبعة لهم[3] أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، أمّا الّتي لها أنصباء: فالفذّ، والتّوأم، والنّافس، والحلس، والمسبل، والمعلّى، والرّقيب، وأمّا الّتي لا أنصباء لها: فالسّفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا[4] يجيلون السّهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك[5] حتّى تقع السّهام[6] الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة[7] فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه ويأكله السّبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثّلاثة الّذين وفّروا[8] ثمنه شيئا، فلمّا جاء الإسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم وقال عزّ وجلّ: «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ»[9] يعني حراما.
المصادر: تهذيب الأحكام 9: 83، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح 89، ورواه الصدوق بإسناده، عن أبي الحسين الأسدي مثله في الفقيه 3: 218 ذيل ح 1007، وسائل الشيعة 24: 37، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب19 ح3 قطعه منه، وأورد صدر الحديث في ص212، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب55 ح1، وأورد الشطر الثاني منه في ص214، ب56 ح1، وبقية ذيله في
--------------------------------------------------
1. ليس في الفقه والوسائل: «على».
2. في الفقيه: «إلاّ ما أدرك».
3. في الفقيه: «لها» بدل «لهم».
4. في الفقيه والجامع: «فكانوا».
5. في الفقيه: «بذلك».
6. في الفقيه زيادة: «الثلاثة».
7. في الفقيه زيادة: «منهم».
8. في الفقيه: «انقدوا» بدل «وفّروا».
9. سورة المائدة 5: 3.
(323)
ص217، ب57 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 191، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطمة، ب3 باب تحريم ما اُهلّ لغير الله به و...، ح7.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في مصباح اللغة: الصنم يقال هو الوثن المتّخذ من الحجارة أو الخشب ويروى عن ابن عبّاس، ويقال: الصنم المتّخذ من الجواهر المعدنيّة التي تذوب والوثن هو المتّخذ من حجر أو خشب أو نحاس أو فضّة.
ولا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها،لا يرخّص الباغي والعادي.
واختلف في المراد منهم كما مرّ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي قاطع الطريق، لرواية ابن أبي نصر.
وقيل: الباغي الذي يبغي الميتة، أي: يرغب في أكلها، والعادي الذي يعدو شبعه.
وقيل: الباغي الذي يبغي الصيد بطرا. ونقل الطبرسيّ رحمهالله أنّه باغي اللذّة وعادي سدّ الجوعة. أو العادي بالمعصية، أو باغ في الإفراط وعاد في التقصير.
وفي القاموس: المخمصة المجاعة، انتهى.
قوله: «ما لم تصطبحوا» هذا الخبر رواه العامّة أيضا عن أبي واقد، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله، واختلفوا في تفسيره.
فقال في النهاية: ومنه الحديث: أنّه سأل متى تحلّ لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بها بقلاً. الاصطباح هنا: أكل الصبوح وهو الغذاء.
والغبوق: العشاء. وأصلهما في الشرب ثمّ استعملا في الأكل، أي: ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة.
قال الأزهري: قد أنكر هذا على أبي عبيد، وفسّر أنّه أراد إذا لم تجدوا لبينة
(324)
تصطبحونها أو شرابا تغتقبونه ولم تجدوا بعد الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلّت لكم الميتة. وقال: هذا هو الصحيح.
وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبو سعيد الضرير: صوابه ما لم تحتفوا بها بغير همز من إحفاء الشعر. ومن قال تحتفئوا مهموزا من الحفأ وهو البرديّ فباطل، لأنّ البرديّ ليس من البقول.
وقال أبو عبيد: هو من الحفاء مهموز مقصور، وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه وقد يؤكل، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ويروى: «ما لم تحتفّوا» بتشديد الفاء من احتففت الشيء إذا أخذته كلّه، كما تحف المرأة وجهها من الشعر.
وقال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث «متى تحلّ لنا الميتة؟ قال: ما لم تجتفئوا بقلاً» أي: تقتلعوه وترموا به، من جفأت القدر إذا رميت بما يجتمع على رأسها من الزبد والوسخ.
وقال في باب الخاء مع الفاء: أو تختفوا بقلاً، أي تظهرونه، يقال: خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته، انتهى.
أقول: يمكن أن يكون المراد ما لم تأكلوا على عادة الاصطباح والاغتباق، بأن تأكلوا متملّيا وتشبعوا منها.
وقوله «أو تحتفوا بقلاً» أي: تستأصلوها وتأكلوها جميعا، بأن يكون احتفاء البقل كناية عن استئصالها، فإنّ مثل هذا التعبير شائع في عرفنا على سبيل التمثيل فلعلّه كان في عرفهم أيضا كذلك.
وفي بعض نسخ الكتاب «تحتقبوا» بالحاء المهملة والقاف والباء الموحّدة فالمراد الإدّخار، أي: ما لم يكن معكم بقل ادّخرتموه.
قال في القاموس: احتقبه ادّخره. وقال: الحقيبة كلّ ما شدّ في مؤخّر رحل
(325)
أو قتب. والظاهر أنّه تصحيف، والله تعالى يعلم.
قوله عليهالسلام: «المنخنقة التي انخنقت» قال في القاموس: خنقه خنقا ككنف فهو خنق، كخنقه فاختنق وانخنقت الشاة بنفسها، وككتاب الحبل يخنق به،كغراب داء يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرية والقلب، ويقال أيضا: أخذ بخناقه بالضمّ والكسر وبخنقه أي بحلقه، انتهى.
ويمكن أن يقرأ أخناقها بالفتح والكسر، وكلاهما لا يخلو من تكلّف أو تجوّز.
قوله عليهالسلام: «والموقوذة التي مرضت» قال في القاموس: الوقذ شدّة الضرب وشاة وقيذ وموقوذ قتلت بالخشب، والوقيذ الصريع والبطيء والثقيل والشديد المرض المشرف كالموقوذ.
وقال أيضا: نطحة كمنعه وضربه أصابه بقرنه، والنطيحة التي تموت به.
وقال أيضا: الزلم محرّكة قدح لا ريش عليه.
وقال أيضا: القدح بالكسر السهم الجمع قداح.
قوله عليهالسلام: «إلاّ ما أدركت ذكاته» في الآية وقع الاستثناء بعد قوله: «وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ»[1] والتأخير إمّا من النسّاخ، أو الروّاة، أو منه عليهالسلام ليعلم أنّ الاستثناء جار في الجميع، وإنّما ذكره بعد أكيل السبع لبعد إدراك الذكاة فيما سواه.
قوله عليهالسلام: والسبل في بعض النسخ «المسبل».
وقال في القاموس: المسبل كمحسن السادس أو الخامس من قداح الميسر.
وقال في الصحاح: الفذ أوّل سهام الميسرة، وهي عشرة: أوّلها الفذ، ثمّ التوأم، ثمّ الرقيب، ثمّ الجلس، ثمّ النافس، ثمّ المسبل، ثمّ المعلّى. وثلاثة لا أنصباء لها، وهي السفيح والمنيح والوغد، انتهى.
--------------------------------------------------
1. سورة المائدة 5: 3 .
(326)
والخبر يدلّ على جواز تعليم القمار وتعلّمه، لا لأن يعمل بل لأن يجتنب.[1]
الحديث 1347: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن درّاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر[2]، في نوادر الجمعة.
المصادر: الكافي 6: 236، كتاب الذبائح، باب الأوقات التي يكره فيها الذبح، ح2، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في تهذيب الأحكام 9: 60، كتاب الصيد والذبائح، ب1 باب الصيد والذكاة، ح254، وسائل الشيعة 24: 40، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب21 ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 137، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب22 باب كراهة الذبح بالليل...، ح1.
قال الحرّ العاملي:
أقول: «ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما». وجاء في هامش الوسائل: الظاهر أنّ مراد الكليني أنّ الحديث الثاني مرويّ في نوادر الجمعة من كتاب عليّ بن إسماعيل، ولفظة «وعن» ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدؤا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنّه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. «منه قدسسره».[3]
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على كراهة الذبح ليلاً كما ذكره الأصحاب، وقوله «في نوادر الجمعة»
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14: 292ـ297 .
2. في التهذيب والجامع زيادة: «ويقول: إنّ الله تعالى جعل الليل سكناً لكلّ شيء، قال: قلت: جعلت فداك، فإن خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح». وليس فيهما: «في نوادر الجمعة».
3. وسائل الشيعة 24: 41 .
(327)
لعلّ المعنى أنّ هذا الخبر أورده عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة، ولعلّ هذا كان مكتوبا في الخبر الأوّل، إمّا في الأصل أو على الهامش فأخّره النسّاخ.[1]
الحديث 1348: وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام[2] ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
المصادر: وسائل الشيعة 24: 54، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب27 ح6 وأورده في ج20: 533، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ب1 ح2. وقد مرّ الحديث في الصفحة 137، رقم الحديث 1165، فراجع هناك.
الحديث 1349: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر؛ وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان، قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله عليهالسلام: لا تأكل من ذبائح اليهود والنّصارى ولا تأكل في آنيتهم.
المصادر: الكافي 6: 240، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، ح11، وسائل الشيعة 24: 54، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب27 ح7، جامع أحاديث الشيعة 28: 119، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب18 باب حكم ذبائح أهل الكتاب و...، ح2.
الحديث 1350: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبي عبدالله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 20 .
2. في الوسائل: «كان عليّ عليهالسلام» بدل «عليّ بن الحسين».
(328)
المصادر: الكافي 6: 240، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، ح12، وسائل الشيعة 24: 54، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب27 ح8، جامع أحاديث الشيعة 28: 122، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب18 باب حكم ذبائح أهل الكتاب و...، ح 12.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
وظاهر تلك الأخبار أنّه يحلّ مع العلم بالتسميّة كما ذهب إليه الصدوق رحمهالله، ويمكن أن يقال: مع سماع التسميّة أيضاً لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله من المسيح عليهالسلام وغيره.[1]
الحديث 1351: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي غفيلة[2] الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقّي، عن بشر[3] بن أبي غيلان الشّيباني قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنّصارى والنصّاب، قال: فلوى شدقه وقال: كُلْها إلى يوم مّا.
المصادر: تهذيب الأحكام 9: 70، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح34، الإستبصار 4: 87، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، ب52 باب ذبائح الكفّار، ح33، وسائل الشيعة 24: 60، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب27 ح28، جامع أحاديث الشيعة 28: 132، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب18 باب حكم ذبائح أهل الكتاب و...، ح56.
قال الشيخ الطوسى:
قال الشيخ رحمهالله: والمخالف لآل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم على ضربين: ضرب: يحلّ أكل ذبائحهم، وهم الذين لا يعادون آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ويظهرون مودّتهم، والثاني:
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 22: 26 .
2. في الوسائل: «ابن أبي عقيلة».
3. في الاستبصار والوسائل: «بشير».
(329)
لا تحلّ ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمّد عليهمالسلام .
وقال الحرّ العاملي:
أقول: هذا ظاهر في التقيّة وفي المنع مع عدمها كما قاله الشيخ وغيره[1].
الشرح: قال الفيض الكاشاني:
بيان: الشدق جانب الفم، ولعلّه أراد عليهالسلام «بيوم ما» يوم رفع التقيّة وظهور دولة الحقّ.
وفي هذا الحديث دلالة على أنّ أخبار جواز الأكل محمولة على حالة التقيّة أو أنّ الفتوى بها وردت تقيّة ويحتمل ذلك، لأنّ المخالفين يجيزون أكل ذبيحتهم، ويمكن حملها على ما إذا سمعوا يذكرون اسم الله عليها كما أشرنا إليه، أو حمل مقيّداتها بما ذكر اسم الله عليه على من كان منهم على أمر موسى وعيسى عليهماالسلام، كما دلّ عليه حديث ابن وهب السابق.[2]
الحديث 1352: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي غفيلة الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقّي، عن بشر بن أبي غيلان الشّيباني قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كُلْها إلى يوم ما.
المصادر: وسائل الشيعة 24: 68، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب28 ح6. مرّ الحديث آنفا في الصفحة 328، رقم الحديث 1351، فراجع.
الحديث 1353: حدّثنا محمّد بن أحمد السنانيّ رضىاللهعنه، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله[3]
--------------------------------------------------
1. تهذيب الأحكام 9: 71، وانظر: المقنعة: 579، ب2 باب الذبائح والأطعمة، وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه.
2. كتاب الوافي 19: 260، وراجع ملاذ الأخيار 14: 260 .
3. ليس في الوسائل: «بن عبد اللّه».
(330)
الحسنيّ رضىاللهعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن قول الله تعالى: «وَ تَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ»،[1] فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لايوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخلّى بينهم وبين اختيارهم، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: «خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ»،[2] قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم كما قال عزّ وجلّ: «بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً»،[3] قال: وسألته عن الله عزّ وجلّ هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال: بل يخيّرهم ويمهلهم حتّى يتوبوا، قلت: فهل يكلّف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول: «وَ مَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ»[4] ثمّ قال عليهالسلام: حدّثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّه قال: من زعم أنّ الله تعالى يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا.
المصادر: عيون أخبارالرضا 1 :123، ب11 باب ما جاء عن الرضا عليّ بن موسى عليهالسلام، ح16، وسائل الشيعة 24: 69، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب28 ح9، جامع أحاديث الشيعة28: 117، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب17 باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين و...، ح9.
الحديث 1354: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى ما يصنع القصابون، قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فَكُلْ
--------------------------------------------------
1. سورة البقرة 2: 17.
2. سورة البقرة 2: 7.
3. سورة النساء 4: 155.
4. سورة فصّلت 41: 46.
(331)
ولا تسأل عنه.
المصادر: تهذيب الأحكام 9: 72، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح41، وسائل الشيعة 24: 70، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب29، ذيل ح1، جامع أحاديث الشيعة28: 135، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، أبواب الذبائح، ب19 باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين و...، ح2.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
قال في الشرائع: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله.
وقال في المسالك: لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الإسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين من يستحلّ ذبيحة الكتابيّ وغيره على أصحّ القولين، عملاً بعموم النصّ، واعتبر في التحرير كون المسلم ممّن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب. وهو ضعيف جدّا، لأنّ جميع المخالفين يستحلّون ذبائحهم، فيلزم على هذا أن يجوز أخذه من المخالف مطلقا، والأخبار ناطقة بخلاف ذلك.
واعلم أنّه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف، وفي موثّقة إسحاق بن عمّار: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيعرف سوق الإسلام بأغلبيّة المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا.
وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنّه هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟ بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها، للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة.في الدروس اقتصر على نفي الاستحباب[1].
--------------------------------------------------
1. ملاذ الأخيار 14: 263.
(332)
الحديث 1355: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده يوما[1] عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال عليهالسلام: إنّ في كتاب عليّ عليهالسلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به.
المصادر: الكافي 6: 254، كتاب الأطعمة، باب ما يقطع من أليات الضأن و...، ح1 تهذيب الأحكام 9: 78، كتاب الصيد والذبائح، ب2 باب الذبائح والأطعمة و...، ح65 وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، ب30، ح1، جامع أحاديث الشيعة 28: 208، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، ب10 باب أنّ ما قطع من أعضاء الحيوان الحيّ فهو ميتة...، ح1.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
يدلّ على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال، وأنّ المقطوع من الضأن ميتة حرام، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني رحمهالله في المسالك، حيث قال: إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرّة، فمقتضى القواعد حلّ الجميع، لأنّه مقتول به، فكان بجملته حلالاً، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحرّكا فهما حلالان أيضا، وكذا لو تحرّكتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا، وكذا لو تحرّك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره، وإن تحرّك أحدهما حركة مستقرّة الحياة وذلك لا يكون إلاّ في النصف الذي فيه الرأس، فإن كان قد أثبته بالجراحة الاُولى، فقد صار مقدورا عليه، فتعيّن الذبح، ولا تجزي سائر الجراحات، وتحلّ
--------------------------------------------------
1. ليس في التهذيب والوسائل: «يوماً».
(333)
تلك القطعة دون المبانة، وإن لم يثبته بها، ولا أدرك ذبحه، بل جرحه جرحا آخر مدنفا[1] حل الصيد، دون تلك القطعة، وإن مات بهما ففي حلّها وجهان:
أجودهما العدم، وإن مات بالجراحة الاُولى بعد مضيّ زمان ولم يتمكّن من الذبح حلّ باقي البدن، وفي القطعة المبانة الوجهان، وفي المسألة أقوال منتشرة، منها: أنّه مع تحرّك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرّك خاصّة، وأنّ حلّهما معا مشروط بتساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم،هو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كلّ واحد من النصفين، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرّك واحد منهما حرما، وهو قول القاضي. ومنها: أنّه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما، وإن لم يخرج دم، فإن كان أحد الشقّين أكبر ومعه الرأس حلّ ذلك الشقّ، وإن تحرّك أحدهما حلّ المتحرك، وهو قول ابن حمزة.[2]
--------------------------------------------------
1. في هامش المسالك 11: 439، قال: («فى الحجريّتين: مدنفاً، وفي «ذ،ط،خ» مدفّفا، ودفّف على الجرح كذفّف: أجهز عليه «لسان العرب 2: 396، انظر مادة: دفف»).
2. مرآة العقول 22: 48 .