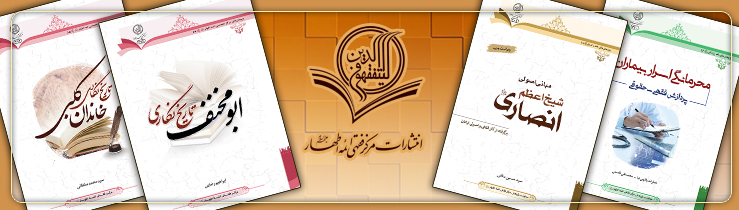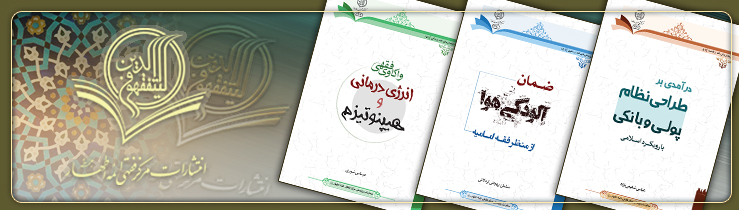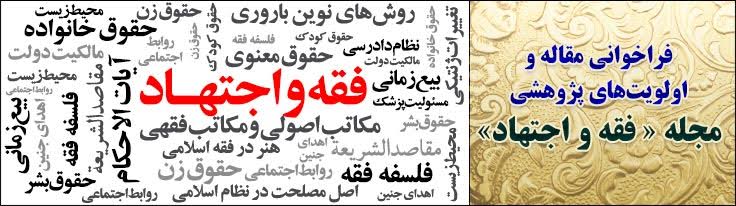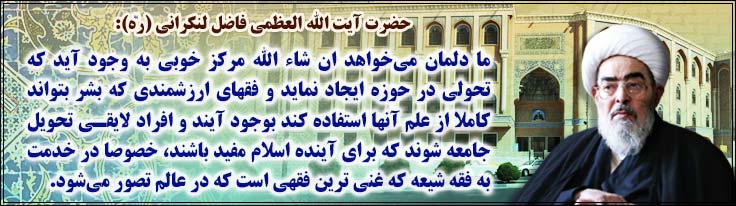أمّا لو التزمنا بوحدة القاعدتين فإنّ إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهّد فمحل إشكال إذ على القول بوحدة القاعدتين فإنّ هناك عنواناً واحداً مشتركاً وهو عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد التجاوز عنه كما أشار إلى ذلك الإمام الخميني وآخرون إلاّ أنّ المذكور في كلام المحقق البروجردي أنّ العنوان الواحد هو عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد المضيّ.
ولا يصدق هذا العنوان (الشيء) على الترتيب والموالاة لتجري فيها القاعدة.
ثمّ يتنازل المحقق العراقي في استمرار كلامه ويقول: لو سلّمنا بجريان القاعدة على القول بوحدة القاعدتين واجهنا إشكالاً آخر وهو أنّ المكلّف إذا أراد أن لا يعتني بشكّه وجب أن يبني على وجود الصحيح أي يجب أن يتعبّد أنّ ما أتى به من الصلاة مصداق لوجود الصلاة الصحيحة، وعليه فلا حاجة إلى قضاء السجدة المنسية أو التشهد الفائت لعدم وجود الخلل هنا، لأنّ قضاء السجدة والتشهّد إنّما يجب فيما لو ترتبت الصحة على العمل على نحو كان الناقصة لا على نحو كان التامة[213].
إشكال: قد يقال هنا بأنّ قضاء السجدة أو التشهّد إنّما ثبت هنا بدليل خاص ولا علاقة لا بمسألة وحدة قاعدتي الفراغ والتجاوز أو تعددّهما.
وبعبارة أخرى فإنّ المكلّف مثلاً لو تيقّن بعد الفراغ من الصلاة بأنّه ترك القراءة لم يُفتِ أحد بوجوب قضاء القراءة بعد الصلاة ولا دليل على وجوب قضائها هنا بخلاف السجدة والتشهّد حيث يوجد دليل خاص على وجوب قضائهما، وعليه فلا علاقة لتعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز ووحدتهما بهذا الأمر.
لكنّه يقال في مقام الردّ عن هذا الإشكال بأنّ الدليل الخاص موجود هنا لكنّ الكلام إنّما هو فيما لو لم نقبل بهذا الدليل وأشكلنا على صحة سنده أو دلالته فنحن نتكلّم عما هو مقتضى القاعدة بغض النظر عن وجود دليل خاص، ولهذا قال المحقق العراقي: بأنّنا لو التزمنا بتعدد قاعدتي الفراغ والتجاوز فإنّ قاعدة الفراغ تثبت الصحّة بمفاد كان الناقصة وأثر هذه الصحة وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسييّن.
وأمّا لو التزمنا بوحدة القاعدتين تثبت بها الصحة بمفاد كان التامّة ولا حاجة حينئذٍ إلى قضاء السجدة أو التشهد. والظاهر أنّ هذه الثمرة التي ذكرها المحقق العراقي ثمرة دقيقة ولا غبار عليها.
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع أبواب الفقه:
لا شك في أن مجرى قاعدة التجاوز هو الشك في وجود أجزاء العمل المركب الواحد كالصلاة ومجرى قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ من مجموع ذلك العمل إنّما الكلام هنا في أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز هل هي مختصّة بباب الطهارة والصلاة.
وبعبارة أخرى هل هي مختصّة بالعبادات حيث تكون ذمّة المكلّف مشغولة بها والشارع إنّما يحكم بعدم الاعتناء بالشك من باب الامتنان ليرى المكلّف ذمتّه بريئةً، أو أنّها تجري في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات ومن العقود والايقاعات؟
مَن ذهب إلى وحدة قاعدة الفراغ والتجاوز يستفاد من كلماتهم أنّها عامّة لجميع أبواب الفقه حيث يقولون بأنّ مورد قاعدة الفراغ والتجاوز وإن كان الغالب في الروايات هو باب الطهارة والصلاة إلا أنّ إطلاق تلك الروايات والحكم الكلي المستفاد منها إنّما يشمل الطهارة والصلاة وسائر أبواب الفقه من العبادات والمعاملات.
ومن هنا فلو شك في صحة عقدٍ أو إيقاع بعد الفراغ منه حُكم بصحّته، وكذا لو شُك في صحّة غسل الميت وتكفينه ودفنه حكمنا بصحتها بسبب تلك الإطلاقات والعمومات.
ولا وجه لاختصاص هذه القاعدة ببابي الطهارة والصلاة ولهذا يقول صاحب الجواهر في هذا المجال: (إنّ هذه القاعدة محكّمة في الصلاة وغيرها من الحجّ والعمرة وغيرهما)[214].
أمّا على مبنی المشهور ـ وهو مختارنا أيضاً ـ من أنّ قاعدة التجاوز مختلفة تماماً عن قاعدة الفراغ وأدلّتهما متغايرة فلابدّ من دراسة كلّ من القاعدتين على نحو الاستقلال ليتضّح لنا هل يستفاد منها العمومية لجميع أبواب الفقه أولا؟
فبالنظر إلى قاعدة الفراغ قامت الشهرة بل نفي الخلاف بل الإجماع على عدم اختصاصها بباب خاصّ وأنّها تجري في جميع أبواب الفقه. ولإثبات هذا التعميم نقول: إنّ روايات قاعدة الفراغ وردت فيها ثلاثة تعابير يستفاد منها التعميم بوضوح:
التعبير الأوّل: (كلّما شككت فيه مّما قد مضى فأمضه كما هو)[215].
حيث ذكرنا سابقاً بأنّ (من) في (مّما) بيانيّة فتكون العبارة عامّة تشمل أيّ عمل من الأعمال مضافاً إلى عدم وجود السؤال في الرواية عن الصلاة أو عبادة أخرى.
ويمكن أن يورد على دلالة هذه العبارة على التعميم إشكالان:
الإشكال الأوّل: هو أنّ السؤال عن الصلاة وإن لم يرد في هذه الرواية إلاّ أنّ هناك ثلاث روايات أخرى متعلقّة بقاعدة الفراغ وقد ذكر فيها بحث الصلاة بقوله: (فامضه ولا تُعد) ويكون (لا تعد) قرينة على عدم شمولية (كلّما شككت فيه مّما قد مضى فأمضه كما هو) لكلّ مركّب، بل يراد به المركبّات الاعتبارية الشرعية المأمور بها المشتغل بها ذمّة المكلّف وهذه لا تتأتي إلاّ في باب العبادات[216].
والجواب عن هذا الإشكال: إنّ روايات باب الصلاة (امض ولا تعد) لا يمكنها أن تقيّد موثقة ابن بكير (فامضه كما هو) لأنّهما مثبتتان وتشملان على حكمين مستقلين فالتعبير بـ (لا تعد) الوارد في الروايات الأخرى لن يكون صالحاً للقرينيّة، هذا كلّه مضافاً إلى أنّ قوله (لا تعد) في روايات باب الصلاة ليس من القيود الدخيلة في الموضوع بل له عنوان الحكم، والقيد إنّما يكون مقيّداً فيما لو كان دخيلاً في الموضوع فلا يمكن لهذا القيد (لا تعد) أن يقيّد الروايات العامة، فالإشكال غير وارد.
الإشكال الثاني: الوارد على الاستدلال بهذه الرواية هو إنّ في صدر الرواية (كلّما شككت فيه) كلمة (ما) اسم موصول مبهم وكلّما استعمل في الكلام لفظ مبهم لزم تقدير كلمة کي يُرفع بها الإبهام فقوله: (كلّما شككت فيه) مبهم فيحتاج إلى تقدير شيء، وهذا المقدّر مردّ بين الأقل والأكثر إذ لا نعلم أن ما يجب تقديره هو خصوص المركبّات العبادية أو هو الأعمّ من المركبات العبادية وغير العبادية؟ وقد ذُكر في علم الأصول أنّ في موارد إبهام اللفظ لمردّد بين الأقل والأكثر لا يمكن التمسّك بإطلاق اللفظ واستفادة المعنى الأعم منه لأنّ عدم التقييد من مقدمات الحكمة في إثبات الإطلاق، والإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة لا يمكنه أن ينفي القيد الذي يدلّ عليه دال آخر.
أمّا مفهوم الإطلاق والعموم فلا يستفاد من حاقّ اللفظ المطلق.
وفيما نحن فيه لا يمكن استفادة المعنى العام والمطلق من لفظ ما الموصول المبهم فلابدّ من تقدير المقدار اللازم تقديره وهو المركبات العبادية، وبالتالي يجب حمل الرواية على المركّبات العبادية من غير التعميم والشمولية لغيرها[217].
الجواب الأوّل عن هذا الإشكال:
إنّا لا ننكر القاعدة الأصولية المذكورة في علم الأصول إلاّ أنّنا في مورد الرواية لو كنّا نحن وعبارة (كلّما شككت فيه) من غير وجود عبارة (مما قد مضى) لكان الإشكال الثاني وارداً لكن قوله(ع): (مما قد مضى) مع كون (من) في (ممّا) بيانية يفيد للمكلّف الملاك ويفهمه بأنّ المراد من هذا المبهم هو الشيء الذي قد مضى. فيكون هذا التعبير (مما قد مضى) رافعاً للإبهام عن ما الموصولة والأصوليون يتّفقون على أن تعليق الحكم مشعرٌ بالعليّة فيكون (مما قد مضى) بمعنى (لأنه مضى) فلا يبقى إبهام مع وجود قوله(ع): (مما قد مضى) ولا يكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ليُستفاد من تلك القاعدة الأصولية.
الجواب الثاني عن هذا الإشكال:
إنّ هذا الشك من أصله ليس منحصراً في المركبّات بل قد يشمل الأمور البسيطة أيضاً مثلاً في باب الإحرام على القول بأنّ الإحرام أمرٌ بسيط فإنّ المكلّف لو خرج من الميقات وشكّ في أنّه هل أحرم على النحو الصحيح أولا تمسّكنا بقاعدة الفراغ في الحكم بصحّة إحرامه.
وعليه فإنّ المستفاد من عموم قوله (مما قد مضى) هو أنّ كلّما مضى محلّه لا ينبغي أن يُشكَّ في صحّته فلا اختصاص لقاعدة الفراغ بالمركبات بل تجري في البسائط أيضاً، فالحاصل أنّ التعبير بـ (كلّما شككت فيه مّما قد مضى) تعبير عامّ يشمل جميع أبواب الفقه.
التعبير الثاني في روايات قاعدة الفراغ الذي يستفاد منه التعميم هو التعليل الوارد في ذيل موثقة بكير بن أعين وهو قوله(ع): (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك)[218] بتقريب أن يقال: بإلغاء الخصوصية من كلمة (يتوضأ) فيكون ملاك الأذكرية المذكورة في الرواية سارياً إلى جميع موارد الشكّ ولا اختصاص له بمركّب دون مركّب آخر، فلو شك المكلّف بعد الصلاة قلنا في حقّه (هو حين يصلّي أذكر منه حين يشكّ) وكذا لو شك في المعاملة بعد الانتهاء منها أو شك في النكاح بعد الفراغ منه فيقال (هو حين وقوع البيع أو حين النكاح أذكر) فبعد إلغاء الخصوصية يمكن أن يقال: (هو حين العمل أذكر منه حين يشك) وعليه تكون قاعدة الفراغ عامّة تجري في جميع أبواب الفقه.
والإشكال الوارد هنا هو: أنّ استفاد التعميم من هذا التعبير مشروطة بأن يكون هذا التعبير وارداً على نحو العلّة لا بعنوان الحكمة، والفرق بين العلّة والحكمة هو أنّ الحكم في العلّة يدور مدار الموضوع المعنون وجوداً وعدماً وليس كذلك في الحكمة فإنّ الحكم متوقّف عليها وجوداً وليس عدم الحكم متوقفاً على عدم الحكمة ولو ذُكرتْ بلسان التعليل فلو قيل: (لا تشرب الخمر لأنّه مسكر) فإنّ الإسكار هنا وإن ذكر بلسان التعليل لكنّه ليس بعلّة بدليل إنّ الخمر حرام وإن لم يتحقّق فيه الإسكار فهو من باب الحكمة. مثال آخر هو مما ذكره الفقهاء في لزوم عدة الطلاق من أنّ الحكمة في اتّخاذ العدّة هي عدم اختلاط المياه، ومن المعلوم أنّنا لو تيقّنا بعدم اختلاط المياه كما لو كان الزوجان منفصلين كلّ منهما بعيد عن الآخر سنوات عديدة فإنّ العدّة بعد الطلاق واجبة على المرأة ومّما يدلّ ذلك على أنّ عنوان عدم اختلاط المياه حكمة لا علّة.
أمّا في باب الخيارات حيث يقال: بأنّ ملاك الخيار هو وجود العيب والحكم الوضعي أي الخيار وجواز الفسخ دائر مدار العيب وعدمه فإنّ العيب علّة.
ومن جهة أخرى فإنّ مجرّد ورود التعبير لا يمكن أن يكون دليلاً على كونه علّة أو حكمة ففي هذه الرواية لا يُحرز من تعبير (أذكر) إنّ الأذكرية علّة أو حكمة. فليس هناك قاعدة عامة نميّز من خلالها الحكمة عن العلّة بل لابدّ من معرفة ذلك من خلال القرائن الموجودة في المقام.
نعم يمكن إراءة طريقين لتمييز العلّة عن الحكمة:
1 ـ عند دوران الأمر بين العلّة والحكمة لابدّ من حمل العنوان على الحكمة لغلبتها على العلّة حيث إنّ الغالب في الأحكام أنّ العنوان فيها حكمة.
إلاّ أنّ هذا الطريق غير تام إذ مضافاً إلى عدم صحّة الصغرى فيه فإنّ الكبرى أي قاعدة (الظنّ يلحق الشيء بالأعم الأغلب) محلّ إشكال.
2 ـ الطريق الثاني هو أنّه قد يقال: بأنّ العلّة منحصرة والحكمة غير منحصرة ففي الصلاة مثلاً هي ذكر الله وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي المعراج وهي عمود الدين فإنّ هذه العناوين من باب الحكمة لا من باب العلّة، فلو أتى المكلّف بصلاة ليست مصداقاً لأحد هذه العناوين فإنّ الواجب يؤدّى بهذا المصداق. وهكذا في باب الصوم لو صام المكلّف من غير حصول التقوى له لم يمكن القول بأنّ صومه لم يكن مصداقاً للصوم الواجب.
والظاهر عدم تمامية هذا الطريق أيضاً إذ قد يكون العنوان حكمة ومع ذلك يكون منحصراً كالخمر الذي لم يرد في حرمته سوى لأنّه مسکر ومع ذلك فإنّ الإسكار حكمة لا علة، وكذلك العكس صحيح حيث قد يكون العنوان علّة ومع ذلك لا يكون منحصراً في الفرد الواحد كالخيارات حيث يمكن القول بأنّ خيار العيب له علّتان العيب والضرر، فلا تكون العلّة منحصرة، وعليه فلا صحة لملاك الانحصار وعدمه في التفريق بين العلّة والحكمة فلابد لنا من الرجوع إلى القرائن لمعرفة أنّ العنوان المذكور علّة أو حكمة ومتى لم نحرز ذلك من القرائن صار الكلام مجملاً غير قابل للتعدّي إلى الموارد المشابهة.
وبعبارة أوضح فإنّ استفدنا العلّية من العنوان كان قابلاً للتعميم والتعدّي إلى سائر الموارد المماثلة ـ بخلاف ما لو كان العنوان حكمة، فعلى سبيل المثال في حرمة الربا لو سلّمنا بأنّ الحرمة ناشئة من كون الربا معنون بعنوان الظلم وكان هذا العنوان علّة جاز لنا أن نعمّم حكم الحرمة حتى في الروايات الدالة على جواز التحيّل في الربا.
أمّا لو كان عنوان الظلم حكمة لم يكن له هذا الأثر، وقد اشتهر أنّ (العلّة تعمّم والحكمة لا تعمّم) مع إمكان المناقشة في هذه القاعدة بأنّ الحكمة لم لا تكون معمّمة؟ فلابد من التفريق بين العلّة والحكمة من جهة العدم أي يلزم من عدم العلّة عدم الحكم ولا يلزم من عدم الحكمة عدم الحكم.
ولا قرينة في التعبير الوارد في موثّقة بكير بن أعين على علية هذا التعبير مضافاً إلى إمكان دعوى أنّ العلّة في عدم الاعتناء بالشك هو قوله(ع): (مما قد مضى) وليس الأذكرية كما سبق آنفاً في التعبير الأوّل أو يمكن القول بأنّ كليهما معاً علةً لا لوحده، وعليه يمكن أن يكون مفاد قوله(ع): (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ) تعميم مجاري قاعدة الفراغ على جميع أبواب الفقه.
التعبير الثالث: المذكور في روايات قاعدة الفراغ الذي يستفاد منه تعميم جريان القاعدة في جميع أبواب الفقه هو عموم التعليل الوارد في ذيل رواية محمد بن مسلم (وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك)[219] وهذه العبارة كناية عن أنّ المكلّف قد أنهى عمله كاملاً ولها عنوان التعليل فتجري في جميع أبواب الفقه من باب أنّ العلّة تعمّم.
ويأتي في هذا التعبير والإشكال عليه جميع ما سبق في التعبير السابق من أنّ العليّة التامّة إنّما هي لمضيّ العمل والفراغ منه ولا عليّة تامّة للأذكرية فلا يمكن استفادة العموم من رواية محمد بن مسلم.
هذا ولكن لمّا كان التعبير الأوّل (كلّما شككت فيه مّما قد مضى) تعبيراً عاماً استنتجنا من ذلك أنّ قاعدة الفراغ عامة تجري في جميع أبواب الفقه وليست مختصّة بباب الصّلاة.
دراسة عموم قاعدة التجاوز:
والمهمّ أن نبحث حول قاعدة التجاوز التي دلّت الأدلّة عندها على أنّها غير قاعدة الفراغ وهي تجري في أثناء العمل هل هي أيضاً عامة تجري في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات.
يرى المحقّق النائيني[220] بأنّ قاعدة التجاوز مختصّة بباب الصلاة واستدلّ على رأيه بدليلين:
الأول:
ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة من أنّ أكثر روايات قاعدة الفراغ ظاهرة في الشك في كلّ العمل والروايات المعدودة المتعلّقة بقاعدة التجاوز حاكمة على روايات قاعدة الفراغ وألحقت الشك في الجزء بالشك في الكلّ وحكمت بوجوب عدم الاعتناء بالشك في الجزء كما هو الشأن في الشك في كلّ العمل بعد الفراغ منه، وعليه فلو شك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق لا يعتنى به وإلحاق الشك في الجزء بالشك في الكلّ يوجب التوسعة التي لابدّ فيها من الاكتفاء على ما دلّت عليه الروايات لأنّ الحكومة عنوان تعبّدي لابدّ فيه من الاكتفاء على القدر المتيقّن الذي هو أجزاء الصلاة.
الدليل الثاني:
هو أنّ القاعدة الأولية في المركّبات هي أنّ مجموع العمل المركب شيء واحد ولا يلاحظ الأجزاء لحاظاً استقلالياً، فمثلاً أنّ أجزاء الوضوء من حيث المجموع تعتبر عملاً واحداً ولم يلاحظ الشارع كل جزءٍ من أجزائه على نحو الاستقلال. والمورد الوحيد الذي خرج من هذه القاعدة حيث لاحظ الشارع أجزاء المركّب مستقلّة هو الصلاة، وعليه فإنّ قاعدة التجاوز يمكن إجراؤها في الصلاة فقط أمّا سائر المركبّات حيث لا لحاظ استقلالي لأجزائها فلا تجري فيها هذه القاعدة[221].
والظاهر أنّ كلا الدليلين قابلٌ للمناقشة، أمّا الدليل الأول فقد ذكرنا سابقاً بأنّ في باب الحكومة يعتبر في حكومة أحد الدليلين على الآخر أن يكون الدليل الحاكم ناظراً عرفاً إلى الدليل المحكوم أمّا بتوسعة موضوعه أو بتضييقه مع أنّ روايات قاعدة التجاوز ليست ناظرة عرفاً إلى روايات قاعدة الفراغ وعليه فلا حكومة هنا.
وأمّا الدليل الثاني فنقول فيه: ما الدليل على أنّ الشارع لاحظ الأجزاء في الصلاة فقط على نحو الاستقلالية؟ إنّ الروايات الواردة في قاعدة التجاوز هي ثلاث روايات يستفاد من جميعها عموم جريانها في جميع أبواب الفقه، وقد استند إليها القائلون بعموم هذه القاعدة كالإمام الخميني[222] وصاحب الجواهر[223].
الرواية الأولى: صحيحة زرارة التي يستفاد من إطلاقها العموم حيث جاء في ذيل الرواية: (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء)[224] فإنّ لكلمة (شيء) اطلاقاً يشمل جميع المركبّات من العبادات وغيرها.
لا يقال بأنّ الإطلاق يتوقف على تمامية مقدّمات الحكمة التي من جملتها عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب حيث لو كان موجوداً بين المتكلّم والمخاطب لم يجز التمسّك بالإطلاق وهذه المقدّمة مفقودة في المقام حيث إنّ القدر المتيقن موجود في الرواية وهو سؤال زرارة المتعلّق بالصلاة فيكون هذا السؤال قرينة على أنّ المراد بلفظ شيء في ذيل الرواية هو أجزاء الصلاة أي (شيء من أجزاء الصلاة لاشيء من أجزاء العمل) لأنّا نقول:
أولاً: بأنّ هذا الإشكال مبنائي أي أنّه يتمّ على قول من يرى أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب مضرٌّ بالإطلاق لكنّ كثيراً من المحقّقين لم يرتضوا هذا المبنى ولا يرون أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب مخلّ بالإطلاق.
ثانياً: أنّ سؤال زرارة وإن كان عن الصلاة لكنّه ليس بعنوان القدر المتيقّن في مقام التخاطب، لأنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب أمر يحتاج إلى طرفين، مثلاً لو تحدّث اثنان عن الطعام ثم قال أحدهما للآخر (جئني بشيء) حُمل لفظ (شيء) على الطعام ولا قدر متيقّن، كذلك في الرواية فإنّ اختصاص سؤال زرارة بباب الصلاة محلّ تأمّل وترديد، إذ لو استمر الكلام لاحتمل أن تتكرّر أسئلة زرارة حول سائر أبواب الفقه.
الرواية الثانية: موثقة إسماعيل بن جابر والعموم يستفاد من ذيلها الذي جاء فيه (كل شيءٍ شكّ فيه مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)[225].
تقريب الاستدلال هو أنّ هذه العبارة تضمّنت على كلمة (كلّ) التي هي من أدوات العموم وهي تدلّ على العموم من دون الحاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة.
الرواية الثالثة التي يستفاد منها عموم جريان قاعدة التجاوز في جميع أبواب الفقه موثقة ابن أبي يعفور وقد جاء في ذيلها قوله(ع): (إنّما الشك إذا كنت في شيءٍ لم تجزه)[226]. وقد بحثنا مفصّلاً فيما سبق حول هذه الرواية وقلنا بأنّ هذه العبارة إن تعلّقت بالشك حين العمل كانت الرواية عامة غير مختصة بباب الصلاة.
والحاصل أنّ قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ ليست مختصة بباب الصلاة والطهارة بل تجري في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات.
نعم وقع النزاع في كلمات الفقهاء في أنّ قاعدة التجاوز هل تجري في الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتيمّم) أولا؟ مثلاً لو شك المكلّف حين غسل يده اليمنى في أنّه هل غسل وجهه أولا؟ فهل تجري قاعدة التجاوز ويحكم بصحّة الوضوء؟ هذا السؤال ما سنجيب عليه فيما يلي من البحث.
البحث في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث:
قام الإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء وقد ألحق الفقهاء به الغسل والتيمّم ولا مجال لهذا البحث من أساسه على مبنى بعض الأعاظم كالمحقق النائيني الذي ذهب إلى اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة حيث يكون خروج بحث الوضوء والغسل والتيمّم من جريان قاعدة التجاوز من باب التخصّص فلا تشملها هذه القاعدة[227].
أمّا على مذهب القائلين بعموم جريان قاعدة التجاوز ـ كما ثبت ذلك عندنا ـ فيكون خروج هذه الأبواب الثلاثة من جريان قاعدة التجاوز من باب التخصيص فالأولى أن نبحث كلاً من الوضوء والغسل والتيمم على نحو الاستقلال لتتّضح لنا المسألة بوضوح أكثر:
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء:
ذُكر في الكتب الفقهية وكلمات الفقهاء ثلاثة أدلّة استدلّوا بها على خروج الوضوء من قاعدة التجاوز الكليّة:
أ: الإجماع: ذكر الفقهاء أنّ الإجماع قائم على أنّ قاعدة التجاوز غير جارية في الوضوء[228] ومن هنا أفتوا بوجوب إعادة غسل الوجه فيما لو شك المكلّف حين غسل اليدين في أنّه هل غسل وجهه أولا، وعليه لابدّ من إعادة الوضوء[229] وهذا من المواضع التي نُقل فيها الإجماع على نحو الاستفاضة.
ب ـ الروايات: استدلّ مضافاً إلى الإجماع بعدّة روايات في هذا المجال وها نحن نبدأ بدراستها وتحليلها:
1 ـ صحيحة زرارة عن الإمام الباقر(ع)حيث يقول فيها الإمام(ع): (إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعدّ عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله تمسحه، ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك)[230].
نظراً إلى صدر هذه الرواية لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء وبالنظر إلى ذيلها تجري قاعدة الفراغ في الوضوء، وعليه يمكن تخصيص العمومات التي مفادها جريان قاعدة التجاوز في جميع أبواب الفقه بواسطة صدر هذه الصحيحة.
نعم يمكن أن يدّعى هنا بأنّ الإجماع المدّعى من قبل المجمعين قد يكون مستنداً إلى هذه الصحيحة وبالتالي يكون الإجماع مدركياً فلا حجيّة له.
2 ـ موثقة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(ع)حيث يقول(ع): (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه)[231].
وقد سبق أنّ مرجع الضمير في قوله(ع)(في غيره) فيه احتمالين:
أحدهما أن يكون مرجعه الوضوء، والآخر أن يكون الضمير راجعاً إلى (شيءٍ) والاستدلال بهذه الرواية على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء إنّما يتمّ فيما لو رجع الضمير إلى الوضوء حيث يكون مفهوم الحديث على هذا الاحتمال أنّه إن لم تدخل في غير الوضوء كان شكّك معتبراً لابدّ من الاعتناء به.
أمّا لو عاد ضمير (غيره) إلى (شيءٍ) كان مفاد الحديث جريان قاعدة التجاوز في الوضوء أيضاً وعليه تتعارض موثقة ابن أبي يعفور مع صحيحة زرارة فتتساقطان ثمّ يجب الرجوع إلى عمومات روايات التجاوز الحاكمة بجريان قاعدة التجاوز في الوضوء أيضاً، ومن هنا فلابدّ من إيجاد حلٍّ لهذا التعارض، فقد ذهب الشيخ الأعظم إلى طريق لحلّ هذا التعارض سنذكره في حديثنا تحت عنوان الدليل الثالث.
ج ـ مجموع أفعال الوضوء فعل واحد:
فقد سلك الشيخ الأنصاري لإخراج أفعال الوضوء من مفاد قاعدة التجاوز ولحلّ التعارض بين موثقة ابن أبي يعفور وصحيحة زرارة مسلكاً آخر مفاده أنّ الوضوء بجميع أجزاءه من المسحتين والغسلتين إنّما هو فعل واحد في نظر الشارع لأنّ مسبّبه وأثره واحد وهو الطهارة، وعليه فليست أجزاء الوضوء عند الشارع كأجزاء الصلاة التي لها لحاظات استقلالية فلم يلاحظ أجزاء الوضوء على أنّها أفعال مستقلّة كأجزاء الصلاة حتّى يُتصوّر لكلّ واحد منها محلّ خاص بحيث يكمن تصوّر التجاوز منه كما يتصور مجموع القراءة في الصلاة فعلاً واحداً لا أنّ كلّ أية تعتبر جزءاً مستقلاً كما سنتحدّث عن ذلك فيما سيأتي تحت عنوان جزء الجزء، وهل تجري قاعدة التجاوز في جزء الجزء أولا؟ فقد ذهب المشهور إلى عدم الجريان ومن هنا يمكن القول بانّ الشارع المقدّس كما اعتبر مجموع القراءة جزءاً واحداً كذلك جعل مجموع أفعال الوضوء جزءاً واحداً.
وعليه فطالما لم ينته المكلّف من الوضوء لم يصدق في حقّه التجاوز عن المحل فلا تعارض هنا بين الروايتين[232].
إشكالات المحقق العراقي على مسلك الشيخ الأنصاري:
أورد المحقق العراقي على كلام الشيخ الانصاري إشكالين:
الأوّل: إن كلام الشيخ بأنّ الشارع قد لاحظ الوضوء بمنزلة شيء واحد لا ينسجم مع ظاهر الموثقة حيث جاء فيها (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء) حيث استعملت فيها من تبعيضيّةً لبيان أجزاء الوضوء فيكون الشارع هنا قد لاحظ أجزاء الوضوء كلحاظ أجزاء الصلاة.
الإشكال الثاني: للمحقق العراقي هو إنّ استدلال الشيخ الأعظم بوحدة المسبب وهو الطهارة على وحدة الوضوء غير تام، لأنّ وحدة المسبّب (الطهارة) ليست دليلاً (لا تدلّ) على وحدة السبب أبداً وإلاّ لقلنا بذلك في كثير من العبادات كالصلاة والحجّ لوحدة المسبّب في الصلاة وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والتقرب إلى الله.
كما أنّ مسبّب الحج كذلك واحد وهو كونه ذكر الله[233].
هذا وقد أيّد المحقق العراقي بعض تلامذته كالمحقق البجنوردي[234] حيث أقرّ بتمامية هذين الإشكالين.
إشكالات نظرية المحقق العراقي:
أجاب بعض الأعاظم[235] في مقام الردّ على المحقق العراقي أمّا عن إشكاله الأوّل فبأنّ مراد الشيخ الأنصاري هو أنّ الشارع قد لاحظ للوضوء المركّب من الأجزاء المتعدّدة وحدة اعتبارية وهي فرع لكون العمل في الظاهر مركبّاً فهو(ع)لا ينفي التركيب للوضوء فلا تنافي بين كلام الشيخ الأنصاري وبين ما قاله العراقي من كون (من) تبعيضيّة مفادها أنّ الوضوء ذو أجزاء.
الظاهر أنّ هذا الجواب في غير محلّه إذ ليس البحث في أنّ الوضوء في الخارج عمل مركب أولا؟ فإنّ الشيخ الأنصاري يرى أنّ الشارع يلاحظ مجموع الوضوء جزءاً واحداً ويعتبر له حكماً واحداً وعليه يكون إشكال المحقق العراقي في محلّه حيث إنّ الشارع بيّن في صدر الموثّقة الحكم للجزء المشكوك من الوضوء ممّا يدلّ بوضوح على أنّ الشارع قد لاحظ أجزاء الوضوء لحاظاً استقلالياً.
أمّا جوابهم عن الإشكال الثاني للمحقق العراقي فهو أنّ الأثر في باب الوضوء يختلف عن أثر الصلاة كلّيّاً ذلك أنّ هناك قسمين من الآثار أحدهماهو الأثر الشرعي الذي يُعبّر عنه بالأثر الجعلي، والآخر هو الأثر التكويني وما هو موجود في باب الوضوء هو الأثر الشرعي والنسبة بين هذا الأثر ومؤثره نسبة المسبّب إلى السبب بمعنى أنّ الشارع قد جعل أفعال الوضوء من الغسلتين والمسحتين سبباً لأثر يعبّر عنه بالطهارة أمّا الأثر الموجود في الصلاة فهو أثر تكويني كالنهي عن الفحشاء والمنكر والتقريب إلى الله فالأثر أن مختلفان ولا يمكن قياس أثر الوضوء على آثار سائر العبادات التي منها الصلاة.
والظاهر أنّ في هذا الجواب تأمّلاً واضحاً وتكلّفاً ظاهراً، أولاًلعدم وجود قرينة في كلمات الشيخ الأنصاري تدلّ على أنّ المراد من الأثر هو خصوص الأثر الشرعي الوضعي دون الأثر التكويني.
ثانياً لو سلّمنا وجود القرينة على ذلك وأنّ الشيخ قد لاحظ الفرق إلاّ أنّ هناك إشكالاً آخر يرد على هذا المجيب وهو أنّه كيف فرّق بين الأثر الشرعي والأثر التكويني؟ فإنّ الأثر التكويني أيضاً بمقتضى قاعدة: (الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد) لابدّ من أن يكون فيه المسبّب الواحد كاشفاً عن وحدة السبب فلا وجه للفرق بين الأثر الشرعي والأثر التكويني بأيّ وجه من الوجوه ـ فالمحقق العراقي إنّما أورد على الشيخ الأنصاري بانّ ما استدلّ به ليس في الواقع دليلاً وبالتالي يبقى كلام الشيخ ادّعاءً من غير دليلٍ.
وبالجملة فإنّ إشكالي المحقق العراقي على كلام الشيخ الأنصاري لا غبار عليهما، وبالتالي لا يكون دليل الشيخ الأنصاري تامّاً، ومن هنا لابدّ من التعرّض فيما يأتي للوجوه الأخرى للجمع بين الصحيحة والموثقة.
دراسة الوجوه الأخرى للجمع بين الصحيحة والموثّقة:
الوجه الثاني للجمع بين صحيحة زرارة وموثقة ابن أبي يعفور هو أنّ الجمع الدلالي بينهما غير متيّسر فيما نحن فيه ومن هنا قالوا:
إنّ الموثقة مخالفة للعامّة بينما الرواية الصحيحة موافقة لهم فيكون صدورها على وجه التقيّة فلابدّ من الأخذ بالموثّقة وطرح الصحيحة.
وهذا الوجه لا صحّة له إذ لو كانت العامة متّفقةً على القول الواحد لصحّ هذا الوجه إلاّ أنّ العامة مختلفة على أقوال متعدّدة فلا يجوز على هذا حملُ الصحيحة على التقيّة.
الوجه الثالث للجمع على ما قيل هو أنّ الأمر (فأعد عليهما) المذكور في صحيحة زرارة لابدّ من حمله على الاستحباب بقرينة قوله(ع)في الموثّقة: (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكّك بشيءٍ).
والإشكال الوارد على هذا الوجه هو أنّ الحمل على الاستحباب إنّما يتم فيما لو أحرزنا أنّ الحكم من الأحكام التكليفيّة، أمّا لو احتملنا كون الحكم إرشادياً فلا مجال للحمل على الاستحباب فإنّ الحكم الموجود في صحيحة زرارة (القائل بأنّ المكلّف طالماً لم يفرغ من الوضوء بل هو منشغل به وجب عليه الاعتناء بشكّه ولابدّ من إعادة العمل) إرشاد إلى حكم العقل.
الوجه الرابع: قالوا من أنّ موثقة ابن أبي يعفور تسقط عن الحجّية والاعتبار بسبب وجود الإجماع المستفيض في هذه المسألة فلابدّ من الأخذ بالحكم الوارد في صحيحة زرارة.
وبعبارة أخرى فإنّ إعراض المشهور عن العمل بمضمون الموثّقة يوجب كسرها وتضعيفها.
بالنسبة إلى هذا الوجه لابدّ من القول بأنّ المسألة مبنائية حيث إنّ مبنى المشهور أنّ إعراض المشهور يؤدّي إلى ضعف الرواية، هذا مضافاً إلى أنّ الإجماع هنا يحتمل استناده إلى صحيحة زرارة فيكون إجماعاً مدركياً كما ذكرنا ذلك فيما سبق، ومن المعلوم أنّ الإجماع المدركي والشهرة المذكورة لا يقدحان بالرواية.
وبعبارة أوضح إنّ الشهرة إنمّا تكون قادحة فيما لو لم يُعلَمْ مستند المشهور والمجمعين أمّا لو أحرزنا مستندهم فلا يكون الإجماع هو الأساس والعمدة بل يرتكز البحث حينئذٍ على صحة مدرك عمل المشهور ومستنده وعلى هذا فلا صحة لهذا الوجه أيضاً.
الوجه الخامس للجمع ما ذكره الشيخ الأعظم[236] وأقرّه المحقق العراقي[237] وهو أن نلتزم بإرجاع ضمير (غيره) الوارد في الموثقة إلى الوضوء لا إلى (الشيء) من باب أنّ الأقرب يمنع الأبعد، وعليه فيكون مفاد الرواية أنّك لو لم تدخل في غير الوضوء كان شكّك معتبراً ويجب الاعتناء به.
نعم هناك اختلاف بسيط بين الشيخ والمحقق العراقي في المقام وهو أنّ الشيخ يرى أنّ المراد بالتجاوز في الوضوء هو التجاوز عن جميع أفعال الوضوء، وذلك بقرينة أنّ مجموع الوضوء عنده يعتبر عملاً واحداً ولم يلاحظ فيه الأجزاء على نحو الاستقلالية، أمّا العراقي فإنه يتمسّك على كلامه بقرينة الإجماع.
وبهذا البيان لكلام الشيخ الأنصاري والمحقق العراقي يمكن أن يجاب عن إشكالات عديدة:
الأوّل: أنّه كيف يمكن أن يُقيّد المصداق مع إبقاء الكبرى الواردة في الرواية على إطلاقها، فيما لو ذُكر المصداق لكبرى كلّيّة فإنّ المصداق المذكور في هذه الرواية هو التجاوز عن الوضوء المقيّد بالتجاوز الخاصّ وهو التجاوز عن مجموع أفعال الوضوء مع أنّ الكبرى تبيّن مطلق التجاوز الشامل للتجاوز عن الجزء والتجاوز عن الكلّ؟
أجاب المحقق العراقي عن هذا الإشكال بأنّه لا مانع من تقييد المصداق مع إبقاء الكبرى على إطلاقها وقد وردت أمثال ذلك في موارد من الفقه منها آية النبأ (إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)[238]حيث يدلّ مفهومها على عدم وجوب التبيّن فيما لو جاء العادل بنبأ.
والمستفاد من هذا المفهوم الذي هو كبرى كلّية أنّ خبر العادل حجة. بينما إنّ مورد الآية ومصداقها هو الإخبار في الموضوعات الخارجية لا في الأحكام مع أنّ الثابت من خلال الأدلّة التي بين أيدينا عدم كفاية خبر العادل الواحد في الموضوعات الخارجية بل لابدّ من وجود شاهدين عادلين.
وعليه يجب تقييد مورد الآية في الموضوعات الخارجية بانضمام عادل آخر ليتمّ قبول خبر العادل مع أنّ الكبرى باقية على إطلاقها ـ وهكذا الحال فيما نحن فيه فإنّ الكبرى أعني قوله(ع): (إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزه).
باقية على إطلاقها بينما أنّ موردها وهو الوضوء قد قُيّد بمجموع الوضوء، وبهذا البيان ينحل إشكال خروج المورد من الكبرى الكلّيّة[239].
كما ينحلّ إشكال التهافت والتعارض بين موثقة ابن أبي يعفور وصحيحة زرارة، وقد سبق بيان ذلك آنفاً.
وبهذا الجواب ينحلّ عند المحقق العراقي إشكال ثالث أيضاً وهو أنّ بين منطوق صدر الموثّقة ومفهوم ذيلها تعارضاً حيث يدلّ منطوق قوله: (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره) على عدم الاعتناء بالشك فيما لو خرج المكلّف من جزء ودخل في جزء آخر وشك في صحّة ذلك الجزء السابق قبل الفراغ من العمل كلّه، مع أنّ مفهوم قوله(ع): (إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزه) هو وجوب الاعتناء بالشك فيما لو لم يفرغ المكلّف من العمل، وعليه يحصل التعارض بين منطوق هذه الموثقة ومفهومها فيما لو شك قبل الفراغ من العمل في صحّة الجزء لا في أصل وجود الجزء.
الإشكالات على الوجه الخامس
للجمع بين صحيحة زرارة وموثقة ابن أبي يعفور المذكور في كلمات الشيخ الأنصاري والمحقق العراقي:
الإشكال الأوّل: إنّ لفظ الوضوء في موثقة ابن أبي يعفور أقرب من لفظ الشيء الوارد فيها والأقرب يمنع الأبعد إلاّ أنّ الإمام(ع)في هذه الرواية إنمّا هو في مقام بيان حكم الشيء لا بيان حكم نفس الوضوء، وهذا أقوى من قرينة الأقربية لإرجاع الضمير إلى نفس الشيء.
وبتعبير أوضح فإنّ كون الإمام في مقام بيان حكم ما شُكّ في صحّته قرينة أقوى من قرينة الأقربية.
الإشكال الثاني إنّما يرد على كلام المحقّق العراقي حيث قال: بأن تقييد المورد والمصداق مع بقاء الكبرى على إطلاقها أمر شائع وكثير فإنّ هذا الادّعاء منه مجرّد دعوى لا دليل عليها ولا صحّة لها.
والإنصاف قلة وقوع ذلك، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كثرته إلاّ أنّ وقوع ذلك فيما لو كان المولى في مقام البيان أمر مستهجن وقبيح ويستنكف العرف أن يكون المورد المبيّن مقيّداً بينما تكون الكبرى الكلّيّة غير مقيدة وهذا نظير ما إذا قال المولى: (أكرم زيداً العالم) ثمّ يقول: (يجب إكرام كلّ عالم) ثمّ يشترط في المصداق الذي هو إكرام زيد خصوصية العدالة بينما لا وجود لهذه الخصوصية في الكبرى، فإنّ العرف لا يقبل ذلك.
الإشكال الثالث: هو أنّ قياس ما نحن فيه بمفهوم آية النبأ قياس مع الفارق إذ مفهوم آية النبأ أجنبي عن مسألة البيّنة والشهادة، بل مفهومها أنّ خبر غير الفاسق واجب القبول، أمّا ضميمة خبر عادل آخر في باب البيّنة فليست من جهة أنّ حجيّة خبر العادل مقيّدة بانضمام خبر عادل آخر بل لأنّ الأدلّة في باب الشهادة تدلّ على عدم كفاية إخبار العادل الواحد ولابدّ من شهادة عادلين اثنين أي أنّ خبر العادل حجة في نفسه إلاّ أنّ الشهادة تحتاج إلى عادلين ولا يكفي فيها العادل الواحد، وعلى هذا فالظاهر أنّ القياس في كلام المحقق العراقي في غير محلّه، لأنّه قياس مع الفارق، وبالجملة فوجه الجمع المذكور في كلمات الشيخ الأنصاري والمحقق الأنصاري غير صحيح.
الوجه السادس: للجمع بين الصحيحة والوثقة: هو أنّ المراد بالشك في موثقة ابن أبي يعفور في قوله(ع): (إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه) هو الشكّ في الصحة، والمراد من (شيءٍ) هو مجموع العمل، وعليه فيكون الإمام(ع)في ذيل الرواية في صدد بيان حكم الشكّ في صحة مجموع العمل بعد الفراغ منه فيكون هذا قرينة على رجوع الضمير في (غيره) إلى الوضوء، وبالتالي تكون الرواية دالة على قاعدة الفراغ لا على قاعدة التجاوز ويكون مضمونها أنّك إذا شككت في جزءٍ من أجزاء الوضوء وأنت قد دخلت في غير الوضوء فلا تعتن بشكك وبهذا يتمّ التوفيق بين هذه الموثقة وبين صحيحة زرارة.
الإشكال الوارد على هذا الوجه هو أن الشكّ في شيءٍ ظاهر أولاً وبالذات إلى الشكّ في وجود ذلك الشيء لا الشكّ في صحته هذا مضافاً إلى أنّ استعمال لفظة من للبيان إنما هو على خلاف الأصل حيث إنّ الأصل الأوّلي في معنى من هو التبعيض.
الوجه السابع للجمع بين الموثقة والصحيحة أن يقال بأنّ المراد من الشكّ في الموثقة هو الشكّ بعد الفراغ من العمل، لكنّه في جزءٍ من أجزائه.
وبعبارة أخرى يكون مفاد الرواية مفاد كان التامّة وعليه فإنّ صدر الرواية ظاهر في أنّ للشيء في قوله(ع): (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره) محلاً قد تجاوز المكلّف عنه ثمّ شك فيه بعد تجاوز محلّه لا أنّه قد شكّ بعد الانتهاء من كلّ العمل.
والإشكال على هذا الوجه أيضاً أنّه خلاف الظاهر.
المختار في الجمع بين الموثّقة وصحيحة زرارة:
والذي نختاره هو أن ذيل الموثقة (إنما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه) كبرى كلّيّة تبيّن قاعدة التجاوز أمّا صدر الرواية (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيءٍ) فلابدّ من التصرف فيه ـ بقرينة الإجماع ـ بأن نلتزم أنّ مجموع أفعال الوضوء يُعتبر عملاً واحداً ولم يلاحظ الشارع أجزاءها على نحو الاستقلال لكن لمّا سبق وأنْ بيّنا بأنّ الإجماع لا يمكن أن يصبح دليلاً على التصرف في مدلول الرواية الاستعمالي فلابدّ من التفكيك في الحجّية بأن يُطرح صدر الرواية لمخالفته مع الإجماع فتثبت الحجية لذيل الرواية المفيد لقاعدة التجاوز ويؤخذ به. هذا غاية ما يمكن بيانه فيما يتعلق بالموثقة.
نعم قد يقال بأنّ هذا الإجماع يحتمل أن يكون مدركياً فلا يمكن التمسّك به ولا يجوز الاستناد إليه لكنّنا نقول بأنّ صدر الرواية لابدّ من طرحه لإعراض المشهور عنه. فإن قيل: إنّ إعراض المشهور إنّما نشأ من صحيحة زرارة والمشهور باستناده إليها قد أعرض عن صدر الموثقة فلا فائدة من هذا الإعراض.
قلنا: فعلى هذا كلّه تصبح الموثقة مجملة ولا يمكن الاستناد إليها ولا بد من التمسّك بالصحيحة لأنّ المجمل لا يقاوم المبيّن ولا يعارضه.
بحث حول جريان قاعدة التجاوز في الغُسل والتيمّم:
اختلف الفقهاء في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز أو أنّهما لا يُلحقان به فتجري فيهما قاعدة التجاوز.
فقد صرّح الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة[240] بأنّ المشهور إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز فيهما كما لا تجري في الوضوء.
أمّا كبار المعاصرين أمثال الإمام الخميني[241] والمحقق الخوئي[242] فقد ذهبوا إلى عدم إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء فتجري قاعدة التجاوز فيهما وعليه فلو شك المكلّف أثناء الغُسل حين غَسل الطرف الأيمن من جسمه في أنّه هل غسل رأسه وعنقه أولا؟ جرت في حقّه قاعدة التجاوز وحُكِمَ بأنّه قد غسلهما، وهكذا الحال في التيمّم.
نعم لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز هنا على مذهب من لا يرى الترتيب واجباً بين غَسْل الطرف الأيمن والطرف الأيسر كما ذهب إليه بعض الأعاظم مثل المحقق الخوئي[243] فعلى مبنى هؤلاء الأعاظم لو شك المكلّف أثناء غَسل الطرف الأيسر من الجسم في أنّه هل غسل طرفه الأيمن أولا؟ وجب عليه أن يعيد غسل الطرف الأيمن لعدم تحقق التجاوز عن المحل حينئذٍ.
هذا كلّه بالنظر إلى الأقوال.
أمّا بالنسبة إلى دليل المسألة وأنّ الدليل ماذا يقتضي؟ فإنّ ما يدلّ على عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء أمران أحدهما الإجماع، والآخر صحيحة زرارة ولا شك في اختصاص مورد هذين الدليلين بالوضوء ولا وجه فيهما لإلحاق الغسل والتيمم بباب الوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز.
وبعبارة أخرى فإنّ إلغاء الخصوصية في التعبّديات أمر مشكل جدّاً ولا وجه له في هذا البحث كما أنّ تنقيح المناط هنا غير ممكن لعدم إحراز وحدة المناط في الوضوء والمناط في الغسل والتيمّم فإنّ اختلاف الأحكام والخصوصيات بين الوضوء من جهة والغسل والتيمم من جهة أخرى دليل على عدم اليقين بتنقيح المناط هنا.
مع ذلك كلّه فإنّ هناك دليلين على الإلحاق لابد من دراستهما والبحث حولهما.
الدليل الأوّل المختصّ بالتيمّم هو أنّ التيمّم بدل الوضوء له عنوان البدلية ولا استقلالية له والبدليّة تقتضي عدم جريان قاعدة التجاوز في البدل (التيمم) كما لم تجز في المبدل منه (الوضوء):
ويرد على هذا الدليل إشكالان:
الأوّل أنّه لا دليل يدل على أنّ التيمم لمّا كان بدلاً عن الوضوء فلابدّ من أنْ يتصف بجميع أحكام الوضوء بل البدلية معناها أنّ التيمم كالوضوء في أنّه مبيح للدخول في الصلاة فالتيمّم يحمل عنوان البدلية عن الوضوء في هذا المقدار من الإباحة، ومن هنا تختلف أحكام التيمم عن أحكام الوضوء.
الإشكال الثاني: هو ما ذكره بعضهم على نحو الاحتمال من أنّ التيمّم كالوضوء فلا تجري فيه قاعدة التجاوز أمّا الغسل فتجري فيه تلك القاعدة. وقد يُتساءل هنا على هذا المبنى في التيمم بدل الغسل حيث لا يمكن القول بالتفصيل بأن يقال: لا تجري قاعدة التجاوز في التيمم بدل الوضوء بينما تجري في التيمم بدل الغسل لأنّ التيمّم فعل واحد ولا يجوز فيه التفصيل.
الدليل الثاني: عامّ وهو ما ذكره واستند إليه الشيخ الأنصاري فإنّه ذكر لإثبات أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. ذكر بأن الشارع إنّما لاحظ جميع أفعال الوضوء فعلاً واحداً ولم يلاحظها على نحو الاستقلال لأنّ الوضوء له أثر واحد يسمّى بالطهارة ومع وحدة الأثر فإنّ المؤثّر واحد وهذا كلّه جارٍ في الغسل والتيمم أيضاً إذ لهما أثر واحد هو الطهارة فيكون الشارع قد لاحظ كلّاً منهما عملاً واحداً ولا تجري قاعدة التجاوز في كلّ ما اعتبره الشارع شيئاً واحداً.
هذا وقد أورد المحقق السيد الخوئي[244] على هذا الدليل إشكالين:
الإشكال الأوّل:
إنّ متعلّق التكلّيف في الوضوء على ما يستفاد من ظاهر الآيات والروايات في باب الوضوء هو أفعال الوضوء من الغسلات والمسحات لا الطهارة.
وبعبارة أخرى فإنّ المأمور به في باب الوضوء نفس الغسلات والمسحات لا الطهارة التي هي أثر تلك الغسلات والمسحات[245].
ومن الجدير بالذكر هنا في إشكال السيد الخوئي أنّ بعض تلامذة السيد قد صرّحوا بأنّ هذا الإشكال منه إنّما نشأ من عدم ذكره نظرية الشيخ الأنصاري على وجهها الصحيح في تقريراته، فإنّ السيد الخوئي قال في تقريره لدليل الشيخ الأنصاري:
ما ذكره شيخنا الأنصاري وهو أنّ التكلّيف إنّما تعلق بالطهارة وإنّما الغسل والمسح مقدّمة لحصولها فالشك في تحقق شيءٍ من الغسل والمسح يرجع إلى الشكّ في حصول الطهارة وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز[246].
لكن بالرجوع إلى كلام الشيخ الأنصاري الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة يتّضح لنا أنّ الشيخ لم يركّز نظره على أنّ المأمور به في باب الوضوء هل هو أفعال الوضوء أو الطهارة بل نظر إلى أنّ الوضوء في الخارج وإن اعتبر عملاً مركباً إلاّ أنّ الشارع لاحظه شيئاً واحداً واعتبر لأفعاله وحدة اعتبارية.
وعليه فإن إشكال المحقق الخوئي الأوّل غير وارد على نظرية الشيخ الأعظم.
الإشكال الثاني:
يقول المحقق الخوئي: لو سلّمنا بأنّ المأمور به في باب الوضوء هو الطهارة وأنّ أفعال الوضوء من الغسلات والمسحات مقدمة للمأمور به.
لكن لابدّ من الالتزام بأنّ قاعدة التجاوز إنّما لا تجري في هذه المقدمات فيما لو كانت مقدمات عقلية خارجية كما لو أمر المولى عبده بقتل رجلٍ وكان قتله متوقّفاً على مقدمات فإنّه لو شك في هذه المقدمات لم تجر قاعدة التجاوز لأنّ ذا المقدمة أي القتل عنوان بسيط والشك في المقدمات يكون من قبيل الشكّ في محصّل العنوان وهو مجرى الاحتياط، لكن الغسلات والمسحات التي هي مقدمة للطهارة في باب الوضوء تعتبر مقدّمات شرعية لأنّ الشارع هو الذي أمر بها، ومن الواضح جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء والمقدمات الشرعية المركبّة[247].
وما يمكن القول في هذا الإشكال هو أن صحّة هذا الإشكال مبتنية على القول بأنّ قاعدة التجاوز قاعدة تعبّدية محضة وعلى هذا يكون من وجوه التفريق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز أنّ قاعدة الفراغ أمر عقلائي دون قاعدة التجاوز.
ومن هنا لا يرد هذا الإشكال على قول من يرى قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة ترجعان إلى عنوان واحد هو عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل وهو عنوان عقلائي كما هو مذهب الإمام الخميني والمحقق البجنوردي، لأنّ التفريق بين المقدمات العقلية والمقدمات الشرعية إنّما يتمّ فيما لو كانت هاتان القاعدتان قاعدتين مستقلتين.
هذا مضافاً إلى ما سبق في الإشكال السابق من أنّ إشكالات السيد الخوئي إنّما نشأت من تفسيره الخاطئ لنظرية الشيخ الأنصاري فلو فُسِّرتْ نظريته على الوجه الصحيح لم ترد عليه هذه الإشكالات. نعم لا ننكر تلك الإشكالات السابقة التي أوردها المحقق العراقي على نظرية الشيخ الأنصاري فأنّها تامة مقبولة ولا داعي إلى إعادتها.
وحاصل ما ذكرنا إلى هنا عدم إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء وأنّ قاعدة التجاوز تجري في هذه الأبواب الفقهية، وقد خرج منها باب الوضوء بالدليل الخاصّ الدال على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء خاصة.
المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل:
يذكر الإمام الخميني بعد هذا الكلام بعض الروايات التي يستفاد منها جريان قاعدة التجاوز في الغسل كصحيحة زرارة التي ذكرناها سابقاً: (قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال: إذا شك ثمّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يُصب بلّةً فإنْ دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه)[248].
فإنّ الإمام الخميني يرى أنّ المستفاد من إطلاق عبارة الإمام(ع): (فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه).
إنّ قاعدة التجاوز تجري من دون أيّ مانع فيما لو كان المكلّف منشغلاً بغسل الجنابة قبل الصلاة وقد دخل من جزءٍ إلى جزءٍ آخر ثمّ شك في الجزء السابق[249].
يقول الإمام الخميني: هناك عبارة أخرى في صحيحة زرارة هذه عدا تلك العبارة السابقة يستفاد منها أن الشكّ بعد تجاوز المحلّ لا اعتبار به في غسل الجنابة.
بحث جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء:
من جملة ما يُبحَث عنه في قاعدة التجاوز هو أنّ قاعدة التجاوز هل هي مختصّة بالأجزاء الأصلية للعمل أو أنّها تجري في أجزاء الأجزاء أيضاً. الشكّ في الأجزاء الأصلية بعد تجاوز المحلّ كما لو شكّ المكلّف حين السجود في إتيان الركوع، أمّا الشكّ في جزء الجزء فكما لو شك أثناء قراءة السورة في الصلاة في أنّه هل قرأ الآية السابقة أولا؟ في هذا البحث آراء مختلفة في كلمات الأعاظم.
اختلفت كلمات الأعاظم وتضاربت آراؤهم في هذه المسألة
نظرية المحقق النائيني:
ذهب المحقق النائيني ومن تبعه من الأعاظم إلى أنّ قاعدة التجاوز مختصّة بالشك في أجزاء العمل الأصلية ولا تجري في جزء الجزء كالشك في الآية السابقة بعد الدخول في غيرها[250].
والدليل على هذا المنع كما يستفاد من كلماته أمران:
الأمر الأوّل: إنّ روايات التجاوز حاكمة على روايات الفراغ وهي أي روايات التجاوز تلحق الشكّ في الجزء بالشك في الجزء فإنّ الشارع أمر بعدم الاعتناء بالشك في أجزاء الصلاة أثناء الصلاة كما لا اعتناء بالشك في كلّ الصلاة بعد الفراغ منها ولم يجعل الشارع جزء الجزء بمنزلة كلّ العمل فلا تجري قاعدة التجاوز في جزء الجزء، وبعبارة أخرى فإنّ أدلّة التنزيل لا تشمل الشكّ في جزء الجزء[251].
ونحن أوردنا فيما سبق على هذا الدليل وذكرنا أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز إنّما يستفاد كلّ منهما على نحو الاستقلال من الروايات ولا ناظرية لإحداهما إلى الأخرى وقد ناقشنا مسألة التنزيل وعليه فلابدّ من طرح هذا الدليل.
الأمر الثاني: أنّ المستفاد من روايات قاعدة التجاوز إنّا لو دخلنا من الجزء إلى الجزء الآخر فلابدّ من استفادة عنوان الخروج من المحل والدخول في غيره، والمراد بالمحل هو المحل الذي حدّده الشارع.
مثلاً إن لركوع الصلاة خصوصيّتين: أـ أنّه مأمور به، ب ـ أنّ له محلاً معيّناً من قبل الشارع، ففي مثل هذه الأجزاء التي لها محلّ معين شرعاً مضافاً إلى كونها مأموراً بها تجري قاعدة التجاوز بحيث أن يكون هذا المحل المعيّن من قبل الشارع دخيلاً في كونها مأموراً بها بمعنى أنّ المكلّف لو أتى بالركوع بعد السجود كان آتياً بجزء المأمور به لكنّه قد أخلّ بترتيب الصلاة.
وعلى هذا فلا تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء التي ليس لها محل معيّن شرعاً، كما لو قدّم وأخرّ المكلّف ألفاظ السورة وقال بدل (الله الصمد): الصمدُ اللهُ ـ أو قال بدل (الله أكبر): أكبر الله، لم يمكن الالتزام بأنّه قد أتى بالمأمور به لكنّه أخلّ بالترتيب، لأنه لم يأت بالمأمور به هنا على الإطلاق فإن الترتيب بين الكلمات له مدخلية في ماهية السورة والكلام فلا تجري في هذه الموارد قاعدة التجاوز لأنّ الشكّ فيها يساوي الشكّ في أصل إتيان المأمور به ووجوده.
وهذا الدليل أيضاً غير تام إذ سيأتي في الأبحاث اللاحقة أنّ المراد بالمحل في قاعدة التجاوز ليس خصوص المحل المقرر شرعاً بل المراد به مطلق التجاوز عن محل جزءٍ من الأجزاء. وسنبحث في الأبحاث القادمة مفصّلاً عما هو المراد بالمحلّ في قاعدة التجاوز إن شاء الله.
نظرية المحقق الأصفهاني:
الدليل الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني كدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء حيث قال بأن كلمة الشيء الواردة في رواية قاعدة التجاوز في قوله(ع): (إذا شككت في شيءٍ ودخلت في غيره) منصرفة إلى الجزء نفسه الشامل للأجزاء الأوّلية المبوّبة كالشك في التكبير والقراءة والركوع والسجود ولا يشمل جزء الجزء الذي هو من الأجزاء الثانوية فالشيء كناية عن أجزاء الصلاة ويشمل أجزاء الصلاة الأصلية المبوّبة دون أجزاء الصلاة[252].
والظاهر أنّ هذا الدليل حسن لا بأس به وإن وقع مخدوشاً فيه من قبل بعض الأعاظم لأنّ الانصراف ليس ممّا يمكن للمرء إنكاره أو قبوله بسهولة بحيث يدّعي أحدٌ الانصراف وينكره الآخر فإنّ الانصراف أمر وجداني، والذي يبدو هنا أنّ الحق مع المحقق الأصفهاني في عدم شمول لفظ الشيء لجزء الجزء. والذي يؤيّد هذا الانصراف تعبير الدخول في غيره الذي لا ينطبق عرفاً على التجاوز من جزء الجزء وبعبارة أخرى فإنّ جزء الجزء عند العرف شيء واحد لا شيئان والعرف يرى جملة (الله أكبر) شيئاً واحداً ولا يفكّك بين (الله) و (أكبر) بحيث يشكّ المكلّف حين التلفظ بـ (أكبر) في أنّه هل تلفّظ بلفظة (الله) أو لا؟ ولو شك كذلك وجب الاعتناء بشكه ولابدّ من إعادة مجموعة جملة (الله أكبر).
نعم يمكن القول بانفصال كلّ آية عن الأخرى في القرآن فيصحّ التفكيك فيها عرفاً، وعليه فلو شك حين قراءة (مالك يوم الدين) هل أتى بـ (الرحمن الرحيم) أولا؟ جرتْ في حقه قاعدة التجاوز لأنّ العرف يرى هاتين الآيتين شيئين مستقلين.
وحاصل رأينا هو أنّه لا يلزم في جريان قاعدة التجاوز أن يلاحظ المحل مقرراً شرعاً بل المحل مطلق وإنما تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء التي يلاحظها العرف على نحو الاستقلال من حيث الدخول والخروج.
وهنا يمكن أن يتساءل المرء بأنّه هل يمكن أن يستفاد من عنوان الأذكرية الوارد في الروايات جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء أيضاً؟
ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من وجهين:
الأوّل: كما ذكرنا سابقاً في الأبحاث الماضية أنّ الأذكرية تتعلّق بروايات قاعدة الفراغ ولا تجري في قاعدة التجاوز، وهذا هو أحد الفروق بين هاتين القاعدتين.
والثاني: أنّ الأذكرية لها عنوان الحكمة لا عنوان العليّة.
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الجزء الأخير من المركّب
من الأبحاث الهامّة في هاتين القاعدتين أنّ قاعدة التجاوز والفراغ هل تجريان في الجزء الأخير من المركب أولا؟ مثلاً لو شك المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في أنّه هل سلّم أولا؟ أو أنّه هل جاء بالتسليم على الوجه الصحيح أولا؟ وكذا لو شك الحاج في باب الحج في أنّه هل جاء بطواف النساء وصلاته اللذي هو الجزء الأخير من واجبات الحجّ؟ وكما لو غلب النعاس على المصلّي في السجود بحيث لا يعلم هل هذا هو سجود صلاته الأخير أو كان سجود الشكر؟ فهل تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في هذه الموارد؟
الحق في الإجابة عن هذا السؤال هو عدم إمكان جريان قاعدة الفراغ بمقتضى التعبيرات الواردة في روايات هذه القاعدة مثل قوله(ع): (بعد ما تفرغ من صلاتك) و (بعد ما ينصرف) و (بعد ما يصلي) لوجود الترديد والشك في تحقق عنوان الفراغ أو الانصراف في الموارد السابقة فلا مجال لجريان هذه القاعدة.
نعم لو حملنا الدخول في الغير الوارد في قاعدة التجاوز بالمعنى الأعمّ وحملنا المحلّ على الأعم من المحل الشرعي والعادي وكان المصلي قد خرج من محلّ صلاته ودخل في عمل آخر أو كان الحاج قد خرج من مكة جاز لنا إجراء قاعدة التجاوز إلاّ أن نلتزم باختصاص قاعدة التجاوز بأثناء العمل فلا يكون للعمل بعد الفراغ منه محل كما استفدنا ذلك من الروايات.
هذا وقد فصّل بعض المحققين[253] في هذه المسألة وذكر عدة صور:
1 ـ يجب تدارك العمل المشكوك فيه فيما لو شك في الجزء الأخير ولما يدخل المكلّف في العمل الآخر.
2 ـ أمّا لو دخل المكلّف في العمل الآخر فللمسألة صور عديدة:
الأوّلى: أن يشكّ في التسليم بعد الدخول في تعقيبات الصلاة أو في سجدتي السهو أو صلاة الاحتياط مما شرعه الشارع بعد الفراغ من الصلاة.
ولا شك هنا في جريان قاعدة الفراغ لأنّ الشكّ هنا من مصاديق الشكّ في الشيء وبعد الدخول في غيره.
إشكال: يبدو أنّ هذا الكلام تام بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، وقد ذكرنا سابقاً أنّ أحد وجوه الفرق بين قاعدتي التجاوز والفراغ أنّ الدخول في الغير غير معتبر في قاعدة التجاوز خلافاً لقاعدة الفراغ.
نعم لا يرد هذا الإشكال على من يعتبر في قاعدة الفراغ الدخول في الغير كالمحقق النائيني[254] الذي يعتقد بأنّ هذا الاشتراط يستفاد من أدلّة قاعدة الفراغ بغض النظر عن اتّحاد القاعدتين ـ حيث لا يمكن أن يكون منشأ لهذه النظرية ـ فإنّ أدلّة قاعدة الفراغ طائفتان فقد ورد هذا القيد في بعضها كصحيحة زرارة حيث يقول فيها الإمام(ع): (إذا خرجت من شيءٍ ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيءٍ). بينما لا وجود لهذا القيد في بعضها الآخر كموثقة ابن بكير حيث جاء فيها: (كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وكذلك موثقة ابن أبي يعفور: (إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه).
ولا بد هنا إمّا من حمل المطلق على المقيّد أو جعل القيد من القيود الواردة في مقام الغالب، وبالتالي لا يكون مقيّداً للإطلاقات.
والتحقيق هو الأوّل لا لأجل وجود المفهوم في القيد ولا لأجل حمل المطلق على المقيد بل إنّ هذا المطلّق ينصرف إلى الفرد الغالب لقصوره الذاتي بالنسبة إلى الفرد غير الغالب، بمعنى أن التجاوز عن الشيء غالباً ما يصدق مع الدخول في الشيء الآخر، ونادراً ما يحصل مع عدم الدخول في الشيء الآخر.
نعم من الواضح أنّ مجرد الغلبة في الوجود الخارجي لا يكون سبباً للانصراف إلاّ أنّنا ندّعي أن المطلق في حقيقته وماهيته له قصور عن الفرد النادر.
وتحقيق القول هو أنّنا ذكرنا في دراستنا لروايات قاعدة التجاوز أنّ صحيحة زرارة هي من الروايات الدالة على قاعدة التجاوز فقط ولا تستفاد منها قاعدة الفراغ كما أنّ الأمثلة الواردة في صدر الرواية هي من مصاديق قاعدة التجاوز والشك في أثناء العمل، وهذه الأمثلة قرينة جليّة على أنّ القاعدة الكلّيّة المذكورة في ذيل الرواية أيضاً محمولة على قاعدة التجاوز وعليه فلا يمكن الالتزام بأنّ من روايات قاعدة الفراغ ما يدل على اعتبار الدخول في الغير بل إنّ روايات قاعدة الفراغ أمّا صريحة في الانصراف عن أصل العمل (بعدما ينصرف من صلاته) أو أنّها صريحة في الفراغ من العمل (بعدما تفرغ من صلاتك)، أو أنّ الوارد فيها مجرد عنوان (ما مضى).
نعم هناك صحيحة أخرى لزرارة تقول: (إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلتَ ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شيء عليك)[255].
وهي كما ذكرنا سابقاً تدلّ على قاعدة الفراغ وقد جاء فيها قيد (وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها) وعلى هذا يمكن اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ بناءً على هذه الرواية فلا تفترق عن قاعدة التجاوز من هذه الناحية إلاّ من جهة أنّ الغير في قاعدة التجاوز هو العمل المترتّب شرعاً على الجزء السابق بينما في قاعدة الفراغ هو الفعل المباين للعمل المشكوك فبحسب هذه الرواية يمكن إجراء قاعدة الفراغ لمن كان منشغلاً بالتعقيبات وشك في التسليم.
رأي المحقق النائيني: هذا وقد ذهب الميرزا النائيني إلى جريان قاعدة التجاوز في هذه المسألة (مسألة انشغال المكلّف بتعقيبات الصلاة مع الشكّ في التسليم) مستدلاً على ما جاء في كتاب أجود التقريرات[256] بأنّ الإمام(ع)في روايات التجاوز قد ألحق الأذان والإقامة بأجزاء الصلاة مما يجعل الفقيه يقطع بعدم خصوصية للأذان والإقامة بل كلّما ألحق بالصلاة من المقدمات والتوابع كالتعقيبات المترتبة على الصلاة شرعاً يصدق عليها الدخول في الغير وهو قد صرّح في فوائد الأصول بأنّه (لا فرق بين الدخول في الإقامة والدخول في التعقيب كلّيهما عن حقيقة الصلاة)[257].
والظاهر عدم تمامية هذه النظرية إذ كما بيّنا مراراً بأن روايات قاعدة التجاوز لها عنوان تعبّدي ولا يمكن لنا تحصيل ذلك القطع الذي ادّعاه الميرزا وكيف يمكن إلحاق توابع الصلاة بمقدماتها مع أنّ المقدمات لها عنوان الدخول في الصلاة بينما تقع التعقيبات بعد الفراغ من الصلاة؟
وعليه فاالظاهر هنا عدم جريان قاعدة التجاوز نعم يمكن إجراء قاعدة الفراغ بمقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في الشكّ في الذراعين.
لأنّ قوله(ع): (صرت في حال أخرى من الصلاة أو غيرها) يشمل هذا المورد من دون شك وترديد.
وقد أورد المحقق الخوئي[258] أيضاً إشكالين على رأي أستاذه هنا:
الإشكال الأوّل: إشكال نقضي بأنّ المكلّف لو شك أثناء الانشغال بالتعقيبات في أنّه هل أتى بأصل الصلاة أولا؟ فإنّ أحداً من الفقهاء لم يلتزم بجريان قاعدة التجاوز هنا.
ويمكن الذبّ عن هذا الإشكال أولاً بأنّه لا علاقة لهذا النقض بالإلحاق وعدم الإلحاق بل إنّ الإشكال وارد على كلّ من يجري قاعدة التجاوز في الشكّ في إتيان أصل العمل سواء ألحقنا التوابع بالمقدمات أم لا.
وثانياً أنّ المحقق النائيني يلتزم بحكومة روايات قاعدة التجاوز على روايات قاعدة الفراغ ولابد في باب الحكومة من التعبّد بمقدار دائرة الدليل الحاكم والدليل الحاكم لا يشمل ذلك الفرض الذي ذكره السيد الخوئي تحت عنوان النقض.
وبعبارة أخرى فإنّ قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء المشكوكة المترتب عليها جزء آخر ولا تجري في أصل العمل.
نعم لو التزم المحقق النائيني بأنّ ملاك التجاوز عن الشيء شامل للتجاوز عن محلّ الشيء وعن أصل الشيء ـ كما صرح بذلك في أجود التقريرات ـ لزمه القول بجريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة أيضاً لصدق التجاوز عن الشيء مع الانشغال بالتعقيبات، وعليه فلا استبعاد لجريان القاعدة في هذا الفرض أيضاً وإن كان لابدّ من الإتيان بالصلاة هنا من سائر الجهات ومع وجود سائر الأدلّة.
الإشكال الثاني: وهو حلّي ويتّضح بالفرق بين المقدمات والتوابع فإنّ الإقامة مترتبة على الأذان شرعاً وتقع بعده ويكون الشكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة من صغريات قاعدة التجاوز بخلاف التعقيبات حيث يعتبر تقديم التسليم عليها دون تأخر التعقيبات عن التسليم وعليه فإنّ التعقيب ليس له محل معيّن مترتب على التسليم في نظر الشارع فلا تجري قاعدة التجاوز.
ومن جهة أخرى لم يحرز عنوان الفراغ وبالتالي لا تجري قاعدة الفراغ ويجب على المكلّف أن يتدارك التسليم.
ويمكن للمحقق النائيني أن يجيب عن هذا الإشكال بأنّ الغرض من الإلحاق هو هذا المطلب بمعنى أنّنا نلحق الجزء غير المترتب على الجزء السابق شرعاً كالتعقيب بالمقدمات التي يتوفّر فيها الترتب الشرعي. وعلى هذا فالأوّلى في النظر هو الإشكال الذي قدمنّاه نحن وهو أنّ لروايات التجاوز عنواناً تعبّدياً فلا يمكننا التعدّي عنها.
الصورة الثانية التي ذكرها هي أنْ يشكّ المكلّف في تسليم الصلاة بعد إتيان الفعل المنافي المبطل للصلاة سواء كان ذلك الفعل عن عمد أم سهواً كالحدث أو النوم.
يعتقد المحقق الخوئي والمحقق العراقي بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة أمّا المحقق النائيني فقد التزم بجريان هذه القاعدة في هذه الصورة في الدورة الأوّلى من الأصول لكنّه عدل عن ذلك في الدورة الثانية وهو قد ذكر وجهين على جريان القاعدة هنا:
الوجه الأوّل لجريان قاعدة التجاوز أنّ ترتّب الفعل المنافي على التسليم إنّما هو من أجل أنّ التسليم له عنوان المحلّل ويكون ترتب المحلّل من باب ترتب المحلّل بالمحلّل، وبالتالي يصدق هنا التجاوز عن الشيء والدخول في غيره.
ثمّ أورد المحقق النائيني إشكالاً على هذا الوجه وهو أنّ القدر المتيقّن من أدلّة قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير الذي يعتبر أحد أجزاء المركّب أو ملحقاته فلا تشمل قاعدة التجاوز الدخول في الغير مطلقاً وبعبارة أخرى أنّه لا يحصل لنا الظن فضلاً عن القطع بكفاية الدخول في الغير المطلق.
الوجه الثاني لجريان قاعدة التجاوز هو: أنّ فعل المبطل أثناء الصلاة لمّا كان موجباً لفسادها بل الأحوط وجوباً حرمته فلابدّ من أن يكون محلّه بعد التسليم ويكون من الأجزاء ويكون من الأجزاء المترتبة على الجزء الأخير شرعاً. فلو جيء بالمبطل وشك في الجزء الأخير صدق حينئذٍ العنوان الكلّي للشك في الشيء بعد الدخول في غيره وجرتْ قاعدة التجاوز.
أمّا وجه عدم جريان قاعدة التجاوز فهو أنّ المبطليّة أثناء العمل أو حرمته مستلزمة لأن يكون المحل الشرعي للمبطل بعد الجزء الأخير ولا يمكن أن يكون المبطل كالتعقيبات بحيث يكون محلّه الشرعي بعد الجزء الأخير، وبينها فرق واضح.
هذا وقد استقرب بعضهم الوجه الأوّل إذ لو فرضنا وقوع الفعل المبطل قبل التسليم لم يمكن للمصلّي الإتيان بالتسليم ولا بدّ من أن يكون محلّ التسليم قبل المبطل، فلو شكّ في التسليم بعد إتيان الفعل المبطل كان ذلك من مصاديق الشكّ في الشيء بعد الدخول في غيره.
الوجه المختار: والظاهر هو أنّ القول بعدم الجريان هو الأقوى، إذ لا ملازمة بين عدم صحّة التسليم بعد المبطل وبين كون محلّ التسليم قبل المبطل ولا يمكن الالتزام بأنّ ما كان مبطلاً لشيءٍ لابدّ أن يكون محلّ ذلك الشيء شرعاً قبل المبطل.
توضيح ذلك أنّه لو جاء المكلّف في أثناء الصلاة بما يُبطل الصلاة كما لو جاء به قبل ركوعها فإنّ أحداً لم يلتزم هنا بأنّ محلّ الركوع شرعاً هو قبل المبطل، هذا مع أنّ المبطل لا اختصاص له بالجزء الأخير بل له عنوان المبطلية بالنسبة لمجموع العمل، مع أنّ قاعدة التجاوز إنّما تجري في الجزء المعيّن المشكوك، وعليه فالظاهر أنّ قاعدة التجاوز غير جارية في هذه الصورة.
وقد ذهب السيد الخوئي[259] إلى هذا الرأي إذ يعتبر في جريان هذه القاعدة أن يكون الجزء المشكوك قبل الجزء الآخر من وجهة نظر الشارع مع أنّ تسليم الصلاة لا يعتبر فيه أن يقع قبل إتيان المبطل عمداً كان أم سهواً وإن اعتبر في صحّته عدم وقوع الفعل المنافي. ومن هنا لا تجري قاعدة التجاوز.
نعم لو قلنا بأنّ وقوع الحدث قبل التسليم يوجب فساد الصلاة كما يراه المحقق النائيني ـ جرتْ قاعدة الفراغ هنا أمّا لو لم نلتزم بإبطاله للصلاة لم تبق لجريان قاعدة الفراغ ثمرة.
ذكر المحقق النائيني بعد أن التزم بعدم جريان قاعدة التجاوز في هذا المورد بأنّ قاعدة الفراغ هي الجارية هنا إذ يُعتبر في جريان قاعدة الفراغ أمران:
أحدهما: التجاوز عن الشيء والفراغ منه.
والثاني: الدخول في غيره المباين مع ذلك الشيء وكلا الأمرين متوفر فيما نحن فيه فإنّ عنوان الدخول في الغير ثابت من أنّه لو أتى بفعل مستحب أو مباح وإن كان غير مناف صدق عنوان الدخول في الغير فضلاً عن إتيان الفعل المنافي فإن عنوان التجاوز عن الشيء صادق معه أيضاً.
لأنّ تحقق معظم الأجزاء كافٍ في إحرازه ولا أثر لإحراز الجزء الأخير كما يقول في استمرار حديثه بأنّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين أن يکون الشكّ في الجزء الأخير إلى الشكّ في بطلان العمل، كما لو شك في الجزء الأخير من الوضوء مع فوات شرط الموالاة أو لم يؤدِّ الشكّ في الجزء الأخير إلى الشكّ في بطلان مجموع العمل كالشك في غسل الطرف الأيسر في الغُسل فيما لو كانت عادة المكلّف أن يغسل جميع الأعضاء في الغسل دفعة واحدة ممّا توجب هذه العادة صدقَ عنوان التجاوز عن العمل ولمّا كان القطع بإتيان معظم الأجزاء حاصلاً جرت قاعدة الفراغ.
وما يلاحظ على نظرية المحقق النائيني هو أنّه ما الدليل على كفاية تحقق معظم الأجزاء في جريان قاعدة الفراغ؟ بل الظاهر من أدلّة هذه القاعدة انصرافها إلى تمام العمل.
وقد أورد المحقق الخوئي على جريان قاعدة الفراغ الوارد في كلام المحقق النائيني بأنّ ملاك جريان قاعدة الفراغ هو إحراز الفراغ وعنوان المضيّ من العمل ولا يحرز هذا العنوان مع الشكّ في تحقق الجزء الأخير، يتابع السيد الخوئي كلامه ويقول: بأننا لا نعتبر عنوان الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، والمعتبر هو إحراز المضيّ من العمل.
هذا وقد احتمل بعضهم أنّ المراد ليس المضيّ واقعاً وحقيقة، إذ لو اعتبرنا هذا العنوان لزم أن تكون هذه القاعدة لغواً وعبثاً ولا يكون لها أيّ مصداق إذ بمجرّد الشكّ في صحّة العمل لا يكون عنوان المضي الواقعي قابلاً للإحراز، وعليه فإنّ المراد بالمضيّ في هذه القاعدة هو المضيّ بحسب الاعتقاد بمعنى أن يعتقد المصلّي بالفراغ من الصلاة حين اشتغاله بالتعقيب أو العمل المنافي.
ومن هنا يرى السيد الحكيم[260] بأنّ المضي الواقعي غير مقصود في المقام لأنّه بمعنى الفراغ من العمل الصحيح ومع هذا الوصف فلا معنى للشك أبداً.
لكنّ التحقيق أن المراد بالمضيّ هو مضيّ ذات العمل سواء على نحو التام أو الناقص وسواء وقع صحيحاً أم فاسداً، وعليه فإنّ المصلي يكون متيقّناً من الفراغ من ذات العمل فلا يمكن لنا أن نفسّر لفظ المضيّ بالمضيّ بحسب الاعتقاد.
تحليل نظرية صاحب منتقى الأصول:
سلك بعض المحققين[261] في جريان القاعدة مسلكاً آخر يتوقف على ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: (أنّ المراد من الفراغ من الصلاة هو الاشتغال بغيرها لا إتمامها والانتهاء منها إذ هما مدلولان التزاميان للفراغ ولا يدلاّن عليه بالمطابقة كما أنّ التعبير بالفراغ لم يرد إلاّ في رواية زرارة المفصّلة...)
ذكر في تفسير الفراغ بأنْ ليس المراد من الفراغ إتمام العمل وأنهاءَه إذ أولاً هذا العنوان مدلول التزامي للفراغ وليس مدلولاً مطابقياً لأنّ الفراغ بمعنى الخلوّ يرادف إنهاء العمل وإتمامه، في مقابل أثناء العمل وبينه، وعليه فإنّ الفراغ إنّما يصدق على الإتمام من جهة استلزامه للخلوّ وعدم الاشتغال بمعنى أنّ بعد إتمام العمل يكون المكلّف خالياً من الاشتغال بالعمل.
وثانياً فإنّ عنوان الفراغ إنّما ورد في رواية زرارة التي فرّقت بين الشكّ في أثناء الوضوء والشك بعد الوضوء، ومن الواضح أنّ المقصود من الفراغ في هذه الرواية هو الاشتغال بغير الوضوء. ويتابع المحقق المذكور کلامه ويقول: بأنه لو أغمضنا النظر عن هذا المطلب وفسرّنا الفراغ بمعنى الإتمام والإنهاء إلاّ أنّ الإتمام حسبما نراه إنّما يتحقّق بإتيان معظم الأجزاء لأنّ المراد من الفراغ عن العمل هو الفراغ من العمل الصحيح أو الفاسد، ومن هنا صحّ كلّام المحقق النائيني حيث فسّر العمل بمعظم الأجزاء، ذلك لأنّ عنوان الإتمام والانتهاء عامّ يشمل ما لو تحقق معظم الأجزاء، وعليه فلو دخل المصلّي في قاطع الصلاة ثمّ شك في صحتها جرت قاعدة الفراغ فيما لو أتى بمعظم الأجزاء وليس هذا إلاّ لأجل أنّ الإتمام بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد يصدق مع تحقق معظم الأجزاء.
الأمر الثاني: ذكر فيه أنّ ما ذكره السيد الخوئي في تفسير لفظة (المضيّ) لا دليل عليه فإنّ المحقق الخوئي فسرّ المضي من العمل بالفوت وعدم التدارك مع أنّ المضي معناه تحقق الفعل في الزمان السابق ولذا لو دخل المكلّف في الفعل المنافي بعد إتيان معظم الأجزاء لا يُفرّق بين أن يكون المنافي عمداً أم سهواً لصدق المعنيّ حين الانشغال بالعمل المنافي للصلاة.
الأمر الثالث: ذكر فيه أنّه لو سلّمنا بأنّ الفراغ من العمل هو الاشتغال بغيره استنتجنا بأنّ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي لا الفراغ الحقيقي.
توضيح ذلك: أنّ هذا المعنى للفراغ أي الاشتغال بالغير لا يمكن أن يتحقّق إلاّ إذا بنى المكلّف على تمامية العمل، وبتعبير أوضح فإنّ الفراغ الحقيقي بالمعنى المذكور آنفاً لا يتحقق إلاّ مع البناء على تمامية العمل فطالما يكون المكلّف منشغلاً بالعمل نفسه وينوي ذلك فهو مشغول بذلك ولم يحصل له الفراغ.
وبهذا البيان يتّضح لنا أنّ لفظ الفراغ قد استعمل في الفراغ الحقيقي وليس هذا الاستعمال مجازياً. والمهم هنا البحث أنّ الفراغ الحقيقي إنّما يتحقق بالفراغ البنائي.
الإشكالات الواردة على رأي صاحب منتقى الأصول:
والظاهر أنّ هناك عدّة ملاحظات على كلام صاحب منتقى الأصول:
الأولى: تتعلّق بالأمر الأوّل من الأمور الثلاثة المذكورة في كلماته وهي أنّ الاشتغال بغير العمل لا علاقة له في معنى الفراغ، وهناك موارد كثيرة يحصل فيها الفراغ من العمل من غير أن ينشغل المكلّف بعمل آخر، فمثلاً من جاء بتسليم الصلاة ثمّ شكّ مباشرة في صحة الركوع أو السجود فإنّ قاعدة الفراغ جارية في حقّه من دون أي محذور مع أنّ المكلّف لم يشتغل بالغير.
الثانية: إنّ المتبادر عرفاً من الفراغ المذكور في الروايات هو تمامية العمل ولا بد من حمل لفظ الفراغ على هذا المعنى وإن كان هذا المعنى مدلولاً التزامياً للمعنى الأوّلي اللّغوي.
الثالثة: أنّ الظاهر في جريان قاعدة الفراغ هو أنّ المصلّي لا بدّ له من أن يعتبر عمله تاماً بحيث يفرغ من ذات العمل، وعليه فلو شك في صحة بعض الأجزاء جرت في حقه قاعدة الفراغ وإنْ لم يقطع بإتيان معظم الأجزاء.
ومن جهة أخرى فلو شكّ في التشهّد وهو في الركعة الأخيرة من الصلاة وقد أتى بمعظم الأجزاء لم يمكنه إجراء قاعدة الفراغ، وعليه فإنّ ما التزم به تبعاً للمحقق النائيني من كفاية تحقق معظم الأجزاء في جريان قاعدة الفراغ، أمر مردود.
الرابعة: إنّ ما قاله من أنّ تعبير الفراغ إنمّا ورد في رواية زرارة فقط من بين جميع الروايات ولابدّ من أنّ يراد بالفراغ في هذه الرواية الاشتغال بالغير محلّ تعجب منه إذ ورد لفظ الفراغ في عدة روايات أخرى كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع): (قال: كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد).
الصورة الثالثة: لو شكّ في تسليم الصلاة مع عدم انشغاله بالمبطل ومن جهة ثانية لم يصدر منه سكوت طويل يؤدّي إلى فوات الموالاة فإنّ مقتضى قاعدتي الاشتغال والاستصحاب الإتيان بالتسليم، ومن الواضح هنا عدم جريان قاعدة التجاوز لعدم تحقق موضوعها وهو الدخول في الغير.
أمّا بالنسبة إلى جريان قاعدة الفراغ أو عدم جريانها فقد احتمل بعضهم جريانها لأنّ هذا الشكّ إنمّا يرجع إلى أنّ المصلي هل يجوز له الاكتفاء بصلاة شكّ في تسليمها أو لا؟ فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ الاكتفاء بصلاة كهذه.
وهذا الكلام ليس بتام، لأنّ هذه النتيجة لقاعدة الفراغ إنّما هي فيما لو كان أصل جريان القاعدة أمراً مسلّماً مع احتمال عدم جريانها أمر وارد في المقام لأنّ المصلّي لو لم يأت بالسّلام فإنّه لا يزال في أثناء العمل ولا تجري هذه القاعدة في أثناء العمل، وقد ذكرنا فيما سبق من الأبحاث بأنّ المعتبر في جريان هذه القاعدة فراغ المكلّف من العمل ولا بد من تحقّق الفراغ العملي مع أنّ هذا العنوان لم يُحرزْ في هذه الصورة.
الصورة الرابعة: هي أن يشكّ المكلّف في تسليم الصلاة ولم يفعل بعدُ ما يبطل الصلاة بل انشغل بما لا يبطلها كما لو بدأ بقراءة القرآن. وحكم هذه الصورة يظهر من حكم الصورة الثالثة.
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشكّ في صحّة الأجزاء:
إلى هنا قد ظهر لنا حكم جريان قاعدة التجاوز عند الشكّ في أصل وجود الجزء كالشك في أصل وجود الركوع بعد الدخول في السجود أو الشكّ في أصل وجود القراءة بعد الدخول في الركوع ولا إشكال في ذلك وإنّما النزاع والإشكال في جريان هذه القاعدة فيما لو شك في صحّة الجزء بسبب احتمال الخلل في شروط ذلك الجزء کما لو شك المكلّف أثناء السجود في أنّه هل كان ركوعه المأتي به صحيحاً أو كان فاسداً بسبب عدم شموله على الطمأنينة فهل يمكن الحكم بالصحّة في هذه الموارد تمسكاً بقاعدة التجاوز؟
نجيب عن هذا التساؤل: بأنّنا لو جعلنا قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة ـ كما ذهب إلى ذلك المحقق البجنوردي والإمام الخميني ـ التزمنا بعدم التفريق بين الشكّ في صحّة الكلّ والشك في صحّة الجزء.
لأنّ المستفاد من الروايات مثل (كلّما شككت فيه مما قد مضى) هو الحكم الكلّي والقاعدة العامّة أي (عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضيّ) وهذا الحكم الكلّي يشمل الأجزاء كما يشمل كلّ العمل أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ من العمل أم بعد التجاوز من محل الشيء، وسواء كان الشكّ في أصل وجود ذلك الجزء أم كان الشكّ في صحة الجزء المأتي به فإنّ هذه الموارد كلّها مشمولة للحكم الكلّي المستفاد من قاعدة الفراغ والتجاوز.
أمّا لو لم نعتبرهما قاعدة واحدة كما ارتأينا ذلك وقلنا بأنّ قاعدة الفراغ متعلّقة بكلّ العمل وبما بعد العمل، بينما تختصّ قاعدة التجاوز بالشك في الأجزاء وبأثناء العمل فمن المشكل إجراء قاعدة التجاوز عند الشكّ في صحّة الجزء لأنّ أخبار قاعدة التجاوز ظاهرة في الشكّ في أصل وجود الجزء لا في صحّته بعد الفراغ من أصل وجوده.
نعم قد يقال: بأنّ الأخبار وإن كان لها ظهور بدوي في الشكّ في أصل وجود الجزء إلاّ أنّنا نحكم من خلال تنقيح المناط بعدم التفريق بين الشكّ في أصل وجود الجزء والشك في صحّته، بل ربّما يدّعى الأولويّة هنا، لأنّ الشكّ في أصل الوجود إذا كان داخلاً في القاعدة فإنّ الشكّ في صحة الجزء بعد الفراغ من وجوده يكون داخلاً في القاعدة بطريق أولى.
هنا وقد شكّك بعض الأعاظم في هذا الدليل من جهة أنّ هذه الأولويّة لو كانت أولوية قطعية لأمكن قبولها لكن لمّا كانت قاعدة التجاوز أمراً تعبّدياً شرعياً ولا يمكن تحصيل القطع بالملاك في الأمور التعبّدية فإن الأولويّة المذكورة لا تكون قطعية ولا يصحّ التمسّك بها.
أمّا جريان قاعدة الفراغ في هذا البحث ففيه رأيان فقد ذهب بعض الأعاظم إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرع لأنّها مختصّة بما إذا شك المكلّف في صحّة مجموع العمل بعد الفراغ منه.
بينما تمسّك بعض آخر من الأعاظم كالمحقق الخوئي[262] وبعض تلامذته بإطلاق موثّقة ابن بكير في هذا الفرض وقالوا: بأنّ لجملة (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى) إطلاقاً يشمل الجزء كما يشمل كلّ العمل ومن هنا فإنّهم صرّحوا بأنّ قاعدة الفراغ كما تجري عند الشك في صحّة كلّ العمل كذلك تجري عند الشك في صحّة الجزء أيضاً.
والظاهر أنّ هذا الاستدلال غير تام أولاً لأنّا قد ذكرنا مراراً بأنّ لفظة من في (ممّا قد مضى) بيانية وليست تبعيضية والفاعل في (مضى) ظاهر في كلّ العمل.
وبعبارة أخرى لا إطلاق لهذه الرواية وعليه فلا تجري قاعدة الفراغ في المقام.
ثانياً: لو سلّمنا إطلاق هذه الرواية إلاّ أنّ هناك تعبيرات في الروايات الأخرى في هذا الباب تكون مقيّدة لإطلاق هذه الرواية مثل (بعد ما تفرغ من صلاتك) ومثل (بعد ما ينصرف) و (بعد ما صلّى) حتّى إنّ التعبير بالأذكرية المذكور في روايات الفراغ له ظهور فيما بعد العمل.
والحاصل: أنّ قاعدة الفراغ تكون مختصّة بما بعد العمل ولا تجري في الشك في صحّة الأجزاء أثناء العمل.
الرأي المختار: وعلى ما استفدناه من روايات قاعدة الفراغ والتجاوز من الفرق بين القاعدتين حيث إنّ قاعدة الفراغ مختصّة بالشك فيما بعد العمل وقاعدة التجاوز بالشك في أثناء العمل وأنكرنا نظرية المشهور في الفرق بين القاعدتين من جهة أنّ مورد قاعدة التجاوز هو الشك في أصل الوجود ومورد قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة.
وعليه نستنتج أنّ قاعدة التجاوز تجري في الشك أثناء العمل مطلقاً سواءً كان الشك في وجود الشيء أم في صحّته. ولا داعي حينئذٍ إلى تنقيح المناط والأولوية في البحث.
ما المراد من المحلّ في قاعدة التجاوز؟
لابدّ من قاعدة التجاوز من التجاوز عن المحلّ والسؤال هنا هو إنّه ما معنى التجاوز عن المحل؟ وما معنى المحلّ؟
ذُكِرَ في الجواب عن هذا السؤال ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأوّل: أنّ المراد بالمحل هو المحل الشرعي المقرر الذي حدّده وعيّنه الشارع المقدّس.
الاحتمال الثاني: إنّ المراد هو المحلّ العقلي فإنّ العقل يجعل للأشياء والأشياء محلاً معيناً عن طريق الملاكات المختلفة فعلى سبيل المثال إن جملة (الله أكبر) من حيث الوضع اللغوي لهذه الهيئة التركيبية يكون لفظ الجلالة مقدّماً فيها على لفظة (أكبر) فالمراد بالمحلّ العقلي هو المحلّ الذي لم يتعيّن من قبل الشارع بل تعيّن وفقاً لضابطة أخرى كالقانون الوضعي.
الاحتمال الثالث: أن يكون المراد بالمحلّ هو المحلّ العادي وهو ما تحقّق بحسب العادة سواء كانت عادةً شخصية أم نوعية، فمثلاً من كانت عادته التوضؤ بعد كلّ حدثٍ أصغر، فلو صدر منه الحدث الأصغر ومضى عليه نصف ساعةٍ مثلاً فهل تجري في حقّه قاعدة التجاوز؟ وبالنسبة إلى هذه الاحتمالات وجريان قاعدة التجاوز فيها لابدّ من القول بأنّ قاعدة التجاوز جارية من غير شكّ وترديد فيما تجاوز محلّه الشرعي فإنّ محل الركوع في الصلاة قبل السجود، فلو شكّ المصلّي حال السجود في إتيان الركوع جرت في حقّه قاعدة التجاوز لمضيّ محلّ الركوع.
وإنّما الكلّام في الاحتمالين الثاني والثالث فهل تجري قاعدة التجاوز مع تجاوز المحلّ العقلي أو العادي أولا؟
فقد بيّنا بالنسبة إلى المحل العقلي بأنّ العقل بنفسه لا يعيّن محلّ الأشياء والأجزاء بوجه من الوجوه بل يحكم بوجوب مراعاة القانون والضابط الموجود في المقام، وبالتالي يرجع المحلّ العقلي إلى المحلّ الشرعي فإنّ القانون في المقام قد يكون هو الشرع كما لو عيّن الشارع محلّ الركوع في الصلاة، وقد يكون هو الوضع كما لو حكم الوضع بتقديم لفظ الجلالة على (أكبر) في جملة (الله أكبر) فيكون ذلك هو المأمور به.
أمّا المحل العادي فقد مثّلنا له بمن كانت عادته التوضؤ بعد الحدث الأصغر فإنّ محلّ الوضوء العادي يكون بعد الحدث الأصغر فلو شك هذا الشخص بعد مضي نصف ساعة على الحدث الأصغر في أنّه هل توضأ أو لا فهل تجري في حقه قاعدة التجاوز من جهة تجاوز محلّ الوضوء العادي عنده؟
فقد أظهر الشيخ الأنصاري[263] تأملّه في ذلك وذكر أدلّة على جريان قاعدة التجاوز وأخرى على عدم جريأنّها في هذا المورد:
فقد ذكر دليلين على جريان القاعدة:
الدليل الأوّل: هو الإطلاق حيث إنّ إطلاق روايات الباب يشمل التجاوز عن المحلّ العادي أيضاً فإنّ المراد بالشيء في قوله(ع): (جاوزت عن شيءٍ) هو مطلق الشيء.
والدليل الثاني: هو التعليل الوارد في رواية زرارة الصحيحة (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ)[264] يرى الشيخ أنّ هذا التعليل يدلّ على أنّ الظاهر هو المقدّم فيما لو دار الأمر بين الظاهر والأصل، فمثلاً من توضأ ثمّ شكّ بعد الانتهاء من الوضوء في أنّه هل مسح رأسه أولا؟ فإنّ الأصل عدم إتيان المسح فلابدّ له من الإتيان بالمسح ثانية لكنّ ظاهر حال المكلّف في مقام امتثال أمر المولى يشهد بأنّ المكلّف قد جاء بجميع الأجزاء والشرائط، وبعبارة أخرى فإن الظاهر على إتيان العمل.
وهذا التعليل يدلّ على أنّ الظاهر مقدّم على الأصل فيما لو تعارضا حتى لو كان منشأ هذا الظهور عادة المكلّف[265].
هذان الدليلان ذكرهما الشيخ على جريان قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحل العادي لكنه يذكر دليلين آخرين على عدم جريان القاعدة في المقام:
الدليل الأوّل: هو أنّ ذلك يستلزم إحداث فقه جديد حيث لم يُفتِ أحدٌ من الفقهاء بأنّ من كانت عادته أن يتوضأ بعد الحدث الأصغر وشك بعد مرور نصف ساعة على الحدث في أنّه هل توضأ بعد ذلك الحدث الأصغر أولا حُكِمَ على أنه متطهرٌ وجاز له الدخول في الصلاة[266]، وعليه فإنّ إجراء قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحل العادي مستلزم لتأسيس فقه جديد.
الدليل الثاني: مضافاً إلى أنّ جريان القاعدة في المقام يخالف الاطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب الإتيان بالوضوء كلّما شك المكلّف قبل الصلاة في أنّه هل توضأ أولا سواء كانت عادة المكلّف أن يتوضأ بعد كلّ حدث أصغر أم لم تكن.
ومن هنا فإن الشيخ الأنصاري رأى أنّ الأمر مشكل وأمر بالتأمل فهو متوقف عملياً ولا بد حينئذٍ من الرجوع إلى أصل الاستصحاب.
أدلة اختصاص القاعدة بالمحل الشرعي:
وهناك أدلّة أخرى يستفاد منها أنّ قاعدة التجاوز مختصّة بالتجاوز عن المحل الشرعي:
الدليل الأوّل: قد ذكرنا في مسألة تعدّد القاعدتين أنّ المستند الوحيد لقاعدة التجاوز هي الروايات، ومن هنا كانت هذه القاعدة أمراً تعبديّاً شرعياً، وبالرجوع إلى روايات قاعدة التجاوز يتّضح لنا أنّ المحلّ العادي لم يذكر في أية واحدةٍ من تلك الروايات، والمذكور في جميع الروايات هو التجاوز عن المحل الشرعي، وقد ذكرنا سابقاً أنّ كثرة الأمثلة توجب تحديد الضابطة.
الدليل الثاني: على مبنى المحقق النائيني القائل بحكومة روايات قاعدة التجاوز على روايات قاعدة الفراغ وإلحاق الشك في الجزء بالشك في الكلّ فإنّ الحكومة لمّا كانت أمراً تعبّدياً فلابدّ من الالتزام بدائرة التعبّد الدالة على المحل الشرعي فقط وإن كنّا قد ناقشنا مبنى المحقق النائيني هذا في المباحث السابقة.
الدليل الثالث: ما أشار الإمام الخميني وهو أنّ المشرّع إذا عين محلاً لأفعال قد أوجبها هو ثمّ أعطانا قاعدة كلّيّة بأنّه كلّما تجاوز عن محل تلك الأفعال ثمّ شككتم فيها لم يجب الاعتناء بها فإنّ العرف والعقلاء إنّما يفهمون من هذا المحلّ ذلك الذي ذكره المشرّع نفسه لا المحل العادي بحسب عادة الشخص أو النوع.
وعلى هذا فإنّ القول بجريان قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحلّ العادي لإطلاق الأدلة مشكل وغير قابل للقبول[267].
ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟
مما وقع فيه الخلاف في بحث قاعدة التجاوز هو أنّه ما المراد من الغير الذي لابدّ من الدخول فيه في قاعدة التجاوز؟ وهل التعبير بقوله(ع): (دخلت في غيره) قيدٌ توضيحي بمعنى أن التجاوز عن الشيء إنّما يتحقّق بالدخول في الغير ولولا الدخول في الغير لما حصل التجاوز.
أو أنّ التجاوز عن المحل عنوان مستقل سواء حصل الدخول في الغير أم لم يحصل؟
المستفاد من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري هو أنّ الدخول في الغير قد يكون محصّلاً للتجاوز، وقد يحصل التجاوز من غير أن يحصل الدخول في الغير.
وحتى يتّضح هذا البحث لابدّ من توضيح المراد من الغير، فهل المراد به هو الغير الذي يترتّب على الجزء المشكوك شرعاً أو أنّ المراد به مطلق الغير والجزء التالي وإن لم يترتب شرعاً على الجزء المشكوك؟ فإنّ السجود في الصلاة جزءٌ مترتّب شرعاً على الركوع مع أنّ العمل الواقع قبل السجود أي الهويّ إليه جزء آخر غير مترتّب شرعاً على الركوع.
وكذلك هل يراد بالغير الأجزاء الأصلية كالركوع والسجود والقيام أو أنّه يشمل الأجزاء غير الأصلية أيضاً كالهويّ إلى السجود والنهوض للقيام.
رأي الشيخ الأنصاري: أنّه يرى أنّ المراد به هو الأجزاء الأصلية للعمل وهو ظاهر صحيحة إسماعيل بن جابر إذ يقول الإمام(ع)في صدر الرواية: (إنّ شك في الركوع بعدما سجد فليمض وإن شك في السجود بعدما قام فليمض)[268].
وهذه العبارة مقدّمة للقاعدة الكلّيّة المذكورة في ذيل الرواية (كلّ شيءٍ شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).
يقول الشيخ الأعظم بأنّ صدر الرواية في صدد تشخيص المصاديق بينما يبيّن ذيل الرواية قاعدتها الكلّيّة أي أنّ المراد من الدخول في الغير هو الدخول في الأجزاء الأصلية يعني الغير الذي رتّبه الشارع على الجزء المشكوك كالركوع والسجود والقيام لا أيّ جزء وإنْ لم يكن أصلياً[269].
وعلى هذا فمن شك حال الهويّ إلى السجود في أنّه هل ركع أو لا يجب عليه الاعتناء بشكه ولابد من الإتيان بالركوع ولا تجري حينئذٍ قاعدة التجاوز.
ويؤيد هذا الرأي رواية أخرى يسأل فيها الراوي من الإمام(ع): (رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجود فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: سجد)[270].
وهذه الرواية صريحة في أنّ الدخول في الأجزاء غير الأصلية غير كافٍ.
رأي المحقق الأصفهاني:
يقول المحقق الأصفهاني في مقابل الشيخ الأنصاري بأنّ الموارد والأمثلة المذكورة في صدر الرواية ليست لتحديد القاعدة الكلّيّة المذكورة في ذيل الرواية بل ذُكرت من باب الأمثلة توطئةً لذكر القاعدة الكلّية[271] وعليه فإنّه يرى أنّ قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء غير الأصلية أيضاً، فلو شك المكلّف حال الهويّ إلى السجود في أنّه هل ركع أولا يجب عليه الإتيان بالركوع.
قد يقال ردّاً على المحقق الأصفهاني بأنّه لو كان الأمر كما تقولون فلِمَ لم يمثّلْ الإمام(ع)في الرواية بالأجزاء غير الأصلية فلا أقلّ من ذكر مثال واحد على ذلك؟ أليس عدم ذكره دليلاً على عدم جريان القاعدة في الأجزاء غير الأصلية؟
وقد التفت المحقق الأصفهاني إلى هذا الإشكال وأجاب: بأنّ الإمام(ع)إنّما لم يذكر هذه الموارد في صدر الرواية لندرة وجودها فإنّ الشك في إتيان الركوع وعدمه عادةً يقع حال السجود ولا يقع لمن هو في حالة الهويّ إلى السجود وقبل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود لقرب عهده من الجزء المشكوك فهذا الشك الذي منشؤه الغفلة غالباً ما يقع في السجود والجزء التالي للسجود[272].
وهو في مقام الإشكال على الشيخ الأنصاري يقول: بأنّ قبول كلام الشيخ الأنصاري يوجب الاكتفاء بتلك الموارد والأمثلة المذكورة في صدر الرواية من غير إمكانية التعدّي إلى موارد أخرى.
ثمّ قال: لو سلّمنا بأنّ ذكر موردي الشك إنّما هو من باب التمثيل ولا اختصاص بهذين الموردين بل لو شككنا حالة القيام بأنّه هل كبّرنا أولا، لابدّ من عدم الاعتناء بهذا الشك.
ومن ناحية ثانية لو التزمنا بوجوب حمل الغير على التحديد وفكّكنا بالتالي بين موضوع الشك من جهة ومعنى الغير من جهة أخرى فإنّ هذا التفكيك لا دليل عليه بل هو تحكّم محض[273].
ويقول أخيراً بأنّ هناك روايات تدلّ على أنّ الدخول في مقدمات الأفعال والأجزاء غير الأصلية كافٍ ويوافق القاعدة كرواية عبد الرحمن حيث يسأل الإمام(ع): (رجلٌ اهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع)[274].
نعم في رواية عبد الرحمن الأخرى يسأل من الإمام(ع): (رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد)[275].
حيث يستفاد من هذه الرواية بأنّ المكلّف لو رفع رأسه من السجود وشكّ في أنّه هل سجد أولا؟ وجب عليه أن يعود ويسجد، ولعلّه لهاتين الروايتين لعبد الرحمن فصّل صاحب المدارك بين الهويّ إلى السجود والنهوض إلى القيام وقال في الأوّل: بعدم الاعتناء بشكّه والبناء على أنّه قد أتى بالركوع، وأمّا في الثاني فقد حكم بوجوب الرجوع والإتيان بالسجود.
الرأي المختار:
من بين هاتين النظريتين يبدو لأوّل وهلة أنّ الحقّ مع الشيخ الأنصاري وأنّ قاعدة التجاوز لا تجري في موارد الهويّ إلى السجود والنهوض للقيام والأجزاء غير الأصلية. وقد وضّحنا ذلك في الأبحاث السابقة.
ومن الأهمية بمكان والذي ينفعنا في موارد كثيرة هو أنّ المورد لا يقيّد وأنّه لو سألنا الإمام(ع)عن حكم موردٍ ما وأجاب الإمام(ع)بذكر قاعدة كلّيّة فإنّ مورد السؤال لا يمكن أن يقيّد القاعدة أمّا لو ذُكرت موارد ونماذج عديدة لها جهة اشتراك واحدة قبل بيان القاعدة الكلّيّة من قبل الإمام(ع)فإنّ القاعدة الكلّيّة تتحدّد من قبل الإمام(ع)بتلك المسائل المشتركة فما نحن فيه من هذا القبيل.
أمّا بالنسبة لما ذكره المحقّق الأصفهاني من لزوم التفكيك فنقول في الجواب: ما هو الإشكال فيما لو علمنا من جهةٍ بأنّ لا خصوصية لمثال الركوع والسجود وحكمنا بسبب علمنا هذا بأنّ القاعدة المذكور في الذيل ليست مختصّة بالركوع والسجود، ومن جهة ثانية نرى أنّ هذه الأمثلة مشتركة في محور خاص وبينها قدر جامع مشترك والعرف يفهم منها تقييد الكبرى الكلّيّة وعليه فلا بد من ارتكاب هذا التفكيك ولا تحكّم في البين.
والحاصل أنّ رأي الشيخ الأعظم الأنصاري قابل للقبول.
نعم قد يدّعي أحدهم في مقام الإشكال بأنّ هناك تعارضاً بين رواية عبد الرحمن في الهويّ إلى السجود وبين رواية إسماعيل بن جابر.
لكنّه يجاب بأنّ في رواية إسماعيل بن جابر إنّما يجب الإتيان بالسجود، لأن الشكّ قد وقع قبل الاستواء والقيام ولم يحصل الغير بعدُ عرفاً، أمّا الهويّ للسجود فهو من المقدّمات القريبة للسجود عرفاً فلم يحصل الدخول في غيره، وعليه فلا تعارض بين هاتين الروايتين.
يرى المحقق النائيني بأنّ الهويّ إلى السجود له مراتب إذ من أوّل الانحناء وحالة التقوّس إلى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود كلّها من مصاديق الهويّ للسجود.
ويمكن حمل عنوان الهويّ في رواية عبد الرحمن على المرتبة الأخيرة القريبة إلى فعلية السجود وعليه يرتفع التنافي والتعارض[276].
والظاهر أنّ حصر الهويّ في المرتبة الأخيرة منه غير صحيح كما أنّ التفريق بين المرتبة الأولى والأخيرة غير دقيق عرفاً بل لابد من القول بأنّ ابتداء الهويّ أيضاً له عنوان مقدميّة السجود وأنّ الأخذ بالاستواء والقيام لا يعتبر مقدمةً للركوع.
وأخيراً يمكن القول بأنّ ما سُئل عنه في الرواية هي الموارد التي تحصل غالباً ولا تكون حينئذٍ صالحة لتقييد القاعدة الكلّية كما لابدّ من القول بأنّ لا خصوصية في تحقق معنى الغير سنشير إلى ذلك في مبحث اعتبار الدخول في الغير بأنّ للغير معنى عاماً.
وعلى هذا فإنّ رأي المحقق الأصفهاني هو الرأي المختار لدينا.
بحث اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ والتجاوز:
من الأبحاث الهامّة الأخرى في هذه القاعدة هو أنّه هل يعتبر الدخول في الغير في جريان كلٍّ من هاتين القاعدتين مضافاً على صدق عنوان التجاوز عن الشيء أو الفراغ عنه؟ أو أنّه معتبر في قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ؟ أو أنّ هذا العنوان أي عنوان الدخول في الغير غير معتبر في كلتا القاعدتين؟
وهل أنّ هذا النزاع نزاع واقعي معنوي أو أنّه مجرّد نزاع لفظي من غير أثر؟
لو التزمنا هنا بوحدة قاعدتي الفراغ والتجاوز كان لابدّ من تحليل جميع الروايات برؤية واحدة وأنْ نلاحظ بأنّ قيد الدخول في الغير هل يستفاد من مجموع هذه الروايات أولا؟
أمّا لو اعتبرناهما قاعدتين مستقلّتين فلابدّ من دراسة روايات كلٍّ من القاعدتين بدقّة على نحو الاستقلال، ولو اتّبعنا هذا المسلك الثاني لاستغنينا عن تحليل الروايات على النحو الأول.
ومن هنا يرد الإشكال على المحقّق النائيني أنّه كيف فكّك في هذا البحث بين قاعدتي الفراغ والتجاوز مع أنّه حصل على كبرى كليّة من مجموع الروايات الواردة في هذا البحث وهو يعتقد بوحدة هاتين القاعدتين.
فإنّه يقول: فتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بوحدة الكبرى المجعولة الشرعية وربّما تترتب على ذلك ثمرات مهمّة)[277].
وجاء في كلامه الآخر: ولكنّ الإنصاف أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد الغاية فإنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ الشارع في مقام ضرب قاعدة كلّية للشك في الشيء بعد التجاوز عنه[278].
نعم يمكن الدفاع عن المحقّق النائيني بأنّه قد استفاد من مجموع الروايات أنّ التجاوز عن الجزء منزّل منزلة التجاوز عن الكلّ وهذا تنزيل شرعي في أصل جريان عدم الاعتناء بالشك لكن لا ضير في أن يختص التجاوز عن الجزء بأحكام أخرى كما يعتقدون بأنّ قاعدة التجاوز يختصّ جريانها بأجزاء الصلاة فلا تجري في سائر المركّبات لاختصاص مورد التعبّد والتنزيل بالصلاة ولهذا تخرج الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتيمّم) من قاعدة التجاوز تخصّصاً.
لكنّه يعتقد في النهاية بأنّ الدخول في الغير معتبر في قاعدة الفراغ على نحو الشرط الشرعي التعبّدي. وبعبارة أخرى فإنّ الدخول في الغير ليس سبباً لصدق عنوان الفراغ في قاعدة الفراغ بل يتحقّق هذا العنوان من غير الدخول في الغير أيضاً أمّا في قاعدة التجاوز فلا يتحقّق عنوان التجاوز من غير الدخول في الغير. وهنا لابدّ لنا من البحث حول كلٍّ من القاعدتين على نحو الاستقلال.
بحث اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة التجاوز:
يستفاد من الروايات المتعدّدة التي استدلّلنا بها على قاعدة التجاوز أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان هذه القاعدة.
توضيح ذلك:
أولاً: أنّه قد ذكر في بعض الروايات أنّ المصلّي بعد أن دخل في السجود قد شكّ في أنه هل ركع أولا؟ وهذا التعبير مفاده أنّ مجرى قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير، وكذلك المستفاد من صدر صحيحة زرارة الواردة في الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كما لو شكّ وهو في الإقامة هل أذّن أولا؟ أو شكّ حال التكبيرة هل أذّن وأقام أولا؟ أو شكّ حال القراءة هل كبّر أولا؟ يستفاد من ذلك أنّ مجرى قاعدة التجاوز هو تحقّق الدخول في الغير.
ثانياً: إنّ الأهمّ من صدر رواية زرارة تلك القاعدة الكليّة في ذيل هذه الرواية.
وبعض الروايات الأخرى حيث يقول الإمام(ع): (إذا خرجت من شيءٍ ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء) وقد نُصّ في هذه العبارة على الدخول في الغير ويستفاد من ظاهره أنّه جزء الموضوع أي أنّ الموضوع في قاعدة التجاوز له جزآن:1ـ الخروج من الشيء 2ـ الدخول في غير ذلك الشيء.
كذلك نُصّ في موثقة إسماعيل بن جابر على الدخول في الغير: (كلّ شيءٍ شك فيه مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).
وهناك موثقة ابن أبي يعفور حيث يقول فيها الإمام(ع): (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلتَ في غيره).
وقد ذكرنا فيما سبق بأنّنا يمكن أن نستخرج من هذه الرواية قاعدة التجاوز، كما يمكن استفادة قاعدة الفراغ منها، وبعبارة أخرى فإنّ هذه الرواية قابلة للدلالة على حجّية كلتا القاعدتين.
والحاصل أنّ المستفاد من موارد السؤال في روايات التجاوز ومن القاعدة الكليّة المذكورة فيها إنّ الدخول في الغير شرط في قاعدة التجاوز.
هل الدخول في الغير شرط شرعي أو عقلي؟
المهم هنا هو أنّ اعتبار الدخول في الغير هل هو بعنوان أنّه شرط شرعي تعبّدي أو أنّه شرط عقلي؟ كما ذكرنا سابقاً أنّ قاعدة التجاوز قاعدة تعبّدية محضة فلابدّ من معرفة أنّ اعتبار هذا الشرط تعبّدي أيضاً أو أنّ لهذا الشرط مدخليّة في عنوان التجاوز بحيث لا يصدق عنوان التجاوز عن الشيء من غير الدخول في الغير؟
ظاهر روايات قاعدة التجاوز أنّ الدخول في الغير ليس عنواناً جعلياً شرعياً تعبّدياً وإنّما هو لتحقيق عنوان التجاوز.
وبتعبير أوضح أنّه ما لم يتحقّق الدخول في الغير يكون محلّ إتيان الجزء باقياً ولم يتحقّق التجاوز عنه، ومن هنا لو شككنا في إتيان ذلك الجزء وجب الإتيان به وبمجرد الدخول في غيره ينتفي محلّ الجزء السابق ويتحقق التجاوز عنه.
وقد اختار المحقق النائيني هذا الرأي حيث يقول: (لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه)[279].
البحث في اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة الفراغ:
يرى المحقق النائيني وجمع آخر من العلماء أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان قاعدة الفراغ على نحو الشرط الشرعي التعبّدي، بينما ذهب آخرون کالمحقق العراقي[280] إلى خلاف هذا الرأي لأنّهم يرون كفاية مجرّد الفراغ من أصل العمل في جريان قاعدة الفراغ، وعليه فلا حاجة إلى الدخول في الغير.
والتحقيق في ذلك يستدعي تحليل ودراسة جهات ثلاث:
الجهة الأولى: هل هناك روايات تدلّ بإطلاقها على جريان قاعدة الفراغ بحيث لم يُذكر فيها الدخول في الغير؟
وهل هناك مانع كالانصراف أو ما يمنع انعقاد الإطلاق أولا؟
الجهة الثانية: لو سلّمنا وجود روايات مطلقة فهل بين روايات قاعدة الفراغ ما يدلّ على التقييد؟
الجهة الثالثة: على فرض وجود روايات دالّة على التقييد فهل هناك ما يدلّ على رفع اليد عن هذا التقييد؟
بحث في الجهة الأولى (وجود روايات مطلقة):
لاشك في وجود روايات مطلقة بين تلك الروايات الواردة في خصوص قاعدة الفراغ وهي:
1 ـ إطلاق موثّقة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع): (كلّ ما شككت فيه مّما قد مضى فامضه كما هو)[281].
2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع): (في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال: لا تعيد ولاشيء عليه)[282].
3 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(ع): (كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد)[283].
4 ـ خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع): (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه)[284].
وعلى هذا فلا شكّ في أصل وجود الإطلاق بحسب ظاهر روايات قاعدة الفراغ لكنّ البحث الأهم هو أنّه هل هناك مانع من هذا الإطلاق كالانصراف أو ما أشبهه أولا؟
قد ذُكر في كلمات الأعاظم وجود مانع من انعقاد الإطلاق لابدّ من التعرّض لها:
الوجه الأول: ذكر المحقّق النائيني[285] أنّه إن كان صدق العنوان على جميع إفراد الطبيعة على حدّ سواء فلاشك في شمول ذلك العنوان المطلق لجميع الأفراد، فمثلاً لفظ الماء شامل لماء البحر وماء المطر وماء البئر على حدٍّ سواء، فلو ورد في كلام الشارع أنّ الماء طاهر كان شاملاً لجميع هذه المياه.
أمّا لو لم يكن شمول العنوان وصدقه على جميع الأفراد على حدّ سواء كعنوان الحيوانية الذّي لا يصدق على البقر والغنم والإنسان على حدّ سواء إذ في شموله للإنسان نوعٌ من الخفاء بحيث لو قيل عند العرف: رأيت حيواناً وقد أريد به الإنسان لم يتقبّله العرف، ففي مثل هذه الموارد لا يشمل اللفظ جميع الموارد بل ينصرف إلى غير الفرد الخفيّ.
يقول النائيني: (فإنّ غلبة الوجود وإن لم توجب الانصراف كما حقّقناه في محلّه إلاّ أنّه فيما إذا كانت الغلبة لأمر خارج.
وأمّا إذا كانت من جهة قصور الماهية ونقصها في الفرد النادر وكانت الماهية تشكيكية بحيث كان شمول الطبيعة له خفياً في نظر العرف فلا محالة يوجب ذلك انصراف المطلق إليه، ولا أقلّ من كونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب، ومحلّ الكلام من هذا القبيل فإنّ صدق التجاوز عن الشيء مع الدخول في الغير أظهر من صدقه مع عدم الدخول فالمطلق في حدّ ذاته قاصرٌ عن الشمول مع عدم الدخول في الغير ولو لم يكن هناك دليل المقيّد أيضاً).
إشكال الوجه الأول: إنّا لا ننكر أصل كلام المحقق النائيني لكنّنا لا نوافقه في أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا شكّ في صدق عنوان الفراغ عرفاً فيما لو لم يتحقّق الدخول في الغير.
وبعبارة أخرى أنّ العرف لا يفرّق في صدق هذه العناوين وشمولها بين ما تحقّق فيه الدخول في الغير وما لم يتحقق فيه ذلك. هذا بخلاف عنوان الحيوانية الذي يرى العرف فرقاً واضحاً بين شموله وصدقه على الغنم والبقر وبين دلالته على الإنسان.
الوجه الثاني: أنّ المحقق الخراساني[286] قد دخل عن طريق وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فيكون ذلك برأيه مانعاً من انعقاد الإطلاق، والقدر المتيقّن في مقام التخاطب بالنسبة إلى الدخول في الغير أمرٌ متحقّق.
إشكال الوجه الثاني:
أولاً: قد تبيّن في الأبحاث السابقة أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق.
ثانياً: أنّ الدخول في الغير له هذا العنوان ـ تأمل واضح لاسيّما أنّ مصطلح الدخول في الغير قد جاء في كلمات الإمام(ع)في بعض الروايات ولا وجود له في كلمات السائل فتأمّلْ.
ثالثاً: في موثقة ابن بكير دلالة على نحو العموم الوضعي حيث استعمل فيها ألفاظ العموم كلفظة (كلّ) فليس البحث عن الإطلاق فضلاً عن مسألة القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
الوجه الثالث: إنّ إطلاق بعض الروايات أمر مسلّم إلاّ أنّ الغالب وقوع الشك في الفراغ مع فرض الدخول في الغير، وعلى هذا فإنّ غلبة الوجود الخارجي سببٌ لانصراف هذا الإطلاق.
إشكال الوجه الثالث: إنّ الغلبة الاستعمالية إنّما تكون منشأ للإنصراف دون غلبة الوجود.
يقول المحقق النائيني:
(مجرّد كون الغالب حصول الشكّ بعد الدخول في الغير لا يوجب انصراف المطلق إلى الغالب فإنّه لا عبرة بغلبة الوجود ما لم تقتض صرف ظهور اللفظ)[287].
فالحاصل أنّ هذه الوجوه الثلاثة لا تكون مانعةً عن انعقاد الإطلاق.
نعم ذُكر في كلمات بعض المحقّقين[288] وجهٌ آخر للمنع من الإطلاق فإنّه قد ذكر أنّ الإطلاق تامّ لا شك فيه في موردين:
أ ـ أن يكون المشكوك جزءاً من أجزاء المركب وقد فرغ المكلف من المركب.
ب ـ أن يكون المشكوك شرطاً من شروط بعض أجزاء المركّب والمكلف قد فرغ من المركب فإنّ هذين الموردين تشملهما عبارة (كلّ ما شككت فيه مّما قد مضى فامضه) سواء كان المراد بالشك الشكّ في وصفٍ من أوصاف الشيء أو كان الشك في أصل وجود الشك، وسواء كان المراد بالمضيّ مضيّ المشكوك نفسه أو مضيّ محل المشكوك.
وبعبارة أخرى أنّ الجزء أو الوصف في هذا المورد كان مشكوكاً وقد تجاوز هو أو محلّه. وعلى أيّ حال فلا شك في أنّ إطلاق الروايات يشمل الشك في الشرط بعد الإتيان بالمشروط، وكذا الشك في جزءٍ من أجزاء المركّب بعد الفراغ من المركّب.
نعم هناك مورد واحد يُشَكّ في شمول الإطلاق له وهو ما لو شكّ المكلّف في جزءٍ من أجزاء المركّب بعد مضيّ المحلّ وقبل الفراغ من المركّب فإنّ شمول موثقة محمد بن مسلم لهذا المورد أمرٌ غير واضح لوجود احتمالين إمّا التصرّف في صدر الرواية (شككت) بحمله على الشك في وصف من الأوصاف لا على الشك في أصل الوجود، وعليه نُبقي قوله(ع): (ما مضى) على ظاهره أي المضيّ أصل العمل.
وإمّا عكس ذلك هو الصحيح بأن نحمل المضيّ على مضيّ المحلّ ونحمل الشكّ على الشك في أصل الوجود، ولمّا لم يكنْ ترجيحٌ لأحد هذين الاحتمالين فلا يكون هذا المورد مشمولاً للرواية ولا يثبت الإطلاق.
وهو يجيب عن هذا الإشكال بأجوبة خمسة أهمّها على الإطلاق جوابان:
الجواب الأول: إنّ المراد بقوله: (ما مضى) في الموثّقة هو مضي زمان المشكوك ومحلّه وهو شايع في استعمالات العرف، فعندما يقال: (مضى الحجّ) أي مضى زمان الحجّ وإن لم يحجّ المكلف نفسه.
والشاهد على ذلك أن الخروج والتجاوز الحقيقي في مجرى روايات هذا الباب مستلزم لإتيان ذلك الجزء بمعنى أنّ المكلّف لو أتى بالجزء واقعاً قيل في حقّه حينئذٍ أنّه قد خرج عن ذلك الشيء وتجاوز عنه مع أنّ المفروض في الروايات أنّ إتيان الجزء أمر مشكوك فيه، وعليه فلابدّ من حمل (ممّا قد مضى) على مضيّ زمان ذلك الجزء لا على مضيّ أصل العمل حتّى لا تشمل الرواية هذا المورد.
الجواب الثاني: إنّ ذيل موثقة ابن أبي يعفور (إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه) يدلّ على الحصر بمعنى أنّ الاعتناء بالشك إنّما يجب فيما لم يتجاوز عنه، أمّا لو تجاوز عنه فلابدّ من عدم الاعتناء به ففي المورد المفروض وإن لم يفرغ المكلّف من مجموع المركّب إلاّ أنّه يجب عدم الاعتناء بالشيءِ لأنّه قد مضى زمانه.
إلى هنا ظهر أولاًأنّه لا إشكال في إطلاق الروايات المطلقة.
وثانياً: إنّ مفاد هذه الروايات هو أنّ أصل المضيّ والتجاوز هو الملاك ولا عبرة بالدخول في الغير. والآن لابدّ من البحث في أن بين سائر الروايات هل هناك ما يدلّ على التقييد أولا؟
بحث الجهة الثانية (وجود روايات دالة على التقييد):
من بين الروايات هناك ثلاث روايات توهم الدلالة على التقييد:
1 ـ صحيحة زرارة عن الإمام الصادق(ع): (إذا خرجت من شيءٍ ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيءٍ)[289] حيث إنّ جملة (دخلت في غيره) في هذه الرواية ظاهرة في التقييد.
يرى[290] بعضٌ أنّه لو أريد الاقتصار على ظاهر هذه الرواية وجب القول بأنّ المعتبر في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز أمران: أحدهما الخروج عن الشيء، والآخر هو الدخول في غيره مع أنّ ظاهر هذين العنوانين لا ينطبق على شيءٍ من الأمثلة المذكورة في صدر هذه الرواية، لأنّ الخروج من الأذان هو الدخول في الإقامة، والخروج من الأذان والإقامة هو الدخول في تكبيرة الإحرام.
وبعبارة أخرى: إنّ الدخول في الغير يوجب الخروج من تلك الأشياء وليس هناك شيء آخر يوجب تحقّق الخروج ولهذا لابدّ من أن نفسّر الرواية على النحو التالي: (إذا رأيت نفسك خارجاً عن الشيء ولذا دخلت في غيره) بمعنى أنّ المكلف يرى نفسه خارجاً عن الشي أي أنّ الخروج اعتقادي وتخيّلي.
وعلى كلّ حال فمن الواضح أنّ الاقتصار على ظاهر هذه الرواية أمرٌ غير ممكن، لأنّ هذا الاقتصار يؤدّي إلى اللغوية إذ الخروج من الشيء ليس شيئاً آخر عدا الدخول في الشيء الآخر فلا يمكن التمسّك بظاهر الرواية.
والخروج عن الشيء في الواقع هو الدخول في الغير والدخول في الغير ليس فعلاً آخر غير الخروج من الشيء.
2 ـ الرواية الأخرى مصحّحة إسماعيل بن جابر من حيث الصدر والذيل إمّا من جهة صدرها فإنّ جميع الأمثلة المذكورة في صدر هذه الرواية مقرونة بذكر الدخول في الغير، كما لو شك في الركوع وهو في السجود ولم يذكر قبله، وأمّا من حيث ذيل الرواية فإنّ الإمام(ع)يقول فيه: (كلّ شيءٍ شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)[291] حيث صرّح بالدخول في الغير.
اُجيب عن هذه الرواية: بالنسبة إلى الذيل لابدّ من جعل الدخول في الغير عطفاً تفسيرياً على التجاوز أي أنّ ما يوجب حصول التجاوز هو الدخول في الغير.
وبعبارة أخرى أنّ التجاوز الخيالي والعادي الظاهري غير كافٍ بل لابدّ من التجاوز الواقعي والخارجي.
ومن هنا ظهر الجواب المتعلّق بصدر الرواية، لأنّ السجود موجب لتحقّق التجاوز، وليس كذلك الهويّ إلى السجود، ومن هنا لو توهّم المكلف أنّه قد أتى بالركوع فهوى إلى السجود والتفت بعد ذلك وجب عليه الرجوع والإتيان بالركوع، لأنّ محلّ الركوع لا زال باقياً ولم يحصل هنا زيادة توجب سجدتي السهو إذ ليس الهويّ بقصد السجود من أجزاء الصلاة ليصدق عليه الزيادة.