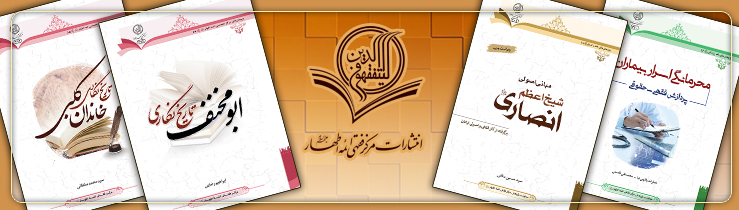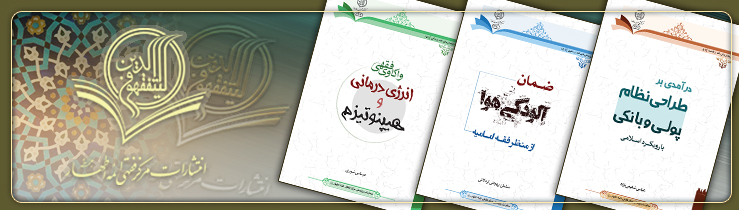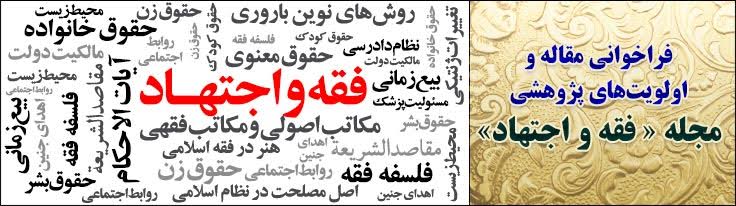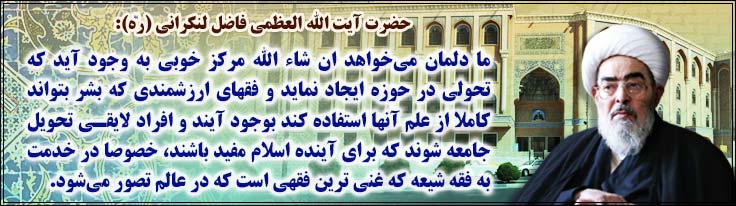ولابدّ من القول فيما يتعلّق بذيل الرواية بأنّ الإمام(ع)إنّما هو في مقام بيان ضابط كلّي بقوله: (إنّما الشكّ إذا كنت في شيءٍ لم تجزه).
8 ـ وعنه (عن محمد بن علي بن محبوب) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(ع): رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة؟ قال(ع): (يمضي في صلاته ولا يعيد)[88].
سند الرواية: (وعنه) ينقل الشيخ الطوسي هذه الرواية عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ إليه هو كالتالي:
(فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب)[89].
(يعقوب بن يزيد) هو يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، من ثقات الإمامية الأجلاء وهو كثير الرواية[90].
والحديث عن ابن أبي عمير ومحمد بن مسلم فقد سبق في الروايات السابقة.
دلالة الرواية: يقول محمد بن مسلم، سألت الإمام الصادق(ع)عن رجل شك في وضوئه بعد الفراغ من صلاته فأجاب الإمام(ع)فليمض على صلاته وليبنِ على أنّه قد أتى بالوضوء ولا لزوم لإعادة الصلاة.
في هذه الرواية أيضاً كسابقتها وقع الخلاف في أنّ المراد من الشكّ هل هو الشكّ في صحّة وضوئه أو الشكّ في أصل فعل الوضوء أوله إطلاق يشمل كليهما؟ الظاهر أنّ المراد هو الشكّ في أصل إتيان الوضوء بأنّ يشك الإنسان بأنّه هل صلّى مع الوضوء أو بدونه؟
9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(ع)يقول: (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذکرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه)[91].
سند الرواية: (محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله) طريق الشيخ الطوسي وفقاً لما ذُكر في (المشيخة) هو: (فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله[92]، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه[93]، عن أبيه[94]، عن سعد بن عبد الله. وأخبرني به أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين[95]، عن أبيه[96] عن سعد بن عبد الله)[97] وهذا الطريق طريق صحيح.
(سعد بن عبد الله) هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، جليل من كبار الفقهاء ومن ثقات الإمامية، له مؤلفات كثيرة[98].
(موسى بن جعفر) هو موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، ذكره الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في كتبهما إلا أنّهما لم يذكرا عن وثاقتهما شيئاً[99].
(أبي جعفر) هو إمّا أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وكلاهما من الثقات.
(الحسن بن الحسين اللؤلؤي) ضعّفه بعض علماء الرجال[100] بينما وثّقه النجاشي[101] وما نعتقده هو أنّه كلّما دار الأمر بين توثيق النجاشي وتضعيف الآخرين ووقع التعارض بينهما، قدّم قول النجاشي على أقوال الآخرين.
(الحسن بن علي بن فضال) كان فطحي المذهب معتقداً إمامة عبدالله بن جعفر(ع)أولاً لكنّه رجع عن ذلك حين وفاته وصار يؤمن بإمامة موسى بن جعفر(ع).
قال عنه الشيخ الطوسي: (روى عن الرضا(ع)وكان خصّيصاً به، كان جليل القدر، عظيم المنزلة زاهداً ورعاً ثقة في الحديث وفي رواياته...)[102] وهو من أصحاب الإجماع على رأيٍ[103].
(عبد الله بن بكير) أيضاً من أصحاب الإجماع، وقد سبق ذكره وذكر محمد بن مسلم الذي هو من الرواة الأجلاء عند ذكرنا للرواية الخامسة.
مدلول الرواية: أنّه كلّما مضى من صلاتك وطهورك ثمّ تذكّرته ابْن ِ على أنّك أتيت به ولا تجب عليك إعادته.
ولابدّ من حمل قوله(ع): (فذكرته تذكّراً) على معنى (فشككت فيه شكّاً) لتدلّ الرواية على قاعدة الفراغ والتجاوز بمعنى أنّك لو شككت بعد إتمام الصلاة أو الوضوء أو الغسل في إتيان جزءٍ من الأجزاء فابن على أنّك أتيت بذلك الجزء ولا تجب الإعادة وعلى هذا فإنّ كلمة (تذكّراً) معناها الالتفات ثانية إلى صحة ذلك الشيء أو إتيانه وهذا هو معنى الشكّ.
وهنا يمكن أن يقال بأنّ المراد بقوله: (فذكرته تذكّراً) هو أن يتذكّر الإنسان بأنّه ترك جزءاً غير ركني من الصلاة كذكر الركوع على سبيل المثال فإنّ الفقهاء يفتون بعدم وجوب الإعادة هنا[104] لكن لمّا كانت الرواية ذكرت كلمة (طهورك) إلى جانب (صلاتك) يتّضح لنا عدم تمامية هذا المعنى وعدم صحة هذا القول لأنّ المصلي إذا قام إلى الصلاة فتذكّر في الأثناء أنّه لم يتوضّأ، أو أنّه حتى لو أتمّ صلاته ثمّ علم أنه لم يتوضّأ قبل الصلاة وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد صلاته[105]، ومن هنا فلابدّ من الالتزام بأنّ المراد بقوله (تذكّرته تذكّراً) هو الشكّ في العمل وذلك بقرينة كلمة (طهورك).
10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال(ع): (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك)[106].
سند الرواية: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن سعيد، وقد ذكرنا طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد وبيّنا أحواله في الرواية الخامسة وقلنا بأنّ هذا الطريق طريق صحيح قابل للركون إليه.
(عن فضالة) هو فضالة بن أيوب الأزدي من أصحاب الإمام موسى بن جعفر(ع)وهو من ثقات الإمامية[107]، وقد قيل بأنّه من أصحاب الإجماع[108].
(عن أبان بن عثمان) هو أبان بن عثمان الأحمر البجلي من أصحاب الإمام الصادق(ع)وله أصل[109].
(بكير بن أعين) هو بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق(ع)حيث توفي أيام حياة الإمام الصادق[110].
يروي المرحوم الكشي روايتين في مدحه وكلتاهما صحيحة وقد جاء في إحداهما: (إنّ أبا عبدالله(ع)لمّا بلغه وفاة بكير بن أعين قال: أمّا والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما)[111]، وعليه فإنّه من ثقات الإمامية.
هذا ولكن الإشكال في هذه الرواية أنّها مضمرة حيث لم يُذكر فيها اسم الإمام المروي عنه لكن لمّا كان المُضْمِر هو بكير بن أعين لا يخلّ الإضمار بالرواية لأنّه لا يروي عن غير الإمام(ع)شيئاً.
دلالة الرواية: يسأل بكير بن أعين في هذه الرواية من الإمام(ع)حكم من شك في الوضوء بعد الفراغ فأجابه الإمام(ع)بأنّ هذا الشخص في حالة الوضوء أكثر التفاتاً من زمان شكه.
بالنظر إلى جواب الإمام(ع)فإنّ هذه الرواية تفيد بأنّ المعيار في عدم الاعتناء بالشك هو الالتفات والذكر حالة الوضوء وأنّ الإنسان حين قيامه بأيّ عمل يكون التفاته إلى أجزاء عمله وشرائطه أكثر منه بعد الانتهاء من العمل.
والأمر الآخر: هو أنّ هذه الرواية بحسب الظاهر مختصّة بباب الوضوء فلا تشمل سائر أبواب الفقه إلا أنّ يقال بأن عبارة (هو حين يتوضأ) في مقام التعليل فتكون العبارة من باب ذكر العلة في مقام بيان المعلول فهي تقوم مقام (ولا يعيد الوضوء) ولمّا كان التعليل بالأمر العقلي شاملاً لغير مورد السؤال جاز أن تجعل الرواية دليلاً على القاعدة وتعميم هذه القاعدة على جميع أبواب الفقه، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بأنه لا خصوصية لعبارة (حين يتوضّأ) ولا علاقة لها في الحكم، ومن هنا يمكن إلغاء الخصوصية وإجراء قاعدة الرواية في سائر أبواب الفقه أيضاً.
11 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال: سألته عن رجل يكون على وضوء وشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال(ع): (إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها وإذ ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك)[112].
سند الرواية: (عبد الله بن جعفر) هو أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري شيخ القميين وكبيرهم وله مؤلّفات كثيرة وهو من ثقات الإمامية ومن أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري[113].
(عبد الله بن الحسن) لم يُذكر هذا الراوي ولم يُوثّق في الكتب الرجالية وهو مجهول كما ذكرنا ذلك في الرواية السادسة وعلى هذا يكون الخلل في سند الرواية.
معنى الرواية: يسأل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)عن حكم رجل كان متوضّئاً ثمّ شك في أنه متوضّئ أو لا، ويجيبه الإمام(ع)بأنّه إذا شك في ذلك أثناء الصلاة وجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضّأ ثمّ يستأنف الصلاة، أمّا إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا داعي إلى التوضؤ ويكفيه ذلك.
حول دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ يقول صاحب الوسائل(ع):
(أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ وآخره قرينة ظاهرة على ذلك، ويمكن حمله على أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء)[114].
لابدّ من القول بعدم دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ والتجاوز، وعليه يجب حمل هذه الرواية أمّا على استصحاب الوضوء السابق أو على الاستحباب أو يقال كما عليه صاحب الوسائل من أنّ المراد بالوضوء هو الاستنجاء، هذا لكن لمّا كان الإشكال في سند الرواية فلا حاجة إلى التدقيق في دلالة متنها.
12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله(ع): أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال(ع): (امض)[115].
سند الرواية: ذكر في البحث عن سند الرواية الخامسة أنّ إسناد الشيخ الطوسي وطريقه إلى الحسين بن سعيد الأهوازي طريق صحيح يُعتمد عليه.
(فضالة) هو فضالة بن أيوب الأزدي حيث ذكرناه في البحث عن سند الرواية العاشرة وهو من أصحاب الإمام موسى بن جعفر(ع)، وقيل هو من أصحاب الإجماع.
(حمّاد بن عثمان) هو حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري، من ثقات الإمامية في الكوفة يروي عن الأئمّة الصادق والكاظم والرضا[116]، وعليه فلا إشكال في سند الرواية وتكون الرواية صحيحة.
دلالة الرواية: في هذه الرواية يسأل حماد بن عثمان عن الإمام الصادق(ع): بقوله: أشك في أثناء الصلاة وأنا ساجد في أنّي هل ركعت أو لا؟ ماذا أصنع؟ ويجيب الإمام(ع)بقوله: (لا تعتن بشكك وابنِ على أنك أتيت بالركوع).
كما تلاحظون فإنّ الرواية تدلّ على قاعدة الفراغ والتجاوز ولا إشكال في دلالتها.
13 ـ وعنه عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله(ع): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال(ع): (قد ركعت، امضه)[117].
سند الرواية: (وعنه) يراد به الحسين بن سعيد الأهوازي الذي يُسند إليه المرحوم الشيخ الطوسي وطريقه إليه طريق صحيح كما ذكرنا.
(صفوان) هو صفوان بن يحيى أبو محمد البَجلي بيّاع السابريّ من ثقات الإمامية الأجلاء، يروي أبوه عن الإمام الصادق(ع)وهو يروي عن الإمام الرضا(ع)وكان له مكانته المميّزة عند الإمام(ع)وهو من أصحاب الإجماع[118].
(حماد بن عثمان) ذكرنا حاله في الرواية السابقة.
النقطة الأخرى هي أنّ الروايتين رواية واحدة ولا تحتسبان روايتين مستقلتين لأنّ الراوي الأوّل الذي يروي مباشرة عن الإمام(ع)شخص واحد هو حماد بن عثمان والمروي عنه هو الإمام الصادق(ع)، وعليه لا بد من الالتزام بأنّ الروايتين رواية واحدة نُقلت عن طريقين.
دلالة الرواية: عبارات هذه الرواية تُشبه عبارات الرواية السابقة وتختلفان في جواب الإمام الصادق(ع)فقط حيث إنّ الإمام(ع)يقول في الرواية السابقة (امض) لكنه(ع)يقول في هذه الرواية: (قد ركعت امض) أي أنّ الإمام(ع)حسب نقل الرواية الثانية يقول لحمّاد بن عثمان: ابن ِ على أنّك ركعت وأنّك في حكم من ركع تعبّداً.
أمّا قوله(ع)في الرواية الأولى (امض) فهو أعم من أنّك ركعت أو لم تركع.
ولهذا المطلب ثمرتان فقهيتان أيضاً حيث أنه لو صار الإنسان مثلاً أجيراً لإتيان حج وبجميع أجزائه وشرائطه ولا يكون الغرض إتيان الحج المبرئ للذمّة فقط فإذا شكّ هذا الأجير بعد الخروج من الإحرام في أنّه هل جاء بالطواف أولا؟ فإن قلنا بأنّ الشارع من خلال قاعدة الفراغ قد عبّده على أنه قد أتى بالمشكوك فيه كان عمله تام الأجزاء قد فعل ما استؤجر له.
أمّا لو لم نقل بهذا التعبّد الشرعي من خلال قاعدة الفراغ فإنّ عمله هذا وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لم يكن تام الأجزاء والشرائط وعليه فلم يأت الأجير بما استؤجر له.
14 ـ وعنه عن فضالة، عن أبان عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله(ع): أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال(ع): (بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنّما ذلك من الشيطان)[119].
سند الرواية: (وعنه) المراد منه حسين بن سعيد الأهوازي، وقد ذكرنا أن طريق الشيخ الطوسي إليه طريق صحيح.
(فضالة) هو فضالة بن أيوب الأزدي وقد ذكرنا في البحث السندي للرواية العاشرة أنّه من ثقات الإمامية ومن أصحاب الإمام موسى بن جعفر(ع)وهو على قول من أصحاب الإجماع أيضاً.
(أبان) هو أبان بن عثمان الأحمر البجلي، وقد سبق الكلّام حوله في الرواية العاشرة.
(الفضيل بن يسار) هو الفضيل بن يسار النهدي من أصحاب الإمام الباقر(ع)والإمام الصادق(ع)ويقول فيه الإمام الصادق(ع): (إنّ فضيلاً من أصحاب أبي وإنّي لأحبّ الرجل أن يُحبّ أصحاب أبيه)[120] وهو من ثقات الإمامية الأجلاّء ومن أصحاب الإجماع[121].
دلالة الرواية: سأل فضيل بن يسار من الإمام الصادق(ع): أشك وأنا قائم حال الصلاة في أني ركعت أم لا؟ ماذا أصنع؟ يجيب الإمام الصادق(ع): (بأنّك أتيت بالركوع فامض في صلاتك فإنّما ذلك الشكّ من الشيطان).
أمّا فيما يتعلّق بالقيام الكامل (أستتم قائماً) المذكور في الرواية ففيه احتمالان:
الأوّل: أنّ المراد هو القيام بعد السجود، وعليه يكون مفاد الرواية عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، وقد ذكر هذا الاحتمال الشيخ الطوسي أيضاً[122]، وعلى هذا تدلّ الرواية على قاعدة الفراغ والتجاوز.
الثاني: أنّ المراد هو القيام قبل السجود، وعليه لما لم يمض محل الركوع فإنّ الروايات الكثيرة دالة على وجوب الإتيان بالركوع، وقد أفتى بمقتضاها الفقهاء[123]، فهذه الرواية إنّما تدلّ على قاعدة الفراغ والتجاوز فيما لو أريد بالقيام بعد السجود ولكن لا بد من الالتزام بعدم ارتباطها بقاعدة الفراغ لقوله(ع)في ذيل الرواية: (إنّما ذلك من الشيطان) وهو قرينة على أنّ مراد الإمام(ع)هو الشكّ الخاص إذ ليس الشيطان منشأً لكلّ شكٍ وإنما شك کثير الشكّ والوسواس فقط من قبل الشيطان.
وبعبارة أوضح أنّ السؤال في الرواية إنّما يتعلّق بمن تحصل له هذه الحالة دائماً أي أنّه كلّما أكمل القيام شك في أنه ركع أم لم يركع، ومن هنا تختص الرواية بكثير الشكّ[124] وتفيد قاعدة (لا شك لكثير الشكّ) وبالتالي لا يمكن عدّها في عداد الروايات الدالة على قاعدة الفراغ والتجاوز.
15ـ وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر(ع): (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيءٍ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)[125].
سند الرواية: (سعد) هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي، من ثقات الإمامية وفقهائهم الأجلاء[126]، وقد بيّنا طريق الشيخ الطوسي إليه في البحث عن سند الرواية التاسعة فلا حاجة إلى الإعادة.
(أحمد بن محمد) هو أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمي شيخ القميين وفقيههم ومن ثقات الإمامية[127].
(أبيه) هو محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري القمي الذي يصفه النجاشي بشيخ القميين ووجه الأشاعرة لكنّه لا يوثقّه[128].
(عبد الله بن المغيرة) هو عبد الله بن المغيرة أبو محمد البجلي من ثقات الإمامية[129].
(إسماعيل بن جابر) هو إسماعيل بن جابر الجعفي الخثعمي الكوفي الذي روى حديث الأذان وهو من ثقات أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)[130].
دلالة الرواية: يقول الإمام(ع)في هذه الرواية لو شك المكلّف بعد السجود في الركوع لا يعتني بشكه ويبني على أنه فعله وكذا لو شك في السجود بعد القيام ثمّ يبيّن الإمام(ع)قاعدة كلّية في ذيل الرواية بقوله: (كلّ شيءٍ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه).
ويمكن أن يقال في هذه الرواية: بأنّ صدر الرواية لمّا كان مرتبطاً بركوع الصلاة وسجودها وقيامها فإن الصدر يخصص ذيل الرواية ويكون قرينة على أنّ المراد من (كلّ شيءٍ شك فيه) هو كلّ شيء من أجزاء الصلاة شك فيه، وعليه فلا تعم القاعدة سائر أبواب الفقه، هذا ولكن لمّا كان المورد لا يخصص الوارد كما بيّنا ذلك مراراً في الأصول فإن صدر الرواية فيما نحن فيه وإن كان متعلقاً بموردين من باب الصلاة إلا أنّه لا يقيد ذيل الرواية بل تبقى القاعدة المبينة في الذيل على كليتها، وبالتالي تصلح هذه الرواية لأن تكون من أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز.
وفي هذا المجال يرى الإمام الخميني بأن المستفاد من هذه الرواية هو الضابط الكلّي ولا تكون هذه الرواية أقل من الصحيحة في باب الاستصحاب في إفادة القاعدة[131].
هناك ثلاث روايات أخرى في هذا الباب من كتاب (وسائل الشيعة) وهي شبيهة بالرواية السابقة ولا شيء زائد فيها ومن هنا فإنّنا نكتفي بذكرها من غير تعليق عليها:
16 ـ وعنه (أي سعد)[132] عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد،[133] عن فضالة، عن العلاء بن رزين[134] عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع؟ قال(ع): (يمضي في صلاته)[135].
17 ـ وعنه (أي سعد) عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [الميمون البصري][136] قال: قلت لأبي عبدالله(ع): رجل أهوى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال(ع): (قد ركع)[137].
18 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء،[138] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)في رجلٍ شك بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال(ع): (يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع...) الحديث[139].
ونذكر هنا أيضاً روايتين أخريين كأدلة على قاعدة الفراغ والتجاوز.
19 ـ محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله[140] عن زرارة عن أبي جعفر(ع)قال: (إذا جاء يقين بعد حائلٍ قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين)[141].
20 ـ محمد بن الحسن بإسناده[142] عن موسى بن القاسم[143]، عن عبد الرحمن بن سيابة[144]، عن حماد[145]، عن حريز[146] عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف أو سبعة، طواف فريضة، قال(ع): (فليعد طوافه) قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك، قال(ع): (ليس عليه شيء)[147].
هذه أهم الروايات التي استدلّ بها على قاعدة الفراغ وإلاّ فإن هناك روايات أخرى في هذا المجال، ويستفاد من جميعها هذه القاعدة الكلّية.
كما لا شكّ في دلالة هذه الروايات على الأمور التالية:
1 ـ عدم الاعتناء بالشك، والبناء على صحة العمل المأتي به فيما لو شك المكلّف في صحة العمل بعد الفراغ والانتهاء منه بشكل كامل، سواء كان العمل بسيطاً أو مركباً وسواء كان منشأ الشكّ في صحة عمله هو الشكّ في الإخلال بالجزء أو بالشرط أو الشكّ في وجود المانع (قاعدة الفراغ).
2 ـ عدم الاعتناء بالشك، والبناء على إتيان الجزء المشكوك فيما لو شك المكلّف في إتيان جزءٍ من المأمور به المركب فيما لو تجاوز محل ذلك الجزء المشكوك ودخل في الجزء التالي (قاعدة التجاوز).
وعلى هذا فإنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كلتيهما تستفادان من الروايات السابقة، هذا ولكن المهم الذي وقع النزاع فيه هو أن القاعدتين هل هما مجعولتان بجعل واحد أو أنّهما قاعدتان منفصلتان مستقلتان؟ وهل قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة عامة تجري في جميع أبواب الفقه أو هي مختصة بباب الصلاة والوضوء التي سنبحث عنها في المباحث القادمة إن شاء الله.
ولا بد قبل الخوض في البحث عن اتحاد القاعدتين أو تعدّدهما من معرفة المراد من (الشكّ) الوارد في الروايات السابقة.
ما المراد من الشكّ في الشيء؟
هناك أربعة احتمالات في خصوص المراد من الشكّ في الشيء المذكور في الروايات:
1 ـ الشكّ في أصل وجود العمل وتحققه.
2 ـ الشكّ في صحة العمل (بعد إحراز أصل وجوده).
3 ـ إنّ الروايات مطلقة تشمل كلا الشكلّين الشكّ في الصحة والشك في الوجود.
4 ـ إنّ الروايات مجملة لا دلالة لها على الشكّ في الوجود أو الشكّ في الصحة.
ولمعرفة إنّ المتعيّن هو أي واحد من هذه الاحتمالات الأربعة لابدّ من البحث أولاً عن إمكان الجمع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز في مقام الثبوت ووجود قدر جامع بينهما أو عدمه ثمّ البحث في مقام الإثبات في تعيين الاحتمال الصحيح في الروايات السابقة.
هذا وإن كان الإمام الخميني(قده)ذهب في هذا البحث إلى أنّ المراد بالشك في الشيء هو الشكّ في أصل وجود العمل وتحققه الشامل للشك في تحقق الجزء أو الشرط في العمل، ويرى أنّ الشكّ في صحة العمل ليس موضوع قاعدة التجاوز وهذا يوافق المتفاهم العرفي مضافاً إلى تأييد هذا الاحتمال من قبل الروايات الأخرى، لأنّ المتفاهم عرفاً من الشكّ هو الشكّ في الوجود لا الشكّ في الصحة[148].
وعلى هذا فإنّنا نبحث أولاً عن مسألة الجمع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز:
إتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز أو تغايرهما:
هناك نزاع هام في هذه القاعدة حول وجود قاعدتين إحداهما قاعدة الفراغ والأخرى قاعدة التجاوز أو أنّهما مجعولتان بجعل واحد في الشريعة؟ وقد ذُكرت في هذا المجال ثلاثة فروق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مما يمكن جعلها سبباً في ظهور الاختلاف والتغاير بين القاعدتين وهذه الفروق الثلاثة هي كالتالي:
1 ـ مورد قاعدة الفراغ الشكّ في الصحة بينما مورد قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود العمل وتحققه.
2 ـ تجري قاعدة الفراغ في الأعمال البسيطة والمركبة بينما تجري قاعدة الفراغ في خصوص الأعمال المركّبة ولا تجري في الأعمال البسيطة.
هذا مضافاً إلى الفرق بينهما في الأعمال المركبة التي تجري فيهما كلتا القاعدتين حيث لا فرق في مورد قاعدة الفراغ بين أن يكون الشكّ في الصحة ناشئاً من احتمال الإخلال بالجزء أو الشرط أو من جهة وجود المانع، أمّا قاعدة التجاوز فأنّها تجري في الجزء المشكوك دون موارد احتمال وجود المانع، مع وجود الخلاف في موارد احتمال الإخلال بالشرط.
3 ـ في قاعدة التجاوز يكون الدخول في الجزء التالي قيداً واقعياً مقوّماً لحقيقة التجاوز، لأنّ التجاوز عن الجزء إنّما يتحقّق فيما لو دخل الإنسان في الجزء التالي من المركّب، أمّا في قاعدة الفراغ فإننا لو اعتبرنا الدخول في الجزء التالي (على الخلاف فيه) فإنّه يكون قيداً اعتبارياً تعبدياً لا واقعياً بمعنى أنّ الشارع يقول: لو تمّ عملك ودخلت في العمل الآخر فلا تعتن بالشك في عملك السابق، فإنّ الشارع هنا يعتبر الدخول في العمل التالي قيداً تعبّدياً وقد كان يمكنه أن لا يذكر هذا الشرط بل يقتصر على ملاحظة انتهاء العمل السابق فقط.
مضافاً إلى ما سبق هو أنّ الفقهاء استفادوا من الروايات الواردة في قاعدة الفراغ عمومية هذه القاعدة والتزموا بجريانها في جميع أبواب الفقه حتى المعاملات من العقود والإيقاعات، بينما التزموا باختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة وعدم جريانها في سائر أبواب الفقه كالوضوء والغسل و... نعم ذهب بعض الفقهاء على خلاف المشهور إلاّ أنّ قاعدة التجاوز أيضاً تجري في جميع أبواب العبادات عدا الوضوء، وعليه فلو قلنا بأنّ القاعدتين قاعدتان مستقلّتان صحّ بالتفكيك المذكور آنفاً، أمّا لو قلنا بأنّهما قاعدة واحدة مجعولة بجعل شرعي واحد لم يتمّ ذلك التفكيك حيث يجب الالتزام إمّا بعمومية هذه القاعدة وجريأنها في جميع أبواب الفقه وإما بعدم شموليتها.
ومن هنا كان البحث في أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز شاملة لجميع أبواب الفقه أم أنّها مختصّة ببعض هذه الأبواب كالصلاة ـ سبباً آخر للنزاع في أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز هل انّهما قاعدتان أو قاعدة واحدة؟
هناك خمسة أقوال هي مجموع الآراء في مسألة اتحاد القاعدتين أو تغايرهما وهي:
1ـ إنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة وليس للشارع في باب الفراغ والتجاوز إلاّ مجعول شرعي واحد، غاية الأمر أنّه قد يعبر عن هذا المجعول الواحد بقاعدة الفراغ وتارة بقاعدة التجاوز.
2ـ ويفهم من كلمات المرحوم الآخوند وجمع كثير من الفقهاء أنّهما قاعدتان مستقلتان والمجعول في قاعدة الفراغ مختلف تماماً عن المجعول في قاعدة التجاوز[149].
3 ـ ذهب المحقق النائيني إلى أنّ القاعدتين وإن كانتا اثنتين بحسب الظاهر إلاّ أنّ قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ وعليه يكون المجعول الشرعي واحداً[150].
4ـ يرى الشيخ الأنصاري والإمام الخميني أنّ هناك قاعدة واحدة لا أكثر وهي قاعدة التجاوز أمّا قاعدة الفراغ فمآلها إلى قاعدة التجاوز.
5ـ إنّ المستفاد من الأدلّة قاعدة الفراغ فقط ولا وجود لقاعدة تسمّى بقاعدة التجاوز.
قبل البحث عن صحة هذه الآراء أو بطلانها لابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا البحث قد وقع في كلمات الفقهاء في مقامين منفصلين:
أ ـ مقام الثبوت ب ـ مقام الإثبات.
ففي مقام الثبوت فقد وقع البحث في أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز مع قطع النظر عن الروايات السابقة هل هما قاعدتان أم أنهما قاعدة واحدة لوجود الجامع بينهما؟ والآراء المذكورة آنفاً إنّما تذكّر في هذا المقام حيث لا بد من البحث عن صحتها أو عدم صحتها.
ثمّ نأتي إلى مقام الإثبات فيما لو توصّلنا إلى عدم وجود جامع بينهما وإنّ قاعدة الفراغ مختلفة عن قاعدة التجاوز ولا بد حينئذٍ بملاحظة الروايات المذكورة من التماس دليل خاص على كلّ من قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، أمّا لو التزمنا باتّحاد القاعدتين كان لابدّ من دراسة الروايات السابقة لمعرفة الروايات المتكفّلة بإثبات القدر الجامع التي تفيد كلتا القاعدتين.
وبعد بيان هذه المقدمة نبدأ بدراسة الآراء والنظريات الواردة في وحدة قاعدة الفراغ والتجاوز أو تعددهما ونعقد البحث في مقامي الثبوت والإثبات.
مقام الثبوت:
أدلّة القائلين بتغاير القاعدتين:
استدلّ القائلون بتعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز على مدّعاهم بأربعة أدلّة، ذكر الميرزا النائيني الأدلّة القائمة على التعدد في مقام الثبوت وهي الأمور التالية:
الدليل الأوّل عدم وجود القدر الجامع بين القاعدتين:
الدليل الأوّل الذي أقيم على تعدد القاعدتين هو أن الموضوع في قاعدة الفراغ هو الشكّ في الصحة وفي قاعدة التجاوز هو الشكّ في الوجود ولا جامع بين الموضوعين.
وقد ذكروا هذا الدليل بثلاثة وجوه وبيانات مختلفة:
البيان الأوّل للمحقق النائيني:
عرض الميرزا النائيني الدليل الأوّل بهذا التقرير: وهو أنّ موضوع الشكّ ومتعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل لمفاد کان الناقصة أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي، أمّا موضوع الشكّ ومتعلقه في قاعدة التجاوز هو وجود الجزء أو عدمه بمفاد كان التامة أي أنّ قاعدة التجاوز تُعبّدنا بالبناء على وجود الجزء المشكوك فلا جامع بين الأمرين لتغاير متعلّق التعبد في كلّ من القاعدتين ففي قاعدة الفراغ يُبحث عن أنّ هذا الموجود صحيح أو لا؟ بينما في قاعدة التجاوز نتساءل: هذا الجزء موجود أولا؟ وكلّ منهما يحتاج إلى جعل مستقل.
كلام الشيخ الأنصاري:
ذهب المرحوم الشيخ الأنصاري(قده)ـ كما ذكرنا ـ إلى اتّحاد القاعدتين ويشكلّ كلامه جواباً عن الدليل الأوّل حيث فسّر قاعدة الفراغ بحيث يكون مآلها إلى قاعدة التجاوز كما أنّه جعل مفاد قاعدة الفراغ مفاد كان التامة حيث قال: (إنّ الشكّ في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو هو، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح)[151].
وعلى هذا البيان فعندما نشك في صحة الشيء الموجود نكون في الواقع قد شككنا في وجود الشيء الصحيح فلا مانع أبداً من تصوير الجامع بينهما لأنّ مفاد القاعدتين هو مفاد كان التامة.
الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الأنصاري :
هناك ثلاثة إشكالات هامّة ترد على کلام الشيخ الأنصاري:
1 ـ إشكالات الميرزا النائيني :
أورد المرحوم المحقق النائيني بعد ذكره للدليل الأوّل ونقله لكلام الشيخ الأعظم إشكالين على هذا الكلام وهما:
أ ـ إنّ إرجاع مفاد قاعدة الفراغ إلى مفاد كان التامة إنّما يخالف مدلول روايات قاعدة الفراغ كرواية (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو)[152] لأنّ ظاهر هذه الروايات هو التعبّد بصحة العمل الموجود لا التعبّد بوجود العمل الصحيح[153] وإن أمكن القول بوجود الملازمة بين هذين الأمرين إلاّ أنّ إثبات وجود العمل الصحيح بقاعدة الفراغ يؤدّي إلى كونها أصلاً مثبتاً ولا حجية للأصل المثبت، ومن هنا يقول الميرزا النائيني في خاتمة مقاله: (فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود العمل الصحيح ربما يُشبه الأكل من القفا)[154].
ب ـ لو سلّمنا رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز وإلى مفاد كان التامة فإنّ القاعدة تفقد كلّيتها وشموليتها وتختص بباب أحكام العبادات فلا تجري في موارد الأحكام الوضعية وباب المعاملات لأنّ العقل في باب الأحكام التكليفية (العبادات) يأمر المكلّف بوجوب إبراء ذمته وتحصيل الفراغ للذمة وهو يتحقّق بإحراز وجود الصحيح في الخارج من غير حاجة إلى أن يشتمل العمل العبادي على جميع شرائط الصحة.
أمّا في باب المعاملات فلا يجب تفريغ الذمة بل اللازم في هذا الباب ترتّب أثر المعاملة وهو يترتب على صحة الموجود أيضاً فعلى سبيل المثال أنّ الملكية تترتّب على صحة البيع الموجود ولا يترتب أثر الملكية إلاّ مع إحراز صحة البيع الخارجي المعيّن، ومن هنا يقول المرحوم النائيني: (مجرد التعبّد بوجود عقد صحيح من دون العقد الموجود لا يترتب عليه أثرٌ خارجاً)[155].
إشكال المحقق الخوئي على رأي المحقق النائيني :
يقول المرحوم آية الله السيّد الخوئي ردّاً على الإشكال الثاني للمحقق النائيني: لا فرق بين العبادات والمعاملات حيث يترتب الأثر في كلا البابين على وجود العمل الصحيح وعليه فلا يجب في المعاملات إحراز صحة المعاملة الخارجية المعيّنة.
ولتوضيح مدعاه يقول بأنّ هنا ثلاثة عناوين:
1 ـ صحة المعاملة الخارجية المعيّنة.
2 ـ وجود المعاملة الخارجية الصحيح.
3 ـ العنوان الكلّي للوجود الصحيح.
يرى المحقق النائيني بأنّ الأثر في باب المعاملات إنّما يترتّب فيما لو أحرزنا بأنّ المعاملة الخارجية مشتملة على جميع شروط الصحة أي أنّه بالعنوان الأوّل (صحة المعاملة الخارجية المعيّنة).
أمّا على رأي المحقق الخوئي فيمكن القول بأنّ الأثر إنّما يترتب على وجود البيع الكلّي الذي تكون هذه المعاملة الخارجية مصداقاً له، وذلك أنّ قاعدة الفراغ لا تجري في البيع الكلّي بما هو كلّي بل تجري في ذلك البيع الكلّي المتحقّق في الخارج بهذه المشخصات الخارجية.
وعلى هذا فإنّ قاعدة الفراغ تضمّن لنا بوجود الصحيح وإن لم يُحرَز فيه جميع شروط الصحة، فلا فرق من هذه الجهة بين العبادات والمعاملات.
وهذا نص کلام المرحوم السيد الخوئي :
(وأما اعتراضه الثاني فلا يرجع إلى محصل لأنّ مفاد قاعدة الفراغ ـ على تقدير الإرجاع المذكور ـ هو الحكم بوجود الصحيح ممّا تعلّق به الشكّ وهو كاف في ترتّب الأثر، فإذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن وشك في صحة هذه المعاملة وفسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ بعد الإرجاع المذكور هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه (الدار) بالثمن المعيّن والتعبّد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتب الأثر وإن لم تثبت صحة هذه المعاملة الشخصية الخارجية كما هو الحال في العبادات... فلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة)[156].
إشكال المحقق العراقي على رأي المحقق النائيني :
يذكر المرحوم المحقق العراقي في إشكاله على الميرزا النائيني أنّ الأثر لا يترتب في العبادات على وجود الصحيح بل يترتّب على صحة الموجود المعلوم في الخارج، فعلى سبيل المثال لو التفت المصلّي بعد الفراغ من صلاته أنّه ترك سجدة واحدة وجب عليه قضاؤها والإتيان بسجدتي السهو، ويرى المحقق العراقي أنّ هذا الحكم (وجوب قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو) إنّما يترتّب على صحة الموجود بمعنى أنّ هذه الصلاة الخارجية تامّة صحيحة من جميع الجهات عدا هذه السجدة.
والمورد الآخر الذي لا يترتّب فيه الأثر على وجود الصحيح إنّما هو في الأمور التي ليس لها ما بإزاء مستقلاً كالترتيب والموالاة وكذا في الأحكام الوضعية كالعقود والإيقاعات حيث يترتب الأثر على صحّة الموجود لا على وجود الصحيح.
وهذا نصّ عبارة المحقق العراقي: (وأمّا توهّم كفاية مجرّد إثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذمّة وخروج المكلّف عن العهدة بلا احتياج إلى إثبات صحّة المأتي به فمدفوع، بأنّ كثيراً ما تمسّ الحاجة إلى إثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السجدة وسجدتي السهو ونحوهما ممّا أخذ في موضوعها صحّة الموجود لا مجرّد وجود الصحيح إذ في نحو هذه الآثار لا يكفي مجرّد إثبات وجود الصحيح في ترتّبها، مع أنّ قاعدة الصحّة تعمّ الوضعيات أيضاً من العقود والإيقاعات التي لا بد فيها من إثبات صحّة العقد أو الإيقاع في ترتيب آثارهما ولا يكفي في ترتبها مجرد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالاة مثلاً لا من جهة الشك في فقد الجزء، فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفاً عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقلّ، لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك...)[157].
وعلى هذا فإنّ المحقق العراقي يرى أنّ الأثر كما يترتّب في المعاملات على صحّة الموجود لا على الوجود الصحيح فكذلك من العبادات ما يترتب فيه الأثر على صحة الموجود إلاّ أنّه من الواضح أنّ المورد الثاني الذي ذكره العراقي من باب النقض إنّما يرتبط بمقام الإثبات دون مقام الثبوت.
نتيجة البحث والاحتمالات الموجودة:
ممّا ذكرنا يمكن الاستنتاج بأنّ في بحث العبادات والمعاملات أربعة احتمالات هي كالتالي:
1 ـ أن يترتب الأثر في البابين على الوجود الصحيح.
2 ـ أن يترتب الأثر في البابين على صحة الموجود.
3 ـ أن يترتب الأثر في العبادات على الوجود الصحيح وفي المعاملات على صحّة الموجود.
4 ـ عدم إمكان الوصول إلى قاعدة كلّيّة في البابين ولابدّ من البحث في كلّ مورد عن أثره الخاص فقد يترتب الأثر على الوجود الصحيح في بعض الموارد كما قد يتعلّق الأثر بصحة الموجود في موارد أخرى.
تحقيق المسألة:
يبدو أنّ الاحتمال الرابع من بين الاحتمالات الأربعة السابقة هو الصحيح فلا يمكن استنتاج حكم كلّي في كلا بابي العبادات والمعاملات بل لابدّ من إتّباع الدليل والبحث في كلّ مورد عن الأثر الخاص المتعلق به.
فإن كان الأثر الخاص في باب العبادات عدم الإعادة أو عدم القضاء فإنّه يترتب على الوجود الصحيح (كما ذكره المحقق النائيني) حيث أنّ وجود العبادة الصحيحة يعتبر مصداقاً يُمتثل به أمر المولى ويحصل فراغ الذمة. وبالتالي يكفي في ترتب عدم الإعادة وعدم القضاء مجرّد أن صار العمل الخارجي مصداقاً للوجود الصحيح ولا داعي إلى صحة الموجود الخارجي بمعنى لابدّية الإتيان بالعبادة في الخارج مع إحراز جميع شرائطها وخصوصياتها.
هذا ولكن بعض الآثار الأخرى كالنهي عن الفحشاء والمنكر وكالمعراجية للصلاة فلا يكفي في ترتّبها الوجود الصحيح بل تترتّب هذه الآثار على الصحّة التامة للعمل الخارجي، وعليه لابد من احراز صحة الصلاة التي جاء بها المكلّف حتى ترتب عليها أثر (النهي عن الفحشاء والمنكر أو المعراجية).
ومن هنا فقد شاع بين الفقهاء أنّه ربّما يكون العمل مسقطاً للتكليف ومصداقاً للامتثال ومع ذلك لا يحمل عليه بعض الآثار الأخرى كالنهي عن الفحشاء أو المعراجية.
ويظهر لي أنّ ذلك جار في باب المعاملات أيضاً إلاّ أنّ الآثار في باب المعاملات غالباً ما تترتب على صحة العقد الموجود في الخارج.
فعلى سبيل المثال: إذا أردنا للبيع الواقع بين شخصين أن يكون مؤثراً في النقل والانتقال للملكية كان لابدّ لنا من إحراز صحّة ذلك البيع في الخارج. أو في البيع الفضولي حيث تكون إجازة المالك شرطاً لصحته فإنّ هذه الإجازة إنّما تكون مكمّلة للبيع فيما لو أحرزنا صحّة البيع الفضولي الواقع في الخارج من جميع الجهات عدا إجازة المالك.
ومع ذلك فإنّنا نجد موارد أخرى في باب المعاملات حيث يتعلّق الأثر على الوجود الصحيح لا على صحة الموجود مثلاً في مورد بيع المعاطاة يترتّب أثر الملكية على المعاطاة التي هي مصداق للوجود الصحيح للبيع.
وعلى هذا فإنّ المسألة تختلف باختلاف الآثار في باب العبادات والمعاملات ولا يمكن القول بأنّ الأثر دائماً للوجود الصحيح أو أنّ الأثر مطلقاً لصحّة الموجود. وبالتالي لا يكون الإشكال الثاني للمحقق النائيني على كلام الشيخ الأنصاري في إرجاع قاعدة الفراغ إلى مفاد كان التامة ليس وارداً.
ولا فرق بين العبادات والمعاملات من جهة ترتّب الأثر.
هذا كلّه في الإشكال الأوّل للمحقق النائيني على رأي الشيخ الأعظم وقد ناقشناه مفصلاً.
2 ـ إشكال المحقق العراقي على رأي الشيخ الأنصاري:
يقول المحقق العراقي في إشكاله على كلام الشيخ الأنصاري بأنّ الأثر المترتب من قبل الشارع على الشك في الصحة يغاير الأثر الذي رتّبه على الشك في الوجود وأنّ ما نراه أحياناً من الملازمة بينهما في الخارج في بعض الموارد لا يستلزم اتحادهما فلا يمكن إرجاع الشك في أصل الوجود إلى الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة.
ومن ناحية أخرى فإن الالتزام برأي الشيخ الأنصاري (القائل بحصول التعبّد بالوجود مضافاً إلى التعبّد بالصحة عند الشك في الصحة) مستلزم للأصل المثبت الذي لا اعتبار له وليس بحجة.
وما نراه هو صحّة هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري، وقد ذكرنا الفرق بين هذين العنوانين في الأبحاث السابقة عند التحقيق في الروايات. وهذا نصّ كلام المحقق العراقي:
(نقول: إنّ الشك في قاعدة التجاوز بعدما كان متعلّقاً بأصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود، نظير الشك في وجود الكرّ والشك في كريّة الموجود، فلا يتصوّر بينهما جامع قريب ثبوتاً حتى يمكن إرادتهما من لفظ واحد، ولا مجال لإرجاع الشكّ في صحّة الموجود إلى الشك في وجود الصحيح أو التام، إذ فرقٌ واضح بين الشك في وجود الصحيح وبين الشك في صحّة الموجود، ومجرد كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه لا يخرجه عن الشك في الشيء بمفاد كان التامة إلى الشك في صحّة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة وإن كان يلازمه خارجاً نظير ملازمة الشك في وجود الكرّ مع كرّية الموجود وحينئذٍ فإذا كان المهمّ في قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود الشيء وفي قاعدة الفراغ إثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة فلا مجال لإرجاع أحد المفادين إلى الآخر ولا لترتيب الأثر المترتب على صحة الموجود بإثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر واتحادهما بحسب المنشأ لأنه من المثبت المفروض عندهم ولذا لا يحكمون بترتيب آثار كريّة الموجود باستصحاب وجود الكرّ وبالعكس)[158].
3 ـ إشكال المحقق الأصفهاني على رأي الشيخ الأنصاري:
دخل المحقق الأصفهاني في مقام الإشكال على الشيخ الأعظم الأنصاري عن طريق التغاير في اعتبارات الماهية ويقول: بأنّ قيد الصحة في العمل يمكن أن يُفرض على نحوين: فتارةً يلاحظ قيد الصحة على نحو اللابشرط، وتارةً أخرى على نحو بشرط الشيء، ويعتبر العمل مقيّداً بالصحة.
ففي موارد الشك في الصحة يلاحظ هذا القيد بشرط الشيء، وفي موارد الشك في الوجود يؤخذ قيد الصحة على نحو اللابشرط، وهذان الاعتباران لحاظان متغايران تماماً حيث لا يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر، فلا يمكن تصوّر جامع واحد بين قاعدتي الفراغ والتجاوز ولا إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز.
(...وإصلاح الجامع بإرجاع الشك في الصحّة في وجود العمل الصحيح كما عن الشيخ الأعظم في بعض فروع المسألة غير معقول، لأنّ ملاحظة العمل مهملاً واقعاً غير معقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمي يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز وملاحظته بنحو الماهية بشرط شيء أي العمل بوصف الصحة يوجب اختصاصه بقاعدة الفراغ والاعتبارات متقابلة فلا يعقل الجمع بينها...)[159].
هذا وقد أجاب المحقق الأصفهاني نفسه بعد هذا الإشكال بأنّ المراد من الصحة ليس ترتيب الأثر لئلا يوجد جامع بين الوجود وترتب الأثر على الموجود. وبالتالي يقول:
إنّ مجرد الاختلاف بين قاعدتي الفراغ والتجاوز من جهة أنّ إحداهما بمفاد كان التامة والأخرى بمفاد كان الناقصة، مجرّد هذا التفاوت غير مانع من تصور القدر الجامع، والصحّة المشكوكة هي القدر الجامع وقد تكون بمفاد كان الناقصة تارة وبمفاد كان التامة تارة أخرى.
(ويندفع أصل الإشكال بأنّ الصحة لا يراد منها ترتب الأثر حتى لا يكون جامعٌ للوجود ولترتب الأثر على الموجود...)[160].
تحقيق البحث في الوجه الأوّل:
الوجه الأوّل لعدم إمكان تصوير الجامع بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز على مبنى الميرزا النائيني هو أنّ مفاد قاعدة التجاوز هو مفاد كان التامة، أمّا مفاد قاعدة الفراغ فهو مفاد كان الناقصة ولا جامع بينهما.
أمّا الشيخ الأنصاري فقد أرجع في مقام الردّ قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز حيث أورد بعض الإعلام إشكالات عديدة على كلامه، منها إشكال المحقق العراقي الذي هو الأقوى من بينها حيث رأى أنّ الشك في عالم الواقع نوعان أحدهما: الشك في الوجود والآخر هو الشك في الصحة.
أمّا إرجاع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح إنّما هو مجرد تأويل لفظي لا يغيّر من الواقع شيئاً، والشاهد على تغايرهما هو أنّ لكلّ من هذين النوعين من الشك أثر خاص به. كما أنّ إرجاع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح كان أصلاً مثبتاً وهذا بحدّ ذاته أكثر من الدليل على المدعى.
مضافاً إلى أنّ هذا الإرجاع ـ على رأي الميرزا النائيني ـ على خلاف الأدلّة في مقام الإثبات وسنبحث عن مقام الإثبات مفصّلاً.
بعد أن علمنا عدم تمامية ردّ الشيخ الأنصاري على الوجه الأوّل وإرجاعه قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز لابدّ لنا من البحث في إمكانية تصوّر القدر الجامع بين مفادي كان التامة وكان الناقصة.
يقول المحقق الاصفهاني في مقام بيان الجامع، بعد الإشكال على كلام الشيخ الأنصاري.
والجواب عنه: (إنّ الصحّة المشكوكة تارةً تلحظ بمفاد كان التامّة وأخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة، فإن لوحظ في مورد الشك وجود الصحّة بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها، كان ذلك، بمفاد كان التامة وإن لوحظ وجود اتّصاف عملٍ بها بأن لوحظت وصفاً لعمل خاصّ كانت بمفاد كان الناقصة، وعليه فلا ملزم للالتزام بأن الملحوظ في هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصحة بل ليس هو إلاّ صحة العمل فإنّه مورد الأثر فيمكن لحاظه بمفاد كان التامة، وعليه فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما لاتحادهما ذاتاً)[161].
نلاحظ أنّ المحقق الاصفهاني قد غيّر صورة المسألة حيث جعلنا صورة المسألة أنّ الشك لو كان بلحاظ اتصاف العمل الموجود بالصحة كان بمفاد كان الناقصة وإن كان بلحاظ أصل وجود العمل كان بمفاد كان التامّة إلاّ أنّ الأصفهاني ذكر أنّ الصحة المشكوكة قدر جامع بين كان التامة وكان الناقصة حيث إن كان الشك في مورد ما قد لوحظ في وجود الصحة من غير اتّصاف عملٍ خاص كان ذلك مفاد كان التامة (قاعدة التجاوز) وإنْ فرض اتّصاف عملٍ خاصّ بحيث كانت الصحة المشكوكة وصفاً لذلك العمل كان مفاد كان الناقصة (قاعدة الفراغ).
وعلى هذا فإنّه لم يجعل الملحوظ اتّصاف العمل بالصحّة بل يجعل الملحوظ صحّة العمل وهي المورد لترتب الأثر، ويمكن لحاظها على نحو مفاد كان التامة.
والذي أعتقده هو أنّ كلام المحقق الأصفهاني كإرجاع الشيخ الأنصاري إنّما هو مجرد توجيه لفظي يخالف الواقع إذ من الواضح أنْ ليس البحث في قاعدة التجاوز عن مسألة الصحّة بل الشك في أصل وجود الجزء لا في صحّته، وذلك كما لو شكّ المصلي في هذه المسألة هل ركع في صلاته أولا؟ وعلى هذا فإنّ الصحة المشكوكة لا يمكن لها أن تكون كقدر جامع بين مفاد كان التامة (قاعدة التجاوز) ومفاد كان الناقصة (قاعدة الفراغ).
ثمّ إنّه بعد رفضنا للجامع الذي ذكره المحقق الأصفهاني يمكن أن يدّعي متوهمّ بأنّ عنوان (الشك) هو قدر جامع بين الشك في الصحة والشكّ في الوجود. إلاّ أنّ هذا التوهم في غير محلّه بدليلين، ولا يمكن أن يقع عنوان الشك جامعاً بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز:
أولاً: إنّا في صدد إيجاد قدر جامع قريب بحيث يكون مذكوراً في رواية وتدّعي وجوده في مقام الإثبات لتدلّ الرواية على قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. مع أنّ عنوان (الشك) قدر جامع بعيد شأنه شأن القول بأن الجامع بين الصحة ووجود العمل هو عنوان (اللفظ) الصادق على كليهما.
ثانياً: إنّا في صدد القدر الجامع في متعلق الشك مع قطع النظر عن الشك نفسه بمعنى أنّنا عندما نقول بأنّ مجرى قاعدة التجاوز هو الشك في الوجود ومجرى قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة لابدّ لنا في مقام بيان القدر الجامع من أن نلتمس القدر الجامع بين الصحة والوجود، كما لو التمسنا قدراً جامعاً بين الشك في الصلاة والشك في البيع فإنّه لابد لنا حينئذٍ من إيجاد عنوانٍ يستفاد من داخله عنوان الصلاة وعنوان البيع، وعنوان الشك ليس كذلك حيث لا يمكن انتزاع الصحة والوجود من عنوان (الشك).
وعليه فالحاصل من مباحث الوجه الأوّل لتعدّد القاعدتين أن لا قدر جامع بين مفاد كان التامّة (قاعدة التجاوز) ومفاد كان الناقصة (قاعدة الفراغ) فالوجه الأوّل للدليل الأوّل تام لا إشكال فيه.
البيان الثاني في الدليل الأوّل:
البيان الثاني في عدم وجود القدر الجامع بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو أنّ الشيء في قاعدة الفراغ متيقّن الوجود أي أنّ قاعدة الفراغ إنّما تعبدّنا بصحة ما هو مفروض الوجود بينما يكون الشيء في قاعدة التجاوز مشكوك الوجود أي تعبّدنا بوجود المشكوك، ولا يمكن تصوّر القدر الجامع بين متيقّن الوجود ومشكوكه.
يقول المحقّق الأصفهاني في هذا المجال: (...إنّ مرجع الشكّ في الصحّة إلى فرض الوجود وهو لا يجامع الشك في الوجود حيث لا جامع بين فرض الوجود وعدم فرض الوجود وهو من الجمع بين المتقابلين...)[162].
ويقول السيد الخوئي أيضاً:
(المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة والتعبّد بها بعد فرض الوجود والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود والتعبّد به مع فرض الشك فيه... فلا يمكن الجمع بينهما في دليلٍ واحد إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشك في الوجود في دليل واحدٍ).[163]
وهذا الوجه كالوجه الأوّل تامٌ وصحيح و[لا غبار عليه] أمّا على مبنى الشيخ الأنصاري الذي يرجع مفاد كان الناقصة إلى كان التامة، كذا وعلى مبنى المحقق الأصفهاني القائل بوجود القدر الجامع بين مفاد كان التامة وكان الناقصة فلا صحّة لهذا الوجه إذ لم يكن الشيء في قاعدة الفراغ متيقّن الوجود بل كان مشكوك الوجود كما في قاعدة التجاوز، هذا على مبنى الشيخ الأنصاري، أمّا المحقق الأصفهاني فقد جعل الشكّ في الصحة قدراً جامعاً بين القاعدتين، وعلى هذين المبنيين لا يتمّ الوجه الثاني.