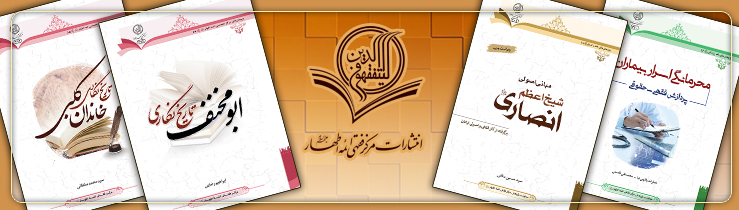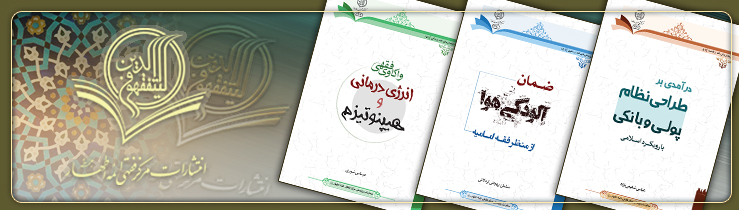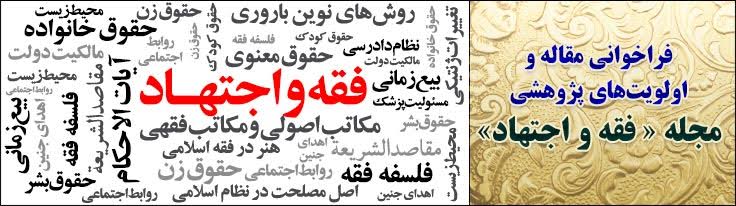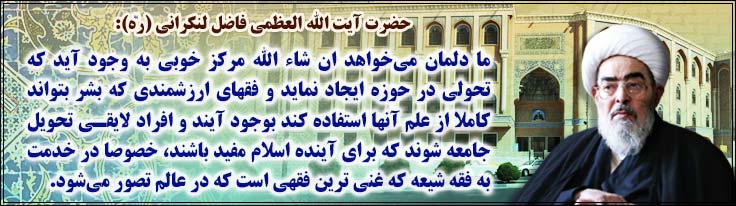بحوث
في قاعدة الفراغ والتجاوز
سلسلة دروس سماحة آية الله
الشيخ محمدجواد الفاضل اللنكراني(دام ظله)
تعريب:الشيخ محمدجواد السعيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمد(ص) وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيّما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن العسكري أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
ليس لباحث أن يشكّ في أهمّية علم الفقه ودوره البنّاء في حياة المجتمع، ولا شكّ أيضاً في أهمّية القواعد الفقهية وهي التي تشكلّ كلّيّات في الفقه ويطبّقها الفقيه والمجتهد على الجزئيات، وللأسف الشديد لم يتناولها الفقهاء المتقدمين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين).
والقاعدة في إصطلاح اللغويين قد وضعت لما هو الأساس للشيء من دون فرق بين كونه مادّياً أو معنويّاً بحيث إنعدامه واضمحلاله يسبب انتفائه فيمثّل لذلك البيت فإنّه ينعدم بانعدام أساسه.
قال ابن منظور: أصل الأُسّ، والقواعد: الإساس، وقواعد البيت إساسه، وفي التنزيل: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ).[1]
وفيه: (فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ)[2]، قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها[3].
وأما تعريف القاعدة اصطلاحاً فهي عبارة عن قضية كلّيّة تنطبق على جميع جزئياتها.
قال التهانوي: هي تُطلَق على معان مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد، وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه[4].
ويشترط في كلمة (القاعدة) أن تكون بنحو القضيّة الكلّية كما سبق، ولكن لا يشترط أن تكون أساساً للعلم بحيث ينتفي بانتفائها، فمثلاً لو انتفت قاعدة واحدة من قواعد الفقه لم ينتف العلم بانتفائها[5].
وهناك أمور مهمّة كلّها ترتبط بالبحث حول القواعد الفقهية منها:
ما المراد من القاعدة الفقهية وهل يشترط في اعتبارها الكلّيّة، وكذلك الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بمعنى أنّها لا تختصّ بباب من الأبواب الفقهية بخلاف الضابط، أو الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية وغير ذلك من المباحث العلمية التي لسنا الآن بصدد بيان ذلك.
تاريخ كتابة القواعد الفقهية
من جملة المباحث المطروحة في مبحث القواعد الفقهية عبارة عن تاريخ كتابة ذلك عند العلماء والفقهاء.
أمّا عند أهل السنّة لعل ذلك يرجع إلى القرن الرابع الهجري، ويدّل عليه وجود بعض المؤلّفات التي كتبت عندهم.
فقد كان كتاب القواعد الفقهية عند الحنفيين من أهل السنّة أول كتاب جُمعت فيه بعض القواعد الفقهية فقد جمع مؤلّفه أبو طاهر الدبّاس ـ من أئمّة الحنفية في بلاد ما وراء النهر ـ سبعة عشر قاعدة فقهية على مذهب أبي حنيفة فكان القرن الرابع بداية تدوين القواعد الفقهية لديهم.
وأما في الوسط الشيعي فيعتبر كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأوّل (778) أقدم كتاب دوَّن فيه القواعد الفقهية وفقاً لمذهب أهل البيت(ع).
ويمكن إرجاع سبب سبق السنّة في تدوين القواعد إلى أمرين:
1. الأمر الأوّل: ماهية فقههم حيث قطعت الرابطة بينهم وبين كلام المعصومين(ع)بعد رحيل النبي الأعظم(ص)، ومن الطبيعي أنّ ذلك الانفصال يجعل الفقه يتبلّور ضمن ضوابط معيّنة.
2. الأمر الثاني: إستخدامهم لأدوات خاصّة بهم في عملية الاستنباط الفقهي كالقياس والاستحسان وغيرهما.
ولا ريب بأنّ الأساس في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة الإمامية هو أن الأئمة(ع) قد وضعوا إليهم أصولاً كلّية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها، كما ورد في الحديث الشريف: (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع)[6].
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ ما قام به المرحوم الشهيد الأوّل (أعلى الله مقامه الشريف) في كتابه القيّم مما يرشدنا إلى أهميّة ما ألّفه في الباب حيث قال(ع) في إجازته لابن خازن:
فممّا صنعته كتاب (القواعد والفوائد) مختصر يشتمل على ضوابط كلّيّة أصولية وفرعية تستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل الأصحاب مثله[7].
ومن هذا المنطلق فقد قام فقهائنا العظام (رضوان الله عليهم أجمعين) بتدوين وتأليف الكتب التي تتعلّق بالقواعد الفقهية نشير إلى بعضها:
1. القواعد والفوائد، للشهيد الأوّل.
2. الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، تأليف محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بـ (ابن أبي جمهور) ت901.
3. عوائد الأيام من مهمّات أدلّة الأحكام، تأليف المولى أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني ت (1245)، وقد يشتمل هذا الكتاب القيم على88 عائدة، وكلّ عائدة تُعد قاعدة فقهية.
4. عناوين الأصول، تأليف السيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي ت (1274).
5. قواعد الفقيه، تأليف الشيخ محمد تقي الفقيه المولود سنة (1329) ضمّنه قواعد مهمّة في الفقه والأصول ومنها قاعدة على اليد وقاعدة تعدد الأيدي وقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج[8].
6. القواعد الجعفرية في قواعد الفقه والأصول، تأليف الشيخ عباس آل كاشف الغطاء ت (1323)[9].
7. القواعد الكلّية الفقهية، تأليف السيد مهدي القزويني ت (1300)[10].
8. القواعد الفقهية، تأليف مهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي
ت (1343) طبع الكتاب في مجلدين[11].
9. القواعد الفقهية، تأليف الشيخ محمد جعفر شريعتمدار الاسترابادي ت (1263) كتبه على ترتيب أبواب الفقه يقرب من خمسة عشر ألف بيت[12].
10. مستقصى القواعد الكلّية الفقهية، تأليف الميرزا حبيب الله الرشتي ت (1312)[13].
11. القواعد الجعفرية في قواعد الفقه والأصول، تأليف الشيخ عباس آل كاشف الغطاء بن الشيخ حسن بن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب (كشف الغطاء) ت (1323)[14].
12. القواعد الفقهية، تأليف السيد محمد باقر اليزدي ت (1294)[15].
13. القواعد الفقهية والأصولية، تأليف ملاّ فتح علي اللنكراني ت (بعد 1339)[16].
14. القواعد الفقهية، تأليف الشيخ محمدباقر البيدكلّي من أعلام القرن الرابع عشر[17].
15. رسالة في بعض القواعد الفقهية، تأليف المولى الآغا فاضل الدرنبدي (ت1286).
وقد بحث المؤلف في هذه الرسالة قاعدة اليد والضرر وقاعدة الإحسان وغيرها[18].
16. قاعدة لا ضرر وقاعدة التسامح، تأليف السيد الميرزا أبو القاسم الطهراني، مجلّد واحد[19].
17. رسالة في قاعدة لا ضرر، ورسالة في قاعدة على اليد ما أخذت، تأليف الشيخ ضياء الدين العراقي[20].
18. قاعدة لا ضرر، تأليف الحسن علي بن محمد باقر بن إسماعيل الواعظ الحسيني[21].
19. الفوائد الغروية، تأليف المولى أبوالحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبدالحميد بن موسى علي بن محمد بن معتوق الاصفهاني الغروي، فرغ منها سنة (1112) وهو كتاب حسن فيه ما يستفاد من الأحاديث من القواعد الفقهية والمسائل الأصولية[22].
20. القواعد الفقهية للفقيد الراحل الشيخ محمد الفاضل اللنكراني(قده).
21. وهناك القواعد الفقهية الاخری ترکنا ذکرها رعاية الاختصار.
نبذة عن كتابة القواعد الفقهية عند أهل السنة
قلنا سابقاً بأنّ أهل السنّة هم السابقين في كتابة وتأليف وتدوين القواعد الفقهية وأشرنا إلى سبب ذلك وطبيعة فقههم المبتني على أساس الرأي والقياس يقتضي ذلك.
ومن الغريب أنّ الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام الشافعي (660)هـ قد أرجع الفقه كلّه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل وأرجع تاج الدين السبكّي الفقه كلّه على نحو الإجمال إلى اعتبار المصالح، فإنّ درء المفاسد من جملتها فعلى ما ذكر عن البعض بأنّ القرن الرابع بداية تدوين القواعد الفقهية وتأليف الكتب فيها لدى العامة، وكانت الحنفيّة من السابقين في هذا المضمار، وبعده بدأ فقهاء سائر المذاهب بتدوين القواعد الفقهية، وشاع الاهتمام بها، ويطلق على قرني السابع والثامن (القرون الذهبية لتدوين القواعد الفقهية) لكثرة الاهتمام بهذه القواعد وتدوين الكتب المتعددة فيها[23].
الكتب المؤلّفة في القواعد الفقهية
الفقه الحنفي: يبدو أنّ المذهب الحنفي ولأسباب كمناهجهم الاستنباطية يعتبر أول مذهب بدأت بكتابة القواعد الفقهية، وقد اشتهر جمع من فقهائه بتدوين القواعد الفقهية.
1ـ أبو طاهر الدبّاس ـ من فقهاء الحنفية في القرن الثالث الهجري في بلاد ما وراء النهر ـ فقد جمع سبعة عشر قاعدة فقهية على مذهب أبي حنيفة، وردّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى هذه القواعد.
2ـ عبيدالله بن حسن بن دلال الكرخي الحنفي، المعروف بأبي الحسن الكرخي ت (340)هـ، صاحب كتاب الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية أو قواعد الكرخي، وجمع فيه (29) قاعدة فقهية، مطبوع.
3ـ أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي القاضي الحنفي (430)هـ له كتاب تأسيس النظر في اختلاف الأئمّة، وفيه أكثر من (80) قاعدة فقهية، مطبوع مع قواعد الكرخي.
4ـ علي بن عثمان الغزي الدمشقي، المشهور بشرف الدين الحنفي (799)هـ له كتاب القواعد في الفروع.
5ـ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نُجَيم (970)هـ له كتاب الأشباه والنظائر في الفروع، وكتبت عليه حوالي (26) شرحاً وتعليقة أشهرها غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر.
6ـ أحمد بن محمد الحموي (1098) له كتاب العقود الحسان في قواعد مذهب النعمان، وهذا الكتاب مجموعة شعرية أنشدها الحموي، وشرحها بنفسه، وسمّى شرحه بـ «فرائد الدرر والمرجان في شرح العقود الحسان».
7ـ عمر بن إبراهيم بن محمد المصري، المعروف بابن نجيم الحنفي (1005ق) صنّف كتاب الأشباه النظائر، مطبوع.
8 ـ محمد بن زين الدين عمر الكفيريّ (1130) له كتاب الأشباه والنظائر.
9 ـ سبعة فقهاء الحنفيين برئاسة أحمد جودت باشا في تركيا بعهد السلطان عبد العزيز خان العثماني، ألّفوا مجلة الأحكام العدلية التي يحتوي على (1851) مادّة و (99) قاعدة، طبع في عام (1292).
10ـ عبد الستار بن عبدالله القريمّي القسطنطين (1304) له كتاب تشريح القواعد الكلّيّة.
11ـ محمود بن محمد بن نسيب بن حسين، المشهور بابن حمزة الحسيني (1305) له كتاب (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية).
12ـ محمد بن محمد بن المصطفى الخادمي، المعروف بأبي السعيد الخادمي (1176) ألف كتاب المجموع المُذَهّب في قواعد المذهب، كخاتمة على كتاب مجاميع الحقايق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد في علم الأصول، وطرح فيه (154) قاعدة فقهية للمذهب الحنفي على ترتيب المعجم.
13ـ إبراهيم بن محمد القيصري الحنفي، المعروف بكوزي بيوكزاده (1252ق) صاحب كتاب مجموعة القواعد.
14 ـ أحمد الزرقاء الحنفي (1357) صاحب كتاب شرح القواعد الفقهية.
15 ـ شيخ عميم الإحسان البنغلادشي، صاحب كتاب قواعد الفقه الذي طبع للمرّة الأوّلى في بنغلادش.
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه المالكي
1 ـ شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن العلاء، إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيّ، المعروف بالقرافيّ (684) له كتاب الفروق الذي سماه بـ: أنواء البروق وأنواع الفروق، ودرس فيه (548) قاعدة فقهية من حيث تفاوتها وتشابهها في أربعة مجلدات، وعرض فيه أسلوب كتابه قواعد الفقه، مطبوع.
2 ـ محمد بن أحمد المالكي، صاحب كتاب قواعد الأحكام الشرعية الذي أتى بالقواعد الفقهية فيه على ترتيب الأبواب الفقهية.
3 ـ محمد بن محمد بن أحمد المالكي المقريّ (758) صاحب كتاب: (عمل من طبّ لمن حبّ)، وقد طبع مجلده الثاني من قبل جامعة رياض.
4 ـ إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي، المشهور بأبي إسحاق الشاطبي (790) ألف كتاب الموافقات في أصول الفقه.
5 ـ أحمد بن يحيى التلمساني الوِنشَريسيّ (914) له كتاب: (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك) ويشتمل على (118) قاعدة فقهية.
6 ـ محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسيّ (914) ألف كتاب: (الكلّيات الفقهية على مذهب المالكية)، وطبع من قِبَل جامعة الزيتونيّة للشريعة وأصول الدين بتونسيّا.
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الشافعي
1ـ معين الدين، أبو حامد، محمد بن إبراهيم الجاجرميّ السهلكيّ الشافعي (613) له كتاب القواعد في فروع الشافعية.
2 ـ أبو محمد، عز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام السلميّ (660) له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مطبوع.
3 ـ صدر الدين، محمد بن عمر المكي، المعروف بابن الوكيل المصريّ الشافعي، وابن المرحل (716) صاحب كتاب: (الأشباه والنظائر).
4 ـ صلاح الدين، أبو سعيد، خليل بن الكَيكلّدي الدمشقيّ، المشهور بالعلائيّ الشافعي (761) صاحب: (المجموع المُذهّب في قواعد المذهب) أو (قواعد العلائي)، و (الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعي).
5 ـ عبد الوهاب بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، المشهور بتاج الدين السبكي (771) له كتاب: (الأشباه والنظائر).
6 ـ محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين، محمد الزركشي المصريّ (794) صاحب كتاب: (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية) أو (القواعد في الفروع) وطبع على ترتيب حروف المعجم، وفي أربعة مجلدات بكويت.
7 ـ جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، المعروف بجلال الدين السيوطي (911) صاحب كتاب: (الأشباه والنظائر).
ومن بين هذه الكتب يعتبر كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي من أهم ما كُتِب في هذه الباب، ورتّبه المؤلف في سبعة كتب، وشرح في الكتاب الأوّل خمسة قواعد رئيسية، وبين فروعها وهي:
أ: الأمور بمقاصدها.
ب: اليقين لا يزول بالشك.
ج: المشقة تجلب التيسير.
د: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ه: العادةُ مُحَكِّمةٌ.
وأتى بأربعين قاعدة فقهية في الكتاب الثاني، ويبدأ هذا القسم بقاعدةِ: (الاجتهادُ لا يُنقض بالاجتهاد) وينتهي بـ: (تقديم المباشرة على السبب)، لكن شمول هذه القواعد أقل من القواعد الخمسة الماضية، وفي الكتاب الثالث جاء بعشرين قاعدة.
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي
1 ـ نجم الدين، سلمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (710) صنّف كتاب: (القواعد الكبرى في فروع الحنابلة).
2 ـ تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (728) صاحبُ كتاب: (القواعد النورانية الفقهية).
3 ـ شمس الدين، محمد بن أبي بكر، المشهور بابن قيّم الجوزيّة (751) صاحب كتاب: (بدايع الفرائد).
4 ـ أبو الفرج، عبد الرحمن بن شهاب بن أحمد بن أبي أحمد، رجب، المشهور بابن رجب الحنبلي (795) له كتاب: (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) أو (القواعد في الفقه الإسلامي) ويحتوي (160) قاعدة فقهية، مطبوع.
5ـ يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، المعروف بابن مِبرد الصالحي (909) صاحبُ كتاب: (القواعد الكلّيّة والضوابط الفقهية)[24].
نحن وهذا الكتاب:
الكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ دراسة تفصيلية معمّقة حول أحد القواعد الفقهية المهمّة وهي (قاعدة الفراغ والتجاوز) لسماحة آية الله الشيخ محمدجواد الفاضل اللنكراني (دام ظله) حيث يُعد ذلك دروس ألقاها على مجموعة من الفضلاء في الحوزة العلمية بقم المقدسة وطلب منّي سماحته تعريب ذلك وطرحت فكرة التعريب على سماحة الأخ الأستاذ الفاضل الشيخ محمد جواد السعيدي (دام عزّه) الذي يُعدّ أحد أساتذة حوزتنا حوزة فقه الأئمة الأطهار(ع) التي أسسّها المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى شيخنا الاستاذ الشيخ محمد الفاضل اللنكراني (قدس الله نفسه الزكية) وقد قام المترجم المحترم من قبل بترجمة كتاب (حق التأليف) ونال في الأواسط العلمية.
وفي الختام نسأل الباري عزوجل أن يوفّقنا لخدمة مذهب أهل البيتbإنه سميع مجيب.
محمد جعفر الطبسي
13/شعبان المعظم/1431هـ
سوريا ـ السيدة زينب(س)
مقدمة المترجم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أمّا بعد فإنّ قاعدة الفراغ والتجاوز إنّما تُعتبر واحدة من أهمّ القواعد الفقهية التي لطالما استند إليها فقهاؤنا العظام في تصحيح المخترعات الشرعية والمركّبات الاعتبارية عند الشك في إتيان جزءٍ أو نسيان شرط منها كما هو الحال في بابي الصلاة والحج، قاعدة بحث فيها الفقهاء وصال في ميدانها العلماء فألّفوا فيها الكثير من المؤلفات وركزوا على دراسة هذه القاعدة وتحليلها من مختلف الزوايا والجهات، ومن هؤلاء مؤلفنا القدير وأستاذنا الكبير الفقيه العلامة آية الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني (أدام الله عزّه) الذّي تزخر المكتبة الإمامية بكتبها القيّمة ومؤلفاته النفيسة في شتى المجالات ولاسيّما في علمي الفقه والأصول، هذه المؤلفات التي ساهمت وتساهم في نشر فقه أهل البيت(ع)وفكرهم وها هي حوزة فقه الأئمة الأطهار(ع)في منطقة السيدة زينب(س)في سوريا بإدارة مديرها المدبّر ومشرفها القدير العلامة الشيخ محمدجعفر الطبسي قد تصدّت في السنوات الخمس التي مرّت على تأسيسها لمهمّة القيام بطبع كثير من مؤلفات مؤلفنا القدير وترجمة عدد لا بأس به من الكتب والكتيبات للمؤلف في علمي الفقه والأصول ووضعها بين أيدي طلبة العلوم الدينية وطلاب الحوزات العلميّة للتزود والاستفادة منها ولا سيّما لمن بلغ منهم مرحلتي السطوح العليا وبحث الخارج.
وقد أُسندتْ إليّ فيما سبق مهمّة القيام بترجمة كتاب (حقّ التأليف) الذي نجح إلى حدّ كبير في أوساط الطلبة الأفاضل فكان له طلابه وقرّاؤه وهذه هي المهمّة الثانية التي لطالما أفتخر بحملها على عاتقي وأشكر سماحة العلامة الشيخ محمد جعفر الطبسي على حسن ظنّه بعملي في الترجمة.
ولقد وجدت من خلال قراءتي الدقيقة وبنظري القاصر أنّ هذا العمل الجديد للمؤلف الجليل عملٌ دقيق وقيّمٌ وجبّار، يجاري مؤلفات فقهائنا الكبار الذين كتبوا في قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد بحث المؤلف في هذه القاعدة من زوايا مختلفة وبأسلوب سهلٍ وبيان سلس وألفاظ عذبةٍ يتذوقها القارئ الكريم بكلّ سهولة ويسار.
سوريا ـ السيدة زينب(س)
الشيخ محمد جواد السعيدي
سم الله الرحمن الرحيم
تعتبر قاعدة الفراغ والتجاوز من القواعد الهامة الّتي استند إليها الفقهاء في كثير من الفروع وأبواب الفقه لاسيّما في العبادات، من هؤلاء الفقهاء المرحوم السيد حيث ذكر في خاتمة كتاب الصلاة (العروة الوثقى)[25] مسائل عديدة تحت عنوان فروع العلم الإجمالي وهي من المسائل الفقهية الهامّة جدّاً وهي تبتني على أمرين أساسيين:
1ـ قاعدة الفراغ والتجاوز،
2ـ حديث لا تعاد.
أمّا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ والتجاوز فقد جرتْ سيرة الأصوليين وطريقة العلماء المتأخرين على إدراجها والبحث عنها في طيّات مباحث الاستصحاب من علم الأصول ـ في البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز على وجه التحديد ـ حيث يعتقد جلّ الأصوليين بل ربّما كلّهم بأنّ قاعدة الفراغ والتجاوز مقّدمة على الاستصحاب أمّا من باب الحكومة وإمّا من باب التخصيص[26].
كما بُحث عن هذه القاعدة كقاعدة فقهية هامة في الكتب المؤلّفة تحت عنوان (القواعد الفقهية).
هذا ولكنّنا لا نجد في كلمات القدماء ما يسمّى بقاعدة الفراغ والتجاوز وإنْ وجدنا الروايات التي تُعدّ مستنداً لهذه القاعدة في عبارات القدماء وكتبهم[27].
أهمّ الأمور الّتي لا بدّ من بيانها في مبحث قاعدة الفراغ والتجاوز وقد كانت محطّ أنظار الباحثين هي كالتالي:
1 ـ مستند ومدرك هذه القاعدة وشروط جريانها
2 ـ الإجابة عن التساؤل بأنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان مستقلّتان؟
3 ـ هل أن قاعدة الفراغ والتجاوز أصلٌ عملي أو أمارة؟ وعلى فرض كونها أصلاً فمن أيّ الأصول العملية هي؟
4 ـ أين تجري هذه القاعدة؟ فهل هي مختصّة ببابي الصلاة والطهارة أو تعمّ جميع أبواب الفقه؟
يبدأ البحث عادةً في الكتب الأصولية في إطار البحث عن قاعدة الفراغ والتجاوز من زاوية أنّها من الأمارات أو الأصول العملية، إلاّ أنّ الترتيب الطبيعي والمنطقي يقتضي أن نبحث أولاً عن أدلّة هذه القاعدة ومداركها ثمّ ننتقل إلى البحث عن كونها من الأمارات أو الأصول العملية.
ومن هنا لابدّ من البحث أولاً عن أدلّة هذه القاعدة ومداركها ثمّ الانتقال إلى الأبحاث الأخرى المتعلّقة بهذه القاعدة والتّي وقع الخلاف فيها.
وقبل هذا وذاك لا بد من بيان تعريف الفراغ والتجاوز للتعرف عليها ولو على نحو الإجمال.
التعريف الإجمالي للقاعدتين
قاعدة الفراغ هي الحكم ظاهراً بصحّة العمل الذي فرغ منه المكلّف، كما لو صلّى المكلّف ثمّ شكّ في صحة جزءٍ من أجزائها أو شرط من شرائطها بعد الانتهاء منها فإنّ قاعدة الفراغ أثبتت في حقّه حكماً ظاهراً بصحّة صلاته.
قاعدة التجاوز
هي الحكم ظاهراً بإتيان الجزء المشكوك بعد تجاوز محلّه، وذلك كما لو شك المصلّي في حالة السجود بأنّه هل ركع أولاً؟ فإنّ قاعدة التجاوز تجعل في حقّه حكماً ظاهرياً بأنّه أتى بالركوع.
وعليه فالفرق بين القاعدتين على القول بأنّهما قاعدتان مستقلّتان (وسيأتي الخلاف في ذلك في الأبحاث القادمة مفصّلاً) هو أنّ مورد قاعدة الفراغ هو الشكّ في صحّة الجزء المأتي به بينما مجرى قاعدة التجاوز هو الشكّ في إتيان الجزء من الأساس.
ومن الجدير بالذكر أنّنا سنذكر الفرق بين هاتين القاعدتين بعد البحث عن مدارك هذه القاعدة.
أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز
مجموع ما يمكن أن يُتوصل إليه من الأدلّة على قاعدة الفراغ والتجاوز من خلال تتبّع كلمات العلماء الأعلام ستّة أدلّة ونحن نذكر منها أولاً: تلك الأدلة القابلة للمناقشة والطعن ثمّ نرجى البحث عن الأخبار والروايات التي تعتبر الدليل الأهمّ على هذه القاعدة إلى نهاية الأدلة.
1 ـ الإجماع العملي:
من خلال التصفّح في الأبواب الفقيهة المختلفة سوف يتبيّن لنا أنّ فقهائنا العظام قد استندوا إلى هذه القاعدة وعملوا بها في شتّى أبواب الفقه كالصلاة والوضوء والحجّ وبعض الموارد الأخرى، والمراد بالإجماع العملي هو هذا الاستناد وعمل الفقهاء في هذه الموارد وإن لم يتحقّق الإجماع القولي منهم في هذه المسألة.
المناقشة في دليليت الإجماع العملي:
مضافاً إلى أنّ تحقق هذا الإجماع في غير باب الصلاة والطهارات (الثلاث) محل نظر وغير معلوم فإنّ الإشكال المهمّ الذي يواجه هذا الدليل هو أنّ هذا الإجماع مدركي قطعاً والإجماع المدركي لا حجية له وذلك أنّ مدرك الفقهاء في موارد استنادهم إلى هذه القاعدة هو تلك الروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام في هذا المجال،
وعليه لم يكن مستند الفقهاء في هذه المسألة هو الإجماع التعبّدي المعتبر، ومن هنا يسقط الدليل المذكور عن الاعتبار والحجّية[28].
2 ـ السيرة المتشرّعة:
حيث استقرّت سيرة المتشرعة العملية على أنّهم إذا قاموا إلى عمل عبادياً كان أو غيره جاؤوا به على شكله الصحيح، على سبيل المثال فإنّ المصلّي عندما يتمّ صلاته لا يفكّر في إعادة صلاته أو قضائها نهائياً إذ يعتقد أنّه صلّى صلاة صحيحة، نعم يمكن لبعض العظماء أن يعيدوا بعض أعمالهم العبادية من باب الاحتياط إلاّ أنّه لا يحكم أيّ مكلّف متشرع على نفسه بإعادة أعماله بمجرد الشكّ في أنّها هل صدرتْ منه على الشكل الصحيح أو لا؟
مناقشة هذا الدليل:
يرد على حجية هذه السيرة ما ورد على الإجماع العملي حيث يحتمل أن تكون السيرة مدركيةً أيْ أنّ سيرة المتشرعة هذه مبتنية على فتوى الفقهاء أو الروايات أو أي دليل آخر فتصبح هذه السيرة فاقدة للاعتبار والحجية كالإجماع المدركي، لاستناد هذه السيرة إلى فتاوى الفقهاء.
فلو سئل الفقهاء عن حكم الوضوء مثلاً فيما لو شكّ في صحته بعد الانتهاء منه فهل تجب الإعادة؟ لأجابوا بالنفي وعدم وجوب الإعادة، وعلى هذا لا يمكن لسيرة المتشرعة أن تقع دليلاً لقاعدة الفراغ والتجاوز.
3 ـ سيرة العقلاء:
قام بناء العقلاء وجرتْ سيرتهم على أنّ المكلّف المختار العالم بأجزاء المأمور به وشرائطه إذا أتى بالمأمور به منه عدّوا عمله تامّاً وصحيحاً، ويمكن أن يدّعى ذلك في قاعدة الفراغ بأن يقال: إنّ المكلّف لو أتى بالعمل وشكّ بعد الفراغ في صحّة عمله فإنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحّة هذا العمل.
فلو سلّمنا صحة هذا الدليل كان لا بدّ من الالتزام بأنّ التعليل الوارد في ذيل بعض الروايات التي سنبحث عنها تحت عنوان الدليل السادس حيث يقول الإمام(ع) حول الشكّ في صحّة الوضوء بعد الفراغ منه: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ)[29]ليس هذا التعليل أمراً تعبّدياً بأن يكون الشارع قد بيّن ذلك وهو في مقام التشريع بل سيكون هذا التعليل أمراً ارتكازياً عقلائياً ويكون الإمام(ع) منوّهاً إلى هذا المرتكز العقلائي في الرواية حيث يمكن اعتبارها كمؤيد للسيرة العقلائية.
مناقشة الاستدلال بالسيرة العقلائية:
لتحقيق أنّ سيرة العقلاء هل يمكن أن تقع دليلاً على قاعدة الفراغ أو لا، لابدّ من بيان أنّ السيرة العقلائية لا تخلو عن صورتين:
1ـ أمّا أن تكون السيرة العقلائية تعبّدية حيث لا حاجة معها إلى بيان الملاك من قبل العقلاء.
2ـ وإمّا أن يكون لسيرة العقلاء مدركٌ لدى العقلاء.
نظير هذا البحث قد جرى في أصالة الحقيقة أيضاً من أنّ أصالة الحقيقة هل هي أصل لفظي عقلائي تعبّدي أو ليست كذلك بل تكون راجعة إلى أصالة عدم القرينة[30]؟ وفيما نحن فيه لو أتى الفاعل العالم المختار بعملٍ فإنّ حكم العقلاء بصحّة عمله بعد الفراغ منه هل هو أصل تعبّدي عقلائي؟ أو ليس تعبدياً بل له ملاك؟
القول بأنّ سيرة العقلاء في مبحث قاعدة الفراغ والتجاوز أصل تعبّدي مشكل جدّاً بل يمكن القول بأنْ لا أصل تعبدي لدى العقلاء، والأصول أو السير العقلائية كلّها قائمة على أساس الملاك، وعلى هذا الأساس لابدّ من معرفة ملاك سيرة العقلاء فيما نحن فيه، فما هو ملاك السيرة العقلائية هنا؟
يمكن الإجابة بأنّ ملاك هذه السيرة ومآلها إلى أصالة عدم الغفلة وذلك أنّ العقلاء يجرون أصالة عدم الغفلة في حقّ مَن قصد إتيان عمله والقيام بتكليفه على النحو الصحيح لكنّه شك في أنه هل عرضت عليه الغفلة أثناء العمل أو لا؟ ومن هنا لابدّ من البحث والتحقيق في موارد إجراء العقلاء أصالة عدم الغفلة هل جريانها مختص بموارد خاصّة أو لا؟
وبتعبير آخر: هناك سؤالان رئيسيان في مورد هذا الأصل ومجراه:
السؤال الأوّل: هل يختصّ جريان أصالة عدم الغفلة في خصوص الأقوال کالخبر والشهادة بحيث لا يشمل الأفعال الخارجية؟
الجواب: يعتقد البعض[31] أنّ مورد أصالة عدم الغفلة هو باب الإخبار والشهادة، وذلك بسبب أنّ العاقل ملتفت إلى الخصوصيات الموجودة في الحادثة والقرائن المكتنفة بالكلام، ومن هنا تجري أصالة عدم الغفلة في شهادة الشاهد أو نقل الخبر عن حادثة أو نقل الرواية فتكون أصالة عدم الغفلة أصلاً عقلائياً لفظياً وعليه لا تجري في دائرة الأفعال الخارجية.
هذا ولكنّ التحقيق جريان هذا الأصل في الأفعال أيضاً لأنّا نجد من أنفسنا أنّنا لو أمرنا شخصاً بإعداد طعام مركّب من عدّة مواد خاصة لكنّا شككنا في أنّه هل أنجز عمله على نحو صحيح أو أنّه كان غافلاً أثناء عمله أجرينا في حقّه أصالة عدم الغفلة وحملنا عمله على الصحّة، ومن هنا لم تكن أصالة عدم الغفلة أصلاً لفظياً عقلائياً صرفاً بل تجري في الأفعال أيضاً.
السؤال الثاني: بعد أن عرفنا جريان أصالة عدم الغفلة في الأفعال أيضاً فلابدّ لنا ـ حتى يتم الاستدلال بسيرة العقلاء على قاعدة الفراغ والتجاوز ـ من أن نحرز بأنّ أصالة عدم الغفلة هل تشمل أقوال المكلّف نفسه وأفعاله بأن يطبّقها المكلّف على أفعال نفسه أو أنّها تختص بأقوال الآخرين وأفعالهم؟
الجواب: الظاهر باعتقادنا أن لا عمومية ولا توسعة لأصالة عدم الغفلة من هذه الجهة فتختص بأقوال الآخرين وأفعالهم ولا أقل من الشكّ في شمول هذا الأصل العقلائي لأفعال المكلّف نفسه ولمّا كانت أصالة عدم الغفلة دليلاً لبيّاً وجب الأخذ بالقدر المتيقّن منه وهو قول الغير وفعله.
وعليه فلا يمكن الركون إلى فعل نفسه بهذا الأصل، وفي النتيجة لا تكون السيرة العقلائية دليلاً على قاعدة الفراغ والتجاوز.
أمّا التعليل الوارد في ذيل الروايات الدالة على السيرة العقلائية التي سندرسها في الدليل السادس فإنّنا سنجيب هناك بأن قوله(ع): (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ) ليس تعليلاً ولا يعد علّة، وقد ذكر بعض الأعاظم كالمحقق النائيني(ع)أنّ هذه العبارة منه(ع)حكمةٌ وليست علّة.
4 ـ إثبات حجية القاعدة بأصالة الصحة:
الدليل الرابع على قاعدة الفراغ أدلّة أصالة الصحة كما هو المستفاد من كلمات الفقيه العظيم الحاج رضا الهمداني من أنّ الأدلّة الدالّة على حجية أصالة الصحة تدلّ بنفسها أيضاً على حجية قاعدة الفراغ التي هي من مصاديق قاعدة أصالة الصحة الكلّية حيث يقول: (إنّ عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ من الوضوء إنّما هو لكونه من جزيئات هذه القاعدة، وهذه القاعدة بنفسها من القواعد الكلّية المسلّمة المعمول بها في جميع أبواب الفقه وهذه هي القاعدة التي يُعبّر عنها بأصالة الصحّة)[32].
فالمرحوم المحقق الهمداني لا يرى قاعدة الفراغ قاعدة مستقلة بل يعتقد أنّها من مصاديق وجزئيات أصالة الصحة التي هي من القواعد الفقهية المسلّمة الجارية في جميع أبواب الفقه كما أنّها أصل عقلائي حيث لو شك في صحة عمل (كالوضوء) بعد الفراغ منه قام بناء العقلاء على أنّ ذلك العمل قد أنجز على النحو الصحيح.
هذا ولكنّه يذكر في صفحات أخرى من كتابه عند الحديث عن قاعدة التجاوز وأنّها تجري فيما لو شك في أصل وجود الجزء بعد تجاوز محله كالركوع مثلاً.
ويذكر أنّ قاعدة التجاوز على خلاف قاعدة الفراغ وليست من مصاديق أصالة الصحة بل هي قاعدة مستقلّة مختصّة بباب الصلاة ولا تجري في سائر أبواب الفقه.
يقول: (إنّ مفاد الروايتين (يعني خبر إسماعيل بن جابر وصحيحة زرارة الذين سنتكلّم عنهما في الدليل السادس) على ما يقتضيه ظاهرهما عدم الاعتناء بالشك في وجود شيء بعد تجاوز محلّه، لا في صحته، فهي قاعدة أخرى غير قاعدة الصحّة... وكيف كان فالظاهر أنّ هذه القاعدة مخصوصة بالصلاة لا أنّها كقاعدة الصحّة سارية جارية في جميع أبواب الفقه)[33].
وعلى هذا فإنّه جعل أدلّة أصالة الصحة دليلاً على قاعدة الفراغ وفرّق بين أصالة الصحة وقاعدة التجاوز من حيث المضمون والمدلول.
مناقشة الدليل المذكور: للتعرف علی أنّ أدلّة أصالة الصحّة يمكنها أن تقع دليلاً على قاعدة الفراغ لابد لنا من أن نعرف هل هناك فرق بينهما أولا؟
تشترك قاعدة الفراغ مع أصالة الصحة في عدّة وجوه ممّا جعلت هذه الوجوه قاعدة الفراغ من مصاديق أصالة الصحة، والوجوه المشتركة بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ هي كالتالي:
1 ـ كما اختُلف في قاعدة الفراغ من جهة أنّها أمارة أو أصل فكذلك وقع الخلاف في أصالة الصحّة.
2 ـ إنّ بعض الشروط المعتبرة عند الفقهاء لإجراء قاعدة الفراغ هي نفسها معتبرة في جريان أصالة الصحة، فعلى سبيل المثال: يُشترط في جريان قاعدة الفراغ إحراز عنوان العمل وذلك أنّ مَنْ فرغ من الوضوء فشك في صحة وضوئه لا بد أن يحرز أنّه قد توضأ، أمّا لو تردّد في أصل العمل ولم يعلم بأنّه توضأ أو غسل وجهه بهدف تبريده فلا تجري قاعدة الفراغ، وهذا الشرط بعينه معتبر في إجراء أصالة الصحة حيث إنّ بناء العقلاء قائم على جريان أصالة الصحة مع إحراز العمل فيكون العمل محكوماً بالصحة.
3 ـ وجه الاشتراك الثالث بين أصالة الصحة وقاعدة الفراغ أنّ أصالة الصحة تجري في جميع أبواب الفقه فكذلك قاعدة الفراغ تجري في جميع أبواب الفقه على ما هو التحقيق، وقد صرّح المرحوم صاحب الجواهر بجريان هذه القاعدة في كلّ عمل مركّب كالصلاة[34].
وسنبين بالتفصيل مدى حدود جريان قاعدة الفراغ.
أمّا وجوه الافتراق بين أصالة الصحة وقاعدة الفراغ المستفادة من كلمات المرحوم المحقق النائيني والمرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري فهي الأمور التالية:
1 ـ أصالة الصحة إنّما تتعلّق بفعل غير المكلّف[35]بينما تتعلّق قاعدة الفراغ بفعل المكلّف نفسه فتفترقان من جهة مجراهما.
2 ـ ترتبط قاعدة الفراغ بما بعد العمل كما هو مستفادٌ من عنوان الفراغ نفسه، أمّا أصالة الصحة فلا تختص بما بعد العمل بل تجري في أثناء العمل[36]أيضاً، فعلى سبيل المثال لو شُكّ في صحة صلاة الميّت والمصلي مشتغلٌ بها على الجنازة جرتْ أصالة الصحة وحكمنها بصحّة صلاته.
والذي يقتضيه النظر عدم تمامية كلا الفرقين فلا يمكن الردّ بهما على كلام المرحوم الهمداني.
أمّا بالنسبة إلى الفرق الأوّل فكما نعتقده ويعتقده بعض المحققين ومنهم المرحوم الهمداني[37]أنّ أصالة الصحة لا اختصاص لها بفعل غير المكلّف بل تجري في فعل المكلّف نفسه أيضاً، وعلى هذا فإنّ قاعدة الفراغ من مصاديق أصالة الصحة ولا تختلف عنها.
والفرق الثاني أيضاً لا يوجب الافتراق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، وذلك لأنّ أصالة الصحة عامّة تشتمل ما بعد الفراغ من العمل وأثناء العمل وتجري فيهما، فتشمل قاعدة الفراغ أيضاً التي تتعلّق بما بعد الانتهاء من العمل وعليه فإنّ هذا الكلام يُثبت أصل المدّعى وهو: أنّ قاعدة الفراغ هي ذاتها أصالة الصحة الجارية بعد الانتهاء من العمل.
تحقيق الكلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة:
إنّ قاعدة الفراغ وأصالة الصحة مختلفتان من حيث الملاك وذلك لأنّ ملاك قاعدة الفراغ هو التوجّه والالتفات كما ورد التعبير في الروايات بالأذكرية يعني أن يكون التفات المكلّف أثناء العمل أكثر من زمن فراغه من العمل حيث يشك في صحته، وهذا الملاك غير متوفر في أصالة الصحة حيث يمكن فيها للعمل الذي قد أُنجز، أن يتّصف بأحد عنواني الصحة والفساد إلا أنّ الشارع أو العقل قد غلب جانب الصحّة على الفساد حيث قال الشارع في هذا المجال: (ضعْ أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه...)[38]ولا علاقة للأذكرية في أصالة الصحة أبداً.
وعليه فإنّ قاعدة الفراغ وأصالة الصحة وإن اشتركتا في بعض الأمور إلا أنّهما مختلفتين من ناحية الملاك ولم يمكنْ عدّ أصالة الصحة بمنزلة الدليل على قاعدة الفراغ.
5 ـ أدلة المحقق الهمداني:
سبق في الدليل السابق أن بيّننا بأن المرحوم المحقق الهمداني جعل قاعدة الفراغ من مصاديق أصالة الصحّة ولم يلتزم بذلك في قاعدة التجاوز، وعلى مبناه كلّما جاز جعله دليلاً على أصالة الصحة كان دليلاً على قاعدة الفراغ أيضاً، وقد ذكر في كتابه ثلاثة أدلة على أصالة الصحة وبالتالي سكتون هذه الأدلّة أدلّة على قاعدة الفراغ أيضاً، ومن هنا كان لابدّ من البحث في هذه الأدلّة.
يقول المرحوم المحقق الهمداني: (...العمدة في حمل الأفعال الماضية الصادرة من المكلّف أو من غيره على الصحيح إنّما هي السيرة القطعية ولولاه لاختلّ نظام المعاش والمعاد، ولم يقم للمسلمين سوقٌ، فضلاً عن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة، إذ ما من أحد إلا إذا التفت إلى أعماله الماضية من عباداته ومعاملاته، إلاّ ويشكّ في أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكاً، كما أنّه لو التفت إلى أعمال غيره، يشكّ في صحّتها غالباً فلو بنى على الاعتناء بشكّه لضاق عليه العيش، كما لا يخفى)[39].
الدليل الأوّل قاعدة لا حرج:
فالدليل الأوّل الذي أقيم على أصالة الصحة قاعدة لا حرج التي تعتبر من القواعد الفقهية المسلّمة، توضيح ذلك في المقام هو: أنّ الإنسان إذا التفت إلى أعماله السابقة أو أعمال الآخرين (الصلاة، الوضوء، المعاملات و...) واستقرأها مفصّلاً سيحصل له الشكّ في كثير منها، فلو وجب الاعتناء بشكّه هذا لزم العسر والحرج، فلو شك مثلاً في صحة صلاة قد أتى بها سابقاً وجب عليه أن يعيدها، ولو التفت إلى هذه الصلاة المعادة حصل له الشكّ في صحتها أيضاً ولزمته الإعادة، وهكذا يستمر الشكّ وتستمر معه إعادة الصلاة وليس هذا إلا عسراً وحرجاً، وهذا الإشكال بعينه يجري في الصوم والمعاملات وساير أمور الحياة.
وعليه فإنّ قاعدة لا حرج كإحدى القواعد الفقهية تدلّ على أنّ الله تعالى لم يشرع حكماً حرجياً في الشريعة ولمّا كان الاعتناء بالشك وعدم إجراء أصالة الصحة موجباً للعسر والحرج يحكم بنفيها من خلال قاعدة لا حرج فيحكم بجريان أصالة الصحة.
الدليل الثاني:
التعليل الوارد في قاعدة اليد: توضيح ذلك أنّه لو لم تكن اليد حجة ولم يمكن للناس أن يحكموا بملكية الأشخاص للأموال التي تحت أيديهم لما قام للمسلمين سوق، فالمرحوم المحقق الهمداني(ع)استفاد من عموم هذا التعليل ليعمّمه على موارد جريان قاعدة الفراغ وأصالة الصحة حيث إنّه لو التزم بلزوم الإعادة في موارد الشكّ في صحّة الأعمال السابقة لم يبق سوق للمسلمين قط.
الدليل الثالث اختلال النظام:
حيث يقال في بيان هذا الدليل بأنّه لو بنينا على وجوب إعادة الأعمال السابقة بمجرّد الشكّ في صحتها لزم اختلال نظام حياة الناس ومعيشتهم وإصابتهم بهلع وضياع، وهذا الدليل مآله إلى الدليل السابق لأنّ الناتج منهما زوال نظام المجتمع واختلال حياة الأفراد.
الرد على أدلّة المرحوم الهمداني:
حيث يمكن الردّ على نحوين:
1 ـ الرد الكلّي الشامل للأدلة الثلاثة.
2 ـ الردود الجزئية الخاصة المتعلّقة بكلّ واحد من تلك الأدلة الثلاثة.
أ ـ الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة:
إنّ الروايات التي تُعد مستنداً لقاعدة الفراغ والتجاوز تتجاوز العشرين رواية وهي إمّا أن لم يذكر فيها تعليل وإما أن ذُكر فيها التعليل بمثل قول الإمام(ع): (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ).
وبتعبير آخر فإنّ الإمام(ع) مع كونه في مقام بيان الدليل إلا أنّه لم يستدلّ في رواية من روايات قاعدة الفراغ والتجاوز باختلال النظام أو (لما قام للمسلمين سوق) أو قاعدة لا حرج، مع أنه(ع) استدلّ في كثير من المسائل الفقهية الحرجية على نفي الحرج ورفع التكليف بالآية الشريفة: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[40]ممّا يدلّ على أنّ هذه الأمور الثلاثة ليست أدلّة على قاعدة الفراغ.
ب ـ الرد الخاص بدليلية (لاحرج):
أولاً: إنّا ننكر وقوع ما نحن فيه (قاعدة الفراغ) صغرى لقاعدة نفي الحرج لأنّ قاعدة نفي الحرج إنّما تتصوّر في موارد يشك فيها غالب الناس في صحة أعمالهم بعد الفراغ من العمل، أمّا أثناء العمل فقلّما يُبتلى المكلّف بهذا النوع من الشكّ، وعليه فليس ما ادّعاه المرحوم الهمداني(ع)من أنه: (ما من أحدٍ إذا التفت إلى أعماله الماضية... إلا ويشك في أكثرها) لا يطابق الواقع، لأنّ الشكّ من هذا القبيل إنّما يقع للقليل من الناس وبالتالي فلا يكون مستلزماً للعسر والحرج.
ثانياً: إنّ قاعدة لا حرج ليست قاعدة ثابتة فلا يمكن إثبات الحكم بالاستناد إليها، وذلك أنّ هذه القاعدة تفيد أنّ الحكم الحرجي لم يُجعل في الشريعة بينما تثبت قاعدة الفراغ صحّة الجزء المشكوك وتثبت قاعدة التجاوز حصول الجزء المشكوك (وهذا على رأي بعض الفقهاء في قاعدة التجاوز لا جميعهم) وعلى هذا فإنّ لسان قاعدة الفراغ والتجاوز مثبت وإيجابي بينما لسان قاعدة لا حرج منفي وسلبي[41].
ج ـ الرد الخاص بالتعليل بقاعدة اليد واختلال النظام:
أولاً: كما أسلفنا في الجواب السابق أنّ الإشكال إنّما يرد على صغرى كلام المرحوم المحقق الهمداني حيث لا يحصل الشكّ من هذا القبيل لجميع الناس وإنّما يحصل لعددٍ قليل منهم ومن هنا فإنّ إعادة الأعمال السابقة لا تؤدّي إلى تعطيل سوق المسلمين فضلاً عن اختلال نظام الحياة.
ثانياً: أنّ التعليل في قوله: (لولاه لما قام للمسلمين سوق) له انصراف ظاهر إلى المعاملات بالمعنى الأعم وبالتالي لا يشمل بابي العبادات والطهارات الذَين هما المجريان الأساسيان لقاعدة الفراغ، فلو أوجب الشارع إعادة العمل فيما لو شُك في صحته بعد الفراغ منه في بابي العبادات والطهارات لم يكن لذلك علاقة بسوق المسلمين أو باختلال نظام معيشة الناس ولم يلزم أي خلل في هذين الأمرين.
وعليه فلا يمكن الاستناد إلى الدليل الخامس القائم على قاعدة الفراغ فهو مردود.
6 ـ الأخبار والروايات:
كما سبق في ابتداء البحث عن أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز أنّ عمدة هذه الأدلّة وأساسها هي الروايات المستفيضة المعتبرة أكثرها، حتى أنّ بعض الأعاظم كالمرحوم الإمام الخميني(قده)لم ينوّه إلى الأدلّة الخمسة السابقة بل دخل مباشرة في البحث عن الروايات وذلك لعدم تمامية تلك الأدلّة ـ كما بيّنا ـ فلا يمكن الاستناد إليها.
وهذه الروايات ورد أغلبها في أبواب الطهارة والصلاة والحج وهي فوق حد الآحاد وقد وصلت إلى حدّ الاستفاضة، ولا يبعد بل يمكن ادّعاء تواترها معنى بعد دراستها والتأمل فيها وإن لم يتحقق التواتر اللفظي في هذه الروايات.
وما يُبحث عنه في الدليل السادس هو أنّ هذه الروايات هل تدلّ على أصل قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا؟ ولا ندخل في تفاصيل البحث في هذا المجال بل ينصب اهتمامنا ببيان أنّ من فرغ من عمل ما ثم شك في صحته فهل تجاوز محله فهل يعتني بشكّه طبقاً لمضمون هذه الروايات؟ فما مدلولها؟
أمّا الروايات فهي:
1ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله(ع)، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: (لا يعيد، ولا شيء عليه)[42].
دراسة سند الرواية:
الرواية صحيحة، والمراد بمحمد بن الحسن هو الشيخ الطوسي(ع)الذي هو من أجلّاء فقهاء الامامية العظام ولا يخفى وثاقته وجلالة قدره وعظمة شأنه على أحد.
وطريق المرحوم الشيخ الطوسي بحسين بن سعيد طريق صحيح وقد ذكر في المشيخة[43]: (الحسين بن سعيد يراد به الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي) الذي صرّح بوثاقته كبار علماء الرجال[44].
(ابن أبي عمير يراد به محمد بن أبي عمير وهو من الثقات والأعاظم عند الإمامية)[45]. (أبي أيوب الخراز يعبر عنه في كتب الرجال بأسماء مختلفة مثل: إبراهيم بن عيسى أبو أيوب إبراهيم الخراز أبو أيوب، إبراهيم بن زياد أبو أيوب، إبراهيم بن زياد و...) والمقصود شخص واحد وهو ثقة وله كتاب النوادر[46].
(محمد بن مسلم) من كبار فقهائنا الأصحاب وكان الأوثق في الكوفة وقد تتلمّذ عند الإمام الباقر والإمام الصادق(ع)[47].
وعلى هذا فلا إشكال في سند هذه الرواية.
دراسة دلالة الرواية:
في هذه الرواية يسأل محمد بن مسلم من الإمام الصادق(ع)حكم من شك بعد الإنصراف من صلاته ويجيب الإمام(ع)بأنّ هذا الشكّ لا يعتنى به فلا تجب إعادة الصلاة.
ومن الواضح أنّ هذه الرواية مختصّة بباب الصلاة).
وتشمل كلمة (يشك) الواردة في الرواية للقسمين من الشكّ (الشكّ في صحة الصلاة والشك في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة). ولابدّ من البحث في كلمة (ينصرف) فهل يراد بالانصراف الانصراف الفقهي الحاصل بالتسليم بعمل آخر؟ يرى الإمام الخميني(ع)إنّ المراد هو الانصراف الفقهي وقد عُبِّر في الروايات عن التسليم في الصلاة بعنوان الانصراف[48].
2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)قال: (كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تُعدْ)[49].
دراسة سند الرواية:
هذه الرواية كسابقتها رواية صحيحة إذ طريق الشيخ الطوسي(ع)بأحمد بن محمد طريق صحيح كما ورد ذلك في مشيخة التهذيب فإنّ أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي[50] وهو من الثقات الأجلاء وطريق الشيخ(ع)إليه هو (ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب (الشيخ الكلّيني(ع)) عن عدة من أصحابنا (وهم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، ومحمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسين السعد آبادي) عن أحمد بن محمد بن خالد[51] وهو طريق صحيح أو (أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو فقيه وشيخ القميين ومن الثقات[52] وطريق الشيخ(ع)هو (ما رويته بهده الأسانيد عن محمد بن يعقوب (الشيخ الكليني) عن عدّة من أصحابنا (وهم أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي، وعلي بن موسى بن جعفر الكمنداني، وأبو سليمان داوود بن كورة القمي، وأبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)[53] وهذا الطريق أيضاً طريق صحيح.
(الحسن بن محبوب) من أصحاب الإمام الرضا(ع)[54] وقد وثّقه الشيخ الطوسي(ع)إلا أنّ النجاشي لم يذكر اسمه في كتابه ولم يتعرّض لترجمته، بينما ذكره الكشي من أصحاب الإجماع[55].
(علي بن رئاب) كوفي من ثقات الإمامية العظماء.
أمّا ترجمة محمد بن مسلم فقد سبقت في الرواية السابقة.
دلالة الرواية:
يقول الإمام الباقر(ع): «إذا شككت في صحة الصلاة أو في إتيان جزء منها، بعد الفراغ منها فامض ولا تعتنِ بشکك ولا حاجة إلى إعادتهاسحشد>».
وهذه الرواية أيضاً تدلّ بوضوح على قاعدة الفراغ والتجاوز في خصوص الصلاة، والجدير بالذكر أنّ المرحوم صاحب الوسائل نقل الرواية بكلمة (كلّما) الدالة على العموم الزماني أي في كلّ زمنٍ شككت بعد إتمام الصلاة لا تعتنِ بشكك، أمّا في تهذيب الأحكام فقد جاءت الرواية بكلمة (كلّ ما) الدالة على العموم الإفرادي أي أنّك إذا شككت بعد الفراغ من الصلاة في أي شيءٍ (سواء في الصحة أم في إتيان جزءٍ من أجزاء الصلاة) فلا تعتنِ.
والصحيح باعتقادي تعبير رواية تهذيب الأحكام لا عبارة وسائل الشيعة.
3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(ع)أنّه قال: (إنّ شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه قد كان قد أتمّ، لم يُعِد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك)[56].
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم[57].
سند الرواية:
(محمد بن علي بن الحسين) هو الشيخ الصدوق من كبار فقهائنا الإمامية، أمّا إسناد المرحوم الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم كما ورد ذلك في مشيخة كتاب الفقيه فهو كالتالي:
الشيخ الصدوق(ع)عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله[58]، عن أبيه[59] عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي[60]، عن أبيه محمد بن خالد[61]، عن العلاء بن رزين[62] عن محمد بن مسلم).
يقع في هذا الطريق أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله وأبوه وهما لم يُوثّقَا في الكتب الرجالية إلاّ أنّنا نعتقد بوثاقتهما نظراً إلى قرائن تدلّ على وثاقتهما وعليه فإنّ هذا الطريق طريق صحيح.
دلالة الرواية:
يقول الإمام(ع)في هذه الرواية: من شكّ بعد الانتهاء من صلاته بأنّه صلّى ثلاث ركعات أم أربعاً وقد كان متيقّناً من تمامية صلاته عند الفراغ منها لم تجب عليه الإعادة لأنّ زمان انصرافه من الصلاة أقرب إلى الواقع من زمان شكّه.
وهذا هو معنى قاعدة الفراغ أي عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الانتهاء من العمل، هذا ولكن في هذه الرواية عبارةً قد تدلّ على عدم ارتباط الرواية بقاعدة الفراغ فلابدّ من التأمل في هذه العبارة التي يقول فيها الإمام(ع)، (وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ...) أي أنّ المصلّي عند انصرافه من الصلاة كان متيقّناً من أنّه قد أتمّ صلاته ثمّ شك بعد مرّة، وبهذا البيان تكون الرواية مرتبطة بقاعدة اليقين والشك الساري حيث أنّ المصلي عند إتمام الصلاة متيقّن من تمامية صلاته ثمّ يحصل له الشكّ في ذلك المتيقّن السابق (تمامية الصلاة) بعد فترة فهنا يُحكم بصحة صلاته طبقاً لقاعدة اليقين فلا تجب الإعادة وعلى هذا فلا دلالة لهذه الرواية على قاعدة الفراغ.
ولکن يمكن حمل الرواية على قاعدة الفراغ بتوجيه بسيط وهو بأن نحمل كلمة (اليقين) على خلاف ظاهر معناها بحيث يقال: إنّ المراد من قوله(ع): (وكان يقينه حين انصرف) أنّ هذا المصلي كان كمن تيقّن بتمامية صلاته وصحّتها لا أنّ هذا المصلي نفسه كان متيقّناً بتمامية صلاته بعد الفراغ منها، وعليه يمكن جعل هذه الرواية دليلاً على قاعدة الفراغ.
والنقطة الأخرى في هذه الرواية أنّه كما نقلنا من كتاب وسائل الشيعة أنّ ابن إدريس أيضاً قد روى هذه الرواية في مستطرفات السرائر من كتاب (محمد بن علي بن محبوب) إلاّ أنّ هناك إشكالاً في سند هذا النقل حيث يقع في سنده (أحمد بن محمد بن يحيى العطار) الذي لم يُوَثَّقْ[63].
4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله(ع): (رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: (يمضي) قلتُ: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: (يمضي) قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: (يمضي) قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: (يمضي على صلاته) ثمّ قال: (يا زرارة إذا خرجتَ من شيءٍ ثمّ دخلت في غيره فشككَ ليس بشيءٍ)[64].
سند الرواية:
لا إشكال في سند هذه الرواية التي تعد من الروايات المعروفة في هذا الباب وتدعى بصحيحة زرارة.
(محمد بن الحسن) هو الشيخ الطوسي وإسناده إلى أحمد بن محمد إسناد صحيح كما سبق تفصيل ذلك.
(أحمد بن محمد بن أبي نصر) يراد به أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أهالي الكوفة ومن ثقات الإمامية وقد التقى بالإمام الرضا(ع)وكانت له مكانة رفيعة عند الإمام(ع)[65].
(حماد بن عيسى) هو حماد بن عيسى الجُهنّي الذي غرق في جحفة وكان من ثقات الإمامية، وقد صرّح بوثاقته الشيخ الطوسي والنجاشي[66].
(حريز بن عبد الله) هو حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي ثقة من أهالي الكوفة[67].
(زرارة بن أعين) غنيّ عن التوصيف وكان من الفقهاء والمتكلّمين في عصره وله شأنه عند الإمام الباقر والإمام الصادق(ع)[68].
ينقل الإمام الخميني(ع)في كتاب الاستصحاب نقلاً عن كتابي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة ذيل الرواية بعبارة (فشككت فليس بشيءٍ) ثمّ يتابع كلامه بأنّ في نسخة (الوافي)[69] ورد التعبير بقوله: (فشككَ ليس بشيء)[70] ولا يضرّ ذلك بالرواية على كلا التعبيرين.
دلالة الرواية:
في هذه الرواية نجد زرارة يسأل من الإمام الصادق(ع)أسئلة عديدة ويجيب عنها الإمام(ع)حيث يذكر فيها خمسة من موارد قاعدة الفراغ ثمّ يبيّن قاعدة كلّية فيها، فقد سأل زرارة من الإمام(ع)حكم المصلي إذا شك في الأذان وهو في الاقامة أو شك في الأذان والاقامة وهو في حالة التكبير أو شك في التكبير وهو منشغل في القراءة في الصلاة أو شك في القراءة وهو في الركوع أو شك في الركوع وهو منشغل بالسجود، والإمام(ع)في كلّ مورد يجيب وجوب المضيّ وعدم الاعتناء بالشك ثمّ يذكر الإمام(ع)قاعدة كلّية بقوله: (يا زرارة إذا خرجت من أي جزء من أجزاء العمل ودخلت في الجزء التالي وشككت في الجزء السابق فلا تعتنِ بشكك ولا ترتبْ عليه أثراً).
ولكلمة (شيء) الواردة في هذه الضابطة الكلّية عمومٌ يشمل جزء العمل فتدلّ الرواية على قاعدة التجاوز كما يشمل كلّ العمل فتدلّ على قاعدة الفراغ.
وممّا يستفاد أيضاً من هذه الرواية هو وجوب الدخول في التالي بعد الفراغ من الأوّل.
توضيح ذلك: أنّ الفقهاء اختلفوا في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في أنّه هل يعتبر الدخول في العمل التالي مضافاً إلى الخروج من العمل الأوّل أو يكفي مجرد الانصراف والفراغ من العمل الأوّل؟ فإن الروايات الثلاث السابقة كانت تدلّ على كفاية مجرد الانصراف والفراغ من العمل، أمّا هذه الرواية فتدلّ على وجوب الدخول في التالي لجريان قاعدة الفراغ والتجاوز فلا يُجزي مجرّد الفراغ والانصراف من العمل.
5 ـ وعنه (الحسين بن سعيد) عن صفوان، عن أبن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)قال: (كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو)[71].
سند الرواية:
(عنه) يراد من الضمير (الحسين بن سعيد)[72] إذا راجعنا إلى تهذيب الأحكام علمنا حيث روى عنه الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ(ع)إليه:
(فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، كلّهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه، وأخبرني به أيضاً أبو الحسين بن أبي جيّد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ورواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد)[73] وهذا الطريق طريق صحيح خالٍ عن إشكال.
(عن صفوان) والمراد صفوان بن يحيى البجلّي وهو من أصحاب الإجماع[74].
(عن ابن بكير) هو عبد الله بن بكير بن أعين أبو علي الشيباني، وهو فطحي المذهب ومع ذلك فإنّه ثقة ومن أصحاب الإجماع[75].
(محمد بن مسلم) وقد سبق ذكره فالرواية موثقة لا إشكال فيها من حيث السند.
دلالة الرواية: هذه الرواية كسابقتها عامة تشمل جميع أبواب الفقه كما أنّها لا اختصاص لها بحين العمل بل تشمل ما بعد العمل، أمّا بالنسبة إلى عبارة هذه الرواية فقد كتبت (كلّما) متّصلة في كتابي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة فتكون ظرفاً زمانياً مع أنّ الصحيح أن تكتب منفصلة على شكل (كلّ ما) ويكون الضمير في (فيه) راجعاً إلى (ما) الموصولة.
6 ـ عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد)[76] عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدْرِ هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال(ع): (إذا شك فليمض في صلاته)[77].
يقع في سند هذه الرواية عبد الله بن الحسن الذي لم يوثّق في كتب الرجال، ومن هنا لا تخلو الرواية من إشكال في سندها.
أمّا معنى الرواية فهو إنّ علي بن جعفر(ع)يروي عن أخيه الإمام الكاظم(ع)في رجل قد ركع وهو لا يعلم هل كبّر أولا؟ أو كان في السجود وشك في ذكر الركوع فهل يعتني بتلك الركعة من الصلاة وسجودها؟ فيجيب الإمام(ع)بأنّه كلّما شك في صلاته لا يعتني بشكه ويبني على أنّه قد أتى بها ولو لاحظنا سؤال الراوي وجواب الإمام(ع)في الرواية تبيّن لنا بوضوح أنّ الرواية ناظرة إلى الشكّ بعد تجاوز محل العمل المشكوك.
ومن هنا يمكن جعل هذه الرواية كدليل من أدلّة قاعدة التجاوز، وعلى هذا فأنّها مختصة بباب الصلاة ولا تعم سائر أبواب الفقه.
7 ـ وعن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله(ع)قال: (إذا شككت في شيءٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيءٍ، إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزْه)[78].
سند الرواية: (وعن المفيد) يعني أن الشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد.
(أحمد بن محمد) يراد به أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو من مشايخ الشيخ المفيد(ع)ثقة جليل القدر[79].
(أبيه) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد فقيه وشيخ القميين، ومن ثقات الشيعة الأجلاء[80].
(سعد بن عبد الله) هو سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي من فقهاء قم وهو ثقة جليل الشأن كثير التصانيف[81].
(أحمد بن محمد بن عيسى) هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من أصحاب الإمام الرضا(ع)ومن ثقات الإمامية وقد قالوا فيه: (أبو جعفر(ع)شيخ القميين ووجههم وفقيههم)[82].
أمّا ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد ذكرت في الروايات السابقة.
(عبدالكريم بن عمرو) يراد به عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي الكوفي يقول فيه النجاشي: (روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ثمّ وقف على أبي الحسن، كان ثقة عيناً يُلَقّب كرّاماً)[83].
ذكره الشيخ الطوسي أيضاً في عداد أصحاب الإمام الكاظم(ع)وقال فيه: (كوفي واقفي خبيث، له كتاب، يروي عن أبي عبد الله(ع))[84] وعليه فقد كان من أجلاء الإمامية وصار واقفي المذهب.
أمّا الروايات التي يرويها مشايخه عنه فأنّها تعود إلى ما قبل صيرورته واقفياً.
(عبد الله بن أبي يعفور) هو عبد الله بن أبي يعفور العبدي قال النجاشي: (ثقة، ثقة، جليل في أصحابنا كريم على أبي عبد الله(ع)ومات في أيّامه، وكان قارئاً يُقرئ في مسجد الكوفة)[85] وقد ذكره الشيخ الطوسي في عداد أصحاب الإمام الصادق[86] .[87]
وعليه فإنّ هذه الرواية موثّقة وذلك لوقوع عبد الكريم بن عمرو الخثعمي في سلسلة سنده.
معنى الرواية: يقول الإمام الصادق في هذه الرواية: إذا شككت في أي فعل من أفعال الوضوء وقد انتقلت إلى غيره فلا اعتبار بشكك والشك المعتبر هو الشكّ في شيء لم تتجاوز عنه.
وفي هذه الرواية عدة نقاط وقع الخلاف فيها، الاولی: ضمير الغائب في قوله(ع): (دخلت في غيره) هل يرجع إلى كلمة (شيءٍ) أو كلمة (الوضوء)؟ الظاهر لأول وهلة أنه يعود إلى (شيءٍ) فيكون المعنى: كلّما شُك في جزءٍ من أفعال الوضوء كغسل الوجه مثلاً وقد انشغل بغيره كغسل اليدين لا يُعتنى بشكه.
النقطة الثانية أنّه ما المراد من قوله(ع): (إذا شككت؟) هل يراد به الشكّ في إتيان الشيء؟ أو الشكّ في صحة الشيء المأتي به؟ أو أن العبارة لها إطلاق يشمل كليهما؟ وسنوضح الجواب عن هذه الأسئلة في الأبحاث القادمة إن شاء الله.