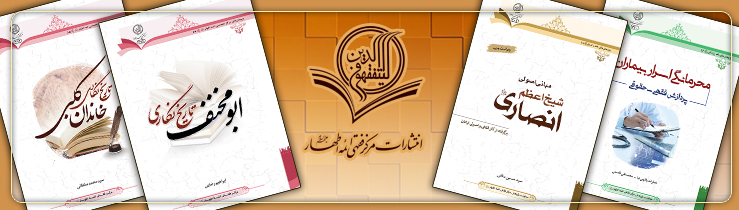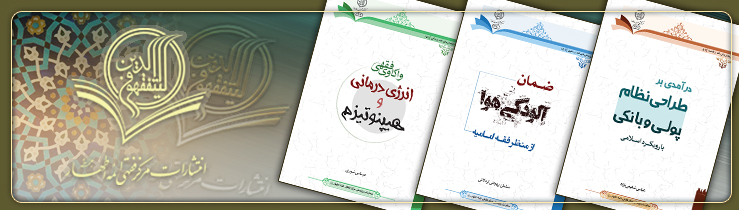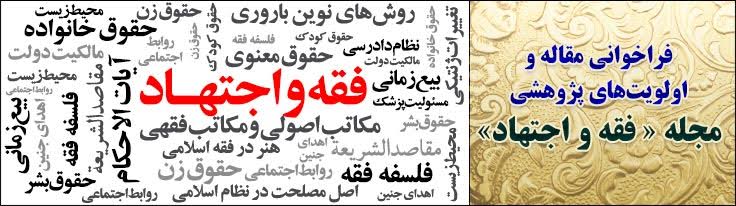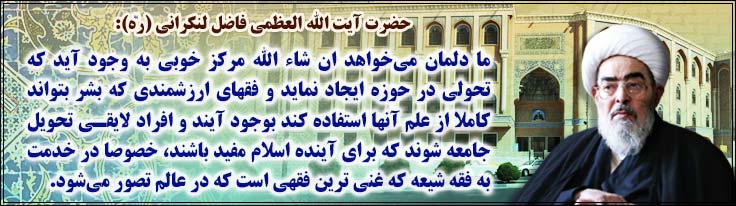(الصفحة313)
الفرع الثالث: حكم النسب مع تحقّق الاستيلاد بغير الجماع
إذا تحقّق الاستيلاد بغير الجماع سواء كان التلقيح على وجه محلّل أو محرّم ففي النسب تفصيل . ولتحقيق الحال في المقام يقع البحث عن أمرين :
أحدهما : ضابط النسب عرفاً والمعيار في الانتساب إلى الأب وإلى الاُمّ وبتبعهما إلى سائر الأقارب .
وثانيهما : الضابط للنسب شرعاً ، وأنّه هل يختلف ضابط الشرع في النسب عن ضابط العرف ، أو أنّ المعيار في النسب الشرعي ما هو المعيار للنسب العرفي ؟
الأمر الأوّل: ضابط النسب عرفاً
الذي يلوح في بادئ النظر هو كفاية الخلق من ماء الرجل في انتساب الولد إليه ، وأنّ المخلوق من نطفة الرجل يعدّ ابناً أو بنتاً له بلا فرق بين تكوّنه في رحم طبيعي أو رحم صناعي; فإنّ التولّد من الرجل باعتبار كون نطفته منشأ للولادة وتكوّن الحمل . وهذا هو القدر المتيقّن من صدق الولادة بالنسبة إلى الأب وصدق الأبوّة .
وأمّا إذا كان التكوّن بسبب غير ماء الرجل ، كما يقال بتكوّن الحمل من بعض خلايا الجسم حيث تزرع في الرحم ، ففي صدق الاُبوّة بمثله إشكال ، بل ربما يمنع من ذلك . والسرّ في ذلك أنّ صدق الألفاظ منوط بوضعها للمعاني ، وحيث لم يكن الاستيلاد بغير النطفة أمراً معهوداً في عصر التشريع ، ولم يكن متصوّراً للناس سابقاً ، فلم يكن للألفاظ وضع بلحاظه .
وليس هناك حكم عقلي بلزوم تولّد الإنسان من أبوين ، ألا ترى أنّه لو زرعت خليّة امرأة في رحمها فأنتجت ولداً لم تكن الاُمّ أباً لولدها ، والسرّ في ذلك أنّ الذكورة شرط في صدق الاُبوّة بحسب المعنى الوضعي .
(الصفحة314)
وبالجملة: بعدما كان الخلق المتعارف بوجه خاصّ ، كان وضع ألفاظ النسب باعتباره ، وأمّا لو تحقّق الخلق بوجه آخر فلا وضع للألفاظ بالنسبة إليه; ولا أقلّ من الشكّ المساوق للجزم بالعدم ، حيث إنّ العرف هو الواضع ، ولا معنى لشكّه فيما هو المنشأ له إلاّ بلحاظ زمان آخر ، وحيث لا يختلف العرف باختلاف الزمان فيكون شكّ العرف في زمان مساوقاً لشكّ العرف الآخر والذي يساوق الجزم بالعدم ، فلاحظ .
إن قلت : تلقيح النطفة في الرحم الصناعي أيضاً لم يكن معهوداً سابقاً ، فكيف تجزم بكفايته في صدق النسب وتحكم بتحقّق المعنى الوضعي في مورده ؟
قلت : الفرق بين زرع الخلية غير النطفة وبين تلقيح النطفة هو أنّ الأوّل من قبيل معنى مباين للموضوع له أو لما هو شرطه ، بخلاف الثاني فإنّ النطفة في الرحم إذا كان كافياً في الانتساب، فإنّ العرف لا يرى تربّي النطفة في الرحم مقوّماً للانتساب بل يعتبر الرحم وعاءً وظرفاً; وعلى هذا الأساس قيل : وإنّما اُمّهات الناس أوعية . وإن كان الحقّ كون الاُمّ زائداً على الوعاء ، مكوّنة للولد في جزئه الآخر ، فإنّ هذه العقيدة ولو خطأ تكفي في تعيين الوضع، والمعنى وإن كان لا ينبغي الوضع كذلك ، ولكنّه حيث كان يتحقّق الوضع بحسبه .
ضابط الاُمومة
أمّا الملاك في انتساب الولد إلى الاُمّ ففي كون الولد مخلوقاً من ماء امرأة كالرجل وإن لم يتربَّ في رحمها ، فلو وقع تلقيح النطفة بماء المرأة خارج رحمها ينتسب الولد إليها كما ينتسب إليه ، أو كون الولد مربّى في رحم وإن لم يكن مخلوقاً من مائها ، فلو لقّحت نطفة رجل بماء امرأة في رحم امرأة اُخرى كان الولد للثانية ، أو كون الملاك مجموع الأمرين ، إشكال .
(الصفحة315)
لا يبعد الأوّل; فإنّ استمرار الجنين في رحم المرأة لايعدّ مقوّماً لصدق التولّد من الشخص ، فهو من قبيل إرضاع الولد بعد الولادة سيما إذا كان نقل الجنين إلى خارج الرحم بعد اكتمال أعضائه أو بعد ولوج الحياة فيه .
وليس انفصال الولد عن الاُمّ دخيلاً في صدق الولد; فلذا يقال: ولدها في بطنها وإن كان يطلق على انفصال الولد أيضاً ، فتأمّل .
وقد يتوهّم أنّ ما سبق من اختصاص الوضع بخصوص المعاني المتصوّرة يقتضي عدم وضع الاُمّ لمثل الفرض المتقدّم ، فيختص الوضع بخصوص الاُمّ التي حملت جنينها دون من تكوّن الولد من مجرّد مائها .
ويردّه : أنّه حيث كان وضع لفظ الاُمّ للتي انعقد الحمل من مائها ، فبمجرّد علوق النطفة في الرحم بماء المرأة تعدّ المرأة اُمّاً والحمل ولداً; أو عند كون الحمل مصوّراً بصورة إنسان يمتاز بها عن سائر الأشياء ، أو عند اكتمال صورته وقبل ولوج الروح فيه ، أو بعد ولوج الروح ، فلا أثر معه لاستمرار الحمل في الرحم .
وكذا لا يتعيّن في الوضع أن يكون مبدأ العلوق في الرحم ، فلو تحقّق ذلك خارج الرحم أيضاً كفى .
شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة
الضابط لعموم الوضع للألفاظ في الموارد الحادثة هو أن لا يكون المورد مبايناًللمعنى الوضعي ، بل كان يعدّ من قبيل مصداق يختلف عن مصداق آخر.
وإن شئت فقل : إنّ الوضع بلحاظ المقارنات للمعنى من قبيل المطلق يستدعي رفض القيود لا جمعها ، لتكون المقارنات الحادثة غير المتصوّرة للواضع القديم مانعاً عن عموم الوضع . ولئن كان الوضع مستدعياً لجمع القيود في اللحاظ فالقيود ملحوظة إجمالاً ، واللحاظ الإجمالي يمكن تعلّقه بالمستحدثات كغيرها .
(الصفحة316)
وكيف كان فذات المعنى لمّا كان أمراً قديماً كفى في صحّة الوضع وإمكانه ، بخلاف ما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ أمراً حادثاً مبايناً للمعنى القديم ، فإنّ الوضع قاصر عنه .
ثمّ إنّا قد أشرنا إلى مفهوم الولد إجمالاً وذكرنا تردّده بين اُمور ، والمتيقّن من موارد صدقه هو فرض انفصاله عن الاُمّ بالولادة ، بل الظاهر ـ كما قدّمناه ـ صدق ذلك بعد الحياة ولو كان بَعدُ في البطن; فلذا يقال: مات ولدها أو طفلها في بطنها .
واحتمال كونه مجازاً من باب التلبّس بالولادة فيما بعد ، بعيد ، بل لا يبعد الصدق قبل ولوج الروح في الجملة .
مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه
إذا تحقّق المفهوم فهو وإلاّ فمع الشكّ يجزم بعدم الوضع كما في كلّ شبهة في المفهوم; والسرّ في ذلك أنّه عند الشكّ في صدق اللفظ في فرض لا بنحو الشبهة الموضوعيّة ، لا يكون هناك وضع للشخص وإلاّ فلا مجال معه للشكّ; لكون الوضع وجدانياً ، حيث إنّ الشخص الشاكّ واحد من أهل العرف فيرى لنفسه من الظهور ما يراه لغيره من أهل عرفه ، فإذا لم يتحقّق له ظهور للفظ فينبغي الجزم بعدم كون اللفظ فعلاً موضوعاً لذاك المعنى .
وإن شئت فقل : إنّ الوضع ليس حكماً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، وإنّما الموضوع للأثر هو تبادر المعنى من اللفظ ، وهو منتف في موارد الشبهات المفهوميّة .
فإن قلت : ما معنى الشكّ في المفهوم مع الجزم بعدم التبادر وعدم الوضع ؟
قلت : لمّا كان المعنى غالباً مرتكزاً بحيث يستحصل بعد التأمّل وإعمال المنبّهات ، فيعرو الشكّ بدواً في المفهوم وإن كان بلحاظ المعنى الارتكازي ، وبعد التأمّل لا شكّ .
(الصفحة317)
ونظير هذا ما يقال في الإشكال على كون التبادر لأهل اللغة دليلاً على الوضع لهم مع أنّ التبادر موقوف على العلم بالوضع ، وإذا توقّف ذلك على التبادر دار; فإنّه يدفع بأنّ الموقوف غير الموقوف عليه حيث يختلفان بالإجمال والتفصيل ، فإنّ العلم بالتفصيل موقوف على التبادر ، وهو موقوف على ذاك الذي عبّرنا عنه بالمعنى الارتكازي .
نعم ، يتصوّر الشكّ في المفهوم في مورد احتمال النقل ، حيث يحتمل أن يكون مفهوم اللفظ في ظرف صدور الأخبار شيء غير ما نفهمه الآن ، وهذا لا يصطلح عليه بالشبهة المفهوميّة ، بل عنوانه في كلماتهم احتمال النقل ، وقد اشتهر بينهم نفيه بالأصل .
كما يتصوّر الشكّ بالنسبة إلى غير أهل المحاورة حيث يتردّد فيما هو المفهوم عندهم ، والمرجع فيه هو العرف لا الأصل العملي . والمفهوم عند العرف ، له تعيّن واقعي لا محالة ولو بالاشتراك .
وبالجملة: لا يكاد يشكّ أهل المحاورة ، فيما هو المفهوم عندهم حتّى لو سلّم الشكّ في الوضع; حيث تقدّم أنّ الوضع لا أثر له ، وإنّما العبرة بالفهم الذي أمره دائر بين النفي والإثبات ، ولا معنى للترديد بينهما لأهل المحاورة .
فقد علم بالذي قدّمناه أنّ إجمال المفهوم لأهل المحاورة فيما هو المفهوم عندهم غير متصور; فإنّه في مثل لفظ اليوم ، فهم ما بين الطلوع والغروب منه معلوم ، وفهم ما زاد على ذلك معلوم العدم لا أنّه غير معلوم; فإنّ مآل الشكّ في سعة مفهوم اليوم إلى عدم كون السعة مفهوماً فعلاً للشاكّ بعد التأمّل ، لا أنّه غير محرز ، مع احتمال كونه مفهوماً; فإنّ الفهم لأهل المحاورة ، أمره دائر بين النفي والإثبات ، فكما لا يعقل كون الواقع مردّداً بينهما ، كذلك الفهم إمّا موجود أو لا وجود له ، ولا يعقل احتمال المحاور لوجوده عنده إلاّ للسفسطي .
(الصفحة318)
وإن شئت فقل : إنّ تفهيم مفهوم ما بين الطلوع والغروب لا يحتاج إلى قرينة في مثل صلِّ في اليوم أو صم اليوم ، أعني ما إذا كان أبعاض اليوم ظرفاً للعمل على البدل أو كان تمام الأبعاض على وجه الاستيعاب ظرفاً ، فيفهم في الأوّل كفاية الصلاة بين حدّي الطلوع والغروب وفي الثاني لزوم الإمساك بينهما; كما ونقطع بعدم فهم ما عدا ما بين الحدّين ، بمعنى أنّ المتكلّم في مقام تفهيم ما عدا ما بين الحدّين ، لايمكن أن يعوّل على هذا اللفظ ، فيتشكّل للّفظ واقع حدّ المعنى ، أي ما يجوز التعويل في تفهيمه على اللفظ بلا قرينة ، سمّيته وضعاً أو لا ، فتأمّل .
ثمرات منع إجمال المفاهيم لأهل المحاورة
تظهر ثمرة ما أسلفناه من عدم تصوّر الإجمال في المفاهيم لأهل المحاورة في موارد مهمّة:
منها : العامّ إذا اتّصل به المخصّص; فإنّهم فصّلوا في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ بين ما اتّصل به والمنفصل عنه ، ونحن حيث أنكرنا الإجمال في المتّصل فضلاً عن غيره كان المرجع ـ في غير موارد ظهور المخصّص فيه ـ هو العامّ حتّى في فرض اتّصال المخصّص به ، دون سائر الأدلّة أو الاُصول العمليّة .
ومنها: ما إذا وقع ما هو المجمل مفهوماً في زعمهم ، شرطاً أو قيداً في الكلام ، فإنّه يفهم منه انتفاء الحكم بانتفائه على زعمنا لا على ما زعموه .
ومنها: مسألة اتّصال الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فإنّهم زعموا سراية الإجمال إلى الكلام بمجرّد أن يشتمل الكلام على ما يصلح قرينة على التصرّف في ظاهره ، فإنّا نقول : إنّ محلّ الكلام هو ما يكون للكلام ظهور في معنى لولا ما يحتمل قرينيّته ، فاتّصال محتمل القرينيّة منشأ اختلال الظهور ، فهذا الذي يحتمل قرينيّته
(الصفحة319)
إمّا أن يصحّ الاعتماد عليه في تفهيم القرينيّة فهو مبيّن لا إجمال فيه ، أو لا يصحّ فهو أيضاً لا يستدعي الإجمال .
ومن جملة تطبيقات البحث هو الحديث الذي نحن بصدد تبيانه ، وهو حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإنّ الجملة الاُولى لو صدرت مستقلّة أفهمت ثبوت النسبة إلى الفراش مع دوران الأمر بين الفراش وغيره من زنا أو وطء شبهة ، معلوم أو مشكوك; ومع الإقتران يفهم منه كون النصّ بصدد بيان الحكم عند الدوران بين الفراش والزنا خاصّة ، كما هو المعروف; ولذا يحكمون في موارد الدوران بين الفراش والشبهة بالقرعة كما قيل ، لا لكون الاقتران من محتمل القرينيّة حتّى يتبجّح به القائل بسراية الإجمال في محتمل القرينيّة ، بل لكون الظاهر من الإلحاق بالفراش هو المنفيّ عن العاهر ، وهذا لا يعقل إلاّ في دوران الأمر بين الفراش والزنا وإلاّ فانتفاء ولد الشبهة ـ لو كان ـ عن العاهر ، سالب بانتفاء الموضوع .
وظنّي ـ والله العالم ـ أنّ جلّ الموارد التي حكموا فيها بسراية الإجمال من محتمل القرينيّة ، كانت القرينيّة ارتكازيّة جزميّة ، كما في هذا المورد فلم تكن ثمرة بين الإجمال وبين ما ندّعيه .
ومن جملة موارد الثمر لما أسلفناه ـ من عدم الإجمال في المفاهيم للألفاظ بالنسبة إلى أهل المحاورة والعرف بحيث يوجب تردّد المعنى ـ هو عدم جواز الرجوع إلى الاُصول العمليّة في مثل ألفاظ الركوع والسجود والصعيد ونحوها ، بل المرجع ما هو نتيجة الاحتياط ، لكن لا بملاكه بل بملاك الدليل الاجتهادي; وذلك فإنّه لو شكّ في تقوّم الركوع بحدّ خاصّ من الانحناء أو تحققه بما دونه ، وكذا لو شكّ في تقوّم السجدة بإلقاء الثقل على المسجد أو تحقّقه بمجرّد المماسّة ، فعلى مسلك القوم ـ المعروف بين المتأخّرين ـ يحكم بالبراءة شأن كلّ الشبهات المفهوميّة ، ولا
(الصفحة320)
يجري استصحاب عدم تحقّق الركوع أو السجود في موارد الشكّ ، لأنّ الاستصحاب لا يجري لتعيين المعاني والأوضاع ، كالشكّ في بقاء اليوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة .
نعم ، لمّا كانت موارد الشبهة المفهوميّة ، من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطي ، حيث يحتمل عدم صدق المفهوم على تقدير الأقلّ مثلاً ، كان الرجوع إلى البراءة فيها مبتنياً على القول بالبراءة في تلك المسألة .
وأمّا على ما حقّقناه فيجب على المكلّف الاحتياط لا للأصل ، بل حتّى على البراءة هناك لابدّ من الاحتياط هنا ، ولكن لا بملاكه بل بملاك الدليل الاجتهادي; فإنّ المفهوم من السجدة لمّا كان هو الوضع وإلقاء الثقل ، وذلك لعدم فهم مجرّد مماسّة الجبهة فعلاً ، والذي نتيجته حصر وضع السجدة لغةً وعرفاً في إلقاء الثقل على المسجد ، فلا ينبغي سقوط الأمر بدون امتثاله والإتيان بمتعلّقه ، فيجب إلقاء الثقل تحقيقاً لإيجاد السجدة لا للشكّ في تحقّق السجدة بدونه; فإنّه بدونه يجزم بعدم تحقّق السجدة ولا يشك .
وهكذا في مثل الصعيد لما كان الشكّ في وضعه لغير التراب مساوقاً لوضعه لخصوص التراب ، تعيّن التيمّم بالتراب لعدم تحقّق امتثال الأمر بدون الاتيان بمتعلّقه . والمسألة بحاجة إلى مزيد تحقيق .
الأمر الثاني: ضابط النسب عند الشارع
نبيّن فيه هل يتّحد اصطلاح الشارع في النسب مع اصطلاح العرفواللغة، أو لا؟
قد اشتهر على ألسنة الفقهاء نفي النسب الشرعي في موارد الزنا ، وأنّ المتولّد من الزنا منفيّ عن أبويه شرعاً وإن كان ولداً عرفاً ولغة .
وليعلم أنّ مجرّد عدم انتساب الولد عن زنا في الشرع لأبويه ، لا يعني أنّ ذلك
(الصفحة321)
اصطلاح خاصّ للشارع; فربما يكون المعنى الشرعي للولد هو المعنى اللغوي والاختلاف بينهما في المصداق نظير اختلافهما في الطهارة والنجاسة ، وعليه فلو كانت طهارة المولد مأخوذةً في صدق النسب عرفاً ، حيث يمكن تخصيصهم لوضع النسب بخصوص ذلك ، فإنّ للعرف نكاحاً وسفاحاً بغضّ النظر عن حكم الشرع ، كان الشارع في استعماله الأنساب تابعاً للعرف وإن اختلف عنه في المصداق وما يعدّ ولد نكاح أو غيره .
ألا ترى أنّ النكاح له معنى عرفي ، وتعيين مصداقه في الشرع في نوع خاصّ لا يعني وضعاً جديداً له شرعاً فكذلك النسب .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعتبر في النسب العرفي طيب الولادة ، بل وضع الأنساب للأعمّ ، فيقع الكلام في تخصيص الشارع للنسب بخصوص موارد طيب الولادة بعنوان الحكومة والذي مآل وضعه إليها ، أوليس للشارع وضع كذلك وإن كان له أحكام خاصّة ببعض موارد النسب العرفي ، كما له أحكام لا تجري في بعض آخر ، من دون تصرّف له في تحديد معنى النسب .
وتظهر الثمرة في موارد عدم الدليل على ثبوت الحكم لعامّة موارد النسب العرفي أو خاصّتها .
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على نقطة، هي أنّه لو فرض نفي النسب شرعاً بين الأب وولده فلا يلازم هذا نفيه بين الولد واُمّه ، فلا ينبغي بمجرّد الدليل على الأوّل الالتزام بالثاني ، كما أنّه لا ملازمة بين نفي النسب في موارد الولادة بالزنا وبين نفيه في موارد التولّد على وجه محرّم آخر كالمساحقة وما شاكلها . فلا تغفل عن هذا المطلب ، فإنّه ينفعك فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
وقبل التعرّض لأدلّة المسألة ينبغي نقل كلمات الفقهاء في المقام لتتّضح الأقوال في المسألة :
(الصفحة322)
كلمات الفقهاء في ضابط النسب شرعاً
قال في موضع من الجواهر ـ عند قول المحقّق في مسألة انتقال النطفة إلى رحم امرأة اُخرى بالمساحقة : «وأمّا لحوق الولد (يعني بصاحب النطفة) فلأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به» : «شرعاً لأنّه الموافق للعرف واللغة; أقصى ما هناك خرج الزاني فيبقى غيره . . . ثمّ قال ـ يعني ماتنه ـ : معرّضاً بما سمعته من ابن إدريس ، يعني قوله : إنّ الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به ؟! وأنكر بعض المتأخّرين ذلك وظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب»(1) .
ثمّ ناقش صاحب الجواهر في مختار المحقّق من لحوق النسب بقوله : «ولكن قد يناقش مع قطع النظر عن النصّ المزبور الجامع لشرائط العمل ، بأنّ ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً; ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة ، وليس هذا منه . وليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً; ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه . والصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان وغيره من الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقّق النسب .
ومن ذلك يظهر الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعاً . كما أنّ من ذلك يظهر لك أنّ المتّجه عدم لحوقه بالصبيّة ـ يعني المساحقة بالفتح ـ وإن لم تكن زانية كما في المسالك ، بل في القواعد: إنّه الأقرب بعد الإشكال فيه»(2) انتهى .
أقول : قوله: «بل المراد منه تحقّق النسب» ظاهره أنّ المراد من النكاح تحقّق النسب به .
- (1) الجواهر 41: 397 .
- (2) نفس المصدر: 398 .
(الصفحة323)
وقال في المواريث ـ عند قول ماتنه : «وأمّا ولد الزنا فلا نسب له» بعد تقييد الزنا بالطرفين ، وفي النسب بأبيه شرعاً ـ : «لأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر» .
وقال في نكاح الجواهر بعد عدّ المحرّمات بالنسب ـ عند قول ماتنه: «فلا يثبت مع الزنا» ـ قال : «النسب إجماعاً بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريته فضلاً عن دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه (فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعاً) على وجه يلحقه الأحكام ، وكذا بالنسبة إلى اُمّه (و) لكن (هل يحرم على الزاني) لو كان بنتاً (والزانية) لو كان ولداً ـ يعني ابناً ذكراً على اللغة العامّية العراقية ، حيث يصطلحون على الذكور من الأولاد بالولد في مقابل البنت ـ ؟ (الوجه أنّه يحرم لأنّه مخلوق من مائه) ومائها فلا ينكح الإنسان بعضه بعضاً كما ورد في بعض النصوص النافية لخلق حوّاء من آدم . (و) أيضاً (هو يسمّى ولداً لغة) والأصل عدم النقل . ومناط التحريم هنا عندنا عليها كما اعترف به في كشف اللثام على وجه يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك ، بل في المسالك: إنّه يظهر من جماعة من علمائنا ، منهم العلاّمة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أنّ التحريم إجماعي ، بل الظاهر اتّفاق المسلمين كافّة على تحريم الولد على اُمّه ، وكأنّه لازم لتحريم البنت على أبيها وإن حكى عن الشافعية عدم تحريمها عليه; نظراً إلى انتفائها شرعاً ، لكنّه كما ترى; ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلّية بعد أن كان مناط التحريم اللغة ـ إلى أن قال ـ : لا ينبغي التأمّل في أنّ مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ، ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي; لانتفاء ما عداه فيه; وهو قاض بعدم ترتّب الأحكام عليه; لأنّ المنفيّ شرعاً كالمنفيّ عقلاً كما أومأ إليه النفي باللعان . فما في القواعد من الإشكال ـ في العتق إن ملك الفرع والأصل ، والشهادة على الأب والقود به وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب ـ في غير محلّه .
(الصفحة324)
وفي كشف اللثام: كالإرث وتحريم زوج البنت على اُمّها والجمع بين الاُختين من الزنا أو إحداهما منه وحبس الأب في دين ابنه إن منع منه ، ثمّ قال : والأولى الاحتياط فيما يتعلّق بالدماء أو النكاح ، وأمّا العتق فالأصل العدم ، مع الشكّ في السبب بل ظهور خلافه . وأصل الشهادة القبول .
قلت : لا ينبغي التأمّل في أنّ المتّجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح ، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه أيضاً في المصاهرات فضلاً عن غير النكاح ، بل قد يتوقّف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه ممّا عرفت .
لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الحلّ من قوّة; بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا ، خصوصاً بعد ظهور اتّحادهما في المناط . ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّه لا وجه لما في المسالك من التردّد في أمثال هذه المسائل كما هو واضح ، انتهى .
وقال ابن إدريس في حدود السرائر ـ في مسألة ما لو وطئ الرجل امرأته فساحقت جارية بكراً فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية ، بعد الإشارة إلى روايتها المتضمّنة لإلحاق الولد بالرجل ـ :
«إلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع; لأنّه غير مولود على فراشهوالرسول (صلى الله عليه وآله) قال: «الولد للفراش» وهذه ليست بفراش للرجل لأنّ الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطء ولا هو من وطئ شبهة بعقد الشبهة»(1) .
وقال في الشرائع في المسألة : «أمّا لحوق الولد فلأنّه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ـ إلى أن قال ـ : وأنكر بعض المتأخّرين ذلك ، فظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب»(2) .
وقال في القواعد في المسألة : «ألحق الولد بالرجل; لأنّه من ماء غير زان . وفي
- (1) سلسلة الينابيع الفقهيّة 23: 240 .
- (2) نفس المصدر 23: 338 .
(الصفحة325)
إلحاقه بالصبيّة إشكال ، أقربه العدم فلا يتوارثان ، ولا يلحق بالكبيرة قطعاً»(1) .
أقول : فرض المساحَقة صبيّة ، مع أنّ المفروض في كلامهم جارية بكر ، والظاهر أنّ المراد به الأمَة أو الاُنثى الشابّة . ثمّ نفيه النسب عن الجارية باعتبار كون استقرار النطفة في رحمها على وجه محرّم .
وقال في المبسوط : «إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستّة أشهر فصاعداً ، لم يلحق نسبه ـ بلا خلاف ـ بالأب . وعندنا لا يلحق باُمّه لحوقاً شرعياً . وعندهم يلحق باُمّه . ولا يحلّ للزاني أن ينكح هذا الولد إن كان بنتاً . وقال قوم منهم : يجوز ذلك على كراهية فيه . وعلى قولنا بتحريم المصاهرة متى ملكها عتقت عليه; لأنّها بنته . فأمّا إذا زنا باُمّه فأتت ببنت فإنّها تحرم عليه بلا خلاف; لأنّها اُخته من اُمّه عند من أجاز في الأوّل»(2) .
وقال في المبسوط : «إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولوداً لقوم ، صارت اُمّه من رضاع ولم يكن الزاني أباه من الرضاع; لأنّ النسب لم يثبت ، فلا يثبت الرضاع . ويقتضي مذهبنا أنّها لا تصير اُمّه; لأنّ نسبه عندنا لايثبت شرعاً من جهتها ولا ترثه بحال .
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا ، لحق باُمّه نسباً عندهم . وعندنا لا يلحق لحوقاً شرعيّاً يتوارثان عليه ، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف ، وعند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتاً وإن كان مكروهاً ، وعند آخرين لا يجوز . ولو ملكه عتق عليه ، وعندنا لا يجوز له أن يتزوّجها غير أنّه لا يعتق عليه; لأنّه لا دليل عليه .
ومن كره تزويجها قال بعضهم : لأنّه يخرج به من الخلاف ، وقال آخرون : لأنّه لا يأمن من أن يكون مخلوقاً من مائه . ولو أخبره الصادق أنّه مخلوق من مائه فإنّها
- (1) نفس المصدر 23: 410 .
- (2) نفس المصدر 38: 188 .
(الصفحة326)
تحرم عليه ، وعلى الأوّل لا تحرم»(1) .
وقال ابن برّاج في جواهره : «إذا ولدت المرأة من زنا وأرضعت بلبنها مولوداً لغيرها ، ما الحكم في ذلك ؟
لم يثبت هاهنا حكم الرضاع; لأنّ النسب إذا لم يثبت ، لم يثبت الرضاع . وهذه المرأة لا تكون أُمّاً للذي ولدته شرعاً ولا يرثه بحال ; وأمّا الزاني فليس أباً له شرعيّاً أيضاً فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه»(2) .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : «والمخلوقة من ماء الرجل من غير عقد صحيح أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه أو شبهة عقد أو وطء ، لم يلتحق نسبها; ويجوز له تملّكها دون التزويج بها والتزويج من بنيها وتزويجه إيّاه بناتها»(3) .
وقال العلاّمة في القواعد : «والنسب يثبت بالنكاح الصحيح والشبهة بدون الزنا ، لكن التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه ، وعلى الولد وطء اُمّه وإن كان منفيّاً عنهما شرعاً . وفي تحريم النظر إشكال . وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها في توابع النسب»(4) .
وقال في جامع المقاصد ذيل كلام القواعد هذا : «لاخلاف بين أهل الإسلام في أنّ النسب الذي هو مناط كثير من الأحكام الشرعية ـ مثل تحريم النكاح ونحوه ـ يثبت بالنكاح الصحيح . والمراد به الوطء المستحقّ شرعاً ، بعقد صحيح أو ملك وإن حرم بعارض كالوطء في الحيض ـ إلى أن قال ـ : ويلحق به وطء الشبهة ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الزنا فلا يثبت به النسب إجماعاً» .
- (1) نفس المصدر 38: 340 .
- (2) نفس المصدر 18: 148 . كذا في نسختي والظاهر: لا ترثه أو لا يرثها بدل «لا يرثه» .
- (3) نفس المصدر : 312 .
- (4) نفس المصدر 19: 594 .
(الصفحة327)
ثمّ تعرّض لتفصيل ما أشار إليه ماتنه من النظر والقود وغيرهما إلى أن قال : «والأصحّ عدم اللحاق في شيء من هذه الأحكام أخذاً بمجامع الاحتياط وتمسّكاً بالأصل حتّى يثبت الناقل»(1) . انتهى .
وقال في الحدائق : «لا خلاف بين العلماء في أنّ النسب يثبت بالنكاح الصحيح ، والمراد به الوطئ المستحقّ شرعاً بعقد صحيح أو تحليل أو ملك وإن حرم لعارض كالوطئ في الحيض . ويلحق به وطئ الشبهة ، والمراد به الوطئ الذي ليس بمستحقّ شرعاً مع ظنّه أنّه مستحقّ . وألحق بوطئ الشبهة وطئ المجنون والنائم ومن في معناه ، والصبي الغير المميّز . ولو اختصّت الشبهة بأحد الطرفين اختصّ به الولد .
وأمّا الوطئ بالزنا فلا يثبت به النسب إجماعاً ، لكن هل يثبت به التحريم الذي هو أحد أحكام النسب؟
المشهور في كلام الأصحاب ذلك ; قالوا: لأنّه من مائه ، فهو يسمّى ولداً لغةً; لأنّ الولد لغة ، حيوان يتولّد من نطفة آخر من نوعه ، والأصل عدم النقل خصوصاً على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية . واستشكله جملة من المتأخّرين ، منهم المحقّق الثاني في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك بأنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغةً ، لزم ثبوت باقي الأحكام المترتّبة على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته وعدم القود من الولد بقتله ونحو ذلك ، وإن كان المعتبر لحوقه شرعاً فاللازم انتفاء الجميع ، فالتفصيل غير واضح .
إلاّ أنّ الظاهر من كلام العلاّمة في التذكرة ـ كما نقل عنه ـ وكذا ولده فخر المحقّقين في شرح القواعد دعوى الإجماع على الحكم المذكور ، وحينئذ فالمعتمد
- (1) جامع المقاصد 12: 190 ـ 192 .
(الصفحة328)
في تخصيص التحريم دون غيره من متفرّعات النسب إنّما هو الإجماع المذكور . ويظهر من المحقّق الثاني في شرح القواعد أنّ عمدة ما تمسّك به في ذلك هو الاحتياط .
أقول : وهو أقوى مستمسك في هذا المقام; إذ لا يخفى أنّ المسألة المذكورة من الشبهات بل من أعظمها . وظاهر العلاّمة في القواعد التوقّف في بعض شقوق المسألة المذكورة والاستشكال فيها ، وهي ما قدّمنا ذكره من جواز النظر وعتقه على القريب ونحوه ممّا تقدّم ذكره ، وما لم يذكر ممّا يتفرّع على النسب . ووجه الإشكال من كونه ولداً لغة ، ومن أنّ الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء إلاّ إلى من ثبت له النسب الشرعي ، وهو هنا مشكوك فيه . ونحوه الانعتاق ، وهكذا في باقي الأفراد المذكورة .
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ـ أيضاً ـ التوقّف وإن كان قد صرّح أوّلاً بأنّ الأقوى عدم ثبوت شيء من أحكام النسب غير التحريم ، إلاّ أنّه قال أخيراً بعد كلام في البين: والإنصاف أنّ القولين موجّهان ، والإجماع حكم آخر .
وغاية ما تمسّك به المحقّق الثاني في نصرة القول المشهور من الفرق بين التحريم وسائر الأحكام المتفرّعة على النسب هو الاحتياط ، قال ما لفظه : والأصحّ عدم الإلحاق في شيء من هذه الأحكام أخذاً بمجامع الاحتياط ، وتمسّكاً بالأصل حتّى يثبت الناقل . ولا ينافي ذلك تحريم النكاح; لأنّه مبنيّ على كمال الاحتياط ، انتهى . وأمّا قوله (عليه السلام) في جملة من الأخبار: وللعاهر الحجر، بمعنى أنّ المتولّد من الزنا لا يلحق بمن تولّد منه فالظاهر أنّه مخصوص بمن تولّد من الزنا على فراش غيره ، كما ينادي به أول الخبر: الولد للفراش ، وحينئذ فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيه بنفي ولا إثبات .
ونقل عن ابن إدريس أنّه علّل التحريم في هذه المسألة بأنّ المتولّد من الزنا
(الصفحة329)
كافر»(1) انتهى كلام البحراني .
أقول : ما ذكره أخيراً من معنى الخبر غريب; فإنّه وإن كان كناية عن نفي النسب عن الزاني ، ولكنّه في مورد يمكن إلحاقه بالفراش ، كما يشهد بذلك تطبيق الحديث في الأحاديث; ولا يمكن إلحاق ولد الزاني بالفراش .
نعم ، مع الشكّ كما هو مورد النصّ لا بأس بإلحاق الولد بالفراش دون الزاني .
وما أبعد ما بين كلامه وكلام من ذكر أنّ الجملتين مستقلّتان كما يأتي نقله إن شاء الله مع ما فيه ، وعلى أساسه أفاد لحوق الولد بالفراش عند وطئ الشبهة وتردّد الولد بين الشبهة والزوج ، فانتظر .
وأمّا ما أفاده من مسألة الاحتياط فإن كان يعني الاحتياط في الشبهة التحريمية كما هو مسلك الأخباري فيردّه: أنّه لا مجال له لا مبنى ولا بناءً :
أمّا الأوّل فلأنّ الحقّ هو الحكم بالبراءة والحلّ في الشبهات .
وأمّا الثاني فلأنّ مورد الاحتياط لو تمّ إنّما هو حيث لا يكون هناك أمارة على الحلّ من عموم وغيره; وآية حلّ النكاح مصحّحة ومبيحة .
ودعوى أنّ الحكم فيها معلّق على غير البنت . فيردّها: أنّه إن كان النسب منفيّاً شرعاً فهو حاكم على الآية ، وإلاّ فلا حاجة إلى أصل الاحتياط .
ودعوى: كون حرمة النكاح لآية {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ}(2) .
ففيها: أنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للزوجيّة .
ودعوى أنّ الأصل في العقود هو الفساد ، فمع أنّه غير أصل الاحتياط ، إنّما يعتمد حيث لا عموم يدلّ على الصحّة .
وممّا ذكرنا علم الإشكال في كلامه (قدس سره) لوكان غرضه من الاحتياط هو الاحتياط
- (1) الحدائق الناضرة 23: 312 ـ 314 .
- (2) سورة المؤمنون الآية 7 .
(الصفحة330)
الخاصّ في الفروج ، على ما يستفاد من كلام الكركي أيضاً . وللكلام ذيل فانتظر .
وقال السيّد الحكيم في نكاح المنهاج: «إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ، ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني .
وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ، ولكن لا إثم عليها في ذلك . وإذا كان الولد اُنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الاُولى دون الثانية; لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل باُمّها»(1) . انتهى .
وخالفه سيّدنا الاُستاذ فأفاد لحوق الولد بصاحب النطفة في الفرض الأوّل والثاني ، وأنّه إذا كان الولد اُنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها .
وقال ابن قدامة في المغني : «ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا واُخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه واُخته من الزنا ، وهو قول عامّة الفقهاء .
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كلّه; لأنّها أجنبيّة منه ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب .
ولنا قول الله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}(2) وهذه بنته ، فإنّها اُنثى مخلوقة من مائه . هذه حقيقة لا تختلف بالحلّ والحرمة ـ إلى أن قال ـ : ولأنّها بضعة منه فلم تحلّ له كبنته من النكاح . وتخلّف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتاً كما لو تخلّف لرقّ أو اختلاف دين»(3) انتهى .
أقول: هذه جملة من كلماتهم ، والذي أظنّ ، أنّ من ذهب من العامّة إلى نفي النسب في الزنا ، اجتهد ذلك من نفي الإرث ، لا أنّه كان له دليل خاصّ على ذلك; كما
- (1) منهاج الصالحين 4: 215 .
- (2) سورة النساء الآية 23 .
- (3) المغني لابن قدامة 7: 485 ، النكاح .
(الصفحة331)
يشهد بذلك كلام ابن قدامة في ردّ القائل بنفي النسب . وأمّا من ذهب من الخاصّة إلى ذلك فقد استند إلى حديث الفراش مشفوعاً بدليل نفي الإرث ، فكان نفي الإرث حاملاً له على استظهار ذلك من حديث الفراش .
أدلّة اختلاف اصطلاح الشارع مع العرف في النسب
الوجه الأوّل : دعوى الإجماع على نفي ولد الزنا شرعاً
ويردّه: قوّة احتمال كون مستندهم في الإفتاء بعض الأخبار التي تأتي إن شاء الله ، ومعه فلا يحصل من الإجماع ظنّ بالحكم فضلاً عن الجزم .
وحيث جرى الحديث عن الإجماع فلا بأس ببيان ما سنح لي أخيراً ممّا يتعلّق بالإجماعات المدّعاة في بعض الكلمات ، من قبيل السيّد المرتضى والشيخ وأمثالهما ، مع كون المسألة مورد اختلاف ، بل اعتراف من مدّعي الإجماع بالاختلاف ، فأقول : حكى لي شيخنا الاُستاذ الوالد (قدس سره) وشيخنا المنتظري عن سيّد مشايخنا البروجردي (قدس سره) أنّ الإجماع في مثل كلام الشيخ ، استدلال إقناعي للمخالفين ، ببيان أنّ الإجماع لا موضوعيّة له عندنا ، وإنّما هو أصل برأسه عند العامّة . وأمّا الشيعة فإنّما يعوّلون على الإجماع حيث نشأ منه الحدس برأي المعصوم ، ومن هنا لا عبرة بإجماع المتأخّرين; لأنّ المنشأ للحدس برأي المعصوم هو إجماع القدماء لو كان ، كما ولا عبرة بالإجماع في المسائل التفريعيّة فضلاً عن الشهرة; لعدم حجّية اجتهاد فقيه لغيره .
(الصفحة332)
وبالجملة : الحجّة هو رأي الإمام ولكنّه كما يستكشف بخبر حجّة أو معلوم مرّة ، كذلك يحدس عبر الإجماع مرّة اُخرى; ولمّا كانت المسألة التي يستدلّ الشيخ فيها بالإجماع ، مشتملة على نصّ من المعصوم وكان الاستدلال بالخبر مثار نزاع وخصام كلامي ، حيث لا يعترف العامّي بحجّية نصوص أئمّتنا (عليهم السلام) ، استبدل الشيخ ذاك الدليل المعتبر عندنا بالإجماع المعتبر عند العامّي وإن كان ملاك الإجماع عنده يختلف عن ملاك الإجماع عندنا ، فحقيقة استدلال الشيخ راجع إلى الاستدلال بمناط الإجماع .
والأمر الذي خطر عندي أخيراً هو أن يكون استدلال مثل الشيخ بالإجماع لغرض الاحتجاج على العامّة لالتزام الشيعي بما يلتزم به من الفتوى ، لا لغرض إلزام العامّة بقبول تلك الفتوى بحيث يستلزم التزام العامّي أيضاً بتلك الفتوى .
والسرّ في ذلك: أنّ إجماع الشيعة بمعنى اتّفاقهم حقيقة لو كان ، لا يكون حجّة عند العامّي ، فضلاً عمّا إذا كان الإجماع عنائياً .
ولمّا كان الإجماع الذي يدّعيه العامّي إجماع طائفة من المسلمين ، وإلاّ فلا سبيل له لدعوى إجماع كلّ المسلمين مع مخالفة الشيعة في الحكم وهم من جملة المسلمين على الأقلّ ، فكانت الحجّة عند العامّي هو إجماع الطائفة ، فإجماع كلّ طائفة من المسلمين يكون حجّة لأنفسهم في زعم العامّي; فلذا جاز للشيعي التمسّك بإجماع الشيعة فيما يذهب إليه .
وهناك توجيه آخر لمثل هذه الإجماعات ، وحاصله: كون هذه إجماعات على القاعدة ، بمعنى أنّ المسألة لمّا كانت بنظر الشيخ أو غيره موضوعاً لمثل أصل البراءة وكانت تلك الأصل في موضوعها مورداً للإجماع ، اُدّعى الإجماع على حكم المسألة وإن لم يكن انطباق موضوع الأصل المذكور على المورد إجماعيّاً .
(الصفحة333)
وقد حكى لي بعض السادة بعض عبائر الشيخ في الخلاف ممّا تنادي بذلك(1) ، حيث استدلّ الشيخ (قدس سره) ببعض الأخبار ثمّ فرّع على ذلك دعوى الإجماع بقوله: فدلّ ذلك على إجماعهم .
وببالي دعوى السيّد المرتضى الإجماع في الانتصار على الحكم في مسألة صرّح بالخلاف فيها بيننا; استناداً إلى أنّ مستند ما ارتضاه وهو أصل البراءة مجمع عليه ، إلاّ أنّي لم أعثر عليه فعلاً .
الوجه الثاني : الحديث المشهور بين الفريقين: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقد رواه العامّة فضلاً عن الخاصّة . والظاهر تواتر الحديث .
ودعوى الجزم بصدوره عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وكذا عن الأئمّة (عليهم السلام) غير مجازفة .
ولنعم ما ذكره بعض السادة من أنّ معاوية لمّا نسب زياداً لغير أبيه وادّعى اُخوّته ، وكانت هذه النسبة على خلاف ما يقتضيه الفراش ، وكان هذا العمل بمرأى من الصحابة ممّن سمع أو روى حديث الفراش ، أوجب ذلك الطعن عليه بذلك على الملأ ، فصار ذلك سبباً لاشتهار هذا الحديث وبلوغه في النقل حدّ التواتر ، كما وطعن على معاوية بمحاربته أمير المؤمنين (عليه السلام) وقتله لعمّار ونصبه يزيداً خليفة بعده .
وبالجملة: لا ينبغي الترديد في صدور الخبر ـ الذي بركاته في حفظ الأنساب والنظام الاجتماعي والعائلي عن الاختلافات والشبهات المهلكة ، غير خافية على أهل البصائر ـ ولولاه لما قام لكثير من الأنساب عمود ولا اخضرّ لها عود .
وكيف كان فمن جملة موارد نقل الحديث في طرقنا هو :
- (1) هو آية الله السيّد موسى الزنجاني ، حيث يستدلّ الشيخ أوّلاً بالنصّ ثمّ يفرع على ذلك إجماع فقهائنا; ومن جملة الموارد ما في كتاب الخلاف 2: 250 ، الحجّ ، المسألة 8 في وجوب الحجّ بمال الابن قال: «دليلنا الأخبار المرويّة في هذا المعنى من جهة الخاصّة وليس فيها ما يخالفها تدلّ على إجماعهم على ذلك» .
(الصفحة334)
صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته»(1) .
وقد رواه الكليني بسند آخر عن علي بن أبي حمزة أيضاً .
ورواه الشيخ والكليني أيضاً بسند آخر عن يحيى(2) .
ورواه الشيخ بإسناد آخر عن أبي بصير وزيد الشحّام(3) .
وبالجملة: فالقطع بصدور خصوص هذا الحديث عن أبي عبدالله (عليه السلام) فضلاً عن سائر الموارد غير مجازف .
وكأنّ الحكم بنفي الإرث مبنيّ على عدم ثبوت النسب بالدعوى في مقابل الفراش وهو الذي تضمّنه صدر الخبر ، ثمّ حكم في الذيل بنفي إرث الوالد من زنا ولده ، فهو حكم على تقدير ثبوت النسب فلا إرث على التقديرين ; فالنفي إضافي أعني ناظر إلى الوالد . و«يورث» مبنيّ للمجهول ، والمعنى أنّه لا يرث من ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته فيرث من ابنه; والاستثناء كأنّه منقطع فإن ابن الوليدة لا يكون من زنا ، فتأمّل .
فقه حديث «الولد للفراش . . .»
إنّ معنى «الولد للفراش» هو أنّه ينتسب للفراش ، والفراش بمعنى ما يفترش لنوم وغيره ، وكأنّه كناية عن المضاجعة المشروعة ، إمّا بإطلاق الفراش على الرجل أو بتقدير مثل صاحب ليكون المعنى: الولد لصاحب الفراش في مقابل من لا
- (1) الوسائل 17: 566 ، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 4 .
(الصفحة335)
حقّ له في افتراش المرأة أو النوم معها في فراش واحد ، كناية عن من يحلّ له الوطء .
قاعدة الفراش أمارة أو حكم ثبوتي؟
إنّ انتساب الولد للفراش ، إمّا يراد به أنّه عند الشكّ في ذلك واحتمال كون الولد ناتجاً من وجه آخر غير الفراش والزوج ، يلحق الولد بالفراش ، فهذا هو القدر المتيقّن من الرواية; بقرينة موارد تطبيقها في الأخبار عند الفريقين ، ومعه لا وجه للاستدلال بالخبر على ما هو محلّ البحث من اشتراط النسب شرعاً بعدم كون الولد حاصلاً من زنا .
وقد يراد منه حصر انتساب الولد إلى الفراش حتّى أنّه لو كان متولّداً من غيره بنحو الجزم ، لم ينتسب لا إلى الزاني; لحكم الشارع بنفي النسب ، ولا إلى الفراش ; لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع . وكأنّ هذا المعنى هو الذي فهمه الأصحاب من هذا الحديث أو من غيره; وعليه يبتني الاستدلال به للمدّعى الذي هو المعروف بين الفقهاء .
غير أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الحديث أو غير ظاهر منه على الأقلّ; لاستلزام إرداته كون الحديث متضمّناً لحكمين: ظاهري عند الشكّ في الزنا ، وواقعي عند الجزم بكون الولد من زنا . وهذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو بحكمه في كونه خلاف الظاهر على الأقلّ لو جاز ـ ولو هنا ـ بدعوى أنّه من الإطلاق لا المعنى المتعدّد .
فهو نظير الاستدلال برواية «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» لقاعدتي الطهارة واستصحابها; وبرواية «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام» لقاعدتي الحلّ واستصحابه .
(الصفحة336)
إلاّ أن يقال بأنّ هذا ليس من استعمال اللفظ في معنى متعدّد ، بل المعنى واحد جامع ، وهو أنّ الولد لا ينتسب إلى غير الفراش ، لا مع احتمال تكوّنه من غير الفراش ولا في مورد الجزم بخلقه من غير الفراش ، وهذا معنى الإطلاق .
ولكن يردّه ـ مع تسليمه في نفسه ـ ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أدلّة لحوق الولد المخلوق من الزنا بوالده وإن لم يحكم بالتوارث بينهما .
وأمّا قوله : «للعاهر الحجر» فالعاهر بمعنى الزاني ، والحجر إمّا بالتحريك أو بسكون الثاني بمعنى المنع; وعلى التقديرين فهو كناية عن عدم لحوق الولد به .
وربّما قيل: إنّ له الحجر ، بمعنى أنّه يرجم .
ويردّ بأنّ الرجم خاصّ ببعض موارد الزنا ، فلو كان الحجر محرّكاً لكان كناية لا حكماً بالرجم ، نظير ما يقال : له التراب ، أو في فيه التراب ، كناية عن أنّه لا شيء له .
لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين الزنا
إنّه على كلا التقديرين من كون صدر الحديث ناظراً إلى مقام الإثبات أو الأعمّ منه ومن مقام الثبوت ، قد يكون التردّد بين الفراش والزنا ، فهذا هو المتيقّن من الحديث ، بمعنى إنّه لو دار الولد بين تكوّنه من الفراش أو خلقه من ماء الزاني ، يلحق بصاحب الفراش . هذا بلحاظ مقام الإثبات . وبلحاظ مقام الثبوت إذا كان منشأ خلق الولد ماء الزاني فلا يحكم بالنسب كما ويحكم بالنسب في مورد الفراش .حكم لحوق الولد بالفراش مع التردّد بينه وبين لحوقه بوطء الشبهة
وقد يكون التردّد بين الفراش وغير الزنا كوطئ الشبهة ، ففي أماريّة الفراش بلحاظ نفي الإلحاق بوطئ الشبهة الواقع أو المحتمل وقوعه ، هذا بحسب
(الصفحة337)
مقام الإثبات ، وكذا بلحاظ مقام الثبوت ، هل الحديث ناظر إلى كون لحوق الولد منحصراً في الفراش حتّى بلحاظ مثل وطء الشبهة ، فلا يلحق الولد عند خلق الولد من ماء الشبهة جزماً ، كما لا يلحق في زعم المشهور عند خلقه من ماء الزنا .
وبالجملة: فهل أنّ حصر الولد بالفراش في مقامي الثبوت والإثبات ، هو بلحاظ ما ذكر في ذيل الحديث من الزنا ، وأمّا بلحاظ غيره فلا ينحصر النسب ثبوتاً وإثباتاً في الفراش؟ فيه كلام.
صرّح السيّد البجنوردي ـ بعد اختياره كون قاعدة الفراش أمارة لا حكماً بلحاظ الثبوت ـ بعدم اختصاص الحصر في مقابل الزنا ، فلو دار الأمر بين الفراش والشبهة لحق الولد بالفراش ، وادّعى لذلك بأنّ صدر الحديث من قوله (عليه السلام) : «الولد للفراش» جملة مستقلّة لا ربط لمعناها بذيل الحديث ، وإنّما ذكر الذيل بلحاظ كون مورد تطبيق الحديث كان التردّد بين الفراش والزنا ، وإلاّ فالقاعدة المستفادة من الحديث هو أنّه متى ما دار انتساب الولد بالفراش وإلى غيره ، لحق بالفراش بلا فرق بين كون الغير هو زنا أو وطىء شبهة ، قال : وإن كان ظاهر الفقهاء خلافه ، وأنّه عند دوران الأمر بين الفراش ووطئ الشبهة يحكم بالقرعة .
أقول : ما أبعد هذا عمّا تقدّم نقله من الحدائق من أنّ معنى «وللعاهر الحجر» هو أنّ المتولّد من الزنا لا يلحق بمن تولّد منه ، وأنّه مخصوص بمن تولّد من الزنا على فراش غيره ، فلا يدلّ الخبر على نفي الولد عن الزاني حيث لا فراش في البين ، وقد تقدّم الإشكال عليه سابقاً .
وكيف كان فما أفاده السيّد البجنوردي (قدس سره) مجرّد دعوى لم يستشهد عليها بشاهد وبيّنة ، فإنّ الحديث من موارد اقتران الكلام بما يصلح للقرينيّة في اصطلاحهم ممّا يمنع على الأقلّ من انعقاد ظهور الكلام في العموم .
(الصفحة338)
قاعدة الفراش عند وطء الشبهة والزنا
يمكن الاستشهاد لعموم قاعدة الفراش لما إذا دار الأمر بين الفراش وبين غيره ، زنا كان أو شبهة ، ببعض الأخبار التي استشهد فيها بهذه القاعدة ممّا لا يحتمل في موردها الزنا أو لا يتعيّن .
وهي معتبرة أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول ـ وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال ـ : «بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود» قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(1) .
ونحوه في النقل الآخر إلاّ أنّه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «الولد للذي عنده الجارية وليصبر; لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر»(2) .
وربما يؤيّده على تأمّل إطلاق معتبرة سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : «للذي عنده; لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر»(3) .
ويدلّ عليه أيضاً صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : «للذي هي عنده فليصبر; لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر»(4) .
- (1) الوسائل 14: 568 ، الباب 58 من نكاح العبيد ، الحديث 2 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (4) نفس المصدر ، الحديث 7 .
(الصفحة339)
نعم ، ربّما ينافي هذه الأخبار معتبرة أبي بصير وسليمان بن خالد ممّا تضمن التعيين بالقرعة .
ففي الاُولى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدِّثنا بأعجب ما ورد عليك ، قال : يارسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه ، كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّوجلّ إلاّ خرج سهم المحقّ»(1) .
وفي الثانية: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى بدت نواجده قال : وقال: ما أعلم فيه شيئاً إلاّ ما قضى عليّ (عليه السلام) »(2) .
والظاهر أنّهما قضيّتان . وكيف كان فقد يدّعى التنافي بين الخبرين وبين ما تقدّم .
ويردّه أنّ مورد ما تقدّم هو تعاقب الأيدي على الجارية من الواطئين; ومورد هذين الخبرين هو كون الواطئين كلّهم ملاك للجارية بالشركة ، فقوله : «تبايعوا جارية» يعني اشتروها جميعاً بالشركة كما يؤكّده تضمين الإمام (عليه السلام) نصيب غير من خرجت القرعة باسمه .
نعم ، يستفاد من هذه الطائفة أنّ الفراش هو أعمّ من يد الشركة ، وأنّه متحقّق ولو مع عدم جواز الوطء للشركة ، ولكون الموطوءة ممّن يجب استبراؤها .
- (1) نفس المصدر ، الباب 57 ، الحديث 4 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 2 .
(الصفحة340)
بخلاف الطائفة الاُخرى ، فإنّها لا تنافي اشتراط حلّ الوطء في تحقّق الفراش ، فإنّ موردها الشراء ، وربّما لا يجب الاستبراء على المشتري عند احتمال استبراء البائع وإن كان ظاهر الفتوى والنصّ وجوبه إلاّ في موارد .
وكيف كان ففي الطائفة الاُخرى كفاية في الدلالة .
فقد تحقّق ممّا أسلفناه أنّه ليس للشارع اصطلاح في ناحية النسب ، وإنّما قصارى ما في الباب هو تخصيص بعض أحكام النسب كالإرث بغير مورد تحقّق الانتساب بالزنا ، وهو مؤكّد لأصل النسب وإلاّ لم يكن تخصيصاً في تلك الأدلّة أيضاً .
الوجه الثالث: ثمّ إنّه قد يستدلّ بوجه آخر لنفي النسب في موارد الزنا ، وذلك بتقريب أنّه بعد ثبوت نفي الإرث في مورده ، يدور الأمر بين كون ذلك تخصيصاً في دليل الإرث أو تخصّصاً فيه ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص ، فأصالة العموم تنفي التخصيص ، ونتيجة ذلك هو نفي النسب في موارد الزنا وإلاّ فمع ثبوته لا مناص من التخصيص في حكم الإرث .
ويردّه ـ مضافاً إلى أنّ الاُصول العقلائيّة إنّما تجري لإحراز المقاصد لا لإثبات كيفيّة الاستعمالات بعد العلم بالمراد; وفيما نحن فيه عدم الإرث محقّق ، وإنّما الشكّ في كونه على وجه التخصيص أو غيره ، ولا أصل يقتضي تعيينه على أحد النحوين ـ أنّه يدور الأمر فيما نحن فيه بين التخصيص وبين الحكومة .
إلاّ أن يقال : إنّ ملاك نفي التخصيص عند الدوران بينه وبين التخصّص ، موجود في هذا الفرض أيضاً ، والعمدة ما قدّمناه من عدم جريان مثل الاُصول اللفظية بعد إحراز المقاصد .
الوجه الرابع: وقد يستدلّ لنفي النسب في الزنا بوجه آخر ، وهو رواية العلل المتضمّنة لتعليل التغليظ في شهادة الزنا; بأنّ فيه قتل نفسه وفيه ذهاب نسب ولده ،
(الصفحة341)
ولفساد الميراث ، بناءً على أنّ المراد أنّ الشهادة على الزنا يستلزم القتل وذهاب نسب ولد الزاني ، بحيث لولا الشهادة كان الولد منسوباً إلى الرجل ، ولكن بسبب الشهادة على كون ولده للزنا تبطل النسبة ، وسيأتي الخبر في حكم الأنساب عند التعرّض لمسألة تلقيح المرأة بماء الأجنبي .
ويردّه ـ مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان على الأقلّ ـ أنّ مرجع الضمير في الظرف هو نفس الزنا ، واستلزام الزنا لذهاب النسب موضّح في بعض الأخبار بجهالة النسب وأنّ الولد لا يعرف أباه ، لا أنّ الزنا يستلزم حكم الشارع بنفي النسب .
ثمّ إنّه تحقّق ممّا ذكرناه أنّ العبرة بالنسب إنّما هو بالمعنى اللغوي والعرفي له ، وأنّه لا دليل على نفي النسب في موارد الزنا فضلاً عمّا إذا تولّد الولد على وجه محرّم آخر ، مثل تلقيح المرأة بماء أجنبي بغير الوطء; بناءً على حرمة ذلك استناداً إلى حديث: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أفرغ ماءه في رحم امرأة تحرم عليه» وغيره ، وسنتعرّض لذلك إن شاء الله تعالى .
أدلّة موافقة الشارع للعرف في النسب
وممّا يؤكّد ما ذكرناه ـ بعد عدم تماميّة دليل المشهور لنفي النسب في الزنا ـ أمران :
الأوّل : عموم أدلّة الأحكام المترتّبة على موضوع الأنساب; فإنّ الأنساب فيها منزلة على العرف كسائر الألفاظ المستعملة في كلام الشارع حيث لم يثبت اصطلاح خاصّ فيها .
الثاني : عدّة من الروايات حكم فيها بإلحاق ولد الزنا بأبيه :
منها: رواية ابن إسحاق المديني عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال : «أيما ولد زنا ولد
(الصفحة342)
في الجاهلية فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام»(1) .
وما في الوسائل ـ من حمله على عدم تحقّق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدّعى أو على كونه ولد من أَمَة وادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه ـ خلاف الظاهر .
ومنها: معتبرة حنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه ؟ قال : «نعم»(2) .
ومعتبرته الاُخرى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات ولم يَدَع وارثاً ، قال : فقال : «يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة» قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً، ثمّ مات النصراني وترك مالاً لمن يكون ميراثه ؟ قال : «يكون ميراثه لابنه من المسلمة»(3) .
وعن الشيخ أنّ الوجه فيه هو إقراره بالولد ، وهو كما ترى سيما في الأخيرة .
ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد ، أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة»(4) .
ويؤكّد ذلك: ما في جملة من الأخبار جمعها صاحب الوسائل في الباب 57 من نكاح العبيد ، ومضمونها: أنّ الشركاء أو غيرهم إذا جامعوا امرأة في طهر واحد ، أقرع بينهم في إلحاق الولد .
ومنها: ما ورد في المساحقة وهو صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يقولان:
- (1) الوسائل 17: 568 ، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 5 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 7 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 8 .
- (4) نفس المصدر: 571 ، الباب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 .
(الصفحة343)
«بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال: وما هي؟ تخبرونا بها ، قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها ، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟
فقال الحسن (عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول ، فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة; لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة; لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ» الحديث .
وفيه أنّه لمّا أخبروا عليّاً (عليه السلام) بما جرى قال: «لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»(1) .
وفي رواية عمرو بن عثمان للقضية نحو ما تقدّم وفيه: «ويلحق الولد بصاحب النطفة»(2) .
وفي رواية إسحاق بن عمّار في حكم المسألة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «ويلحق الولد بأبيه» وفي روايته الاُخرى: «الولد للرجل»(3) .
ومنها: ما ورد في تعليل حرمة الزنا بأنّ فيه ذهاب الأنساب ، موضّحاً له بأنّ المرأة لا تعلم مَن أحبلها والولد لم يعرف من أبوه ، فقد قرّرت أبوّة الزاني إلاّ أنّه لمكان كون الزناعرضة لتعدّدالزانيوجهالة من تولّد الولد من مائه ، حرم ، فتأمّل(4) .
- (1) الوسائل 18: 426 ، الباب 3 من حدّ السحق ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 2 و 4 .
- (4) وجهه ـ مضافاً إلى كونه مجرّد استعمال أعمّ من الحقيقة ، وأنّ المراد فيه معلوم ـ أنّ الاُبوّة المفروضة هي بغضّ النظر عن حرمة الزنا ، وانتفاء النسب إنّما هو بعد التحريم .
(الصفحة344)
ومنه يعلم المراد من تعليل حرمة الزنا بأنّ فيه انقطاع الأنساب ، وأنّه ليس المراد الانقطاع تعبّداً بل الانقطاع بسبب الجهالة .
وممّا يؤكّد ثبوت النسب في ولد الزنا قضيّة إلحاق معاوية زياداً بأبي سفيان; وإنّما اعتبر ذلك من مثالبه من حيث إثبات النسب مع عدم الفراش الذي هو الحجّة على النسب، وقد كان ادّعى زياداً عدّة رجال كلّهم واقعوا اُمّه في زمان واحد ، فادّعى معاوية نسباً لا حجّة عليه بل كان الحجّة على خلافه، حيث كانت أُمّ زياد فراشاً لبعض، ولو كان النسب شرعاً متقوّماً واقعاً بالفراش لكان الردّ على معاوية بذلك أولى، فلاحظ.
ضابط الاُمومة
والذي يتراءى من صدق الاُمومة هو كون العبرة فيها بتكوّن الولد من مائها كماء الرجل ، ولا عبرة بترعرع الطفل والجنين في رحمها وأحشائها ، فلو علقت نطفة الرجل بماء المرأة في رحم امرأة اُخرى ، كانت الاُمّ هي الأولى دون من تربّى الجنين في رحمها .
إلاّ أنّ المنسوب إلى سيّدنا الأستاذ (قدس سره) ـ فيما حكي عنه في جملة أجوبة من المسائل ـ أنّ الاُمّ هي المرأة التي تربّى الجنين في رحمها دون التي أُخذ ماؤها وعلقت النطفة به; مستشهداً لذلك بما في قوله في آية الظهار : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ
(الصفحة345)
الاَّئِى وَلَدْنَهُمْ}(1) .
بدعوى أنّ المستفاد من ذيل الآية حصرُ الاُمومة بالتي تلد; وحيث إنّ الوالدة هي من ربّته الرحم فهي الاُمّ . وقد تبعه في ذلك بعض مشايخنا المعاصرين .
ولا أدري أنّ غرضه (قدس سره) هل هو كون الاُمومة بهذا المعنى اصطلاحاً شرعيّاً؟ أو أنّ الاُمومة بهذا المعنى اصطلاح عرفي ، يؤكّده ما تضمّنته آية الظهار .
وكيف كان فينبغي أن يعدّ هذا من الغرائب ، وذلك:
أوّلاً : لأنّ الآية إنّما هي بصدد نفي كون الزوجة التي وقع الظهار بها اُمّاً; لعدم كونها والدة ، فحصر الوالدة فيما ذكر في الآية إنّما هو بالإضافة إلى الأزواج وإلاّ فليست الآية بصدد بيان حدّ الاُمومة .
وثانياً : منع كون الولادة منسوبة إلى صاحب الرحم المربّية ، بل كما يكون التولّد من الأب باعتبار نطفته كذلك يكون التولّد من الاُمّ باعتبار مائها ونطفتها .
فالوالدة للطفل هو الذي انفصل الطفل عنها باعتبار كون الماء المكوّن للطفل مأخوذاً منها ، وإلاّ فشأن الرحم ـ بغضّ النظر عن ذاك الماء ـ شأن الأنابيب الطبّية التي تربّى النطف بعد تلقيح البويضات بها فيها ، فهل ترى أنّ تلك الأنابيب يعبّر عنها بالاُمّ؟! أو أنّ الأطفال الذين تربّوا في مثلها لا اُمّ لهم؟! وهذا من جملة النقض على سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) فيما نسب إليه .
ثمّ إنّه قد يؤكّد انتساب الولد إلى الاُمّ التي اُخذ ماؤها للتلقيح ، بما ورد في قوله تعالى في بيان مبدأ تكوّن الإنسان : {إِنَّا خَلَقْنَا الاِْنسَانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ}(2) ، وقوله تعالى : {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}(3) .
- (1) سورة المجادلة الآية 2 .
- (2) سورة الإنسان الآية 2 .
- (3) سورة الطارق الآية 7 .
(الصفحة346)
ويردّه أنّه لا شبهة في كون منشأ الولد هو نطفة الرجل والمرأة ، ولكن الشأن في إثبات أنّ كلّ ما ينشأ منه الولد فهو أب واُمّ ، وإلاّ فالنباتات والمأكولات بل التراب هو منشأ خلق الإنسان كما صرّح بذلك في القرآن الكريم ، فهل يتوهّم استلزامه لنسبة الولادة عرفاً إليها على وجه الحقيقة ؟!
نعم ، ربّما يطلق بنحو من العناية والمجاز الاُمّ على الأصل لكلّ شيء ، ولكنّه ليس على وجه الحقيقة بلا ريب .
هذا ، مضافاً إلى احتمال كون الآية بصدد منشأية نطفة الرجل للولادة وأنّها الأصل ، واحتمال كون دخل ماء المرأة من قبيل دخل الرحم ، وإن كنّا لا ننكر انفعال النطفة من صفات المرأة ، ولكنّه لا يستلزم تركّب الجنين من المائين; كعدم تركّبه مع الرحم ، فماؤها من قبيل لبنها في توريث الصفات من دون دخل في التركيب على حدّ دخل ماء الرجل .
نعم ، في قوله تعالى : {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنثَى}(1) دلالة على منشأية ماء المرأة أيضاً ولو كان المراد خصوص آدم وحوّاء فضلاً عمّا إذا كان المراد كلّ ذكر واُنثى ، ولكن يمكن أن يكون المراد النشوء غير النشوء من نطفة الرجل ، ممّا يتحقّق بمجرّد الظرفية الأوّلية للاُنثى في مبدأ الخلقة ، فتأمّل .
انتشار الحرمة والمحرميّة بين الولد وبين الحامل له مع كون النطفة من غيرها
إنّ هنا كلاماً لا بأس بالتعرّض له استطراداً; لشدّة مناسبته بالمقام ، وبيانه: أنّه بعدما تحقّق نفي النسبة بين الجنين وبين الاُمّ المستأجرة لحملها ، فهل تعتبر هذه
- (1) سورة الحجرات الآية 13 .
(الصفحة347)
المرأة ـ بعد نفي الاُمومة ـ أجنبيّة عنه بالمرّة كسائر الأجانب ، يجوز للحمل لو كان ذكراً أن يتزوّج بها فضلاً عن اُمّها وبناتها وسائر النساء المحرّمات على ولد المرأة حقيقة ؟!
ربما ذهب بعضهم إلى انتشار الحرمة بين الطفل وبين الاُمّ المستأجرة ، كما في موارد الرضاع ممّا لا نسبة حقيقة ولكن يحكم بالحرمة للرضاع ، وفيما نحن فيه يحكم بالحرمة أيضاً مع عدم النسبة .
وربما احتاط بعضهم في الفتوى فحكم بالتجنّب احتياطاً عن الاُمّ المكوّنة لنطفته وعن الاُمّ الحامل له .
أمّاالوجه في هذا الاحتياط فهو التردّد في صدق الاُمّ على إحداهما ، ولكن يعلم إجمالاً بحرمة إحداهما لكونها الاُمّ ، فيجب الاحتياط كما في كلّ علم إجمالي منجّز .
ولكن يردّه أنّه لو كان ملاك التجنّب هو العلم الإجمالي لكان تنجّز التكليف منوطاً بشرائط منجّزية العلم ، فلو انعدمت أو بعضها كما لو ماتت إحدى الاُمّين قبل بلوغ الطفل فلا أثر للعلم الإجمالي .
ويمكن توجيه الاحتياط هذا ـ بغضّ النظر عن العلم الإجمالي ـ بأنّ صحّة النكاح كسائر المعاملات بحاجة إلى دليل ، وبدونه فالأصل هو الفساد ، وحيث إنّ دليل صحّة النكاح قد رخّص في نكاح ما عدا المحرّمات التي منها الاُمّ ، لم يمكن الحكم بصحّة نكاح المشكوك كونها اُمّاً بشبهة مفهومية كما في المقام ، كما لا يصحّ التمسّك في الشبهات الموضوعيّة . وأمّا الدليل على الصحّة في الموضوعات المشتبهة هو الأصل الموضوعي .
نعم ، لو كان هناك عموم دالّ على صحّة النكاح ، غير مقترن بالمقيّد المشتبه ، كعموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) على ما هو زعم الفقهاء في التمسّك بها لتصحيح
- (1) سورة المائدة الآية 1 .
(الصفحة348)
العقود فضلاً عن لزومها ـ وإن كان لا أدري تمسّكهم به في النكاح ـ أمكن التمسّك به لصحّة النكاح في موارد الشبهة المفهومية إذا لم يكن مانع العلم الإجمالي .
بل يمكن عدم صحّة التمسّك بمثل هذا العموم أيضاً ، لا لكون المقيّد المجمل مفهوماً والمنفصل كالمتّصل في سراية الإجمال ، بل لأنّ حرمة التزوّج بالاُمّ من مسلّمات الدين ممّا يعد كالقرينة المتّصلة والموجب إجمالها; لإجمال أصل الكلام .
هذا بناءً على ما هو المعروف من تحقّق الشبهة المفهومية في الألفاظ ، وأمّا بناءً على ما تقدّم من عدم تصوّر ذلك لأهل اللغة ، حيث إنّ الشكّ في الوضع يساوق الجزم بعدمه ، فلا موضوع لهذا البحث .
هذا ، مع أنّه ربّما يمنع من وجود اُمّ للطفل المفروض ، لاحتمال تقوّم الاُمومة لولا ما استظهرناه ، بمجموع أمرين: التكوّن من مائها والحمل له ، أو لا أقلّ من عدم حمل أجنبيّة له; فإنّ الشكّ في اُمومة كلّ من المرأتين يوجب الجزم بعدمها فيهما على ما أسلفناه .
ولا بُعد في عدم اُمّ للطفل أو عدم الأب ، لا من جهة الإعجاز كما في عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام ، بل من جهة الإمكان فعلاً على ما ينقل من زرع بعض خلايا جسم المرأة في رحمها ممّا يوجب تولّد مشابه لصاحب الخلقة، ممّا أثار ضجّة في العالم ، وقد حرّم من قبل الكنيسة وغيرها لجملة من المفاسد .
فيا ترى إنّ صاحب الخليّة أب وهي امرأة فرضاً ، فإذا فرض زرع خليّة من غير إنسان في رحم المرأة فتولّد منها الولد فمَن هو أبوه ؟!
ولكن عرفت فيما قدّمناه أنّ الأمر لا يصل إلى هذا ، بعد كون الاُمومة متقوّمة بتولّد الطفل من ماء المرأة لا بحملها له ، لا مستقلاًّ ولا منضمّاً .
(الصفحة349)
أدلّة انتشار الحرمة بسبب مجرّد الحمل
هذا ، لنرجع إلى ما كنّا بصدده من حكم انتشار الحرمة بسبب الحمل وعدمه ممّا ذهب إليه بعض ، والذي يمكن الاستدلال به لذلك هو وجوه :
الوجه الأوّل : فحوى ما دلّ على محرميّة الرضاع ونشره للحرمة ، فإنّ الرضاع الموجب لإنماء الولد بمقدار عشر أو خمسة عشر رضعة إذا أثّر في نشر الحرمة فما ظنّك بالحمل المكوّن لتمام النماء ؟
ويردّه أنّه مبنيّ على كون المتفاهم من دليل انتشار الحرمة بالرضاع، هو كون الإنماء علّة لها ، وهذا ممنوع . أفهل ترى أنّ المفهوم من الحديث المتواتر : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هو أنّ الموجب لمحرمّية الرضاع وتمام العلّة هو تأثيره في التنمية .
هذا ، سيّما إذا انضمّ إليه ما ورد من الشروط المعتبرة في الرضاع ممّا لا تنتشر الحرمة بدونها مع تحقّق النماء أضعاف ما يتحقّق في مورد الرضاع المحرّم ، فلو أرضعت امرأة بدون فحل أو من غير ثدي مباشرة أو نحو ذلك ، حولين كاملين ، لم يحرم مع أنّ الرضاع يوماً وليلة مع الشرائط محرّم ، فكيف يجزم بمناط الحكم مع ذلك ؟!
الوجه الثاني : دعوى إيماء جملة من النصوص بكون العلّة المحرّمة في الرضاع هو إنباته اللحم والدم وشدّه للعظم ، ممّا يكون تحقّقه في مورد الحمل آكد وآكد; وذلك فإنّ هذه النصوص على طائفتين:
إحداهما: ما تضمن أنّ الرضاع المحرّم هو ما انبت اللحم والدم وشدّ العظم ، كما في صحيح حمّاد بن عثمان وعبدالله بن سنان(1) وغيرهما .
- (1) الوسائل 14: 289 ، الباب 3 من ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 2 .
(الصفحة350)
وثانيتهما: ما تضمّن تعليل كفاية أنواع من الرضعات; معلّلاً بأنّها تنبت اللحم وتشدّ العظم; وعدم كفاية غيرها; لعدم إنباتها اللحم كما في صحيح علي ابن رئاب(1) .
ويردّ هذا أيضاً: أمّا الاستدلال بالطائفة الاُولى فواضح; فإنّها دلّت على أنّ الرضاع المحرّم هو ما أنبت اللحم ، وأين هذا من كون تمام العلّة إنبات اللحم؟! بل الموضوع والعلّة هو الإرضاع المنبت .
فيا ترى لو قال القائل: كُل الرمّان الكبير ، فهل يفهم منه أنّ تمام العلّة أو الموضوع هو الكبر فيجب أكل كلّ كبير ! ولعمري هذا لمن العجب العجاب لو لم يكن أعجبها .
ومن هذا يظهر الجواب عن الطائفة الثانية; فإنّه لمّا كان نشر الحرمة بالإرضاع الموجب لنبات اللحم معهوداً عند الشيعة ، كان التنبيه على كفاية مثل عشر رضعات المحقّقة لنبات اللحم بذلك .
وإن شئت فقل : إنّ العلّة هو الإرضاع المنبت للحم لا الإنبات المطلق .
الوجه الثالث : ما ورد في المولى إذا وطأ الجارية الحامل من غيره ، من النهي عن بيع الولد والأمر بعتقه والإجراء له من ماله; معلّلاً بأنّه غذّاه بنطفته كما في معتبرة إسحاق بن عمّار وغياث بن إبراهيم والسكوني(2) .
ويردّه أنّه مجرّد إشعار أو استحسان ، فإنّ حكم الولد هو الانعتاق بالتملّك وكونه وارثاً ، وأمّا المغذّى بالنطفة فقد حكم بعتقه والإجراء له ، فأين هذا من الدلالة على نشر الحرمة ؟! فلاحظ .
مضافاً إلى أنّ الحامل لم تغذّه بنطفتها وإنّما غذّته بغير النطفة ، ولا دليل على أنّ
- (1) نفس المصدر: 14 / 283 ، الباب 2 من ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
- (2) الوسائل 14: 507 الباب 9 من نكاح العبيد .
(الصفحة351)
مطلق التغذية موجب للحكم .
فقد تحصّل عدم تماميّة شيء من الوجوه المتقدّمة لإثبات نشر الحرمة .
كون الاُمّ المستأجرة للحمل رحماً للولد
وهذا أيضاً لا يخلو من تأمّل; لاحتمال كون الرحم هو التولّد من رحم كانت هي منشأ النطفة أيضاً ، فتأمّل .
وأمّا ما تضمّن التوصية بالاُمّهات; معلّلاً بأنّها حملت الولد ، فلا يستفاد منها كون الحمل تمام العلّة في الانتساب والولادة ، بل هي خاصّة بالمتعارف من الحوامل من كونهن اُمّهات من جهة النطف أيضاً .
الوجه الرابع: وقد يتمسّك لدعوى نشر الحرمة بمجرّد الحمل وإن لم يثبت النسب بوجه آخر ، وهو الخبر الوارد في بدء الخلق ، وأنّه لم تكن حوّاء مخلوقة من ضلع آدم لاستلزامه نكاح الإنسان بعضه بعضاً ، كما في خبر العلل في الموثّق عن أحمد بن إبراهيم بن عمّار (عن عمّار خ ل) عن ابن نويه (نوبة ـ خ ل في الفقيه) عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث :
قيل له : إنّ أُناساً عندنا يقولون: إنّ الله عزّوجلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، قال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ، يقول من يقول هذا : إنّ الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ، وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ، يقول: إنّ آدم كان ينكح بعضه
(الصفحة352)
بعضاً إذا كانت من ضلعه . . .» الحديث(1) .
ونحوه ، وبل مثله ، بل هو هو ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة ، والسند صحيح كما عن الخلاصة .
ويرد عليه ـ بغضّ النظر عن ضعف السند ـ أنّ مدلول الخبر لو كان حرمة نكاح الإنسان بعضه بعضاً إلاّ أنّ الحمل في مفروضنا هو بعض من أخذ مائها لتلقيح النطفة .
إلاّ أن يُقال : كما أنّ الولد بعض من تلك ، لكنّه مشتمل على أجزاء من المرأة الحامل له ، فتأمّل .
الوجه الخامس: وقد يتمسّك لانتشار الحرمة بين الولد والحامل له بوجه آخر ، وهو ما دلّ على النهي عن نكاح القابلة المباشرة للولادة وبنتها; معلّلاً بأنّها بعض اُمّهاته . ففي رواية جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : «لا ، ولا ابنتها ، هي بعض اُمّهاته» (2) .
وفي مرسلة الكليني عن معاوية بن عمّار : «وإن قبلت وربت حرمت عليه». ورواه الصدوق باسناده عن ابن عمّار(3) .
وفي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث : «وإن كانت قبلته وربّته وكفلته فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي»(4) .
وفي خبر آخر : «وصديقي»(5) .
ويردّه ـ مع أنّ الحكم في موردها مبنيّ على الكراهة لا للتحريم ولو بقرينة
- (1) الوسائل 14: 267 ، الباب 28 من النكاح المحرّم ، الحديث 1 .
- (2) الوسائل 14: 386 ، الباب 39 من ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر: 386 ، الباب 39 من المحرّمات بالمصاهرة .
- (4) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (5) نفس المصدر ، الحديث 7 .
(الصفحة353)
سائر الأخبار ـ أنّ التعدّي من موردها إلى الحامل مبنيّ على الاستحسان ، فتأمّل .
نعم ، حرمة القابلة المربّية هي مقتضى الصناعة ، فإنّ ما دلّ على حلّها فيما عثرت عليه مطلق لابدّ من حمله على غير مورد القيد .
هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الروايات لا تخلو عن دلالة على نشر الحرمة فيما نحن فيه .
(الصفحة354)
المسألة الثانية : بعدما تقدّم من حلّ تلقيح الزوجة بنطفة من زوجها ، فهل يجوز ذلك في العدّة الرجعيّة من طلاقه إيّاها ؟ الظاهر هو الجواز أمّا تلقيحها بماء الأجنبي فلا يجوز قطعاً ، وأمّا بعد العدّة فحكم تلقيحها بماء زوجها حكم سائر الأجنبيّات (1) .
(1) المطلّقة الرجعيّة إن قلنا بكونها بعد زوجة كما اختاره سيدنا الاُستاذ ، ويظهر من غيره كالمحقّق في الشرائع في بحث الرجعة ، وإن كان يظهر من الجواهر توجيه أمثال عبارته بما هو المعروف من كونها في حكم الزوجة ، فلا إشكال; فإنّ المحرم إفراغ الماء في فرج امرأة تحرم عليه وليست الزوجة كذلك .
ودعوى أنّ المطلّقة أجنبية وإنّما هي بحكم الزوجة في بعض الأحكام .
يدفعها ـ مضافاً إلى كونه خلاف الفرض ـ منع المبنى حسب ظواهر عدّة من النصوص التي منها: ما ورد في عدم جواز إخراجها في العدّة من منزل زوجها ، وأنّها تعتدّ في منزل زوجها(1); فإنّ التعبير بالزوج دليل على بقاء الزوجية ما لم تنقض العدّة .
وإرادة الزوجية بلحاظ ما قبل الطلاق مجاز يخالف الأصل .
- (1) الوسائل 15: 434 ، الباب 18 من العدد ، الأحاديث 1 و4 و7 .
(الصفحة355)
تلقيح الرجعيّة بنطفة زوجها في العدّة بناءً على عدم كونها زوجة
إذن لو قلنا بأنّ الرجعيّة زوجة فلا محذور في تلقيحها بماء زوجها ; وأمّا إذا قلنا بأنّها بحكم الزوجة كما هوالمعروف على ألسنة الفقهاء:
فإن قلنا بكونها كالزوجة في كلّ الآثار فكذلك; لأنّ من أحكام الزوجة جواز تلقيحها بماء زوجها .
وأمّا إذا قلنا بأنّها تشترك مع الزوجة في بعض الأحكام ، فالظاهر أيضاً ذلك; وذلك لأنّ المتيقّن من الأحكام الثابتة للرجعيّة هو جواز وطئها والذي به تتحقّق الرجعة ولو تعبّداً; حيث لا يشترط ـ على ما صرّح به في الجواهر استناداً إلى النصوص ـ قصد الرجوع بذلك ، بل قيل: إنّه لا يخلّ به قصد عدم الرجوع ، فإذا جاز وطئ الرجعيّة جاز تلقيحها ، فإنّ الوطء الجائز هو أعمّ منه مع الإنزال .
وإن شئت فقل : إنّ المحرّم من تلقيح الأجنبيّة هو غير الرجعيّة; وذلك لأنّ الدليل على حرمة التلقيح هو النصّ المتضمّن للعن من أفرغ ماءه في فرج امرأة تحرم عليه ، فإنّه لو لم يكن كناية عن الزنا فالمنساق منه هو ما كان إفراغ المني بمثل الوطء ، ثمّ يلحقه إفراغ الماء بغير الوطء; بدعوى عدم الفرق ، وحيث كان الوطء وإفراغ الماء في الرحم جائزاً كما في الرجعية فكيف يمكن دعوى حرمة إفراغ الماء في رحمها بغير الوطئ ؟!
وكيف كان فظاهر دليل جواز الوطئ المفهوم من عدّه رجعة لا حدّ فيها ، هو جواز ملابسات الوطئ التي منها صبّ المني في رحمها أو على فرجها ، الذي هو معرض الوصول إلى الرحم ، بل دليل حرمة التلقيح قاصر عن الرجعيّة بالنسبة إلى زوجها ، فإنّ الموضوع في النصّ هو المرأة المحرمة وليست الرجعية كذلك بالنسبة إلى زوجها .
(الصفحة356)
نعم ، لو كان دليل حرمة التلقيح آية الأمر بحفظ الفروج ـ كما تقدّم ـ عمّ المورد ، ويكون خروج الرجعيّة عنها بالتخصيص .
عدم جواز تلقيح الرجعيّة بنطفة غير الزوج
أمّا عدم جواز تلقيحها بماء الأجنبي فإن قلنا بعدم جواز تلقيح الأجنبيّة مطلقاً فظاهر ، فإنّ المطلّقة من أفراد الأجنبيّة ; وأمّا إذا منع من ذلك فكذلك; لأنّ مقتضى الاعتداد عليها هو التجنّب عن الوطئ وما بحكمه ، فإنّ العدّة ليست فائدتها الرجعة فقط ، بل الغرض منه أعمّ منه ومن حفظ الأرحام من اختلاط المياه فيها .
وإن شئت فقل : إنّ لزوم العدّة عليها تكليفاً يقتضي وجوب صيانة رحمها من ماء الأجنبي بوطء أو غيره ، فلا تبتني حرمة تلقيحها على نصّ خاصّ ، كما في غيرها .
ثمّ إنّ من قبيل النصّ المتقدّم في إطلاق الزوجة على الرجعية ما كان في مضماره ممّا دلّ على أنّ المطلّقة لا ينبغي لها الخروج إلاّ بإذن زوجها(1) .
ففي صحيح سعد بن أبي خلف ـ وفي الجواهر صحيح أبي خلف وهو سهو ولعلّه من الناسخ ـ عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها ـ إلى أن قال ـ : والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تعتدّ في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها»(2) .
وفي موثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال :
- (1) نفس المصدر ، الحديث 7 .
- (2) نفس المصدر: 436 ، الباب 20 من العدد ، الحديث 1 .
(الصفحة357)
«في بيت زوجها»(1) .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها»(2) .
وفي صحيح ابن عمّار ـ بناءً على أنّ محمّد بن زياد هو العطّار ـ : «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»(3) .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها . . .» الحديث (4) .
ونحوها غيرها في هذا المضمار(5) .
إن قلت : لا مجال لأصالة الحقيقة بعد العلم بالمراد وأنّه الزوج المطلّق ، وإنّما الاُصول تجري لإحراز المراد .
قلت : نعم ، ولكن هذا إنّما يتمّ في غير الاُمور الاعتبارية ممّن له الحكم ، وأمّا من كان الحكم بيده فاعتباره مثل الزوجيّة راجع إلى نوع من الحكومة التي معها تترتّب الأحكام، سواء كان الإطلاق حقيقة أو مجازاً .
وإن شئت فقل : إنّ إطلاق الزوج على المطلّق راجع إلى اعتباره زوجاً تترتّب جميع أحكام الزوج عليه إلاّ بدليل على خلافه ، وهذا بخلاف من ليس بيده الحكم ، فإنّه يتعيّن أن يكون إطلاقه اللفظ بعناية المجاز ولمجرّد الاستعمال لا بداعي ترتّب أحكام جعلية اُخرى .
إلاّ أن يقال : إنّ المشرّع وإن كان يمكنه الاستعمال بعنوان الحكومة ، ولكن لا
- (1) نفس المصدر: 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 4 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر: 439 ، الباب 22 من العدد ، الحديث 2 .
- (4) نفس المصدر: 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 2 .
- (5) راجع بقيّة أحاديث الأبواب المشار إليها في التعاليق المتقدِّمة .
(الصفحة358)
يتعيّن شأنه في ذلك ، بل يمكنه الاستعمال بعنوان المجاز وإلاّ لزم أن يكون كلّ استعمال غير حقيقي منه، ممّا يمكن فيه أن يكون بعنوان الحكومة منزّلاً عليها .
وبتعبير آخر: أنّ المشرّع في حكمه بأنّ الرجعيّة لا تخرج من بيت زوجها ، بصدد حكم غير اعتبار الزوجيّة . فهذه النصوص من قبيل ما تضمن أنّ الزوج يحقّ له تغسيل زوجته والنظر إليها ، مع أنّ سيّدنا الأستاذ مصرّح بأنّ الزوجية تبطل بالموت .
وفي الجواهر : «كثرة النصوص بأنّ الرجعيّة في العدّة زوجة ، المنزل على إرادة حكم الزوجة الذي منه جواز وطئها»(1) .
ولعلّه يشير بالنصوص الكثيرة إلى التي أشكلنا في دلالتها ، وتمام الكلام في غير المقام .
وكيف كان فمّما يدلّ على الحكم معتبرة يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال : «يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود» قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : «نعم ، وهي امرأته . . .» الحديث(2) .
ويؤيّده المرسل كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ، ولم يشهد على رجعتها ؟ قال : «هي امرأته ما لم تنقض العدّة . . .» الحديث(3) .
وحمل الخبرين على أنّها بحكم امرأته خلاف الظاهر ، بعدما كان الحكم بالزوجيّة بيد الشارع .
نعم ، في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث في طلاق الرجعية :
- (1) الجواهر 32: 182 .
- (2) الوسائل 15: 382 ، الباب 20 من أقسام الطلاق ، الحديث 11 .
- (3) نفس المصدر: 372 ، الباب 13 من أقسام الطلاق ، الحديث 6 .
(الصفحة359)
«فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها ، لم يكن طلاقه الثاني طلاقاً; لأنّه طلّق طالقاً; ولأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده . . .» الحديث(1) .
بناءً على أنّ المراد من الملكيّة الزوجيّة . والسند لا بأس به سوى أنّ الراوي عن ابن مسكان مردّد بين ابن أبي نجران وغيره ، فيكون مجهولاً ، إلاّ أنّ الراوي عنه إبراهيم بن هاشم .
وفيه ـ مع الغضّ عن السند ـ قوّة احتمال إرادة عدم وقوع الطلاق بالمطلّقة قبل المراجعة ، فلا ينافي كونها محكومة بالزوجيّة; فإنّ الحكم بها حيثي ، فمن حيث جواز تطليقها ليست بحكم الزوجة; لأنّها مطلّقة إنشاءً ، ومن سائر الجهات هي زوجة ومحكومة بها لا أنّها بحكمها ، فلاحظ . ولا أقلّ من كونه مقتضى الجمع بين ما تقدّم وهذه .
ثمّ إنّه بالذي بيّناه من أنّ مستند اعتبار الرجعيّة زوجة هو النصّ يرتفع الإشكال والغبار ، ولا يفرّق بعده بين مباني الفقهاء في حقيقة الرجعة وكيفيّة تأثيرها . وكذا لا يفرّق بين كونها زوجة حقيقة أو حكماً .
وإن شئت زيادة توضيح لذلك نقول :
مقتضى القاعدة في المطلّقة أيّام العدّة هل تكون زوجة أم لا؟
- (1) الوسائل 22: 109 ، الباب 2 في كيفيّة طلاق العدّة ، الحديث 2 .
(الصفحة360)
المانع من تأثير العقد إلى حين الفسخ ، على ما هو المعروف .
وإن شئت فقل : إنّ الطلاق مؤثّر على القاعدة في الفرقة وزوال الزوجيّة ، ومجرّد الترخيص في بعض الآثار المترتّبة على الزوجيّة بعد الطلاق لا يقتضي الحكم ببقاء الزوجيّة ما لم يكن الأثر مختصّاً بالزوجيّة .
وقد تقدّم أنّ مثل حلّ النظر للرجل وحلّ إبداء الزينة للمرأة لا يختصّان بالزوجة; ولذا يجوز لمريد الزواج النظر إلى امرأة يريد نكاحها ويحلّ لها التبرّج عنده في الجملة ، بل لو لم يكن هناك مورد كذلك شرعاً ، لم يكن ذلك شاهداً لاختصاص جواز النظر والتبرّج بموارد الزوجيّة إلاّ مجرّد احتمال لا ينهض دليلاً .
فحلّ الرجوع ونحوه أعمّ من بقاء الزوجيّة ، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الزوجيّة عند الشكّ بعد دليل صحّة الطلاق ونفوذه المقتضي لتأثيره على ما أنشأ; فإنّ الإنشاءات من عقد وإيقاع تابعة للقصود ، كما قرّر في محلّه .
وعليه فالمطلّقة الرجعيّة كالبائن لا تكون زوجة; وإنّما الفرق بينهما بحسب الدليل ولاية الرجل على الرجوع بلا استئذان المرأة في الرجعيّة دون البائن . فالرجوع نكاح جديد; وعدم توقّفه على الإذن من المرأة للدليل; حيث لا موجب لتوقّف صحّة كلّ نكاح على إذن المرأة . ألا ترى أنّ الولي يزوّج البنت بلا إذن منها ، فليكن الرجل والزوج المطلّق في بعض الفروض وليّاً عليها بوجه خاصّ .
فمن غريب القول بعد هذا دعوى أنّ الرجعة لو كانت نكاحاً جديداً لتوقّف على إذن المرأة ، إلاّ أن يراد كون الرجعة عقد نكاح جديد ، ولا موجب للالتزام به ، بل الرجوع إيقاع .
كما أنّ من غريب القول دعوى أنّ الرجعيّة لو كانت زوجة لم يحرم وطئها; فإنّه مضافاً إلى كون حرمة وطئها محلّ خلاف ، لو سلّم لا ينافي الزوجيّة; فإنّ المظاهرة زوجة ولا يحلّ وطئها إلاّ بعد التكفير . وكذا في بعض آخر من الموارد .
(الصفحة361)
هذا ، غير أنّ الالتزام بوقوع الفرقة بمجرّد الطلاق ، لمّا كان مبنيّاً على القاعدة ودليل صحّة الطلاق ، فلو قام دليل على عدم تأثيره مباشرةً ، بل بعد انقضاء العدّة ، كان متّبعاً ، فهو نظير ما دلّ على عدم نفوذ البيع في التمليك والتملّك إلاّ بعد التقابض أو القبض أو الإقباض في بعض الموارد ، كالصرف والسلم اتّفاقاً ، وعدم تأثير البيع مدّة الخيار على بعض الفتاوى .
وتنزيل دليل اعتبار المطلّقة في العدّة زوجة على أنّها بحكم الزوجة ، تأويل بلا موجب ولا دليل; فهو من قبيل دعوى أنّ المبيع قبل القبض فيما يشترط في نفوذ بيعه القبض بحكم ملك البائع .
وممّا ذكرنا تعرف الوجه في ردّ ما في بعض كلماتهم ، من أنّ الرجعيّة ليست زوجة; لزوال النكاح بالطلاق ، والزائل لا يعود .
إذ فيه: أنّ قاعدة امتناع المعدوم ، لو تمّت فإنّما هو في غير الاعتباريّات ، وأمّا فيها فلا بأس باعتبار عود الزائل .
وإن أشكل في ذلك بأنّه لا فرق في امتناع عود المعدوم والزائل ، بين الأمر الحقيقي والاعتباري ، قلنا: إنّه لا يدور الحكم بالزوجيّة في الرجعيّة على عود الزائل ، بل مدار الدليل على اعتبار الزوجيّة ولو تعبّداً وقد قام ، كما تقدّم .
وما في بعض الكلمات من أنّ إطلاق الزوجة على الرجعيّة مجاز ومسامحة ، يدفعه أنّ المجاز إنّما هو في حسبان غير الشارع ، وأمّا عند الشارع فبعد اعتباره الزوجيّة وحكمه بذلك يحكم بها ، ولا يهمّ كون إطلاق الزوجة عليها في العرف مجازاً بعد كون حكومة الشارع مقدّماً في لسانه على سائر الاصطلاحات .
ثمّ إنّ الرجعة ، حيث يشكّ في تأثيرها من حينها أو من حين الطلاق ، بنحو الشرط المتأخّر أو بنحو الكشف الحقيقي والانقلابي أو بنحو الكشف الحكمي ، قلنا : إنّ ظاهر الدليل كون التأثير من حينها وبنحو الشرط المقارن ، ولكنّ الظاهر
(الصفحة362)
أنّ هذا البحث لا ثمر له بعد وقوع الفرقة عند انقضاء العدّة بدون الرجوع ، وبعد اعتبار المطلّقة في العدّة زوجة تعبّداً حتّى بدون الرجوع ، بحيث يترتّب عليها تمام أحكام الزوجيّة، ومنها جواز الوطء ولو بدون قصد الرجوع على قول ووجه قوي.
نعم ، لا منافاة بين بين حلّ وطئها وعدم زوجيّتها ، بحيث لو لم يدلّ دليل على وقوع الرجعة بالوطيء لا بقصده كان وطئها حلالاً وإن لم تكن زوجة . وعليه فلا ملازمة بين حلّ وطئها وزوجيّتها كما لا ملازمة بين حرمة وطئها وعدم الزوجيّة . وأيضاً لا منافاة بين حرمة الوطء وبين الزوجيّة .
وبالجملة فالبحث في كيفيّة تأثير الرجعة غير مثمر بعد الذي قدّمناه .
مقتضى الأصل العملي في الرجعيّة هل تكون زوجة أم لا؟
ثمّ إنّه لو شكّ في زوجيّة الرجعيّة بعد الطلاق ، ولم يكن في دليل الطلاق إطلاق يقتضي تنفيذه على نحو إنشائه ، كان مقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء الزوجيّة . ولا يقاس بمورد الشكّ في الزوجيّة بعد الموت ، والسرّ في الفرق هو أنّ نسبة الطلاق إلى عقد النكاح نسبة الناسخ إلى المنسوخ ، فالزوجيّة المستمرّة مُنشأة إلاّ أنّ الطلاق يرفعها ، ومع الشكّ في الرافع يستصحب بقاء النكاح .
بل قد يقال بأنّه لا حاجة إلى الاستصحاب أيضاً; فإنّ دليل صحّة النكاح يقتضي نفوذه حتّى بعد فرض إنشاء الطلاق ، فما لم يقم دليل على تأثيره في إلغاء النكاح ، يكون العقد مستمرّاً للإطلاق .
وعلى هذا الأساس حكم الشيخ الأعظم الأنصاري ـ على ما ببالي ـ في بعض وجوه أصالة اللزوم في العقود ، بأنّ دليل صحّة العقد يقتضي تأثيره حتّى بعد الفسخ، كما يقتضي تأثيره عند إنشاء الفسخ بما يشكّ في صحّته .
وكذا على هذا الأساس يمكن أن يُقال باستصحاب الحكم عند الشكّ في
(الصفحة363)
نسخه ، حتّى لو منع من حجّيّة الاستصحاب; فإنّه ليس من الاستصحاب المصطلح ، بل تمسّك بعموم دليل الحكم المنسوخ ـ العموم الأزماني ـ ما لم يقم دليل على تخصيصه ببعض الأزمنة ، الذي هو مفاد دليل النسخ .
إن قلت : إنّ حجّية دليل الحكم المنسوخ منوطة بعدم نسخه ، ومع احتماله فلايحرز حجّيته بل يحتمل .
وإن شئت فقل : إنّ التمسّك بدليل الحكم مع احتمال نسخه دوريّ; لأنّه موقوف على عدم النسخ ، الموقوف على الحجّية الموقوفة على عدم النسخ .
قلنا : إنّ حجّية دليل المنسوخ موقوف على عدم إحراز نسخه ، وهذا ثابت بالوجدان بلا حاجة إلى التعبّد ، فالتمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم النسخ من أردأ التعبّد; لأنّه تعبّد في مورد يكون مضمونه ثابتاً بنحو القطع .
ويشهد لما ذكرنا عدم صحّة اعتذار العبد في مخالفة الحكم باحتمال نسخه ، كعدم صحّة اعتذاره باحتمال إرادة المولى خلاف الظاهر .
وبالجملة: فكما أنّ الظواهر حجّة عند احتمال قرينة غير واصلة على إرادة خلاف الظاهر ، كذلك ظهور الخطاب في الاستمرار حجّة عند عدم الدليل الواصل على انقطاع الحكم ونسخه .
تأثير الفسخ في العقود من حينه أو من حينها
(الصفحة364)
يستدعي نقض ملك نماء المعقود عليه .
وربما يؤكّد ذلك موثّق إسحاق بن عمّار قال : حدّثني مَن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذا وتكون لك ، أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ؟
فقال : «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه» قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة؟ فقال : «الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله»(1) .
أقول : هذه الرواية تعدّ مرسلة; لأنّ إسحاقاً لم يسمع من الإمام وإنّما روى عمّن سمع ، وهو مجهول . وجزمه بأنّ ذاك سمع حجّة له لا لنا .
نعم ، في نقل الصدوق هكذا: إسحاق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله رجل . . . إلخ .
فتكون الرواية فاقدة للإرسال ، والمظنون أنّه سهو من الصدوق أو غيره في سنده; حيث تخيّل أنّ قول: «سأله رجل» عبارة اُخرى عن قول: حدّثني من سمع فحذف الأوّل .
ثمّ لو شكّ في كون الرواية مسندة أو مرسلة يشكل الاعتماد عليها ، مع غضّ النظر عن كون الكليني أضبط وكون نقله مؤيّداً بنقل الشيخ .
هذا ، ولكن في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ، فقال : «إن كان في تلك الثلاثة يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء»(2) .
- (1) الوسائل 12: 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الباب 13 ، الحديث 1 .
(الصفحة365)
ويؤيّده مرسلة معاني الأخبار : «من اشترى محفلة فليرد معها صاعاً»(1) . والمحفلة: الشاة المصراة .
وقد يجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الاستحباب ، فلا يجب ردّ بدل نماء المبيع بعد الفسخ .
حقيقة الفسخ والأصل فيها
لا أقول: إنّ مقتضى الفسخ هو الكشف الانقلابي عن بطلان المعاملة; فإنّه ينافي دليل صحّة المعاملة واقعاً إلى زمان الفسخ .
بل أقول: مقتضى الفسخ إلغاء أثر المعاملة حتّى الآثار السابقة على الفسخ ، ولكن بلحاظ الاستمرار ، فبعد الفسخ ومن حينه يحكم بعدم ملك المشتري لنماء المبيع بعدما كان يحكم قبل الفسخ واقعاً بملك المشتري للنماء .
ونتيجة ذلك: خروج النماء عن ملك من انتقل إليه الأصل بتبع خروج الأصل عن ملكه . ويؤكّد هذا ما تضمّنه صحيح الحلبي ، فلو ثبت خلاف هذا كان إمضاءً للفسخ على خلاف ما أنشأه الفاسخ ، فيكون من قبيل الحكم بصحّة المعاملة بعد التقابض ، مع أنّ مقصود المتعاملين التأثير قبله ومن حين المعاملة .
وأمّا ما تضمّنه موثّق إسحاق ـ بغضّ النظر عن سندهـ فإنّه لو تمّ لأوجب رفع
- (1) نفس المصدر ، الحديث 3 .
(الصفحة366)
اليد عن القاعدة ، ولكن دلالته مبنيّة على أن يكون مورده الفسخ، كما هو المعروف في فهمهم منه ومن أمثاله من النصوص ، حيث جعلوه دليلاً على مسألة بيع الخيار ، ولكن لم يعلم كون ردّ المبيع بردّ الثمن في الخبر من الفسخ ، بل لا يبعد كونه معاملة مستقلّة يعبّر عنه في الفارسية بـ «واگذار كردن» ومعناه ترك الشيء للغير وأن تَدَعَه له، ومعه فلا موجب لرفع اليد عن القاعدة .
وأمّا ما في بعض كلمات الشيخ الأنصاري (قدس سره) : من أنّ تأثير العقد من حينه ليس مقصوداً بالإنشاء ليقتضي الفسخ نقضه ، وإنّما هو مقتضى تنفيذ العقد مطلقاً وتصحيحه شرعاً .
ففيه: منع ذلك جدّاً; فإنّ العقود مختلفة فيما هو المنشأ بها من مقارنة الأثر للعقد وعدمها ، فقد يقصد إجارة الدار من بعد مدّة كما قد يقصد الإجارة من حينها ، فدعوى أنّ زمان تحقّق المنشأ خارج عن مدلول الإنشاء ممنوعة .
ولعلّ الذي حمله على ذلك ملاحظة إمضاء الشارع لبعض العقود منفصلاً عن زمان العقد ، كالمشروط بالقبض والتقابض ونحوهما ، مع أنّ ذلك حكم على خلاف القاعدة والإنشاء; ولئن كان هناك مورد لتنفيذ العقود على خلاف القصود فهو هذا وما أشبهه .
نعم ، هنا شيء ، وهو أنّه لو كان العقد في تأثيره منحلاًّ بلحاظ الأزمنة ، على نحو العام الاستغراقي لا المجموعي ، أمكن إلغاء أثر العقد من حين الفسخ من دون أن يستلزم الإلغاء من حين العقد .
والسرّ في ذلك : أنّ حقيقة مثل هذا العقد منحلّة إلى عقود متعدّدة هي واحدة بالصورة ، فهو كما لو أنشأ بيعاً وإجارة في عقد واحد غير مشروط أحدهما بالآخر ، كما لو صدرا في زمانين متعاقبين ، وتصوير العقد المنحلّ إلى عقود في مثل إجارة الأعيان لا محذور فيه; حيث إنّ الإجارة تملّك المنفعة ، ويمكن فرض المنافع
(الصفحة367)
المتعدّدة مورد الإجارة على نحو الانحلال بالعموم الاستغراقي .
وأمّا في البيع فيشكل الأمر فيه إثباتاً ـ وإن كان لا محذور فيه من حيث التصوّر ـ فإنّ العين نقلها بلحاظ زمان دون سائر الأزمنة لا يعدّ بيعاً عرفيّاً; فإنّ البيع هو نقلها رأساً ولو مع خيار الاسترداد .
إلاّ أن يقال : إنّ مثل هذه المعاملة وإن لم تكن بيعاً ، ولكن لا محذور في تصحيحها بعموم أدلّة المعاملات ، فلا تترتّب عليها أحكام البيع ولتترتّب عليها سائر الأحكام الثابتة للمعاملات بعنوان عام .
ثمّ يقع الكلام في أنّ الطلاق المشروع هو ما كان إنشاء الفرقة فيه بلحاظ الأزمنة على نحو العام الاستغراقي أو المجموعي؟
فعلى الثاني تكون الرجعة نقضاً للعقد من الأساس ، وعلى الأوّل يعقل في الرجوع نقض الفرقة أصلاً كما يعقل نقض الفرقة من حين الرجعة .
ثمّ لو شكّ ، فقد يكون الشكّ في ما هو المشروع من العقد أو الطلاق ، وأنّه بنحو العام المجموعي أو الاستغراقي أو الأعمّ ، فحيث لم يتمّ دليل على الإطلاق ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من صحّته ، والظاهر أنّه العامّ المجموعي .
وقد يكون الشكّ فيما هو الواقع في الخارج على تقدير صحّة العقد والإيقاع على الوجوه المتعدّدة ، وأنّهما وقعا على وجه يجوز التبعيض في فسخهما ، وذلك بوقوعهما بنحو العام الاستغراقي ، أو على وجه لا يجوز تبعيضهما في الفسخ؟
والأصل يقتضي الثاني; للشكّ في تأثير الفسخ ، بينما أنّ المتيقّن هو فسخ العقد من الأساس ، لجوازه على تقدير كون العقد والإيقاع بنحو الاستغراق أو المجموع; بخلاف التبعيض في الفسخ; فإنّه فرع كونهما بنحو الاستغراق ، فلاحظ .
هذا على تقدير كون الخيار المجعول عامّاً ، وأمّا إذا احتمل تخصيص الخيار ببعض الأزمنة فله حكم آخر ، وتفصيل المقال محوّل إلى غير المقام ، والله العالم .
(الصفحة368)
فقد تحصّل ممّا ذكرناه في المقام :
أوّلاً : جواز تلقيح الرجعيّة بماء زوجها ، أمّا بناءً على بقاء الزوجية حقيقة قبل انقضاء العدّة فظاهر ، وأمّا بناءً على عدمه ، فلكونها في حكم الزوجة والتي من جملة أحكامها جواز المجامعة والتلقيح ، فلا يبتني الحكم في المسألة على بعض المباني هناك .
ثانياً : أنّ عمدة ما يدلّ على كون الرجعيّة زوجة هو روايتا يزيد الكناسي ومحمّد بن مسلم; وظاهرهما أنّها زوجة حقيقة . ولا بأس بسند الأوّل ، إلاّ من جهة يزيد فقد قيل: إنّه بريد ـ بالموحّدة ـ والراء المهملة وأنّه ممدوح، ومال سيّدنا الاُستاذ إلى أنّه بالياء المثنّاة من تحت والزاء المعجمة وأنّه متّحد مع القمّاط الثقة . كما ومال الأردبيلي إلى أنّه متّحد مع بريد ـ بالموحّدة ثمّ المهملة ـ ابن معاوية العجلي الجليل .
وكيف كان فمّما يؤكّد وثاقته هو إكثار أبي أيّوب الخزّاز إبراهيم بن عثمان أو ابن سعيد عنه ، كما وروى عنه بعض آخر من الأجلّة ، فلا يبعد صحّة الرواية .
كما أنّ سند الثاني أيضاً صحيح إلاّ من جهة الإرسال ، ولعلّه لا يضرّ بعد كون المرسل هو المعلّى بعنوان بعض أصحابه .
كما واستدلّ للزوجيّة بما تضمن أنّها تبين بانقضاء العدة ممّا ظاهره بقاء عصمة الزوجيّة ، واستدلّ لذلك أيضاً بترتّب جملة من آثار الزوجيّة في موردها; وبإطلاق الزوجة عليها والزوج على بعلها .
وإن كان يرد على الأخيرين: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وترتّب الآثار أعمّ من الزوجيّة . وعلى الثاني باحتمال كون المراد انقطاع حقّ الرجوع ، ولا أقلّ من الشكّ الموجب للإجمال .
وقد يستدلّ للزوجيّة بوجه خامس هو دعوى الإجماع في بعض الكلمات .
ويردّه: احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدّمة .
(الصفحة369)
أدلّة اعتبار المطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة
الأوّل : أنّ مفهوم الرجعة يقتضي زوال الزوجيّة قبل الرجعة وإلاّ فلا معنى لإرجاع ما هو باق .
ويردّه: احتمال كون المراد الرجوع عمّا أنشأه الزوج من الطلاق المؤثّر بعد انقضاء العدّة لولا الرجوع ، لا الرجوع بمعنى عود الذاهب .
الثاني : كونه مقتضى صحّة الطلاق شرعاً .
ويردّه أنّ الصحّة تجامع الزوجيّة قبل انقضاء العدّة ، وتكون الصحّة بلحاظ ما بعد العدّة وإن كان بحاجة إلى دليل وقد قام .
الثالث : إنّ مقتضى إطلاق تنفيذ الطلاق الحكم بتأثيره من حينه ، فإنّ هذا هو الظاهر من الدليل ، ومقتضى الحكم بالزوجيّة بعد الطلاق ، عدم التأثير من حينه ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الظاهرين : إمّا الزوجيّة بحملها على الحكميّة ، أو صحّة الطلاق بحملها على التأثير بعد العدّة ، فإذا لم يكن الأوّل مقتضى الجمع العرفي ـ وهو الظاهر ـ فلا أقلّ من الإجمال .
ويردّه أنّ نسبة الحكم بالزوجيّة إلى الحكم بصحّة الطلاق هو نسبة الخاص إلى العام والمقيّد إلى المطلق ، فإنّ إطلاق صحّة الطلاق يقتضي نفي الزوجية بقول مطلق في العدّة وبعدها ، ودليل الزوجية في العدّة يقيّد ذاك الإطلاق .
ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ (قدس سره) وإن اختار كون الرجعيّة زوجة ، ولكنّه لم يأت في الدلالة على ذلك بما يقنع; حيث استدلّ لذلك بما تضمن أنّها تبين بانقضاء العدّة ، فتدلّ بالمفهوم على بقاء الزوجيّة قبل الانقضاء .
وأيّده بما تضمن ترغيبها في التزيّن وإراءة نفسها للرجل ليرغب في الرجوع ، مع أنّ الأجنبيّة لا يجوز لها ذلك . ثمّ قال : «ولأجل ما ذكرنا يجوز لزوجها النظر إليها
(الصفحة370)
في العدّة وتقبيلها ومسّها »(1) انتهى .
أقول : البينونة بعد العدّة بمعنى عدم صحّة الرجوع لا انقضاء الزوجيّة ، لا أقلّ من الاحتمال ، وذلك بقرينة المقابلة بين البائن وغيرها .
إلاّ أن يقال : إنّ ظاهر عدم البينونة قبل انقضاء العدّة ، هو بقاء العصمة السابقة وهي الزوجيّة ، فالاتّصال لا ينقطع ولا يبين إلاّ بعد العدّة .
ونيابة عصمة اُخرى تبيح الرجوع خاصّة خلاف المنساق ، فتأمّل .
وأمّا ما أيّد به الدعوى ، فيردّه أنّه تخصيص في دليل وجوب التستّر على المرأة وحرمة النظر على الرجل ، نظير ما ورد في جواز تكشّف المرأة لخاطبها وجواز نظره إليها ، أفهل يحتمل فقيه أن يكون في ذلك أضعف إيماء إلى الزوجيّة ؟! كلاّ ، ولكنّ الجواد قد يكبو; والعمدة ما قدّمناه .
ثمّ إنّ الظاهر من محكي كشف اللثام أنّ القول بكون الرجعيّة زوجة ، لا بحكمها ، مشهوراً مظنّة الإجماع .
قال في الجواهر ـ في مسألة عدم صحّة مراجعة المرتدّة ـ :
«في المسالك وغيرها ، بناء المسألة على أنّ الطلاق رافع لحكم الزوجيّة رفعاً متزلزلاً يستقرّ بانقضاء العدّة ، أو أنّ خروج العدّة تمام السبب في زوال الزوجيّة ، مؤيّداً للأوّل بتحريم وطئها لغير الرجعة . وفي كشف اللثام بأنّها ـ يعني الرجعة ـ ابتداء نكاح; فإنّ الطلاق زوال له والزائل لا يعود ، وإطلاق الزوجة عليها مجاز; لثبوت أحكامها لها وهو لا يفيد الزوجيّة .
والثاني ـ يعني مؤيّداً له ـ بعدم وجوب الحدّ بوطئها ، ووقوع الظهار واللعان والإيلاء بها ، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس ، بل في كشف اللثام: نسبته إلى
- (1) التنقيح 8: 126 ، الغسل المستحبّ .
(الصفحة371)
المفهوم من الأخبار والأحكام (والإجماع خ ل) والفتاوى ، وزاد بأنّها: لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح; ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها»(1) انتهى .
وممّن يظهر منه دعوى الإجماع على كون الرجعية زوجة هو الشيخ في محكي مبسوطه ، قال في طلاق السرائر : «فأمّا الطلاق الرجعي فهو أن يطلّق المدخول بها واحدة ويدعها تعتدّ . ويجب عليه السكنى لها والنفقة والكسوة ، ولا يحرم عليه النظر إليها ووطؤها ، ويحرم عليه العقد على اُختها وعلى خامسة إذا كانت هي رابعة .
وعقد الباب أنّها عندنا زوجة . وقال المخالف: حكمها حكم الزوجة .
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : بل هي عندنا زوجة; لأنّ المخالف قال : حكمها حكم الزوجات ، قال هو ردّاً عليه: بل هي عندنا زوجة ، ونِعم ما قال (رحمه الله)»(2) انتهى .
ثمّ استدلّ لتحقّق الرجوع بجملة من الأقوال والأفعال بقوله تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(3) ثمّ قال : «فسمّى المطلق طلاقاً رجعيّاً بعلاً ، ولا يكون كذلك إلاّ والمرأة بعلة» انتهى .
- (1) الجواهر 32: 187 .
- (2) السرائر 2: 667 . قال المعلّق تعليقاً على النقل عن المبسوط: «لا يوجد بعينه ، بل في كتاب الإيلاء خلافه ، والعبارة هكذا: إذا آلى من الرجعيّة صحّ الإيلاء; لأنّها في حكم الزوجات بلا خلاف» .
- (3) سورة البقرة الآية 228 .
(الصفحة372)
المسألة الثالثة : هل يجوز للمتوفى عنها زوجها ـ في العدّة أو بعدها ـ تلقيحها بماء زوجها ؟ فيه إشكال (1) .
(1) إذا قلنا بأنّ الزوجيّة تبطل بالموت ، وأنّها مغيّاة بالحياة ، كما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) فتصير المرأة أجنبيّة عن زوجها بموته ، فحرمة تلقيحها واضح بناءً على النصّ الخاص وإلاّ فالعدّة لا تقتضي تحرّزها من ماء زوجها; فإنّ الغرض من الاعتداد عدم اختلاط ماء زوجها الميّت مع ماء الأجانب ، كما أنّ التلقيح لاينافي الحداد .
وأمّا لو منعنا عن بطلان الزوجيّة بالموت فلا إشكال في حرمة تلقيحها بماء الأجانب ، لا للنصّ الوارد في إفراغ الماء في رحم امرأة تحرم عليه وإن كانت دلالته تامّة; بل لعنوان العدّة التي من جملة المقصود منها حفظ رحمها من اختلاط ماء زوجها الميّت بماء غيره .
وأمّا تلقيحها بماء زوجها فالظاهر أنّ حرمة التلقيح ممّا لا موجب له:
لا لعنوان العدّة ، فإنّ المقصود منها كما تكرّر عدم اختلاط ماء زوجها بغيره .
ولا للنصّ الخاصّ فإنّ الزوجة وإن حرم وطئها على الزوج بموتها وكذا يحرم عليها الاستمتاع ببدن زوجها ، ولكن لا يبعد أنّ المنساق من النصّ الخاصّ في مسألة التلقيح هو غير الزوجة ، فإنّ العنوان في ذلك النصّ هو المرأة المحرّمة ، لا التي
(الصفحة373)
يحرم وطئها ، فلا يشمل مثل وطء الحائض .
وإن شئت فقل: إنّ العنوان المأخوذ في النصّ هو عنوان مشير إلى غير الزوجة .
نعم ، لو كان مستند تحريم التلقيح آية حفظ الفرج فهي عامّة ، وسيأتي الكلام حول المسألة إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من اقتضاء العدّة ، عدم التلقيح بماء غير الزوج فهو بلحاظ غير ما كان الغرض منه خصوص الحداد ، فلو بلغ المرأة موت زوجها الغائب سنة وجب عليها الاعتداد ، لكنّه للحداد ، ولا ينافيه التلقيح كما تقدّم ، فلاحظ .
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
بقي الكلام فيما أشرنا إليه من الخلاف في كون الموت موجباً لبطلان الزوجية . قال سيّدنا الاُستاذ : «علقة الزوجيّة إنّما تنقطع بالموت عرفاً ، لا بانقضاء العدّة; إذ لا معنى لاعتبار الزوجيّة للجماد الذي منه الميّت»(1) .
أقول : ظاهر صدر كلامه تأثير الموت في زوال الزوجيّة عرفاً ، وظاهر ذيل كلامه أنّ إنشاء الزوجيّة محدود بحال الحياة إلاّ أن يرجع الأوّل إلى الثاني ، فلاحظ .
ويمكن الإشكال فيه بأنّ الزوجيّة بعد الموت كالزوجيّة حال الإغماء ، سيّما الذي لا يعود معه إلى الإفاقة ، أفهل يحتمل فقيه بطلان الزوجيّة بالإغماء ؟
وفي الجواهر في مسألة تغسيل الزوجة بعد العدّة: «قال في الذكرى : ولا عبرة
- (1) التنقيح 8 : 127 .
(الصفحة374)
بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض عندنا بعيداً ، انتهى . ونحوه في الروض والروضة وكذا جامع المقاصد ، بل يشعر قول: عندنا في الكتب الثلاثة بكونه مجمعاً عليه ، والظاهر أنّ مرادهم بالعدّة عدّة الوفاة .
وربّما استشكل في الحكم بعض متأخِّري المتأخِّرين; معلّلاً ذلك بصيرورتها أجنبيّة والحال هذه ، وفيه: منع صيرورتها أجنبيّة بذلك ، بل صدق اسم الزوجة عليها محقّق»(1) .
أقول : يبقى عليه ـ مع الغضّ عمّا ذكره سيّدنا الاُستاذ ـ النقض بما لو تزوّجت المرأة بعد وفاة زوجها ، فإنّ زوجيّتها مستلزم لكونها ذات بعلين ، فلو لم يكن الموت أو انقضاء العدّة سبب الفرقة فما هو السبب؟
ويمكن ردّه بعدم البأس بتعدّد البعل هكذا; فإنّ الممنوع تعدّد الزوج الحيّ لا الميّت أحدهما ، فليكن تعدّد الزوج في الفرض من قبيل تعدّد الزوجة في غير المقام جائزاً وإن كان فيه نوع من الاستيحاش بدواً .
ويؤكّد بقاء الزوجيّة بعد الموت ما ببالي في بعض الأخبار من كون زوجة المؤمن معه في الجنّة وأنّه يشفع فيها .
هذا ، ومع ذلك فلا يبعد ما أفاده سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) ; وذلك نظراً إلى قصور الإنشاء عن اعتبار الزوجيّة بعد الموت ، ولا أقلّ من الشكّ .
وأمّا النقض المتقدّم فيدفعه أنّ الإنشاء لا قصور فيه عن شموله مدّة الإغماء سيما إذا كان في معرض الإفاقة أو آيلاً إليها ، ويكون الإغماء كالنوم غير موجب لخروج مدّته عن إطلاق الإنشاء ، والله العالم .
- (1) الجواهر 4: 56 .
(الصفحة375)
ردّ التمسّك باستصحاب بقاء الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين
وأمّا الاستدلال لبقاء الزوجيّة بعد الموت بالاستصحاب ـ كما في كلام بعضهم(1)ـ فهو من الغرائب; إذ فيه:
أوّلاً : أنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب بعد الجزم باختصاص الزوجيّة بحال الحياة .
وثانياً : لو فرض الشكّ في بقاء الزوجيّة ، فإنّ استصحاب عدم إنشاء الزوجيّة لما بعد الموت حاكم على استصحاب بقاء الزوجيّة ، ولا أقلّ من المعارضة . وهذا من قبيل ما قيل في بحث عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، لحكومة استصحاب عدم الجعل على بقاء المجعول أو تعارضهما على الأقلّ .
وثالثاً : أنّ الاستصحاب لا يزيد على الجزم ببقاء الزوجيّة ، وهو لا يقتضي ترتيب الأحكام على الجسد المجرّد عن الروح وعلى الجماد ، لتعدّد الموضوع بلا ريب ; فإنّ بدن المرأة إنّما كان محكوماً بتلك الأحكام في حال الحياة ، باعتبارها إنساناً ، وقد انعدم هذا العنوان عن البدن بالموت ، فهو نظير استصحاب الزوجيّة لترتيب آثارها على الجزء المنفصل كاليد المقطوعة، ممّا لا يعدّ بعد الانفصال جزءً وإنّما كان جزءً قبل الانفصال .
ومنه يظهر الكلام فيما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من اتّصاف الجسد بعد الموت بالزوجيّة ، وكأنّه ناشئ من إطلاق عنوان زيد وهند على الجسد بعد الموت ، غفلة عن أنّه بالمسامحة ، وإلاّ فزيد كان الجسد المشتمل على الحياة .
ودعوى أنّ جسد المرأة صادق بعد الموت ، وكان الجسد موضوع الحكم حال الحياة .
- (1) مهذّب الأحكام للسيّد السبزواري .
(الصفحة376)
يدفعها أنّ الجسد لا بعنوانه ، بل بعنوان كونه إنساناً وزيداً وهنداً ، كان موضوع الحكم .
هذا ، مع أنّ إسناد الجسد إلى مثل زيد إنّما هو باعتبار الزمان السابق لا فعلاً ، فكما أنّ اليد المقطوعة لزيد لا تعدّ يده وجزءً منه فعلاً وحال الانفصال ، كذلك بدنه لا يعدّ بدناً له فعلاً وإنّما كان بدنه حال الحياة ، وربّما صار روحه فعلاً في بدن أو قالب آخر .
نعم ، ما كان بدناً سابقاً للإنسان ، موضوع للأحكام كوجوب التجهيز ونحوه ، وهذا لا يلازم كون انتساب البدن إلى الإنسان الميّت ، حقيقيّاً .
(الصفحة377)
المسألة الرابعة : إذا وضعت ذات الرحم المستأجرة ، حملها فدرّت ثدياها ، فهل يوجب لبنها إذا أرضعت ولداً آخر نشرَ الحرمة ؟ فيه إشكال (1) .
(1) البحث في نشر الحرمة بلبن المرأة المستأجرة للحمل ، من جهة أنّ الموجب لنشر الحرمة هو لبن الولادة ، وإذا فرض انتساب الولد إلى المرأة الاُخرى، فكيف تنتشر الحرمة بإرضاعها مع أنّ لبنها درّ من غير ولادة ؟
والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ عموم التحريم بالرضاع ، يقتضي عدم اختصاص الرضاع المحرّم بما كان اللبن عن ولادة كما هو ظاهر ، وما دلّ على التخصيص ، فالقدر المتيقّن منه ما إذا درّ اللبن بلا حمل ، فإن لم يتحقّق له إطلاق لما إذا كان اللبن من جهة الحمل كان المرجع عموم دليل الرضاع .
والسرّ في ذلك : أنّ الولادة تطلق على معنيين: الأوّل : باعتبار من انفصلت عنها النطفة ، والثاني : باعتبار وضع الحمل بعد التنمية . ويعبّر عن الثاني في الفارسية بـ «زايمان» ، فإذا لم يتحقّق خروج الولادة بالمعنى الثاني عن عموم دليل الرضاع كان الحكم هوالعموم لا غير .
مضافاً إلى كون عنوان غير الولادة واقعاً في سؤال الراوي ، ولعلّ المنساق منها ما هو المعهود لهم من كون الوضع بعد الحمل ممّن خلق الولد من مائها ، والمنساق من عدم هذا أيضاً ما هو المعهود لهم من درّ اللبن بلا ولادة ولا حمل ولا وضع . وأمّا
(الصفحة378)
فرض مجرّد الحمل فلعدم تصوّرهم له ، خارج عن مورد السؤال ، فتأمّل .
ففي صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : «لا»(1) .
رواه الصدوق في الصحيح ، وسند الكليني لا بأس برجاله إلاّ الميثمي فإنّه لم يوثّق .
ونحو هذه الرواية في الدلالة خبر يعقوب بن شعيب ، ولا بأس برجاله أيضاً إلاّ موسى بن عمر فإنّه لم يوثّق .
ويدلّ على تحريم اللبن في فرض مسألتنا: صحيح عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لبن الفحل ، قال : «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولَد امرأة أُخرى فهو حرام»(2) .
فإنّ المفهوم منه أنّ انتساب الولد إلى الأب والزوج كاف في نشر الحرمة وإن لم تنتسب الولادة إلى الاُنثى .
- (1) الوسائل 14: 302 ، الباب 9 من الرضاع ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر: 294 ، الباب 6 من الرضاع ، الحديث 4 .
(الصفحة379)
المسألة الخامسة : المعروف بين المتأخّرين أنّه لا يجوز تلقيح المرأة بنطفة الأجنبي . وعلى تقديره ، ففي لحوق الولد شرعاً بالزوجين ، شبهة ، والأقوى هو اللحوق(1) .
(1) يمكن أن يستدلّ للمنع من تلقيح المرأة بنطفة الأجنبي بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}(1) .
بناءً على أنّ حفظ الفرج لا يختصّ بخصوص الاستمتاعات ، بل هو مطلق لكلّ ما يناسب الفرج الذي منه التلقيح . وهذا الدليل هو العمدة في حكم المسألة ، وإلاّ فسائر ما يأتي من الوجوه لا يصلح إلاّ مؤيّداً للحكم .
ودعوى أنّ المنصرف من حفظ الفرج هو خصوص الوطئ أو مطلق الاستمتاع بحاجة إلى إثبات .
الثاني : قوله تعالى في بيان صفات المؤمن : {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}(2) .
ولكن استفادة اللزوم من الآية ، مع تضمّنها لبعض صفات المدح غير اللازمة ،
- (1) سورة النور الآية 31 .
- (2) سورة الأحزاب الآية 35 .
(الصفحة380)
كما ترى ، وإن كان لا يبعد ذلك; نظراً إلى أنّ حفظ الفرج مناسب للحكم الإلزامي ، فيكون مطلق حفظ الفرج ـ الذي منه التحفّظ عن التلقيح ـ أيضاً واجباً .
الثالث : قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(1) .
وقد ورد الاستدلال بهذه الآية في بعض المسطورات ، ولكنّه من الغرائب; فإنّ التلقيح ليس من شؤون الفرج في الرجل ، بل هو من شؤون حفظ الفرج في المرأة ، فلو كان الاستمناء على وجه محلّل فهل يكون أخذ النطفة وإلقائها في رحم غير الزوجة منافياً لحفظ الرجل فرجه؟ ولعمري هذا لمن العجب العجاب .
الرابع : معتبرة عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته (نطفة عقاب) في رحم يحرم عليه»(2) .
ودلالة الرواية واضحة، ولا موجب لجعلها كناية عن مجرّد حرمة الزنا; فإنّ إفراغ النطفة عادةً وإن كان في مورد الوطء إلاّ أنّ جعل النطفة في الرحم لا يختصّ قديماً وحديثاً بذلك ; فلذا لو أخذ الزاني نطفته بيده حرم عليه إدخالها في رحم المزنيّ بها زائداً على حرمة أصل الزنا ، بل ويحرم إفراغ المني ـ في الزنا ـ في الفرج زائداً على حرمة الزنا ، بل ويحرم إفراغها على الفرج إذا كان منشأ لتحوّلها إلى الرحم; كلّ ذلك لإطلاق الحديث المتقدّم لو صحّ سنده .
ويمكن الخدشة في الدلالة: بأنّ من المحتمل إرادة حرمة الإنزال في مورد الزنا ، ببيان أنّ المراد حرمة هذه المرتبة من التلذّذ في الزنا حرمة مغلّظة ; ولذا قال في عنوان الباب في الوسائل: «باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرّمة ، ووجوب
- (1) سورة المؤمنون الآية 5 و 6 .
- (2) الوسائل 14 : 239 الباب 4 من النكاح المحرّم ، الحديث 1 .
(الصفحة381)
العزل في الزنا»(1) فتأمّل .
ولكن السند مشتمل على ابن سالم ، ولم يرد فيه توثيق سوى أنّه روى عنه ابن أبي عمير على ما ببالي ، وروى عنه ابن عيسى ويونس; وقد أكثر عنه يونس فلا يبعد حصول الوثوق بخبره .
وقد بنى غير واحد على وثاقة كلّ من يروي عنه ابن أبي عمير ممّن لم يثبت أو لم ينقل جرحه; نظراً إلى قول الشيخ في العدّة ناسباً له إلى الأصحاب; حيث ذكر ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ، ثمّ قال: «وغيرهم ممّن عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة»(2) وإن ذهب بعض مشايخنا إلى أنّ هذا اجتهاد للشيخ من كلام الكشي في أصحاب الإجماع .
فإنّ تعبيره «عرفوا» يفيد وضوح القضية عند الأصحاب .
بل بغضّ النظر عن كلام الشيخ فإنّ رواية الأجلّة ، خصوصاً إكثارهم النقل من شخص ، ولاسيما النقل في مسائل غير واضحة ، دالّ على وثاقة المرويّ عنه في نظرهم، فتكون شهادة عملية بالوثاقة فضلاً عن كونه مدحاً موجباً لاندراج الخبر في الحسن الذي هو معتبر عند متأخّري الأصحاب ، وإن كان فيه إشكال عندي .
الإشكال في العمل بالأخبار الحسان وضابط الخبر الحسن
والإشكال بالنظر إلى أنّ المدح الموجب لكون الخبر حسناً اصطلاحاً ، إن كان دالاًّ على التوثيق ـ وإن لم يكن بلفظه ـ كما لو قيل: «إنّه خيّر» أو «وجه أصحابنا»ونحوهما ، فالخبر باعتباره يكون صحيحاً لا حسناً; حيث لا يشترط في
- (1) نفس المصدر 20: 317 .
- (2) خاتمة المستدرك 5: 120 ، نقلاً عن عدّة الأصول .
(الصفحة382)
الوثاقة أكثر من التوثيق ، لا بتعبير خاص ، وإلاّ فيرجع التفريق بين ما ثبتت وثاقة الراوي فيه بلفظ وغيره ، بِعدّ أحدهما حسناً والآخر صحيحاً ، مجرّد اصطلاح لغو لا فائدة مهمّة فيه ، وهذا لا ينبغي صدوره من أصاغر الطلبة فضلاً عن أعاظم الفقه ممّن أسّسوا هذا الاصطلاح .
وإن كان ذاك المدح لا يدلّ على توثيق مخبره لا يمكن التعويل عليه; ولا دليل على اعتباره ، فإنّ نهاية ما قامت عليه السيرة ودلّت عليه الأدلّة هو اعتبار خبر الثقة لا الممدوح .
وقد ذهب سيّدنا الأستاذ (قدس سره) إلى حجّية الخبر الحسن كخبر الثقة، قال في المحكي عنه : «فتحصّل أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة ، ولا يرد على الاستدلال بها شيء من الإشكال . ولا يخفى أنّ مقتضى السيرة حجّية الصحيحة والحسنة والموثّقة; فإنّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة ، فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته ، أو بنقل ثقة غير إمامي لا يكون العبد معذوراً في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء»(1) . انتهى .
أقول : ليت شعري إذا كان المدرك بناء العقلاء، فهل يفرّقون بين خبر الإمامي الممدوح وغير الإمامي ؟ ولعمري إنّ هذه الدعوى لمن أعجب العجاب .
وقد حكى لي بعض السادة أنّ المحدّث النوري ذكر أنّ الخبر الحسن راجع إلى الصحيح; بناءً على اعتبار حسن الظاهر كافياً في العدالة ، كما هو مبنى غير واحد .
وقد حكى المحدّث المتقدّم ، عن بحر العلوم في رجاله كلاماً يماثل ما ذهب إليه مؤيّداً لمختاره ، قال: «التحقيق أنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها; فإنّه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه ، بخلاف الحسن فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر ، المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال .
- (1) مصباح الاُصول 2: 200 .
(الصفحة383)
وبهذا يزول الإشكال في القول بحجّية الحسن ، مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب . انتهى ما أردنا نقله من كلامه الذي هو القول الفصل والكلام الجزل في هذا المقام الذي زلّت فيه أقدام الأعلام»(1) انتهى كلام المحدّث النوري .
أقول : يظهر من كلام المحدّث النوري (قدس سره) وما حكاه عن السيّد بحر العلوم ، أنّ مطلق المدح لا يوجب اندراج الخبر في الحسن ، بل ذاك هو المدح الكاشف عن العدالة . وعليه ليتني كنت أدري أنّ من شهدوا بوثاقته من كثير من الرواة فهل كان مدرك الشهادة عندهم سوى حسن الظاهر ، فعاد التفريق بين قسمي الحديث اصطلاحاً لغواً ، بل رجعت جلّ الأحاديث الصحيحة حساناً .
وقد ذكر بعض مشايخنا أنّه لمّا كان مدرك حجّيّة الخبر هو السيرة العقلائية ، والعقلاء يعتبرون المدح طريقاً إلى الوثاقة وحجّة عليها ، جاز العمل بالأخبار الحسان كالموثّقات والصحاح .
أقول : إن كان مراده كون المدح دالاًّ على الوثاقة فيرجع إلى ما ذكرناه أوّلاً وأشكلنا عليه . وإن كان مراده كون المدح دالاًّ على حسن الظاهر ـ الذي هو حجّة على العدالة ـ فيرجع إلى كلام النوري ، وقد تقدّم إشكاله .
وإن كان مراده أنّ بناء العقلاء على العمل بخبر الممدوح مطلقاً ، فيرجع إلى كلام سيّدنا الأستاذ (قدس سره) ، وقد تقدّم ما فيه .
مضافاً إلى أنّه لم يثبت بناء من العقلاء على العمل بخبر الممدوح ، بل ربما ذهب غير واحد إلى عدم حجّية خبر الثقة ، وإنّما الحجّة الخبر الموثوق به ، فما ظنّك بخبر الممدوح ؟
ثمّ إنّه قد يقال : إنّ الخبر الصحيح هو ما كان راويه إماميّاً ثبتت وثاقته بنصّ ،
- (1) خاتمة المستدرك 7: 97، الفائدة التاسعة .
(الصفحة384)
كالتعبير عنه بأنّه ثقة ، ومثل هذا التعبير يدلّ مضافاً إلى وثاقة المخبر بمعنى أنّه لا يتعمّد الكذب، علىوثاقة خبره بحسب العادة، بمعنى أنّه ضابط لمايحكيه من الأخبار.
والدلالة على كون الراوي ضابطاً إمّا بنفس دلالة اللفظ الدالّ على التوثيق ، أو بالإطلاق المقامي ، فإنّ الغرض من التوثيق ـ لو كانت دلالته اللفظية على مجرّد وثاقة المخبر ، بمعنى عدم تعمّده الكذب ـ إنّما هو صحّة الاعتماد على خبره; وهذا لا يتمّ بمجرّد الصدق من حيث المخبر ما لم ينضمّ إليه الصدق من حيث الخبر ـ أعني الضبط ـ فيكون السكوت عن عدم الضبط دالاًّ على كون الموثّق ـ بالفتح ـ ضابطاً .
وأمّا إذا كان الرجل ممدوحاً فإنّ نهاية ما يدلّ عليه المدح هو إثبات العدالة ، وهذا لا يدلّ لا لفظاً ولا بإطلاق مقامي على الضبط; لعدم كون المدح بلحاظ مقام الرواية ، فلابدّ من إثبات الضبط بدليل آخر .
ولا يبعد بناء العقلاء على الضبط عند الشكّ، وأنّ من ثبتت عدالته ووثاقته من حيث الاخبار ـ بمعنى عدم تعمّده الكذب ـ يبنون على ضبطه ووثاقته من حيث خبره أيضاً ما لم يثبت الخلاف .
أقول : هذا وجه جيّد للتفصيل بين الخبرين لو تمّ بناء العقلاء على كون الرجل ضابطاً عند الشكّ أوّلاً ، وكان مراد أهل الفنّ من المدح الموجب لكون الخبر حسناً هو المدح الدالّ على العدالة ثانياً; وفيهما معاً تأمّل سيما الثاني كما يظهر من موارد استعمالاتهم لهذا الاصطلاح وإن كان الأوّل غير بعيد ، والله العالم .
قال أبو علي في رجاله: «فائدة: من المدح ماله دخل في قوّة السند وصدق القول ، مثل: خيّر وصالح . ومنه ما له دخل في المتن ، مثل: فهيم وحافظ . ومنه ما لا دخل له فيهما ، كشاعر وقارئ; ومنشأ صيرورة الحديث حسناً وقويّاً هو الأوّل ، وأمّا الثاني فيعتبر في مقام الترجيح والتقوية بعد كون الحديث معتبراً ، وأمّا الثالث فلا اعتبار له لأجل الحديث . نعم ، ربّما يضم إلى التوثيق وذكر أسباب الحسن والقوّة ، إظهاراً لزيادة الكمال فهو من المكمّلات» . انتهى .
(الصفحة385)
أقول: كلامه في تحديد الخبر الحسن واضح الدلالة على أنّ القوّة فيه لا تبلغ حدّ الوثاقة ، وإن كان تمثيله للألفاظ الدالّة عليه لا يخلو من مسامحة ، فإنّ الخيّر والصالح لا يكاد يطلقان على الكاذب أو المتّهم به ، إلاّ أن يرجع إلى ثبوت الصلاح والخير عن الرجل وعدم تحقّق خلافه ومنه الكذب فيرجع الخبر الحسن نوعاً ما إلى ما أفاده النوري .
وقال المولى علي الكني في توضيح المقال: «وأمّا الحسن فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بما لم يبلغ حدّ الوثاقة مطلقاً ، فإن بلغ حدّها ففي البعض خاصّة»(1) انتهى .
وربما ينسب إلى أهل السنّة الذين هم الأصل في تقسيم الحديث على أساس هذه الاصطلاحات ، ومنهم سرى إلينا ، ولذا عيّر الأخباريون منّا الاُصوليين في متابعة هذه الاصطلاحات ، أنّ المعنيّ بالحسن ما كان راويه ثقة كالصحيح إلاّ أنّ اختلافه عن الصحيح في الضبط; وكان الغرض من ذلك توجيه العمل بأحاديث بعض الرواة ممّن كان ردّ أحاديثهم موجباً لذهاب كثير من أحاديثهم .
التحقيق في الأخبار الحسان
والضابط في جواز العمل بالخبر هو كون الراوي مشتملاً على صفتين:
إحداهما: الوثاقة في القول ، بمعنى عدم احتمال تعمّده الكذب أو عدم كون احتماله بحدّ يعتنى به .
ثانيهما: الوثاقة في المقول ، والذي يصطلح عليه عندهم بالضبط ، وكون
- (1) توضيح المقال: 246 ، طبعة دار الحديث.
(الصفحة386)
الراوي ضابطاً لا يسهو خارجاً عن المعتاد .
والوجه في الأوّل ظاهر; فإنّ الأدلّة اللفظية وبناء العقلاء متطابقة على ذلك .
والوجه في الثاني ـ مع عدم ورود لفظ الضبط في الآثار ، مضافاً إلى ما يمكن أن يقال من تضمّن لفظة الثقة لذلك أو إيحائه إليه ـ هو أنّ بناء العقلاء الذي هو العمدة في العمل بالأخبار على ذلك; والأدلّة اللفظية مُمضية لهذا البناء; ولم تؤسّس; ولئن اختلفت عن مورد البناء فبزيادة مثل قيد العدالة التي لا تنافي الإمضاء .
وعليه فلو كان الراوي ثقة من الجهتين جاز العمل بخبره ، عبّر عنه بالحسن أو غيره ، وإلاّ فلا ، كذلك . وقد خرجنا عن وضع الرسالة لعدم تعرّضهم لهذه المسألة في الكلمات بصورة منقّحة فيما أعلم ، والله الهادي .
الخامس : ما رواه الصدوق بسنده إلى سليمان بن داود المنقري عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً»(1) .
ورواه في الفقيه مرسلاً; وسند الخصال لا بأس برجاله إلاّ القاسم بن محمّد وهو الإصبهاني المعروف بكاسام أو كاسولا ، والذي استظهر الأردبيلي اتّحاده مع القمي والجوهري; وقد أكثر الأجلاّء في النقل عنه; وأكثر هو في النقل عنهم .
وعن النجاشي: «لم يكن بالمرضيّ»(2) ولعلّه يعني بذلك ما عن ابن الغضائري: «إنّ حديثه يعرف تارةً وينكر اُخرى ويجوز أن يخرج شاهداً»(3) . وعليه فهو ممدوح نوعاً ما فيكون الحديث حسناً .
هذا ، ولكنّ الظاهر قصور الخبر عن الدلالة; فإنّ «حراماً» حال للإفراغ ،
- (1) الوسائل 14: 239 ، الباب 4 من النكاح المحرّم ، الحديث 2 .
- (2) رجال النجاشي: 315 ، الرقم 863 .
- (3) خلاصة الأقوال: 389 ، الرقم 5 .
(الصفحة387)
فتدلّ على أنّ الاستمناء المحرّم مع صبّ النطفة في الرحم محرّم ، فهو من قبيل الكبرى والضرورة بشرط المحمول ، ويكفي مصداقاً له مثل الزنا أو وطء الحائض .
وبتعبير آخر يستفاد من الخبر أنّ الإفراغ يقع على وجهين، وأمّا تعيين المحرّم لا، إلاّ أن يكون حراماً ، تمييزاً للمرأة أي امرأة محرّمة; نظراً إلى تساوي المصدر في المؤنّث والمذكّر .
ويمكن أن يورد عليه: باحتمال كون المراد حرمة التلذّذ بالإنزال في مثل الزنا ، كما تقدّم في الخبر السابق .
السادس : خبر إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الزنا شرّ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة ؟
فقال : «يا إسحاق! واحد ، ولكن زِيدَ هذا لتضييعه النطفة ، ولوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّوجلّ به»(1) .
ولو تمّت دلالته إلاّ أنّ سنده ضعيف .
فتحصّل: أنّ العمدة في الدلالة هي ما تقدّم من الآية; وغيرها لو تمّت دلالته فهو مؤيّد .
ويمكن الاستدلال لحرمة تلقيح الأجنبيّة في المسألة في الجملة ، ببعض النصوص الواردة في بعض أحكام الأنساب .
عدّة من أحكام النسب
الأوّل : عدم جواز إثبات النسب على خلاف موازين الشرع ـ والتي هي مبنيّة على موازين العرف ـ ما لم يثبت اصطلاح خاصّ للشارع في مورد ، كما ادُّعي
- (1) الوسائل 14: 267 ، الباب 28 من النكاح المحرّم ، الحديث 4 .
(الصفحة388)
ونسب إلى المشهور في ولد الزنا ، وأنّه منفيّ شرعاً عن أبويه .
مثلاً: الولدمنسوب إلى أبيه عرفاً وشرعاً; فلا يجوز التبنّي على ما هو المتعارف من أخذ الولد المجهول النسب أو الفاقد للأبوين لموت وغيره ، ونسبته إلى آخذه .
ويدلّ عليه : ـ مضافاً إلى قوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الاَّئِى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً}(1) . ومضافاً إلى كلّ ما دلّ على موازين الأنساب بحسب الثبوت ـ عدّة من الروايات : منها: ما تضمّن المنع من نسبة شخص إلى غير أبيه .
1 ـ فعن المثنّى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «وجد في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة : إنّ أعتى الناس على الله ، القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادّعى لغير أبيه فهو كافر بما أُنزل على محمّد (صلى الله عليه وآله) . . .» الحديث(2) .
2 ـ وفي مرسل تحف العقول عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) في خطبة حجّة الوداع أنّه قال : «أيّها الناس إنّ الله قد قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث; والولد للفراش وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(3) .
الثاني : عدم جواز نفي نسب محقّق ثبوتاً على الموازين الشرعيّة ، أو ثابت شرعاً عند الشكّ .
ويدلّ عليه أوّلاً: ما دلّ على ميزان الأنساب :
- (1) سورة الأحزاب الآيتان 4 و 5 .
- (2) الوسائل 19: 11 ، الباب 4 من القصاص في النفس ، الحديث 2 .
- (3) الوسائل 13: 376 ، الباب 16 من أحكام الوصايا ، الحديث 14 .
(الصفحة389)
1 ـ رواية الفضيل بن سعدان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان في ذؤابة سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس جميعاً على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً . وكفر بالله العظيم الانتفاء من نسب وإن دقّ»(1) .
2 ـ صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كفر بالله من تبرّأ من نسب وإن دقّ»(2) .
ورواه في الوسائل أيضاً بسند آخر في باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت من كتاب النكاح ، الباب 107 من أحكام الأولاد .
3 ـ رواية ابن أبي عمير وابن فضّال عن رجال شتّى ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) إنّهما قالا : «كفر بالله العظيم من انتفى (الانتفاء) من حسب وإن دقّ»(3) .
أقول : الظاهر أنّ الحسب سهو ، والصحيح هو النسب .
وأمّا ما يدلّ على عدم جواز نفي النسب الثابت شرعاً وإن كان مشكوكاً ، فهو كلّ ما دلّ على أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وهي روايات كثيرة :
1 ـ معتبرة سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدّعي الحمل ؟ قال : «ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر»(4) .
2 ـ معتبرة سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق؟ قال : «يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قال :
- (1) نفس المصدر 19: 12 ، الباب 4 من قصاص النفس ، الحديث 6 .
- (2) نفس المصدر 18: 568 ، الباب 10 من حدّ المرتدّ ، الحديث 51 .
- ورواه بسند آخر في 15 / 222 ، الباب 107 من أحكام الأولاد .
- (3) نفس المصدر 15: 222 ، الباب 107 من أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
- (4) الوسائل 14 : 565 ، الباب 56 من نكاح العبيد ، الحديث 1 .
(الصفحة390)
أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد»(1) .
وقوله : «يطيف بها» يعني به ظاهراً الدخول والاستمتاع منها .
3 ـ روايته الاُخرى ـ والظاهر اتّحادهما ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : «أرى أن لا يباع هذا يا سعيد» قال : وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال : «أتتّهمها ؟» فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : «أيتّهمها أهلك ؟» قلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : «فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد»(2) .
4 ـ خبر الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : «بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود» قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث ؟ قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر»(3) .
إلى غير ذلك ممّا تضمن أنّ الولد للفراش .
ويدلّ عليه ثانياً: ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان يعزل ، معلّلاً بأنّ «الوكاء قد ينفلت»(4) .
وثالثاً: ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان ينزل على الفرج وإن لم يدخل(5) .
ويؤيّده ما تضمّن ثبوت اللعان بنفي الولد .
الثالث : عدم جواز إثبات نسب عند الشكّ على خلاف الموازين .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 5 .
- (3) نفس المصدر ، الباب 58 ، الحديث 2 و 3 .
- (4) الوسائل 15: 113 ، الباب 15 من أحكام الأولاد ، الحديث 1 .
- (5) نفس المصدر ، الباب 16 من أحكام الأولاد .
(الصفحة391)
والفرق بين هذاالحكم وماذكرناه أوّلاً: هوأنّ الأوّل يتعلّق بمرحلة الثبوت ، وأنّ الولد المتحقّق كونه من نطفة فلان ومن رحم كذا لا يجوز نسبته إلى غير أبيه واُمّه .
والثاني: يرتبط بمرحلة الإثبات ، وأنّه إذا كانت الحجّة تعيّن نسبة شخص إلى مورد ، فلا يجوز دعوى تغاير تلك النسبة .
كما أنّ الفرق بين هذا وبين الحكم الثاني هو أنّه في الثاني يحكم بعدم جواز نفي النسبة، عمّن تقتضي الموازين النسبة إليه،وفي هذايحكم بعدم جوازالنسبة إلى الخلاف.
مثلاً: الميزان في النسب عند الشكّ إمّا الفراش أو البيِّنة أو الشياع ، ولكن لا يجوز إثبات النسب بالقيافة حتّى إذا لم يكن دليل على عدم ثبوت النسب بها .
ويدلّ على هذا الحكم ـ مضافاً إلى الأصل حيث لا دليل على اعتبار أمارة ـ إطلاق حديث الفراش; فإنّ الفراش حجّة على النسبة وإن كانت القيافة ونحوها تقتضي خلافه .
حكم التسبيب إلى اشتباه النسب
وهذه الطائفة هي المرتبطة بالمقام; فإنّ تلقيح المرأة بنطفة غير زوجها عرضة لاختلاط الأنساب ، فيما جهل صاحب النطفة ، بل وفيما علم ، فإنّه مع ذلك ربما يوجب التنازع والتشاحّ حيث لا حجّة على تعيين صاحب النطفة عند الخصومة ، ولا أمارة على تعيين صاحبها كما في الزوج والفراش .
وبما يدلّ عليه ، يمكن الاستدلال لحرمة الاستتئام ، فإنّه يوجب اشتباه النسب وتمويهه على الناس ، فلا يُدرى أنّ ابن زيد هو أيّ من المتشابهين .
وكيف كان فيدلّ عليه اُمور:
الأوّل: جميع ما دلّ على ثبوت العدّة في الطلاق ، والاستبراء في ملك اليمين وفي
(الصفحة392)
الزنا; فإنّ المنساق منها هو حفظ الأرحام عن اختلاط المياه واشتباه من كان الولد منه.
فإن قلت : إنّ المحذور بحسب النصّ هو اشتباه النسب على نفس المنسوب ، حيث تضمّن النصّ أنّ المحذور عدم دراية الولد بأنّه ممّن .
قلت : بل المحذور أعمّ منه ومن عدم دراية غيره النسبة; حيث تضمّن النصّ ـ أيضاً ـ عدم دراية المرأة مَن أحبلها. كماأنّ من عموم التعليل يستفادعدم خصوصيّة جهالة الانتساب إلى الأب، وأنّ التسبيب إلى جهالة الانتساب إلى الاُمّ أيضاً كذلك.
والفرض الممكن من ذلك في الأعصار السابقة هو تبديل طفلين متولّدين من اُمّين ، أو جعلهما في مكان واحد بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر ; والممكن منه في هذه الأعصار هو أخذ ماء امرأة مجهولة لتلقيحه بنطفة رجل وزرعه في رحم امرأة اُخرى ، بناءً على انتساب الولد إلى المرأة التي أخذ مائها لا إلى الحامل .
الثاني: ويدلّ عليه ـ أيضاً ـ ما دلّ على تعليل حرمة الزنا بأنّ فيه ذهاب الأنساب، وفي تعبير آخر: انقطاع الأنساب ، وأنّ المرأة لا تعلم من أحبلها ، والولد لا يعرف أباه.
الثالث: ويدلّ عليه تعليل عدم جواز تزويج المرأة بأكثر من رجل ، بخلاف العكس ، بأنّ الولد لا يعرف لمن هو ، وفيه فساد الأنساب والمواريث والمعارف .
الرابع: ويدلّ عليه ما ورد في تعليل حدّ القذف، بأنّ فيه نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب ، راجع للتعرّف على حقيقة هذه الأدلّة سيما الثلاثة الأخيرة أخبار محمّد بن سنان(1) ومرسلة الاحتجاج(2) .
- (1) الوسائل 14: 234 ، الباب 1 من النكاح المحرّم ، الحديث 15 .
و14: 398 ، الباب 1 من العدد ، الحديث 2 .
و18: 432 ، الباب 2 من حدّ القذف . و 18: 174 ، الباب 5 من كيفيّة الحكم .
(2) نفس المصدر 14: 252 ، الباب 17 من النكاح المحرّم .