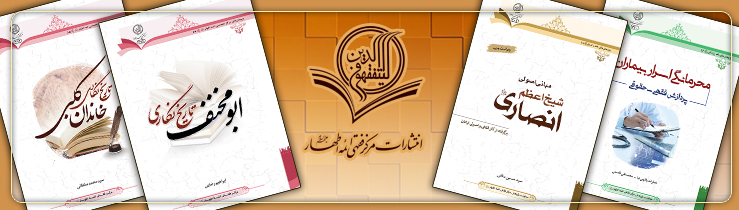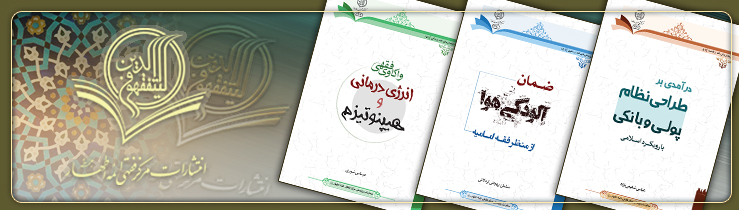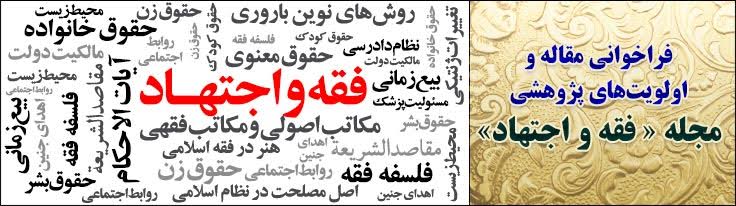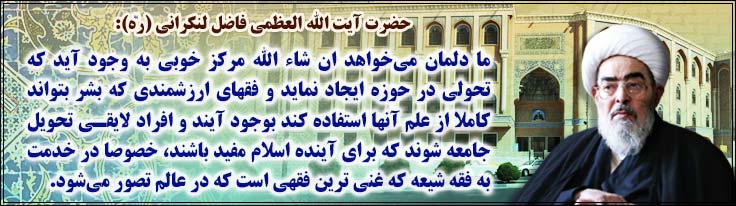(الصفحة141)
التمسّك بقاعدة الإضطرار لتجويز أخذ عضو من الميّت
الأوّل: قاعدة الاضطرار المستفادة من حديث : «ما من محرّم إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه»(1) وذلك حيث تصدق الضرورة كحاجة المريض في بقاء حياته أو
- (1) قد ورد عنوان نفي التكليف عند الاضطرار في حديث الرفع فهذا ليس مورد استشهادنا .
- وورد حلّ عامّة المحرّمات للمضطرّ إليها في أحاديث هي:
- 1 ـ موثّق أبي بصير بسماعة ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: «لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها; وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» . الوسائل 4: 690 ، الباب 1 من القيام ، الحديث 7 .
- 2 ـ موثّق سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة ، أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيّام إلاّ إيماءً وهو على حاله؟ فقال: «لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّ لمن اضطرّ إليه» المصدر ، الحديث 6 .
- 3 ـ ونحوهما صحيح محمّد بن مسلم المروي في الباب 7 من أبواب القيام الحديث 1 .
- 4 ـ موثّق سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اُكره واضطرّ إليه وقال: ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه . رواه في أيمان الوسائل الباب 12 الحديث 18 .
- وهذا المضمون هو الذي نعنيه في المقام وغيره ممّا يأتي .
- وقد قرّبنا في محلّه دلالة هذه الأحاديث على قاعدة الميسور بعد قصور ما ذكر لها من دليل . ولئن تمّ للقاعدة دليل فهو هذا . وحملها على تطبيق قاعدة الاضطرار على سقوط ذات الشرط ولو بسقوط المركب لا سقوط الشرطية مع بقاء المركب بعيد في الغاية سيما في الأوّل .
- كما أنّ حملها على تطبيق المحرم المضطرّ إليه على ترك الواجب الاختياري خلاف الظاهر .
- كما وذكرنا في فقه الحديث أنّ الحرام والحلال في الأحاديث لا تخصّ التكليفيين ، بل يعمّان الحرمة والحلّ الوضعيّين . ومن جملة موارد استعمالهما في الوضعين زيادة على التكليفين هو روايات المقام بقرينة تطبيقها على المورد ، أعني الصلاة مستلقياً وحال إمساك المرأة للمسجد .
- وعلى هذا الأساس قرّبنا دلالة آية حلّ البيع على صحّته ، لا أنّ حلّ البيع بمعنى الحلّ تكليفاً واستفادة الصحّة بالملازمة وغيرها . فما اشتهر أنّ الأصل في الحلّ والحرمة هو التكليفي منهما في غير محلّه .
- بل يصرف اللفظ بمناسبة الموارد على المناسب من التكليف أو الوضع أو هما .
- والمناسب للمعاملات كالبيع هو الوضع أعني الصحّة; لأنّه المعنيُّ بإنشائها; بخلاف مثل الأكل والشرب فإنّ المناسب لهما التكليف .
- وعليه فحمل الحلّ والحرمة في المعاملات على التكليفي وإن كان ممكناً عقلاً ولكنّه بحاجة إلى عناية وقرينة في مقام الإثبات كما في حرمة البيع الربوي .
- ومنه يظهر الكلام في الأمر والنهي في المعاملات فإنّ الظاهر من نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر هو عدم صحّته لا حرمته تكليفاً كالبيع الربوي فضلاً عن ظهوره في ذلك .
(الصفحة142)
سلامته في أمور يعدّ انتفاؤها حرجاً على المكلّف ، إلى عضو من الميّت; فإنّه مع تسليم كون القاعدة المتقدِّمة امتنانية لا مانع من تطبيقها على المقام وإن نافى الامتنان على الميّت ، فإنّ الأحاديث الامتنانيّة وإن نيطَ جريانها بعدم استلزامه خلاف الامتنان على مسلم آخر . ولكن المتيقّن من ذلك هو استلزام جريانه خلاف الامتنان على الأحياء دون الأجساد والموتى أو موارد اشتباه الحياة مفهوماً; فإنّه لا قصور في عمومها عن شيء من ذلك . نعم ، لابدّ أن لا يعدّ الفعل هتكاً ولو للميّت .
على أنّه لا موجب لتخصيص قاعدة الاضطرار المستندة إلى الحديث المتقدّم بمواردالامتنان وإن اختصّت قاعدة الاضطرارالمستندة إلى حديث الرفع بتلك الموارد.
الثاني: التمسّك بقاعدة الإلزام لأخذ العضو من الميّت، و ممّا يمكن أن يستدلّ به لجواز أخذ الأعضاء في الجملة من الميّت بل ممّن مات دماغه ، هو قاعدة الإلزام حيث تجري في الكفّار وأهل السنّة من المسلمين ، فلو كان الشيعي بحاجة إلى قلب أو عضو آخر وكان السنّي يرى جواز بذل الأعضاء بعوض أو مجّاناً لغيره وفرض أنّه باع عضواً من نفسه حال الحياة لتؤخذ بعد موت أو نحوه ، وكان يعتقد في مذهبه جواز ذلك ووجوب البذل معه ، جاز للشيعي أخذ العضو منه ، بناءً على قاعدة الإلزام وإن كانت القاعدة ـ لولا الإلزام ـ عدم جواز ذلك كما هو الشأن في سائر تطبيقات قاعدة الإلزام ، حيث إنّ الحكم الأوّلي مخالف لها ويجوز الأخذ بعنوان حكم واقعي ثانوي كالحكم في موارد الحرج والضرر وغيرهما .
وتوضيح المطلب ببعض التفصيل ، هو أنّ الذي يؤخذ منه عضو قد يكون أخذه وقطعه منه حال الحياة، فلا إشكال حينئذ لانطباق قاعدة الإلزام على
(الصفحة143)
نفس باذل العضو ، بل لو كان العضو ممّا تتقوّم به الحياة وكان يرى جواز بذله ويكون ذلك مستلزماً لإعدامه ، جاز أيضاً بناءً على عموم قاعدة الإلزام . غير أنّ قاعدة الإلزام موردها ما إذا عاد نفع بسبب جريانها إلى الشيعي ، فلو انتفع الشيعي بعضو من سنّي وكان السنّي يرى صحّة بذله بمثل بيع وباعَ أُلزم حينئذ بذلك .
وأمّا إذا كان أخذ العضو منه في زمان لا يصحّ إلزامه ، لموت أو إغماء أو ذهاب شعور مع بقاء حياة بعض الأعضاء ، فقد تنطبق قاعدة الإلزام بلحاظ وليّه أو أهل نحلته ، فليس لهم مزاحمة الشيعي في أخذ أعضاء سنّي بيع عضوه ليؤخذ في مثل حال الموت الدماغي حيث يرون جواز ذلك ، فالإلزام وإن لم يطبّق على نفس مَن يؤخذ منه العضو لعدم قابليّته للإلزام، ولكنّه يطبّق على من يزاحم أخذ العضو من أهل ملّته هذا .
مع احتمال إلزام نفس من يؤخذ منه العضو بلحاظ حال شعوره وإن كان ظرف الفائدة هو حال الموت الدماغي .
هذا مضافاً إلى أنّ دليل الإلزام لا ينحصر في هذا العنوان ، بل عمدة الدليل هو ما تضمّن جواز ما يستحلّه أهل دين عليه ، وما تضمّن لزوم ما يدين به الشخص عليه ، وهذا العنوان ينطبق حال الموت كما يمكن تطبيقه حال الحياة فيقال للميّت حال موته: إنّه يجوز عليه ما كان يستحلّه وإنّه دانَ بلزوم بذل العضو حال موته فيلزمه ذلك . فعنوان الإلزام وإن كان لا يصدق بالموت إلاّ أنّ عنوان اللزوم والجواز صادق عليه .
وأمّا إذا مات السنّي وقد باع هو أو وليّه أعضاءه فيظهر حكمه من الفرض السابق ، فإنّه إذا جاز أخذ أعضائه حال حياته فكيف بما بعد الموت .
ودعوى عدم صدق الإلزام بالنسبة إلى الميّت ، تقدّم دفعها صغرى وكبرى .
(الصفحة144)
فإن قلت : إنّ الإلزام إنّما يجري حيث لا يكون الشيعي مكلّفاً بحكم تكليفي إلزامي في مورده ، ومعه فلا يصحّ مخالفته استناداً إلى قاعدة الإلزام; فلا يجوز مثلاً بيع الخمر للذمّي استناداً إلى الإلزام; وذلك لحرمته على المسلم ، ولا يكون الإلزام رافعاً للحرمة وإن كان على تقدير البيع وارتكاب الحرام يستحقّ الثمن عليه ، للإلزام . وحيث لا يجوز أخذ أعضاء المسلم والمُثلة به ، ولا موضوع للإلزام في مورده ليرفع التحريم فلا مجال لارتكابه .
وإن شئت فقل : إنّ الإلزام حيث يتحقّق موضوعه ترتّب عليه الحكم; ولا موضوع له في مورد بيع الخمر قبل تحقّقه وإن كان بتحقّقه يتحقّق موضوع الإلزام بالثمن . وكذا لا موضوع له في الميّت السنّي بلحاظ المثلة به; لعدم قابليّته للإلزام . وجواز إلزام وليّه أو أهل نحلته بعدم المزاحمة لأخذ أعضائه ، لا يسوغ ارتكاب ما هو محرّم على الشيعيّ كحرمة بيع الخمر .
قلت أوّلاً : تقدّم صدق الإلزام في مورد الموت الدماغي .
ثانياً: عدم دوران جريان مفاد قاعدة الإلزام مدار صدق الإلزام ، فراجع .
وثالثاً: نمنع اختصاص قاعدة الإلزام بما لا يكون في مورد الملزم الشيعي حكم إلزامي ، بل موردها في الروايات ـ وهو مطلقة السنّي ـ ما يكون الملزم مكلّفاً بحكم إلزاميّ لولا القاعدة .
رابعاً: أنّ المستفاد من أدلّة حرمة الميّت ، أنّ حرمته واحترامه حال موته كحرمته حال حياته ; فإذا كان الميّت حال حياته لا حرمة له ولو بلحاظ هدر عضوه ببيع ونحوه فلا حرمة له بعد موته أيضاً; لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ على ما في النصّ .
وإن شئت فقل : إنّه إذا جاز أخذ عضوه حيّاً للإلزام ، جاز أخذ عضوه ميّتاً ، لقصور دليل حرمته ميّتاً عمّا لا حرمة له في حال الحياة .
(الصفحة145)
نعم ، ورد في بعض النصوص أنّ حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ ، ولكن مفروضه هو من له حرمة حال الحياة تكون حرمته بعد الموت أشدّ وأعظم ، وهذا ممّن لا حرمة له في حياته; إلاّ أن يُراد حرمته بلحاظ غير قطع العضو في حال الحياة ، وتكون حرمته بعد الموت بلحاظ قطع العضو ، فتأمّل .
ولو قصر الدليل عن إثبات حلّ أخذ عضوه حال موته ، كفى في الجملة استصحاب ذلك; بناءً على جريانه في الشبهة الحكمية .
لا يقال : إنّ جواز فعل حال الحياة للإلزام لا يلازم جوازه حال الموت ، ألا ترى أنّه يجوز لوليّ الدم قطع رأس الجاني قصاصاً ، ولو مات الجاني قبله لا يجوز له قطع رأسه .
فإنّه يقال : لو تمّ ذلك فإنّما هو لكون الدليل على جواز قطع رأس الجاني هو سلطنة الولي على القصاص المتقوّم صدقه بحياة المقتصّ منه ، فلا يصدق القصاص إلاّ على قتل الجاني المتحقّق بقطع رأسه حيّاً لا مطلق قطع الرأس .
وإن شئت قلت : إنّ الموضوع هو القصاص لا قطع الرأس والقتل ، والقصاص عنوان توليدي يحقّقه قطع الرأس ، وحيث يموت الجاني فلا موضوع للقصاص . وإثبات جواز قطع رأسه يكون بعنوان آخر ويعدّ موضوعاً آخر غير القتل والقصاص فهو بحاجة إلى دليل .
ولا يجوز الاستناد في جوازه إلى مثل الاستصحاب أيضاً ، لتعدّد الموضوع ، ويكون إثبات الحكم فيه من قبيل القياس لا الاستصحاب .
وعلى هذا الأساس ذكرنا أنّه لو شكّ في حياة الجاني لم يجز ذبحه بدليل القصاص; للشكّ في صدقه . ولا يجري الاستصحاب لإثبات حياته بلحاظ جواز ذبحه ، لكونه من المثبت; فإنّ الاستصحاب في القيد لا يثبت المقيّد وإن ثبت به جزء المركّب ، ولكنّه غير ما نحن فيه ، فإنّ الذبح المقيّد بالوقوع حال الحياة هو المعنون
(الصفحة146)
بالقصاص والقتل ، لا أنّ القتل مركّب من ذبح وحياة ليجري الاستصحاب في جزئه وهو الحياة ويثبت الجزء الآخر بالوجدان; نظير استصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الثوب النجس المغسول به .
وبالجملة : فالذبح بالنسبة إلى القتل من قبيل السبب والمسبّب ، وموضوع الحكم هو الثاني لا الأوّل ، ولا يسري الحكم من المسبّب إلى السبب وإنّما يكون السبب مقدّمة ، فلذا يجب الاحتياط حيث يكون الموضوع للحكم الوجوبي هو المسبّب ، وهذا بخلاف قطع العضو فإنّه وإن جاز بعنوان الإلزام إلاّ أنّ نسبة الإلزام إليه هو نسبة العنوان والمعنون، ممّا يؤدّي إلى سريان الحكم إلى المعنون وإن كان في الدليل مرتّباً على العنوان; نظير حرمة الخمر الذي يكون الموضوع في الحقيقة هو الخمر الخارجي وإن كان التحريم مرتّباً على عنوان الخمر .
ومن هنا لو فرض عدم صدق الإلزام بالموت ، لم يناف ذلك بقاء العنوان والموضوع ـ أعني قطع العضو ـ الموجب لجواز إجراء الاستصحاب ، بحيث لو جاز قطع العضو بعد الموت كان ذلك استمراراً للحكم الثابت حال الحياة لا حكماً في موضوع مغاير عند العرف ممّا يعدّ قياساً لولا الدليل على الحكم .
ومن هنا تبيّن أنّه لو شكّ في جواز أخذ أعضاء السنّي بعد موته فيما جاز ذلك حال حياته لمثل الإلزام ، جرى استصحاب الجواز ، لوحدة الموضوع بنظر العرف وإن قصر دليل الحكم ، أعني قاعدة الإلزام عن إثباته بعد الموت .
وليس عنوان الإلزام من قبيل عنوان القتل والقصاص أمراً توليدياً مقوّماً للموضوع كما تقدّم بل هو من قبيل العلّة ، والجهات التعليليّة لا تقوّم الموضوع بنظر العرف .
خامساً: أنّ دليل حرمة الميّت ، خاصّ بالمؤمن ، وأنّ حرمة المؤمن ميّتاً
(الصفحة147)
كحرمته وهو حيّ ، وربما لا يصدق المؤمن على كلّ مسلم فضلاً عن غيره(1) .
إلاّ أن يُقال بأنّ بعض الأدلّة عامّ لعامّة المسلمين بل ولغيرهم ، ففي النصّ : «إيّاكم والمُثلة ولو بالكلب العقور»(2) . وفي بعض النصوص : «حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ سواء»(3) .
- (1) ربما ورد في بعض الكلمات أنّ المستفاد من النصوص الشرعيّة صيانة بني آدم من حيث كونهم بني آدم وإن كانوا كفّاراً; لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ . . .) الإسراء: 70 . ولآيات كثيرة دلّت على رعاية الله لتمام أفراد الإنسان بلا خصوصية للمسلمين; كقوله تعالى: (وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) الشعراء: 183 . وقوله: (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) الحج: 65 . وقوله: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) النساء: 58 . وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ . . . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الاَْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ . . .) البقرة: 204 ـ 205 . وغيرها .
ومفاد الآية الأخيرة مبغوضيّة قطع وهلاك النسل البشري وهلاك الحرث والمنابع الطبيعيّة ودمار الأرض وما يقابل عمارتها . ويؤكّده الآيات العديدة الدالّة على استخلاف بني آدم لعمارة الأرض; وهذا بمنزلة العموم الفوقاني الذي لا يرفع اليد عنه إلاّ بمخصّص كأدلّة الجهاد .
ولا منافاة بين عدم الكرامة في غير المتّقي وبين عدم جواز الهتك والإهلاك . وهناك أحكام لذات الإنسان بغضّ النظر عن تديّنه كما هناك أحكام للأبوين بغضّ النظر عن إيمانهما .
وعلى هذا فليس مقتضى القاعدة عدم الحرمة للكافر كي يتمسّك به في جواز تشريح ميته ، بل دمه ليس هدراً إلاّ بعد رفضه الإسلام بعد الدعوة .
بل وعدم الحرمة للكافر الحربي في عرضه وماله ودمه لا يعني عدم حرمة بدنه; لأنّ العقيدة الفاسدة تلغي الجانب الاعتباري وهو عرضه وماله دون بدنه المنسوب إلى الله; ولذا لا ينبغي تعييبه في بدنه . فهتك الكافر من حيث الإنسانية غير سائغ وإن جاز من حيث ظلمه ومحاربته .
أقول: هذا الكلام لا يرجع إلى محصل في إثبات حرمة بدن الكافر وعدم جواز تشريحه بعد موته; فإنّ إنسانية الإنسان بحياته وأمّا بعد موته فهو جماد لا إنسان . وثبوت الحرمة لبدن المسلم من شؤون كرامة الإنسان ولا مثبت لكونها من حيث الإنسانية . نعم ، دلّ الدليل كما يأتي إن شاء الله تعالى على النهي عن المُثلة ولو بالكلب العقور ونقول بمقتضاه . ومعه لا حاجة إلى التطويلات المتقدّمة .
(2) عوالي اللآلئ 1: 148 ، ح7 . ورواه في الوسائل عن نهج البلاغة 19: 96 ، الباب 62 من قصاص النفس ، الحديث 6 .
(3) راجع الوسائل 19: 247 الباب 24 و 25 من أبواب ديات الأعضاء .
(الصفحة148)
نعم ، في خبر: «إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً»(1) ، ولكنّه لا ينافي الإطلاق .
ثمّ إنّ السنّي قد يرى نفسه ملزماً ببذل العضو فينطبق عليه الإلزام بوضوح . وقد يرى جواز ذلك بلا لزوم ، ففي جريان قاعدة الإلزام في مثله إشكال; منشأه احتمال اختصاص مفهوم الإلزام في ذاته بالأحكام الاقتضائية دون الترخيصيّة ، فمن اعتقد حلّ الهبة لم يكن إيجابها عليه مقتضى الإلزام بخلاف ما لو اعتقد ضمانه بمال ، فإنّ الإلزام يقتضي إيجابه عليه . وعلى هذا الأساس ربما يفصل في الإلزام بين موارد بيع السنّي عضوه فيجوز إلزامه بتسليمه ، وبين موارد البذل الابتدائي منه فلا مورد لإلزامه; لعدم كونه ملزماً بالأخذ بأحد طرفي الأحكام الترخيصيّة .
هذا ، ويمكن عدّ عدّة ممّا ذكرناه ذيل قاعدة الإلزام وجهاً مستقلاًّ لما رمناه من إثبات جواز أخذ العضو في المسألة ، فلاحظ وإن كانت نتيجتها أخصّ من مدّعى .
مباشرة الطبيب لما يحرم عليه اختياراً ، لو حلّ للمريض أو وجب
- (1) عوالي اللآلئ 3: 653 ، ح127 . ونحوه في دعائم الإسلام 2: 456 ، ح1607 . ورواه في الوسائل عن الكافي 19: 251 ، الباب 25 من ديات الأعضاء .
(الصفحة149)
المضطرّ ، بأمر من المريض وطلبه فيباح كما لو باشر نفس المريض أخذ العضو لترقيعه بنفسه ؟
نسب إلى بعض مشايخنا المعاصرين القول بجواز المباشرة لغير المضطرّ . ويلوح من بعضهم خلاف ذلك ، حيث أفاد عدم جواز إسقاط الطبيب للجنين الذي يخاف منه على حياة أمّه ، وإنّما يسوغ له دلالة المريض والحامل على استعمال شيء يسقط الحمل فلا يباشر الإسقاط إلاّ المضطرّ ، ولا يوجب الاضطرار حلّ الإسقاط لغيره .
والإشكال فيه ، ناشئ من جهة أنّ الحرام في حال الاختيار إنّما أحلّ للمضطرّ وليس المباشر ـ في الفرض ـ مضطرّاً ، وإنّما المضطرّ هو الآمر فهو من قبيل أن يشرب غير المضطرّ خمراً بأمر من المضطرّ ، وإن افترقا في انتساب الفعل التسبيبي إلى المضطرّ دون مثل شرب الخمر ، ولكنّه لا يكون فارقاً فيما هو ملاك عدم جواز ارتكاب المحرم .
انتساب الجناية إلى غير المباشر وإن اختصّ القصاص بالمباشر
فإن قلت : فعل المباشر ينسب إلى المضطرّ حيث يكون بأمره وبه يُفرّق عن مثال شرب الخمر .
قلت : نعم ، ولكن هذا الانتساب لا يمنع من نسبته إلى المباشر أيضاً فينبغي أن يلحقه الحكم من هذه الجهة أيضاً وهو الحرمة . ويشهد لذلك ثبوت القصاص على المباشر وإن كان القتل بأمر الغير فإنّه حكم على القاعدة ، وهذا لا ينافي نسبة القتل إلى الآمر أيضاً، فإنّ القصاص حكم قسم من القاتل وهو القاتل بالمباشرة لا بالتسبيب . ولو كنّا نحن والقاعدة لأثبتنا القصاص في مطلق القاتل الحقيقي; ولا يشترط في صدق القاتل حقيقة مباشرة القتل; فإنّ بعض الأفعال يكفي في نسبتها
(الصفحة150)
التسبيب إليها ، كما لا ينافي صدق البيع حقيقة مباشرة غير المالك بأمره .
والضابط: أنّ هناك أُموراً اعتبارية كالمعاملات ، وغير اعتباريّة كالبناء ونقل الأثقال والحلق وغيرها ، لا يعتبر في انتسابها إلى الشخص كونه مباشراً لفعلها; بل تنتسب إلى الشخص حيث صدرت بطلبه وأمره . ومنها أداء الديون وجباية الأموال من خراج وغيره من الصدقات .
وبالجملة : انتساب الفعل إلى المضطرّ وإن اقتضى ثبوت الحلّ ولكنّه يقتضي الحلّ للآمر ، وحيث يكون للفعل حيثيتان: إحداهما حيثية انتسابه إلى الآمر ، والاُخرى انتسابه إلى المباشر ، ولا ملازمة في الحكم بين الحيثيّتين وإن تحقّقتا بفعل واحد ، لم يكن جواز الفعل من جهة مستدعياً لحلّه من جهة أُخرى; فهو كما لو تحقّق أمران بفعل واحد كقتل بريء ومهدور بضربة واحدة ، وإن افترق عنه بأنّ الضرب مقدّمة القتل لا هو بعينه فهو من قبيل الأفعال التسبّبيّة ممّا يكون الحكم مترتّباً على المسبّب لا على السبب ، ويكفي لكون المسبّب صالحاً لترتّب الحكم عليه كون سببه تحت الاختيار ، بخلاف مثل قطع العضو ممّا يكون بنفسه حراماً أو حلالاً من حيث الانتساب إلى شخصين .
توجيه صحّة معاملات الصبي المجاز من الولي
نعم ، ربّما يكون الفعل من حيث انتسابه إلى بعض الجهات ممّا لا اقتضاء فيه ، فهو من قبيل ثبوت الحكم الاقتضائي مع الحكم اللااقتضائي . وعلى هذا الأساس حكمنا بصحّة معاملة الصبي في ماله إذا كان بأمر وليّه ، حيث تنتسب المعاملة إلى الوليّ إضافةً إلى انتسابها إلى نفس الصبي ، والمؤثّر في الصحّة هو الأوّل ، وأمّا الثاني فلا اقتضاء فيه للصحّة لا أنّه مقتض للفساد ، حتّى يكون من قبيل معارضة مقتضى الصحّة والفساد .
(الصفحة151)
ربما يستدلّ لفساد معاملاته مع كونه مجازاً بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}(1) . ونحوه قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً}(2) ، وعلى هذا الأساس ربما نسب إلى سيّدنا الاستاذ (قدس سره) التفصيل في معاملات الصبي المأذونة بين الإذن الخاص كبيع معيّن وبين الإذن العام فلا يجوز الثاني .
ويرد عليه: أنّ دفع مال الصبي إليه المغيّى بالرشد والبلوغ هو خلع اليد عن ماله لا ترخيصه في المعاملة; ولذا لا تنسب معاملاته إلى الوليّ حينئذ فهذا النحو من الدفع غير سائغ قبل البلوغ . وأمّا الإذن له في المعاملة مع رعاية الغبطة بنحو تستند معاملة الصبي أو معاملاته إلى الولي ـ فهو خارج من الآية ظاهراً . وقد اعترف سيّدنا الأستاذ فيما حكى عنه بصحّة معاملة الصبي المأذون فيها بالخصوص على القاعدة ، وعدم شمول الآية المتقدّمة لمثله .
وإن شئت قلت: إنّ نفس تعبير الآية بالمنع من دفع مال السفيه الذي للوليّ قيمومة عليه، إليه مشير إلى نكتة المنع من قيومة الوليّ عليه، فليس النهي إلاّ مشيراً إلى القيمومة لا أنّه نهي مستقلّ عن ذلك. ومنه يعلم أنّ ما في الآية التي بعدها من الأمر بدفع مال اليتيم له بعد البلوغ والرشد إرشاد إلى انقطاع الولاية والقيمومة ووجوب الدفع إليه لذلك وأنّ هذا الوجوب غير متحقّق قبل ذلك.
وعلى هذا فلا مانع من استقلال الصبي بالمعاملة بإذن الولي فضلاً عمّا إذا عيّن له الوليّ معاملة خاصّة، وعمّا إذا كان الصبي موظّفاً بإجراء الصيغة خاصّة. وأمّا إذا كان إرسال الصبي إبرازاً من الولي وإنشاءً فالمعاملة من الوليّ ولا أثر لقصد الصبي. كما أنّه اتّضح أنّ ما تضمّن عدم جواز أمر الغلام حتّى يبلغ لا ينافي ما ذكرنا. وأنّه
- (1) سورة النساء الآية 6 .
- (2) سورة النساء الآية 5 .
(الصفحة152)
لايستفاد من الدليل كون الصبيّ مسلوب العبارة، وما تضمّن أنّ عمده خطأ لا إطلاق له لمثل عباراته. ولذا يقبل إسلامه. وفي بعض النصوص المعتبرة أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) وكّل صبيّاً في أن يزوّجه امرأة وهو معتبرة إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «تزوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) اُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم»(1). وتمام الكلام في محلّه.
- (1) الوسائل 14: 222، الباب 16 من عقد النكاح، الحديث 1.
(الصفحة153)
المسألة الخامسة : لا يجوز قطع شيء من أعضاء الميّت المسلم ولا شقّها; وتثبت الدية على تقدير فعل ذلك . وهذا الحكم ثابت في حال الاختيار ، وأمّا عند الحاجة إلى ذلك للتعليم في الطبابة أو الترقيع بالغير ففي الجواز إشكال (1) .
(1) لا إشكال بل لا خلاف في الحكمين الأوّلين ، وسيتّضح مدرك ذلك ضمن ما يأتي من البحث فيما نحن بصدده هنا من بيان مسألة قطع العضو للترقيع .
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع البدن بعضو
ثمّ إنّه يظهر من غير واحد من الفقهاء عدم جواز الترقيع ، بل ظاهر غير واحد من القدماء التسالم على ذلك ، بل يظهر منهم دعوى الإجماع . وكيف كان فالمشهور بينهم هو ذلك ، فإنّ مسألة الترقيع بالصورة المتعارفة الآن وإن لم تكن مورد ابتلاء الناس سابقاً ، إلاّ أنّها بوجه آخر مورد تعرّض للنصّ وكلمات الأصحاب .
قال في السرائر : «ومن قطع شحمة اُذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه فعالج الجاني اُذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة اُذنه; حتّى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص» .
وهكذا حكم المجنيّ عليه; سواء كان ظالماً أو مظلوماً ، جانياً أو مجنيّاً عليه;
(الصفحة154)
لأنّه حامل نجاسة . وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما بل جميع الناس .
وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء ، إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة ، ووجب على السلطان ذلك; لكونه حاملاً للنجاسة ، فلا تصحّ منه الصلاة حينئذ .
وكذلك إذا جبر عظم بعظم نجس العين ولم يكن في قلعه خوف على النفس ولا مشقّة عظيمة; يجب إجباره على قلعه ولا تصحّ معه صلاته . فأمّا إن خاف من قلعه على نفسه فلا يجب قلعه ولا يجوز إجباره على ذلك وتكون صلاته صحيحة; لموضع الضرورة ، ولقوله (عليه السلام) : لا ضرر ولا إضرار(1) .
وقال العلاّمة في تلخيص المرام : «ولو ألصق المقتص منه الاُذن ـ يعني المجنيّ عليه ـ ، قيل: للجاني الإزالة ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها . وكذا لو قطع بعضها»(2) .
وسيأتي نقل عبارة غير واحد من الفقهاء عند الاستدلال لعدم جواز الترقيع ، بأنّه مستلزم لحمل النجس حال الصلاة وغيرها ممّا هو مشروط بالطهارة ، فانتظر.
أدلّة المنع عن أخذ عضو الميّت للترقيع ، وكذا الترقيع بغير العضو المأخوذ من الميّت
- (1) سلسلة الينابيع الفقهية 25: 372 .
- (2) نفس المصدر 40 : 471 .
(الصفحة155)
الوجه الأوّل: الاستدلال بنصوص احترام الميّت
قد دلّ غير واحد من النصوص على أنّ حرمة الميّت كحرمته وهو حيّ ، وأنّ الله حرّم من الأموات ما حرّم منهم أحياءً ، والمنساق من هذه الروايات أنّ ثبوت الدية في الجنايات إنّما هو لحرمة الأشخاص ، وكون هتكهم موجباً لذلك .
نعم ، ربما تكون الجناية عن غير عمد ومع ذلك تثبت الدية في الأحياء ، ولكن ثبوتها في الميّت بهذه الأخبار غير واضح ; لعدم كون فعل غير العامد هتكاً فهو من قبيل فعل غير المختار ، فكما أنّه يسقط الحكم التكليفي والحرمة التكليفيّة في الساهي كذلك إناطة الدية بهتك الحرمة تقتضي سقوطها في غير مورده إلاّ أن يثبت إطلاق بنصّ آخر .
وما ورد في بعض النصوص من إطلاق الدية في قطع رأس الميّت ، فقد علّل في بعضها بأنّ الله حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً .
نعم ، في بعض النصوص(1) التعرّض لحكم المغسّل للميّت إذا شقّت مسحاته بطن الميّت ، وظاهره غير العامد ، ولكن ظاهره عدم ثبوت الدية ، بل المتفاهم منه كسائر الأخبار ، حيث فرعت الدية على حرمة الميّت ، أنّها بملاك الهتك .
ويؤكّد ذلك ما في ذيل الخبر من عدم ثبوت الدية في الفعل خطأ ، ومعه فلا يبعد عدم الدية في مورد الاضطرار أيضاً لا قياساً ، بل لوحدة الملاك أعني الاشتراك في عدم الهتك الذي كان هو الموجب للدية بمقتضى النص; ولا أقلّ من قصور مقتضى الدية الناشئ من عدم الدليل عليها ، الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي للبراءة ، بعد أن عرفت اختصاص هذه النصوص بالدية في موارد الهتك ولو لم يكن بملاكه . وسيأتي زيادة بيان على هذا .
- (1) الوسائل 19: 247 ، الباب 24 من ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
(الصفحة156)
ويلوح من بعض الأخبار عدم ثبوت الدية عند اذن المجنيّ عليه في الجناية; وهو ما تضمّن استئذان الإمام (عليه السلام) في خدش يسير ، مبيّناً أنّ ديته ثابتة في كتاب علي (عليه السلام) ، كما في صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله في حديث قال :
«إنّ عندنا الجامعة» قلت : وما الجامعة؟ قال : «صحيفة فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش» وضرب بيده إليّ فقال : «أتأذن يا أبا محمّد»؟ قلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده : «حتّى ارش هذا»(1) .
ملاك حرمة قطع أعضاء الميّت
وما تضمّنه بعض النصوص من كون حرمة الميّت أعظم فالظاهر أنّه فيما كان له على تقدير الحياة حرمة ، فرعاية الحريم في مورد الميّت آكد ، وتكون الجناية على الميّت الذي لا يمكنه الدفاع عن نفسه أشدّ حرمة وأكبر; لا ثبوت حرمة للميّت فيما لا تثبت حرمة للحيّ .
وعلى هذا الأساس لو أذن الحيّ في شقّ أعضائه أو أخذها فهو كما لو أذِن الحيّ في ذلك ، فلابدّ في ثبوت الحرمة عند الموت من إثباتها في حال الحياة .
ويظهر من بعض الروايات أنّ الدية في الحيّ أيضاً لهتك حرمته بحيث لو أذن في الجناية عليه ـ والتعبير بالجناية حينئذ من ضيق التعبير ـ فلا دية كما لا حرمة
- (1) الوسائل 19 : 271 ، الباب 48 من ديات الأعضاء .
(الصفحة157)
تكليفاً; ولا حرمة ـ بمعنى أنّه لا احترام ـ سالبة بانتفاء الموضوع . وهو ما أشرنا إليه آنفاً من استئذان الإمام (عليه السلام) من الراوي في غمز يده أو خدشه مبيّناً ورود حكم في كتاب عليّ (عليه السلام) .
وربما كان ثبوت الدية في غير العامد من باب الاحتياط; لئلاّ يتساهل الناس فيكثر السهو منهم في الجناية على النفوس والدماء .
نعم ، لا يجوز الإذن في التعدّي على النفس بما فيه اجتياحها، كما لا يحقّ لنفس الإنسان أن يباشر ذلك .
ملاك الدية
فقد تحصّل ممّا قدّمناه :
1 ـ أنّ ما دلّ على حرمة التعدّي على الميّت في أعضائه قاصر عن إثبات الحرمة في غير مورد الهتك . نعم ، في معتبرة جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : «قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ»(1) .
ولكنّه أيضاً لا إطلاق فيه لغير مورد الهتك ظاهراً ، مع أنّ التعدّي من الرأس
- (1) الكافي 7: 348 باب الرجل يقطع رأس ميّت . . . الحديث 2 .
(الصفحة158)
إلى غيره سيما في مورد عدم الهتك لا موجب له .
وبالجملة : فمدلول هذه الأخبار حرمة هتك الميّت كحرمة هتك الحيّ . وأمّا أنّ كلّ ما يعدّ هتكاً للحيّ فهو غير جائز في الميّت فلا . وربما يكون للحياة مدخل في صدق الهتك على فعل ، بحيث لو فعل بعد موته لم يعدّ هتكاً . وليست هذه الأخبار بصدد الحكومة والتعبد فيما يعدّ هتكاً .
والأولى الاستدلال لعدم جواز قطع أعضاء الميّت وإن لم يعدّ هتكاً بما سيأتي من نصوص دفن أجزاء الميّت وعدم جواز أخذ ظفره وشعره ، وإن كان يأتي الإشكال عليها أيضاً .
2 ـ أنّ ما دلّ على الدية في الجناية على الميّت محمول على العامد بقرينة خبر الحسين بن خالد والظاهر أنّه ابن أبي العلاء; ولذا لم يذكر في الفقيه سنده إلاّ إليه .
وأمّا المضطرّ فهو وإن كان عامداً إلاّ أنّ تعليل الدية بهتك الحرمة ربما يقتضي التعدّي من غير العامد إليه .
نعم ، تثبت الدية في الجناية على الأحياء ولو خطأً; للنصّ الخاصّ . وربما كان ثبوتها في الحيّ بملاك الاحتياط في الجناية عليهم ، ممّا لا علم بثبوته على حدّ الإلزام في الميّت ، بل الظاهر من خبر الحسين بن خالد أنّ ثبوت الدية في مورد الجناية على الميّت بملاك المثلة وهي عبارة عن الهتك بكيفيّة خاصّة .
الوجه الثاني: الاستدلال بدليل حرمة المثلة
(الصفحة159)
وإشاعة نقائصه ، فهي نظير الغيبة التي عدّت أكلاً للحم الأخ .
ولعلّ من قبيله ما ورد من التعبير بكسر عظم الميّت، فيراد به ما هو من قبيل الغيبة الذي عبّر عنها بأكل اللحم في معتبر مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميّت ، فقال : «حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ»(1) .
وأوضح منه معتبرة صفوان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء»(2) .
وكأنّ سوء الظنّ بالغير كسر لعظامه، فلاحظ .
ويؤكّد ما ذكرنا من تعريف المُثلة ، ما ورد في حرمة أكل لحم المسوخ معللاًّ بأنّها مثلة(3) .
حكم المثلة
المفهوم من الأخبار حرمتها بالحيّ والميّت وعدم اختصاص حرمتها بالمسلمين ، فلا يجوز التمثيل بالكافر أيضاً حتّى بعد موته ، ولا بحيّ مهدور وإنّما يقتل المهدور فيجاز عليه بالسيف ولا يجوز العبث بالحيّ في كيفيّة القتل .
نعم ، يستثنى من ذلك المحارب فإنّه يقطّع حسب ما ورد في الآية ، تقطع يده ورجله من خلاف ، كما أنّ المُثلة في موارد القصاص في الأطراف أيضاً خارج عن عموم المُثلة بالتخصيص . وأمّا في النفس فيثبت القصاص بغير المثلة وإن كان
- (1) الوسائل 19: 251 ، الباب 25 من ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (3) نفس المصدر 16: 313 ، الباب 2 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
(الصفحة160)
الجاني قد مثّل بالمجني عليه بقتله بالمثلة .
قال صاحب الوسائل في عنوان باب : «باب أنّ الثابت من القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل»(1) ، هذا .
وعدم جواز التعذيب مستفاد من رواية أبي الصباح في هذا الباب ; وأمّا عدم جواز المُثلة فقد ورد في مرسل إسحاق بن عمّار ، ولكنّه مع ضعف سنده معارض بعموم ما دلّ على جواز القصاص أو إطلاقه بالعموم من وجه; لأنّ دلالته على المنع من التمثيل فيما كان الجاني ممثّلاً في جنايته وقتله بالإطلاق . كما أنّه يشمل عموم ولاية الولي على القصاص قتل الجاني بتمام الحالات سيّما الحالة التي قتل الجاني بها قتيله .
إلاّ أنّه يمكن أن يُقال : إنّ نسبة مثل هذا الدليل إلى دليل القصاص هو نسبة الحاكم; فإنّه ناظر إلى دليله .
نعم ، لو كان النهي عن المُثلة مطلقاً كانت النسبة التعارض ، ولكن مورد النصّ هو المثلة بالقاتل في مورد القصاص ، فهو وإطلاقه حاكم على إطلاق دليل القصاص ولا تلحظ النسبة .
حكومة المنع من المثلة على دليل القصاص ونحوه
- (1) نفس المصدر 29: 126 ، الباب 62 من قصاص النفس .
(الصفحة161)
ملاحظة النسبة بينه وبين المحكوم ، هو كون الحاكم مفسّراً وشارحاً بلفظه ومتنه للدليل المحكوم ، بخلاف المخصّص فإنّه وإن كان شارحاً وقرينة على المراد الجدّي من العام إلاّ أنّ قرينيّته نوعيّة من دون أن يكون بشخصه دالاًّ على ذلك ; ولذا لا يحكي الخاص عن وجود عامّ بخلاف الحاكم ، فإنّه حاك عن وجود محكوم . وحيث كان الملاك في تقديم الحاكم هو النظارة الخاصّة لشخص الكلام ، فحيث وجد ذلك فإنّه يكون مقدّماً على الدليل الآخر وإن لم يصطلح عليه باصطلاح الحكومة ، وعلى هذا الأساس تراهم يحكّمون دليل «لا ضرر» و«لا حرج» ونحوهما على أدلّة الأحكام الأوّلية .
وعلى هذا فالدليل المخصّص ، حيث يكون دالاًّ وحاكياً عن وجود عام ويكون بلسانه وشخصه مضيّقاً لحدود العام وللمراد الجدّي منه ، يكون متقدّماً على العام وإن كان النسبة بينهما نسبة العموم من وجه لا العموم والخصوص المطلق .
فلو ورد أمر بالصلاة مطلقاً ودلّ دليل على النهي عن أداء الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه كان ملاك تقديم الثاني هو الحكومة وإن كانت نسبته إلى الأمر المطلق بالصلاة نسبة الخاصّ ، فلا يتقدّم بملاك التخصيص هو الذي عبارة عن القرينيّة النوعيّة بل هو قرينة شخصيّة .
ولو ورد الأمر بالتصدّق على الفقير ثمّ ورد النهي عن إكرام الفاسق بعنوان التفسير ، وأنّه حيث يؤمر بإكرامه فالمراد به غير الفاسق ، فإنّ النسبة بين الفقير والفاسق وإن كان هو العموم من وجه، ولكن لمّا كان دليل الفاسق شارحاً بشخصه لغيره قدّم بلا ملاحظة النسبة .
والسرّ في ذلك كلّه أنّ الملاك في تقديم دليل بما له من الظهور على غيره ، هو كون المقدّم على تقدير اتّصاله بالآخر مقدّماً أيضاً بما له من المفهوم على تقدير الانفصال ، بحيث لا يكون اتّصاله مانعاً من ظهوره المنعقد على تقديم الانفصال .
(الصفحة162)
وفي موارد تفسير دليل لغيره يكون الأمر كذلك ، فلو قال: تصدّق على الفقير ولا تكرم فاسقاً أو قال : تصدّق على الفقير ومقصودي أن لا تكرم فاسقاً ، فإنّ إطلاق المفسّر مقدّم على إطلاق الفقير بلا ملاحظة النسبة .
إذا عرفت ما ذكرناه فما نحن فيه من هذا القبيل; فإنّ النهي عن المُثلة بالقاتل وكذا النهي عن مطلق المُثلة شارح بشخصه للقصاص المشروع ، ولغير القصاص من القتل الجائز ; فلا فرق في تقديمه على عموم القصاص بين أن يقول: المُثلة ليس قصاصاً أو لا قصاص بمثلة ، وبين أن يقول: أعني بالقصاص هو ما يكون بغير المثلة ، وما كان من قبيله .
نصوص حرمة المثلة
منها: ما ورد من النهي عن المُثلة بالقتيل والميّت ومطلقاً .
كخبر الحسين بن خالد المتقدّم ومضمونه: الدية في المُثلة ، إلاّ أن يستفاد من ذلك الحرمة تكليفاً أيضاً .
وصحيح معاوية بن عمّار قال : أظنّه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا . . .»(1) .
ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله عزّوجلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه عامّة ،
- (1) الوسائل 11: 43 ، الباب 15 من جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
(الصفحة163)
ثمّ يقول : اُغز بسم الله وفي سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً ولا في شاهق . . .» (1) .
وخبر عبد الرحمن بن جندب عن أبيه: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا فيقول : «لا تقاتلوا القوم حتّى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة ـ إلى أن قال ـ : فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجيزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل»(2) .
وحديث الكليني قال : وفي حديث مالك بن أنس قال : حرّض أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس بصفّين فقال : إنّ الله عزّوجلّ ـ إلى أن قال ـ : ولا تمثّلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً . . .» (3) .
وما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته للحسن (عليه السلام) : «يا بني عبد المطّلب لا ألفينّكم تخوضون في دماء المسلمين خوضاً ، تقولون: قتل أمير المؤمنين ، ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي ـ إلى أن قال ـ : ولا يمثّل بالرجل فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : إيّاكم والمُثلة ولو بالكلب العقور . . .» (4) .
وفي خبر قرب الإسناد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به» (5) .
وفي صحيح أبي الصباح الكناني ـ وإن كان في سنده محمّد بن الفضيل ، فإنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة منسوباً إلى جدّه لا محمّد بن الفضيل الذي لم تثبت
- (1) نفس المصدر: الحديث 3 .
- (2) نفس المصدر 11: 69 ، الباب 33 من جهاد العدوّ ، الحديث 1 . وفي الكافي 5: 39 ، الحديث 3: «ولا تجهزوا على جريح . . .» .
- (3) الوسائل 11: 72 ، الباب 34 من جهاد العدوّ ، الحديث 3 .
- (4) نفس المصدر 19: 96 ، الباب 62 من قصاص النفس ، الحديث 6 .
- (5) نفس المصدر ، الحديث 4 . قرب الإسناد: 143 ، الحديث 515 .
(الصفحة164)
وثاقته; وذلك بقرينة روايته عن الكناني ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال : «نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف»(1) .
ونحوه خبر موسى بن بكير .
وفي خبر إسحاق بن عمّار المشتمل على الإرسال قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال في القصاص ـ : «نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل»(2) .
وما تضمّن النهي عن المُثلة بالقاتل فهو خاص لا يدلّ على حرمة المُثلة بالميّت .
حقيقة المثلة
أمّا معنى المثلة فقد قدّمنا إنّه جعل شخص غرضاً للإهانة والهتك ، بقطع عضوه والتنكيل به . ولا يبعد شمولها لغيرهما وقد تقدّم إطلاق المُثلة على المسوخ .
قال في لسان العرب : «مثّل بالرجل يمثِّل مثلاً ومُثلة ، الأخيرة عن ابن الأعرابي ، ومثل ، كلاهما نكّل به وهي المَثُلة والمُثلة ، وقوله تعالى : {وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ}(3) . الجوهري المَثُلة ـ بفتح الميم وضم التاء ـ : العقوبة; والجمع المثلات .
التهذيب: وقوله تعالى : {الْمَثُلاَتُ} العقوبات . والعرب تقول للعقوبة: مَثُلة ومُثلة ; فمن قال : مَثُلة ، جمعها على مَثُلات ، ومن قال: مُثلة جمعها على مُثُلات ومُثَلات ومُثْلات بإسكاء الثاء . قوله تعالى : {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ} أي
- (1) نفس المصدر 19: 96 ، الباب 62 من قصاص النفس ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (3) سورة الرعد الآية 6 .
(الصفحة165)
تقدّم من العذاب ما هو مثلة وما فيه نكال لهم لو اتّعظوا . وكأنّ المثل مأخوذ من المَثَل; لأنّه إذا شنع في عقوبته جعله مثلاً وعلَماً .
وفي الحديث نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمثّل بالدواب ، وأن تؤكل الممثول بها ، وهو أن تصيب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حيّة .
وفي الحديث أنّه نهى عن المثلة . يُقال : مَثُلْت بالحيوان أمثل به مثلاً ، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به; ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه واُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه . والاسم المُثلة . فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة . وفي الحديث : من مثّل بالشّعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة ; مُثلة الشعر: حلقه من الخدود ، وقيل: نتفه أو تغييره بالسواد . وروي عن طاووس أنّه قال : جعله الله طهرة فجعله نكالاً»(1) . انتهى .
ثمّ إنّ أخذ عضو باطن لا يستلزم شقّ أو قطع ظواهر أعضاء الميّت ، لا يعدّ مثلة; فإنّ المثلة عبارة عن إخزاء الغير وإظهار معايبه ونقصه ، وأمّا النقص الباطن فلا يعدّ مثلة .
بل وكذا أخذ الأعضاء الظاهرة من الميّت إذا لم يكن بداعي الإهانة والهتك ، بل كان لغرض الترقيع بحيّ سيّما بإجازة الميّت نفسه ، بل وأخذ العضو من الحيّ برضاه .
ويؤكّد ما ذكرنا من عدم صدق المثلة فيما تقدّم ، أنّه لا يعدّ قطع الأعضاء الفاسدة للعلاج ـ ودفعاً لسراية الفساد إلى سائر الأعضاء ـ مثلة ، لا أنّه يعدّ مثلة جائزة ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق المثلة في ذلك .
ولو فرض إطلاق المثلة في غير موارد قصد الهتك والتنكيل كما في حديث:
- (1) لسان العرب 11: 615 «مثل» .
(الصفحة166)
حلق الرأس مثلة أو حلق اللحية من المثلة(1) فهو أعمّ من كونه حقيقة .
فقد تحصّل ممّا قدّمناه عدم ملازمة أخذ العضو من حيّ أو ميّت للترقيع لصدق المثلة ، فلا وجه للاستناد في المنع من أخذ الأعضاء للترقيع بدليل المثلة .
نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ
الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ
كما أنّه تقدّم أنّ قاعدة الاضطرار المبحوث عنها ، هي المستفادة من الأخبار الخاصّة المتضمّنة لقولهم (عليهم السلام): «ما من محرّم إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه» لا المستفاد من حديث الرفع ، حتّى يشكل بأنّه امتناني ، وجريان مثله موقوف على أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ مسلم ، هذا .
مع ما قدّمناه من أنّ المتيقّن من ذلك هو أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ الأحياء دون الموتى ; فلا بأس بالاستناد إلى حديث الرفع أيضاً في المقام .
- (1) مستدرك الوسائل 1: 406 ، الباب 40 و 60 من آداب الحمّام .
(الصفحة167)
قصور قاعدة الاضطرار عن تحويل الضرورة إلى الغير
قد يشكل التمسّك بقاعدة الاضطرار بأنّه لو تمّ لجاز التمسّك به في أخذ العضو من الحيّ أيضاً بدون رضاه وقهراً عليه; وذلك لعدم الفرق والإطلاق .
وقد يورد عليه بأنّ قاعدة الاضطرار محكومة بقاعدة «لا ضرر» في أخذ العضو من الحيّ دون الميّت; وذلك فإنّ جواز أخذ العضو من الحيّ قهراً عليه حكم ضرري منفي بدليل «لا ضرر» .
ويدفعه: أنّه كما أنّ جواز أخذ العضو من الحيّ حكم ضرري ، كذلك تحريم ذلك حكم ضرري على المضطرّ . ولكن سقوط قاعدة «لا ضرر» ليس بسبب التعارض بين تطبيقهاعلى الموردين ،بل سقوط «لا ضرر» بقصورها وعدم المقتضى لها ، فإنّها امتنانيّة وحيث استلزم جريانها خلاف الامتنان على أحد فلا تجري .
والحقّ أنّ دليل الاضطرار قاصر عن إثبات جواز دفع الضرورة ، بتحويلها إلى الغير ، حتّى الكافر فضلاً عن المسلم ، والضرورة اليسيرة فضلاً عن الكثيرة والمساوية للضرورة المدفوعة . والسرّ في ذلك أنّ المتفاهم من حديث الاضطرار هو أنّه لتدارك الضرورة ودفعها ، وأمّا إيجادها في محلّ آخر فهو نقض للغرض ، فإنّه لا خصوصيّة لبعض الناس على بعض بلحاظ الأدلّة المتكفّلة للأحكام ، ولا أقلّ من إجمال الحديث وكون ما ذكرنا من قبيل ما يصلح للقرينيّة المانعة من الإطلاق .
وعلى هذا الأساس فلو اضطرّ لحفظ حياته إلى طعام للغير ، فإن كان صاحب الطعام أيضاً مضطرّاً إلى ذلك لم يجز لغيره دفع ضرورته بأخذ مال الغير ، فإنّ الغاية من تشريع القاعدة هو دفع الضرورة ، وأمّا إذا كان دفع الضرورة منشأ لوقوع ضرورة اُخرى أشدّ أو مساوية بل أنقص فهو مناف للغرض الذي من أجله شرعت القاعدة حسب ما يتفاهم عرفاً ولو بمناسبة الحكم والموضوع .
(الصفحة168)
الوجه الثالث: الاستدلال بدليل وجوب الدفن
وممّا يمكن الاستدلال به للمنع من أخذ عضو الميّت المسلم هو ما دلّ على وجوب دفنه بأبعاضه فإنّ الميّت اسم للمجموع ، وبعض الميّت داخل فيه . وعلى هذا الأساس يقال: إنّ ما دلّ على عدّ العضو المبان من الحيّ ميتة فهو تعبّد ، وتنزيل للجزء منزلة الكلّ في الحكم بالنجاسة ونحوها .
والجواب عنه إجمالاً هو أنّ موضوع هذا الحكم هو الميّت ، والعضو المبان بعد ترقيعه وحياته الجديدة لا يعدّ ميتة وميّتاً حتّى يجب دفنه .
وتفصيل الجواب هو أنّ نصوص المسألة مختلفة وأنّها على ألسنة شتّى:
ألسنة نصوص دفن الميّت وأبعاضه
ورواه في الكافي وفيه: عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) إلى قوله: «يجب عليه» .
فإنّ المفهوم منه وجوب لحد السقط ودفنه لا دفن بعضه .
ومن جملة النصوص ما دلّ على وجوب دفن أبعاض الميّت حتّى الشعر والظفر وأنّه لا يُزال عنه شيء .
1 ـ صحيح ابن أبي عمير أو حسنته ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه»(2) .
- (1) الوسائل 2: 695 ، الباب 12 من غسل الميّت ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر: 694 ، الباب 11 من غسل الميّت ، الحديث 1 .
(الصفحة169)
والظاهر من تخصيص الشعر والظفر بالذكر هو كونهما معرض الفصل عن الميّت سيّما في تلك الأزمنة دون سائر أجزائه ، فإذا كان «لا يمسّ» يعني لا يُزال عن الميّت مثل الظفر والشعر فكيف يجوز إزالة عضو آخر منه ؟!
2 ـ موثّق أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) ـ يعني الباقر ـ عن الرجل يتوفّى أتقلّم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال : «لا»(1) .
ودلالته على عدم جواز فصل شيء من الميّت أوضح من سابقه ، فإنّه إذا لم يجز أخذ شعره ونحوه للتنظيف ودفع التشويه عن الميّت ، فما ظنّك بأخذ سائر أجزائه؟ فلا يناط المنع من أخذ أجزائه بما إذا استلزم شيء من ذلك الهتك ، فإنّ أخذ الشعر والظفر لا يكون هتكاً مطلقاً ، فكيف بما إذا طالا من المرض .
3 ـ وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو تقلّم ظفره ؟ قال : «لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه»(2) .
وأمّا ما ورد من كراهة الإمام (عليه السلام) قصّ ظفر الميّت أو شعره كما في خبر طلحة(3) ، فمع ضعف سنده لا دلالة فيه على الكراهة المصطلحة كما لا يخفى على أهله; فإنّ استعمال الكراهة في الروايات في موارد الحرمة شائع ، وليس هو من قبيل استعمال النهي في الكراهة ممّا لا ينافي ظهوره في الحرمة عند فقد القرينة .
ومثله ما عن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كره أمير المؤمنين أن يحلق عانة الميّت إذا غسل أو يُقلَّم له ظفر أو يجزّ له شعر»(4) .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 5 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (4) نفس المصدر ، الحديث 2 .
(الصفحة170)
بل ورد في بعض الأخبار وأظنّها صحيحة: «إنّ عليّاً (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال»(1) فحيث يرد كراهته (عليه السلام) لشيء ، يحمل على الحرمة وعدم الحلّ .
إلاّ أن يقال : إنّه كان يكره غير الحرام من المكروه الاصطلاحي جزماً بما يناسبه من مرتبة الكراهة ، فكيف يمكن الأخذ بهذا المضمون إلاّ أن يحمل الحلال على المباح الاصطلاحي المقابل للمكروه والمستحبّ ومعه فلا يفيد كراهته (عليه السلام) لشيء ، لإثبات حرمته .
إلاّ أنّ بخاطري هو استشهاد الإمام (عليه السلام) بكراهة علي (عليه السلام) لشيء لإثبات حرمته .
ويمكن أن يكون مورد استشهاد الإمام (عليه السلام) كان ممّا لا يحتمل فيه الكراهة المصطلحة ، بل كان الأمر دائراً بين الجواز والمنع . والكراهة في مثله تلازم الحرمة كما لاتخفى .
وكيف كان فنحن في غنى عن إثبات الحرمة بمثله بعد دلالة سائر الروايات على عدم جواز أخذ شيء من أجزاء الميّت ، وإنّما كان المقصود عدم منافاة الكراهة في استعمال الأخبار للحرمة المصطلحة عندنا .
ثمّ إنّ الاستناد لعدم جواز قطع عضو من الميّت وإن لم يكن هتكاً ، إلى هذه الروايات كان أولى ممّا تقدّم من نصوص حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً; حيث كان دلالة تلك على حرمة الهتك خاصّة بخلاف هذه الأخبار .
4 ـ معتبرة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهم السلام) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : «يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويُدفن»(2) .
5 ـ صحيح خالد القلانسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل يأكله
- (1) نفس المصدر 12: 447 ، الباب 15 من الربا ، الحديث 1 .
- (2) الوسائل 2: 815 ، الباب 38 من صلاة الجنازة .
(الصفحة171)
السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : «يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويُدفن . . .»(1) .
6 ـ ومثله صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) .
فإنّ ظاهر الأمر هو التعيين . وجواز أخذ العضو للترقيع ينافي تعيّن الدفن .
7 ـ صحيح البرقي عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا وجد الرجل قتيلاً ، فإن وجد له عضو تامّ صلّى عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن»(3) .
ويمكن ضمّ عدّة من الروايات دلّت على الأمر بالصلاة على بعض أعضاء الميّت(4) بعد أن كان من الواضح أنّ الصلاة بعنوان بعض أحكام التجهيز للميّت والعضو الذي يرقع بحيّ ، كيف يصلّى عليه ؟!
هذا وقد يشكل دلالة هذه الأخبار بأنّها ناظرة إلى حكم أجزاء الميّت في الأعصار السابقة ، حيث كان يدور أمرها بين الدفن وبين الطرح ، ولم يكن الترقيع ميسّراً لهم حتّى تكون الروايات ناظرة إلى المنع عنه بالأمر بالدفن معيناً ; فيكون تعيين الدفن بالإضافة إلى مثل الطرح وإطعامها الحيوانات والسباع .
ويرده ما صدّرنا به الرسالة هذه: من أنّ القضايا في الروايات هي حقيقيّة ، ومجرّد كون بعض الحالات والصور غير ميسّرة في تلك الأعصار لا يعدّ مانعاً من الإطلاق في النصوص بلحاظ الأزمنة التي يمكن فيها تلك الحالات; فلذا يكون الاستناد في طرح الإطلاقات إلى مثل هذه الاحتمالات تخرّصاً وموجباً لانسداد
- (1) نفس المصدر ، الحديث 5 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 6 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 9 .
- (4) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب .
(الصفحة172)
باب الأدلّة والأمارات بلحاظ مستحدثات المسائل ، وقد أشبعنا الكلام فيه ـ سابقاً ـ بما يتّضح به الأمر زيادة على هذا ، فراجع إن شئت .
الجواب عن الاستدلال بأخبار الدفن على عدم جواز أخذ أعضاء الميّت للترقيع
أوّلاً: أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان تنزيل أجزاء الميّت منزلة الميّت الكامل في وجوب الدفن وغيره ، وأمّا أنّ الدفن الثابت في الميّت فملاكه ومورده ماذا؟ فهذا لابدّ من إثباته بدليل آخر .
وكذا حديث السقط فإنّه ناظر إلى مساواة السقط للميّت في اللحد .
وأمّا أنّ الحكم الثابت في الميّت فهو دفن كلّه وعدم جواز تبعيضه في الدفن بعد أخذ بعض أعضائه للترقيع فهذه النصوص قاصرة عن ذلك .
ومنه يظهر الكلام في نصوص الظفر والشعر ، فإنّها دالّة على عدم جواز طرح هذه الأجزاء التي ربّما لا تعدّ جزءً للإنسان; فلذا تفصل عنه في حياته وتطرح في المزابل ، وأنّ الدفن الواجب ثابت في مثل هذه الأجزاء أيضاً فلا يجوز طرحها في المزبلة كما كان يجوز حال الحياة .
وبالجملة : فمفهوم هذه الأخبار طرّاً هو وجوب الدفن على إجماله بنحو ما كان يجب دفن الكلّ ، فلا إطلاق فيه لموارد وجوب الدفن في شيء من الموردين .
وثانياً: مدلول الأخبار المتقدِّمة وجوب دفن أجزاء الميّت معه لا وجوب دفن الجزء المنفصل عن الحيّ .
وقد يقال: إنّ ما دلّ على وجوب دفن الميّت ، الظاهر في دفن جميع أجزائه ، ظاهر في دفنه بأجزائه الفعليّة; والجزءالمنفصل لا يعدّ جزءاً بالفعل ، وإنّما كان جزءاً;
(الصفحة173)
وإطلاقه عليه مجاز بلحاظ حال الانقضاء ; ألا ترى أنّ الحيّ إذا قصّ ظفره لا يعدّه جزءً بالفعل وإن كان يصدق على الظفر قبل القصّ أنّه بعضه وجزئه . وعلى أساسه يحكم بنجاسة ظفر الكافر والكلب والخنزير ونجاسة غير الظفر من شعره وغيره .
مع أنّه بعد انفصال مثل الشعر لا يعدّ الشعر المفصول ونحوه جزءً بالفعل .
وعليه فيدّعى إطلاق روايات دفن الجزء وأنّها مسوقة لبيان الإطلاق لا لبيان الدفن إجمالاً ، حيث إنّ وجوب دفن الجزء المنفصل خلاف القاعدة المستفادة من دفن الميّت الظاهر في الميّت بأجزائه المتّصلة .
قلت : نعم ، هذه الأخبار من ناحية دلالتها على أصل وجوب الدفن على خلاف القاعدة ، ولكنّ المقصود أنّها بلحاظ مورد الدفن لا إطلاق فيها ، وإنّما هي ناظرة إلى وجوب دفن الجزء فيما كان يجب الدفن في الكلّ . وأمّا الكلّ فإنّه يدفن حتّى بعد نفخ الروح فيه مجدّداً بعد الموت ، أو يكون وجوب الدفن بنحو ينافي جواز الإحياء المانع من الدفن ، فلا دلالة في هذه الأخبار على ذلك .
ولولا القطع بعدم منع حياة الجزء بعد انفصاله ، بالترقيع بحيّ آخر ، عن وجوب تجهيز أصل الميّت ودفنه ، واحتمل وحدة حكم الجزء المرقع والأصل ، لم يكن احتمال عدم جواز دفن الأصل رعاية لحياة بعضه ـ وهو الجزء المنفصل ـ أولى من احتمال وجوب دفن الجزء الترقيعي ، فهو كما لو بقيت حياة بعض الأجزاء قبل الانفصال.
هذا ، وبالجملة فموضوع وجوب الدفن هو الميّت ، وجزؤه المنفصل لا يعدّ جزئه إلاّ مسامحة . وما دلّ على وجوب دفن جزئه المنفصل ليس إطلاقه مسوقاً لبيان موارد الدفن ، وإنّما هو لبيان وجوب الدفن في الجملة فيما يجب دفن الميّت الكامل وأنّ الجزء بحكم الكلّ ، فكما أنّ الميّت الكامل لايدفن بحدوث الموت ، فيما تجدّدت له الحياة فكذا أبعاضه كما اتّضح .
(الصفحة174)
وليس المراد أنّ وجوب دفن البعض هو حيث يجب بالفعل دفن الأصل المأخوذ منه الجزء .
قد يقال : بأنّ نهاية ما يقتضيه هذا البيان أنّ أبعاض الميّت بعد الترقيع لا تدفن ، وأمّا قبله فلا قصور عن شمول دليل الدفن له فيجب ، ونتيجته عدم جواز الترقيع; لمنافاته مع العمل بالواجب . كما لا يجوز إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وإن جاز التيمّم لو فعل ذلك وعصى; فإنّه تفويت للواجب الفعلي وتعجيز للنفس عن ذلك ، وهو قبيح عقلاً ومعصية للتكليف المنجز عقلائياً وعرفاً .
قلت : الحقّ أنّ القضايا الحقيقيّة في نفسها غير ناظرة إلى موضوعاتها بإيجاد أو إبقاء وإنّما شأنها ومقوّمها إثبات الحكم على تقدير تحقّق الموضوع ، فكما أنّ الحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه كذلك لا يدعو إلى إبقائه ، بل ربّما يكون الداعي إلى جعل الحكم انعدام الموضوع كما في الحدود ، وإن كان هذا أيضاً خارجاً عن ماهيّة القضيّة فإنّ الدواعي ليست مقوّمات لذويها . هذا كلّه بالنسبة إلى غير القدرة .
وجوب التحفّظ على موضوع القدرة
أمّا القدرة فالظاهر أنّ العقل حاكم بقبح تقويتها وإعدامها وإن كانت موضوعاً للتكليف ينتفي الحكم بانتفائه .
وأمّا في غيرها من القيود المأخوذة شرعاً وعرفاً في موضوعات الأحكام فلا موجب لوجوب التحفّظ عليها على تقدير وجودها ما لم يقم دليل على ذلك ، وذلك نظير السفر والحضر حيث إنّ الموضوع لوجوب القصر هو الأوّل ، والثاني موضوع لوجوب التمام ، وكذا في الصوم فلا يجب التحفّظ على أحدهما حيث يتحقّق في أوّل الوقت ، بل للمكلّف التحوّل من موضوع إلى غيره ، على ما هو الظاهر من دليل القصر والتمام من كون الموضوع في الأوّل هو المسافر وفي الثاني
(الصفحة175)
الحاضر وإن قيل بغير ذلك ، وأنّ الموضوع هو غير ذلك وأنّ المكلّف هو الموضوع ، وهو مخاطب بالجامع بين القصر في السفر والإتمام في الحضر .
وبالجملة فالمتفاهم العرفي من عدم انتفاء الحكم على تقدير انتفاء الموضوع ، هو أنّ متعلّق الحكم بمناط من الأهمّية لا يسقط بانتفاء موضوع الحكم ، فأهمّية الصلاة بدرجة لا تسقط بعدم وجدان الماء الذي هو موضوع وجوب الصلاة مع الطهارة المائيّة ، حتّى أنّ الصلاة تجب حينئذ حتّى مع عدم وفاء مصلحتها بمصلحة الصلاة مع الوضوء .
ثمّ إنّ هذا على تقدير عدم انقضاء زمان يتمكّن منه من الطهارة المائيّة ، وأمّا معه فواضح أنّ الواجب الاختياري يستقرّ على المكلّف ، لتمكّنه من فعله حيث يكفي في صحّة التكليف بشيء التمكّن من صرف الوجود المتحقّق بالتمكّن من فرد واحد من الطبيعي ، ويكون تعجيز النفس عن امتثاله فيما بعد قبيحاً; بملاك حكم العقل بقبح التعجيز كما تقدّم .
فالمتحصّل: أنّ القدرة تارةً تفرض مع انقضاء زمان يمكن فيه الفعل ، بمعنى تحقّق زمان في الخارج يسع الفعل وإن كان وقت فعله بعدُ باقياً ، لسعة الوقت لأكثر من مرّة ، فعدم جواز التعجيز فيه بالخروج عن موضوع الحكم الاختياري إنّما هو بملاك قبح التعجيز المتقدّم استثناؤه أوّلاً . وقد يكون فرض القدرة قبل مضيّ زمان يسع الفعل الاختياري أو شرطه الاختياري فهذا هو موضوع الاستثناء الثاني .
هذا إذا لم يكن التعجيز بتبديل الموضوع إلى غير الموضوعات الاضطرارية وإلاّ فلا يحكم العقل بقبح ذلك; كما في وجوب الاجتناب عن النجس ، فلا قبح في تعجيز النفس عنه بتبديل النجس إلى الطاهر وإعدام الموضوع بغسله أو قلبه أو إحالته; فإنّ عدم وجوب الاجتناب بعد التبديل والتحويل ليس من قبيل الحكم الثانوي الاضطراري .
(الصفحة176)
التحوّل من موضوع الحكم الاختياري إلى الحكم الاضطراري
نعم ، فيما كان موضوع حكم هو الاضطرار والضرورة وعدم التمكّن من شيء ، فإنّ المتفاهم العرفي من ذلك عدم جواز الاندراج تحته بالاختيار فيما صار التكليف فعليّاً .
وعلى هذا الأساس أفاد شيخنا التبريزي أنّه لو صيّر المكلّف نفسه مضطرّاً بالاختيار لا يشمله دليل الحكم الاضطراري إلاّ بالقرينة ، وأنّ موضوع الحكم الاضطراري هو الضرورة لا بالاختيار .
وأمّا إذا كان الموضوع من العناوين الاُخرى كالحضر والسفر ومن شغله السفر ومن بيته معه ، وعنوان العيال والضيف في باب الزكاة الموجبين لسقوط الزكاة ، وما شاكل ذلك من الحيض أثناء يوم الصوم وغيرها ، فلا بأس بالاندراج تحت بعضها بالاختيار; بل والتحوّل من عنوان إلى آخر .
وكذا لا يقتضي دليل النفقة التحفّظ على موضوعه بعدم طلاق الزوجة أو عدم قتل الرحم الكافر . وكذا عامّة أدلّة التكاليف لا تقتضي التحفّظ على موضوعها بعدم التعرّض للإغماء والجنون والنوم والغفلة والنسيان ، وكذا دليل وجوب النفقة على القريب لا يقتضي التحفّظ على فقر الرحم ، بل ربما كان التحفّظ على الموضوع حراماً وظلماً وإن كان على تقديره يترتّب الحكم .
فالمتحصّل هو أنّ في ما عدا القدرة المعتبرة عقلاً في موضوع الأحكام وفي ما عدا موضوع الحكم الاضطراري ، لا مانع من درج النفس تحته بالاختيار . وأمّا هما فالظاهر أنّ العقل حاكم بقبح تفويت القدرة ، والمتفاهم العرفي من أدلّة الأحكام الاضطراريّة عدم جواز جعل النفس موضوعاً لها اختياراً بعد كونه
(الصفحة177)
متّصفاً بموضوع الحكم الاختياري . ولا خصوصية للأحكام الاضطرارية سوى أنّها أحكام ثانويّة ، ولا يبعد سراية الحكم إلى كلّ حكم ثانوي من قبيل الحرج والإكراه والقضاء ، فلا يجوز التحيّل في إسقاط الأحكام الأوّلية بالاندراج تحتها وإن كان بذلك ـ ولو بسوء الاختيار ـ يسقط الحكم الأوّلي .
فمن عرّض نفسه للإكراه على المحرّمات سقط عنه الخطاب بالتحريم وإن عوقب وأثم بإقدامه على ذلك اختياراً(1) .
وكذا من اضطرّ إلى العصيان بترك الواجب أو غيره بسوء اختياره ، كما لو أكل في الليل ما لا يتمكّن معه من صوم النهار ، ولكنّه يتمكّن من ترك الاتصاف بالعصيان بالسفر قبل الزوال والخروج عن موضوع وجوب الصوم ، فإن ترك صوم المضطرّ إلى الإفطار بملاك الضرورة والحكم فيه ثانوي بخلاف ترك الصوم في السفر فإنّ السفر من الحالات والانقسامات الأوّلية للمكلّف ، فلاحظ .
ومن قبيله من لم يصلِّ في الوقت حتّى بقي منه مقدار ركعتين وهو حاضر ، لكنّه يتمكّن من الاتّصاف بالسفر; لكونه قريباً من حدّ الرخصة ، فلا يبعد وجوب ذلك عليه عقلاً وإلاّ فقد خالف الحكم الشرعي بوجوب الجامع بين القصر والتمام . وكذا لو كان قاصداً للعشرة ولم يكن بعد صلّى رباعيّة فضاق الوقت عن صلاة العصر تماماً بسوء الاختيار بل وبدونه في وجه ، فإنّه يتمكّن من فعل الصلاة الأدائية بالرجوع عن قصد الإقامة .
وعلى الوجه المشار إليه ربما نقول بوجوب السفر على من فوّت على نفسه القدرة على الصلاة تماماً حتّى لو قلنا بأنّ الصلاة التامّة واجبة على الحاضر والقصر
- (1) إلاّ أن يقال: إنّ سقوط التكليف قد يكون عقلياً كما في موارد العجز ، وقد يكون بحكم الشارع كما في الإكراه والاضطرار ونحوهما ، والمنساق من الدليل في الثاني هو سقوط التكليف فيما كان الاتصاف بالموضوع بغير اختيار .
(الصفحة178)
واجبة على المسافر، لا أنّ الواجب على المكلّف هو الجامع بين التمام حاضراً والقصر مسافراً، فلاحظ .
ولا يبعد أن يكون ما دلّ على جواز الفرار من الحرام إلى الحلال دالاًّ على ذلك وإن كنّا في غنى عنه كما اتّضح .
وقد عقد الفقهاء فصلاً بعنوان الحيل وبيان المشروع منه في كتاب الطلاق، وقد ورد شطرٌ من الأخبار المناسبة له في باب الصرف والربا وغيرهما(1) .
منافاة الاحتيال في بعض الموارد للغرض من الحكم
الوجه الرابع: نجاسة العضو الترقيعي
- (1) راجع الجواهر 32 : 201 ، والوسائل 12 : 455 ، الباب 20 من الربا . و 12: 368 ، الباب 3 من أحكام العقود ، و13: 99 ، الباب 15 من القرض .
(الصفحة179)
دعوى الإجماع على عدم جواز ترقيع عضو بالبدن
ربما يلوح من بعض الكلمات دعوى الإجماع على عدم جواز الترقيع .
قال في محكيّ الخلاف : «إذا قلع سنّ متغر ، كان له قلع سنّه ، فإذا قلعه ثمّ عاد سنّ الجاني كان عليه أن يقلعه ثانياً» ثمّ استدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم(1) .
وأورد عليه في السرائر بأنّ «هذا قول الشافعي وأنّه استدلّ شيخنا بما يضحك الثكلى ، يا سبحان الله! مَن أجمع معه على ذلك؟ وأيّ أخبار لهم فيه ، وإنّما أجمعنا في الأذن لاُمور : أحدها: أنّها ميتة فلا يجوز الصلاة له; لأنّه حامل نجاسة فيجب إزالتها . والثاني : إجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا ، فمن عدّاه إلى غيرها فقد قاس ، والقياس عندنا باطل ـ إلى أن قال ـ : وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف فإنّه قد رجع عن ذلك في مبسوطه» .
أقول : ويا سبحان الله! كيف يرجع الشيخ في مبسوطه، وسيأتي كما تقدّم أيضاً نقل عبارته .
وقال في موضع آخر من السرائر: «ومن قطع شحمة اُذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه ، فعالج الجاني اُذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة اُذنه حتّى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص . وهكذا حكم المجنيّ عليه سواء كان ظالماً أو مظلوماً ، جانياً أو مجنيّاً عليه; لأنّه حامل نجاسة . وليس إنكاره ومطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما ، بل جميع الناس . وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة ، ووجب على السلطان ذلك; لكونه حاملاً للنجاسة فلا تصحّ منه الصلاة . وكذلك إذا جبر عظمه بعظم نجس العين ولم
- (1) راجع الخلاف ، المسألة 77 من كتاب الجنايات ، سلسلة الينابيع 40 / 39 .
- وفي المبسوط في المسألة: فله قلعها أبداً حتّى يعدم إنباتها وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
(الصفحة180)
يكن في قلعه خوف على النفس ومشقّة عظيمة يجب إجباره على قلعه ، ولا تصحّ معه صلاته . فأمّا إن خاف من قلعه على نفسه ، يجب قلعه ولا يجوز إجباره على ذلك وتكون صحيحة لموضع الضرورة; لقوله (عليه السلام) : «لاضرر ولا ضرار»(1) .
أقول : لا منافاة بين تعدّيه من عدم جواز ترقيع الاُذن إلى سائر الأعضاء والجوارح على ما صرّح به هنا ، وبين ما تقدّم في عبارته الاُولى من أنّ التعدّي من الاُذن المجمع على الحكم فيه والمنصوص قياس; وذلك فإنّ مورد التعدّي هناك غير الترقيع بالنجس ، حيث فرض نبات السنّ هبة مجدّدة من الله ، فالتعدّي إليه قياس ، ومع الفارق بخلاف التعدّي إلى سائر الأعضاء الترقيعيّة ، فإنّه لعموم النجاسة أو عموم التعليل في النصّ ، فلاحظ .
وفي المقنعة : «لو أنّ رجلاً قطع شحمة اُذن رجل ثمّ طلب القصاص فاقتصّ له منه فعالج اُذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل منه ، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل به من شحمة اُذنه حتّى يعود إلى الحال التي استحقّ بها القصاص . وكذلك القول فيما سوى شحمة الاُذن من العظام والجوارح كلّها إذا وقع فيها القصاص ويعالج صاحبها حتّى عادت إلى الصلاح . وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتّى يعالج ويستبرئ حاله بأهل الصناعة»(2) .
وفي الكافي للحلبي : «فإن اقتصّ بجرح فبرئ المجروح والمقتصّ منه أو لم يبرأ ، فلا شيء لأحدهما على صاحبه . وإن يبرأ أحدهما والتأم جرحه ، اُعيد القصاص من الآخر إن كان القصاص بإذنه; وإن كان بغير إذنه رجع المقتصّ منه على المعتدي دون المجنيّ عليه»(3) .
- (1) سلسلة الينابيع الفقهية 25: 372 .
- (2) المقنعة: 761 .
- (3) سلسلة الينابيع الفقهية 24: 92 .
(الصفحة181)
وفي النهاية : «ومن قطع شحمة اُذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له فعالج اُذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل به من شحمة اُذنه حتّى يعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص . وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء»(1) .
وفي جواهر الفقه لابن البرّاج : «إذا قطع رجل اُذن آخر فأخذها المجنيّ عليه وألصقها فالتصقت بمكانها في الحال هل له قصاص مع ذلك أم لا؟
الجواب : له القصاص; لأنّ القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت ، وليس لإلصاقها تأثير في إسقاط; لأنّها ميتة قد ألصقها بنفسه ، وذلك ممّا يلزم إزالته عن نفسه ، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلّق بالصلاة من المسائل .
مسألة : المسألة وقال الجاني: إن اُريد القصاص منّي فأزيلوا القطعة التي ألصقها ، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتّى يزال ذلك أم لا؟
الجواب: قد بيّنا أنّ هذه القطعة يجب إزالتها قسراً ، أراد ذلك الجاني أم لم يرده ، وأمّا المنع بذلك من القصاص فلا يصحّ; لأنّا قد بيّنا أنّ القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت»(2) .
وقال في القواعد : «ولو أبان الاُذن فألصقها المجنيّ عليه فالتصقت بالدم الحارّ وجب القصاص . والأمر في إزالتها إلى الحاكم ، فإن أمن من هلاكه وجب إزالتها وإلاّ فلا . وكذا لو ألصق الجاني اُذنه بعد القصاص لم يكن للمجنيّ عليه الاعتراض .
ولو قطع بعض الاُذن ولم يبنه فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب وإلاّ فلا . ولو ألصقها المجنيّ عليه لم يؤمر بالإزالة ، وله القصاص»(3) .
- (1) نفس المصدر: 133 .
- (2) نفس المصدر 24: 155 .
- (3) نفس المصدر 25: 577 .
(الصفحة182)
وفي التنقيح الرائع ـ تعليقاً على قول ماتنه ـ: «ولو قطع شحمة اُذن فاقتصّ منه فألصقها المجنيّ عليه كان للجاني إزالتها ، ليتساويا في الشَيْن . قال :
لا خلاف في جواز إزالتها لكن اختلف في العلّة ، وقيل: ليتساويا في الشين كما ذكره المصنّف . وقيل: لكونها ميتة; ويتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك ، كان للإمام إزالتها على القول الثاني; لكونه حاملاً نجاسة فلا تصحّ الصلاة مع ذلك»(1) .
وفي الشرائع : «لو قطعت اُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجنيّ عليه (الجواهر: ففي المتن والنافع ومحكي المقنعة والجواهر) كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة» .
أضاف إليه في الجواهر : «في الشين المستفادة من حسنة إسحاق بن عمّار أو موثّقه . . .» إلى أن ذكر عبارة التنقيح في التعليل وقال :
«ولا يخفى عليك عدم المنافاة بين التعليلين ، بعد قضاء الأدلّة بهما ـ إلى أن قال ـ : «والتحقيق الإلتفات إليهما ، فمع العضو يبقى حقّ النجاسة ، ومع سقوط النجاسة إمّا لعدم انفصالها تماماً فلا تكون مبانة من حيّ ، أو لحصول ضرر ، يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها ، يبقى حقّ المساواة في الشين بل لا يكون حقّ غيره; بناءً على عدم جريان حكم الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيها ، بل قد يمنع بطلان الصلاة بها; لكونها كالمحمول . وعلى كلّ حال فذلك أمر خارج عمّا نحن فيه»(2) .
وفي المهذّب : «وإذا قطع اُذن رجل فأبانها ثمّ ألصقها المجنيّ عليه في الحال فالتصقت ، كان على الجاني القصاص; لأنّ القصاص يجب بالإبانة . فإن قال الجاني: أزيلوا اُذنه واقتصّوا منّي كان له ذلك; لأنّه ألصق بها ميتة ، فإن كان ذلك ثمّ ألصقها
- (1) التنقيح الرائع 4: 454 .
- (2) الجواهر 42: 365 ، قصاص الطرف .
(الصفحة183)
الجاني فالتصقت وقع القصاص موقعه . فإن قال المجنيّ عليه: قد التصقت اُذنه بعد إبانتها ، أزيلوها عنه ، وجب إزالتها بمقتضى ذلك»(1) .
وفي الخلاف : «إذا قطع اُذن غيره قطعت اُذنه; فإن أخذ الجاني اُذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها . وقال الشافعي: ليس له ذلك ، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها; لأنّه حامل نجاسة; لأنّها بالبينونة صارت ميتة فلا تصحّ صلاته ما دامت معه; دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(2) .
وفي المبسوط في مسألة ما إذا عادت سنّ الجاني بعد (القصاص) ولم تعد سنّ المجنيّ عليه : «فمن قال هذه هبة مجدّدة قال: لا شيء للمجنيّ عليه; لأنّه أخذ سنّ الجاني قصاصاً ، وقد وهب الله له سنّاً; ومن قال: هذه تلك ، فهل للمجنيّ عليه قلعها ثانياً؟ قال قوم: له ذلك; لأنّه أعدم سنّ المجنيّ عليه ، فله قلعها أبداً حتّى يعدم إنباتها ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا»(3) .
وقال في المغني : «فإن قطع اُذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت فقال القاضي: يجب القصاص ، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق; لأنّه وجب بالإبانة وقد وجدت الإبانة ، وقال أبو بكر : لا قصاص فيها ، وهو قول مالك; لأنّها لم تبِن على الدوام فلم يستحقّ إبانة اُذن الجاني دواماً . وعلى قول أبي بكر: إذا لم تسقط ، له دية الاُذن ، وهو قول أصحاب الرأي ـ إلى أن قال ـ: وإن قطع اُذن إنسان فاستوفى منه فألصق الجاني اُذنه فالتصقت وطلب المجنيّ عليه إبانتها لم يكن له ذلك; لأنّ الإبانة قد حصلت والقصاص قد استوفي فلم يبق له قبله حقّ ـ إلى أن
- (1) سلسلة الينابيع: 24 / 183 .
- (2) نفس المصدر 40 : 37 ، من القسم الثاني ، المسألة 20 من كتاب الجنايات .
- (3) نفس المصدر 40: 216 ، كتاب الجراح .
(الصفحة184)
قال ـ : والحكم في السنّ كالحكم في الاُذن »(1) انتهى .
هذه جملة من كلمات الفقهاء; والذي ينبغي أن يقال : إنّ هنا مسألتين بل أربع :
الاُولى : جواز مطالبة الجاني بإزالة عضو المجنيّ عليه إذا كان المجنيّ عليه رقعها بعد القصاص من الجاني .
الثانية: جواز مطالبة المجنيّ عليه بإزالة العضو الذي اقتصّه إذا رقعه الجاني بعد القصاص.
والثالثة : حكم جواز مطالبة المجنيّ عليه بالقصاص فيما إذا رقع عضوه قبل المطالبة بالقصاص وإجرائه .
والرابعة : اختصاص الحكم بقطع الاُذن أو ثبوته في سائر الأعضاء .
وقد اُشير إلى هذه المسائل في كلماتهم سيّما الأوليين . والذي يخطر بالبال أنّ الفقهاء سيّما القدماء منهم ومن جرى في تصنيفه على التعرّض للمسائل المنصوصة ، تعرّضوا للمسألتين الأُوليين أو إحداهما فيما إذا كان العضو المجنيّ عليه هو شحمة الاُذن بتمامها ، وربما أُضيفت إليه ذهاب بعضه .
ويلوح من بعضهم أنّ مدرك الحكم في المسألة هو الأخبار ، وأنّ الإجماع قائم على الحكم . وربما علّل بنجاسة العضو المانعة من اصطحابه في الصلاة .
والظاهر أنّ الوجه الأخير وجه تبرّعي سرى إليهم من العامّة ، وقد تقدّم حكايته في الخلاف عن الشافعي .
قال ابن قدامة في المغني : «ومَن ألصق اُذنه بعد إبانتها ، أو سنّه فهل يلزمه إبانتها؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين فيما بان من الآدمي ، وهي هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا : هو نجس ، لزمته إزالتها ما لم يخف الضرر بإزالتها كما لو جبر عظمه
- (1) المغني لابن قدامة 9 : 422 .
(الصفحة185)
بعظم نجس ، وإن قلنا بطهارتها لم يلزمه إزالتها; وهذا اختيار أبي بكر وقول عطاء بن رباح وعطاء الخراساني; وهو الصحيح; لأنّه جزء آدمي طاهر في حياته وموته فكان طاهراً كحالة اتّصاله ثمّ تعرّض لحكم القطع إذا لم ينفصل»(1) .
مستند ترقيع العضو من النصّ الخاصّ وفقهه
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : «إنّ رجلاً قطع من بعض اُذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى عليّ (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اُذنه فردّه على اُذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال (عليه السلام) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين»(2) .
ومعنى الخبر هو أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد رفع القضيّة إليه من قبل المجنيّ عليه ، أقاد المجنيّ عليه ، يعني أقاد و أخذ له القصاص ، فالضمير البارز المتّصل عائد إلى المجنيّ عليه وإن كان المعروف حسب فتاوى الأصحاب ـ كما تقدّمت ـ هو عوده إلى الجاني ليكون المعنى: أوقع به القصاص .
واستعمال أقاد بمعنى أخذ القصاص شائع، ورد في الروايات التي منها رواية الوليد بن صبيح قال: قال داود بن علي لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما أنا قتلته ـ يعني المعلّى ـ قال: «فمن قتله؟» قال: السيرافي ـ وكان صاحب شرطته ـ قال: «أقدنا منه» قال:
- (1) المغني لابن قدامة 9 : 22 .
- (2) الوسائل 19: 139 ، الباب 23 من قصاص الطرف ، الحديث 1 .
(الصفحة186)
قد أقدتك . قال: فلمّا أُخذ السيرافي وقدّم ليُقتل ، جعل يقول: يا معشر المسلمين! أيأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمّ يقتلوني ، فقتل السيرافي(1) .
ونحوه غيره .
ثمّ إنّ المراد بالآخر ، المذكور أوّلاً ، هو الجاني; ويؤكّده ردّ الشحمة إلى الاُذن بدمه ، يعني طريّاً ، فإنّ حمل ذلك على المجنيّ عليه لا يناسب هذه الفقرة; وذلك لوقوع الفصل بين الجناية وبين القصاص فرضاً ، الأمر الذي لا يصدق معه ردّ المجنيّ عليه شحمة اُذنه بدمه . وعليه فالآخر المذكور ثانياً في الخبر هو المجنيّ عليه .
ويؤكّده أيضاً قوله : «فاستقاده» يعني طلب منه القود والقصاص ، ولا معنى لطلب الجاني القصاص من المجنيّ عليه; فإنّ حقيقة القصاص استيفاء بدل الجناية ، ولا جناية من المجنيّ عليه ليستوفي بدله الجاني إلاّ بدعوى أنّ إطلاق القصاص في مثله مجاز مجاراة مع مقابله ، نظير قوله تعالى : {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(2) حيث أطلق الاعتداء على القصاص; لكنّه بلا شاهد في المقام .
وأيضاً يؤكّد ما ذكرنا قوله (عليه السلام) : «فقطعت ثانية» فإنّه يناسب كون القطع الثاني تثنية لفعله (عليه السلام) أوّلاً ، وهو يناسب إيقاع القطعين بالجاني . وحمل التثنية عليها باعتبار سبق فعل الجاني كما ترى . هذا مضافاً إلى أنّ التعليل لا يناسب إلاّ ما ذكرنا .
وبالجملة: الرواية ناظرة إلى إحدى المسألتين لا محالة; والمتراءى منها ، بل هي كالصريح في المسألة الثانية ـ أعني ترقيع الجاني ـ سيما بقرينة التعليل ; وأمّا المسألة الاُولى ـ أعني ترقيع المجنيّ عليه ـ فلم أعثر على نصّ خاصّ فيها .
والظاهر أنّه لا نصّ فيها ، وإنّما استند من استند فيها إلى نصّ إلى نفس هذا
- (1) نفس المصدر 19: 33 الباب 13 من قصاص النفس ، الحديث 3 .
- (2) سورة البقرة الآية 194 .
(الصفحة187)
الخبر; وذلك أوّلاً : لعدم احتمال رواية اُخرى استندوا إليها في هذه المسألة عداها .
وثانياً : أنّ الشيخ في التهذيب في باب القصاص من المقنعة المشتمل على خصوص المسألة الاُولى ، تعرّض لروايات لا تناسب المسألتين ، سوى رواية إسحاق; ولو كان فيهما سيّما في المسألة الاُولى نصّ لذكره وتعرّض له .
وكيف كان فالظاهر استنادهم في المسألة الاُولى إلى هذه الرواية ، والظاهر أنّ هذه الرواية كما قدّمنا إنّما تعرّضت للمسألة الثانية وإن أمكن حملها على المسألة الاُولى بتكلّف ، وذلك بحمل قوله : «فأخذ الآخر» على المجنيّ عليه وأنّه لَحَم اُذنه بعد أخذه بالقصاص ، وقوله : «فعاد الآخر» يكون بمعنى عود الجاني ، وقوله : «فقطعت ثانية يكون بمعنى بعد قطع الجاني» وقوله في التعليل : «يكون القصاص من أجل الشين» بمعنى الشين الحاصل في المجنيّ عليه ، وأنّه الموجب للقصاص ، وكأنّ هذا الاستظهار هو مبنيّ من طرح المسألة الاُولى .
ولكن هذا كلّه خلاف الظاهر جدّاً سيما تأويل التعليل بالشين بما ذكر; فإنّه مضافاً إلى بشاعته في نفسه ، لو كان الموجب للقصاص هو شين المجنيّ عليه فلا موجب للقصاص إذا كان الشين قابلاً للرفع ، فالمناسب للتعليل هو عدم إجراء القصاص في مثله ، لا إجرائه ثمّ العود على المجنيّ عليه بظلم بعدما ظلم عليه الجاني أوّلاً .
ولعمري أنّ مثل هذا أو احتماله ممّا يوهن الاعتماد على الشهرات في المسائل .
ثمّ إنّ المدرك لمثل المحقّق وغيره في تعليلهم الحكم بإزالة الجاني ما رقعه المجنيّ عليه بالمماثلة ، كما في الشرائع ، والتساوي في الشين كما في المختصر ، هو هذا التعليل الوارد في النصّ; ولا ينبغي حمل كلمات الكرام على مثل هذه المحامل .
والظاهر أنّ المراد منه هو كون القصاص لأجل إيراد العيب وتحكيمه على الجاني لا مجرّد إيلام وإحداث عيب; فإنّ الغاية من القصاص هو جعله رادعاً عن
(الصفحة188)
الجناية وأبلغ ما يكون هذا إذا كان العيب والقصاص دائم الأثر وباقيه ، فالقصاص بدون بقاء أثره بالترقيع كأنّه لغو ، وهو المقصود ظاهراً بقوله (عليه السلام) : «جعل القصاص من أجل الشين» .
نعم ، المتفاهم منه أن جعل القصاص لأجل الشين الحاصل في المجنيّ عليه ، فإذا كان المجنيّ عليه رقع عضوه وكان متمكِّناً من ذلك فلا مانع من ترقيع الجاني أيضاً وإلاّ كان عذاب الجاني زائداً على جنايته وخارجاً عن حقيقة القصاص ، وسيأتي للكلام تتمّة إن شاء الله تعالى .
وهذا التعليل من قبيل بيان حكمة القصاص في النفس الوارد في قوله تعالى : {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ}(1) ، فكما أنّ في قصاص النفس ضمان لحياة الناس كذلك في قصاص الطرف أمان لسلامة الناس من الاعتداء .
ولا ينافي هذا ـ الذي ذكرناه أخيراً ـ ما تقدّم من أنّ المراد من الشين هو إيراده على الجاني على وجه لا يُمكَّن من الترقيع; فإنّ ذلك هو المدلول المطابقي والذي ذكرناه أخيراً هو المفهوم ، من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، ولا منافاة بين الأمرين ، فلاحظ .
ثمّ إنّ الذي تقتضيه القواعد ـ بغضّ النظر عن هذا النصّ ـ هو كون الجناية من الجاني موجباً لحقّ القصاص للمجنيّ عليه ، كما قال تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(2) ، وإن كان المجنيّ عليه عالج الجناية ورفعها بالترقيع ونحوه; ولذا لم يحتمل فقيه في الجراحات سقوط حقّ القصاص إذا برئ الجرح الواقع بالجناية .
ولعلّ الذي يحدو إلى احتمال سقوط القصاص في قطع العضو بعد ترقيعه هو
- (1) سورة البقرة الآية 179 .
- (2) سورة البقرة الآية 194 .
(الصفحة189)
كون القصاص من أجل ذهاب العضو ومنفعته ، وحيث إنّ العضو ثابت ولو بإعجاز أو غيره فلا موجب للقصاص ، وهذا غفلة عن أنّ موجب القصاص هو الاعتداء المتحقّق أوّلاً ، والواقع لا يتغيّر عمّا وقع عليه .
وأمّا ذهاب الفقهاء إلى عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان العضو المجنيّ عليه ممّا يعود كالسنّ في بعض السنين ، فإنّما هو من جهة عدم المماثلة بين عضو الجاني ومورد الجناية . والقصاص عبارة عن متابعة أثر الجاني بمثل اعتدائه لا بزيادة ، فإنّها ليست بقصاص بل عدوان مجدّد ، ولا ينبغي للمظلوم أن يظلم وإنّما له أن يقتصّ .
فرع: حكم القصاص مع اختلاف الجاني والمجنيّ عليه في إمكان ترقيع عضوهما
لو كان العضو المجنيّ عليه قابلاً للالتحام والترقيع دون الجاني لمرض ونحوه ، فهل يجوز القصاص؟ فيه إشكال; منشأه ما قدّمناه من احتمال عدم صدق القصاص حينئذ . نعم ، لو كان الجاني بحيث لو اقتصّ منه لا يندمل جرحه ، لمرض ونحوه فإنّه لا يجوز القصاص بلا إشكال سيما إذا كان جرحه ممّا يسري إلى النفس .
والذي يخطر ببالي عاجلاً في هذا الفرع ، أنّه بدون تمكّن المجنيّ عليه من الترقيع ولو للغفلة يثبت له القصاص ، وأمّا مع التمكّن فلا ، فإنّه من قبيل جناية من لا ينبت سنّه على صبي ينبت سنّه حيث لا يثبت القصاص في مثله عندهم .
رجوع إلى أصل المسألة
المتحصّل في أصل المسألة أنّ للمجنيّ عليه القصاص بمجرّد الجناية ، ولا يكون ترقيع المجنيّ عليه موضع الجناية مانعاً من القصاص إلاّ على احتمال موهوم تقدّم
(الصفحة190)
ضمن خبر إسحاق وإن ذهب إليه بعض الأجلّة . هذا كلّه في المجنيّ عليه .
وأمّا الجاني فالذي تقتضيه القواعد هو سقوط الحقّ باستيفاء القصاص منه مرّة واحدة ، بلا فرق بين ما إذا عالج موضع القصاص بترقيع أو عاد العضو بنبات غير معتاد كالسنّ في بعض السنين ، وأمّا زرع السنّ فإنّه لا بأس به بلا إشكال .
نعم ، إذا كان عضو الجاني ممّا يعود حسب العادة كالسنّ في بعض السنين فاقتصّ المجنيّ عليه ربما يثبت للمجنيّ عليه الأرش أيضاً ، وهو تفاوت ما بين العضو الذي لا يقبل العود وما يكون قابلاً له .
ويحتمل تعيّن الأرش أو الدية دون القصاص; لعدم التماثل بين العضوين إلاّ بدعوى أنّ عضو الجاني هو مثل العضو المجنيّ عليه مع نقص يتدارك بالأرش ، وليس من قبيل العضوين المتباينين .
وربما يحتمل في مثل السنّ ، وجوب الانتظار أو جوازه إلى أن ينبت للجاني ما يماثل عضو المجنيّ عليه ، فلو قلعت اُنثى بالغة سنّ رجل ، وكسنّ الاُنثى ممّا يقبل العود لصغرها دون الرجل، فينتظر بها حتّى تبلغ سنّاً لا يقبل سنّها العود بحسب العادة فيقتصّ منها ; والمسألة بحاجة إلى مراجعة .
وكيف كان فقضيّة القواعد عدم جواز تكرار القصاص ، ولكن مقتضى معتبرة إسحاق والتعليل الوارد فيه هو جواز تكرّره .
بل ربما كان المتفاهم من إطلاق أدلّة القصاص أيضاً ذلك، وكان التعليل بما هو مرتكز أو مناسب عرفاً . والمتيقّن منه ما إذا كان عود عضو الجاني بترقيع دون ما إذا عاد بصورة طبيعيّة بهبة مجدّدة من الله ولم يعلم عموم التعليل لذلك ، فلاحظ .
وقد صرّح غير واحد بأنّه إذا عاد عضو الجاني بعد القصاص فيما لم يكن عوده معتاداً فهو هبة مجدّدة من الله لم يقتصّ منه ثانياً ، ولكن تقدّم في عبارة المبسوط بناء
(الصفحة191)
جواز قلع سنّ الجاني إذا عادت بعد القصاص على كونها هبة جديدة فلا تقلع أو كونها هي المقلوعة فتقلع أبداً ، ونسبه إلى مذهب الأصحاب ، وكأنّ مراده من كونها هي المقلوعة هو صدق العينيّة بالنظر المسامحي العرفي ليجوز ويصدق في مورده القصاص .
وبعبارة اُخرى: السنّ العائدة هي السنّ التي قلعها الجاني من المجنيّ عليه ، ومقتضى دليل القصاص أو إطلاقه هو جواز القصاص ، ما تحقّق موضوعه . فللمجني عليه أن يقلع مثلاً ثنيّة الجاني ، فلو نبتت مائة مرّة جاز ذلك . ومقتضى ذلك هو أنّ عود عضو الجاني لو كان بالترقيع أيضاً جاز للمجنيّ عليه إزالتها; لأنّه يصدق أنّه العضو الذي اُزيل من المجنيّ عليه ، بلا فرق بين كون المرقع بالجاني هو نفس المقطوع أو عضو آخر رقع به ، كما لو أخذ من ميّت ورقع به أو أخذ من بعض أجزاء بدنه المستور ورقع بموضع ظاهر .
وبالجملة : فكما أنّ كبر عضو الجاني بالنسبة إلى المجنيّ عليه لا يمنع من القصاص ، كذلك تكرّر عضوه المماثل لا يكون مانعاً من صدق القصاص; فإنّ الجاني جعل المجنيّ عليه محروماً من عضو خاصّ ، فللمجنيّ عليه أن يحرمه من ذاك العضو ، ولا يكون إلاّ بتكرار القصاص . غايته أنّ الجناية كان موجباً لحرمان المجنيّ عليه بفعل واحد ، وحرمان الجاني لا يكون إلاّ بفعل متعدّد، فهو كما لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صغر العضو وضعفه، بحيث تحقّقت الجناية مثلاً بضربة واحدة قليلة الألم وكان القصاص بحاجة إلى أكثر من ضربة وألم زائد .
وبالجملة : فيظهر من المبسوط تكرار القصاص على القاعدة بلا حاجة إلى رواية ، والتعبير بالتكرار مسامحة ، وإلاّ فلا تكرار في القصاص ، وإنّما التكرار في إزالة عضو الجاني .
(الصفحة192)
ثمّ إنّ مقتضى تعليل القصاص ـ دون الحدّ ـ بالشين ، هو جواز احتيال الجاني بتخدير العضو الذي يراد قصاصه لئلاّ يحسّ بالألم ، وهذا هو الفارق بين القصاص والحدود، فإنّ حقيقة الحدّ عقوبة لا تتحقّق بدون الإيلام حسب المتفاهم العرفي وإن كانت الفضيحة في مثل الجلد بنفسها أيضاً عقوبة .
نعم ، في مثل ما إذا كان الحدّ هو القتل ربما يحصل الغرض بإيجاده بدون إيلام كالقتل حال النوم أو الإغماء .
ولكن مقتضى حقيقة القصاص جواز مطالبة المجنيّ عليه بعدم التخدير; رعايةً للمماثلة بين الجناية والقصاص .
نعم ، لو كان عضو المجنيّ عليه حال الجناية لا حسّ له ، جاز احتيال الجاني في عضوه أيضاً إلى مثل ذلك .
هذا مع أنّ مقتضى القاعدة أيضاً جواز تخدير العضو عند القصاص حيث لم يقم دليل على المنع .
هذا كلّه في حقّ القصاص وكان التعرّض له استطراداً .
حكم نجاسة العضو بعد الترقيع
أمّا أوّلاً: فلأنّ الحكم في مسألتنا ـ أعني جواز الترقيع بعضو الغير والميّت ـ لا تختصّ بخصوص الأعضاء التي تحلّها الحياة ، بل يقع الكلام في أخذ سنّ الميّت
(الصفحة193)
لزرعها في الحيّ ، وقد ورد بجوازه نصّ صحيح(1) ، أو أخذ بعض عظامه; لذلك فلا يكون التعليل بالنجاسة جارياً في أمثال ذلك .
وثانياً : قد يكون أخذ العضو من الميّت بعد غُسله فيما كان مسلماً أو كان شهيداً لايحتاج طهارته إلى غسل، فلا يكون التعليل بالنجاسة مانعاً من الترقيع في مثل ذلك.
وثالثاً : أنّه قد يكون الترقيع بالأجزاء الباطنة كزرع الكلية ونحوها ، ولا دليل على المنع من اصطحاب الميتة بهذا النحو في الصلاة والطواف ، وإلاّ كان الدم ونحوه من النجاسات في البدن مانعاً ، فتأمّل .
وما دلّ على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتّى شعره ووبره وكذا الميتة على ما ببالي ، وإن كان شاملاً لمثل اشتمال ثوب المصلّي على شعرة واحدة مثلاً ، ولا يختصّ بما إذا كان ظرفاً للمصلّي كثوب ليصدق صلّى في كذا ، وذلك بقرينة عدّ مثل بول ما لا يؤكل لحمه في عداد ما لا يجوز الصلاة فيه على ما بذهني ; ولكن لا موجب للتعدّي عن ذلك إلى مثل وجود الميتة في باطن المكلّف والمصلّي أو هو منصرف عن مثله .
ورابعاً : أنّ المسألة ـ أعني اصطحاب الميتة في موارد الترقيع ـ ممّا لا واقع لها من الأساس; فإنّ الجزء الترقيعي يعود حيّاً وجزءً بالترقيع كسائر الأجزاء الأصليّة له ، يجري عليه حكم سائر أجزائه ، فإنّه جزء المسلم محكوم بطهارته ، والقصاص فيه بعنوان جزء المسلم لو جنى عليه ووجوب غسله في الغسل وحرمة
- (1) وهو معتبرة الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه؟ قال: «لا بأس» الحديث . رواه في الوسائل 16: 367 الباب 33 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 12 .
- وظنّي أنّ بعضهم نقل الرواية عن زرارة; وهو وهم كما لا يخفى . نعم ، بعض فقرات الحديث ممّا لم ننقله ظاهره أنّه حديث زرارة إن لم يكن سقط فيه كلمة «وأنا حاضر» المذكورة في هذه الفقرة .
(الصفحة194)
إبانته; بناءً على حرمة الإضرار بالبدن وغير ذلك من الأحكام ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأخوذ منه نجس العين كالكافر والكلب أو غيره ; فإنّ نجاسة أعضاء الكافر وغيره ما دامت النسبة وبدونها ، فإسراء الحكم يكون من القياس .
إن قلت : كيف لا يعدّ الجزء المفصول من الكافر منتسباً إليه بعنوان الجزئية ، وسيأتي أنّ دليل نجاسة الميتة شامل لأجزائها حتّى بعد الانفصال ، ولولا عدم كون الانفصال مانعاً من الجزئية ، لم يكن موجب لنجاسة أبعاض الميتة ؟
قلت : فرق بين الحيّ والميّت ، فإنّ جزء الحيّ لا يكون جزءً له إلاّ حال اتّصاله ، وبالانفصال يصدق أنّه كان جزءً له ، فاليد المقطوعة من الحيّ ليست من أجزائه حينئذ لعدم حياتها ، وهذا بخلاف الميّت فإنّه عين مجموع الأجزاء متّصلة أو منفصلة ، ولا دخل للاتّصال في صدق أنّه جزء للميّت ، فتأمّل .
بل أقول خامساً : مقتضى معتبرة إسحاق المتقدّمة بإطلاقها المقامي لا اللفظي هو عدم تأثير النجاسة في المنع من الترقيع ، بل عدم نجاسة العضو بعد الترقيع; حيث اعتبر المانع خصوص حقّ القصاص وهو معرض الإسقاط ، لأنّه حقّ المجنيّ عليه ، فلو كان المانع شيء آخر كالنجاسة لنبّه عليه; لأنّها معرض الابتلاء وإن لم يكن مورد الابتلاء في مورد الخبر وهو القضيّة الخاصّة; ولكن بيان الإمام (عليه السلام) لتلك القضيّة إنّما هو بداعي بيان الحكم لا مجرّد الحكاية ونقل القصّة .
وبالجملة : لا يبعد دعوى أنّ المفهوم من موثّق إسحاق هو أنّ المانع الوحيد للترقيع في مورد وهو حقّ القصاص لا مسألة النجاسة وإلاّ لنبّه عليه .
وسادساً : قد يكون الترقيع في موضع الاضطرار كالاضطرار إلى الكلية والقلب وما شاكل ذلك ، فهب نجاسة ذلك كلّه وهب حرمة اصطحاب النجس في الصلاة حال الاختيار ، ولكن لا مانع ولا مانعية عند الاضطرار بلا كلام .
ومن هنا يجوز الصلاة في الثوب النجس عند الاضطرار لبرد ونحوه ،
(الصفحة195)
ولا يكون ذلك موجباً لسقوط الصلاة جزماً .
وسابعاً : إذا كان الترقيع في غير موارد الضرورة ، لكنّه بعده يكون إزالة العضو المرقع إضراراً بالنفس ، إلاّ أن يقال : إنّ دليل حرمة الإضرار بالنفس هو الإجماع ، ولا إجماع في مثله ، ولكنّه قد يكون وجوب إزالة العضو المرقع حرجاً .
وثامناً : قد يكون المنع من الترقيع حكماً حرجيّاً ، فإنّ الأعمى إذا أمكن إزالة عماه بترقيع جزء يسير من عين ميّت، أفلا يكون تحريم الترقيع عليه حكماً ضررياً ولا أقل حرجيّاً وعسراً .
الإشكال في حكومة دليل نفي الحرج على المحرمات ودفعه
وبالجملة متعلّقات الوجوب هي المجعولات وإن كان جعلها بجعل الوجوب في مواردها دون المحرّمات .
وأمّا في المحرّمات فمتعلّقات الحرمة ليست مجعولة على العهدة ولو باعتبار تركها ، فلم يجعل عدم الزنا واللواط على المكلّفين كما جعل الحجّ والصوم والصلاة عليهم ، فلا يكون دليل نفي الحرج نافياً لما هو غير مجعول في لسان الأدلّة على
(الصفحة196)
العهدة وإن كان مجعولاً بالحمل الشائع .
فيردّه: منع كون المحرّمات في نفسها على العموم حرجيّة ، فأيّ حرج في ترك السرقة والكذب والسباب وشرب الخمر وغيرها من كثير من المحرّمات؟
ولو سلّم كون بعض أنواعها حرجيّاً في ذاته ، فأدلّة نفي الحرج لا تكون نافية لمثله خاصّة ، وذاك فيما إذا لم يكن الحرج فيه خارجاً عمّا هو المعتاد في مثله; دفعاً للغوية في دليل الحكم الأوّلي ، وأمّا إذا زاد الحرج على ذلك فلا يبعد شمول دليل نفي الحرج له أيضاً، فتأمّل . ولذا ذكروا في الأحكام الضررية بطباعها بأنّ أدلّة نفي الضرر ينفيها إذا خرج الضرر عمّا هو المعتاد في مثله ، فراجع .
وأمّا الدعوى الثانية فيرد عليها:
أوّلاً : أنّ المنفي في دليل الحرج هو جعل الحرج الشامل للحكم الحرجي كشموله لمتعلّقات الأحكام كالصوم الحرجي ، بل الحرج في المتعلّقات باعتبار الحكم; ولذا لا حرج في غير الإلزام ، فإنّ الحكم من موارد جعل الشارع ولو بالحمل الشائع .
ودعوى أنّ أدلّة الحرج ناظرة إلى نفي ما ورد في لسانه الجعل وما بمعناه ـ كقوله تعالى : {للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(1) أو {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(2) أو {إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}(3) ـ لا شاهد لها ، ويدفعها إطلاق الدليل النافي للحرج .
وثانياً : أنّه لا ينحصر دليل نفي الحرج في مثل {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج}(4) ، بل يمكن الاستناد في إثبات ذلك إلى ما دلّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعث
- (1) سورة آل عمران الآية 97 .
- (2) سورة البقرة الآية 183 .
- (3) سورة النساء الآية 103 .
- (4) سورة الحج الآية 78 .
(الصفحة197)
بالشريعة السمحة السهلة; ولا سماحة ولا سهولة في إثبات المحرمات الحرجيّة على المكلّفين .
وحكومته على أدلّة الشرائع والأحكام كحكومة {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج} بملاك النظارة ، فلا تلحظ النسبة بينه وبين غيره .
ورواية بعثة النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالحنيفيّة السمحة ، رواها في الوسائل عن الشيخ في الأمالي بسنده إلى أبي ذرّ في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) له ، وعن الكليني بسنده إلى ابن القداح وفيه سهل بن زياد . وعن الكليني بسنده إلى سدير وفيه زريق بن الزبير ، هكذا في دعاء للسجّاد (عليه السلام) : «واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة (السهلة) ملّة إبراهيم خليلك ودين محمّد (صلى الله عليه وآله) . . .» .
وأمّا ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سُئل : أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : «لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة»(1) .
فالظاهر أنّ المراد من الدين فيه: الحكم الذي يتعبّد ويعمل به وإن كان غيره أيضاً ممّا يجوز لكونه حكماً ترخيصيّاً .
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على إطلاق أدلّة الأحكام وردّه
ثمّ إنّ حكومة دليل نفي الحرج ونحوه مبنيّة على كونه ناظراً إلى أدلّة الأحكام الأوّلية وتحديدها بغير مورد الحرج . وبتعبير آخر: ملاك الحكومة فيه هو اللغويّة بدونها ، نظير لا ربا بين الوالد والولد; وهذا مبتن على عدم صلاحية دليل الحرج
- (1) الوسائل 5: 246 كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب الصلوات المندوبة ; 14: 74 ، الباب 48 من مقدّمات النكاح; 1: 388 ، الباب 30 من آداب الحمّام 1: 152 الباب 8 من الماء المضاف .
(الصفحة198)
لنفي الحكم الذي يكون حرجيّاً من أصله; وحيث إنّ إطلاق الدليل شامل لذلك أيضاً كشموله لما إذا كان الحرج في إطلاق الحكم ، وإن لم يكن الحكم بطبعه حرجيّاً فلا لغويّة في دليل نفي الحرج حينئذ لو حمل على نفي الحكم الذي يكون حرجيّاً بطبعه; ونتيجة ذلك هو التعارض بين دليل نفي الحكم الحرجي وإطلاق أدلّة الأحكام الأوّلية بلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر .
ونظير هذا ما ذكرنا في قاعدة لا ضرر; بناءً على شمولها للأحكام التي هي ضررية بطباعها وعدم اختصاصها بالأحكام التي يكون إطلاقها ضررياً .
نعم ، الاستشهاد بآية نفي الحرج في تخصيص الأحكام الأوّلية بلا لحاظ النسبة على ما ورد في بعض الأخبار المعتبرة ، يُعيّن تقديم دليل نفي الحرج على غيره ، ولكنّه من تقديم أحد المتعارضين على غيره بقرينة خارجيّة .
إلاّ أن يقال: إنّ الخبر تضمّن تقديم دليل نفي الحرج بعنوان أنّه يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، لا بعنوان تقديم أحد المتعارضين تعبّداً ، وحيث إنّ لسان لا ضرر ونحوه متّحد مع لسان نفي الحرج، فيقدّم دليل نفي الضرر أيضاً على سائر الأدلّة بلا لحاظ النسبة .
هذا مضافاً إلى أنّ جعل لا ضرر في مورد إطلاق دليل السلطنة للمالك على ماله يأبى عن تخصيص دليل نفي الضرر بخصوص الأحكام التي تكون ضررية بطباعها .
الوجه الخامس: عدم جواز الترقيع لكون الجزء المبان ميتة
ربّما يستند في عدم جواز الترقيع وإن كان العضو مأخوذاً من غير الميّت ، للحكم بنجاسة العضو المبان من الحيّ وكذا المبان من الميّت بالأولويّة ـ وإن كانت نجاسة أعضاء الميّت لا تحتاج إلى دليل سوى دليل نجاسة الميّت ـ إلى ما ورد في
(الصفحة199)
النصّ من أنّ: «ما قطعته الحبال فهو ميتة» وهو معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكر اسم الله عليه»(1) .
ونحوه معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت (ميتة خ ل) وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكه ثمّ كُلْ منه»(2) .
ونحوه معتبرة زرارة ورواية عبدالله بن سليمان ، إلاّ أنّ في الأخير روى إلى قوله : «فهو ميتة» (3) .
ولكنّ المتفاهم عرفاً من ذلك هو عدم جواز الانتفاع به كما ينتفع ببقيّة الصيد على تقدير تذكيته ، وأنّ الجزء المنقطع قبل التذكية لا يذكّى بتذكية الصيد بعد ذلك
- (1) الوسائل 16: 236 الباب 24 من الصيد والذبائح ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 3 و 4 .
- ثمّ إنّ من قبيل هذه النصوص هو ما ورد في أليات الغنم المقطوعة حال حياتها من الحكم بكونها ميتة كمعتبرة عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّه قال في أليات الضأن: «تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة» . الوسائل: الباب 62 من النجاسات .
- ومعتبرة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» . الوسائل: الباب 2 من غسل المسّ .
- ورواية الكاهلي وفي سنده سهل في حديث السؤال عن قطع أليات الغنم: «إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) : إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» . الوسائل: الباب 30 من الصيد والذبائح .
- وفي رواية الحسن بن عليّ عن أبي الحسن (عليه السلام) في الأليات المقطوعة: هي حرام . نفس المصدر .
- والجواب عن الاستدلال بهذه الروايات يتّضح من الجواب عن الاستدلال بالروايات المذكورة في المتن .
(الصفحة200)
فضلاً عمّا إذا هرب الصيد ولم يمكن تذكيته .
ولو سلّم إطلاقه لما إذا رقع الجزء المقطوع وعادت إليه الحياة، فمورد الخبر هو أجزاء الصيد لا مثل جزء إنسان قطع للترقيع بحيّ .
ودعوى العلم بعدم الفرق في النجاسة بينهما إنّما تتمّ قبل الترقيع لا بعده .
إلاّ أن يكون المدّعى هو أنّ المتفاهم العرفي من النصّ هو الإطلاق والشمول لأجزاء الإنسان ، وأنّ الموضوع هو الجزء المبان من الحيّ صيداً كان أو إنساناً ، ولكن مع احتمال كون المراد من الميتة تعبّداً وحكومة هو ذلك بلحاظ بعض أحكام الميتة ، وهي الأحكام الثابتة في غير الإنسان أعني مثل الأكل ، وذلك بقرينة الحبال المنصرف إلى المعدّ لصيد الحيوان ، لا موجب للتعدّي إلى أجزاء الإنسان والترقيع بها .
ودعوى أنّ إطلاق التعبّد بكونه ميتة يوجب شموله للأحكام الثابتة في الإنسان ، يدفعها أنّ قرينة الحبال موجب للإجمال لاحتمال القرينيّة والاعتماد عليه في التخصيص ، ومعه فلا ينعقد الإطلاق .
هذا مع أنّ الذي يطلق على الإنسان هو الميّت لا الميتة .
بل يمكن أن يقال : إنّ مصبّ الرواية هو العضو المقطوع من شيء قابل للتذكية إلاّ أنّه حيث قطع بغير التذكية وبقطع الحبال عند اضطراب الحيوان فيها كان ميتة; فلا يشمل ما إذا كان المقطوع منه غير قابل للتذكية كالإنسان ، والتعدّي إليه قياس واضح .
ويؤكّد ما ذكرنا من كون الخبر ناظراً إلى الأكل لا غيره، فلاحظ ذيل الخبر .
ومجرّد اشتراك العضو المقطوع من الإنسان مع المقطوع من الحيوان القابل للتذكية في الحكم قبل الترقيع لا يوجب الاشتراك بعده .
وبالجملة : حكومة النصّ بكون الجزء المبان من الحيّ ميتة لا إطلاق له
(الصفحة201)
بالنسبة إلى الجزء المبان من الإنسان; بناءً على إطلاق الميتة والتنزيل لما بعد الترقيع .
ثمّ إنّه يلزم القائل بإطلاق التنزيل وجوب غسل المسّ فيما رقع إنسان بجزء مشتمل على عظم من ميّت كلّما مسّ ذلك الجزء ، وهذا أيضاً بعيد في نفسه .
هذا في العضو المبان من الإنسان الحيّ ، وأمّا المبان من الإنسان الميّت فما دلّ على نجاسة الميّت وإن ا قتضى نجاسته بتمام أجزائه ، مجتمعة ومتفرّقةً ، ولكن قصاراه هو النجاسة ما دام العنوان ، فإذا صار الجزء حيّاً بالترقيع فلا دليل على نجاسته إلاّ الاستصحاب المدفوع بأنّه مشروط بوحدة الموضوع في المتيقّن والمشكوك ، وهو قطعي الانتفاء ، ولا أقلّ من الشكّ ، للشكّ في الموضوع وأنّه الميتة المنتفي بعد الترقيع أو غيره الباقي في حال الترقيع ، ومعه فلا يجري الاستصحاب .
وقد تقدّم أنّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس ، لا يقتضي التحفّظ على موضوعه بالإبقاء ، بل كما يجوز تطهير النجس بالغسل فيما كان قابلاً له ، يجوز إعدام الموضوع وتحويله إلى موضوع آخر غير محكوم بالنجاسة كتخليل الخمر وإحراق الميتة وتبديله برماد وتمليح الكلب وما شاكل ذلك . وليكن جعل الميتة جزءً للحيّ المحكوم بالطهارة من هذا القبيل . وعدم جواز إحراق الميّت المسلم فهو بدليل وجوب التجهيز لا دليل وجوب الاجتناب عن النجس .
ولولا ما ذكرناه من عدم الموجب لنجاسة العضو بعد الترقيع ، لم يصحّ الاستناد في طهارة أعضاء الميّت الباطنة إلى كونه ميّتاً مغسّلاً فيكون طاهراً ، وذلك فإنّ المتيقّن من طهارة الميّت بغسله هو طهارة أعضائه الظاهرة ، وأمّا أعضاؤه الباطنة ككليته وغيرها فغير معلوم ، ومقتضى إطلاق نجاسة الميّت قبل غسله هو نجاسته بتمام أعضائه مطلقاً ، فيحتاج طهارة بواطنه إلى دليل ، ومع إجمال دليل الطهارة يقتصر في رفع اليد عن دليل النجاسة على المتيقّن .
(الصفحة202)
أدلّة الجواز
في مسألة أخذ العضو من الحيّ والميّت للترقيع
ممّا يمكن الاستدلال به لجواز أخذ العضو من الميّت بل الحيّ ـ بعد عدم تماميّة ما يمكن الاستدلال به للمنع ، زيادة على ما تقدّم في المسألة السابقة من قاعدة الاضطرار في بعض الفروض وقاعدة الإلزام في بعض الموارد ، وغير ذلك ممّا تقدّم ـ وجوه:
الأوّل: الأصل حيث لا يكون هناك دليل آخر .
الثاني: غير أنّه يمكن الاستدلال للجواز بما دلّ على أنّ الله خوّل إلى المؤمن كلّ شيء عدا إذلال نفسه ، وقد ورد هذا المضمون في غير واحدة من الروايات :
روى الكليني في الموثّق عن سماعة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «إنّ الله عزّوجلّ فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه ، أما تسمع لقول الله عزّوجلّ : {وَللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}(1) فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاً ، يعزّ والله بالإيمان والإسلام»(2) .
وفي الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسه»(3) .
- (1) سورة المنافقون الآية 8 .
- (2) الوسائل 11: 424 الباب 12 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 3 .
(الصفحة203)
وروي عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحو من موثّق سماعة(1) .
ومفادها حرمة الإذلال وجواز ما عداه من شؤون النفس ، وهذا عامّ ومطلق ، يؤخذ به إلاّ فيما قامت الحجّة على تخصيصه وتقييده .
والظاهر أنّ المحرّمات من قبيل شرب الخمر أو إيذاء الآخرين خارجة بالتخصّص; فإنّ المنساق من هذه النصوص هو حلّ ما كان من شؤونه ويتعلّق بنفسه .
ولو عمّتها لرفعنا اليد عن العموم بالتخصيص أيضاً ، ولا يلزم فيه تخصيص مستهجن . كيف؟ ولا يكون عمومه أكثر ممّا دلّ على حلّ كلّ شيء ، لا ما كان بلسان جعل لكم ما في الأرض جميعاً; فإنّ لسانه لسان تكوين لا تشريع ، ولا موجب لتخصيصه حتّى في المحرّمات ، فإنّ المحرّمات أيضاً مجعولة جعل تكوين وخلق للإنسان ، ولكن لا للانتفاع به في المحرّم ، فإنّ الميتة إذا حلّ الانتفاع بها في غير الأكل أو جاز الانتفاع بها بالتحويل إلى مادّة أُخرى ، صحّ أن يقال إنّ الميتة مخلوقة للإنسان وإن كان لا يصدق أنّ الميتة بعنوانها محلّلة له; لأنّ الميتة حين تعنونها بهذا العنوان ليست محلّلة; لكون إطلاق الحكم بالحلّ محمولاً على الشيء باعتبار منافعه المقصودة وهو الأكل في اللحوم . وهكذا الخمر ، فإنّه يصدق خلقها للإنسان إذا كان الغرض هو الانتفاع بها ولو بعد التخليل .
وبالجملة : مفاد جعل أو خلق لكم ما في الأرض ليس لسان تشريع.
بل الدليل على حلّ كلّ شيء وأنّه الأصل بمعنى العموم هو قوله تعالى : {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} إلى قوله تعالى : {وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(2) . ومع ذلك فهذا العام قابل للتخصيص بعامّة
- (1) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (2) سورة الأنعام الآيات 151 ـ 153 .
(الصفحة204)
المحرّمات في الشريعة .
الثالث: وممّا ذكرنا تعرف أنّ آية حلّ ما عدا المحرّمات المذكورة فيها أيضاً دليل على الحكم في مسألتنا ، أعني جواز أخذ العضو من الميّت بلا حاجة إلى الأصل حتّى يكون مذهب الأخباري القائل بالاحتياط في الشبهات التحريميّة مانعاً من المصير إلى الحلّ .
الرابع: ثمّ إنّ ممّا يمكن الاستدلال به لجواز أخذ العضو من الحيّ للترقيع ، هو حديث إجابة المضطرّ الدالّ على لزوم إجابته; بدعوى عمومه لما نحن فيه .
روى الشيخ في الموثّق عن السكوني(1) عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»(2) .
وفي الوسائل عنوان الباب هكذا: باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لصّ أو سبع أو نحوهما . وزاد في عنوانه في أبواب الدفاع من الحدود . وردّ عادية الماء والنار عن المسلمين .
وروى الكليني في المضعّف كالصحيح ، عن عاصم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ
- (1) وهو ثقة على ما يظهر من تعبير الشيخ في العدّة ، وإن كان السكوني وهو إسماعيل بن زياد عاميّاً . ولمّا كان عمدة رواياته مرويّة بواسطة النوفلي الحسين بن يزيد كان هو ثقة أيضاً، كما يظهر من الشيخ أنّ الأصحاب عملوا بروايات السكوني وعمدتها واصلة بواسطته . مع أنّ الرجلين من المشاهير ولو كان فيهما قدح علم لا محالة .
- وذكر سيّدنا الأستاذ أنّ النوفلي من رجال تفسير القمي فهو ثقة بالتوثيق العام .
- هذا مع أنّ السند المشتمل على الرجلين كثير في الكافي ، وكأنّ اختيار الكليني له لقلّة الوسائط ، فإنّ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، ولولا وثاقة كلّ رجاله لم يكن وجه لترجيح خبر غير الثقة قليل الواسطة على خبر الثقة كثير الواسطة .
- ودعوى أنّه في تمام الموارد من الخبر الموثوق به وإن لم يكن راويه ثقة ، لا تخلو عن جزاف .
- (2) الوسائل 11: 108 ، الباب 59 من جهاد العدو ، الحديث 1 .
- ورواه في الحدود 18: 590 الباب 7 من الدفاع .
(الصفحة205)
النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «من أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم ، ومن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»(1) .
وفي الوسائل: «عمر بن عاصم الكوفي» وهو سهو والصحيح عمّه عاصم الكوفي، وهو عاصم بن حميد الحنّاط .
وعنوان باب الخبر في الوسائل: وجوب الاهتمام بأمور المسلمين .
ولكن يرد على الاستدلال به:
أوّلاً : أنّه مخصوص بخصوص موارد صدق الضرورة ، كأخذ العضو من الميّت لحفظ حياة الحيّ أو ما شاكله ممّا يصدق الاضطرار معه ، وأمّا غير ذلك كترقيع جلد يسير بالحيّ للتجميل فلا يعمّ .
وثانياً : عدم دلالته على وجوب الإجابة حتّى في مورد الضرورة إلى العضو كموارد توقّف الحياة ; والسرّ في ذلك ما قرّرناه وحرّرناه في محلّه من أنّ أدلّة الأحكام الثانويّة من هذا القبيل ، كاستحباب الوفاء بالوعد ووجوب الوفاء بالنذر وما شاكل ذلك ، ليس ناظراً إلى تحديد مواردها وإنّما مدلولها وجوب الوفاء أو استحبابه فيما كان الأمر مباحاً، بغضّ النظر عن دليل وجوب الوفاء واستحبابه وغيره من الأحكام الثانوية .
فلابدّ من إثبات الحلّ خارجاً ليحرز اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء واستحبابه ، وبدونه فالتمسّك بدليل الوفاء يكون تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقيّة; ولذا لا ترى أحداً من الفقهاء يتمسّك لصحّة النذر إذا شكّ في حلّ متعلّقه بدليل صحّة النذور ووجوب الوفاء بها . وكذا لا مجال لتوهّم إثبات حلّ شيء بمجرّد وعد المؤمن به .
- (1) الوسائل 11: 559 الباب 18 من فعل المعروف ، الحديث 3 .
(الصفحة206)
قصور أوفوا بالعقود عن تصحيح المعاملات
مضافاً إلى أنّ عموم «أوفوا بالعقود» مخصّص بغير العقود المحرّمة ، لا بعنوان العقد المحرّم حتّى يقال: إنّ الخارج والمخصّص هو واقع العقود المحرّمة بعنوان الربا وما شاكلها .
وبعبارة اُخرى ما هو فاسد ومحرّم بالحمل الشائع فيقتصر في تخصيصه على المقدار الثابت فيه التخصيص ، بل المخصّص هو عنوان: إلاّ شرط أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ، فالعقد الذي يجب الوفاء به هو العقد الذي لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً ، وإثبات هذا العنوان بالعموم تمسّك بالعام في المصداق المشتبه .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب هو عدم نفوذ العقد وعدم صحّته ، فلا مجال للعام في مورد ينقّح خلاف موضوعه بالاستصحاب; فلا يتوهّم أنّ أصالة الفساد لا مجال لها مع العموم ، لأنّه دليل اجتهادي; فإنّ الاُصول المنقّحة للموضوعات مقدّمة على العمومات كما هو واضح .
ولا يلزم إلغاء «أوفوا بالعقود» إلاّ إذا كان مسوقاً لتصحيح المعاملات ، وأمّا إذا كان مساقها لزوم المعاملات الصحيحة فليس بعد حمله على ما ذكرنا أي إلغاء ، وتمام الكلام في غير المقام .
وبالجملة : ما تضمّن الحكم بعنوان ثانوي ـ ومن جملته وجوب إجابة المضطرّ كاستحباب الوفاء بالعهد أو وجوب الوفاء بالنذر ـ لا يثبت حلّ متعلّقه ، وإنّما هو ناظر إلى الحكم حيث ثبت حلّ الفعل في نفسه فيجب بعنوان إجابة المضطرّ ويستحبّ بعنوان إجابة المؤمن وهكذا .
(الصفحة207)
ليت شعري هل يتوهّم عامّي فضلاً عن متفقّه فكيف بفقيه ، أنّ ما دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن أو الإحسان إليه يدلّ على حلّ أخذ عضو من الميّت للترقيع به ؟
وما دلّ على وجوب إجابة المضطرّ وإن اختلف عمّا دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن وغيره بالوجوب والاستحباب ، ولكنّه لا يختلف عنه في متعلّق الحكم وأنّه الإجابة والقضاء في كلّ شيء .
هذا ، ولولا ما ذكرناه من أنّ المنساق من هذه الأدلّة هو الحكم فيما ثبت الحلّ بدليل خارج ، لم يكن وجه لتخصيصها بغير المحرّمات ، بل وقع التعارض بين هذه الأدلّة وأدلّة المحرّمات لا محالة; لاحتمال اختصاص الحرمة بغير مورد حاجة المؤمن وطلبه وعدته وهكذا ، والنسبة هي العموم من وجه ، ولا يظنّ بفقيه أن يحتمل مثل ذلك .
الخامس: وقد يستدلّ لجواز قطع العضو من الميّت لترقيعه بالحيّ بما دلّ على جواز تقطيع الجنين الميّت لإنقاذ حياة اُمّه الحامل وبالعكس .
مثل معتبرة عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: «شقّ (يشقّ) بطنها ويخرجولدها» ونحوه صحيحه الآخر(1).
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : «نعم ، ويخاط بطنها»(2) .
ونحوه معتبرة ابن اُذينة(3) وقريب من ذلك غير واحد من الأخبار .
- (1) الوسائل 2: 673 ، الباب 46 من الاحتضار ، الحديث 2 و6 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 7 .
(الصفحة208)
وأمّا الدليل على جواز تقطيع الجنين فهو الصحيح عن وهب بن وهب أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك ، يشقّ بطنها ويخرج الولد . وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه»(1) .
ولا بأس بسنده إلاّ من جهة وهب فقد ضعف . وقيل: إنّه كذّاب أو أكذب البريّة ، ولكن روى عنه الأجلاّء . وقد ردّ الشيخ في موضع من التهذيب رواية وقع هو في سندها بأنّه عامّي متروك العمل بما يختصّ بروايته ، ولو كان كما اشتهر كذّاباً لكان ردّ الرواية بذلك أولى . وكأنّ مراده من ردّ ما اختصّ العامّي بروايته هو خبر العامّي المعارض بخبر الإمامي لا بدون المعارض إذا اختصّ العامّي بنقله ، وإلاّ فإنّ نفس الشيخ في العدّة ذكر أنّ الأصحاب عملوا في موارد عدم النصّ من الإمامي بأحاديث جمع من العامّة وعدّ منهم السكوني .
وبالجملة : يلوح من تعبير الشيخ في التهذيب توثيق الرجل سيما إذا ضمّ إلى عبارته المنقولة عن العدّة في شأن الرواة من العامّة .
هذا ، ولكن يرد على الاستدلال بهذه الأخبار:
أوّلاً : ورودها في موضع خاص ، والتعدّي إلى سائر الموارد قياس لا نقول به .
وثانياً : أنّ موردها قطع العضو بدون أخذها للترقيع ، فنهاية مدلولها جواز تشريح الميّت لمصلحة الحيّ ، وأين هذا من أخذ عضوه لذلك ؟
والإنصاف أنّ دلالة هذه الأخبار على جواز تقطيع الميّت ـ وهو الذي يصطلح عليه بتشريح الميّت ـ لمصلحة الحيّ غير بعيدة وإن كان مورد الخبر هو تقطيع الاُمّ لإنجاء الولد أو بالعكس .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 3 .
(الصفحة209)
السادس: وممّا يمكن الاستدلال به لجواز الترقيع هو الرواية المتقدِّمة في ترقيع الاُذن; فإنّ المنساق منه هو كون قطع الاُذن من أجل الغرض من القصاص وهو الشين بالجاني لا من حيث النجاسة .
وإن شئت فقل: إنّ مقتضى الإطلاق المقامي فيه ـ لو لم يكن اللفظي ـ جواز الترقيع وعدم نجاسة العضو حينئذ .
تنبيه: قد اتّضح ممّا قدّمناه جملة من الكلام في مسألة تقطيع أعضاء الميّت للتعليم والتعرّف على معالجة المرضى سيّما المضطرّين من المسلمين، فمن تتوقّع ضرورتهم فضلاً عمّا لو تحقّقت ضرورة بالفعل; وخصوصاً مع إذن الميّت أو وليّه.
ومحصّل الكلام فيها: عدم صدق المُثلة في مثلها. وكون المنع للهتك المنتفي موضوعاً بمثل الإذن سيّما من نفس الميّت، بل وبدونه أحياناً إذا لم يكن نهي عن ذلك. هذا مع اقتضاء الضرورة بدليلها المتكرّر فيما تقدّم للحلّ على تقدير إطلاق دليل الحرمة. مع دلالة ما تضمّن شقّ بطن الاُمّ الميّتة لإخراج ولدها الحيّ وبالعكس، أعني تقطيع الولد الميّت في البطن حفظاً للاُمّ.
(الصفحة210)
المسألة السادسة : أخذ العضو من الحيّ للترقيع بحيّ آخر ، له صور يجوز في بعضها دون بعض (1) .
(1) لا يجوز قطع العضو من الحيّ لغرض الترقيع أو غيره إذا استلزم ذلك موته وقتله ، ولا فرق في ذلك بين إذن الشخص وعدمه; فإنّه لا ولاية للإنسان على قتل نفسه .
حكم الانتحار عند الاضطرار
نعم ، المعروف على الألسنة عدم جواز قتل الإنسان نفسه مطلقاً ، بلا فرق بين فرض الاختيار وفرض الإكراه والاضطرار وموارد كون الحياة حرجياً ، كموارد المرض الشديد المشتمل على الآلام الشديدة ممّا تكون الحياة معها حرجاً شديداً .
ولكن هذا الحكم لو تمّ فإنّه على خلاف القاعدة; فإنّ مقتضاها ارتفاع الحرمة عند الضرورة والإكراه والحرج بلا فرق بين القتل وغيره ، فإنّ قتل النفس وإن كان محرّماً إلاّ أنّ حرمته عند الحرج وغيره ثابتة بإطلاق دليل الحرمة .
ومن الواضح أنّ إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية محكومة بأدلّة نفي الحرج ونحوه ، إلاّ مع قيام دليل على تخصيص مثل أدلّة الحرج ، فيثبت الحكم الأوّلي وإن كان حرجيّاً ، فلابدّ إذن من دليل خاصّ على حرمة قتل الإنسان نفسه في مورد
(الصفحة211)
يكون حرمة القتل حرجيّاً أو ضرريّاً أو كان الإنسان مضطرّاً إلى القتل لدفع ضرورته.
وقد يقال : إنّ أدلّة الحرج ونحوه قاصرة عن نفي الأحكام الأوّلية إلاّ في مورد الحياة ، فهي ناظرة إلى نفي مثل الحرج حيث لايستلزم نفي الحياة .
ولكنّه مجرّد دعوى لا شاهد عليها بعد إطلاق الأدلّة في نفي الحرج وغيره أو عمومها .
وقد يقال : إنّ حرمة قتل النفس على الإنسان من الأحكام الحرجية بذاتها ، وأدلّة نفي الحرج تنفي إطلاق الحكم غير الحرجي بذاته ; وذلك لأنّ الإنسان لا يقتل نفسه بحسب العادة اختياراً ، فالدليل ناظر إلى ما يقع مورد الابتلاء من قتل الإنسان نفسه عند كون الحياة حرجاً عليه ، ولا أقلّ من كونه المتيقّن من إطلاق الدليل .
وحمل دليل حرمة قتل النفس على غير مورد الابتلاء ، من قبيل الحمل على الفرد النادر; وهو حمل مستهجن .
ويمكن الإجابة عنه بأنّ هذا إنّما يتمّ فيما كان الدليل على حرمة قتل النفس مسوقاً لذلك .
وأمّا إذا كان الدليل مسوقاً لشيء آخر وإن كان يستفاد منه حرمة قتل الإنسان نفسه ، فلا بأس بحمله على الفرد النادر; لعدم الاستهجان في مثله . وحيث إنّ عمدة الدليل على حرمة القتل ما ورد في حرمة أكل الطين; معلّلاً بأنّه من أكله فمات فقد أعان على نفسه ، فلا بأس بحمله على غير موارد الحرج .
(الصفحة212)
نصوص حرمة الانتحار
ومعتبرة معاوية بن عمّار عن ناجية ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إنّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة ويموت بكلّ ميتة إلاّ أنّه لا يقتل نفسه»(2) .
والعمدة هو الخبر الأوّل ، فإنّ لسان رواية ابن عمّار أعمّ من الإلزاميات وإن كان الاشتمال على الإيمان لازماً .
وممّا أسبقنا تعرف عدم صحّة الاستدلال لحرمة قتل النفس في موارد الحياة الحرجيّة بقوله تعالى : {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(3) فإنّها مسوقة لحرمة التعرّض للهلاك والخطر ، وإن اُستفيد منه حرمة قتل النفس بالفحوى ، ولكنّه قابل للحمل على غير موارد الحياة الحرجيّة .
ثمّ إنّ الاستدلال بالأخبار الخاصّة على حرمة قتل النفس في موارد الحياة
- (1) الوسائل 13: 441 ، الباب 52 من أحكام الوصايا . رواه الصدوق في الفقيه 3: 374 أيضاً مرسلاً ضمن باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عزّوجلّ عليها النار الحديث 23 ورواه صاحب الوسائل عنه أيضاً في 19: 13 الباب 5 من قصاص النفس ، وزاد عليها في الفقيه ، وحكاه في الوسائل: قال الله تبارك وتعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) . سورة النساء الآيتان 29 و 30 .
أقول: ظنّي أنّ ذكر الآية ، من الصدوق ، لاتمام الخبر . ويؤكّده خلوّ مسنده في الفقيه ـ أعني رواية الحنّاط ـ عن ذلك . وقد رواه في الوسائل عن عقاب الأعمال أيضاً بدون زيادة . والله العالم .
(2) الوسائل 19: 13 ، الباب 5 من قصاص النفس الحديث 3 .
(3) سورة البقرة الآية 195 .
(الصفحة213)
الحرجيّة مبتن على أحد أمرين :
الأوّل : كون تخصيصها بغير موارد الحياة الحرجيّة من التخصيص بالفرد النادر المستهجن .
والثاني : عدم حكومة أدلّة الحرج على المحرّمات بالتقريب المتقدّم آنفاً ، من كونها حاكمة على خصوص الأدلّة المتضمّنة للجعل المخصوص بالواجبات; فإنّها المتضمّنة لعنوان الجعل وما بحكمه بالحمل الأوّلي .
وأمّا المحرّمات فإنّها وإن كانت مجعولة بالحمل الشائع ، لكن أدلّة الحرج قاصرة عن تخصيصها ، وقد تقدّم تمام توضيح ذلك مع ردّه .
فالمتحصّل أنّ حرمة قتل النفس في موارد الحياة الحرجيّة مبتن على عدم إمكان تخصيص دليلها بغير موارد الحرج .
نعم ، يبقى في المقام شيء ، وهو أنّه قد يستند في إثبات تحريم قتل النفس في هذه الموارد إلى معرفة ذلك من مذاق الشرع المعلوم بما ورد في أجر المريض ، والصبر عند الآلام والبلايا وما شاكل ذلك ، ولكنّه لا يخلو من خفاء .
(الصفحة214)
وأمّا إذا لم يستلزم قطع عضو الحيّ موته ، فهل يجوز ذلك؟ فيه تفصيل (1).
(1) لا إشكال في عدم جوازه بدون إذن صاحبه; فإنّه جناية وعدوان ، ويدلّ على حرمته كلّ ما دلّ على النهي عن الاعتداء .
وعلى تقدير الجناية يثبت القصاص والدية على التفصيل المحرّر في محلّه .
حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع
أمّا أخذ العضو من الحيّ برضاه مجّاناً أو بعوض ، فقد فصل غير واحد في المقام بين الأعضاء الرئيسة كالعين واليد والرجل فلا يجوز الإذن في ذلك .وعلى تقديره لا يحلّ الأخذ منه وإن كان لا يبعد عدم ثبوت الدية على تقدير الإذن; لما يظهر من بعض الأخبار من أنّ ثبوت الدية إنّما هو لهتك الجاني حرمة المجنيّ عليه على ما ورد في النصّ الوارد في الجناية على الميّت ، وما ورد من استئذان الإمام (عليه السلام) في غمز يد الراوي ، وبين غيرها من الأعضاء فيجوز الإذن ويحلّ الأخذ عنده .
وقد ظهر جملة من الكلام في ذلك عند التكلّم في مسألة الترقيع بأعضاء الميّت ، والذي من جملته قضيّة نجاسة العضو المبان من الحيّ حتّى بعد الترقيع بحيّ آخر ، مع ما عندنا في ذلك .
والذي يمكن أن يقال هنا زائداً على ما تقدّم هو: الاستدلال لعدم جواز الإذن في أخذ العضو من البدن بوجوه:
(الصفحة215)
الوجه الأوّل: المنع من الظلم على النفس
وقوله تعالى : {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوح وَعَاد وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}(2) .
وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الاَْرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً}(3) إلى غير ذلك من الآيات التي هي بهذا المضمون وهي كثيرة جدّاً .
ولكن الظاهر أنّ الظلم إنّما يصدق إذا لم يكن هناك عوض وغرض عقلائي في بذل العضو وإلاّ فلا يصدق عنوان ظلم النفس . فهل ترى أنّ من بذل نفسه فضلاً عن بعض أعضائه في الجهاد يعدّ ظالماً لنفسه؟! ولا فرق في العوض بين العوض الاُخروي والتعويض بمال الدّنيا .
أو ترى أنّ من حمّل نفسه المشاق للتجارة فركب البحر وعرّض نفسه للمخاوف والأخطار بغية الكسب والربح ، يعدّ ظالماً لنفسه أو يكون خادماً لها بجعلها غنيّة عن السؤال والفقر والذلّ والمهانة ؟!
وعلى هذا الأساس ربما يقال: بعدم جريان حديث «لا ضرر» في التكاليف
- (1) سورة الطلاق الآية 1 .
- (2) سورة التوبة الآية 70 .
- (3) سورة النساء الآية 97 .
(الصفحة216)
حيث يكون إطلاقها منشأ لضرر مادّي; فإنّ ذلك لا يعدّ ضرراً بعدما كان المكلّف يعوّض عنها في الآخرة . ومعه يحمل الحديث على عدم جواز الإضرار بالناس لا تقييد الأحكام .
وإن كان يرد على هذا: أنّه إلغاء لحديث «لا ضرر...» بحسب ما هو المفهوم منه; فإنّ المنساق منه هو أنّ الضرر العرفي منفيّ أو لا يجوز ، فلو كان التدارك الأخروي كافياً لم يكن الحمل المتقدّم للحديث مصحّحاً له ، فإنّه إذا كان الشارع يتدارك الإضرار في الآخرة لم يكن ذلك إضراراً ، فلا بأس للناس أن يباشروا إضرار غيرهم ، فتأمّل .
ثمّ إنّه حيث جاز بذل العضو فقد يجب إذا لم يكن فيه حرج على المكلّف ، وذلك فيما إذا توقّف حفظ حياة مسلم على ذلك; وذلك لحديث وجوب إجابة المضطرّ . وأمّا مع الحرج فلا ; لدليل نفي الحرج .
ومن قبيل ما يجب فيه البذل هو بذل الدم لحفظ حياة الغير ممّا لا مؤونة فيه ولا حرج عادة ، فلو كان عضو من هذا القبيل كان بذله واجباً ، بل وكذا إذا اضطرّ مسلم ولو لغير حياته ، كما لو كان شديد المرض بحيث يصدق معه الاضطرار .
الوجه الثاني: نصوص عدم جواز الإضرار بالبدن
قد يستدلّ لعدم جواز بذل العضو بعدم جواز الإضرار بالنفس; وذلك استناداً إلى بعض الأخبار زيادة على ما تقدّم من كون الإضرار بالبدن ظلماً للنفس ، على ما مرّ :منها : معتبرة محمّد بن عذافر عن أبيه ـ ولم يوثّق ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وقد روى هذا الخبر بأسانيد أُخر عن مفضّل بن عمر ، كما وروى في الصحيح عن عذافر عن أبي جعفر (عليه السلام) ويحتمل السهو في أحد النقلين ; فإنّه رواه الصدوق في الأمالي عن
(الصفحة217)
أبي عبدالله على ما ذكرناه أوّلاً ، كما ورواه في العلل عن محمّد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر (عليه السلام) . ورواه أيضاً في العلل في الصحيح عن عذافر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، كما ورواه الكليني والشيخ أيضاً بسند آخر . وكيف كان فسند الصدوق إلى محمّد بن عذافر صحيح ، وهو ثقة وعذافر لم يوثّق .
والرواية حسب نقلها عن الكافي هكذا : مفضّل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني جعلني الله فداك ، لِمَ حرّم الله الخمر والميتة و الدم ولحم الخنزير؟ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه (ذلك ـ علل) من رغبة منه فيما حرّم عليهم (أحلّ لهم ـ يه) ولا زهد فيما أحلّ لهم (حرّم عليهم ـ يه) ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم; ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه ـ إلى أن قال ـ : أمّا الميتة فإنّه لابدّ منها (لم ينل منها ـ خ) أحد إلاّ ضعف بدنه (ونحل جسمه) وذهبت قوّته . . .» (1) .
وقد ذكر في الدم والخمر بعض ما فيهما من المضار .
ومن قبيل الخبر المتقدّم رواية محمّد بن سنان المرويّة في العلل والعيون بأسانيد عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في حديث :
«وحرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ـ إلى أن قال ـ : وحرّم الله الدم كتحريم الميتة; لما فيه من فساد الأبدان ، وأنّه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب وقلّة الرأفة والرحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه»(2) .
- (1) الوسائل 16: 309 ، الباب 1 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 .
(الصفحة218)
ونحوه في هذا المجال وبيان بعض آثار أكل المحرّمات مرسلة الاحتجاج(1) .
هذا ، ولكن لا يبعد أنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ العلّة للتحريم هو مجموع ما ذكر في الأخبار من المضارّ للبدن والروح لا خصوص ضرر البدن ، فتقصر الأخبار عن الدلالة على المدّعى .
ومن جملة الأخبار ما في معتبرة طلحة بن زيد : «الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»(2) .
بتقريب: أنّ المفروض في الرواية كون النفس غير مضارّ ، بمعنى عدم حلّ الإضرار بها ، ثمّ عطف الجار عليها في المنع من الإضرار .
ويمكن تقريب الخبر بوجه آخر ، هو أنّ الإضرار بالجار محرّم بلا ريب ، فكان الإضرار بالنفس المقيس عليها الجار كذلك .
ويشكل بكون الإضرار بالنفس المنفيّ ربما لا يكون بلحاظ الحكم الشرعي حتّى يدلّ على تحريمه ، بل باعتبار الجبلة والفطرة ويكون قياس الجار عليه بلحاظ جعل الحكم الشرعي له خاصّة .
الوجه الثالث: ربما يستدلّ لعدم جواز الإضرار بالبدن بحديث «لا ضرر»(3)
بدعوى أنّ مقتضى نفي جنس الضرر هو عدم وقوعه خارجاً فيما أمكن المنع من وقوعه بلحاظ حكم الشارع ، وذلك بالمنع من الترخيص فيه في موارد الإضرار بالغير أو بالنفس كتقييد نفس الأحكام الشرعية بغير ما ينشأ منها الضرر.
والجواب عنه: أنّ المنساق من الحديث هو عدم وقوع الضرر مستنداً إلى الشارع ، لا عدم وقوع ضرر في الخارج أصلاً ولو بمناسبة الحكم والموضوع .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 5 .
- (2) نفس المصدر 8: 487 ، الباب 86 من العشرة ، الحديث 2 .
- (3) نفس المصدر 17: 340، الباب 12 من إحياء الموات.
(الصفحة219)
والمعنى أنّه في حيطة التشريعات ليس هناك ما يوجب الضرر ، وأين هذا ممّا إذا استند الضرر إلى نفس الإنسان ، وكان استناده إلى الشارع لمجرّد عدم المنع منه ممّا لا يوجب استناده إليه .
إن قلت : كيف لا يستند الضرر إلى الشارع لمجرّد عدم المانع والترخيص ، مع فرض استناده إليه في مورد الترخيص في الإضرار بالغير .
قلت : استناد الضرر في الثاني إلى الشارع; لعدم اختيار من يقع عليه الضرر في منعه ، بخلاف الإضرار بالنفس فإنّه بالاختيار من المضرّ فلا يستند إلاّ إليه .
ثمّ إنّ هناك جملة من الروايات تضمّنت النهي عن الوضوء المستلزم للضرر ، وكذا عن الصوم ونحو ذلك من العبادات الضرريّة .
ولا مجال للاستدلال بها على حرمة الإضرار بالبدن; فإنّها مسوقة لبيان عدم وجوب الوضوء والصوم ونحوهما ، وهي للإرشاد إلى عدم صحّة هذه العبادات حيث تستلزم الضرر ، وأمّا حرمة الإضرار فلا .
الوجه الرابع: الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق الله
بدعوى أنّ تغيير خلق الله من أوامر الشيطان ووساوسه وتسويلاته فلا يجوز، وهذا يصدق على قطع الأعضاء ولو لغرض الترقيع بالغير فإنّه تغيير لخلق الله .
ويدفعه أنّ حمل تغيير خلق الله على هذا المعنى الساذج الذي يتوهّم من هذا اللفظ بدءاً لا مجال له; فإنّه مستلزم لتخصيص مستهجن ، إذ ما من شيء من
- (1) سورة النساء الآية 119 .
(الصفحة220)
خلق الله عادةً إلاّ ويغيّر ، فالحنطة تطحن للأكل والحيوانات تذبح لذلك ، والصوف والقطن يغزلان ويحاكان للّبس ، وهكذا وهكذا ، فهل يحتمل أنّ هذه التغييرات مشمولة للآية وأنّها خارجة بالتخصيص .
والذي يلوح لي من الآية ـ سيما بقرينة موردها وتطبيقها على تبتيك آذان الأنعام ظاهراً ـ هو أنّها ناظرة إلى المنع من تغيير خلق الله عمّا أعدّ له بتحريفه عن مسيره الذي أُعدّ له ، فالأنعام مخلوقة لانتفاع الإنسان بها وبلحمها وبجلودها وسائر منافعها، فتسييبها وإرسالها وعدّها محرّمة على الإنسان على ما كان متعارفاً في الجاهليّة بتغيير في ظاهر خلقها بتبتيك الآذان علامة على التشريع الخاصّ ، تغيير مذموم .
وإن شئت قلت : إنّ الآية ناظرة إلى حرمة التشريع في المخلوقات بالتغيير فيها تكويناً لتحريفها تشريعاً عن ما سيّرت له في الشريعة والدِّين .
ومن قبيله تشريع الإخصاء واللواطوالزنا لدفع الشهوة، مع أنّ الشهوة مسيّرة في التشريع الإسلامي في سبيل النكاح ، فتحريفها عن هذا المسير تغيير مذموم .
ويؤكّد ما ذكرنا ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الآية بدين الله . وقد فسّرت في بعض الكلمات بالفطرة مستشهداً بقوله تعالى : {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}(1) .
حكم الإخصاء
ويؤكّد ما ذكرنا ـ من عدم حرمة مجرّد التغيير في المخلوقات ما لم يرجع إلى التشريع ـ الروايات التي تضمّنت جواز الإخصاء في الحيوان بل مطلقاً ، كما في- (1) سورة الروم الآية 30 .
(الصفحة221)
موثّقة يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن (عليه السلام) قال : «لابأس به»(1) .
وظاهر صاحب الوسائل حمله على إخصاء الدواب ، حيث ذكره تحت عنوان جواز إخصاء الدواب ولكن ظاهر الرواية الإطلاق(2) .
وفي معتبرة يونس الاُخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن إخصاء الغنم ،
- (1) الوسائل 8 : 382 ، الباب 36 من أحكام الدواب ، الحديث 2 .
- (2) شأن النصوص مع احتمال فقد قرينة بسبب تقطيعها:
- يشكل التمسّك بإطلاقها فيما كان الخبر في الجوامع السابقة على الوسائل كالكتب الأربعة مذكورة تحت عنوان خاصّ; والسرّ في ذلك أنّ الروايات في الكتب الأربعة بل والسابقة عليها ، قطّعت للتوزيع على الأبواب المناسبة ، فحيث يحتمل اشتمال الخبر المقطّع على قرينة عندهم تخصّه بالباب الخاصّ ، يشكل التمسّك بإطلاقه .
- لا يقال: مقتضى وثاقة أصحاب الجوامع وأمانتهم ذكر القرائن لو كانت . وأصالة عدم القرينة العقلائية تنفي وجود قرينة ، وهذا الأصل مرجعه إلى ضبط الراوي ووثاقته .
- قلت: نعم ، مقتضى الضبط ذكر القرائن ، ولكن اللازم هو ذ كر خصوص القرائن الدخيلة فيما يرتبط بالعنوان الذي ذكر الخبر تحته لا مطلق القرائن ، ولا أقلّ من كون ذلك هو المتيقّن .
- وعلى أساس هذا الإشكال أشكلنا في عموم عمد الصبيّ وخطأه واحد ، المذكور تحت عنوان الجنايات ، لمثل معاملاته وسائر أعماله وعباداته غير جناياته .
- حيث ورد الحديث ـ على ما ببالي ـ في مورد آخر مذيّلاً بقول: تحمله العاقلة ، المخصّص له بالجنايات ، فلا يبقى وثوق بالإطلاق .
- نعم ، لو كان العنوان الذي روى المطلق تحته عنواناً عامّاً كان إطلاق الحديث حجّة لنا; نظراً إلى نفي القرينة المخصّصة له بالأصل الراجع إلى كون ناقله ضابطاً .
- تأمّل بربّك فيما روى من حديث: «ما عبد الله بشيء أفضل من المشي» فهل يفتي فقيه باستحباب مطلق المشي كما هو مقتضى إطلاق الحديث؟ وإنّما عنونه المحدّثون في أبواب الحجّ ودليلاً على استحباب الحجّ ماشياً .
- تأمّل في أطراف ما تلوناه عليك ولا تستعجل بالردّ عليه ولا تخف إجمال عامّة الروايات ، فإنّ موارد احتمال القرينة بالمعنى الذي ذكرناه ليس كثيراً .
(الصفحة222)
قال : «لا بأس»(1) .
نعم ، في رواية عثمان بن مظعون قال : قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : أردت يارسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أختصي؟ قال : «لا تفعل يا عثمان فإنّ اختصاء اُمّتي الصيام»(2)مع كلام طويل .
والظاهر ـ مضافاً إلى ضعف سنده ـ أنّ النهي ليس للتحريم هنا ، بل إرشاد إلى ما كان يبتغيه عثمان من التقرّب بإطفاء الشهوة ، فبيّن له الطريقة المشروعة والعبادة المطلوبة ، وقد كان إخصاء الغلمان أمراً متعارفاً وربما تزيد القيمة بسببه(3) ، ولو كان محرّماً لنبّه عليه في الأخبار .
ويؤكّد ما ذكرنا من عدم حرمة مجرّد التغيير مرسلة الاحتجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في سؤال الزنديق قال : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال : «لا» قال : فإنّ الله خلق خلقه غرلاً ، فلِمَ غيّرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله؟ وعبتم الأغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم! أم تقولون:إنّ ذلك كان من الله خطأً غير حكمة؟! فقال أبوعبدالله (عليه السلام) : «ذلك من الله حكمة وصواب غير أنّه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه; كما أنّ المولود إذا خرج من بطن اُمّه وجدتم سرّته متّصلة بسرّة اُمّه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها; وفي تركها فساد بين المولود والاُمّ; وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلّم وكان قادراً يوم دبّر خلقه لا تطول; وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ; وكذلك الثيران خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في
- (1) نفس المصدر ، الحديث 6 .
- (2) نفس المصدر 7 : 300 ، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 2 .
- (3) راجع نفس المصدر 11 : 100 ، الباب 50 من جهاد العدو ; و 13 : 27 ، الباب 2 من بيع الحيوان .
(الصفحة223)
تقدير الله عزّوجلّ» (1) .
وبالجملة: ربما ينساق ممّا دلّ على جواز الإخصاء جوازُ التصرّف في البدن بما فيه غرض عقلائي ما لم يدلّ دليل على المنع ، ويكون هذا مؤيّداً لجواز الرضا بقطع العضوللترقيع سيّما الأعضاء الباطنة ممّا لا يوجب بذلها ذلاًّ أو مهانة بحسب الظاهر .
إلاّ أن يقال: إنّ الأعضاء مخلوقة لغير غرض قطعها ، فكما أنّ قطعها بالإتلاف يعدّ من التغيير المذموم الذي هو مدلول الآية فكذا قطعها لغرض الترقيع .
ويردّه ـ مضافاً إلى أنّه من قبيل القضيّة بشرط المحمول ـ أنّ مطلق القطع والتغيير ليس مذموماً بحسب الآية ، وإنّما المذموم التغيير بعنوان التشريع وجعل حكم على حساب الشارع ، كما إذا قطع عضوه بعنوان كونه مطلوباً شرعيّاً لغرض الترقيع ، وأمّا فعله بعنوان أمر مباح لا مطلوب فليس مصداقاً للآية ، والله العالم .
الوجه الخامس: قد يستدلّ لتحريم الإضرار بالبدن سيّما ببذل الأعضاء المهمّة كاليد والرجل والعين بمعرفة ذلك من مذاق الشارع .
ولكن عهدة هذه الدعوى على مدّعيها ، كدعوى الإجماع على حرمة الإضرار بالبدن ، بعد قوّة احتمال استناد الفتاوى إلى بعض الوجوه المتقدّمة .
فقد تحصّل ممّا قدّمناه عدم دليل على حرمة الإضرار بالبدن . ويكفي في جوازه الأصل ، بل تقدّم سابقاً الاستدلال لذلك بما دلّ على أنّ الله خوّل إلى المؤمن أموره كلّها عدا إذلال نفسه ، فراجع المسألة السابقة .
ويؤكّد ما ذكرنا: ما تضمّن الاستئذان في غمز يد الراوي لتبيين ورود أرشه ، في كتاب عليّ (عليه السلام) ، ممّا يلوح منه أنّ عدم جواز الإضرار بالغير إنّما هو بملاك الهتك ممّا يرتفع برضاه والإذن فيه .
كما أنّ ممّا ذكرنا يتّضح أنّه لا مجال للاستدلال على حرمة قطع الأعضاء ، بما دلّ
- (1) الوسائل 15 : 162 ، الباب 52 من أحكام الأولاد ، الحديث 7 .
(الصفحة224)
على ثبوت الدية فيها بلا فرق بين رضا المقطوع منه وعدمه .
فقد تقدّم أنّ الدية بملاك الهتك المنتفي مع الإذن ، كما يؤكّده الحديث الآنف وما ورد من ثبوت الدية في الميّت; معلّلاً بأنّ حرمة الميّت كحرمته وهو حيّ .
نعم، هنا وجه آخر سيأتي بيانه إجمالاً إن شاء الله عند التعرّض لحرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب ، وحاصله: مبغوضيّة الفساد والإفساد في الأرض بمصاديقه المختلفة، ومن جملته تنقيص البدن والإضرار به. ولكنّه إنّما يتمّ حيث لا يكون في قطع العضو غرض عقلائي ومن جملته بذله للترقيع; فإنّه لا يعدّ فساداً في الأرض عرفاً، والله العالم.
(الصفحة225)
فروع في مسألة ترقيع الأعضاء :
الفرع الأوّل: بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه
نعم ، لو كان المدّعى حرمة بذل العضو على الإطلاق لم يحلّ في مثل ما ذكر من الفرض ، ولكنّه مجرّد دعوى لا يساعدها دليل ، بل ولا ما ادّعى دلالته على أصل الحرمة لو سلّمت .
الفرع الثاني: المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع
لو قلنا بجواز قطع العضو أو لم نقل ، فهل يحلّ المعاوضة على العضو وبذل العوض بإزائه؟ فيه تفصيل .
وربما اُفيد جواز أخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه لا عوضاً عن العضو . كما وقد يفصّل بين أخذ العضو قبل القطع للترقيع أو بعده .
والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ العوض قد يجعل بإزاء نفس العضو ، وقد يكون
(الصفحة226)
بإزاء رفع اليد :
أمّا الأوّل: فيمكن تقريب جوازه بعد ردّ ما يمكن الاستناد إليه في المنع وهو عدّة وجوه :
أدلّة عدم صحّة المعاوضة على الأعضاء
الوجه الأوّل : إنّ حقيقة المعاوضة تتضمّن عقلاً دخول العوض في ملك من يخرج عن ملكه المعوض . وقد مال إلى هذا الشيخ الأعظم في مكاسبه بعدما نسبه إلى العلاّمة ، وقد جنح إلى هذا سيّدنا الأستاذ (قدس سره) ولازم هذه الحقيقة أن يكون العوض متّصفاً بأمرين :
مقوّمات المعاوضة
الأوّل : كونه ملكاً ، فلايصحّ بيع المباحات كالأراضي المحجرة قبل تعميرها وإن كان المحجِّر أولى بها من غيره .
والثاني : كونه ملكاً لمن يمتلك العوض بإزائه ، فلا يجوز بيع مال الغير للنفس; فإنّه مستلزم لخروج المعوّض عن ملك ودخول العوض في ملك غير من يخرج المعوّض عن ملكه .
وعلى هذا الأساس حكموا بعدم صحّة بيع عين مال الغير للنفس وإن أذن المالك فيه; حيث إنّ إذن المالك ليس مشرّعاً لما لا يحلّ وإنّما يبيح المحلّلات; فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم لا على الأحكام ، فلا يجوز للمالك أن يجيز لغيره صرف ماله في المحرّمات سواء كان التحريم تكليفاً أو حرمة وضعيّة .
إذا علم ما ذكرنا فنقول : لا موجب لملك الإنسان لأعضائه ، ومجرّد كونها تحت
(الصفحة227)
سيطرته تكويناً لايلازم الحكم بالملكيّة التشريعيّة ، بل الملكيّة التشريعيّة في الرقاب كالعبد والإماء لا يلازم الملكيّة بلحاظ أعضائهم; فإنّ ملك الرقبة بلحاظ المنافع والخدمة ونحوها لا بلحاظ الأجزاء . ومن هنا لا يصحّ بيع يد العبد أو رجله .
وبالجملة حيثيّة الملكيّة بلحاظ المنافع تختلف عنها بلحاظ الأجزاء ولا ملازمة بين الأمرين .
وعليه فالمعاوضة على الأعضاء غير ممكنة; لعدم موضوعها وهو الملك ولو لعدم الدليل ، ويكفي في إثباته الأصل ولو بلحاظ الأزل .
هذا ، ولكن المحقَّق عندي ـ وفاقاً للمحقّق اليزدي على ما ببالي ـ عدم تقوّم المعاوضة إلاّ بالعوض ، وأمّا كونه مملوكاً فهو شرط صحّة المعاوضة ما لم يأذن المالك ومعه فلا اشتراط أيضاً . ويؤيّده جواز أداء الدين بمال الغير، وتمام الكلام في غير المقام .
ومحصل الكلام فيه: تقوّم المعاوضة بالعوضين دون ملك المتعاوضين وإن كان إطلاق المعاوضة ينصرف إلى تمليك المالكين وتملّكهما .
الوجه الثاني : دعوى اشتراط صحّة البيع بالملك وإن لم تكن المعاوضة متقوّمة به; وذلك استناداً إلى ما روي من أنّه: «لا بيع إلاّ في ملك» ولو بلفظ آخر كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله ؟ قال : «ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»(1) .
- (1) الوسائل 12: 377 ، الباب 8 من أحكام العقود ، الحديث 8 .
(الصفحة228)
معنى لا بيع إلاّ في ملك
لا يبعد الإجابة على ذلك بأنّ الحديث ناظر إلى ملك البيع لا ملك المبيع ، فهو ناظر إلى اشتراط السلطنة في حلّ البيع ، فلا يجوز بيع مال الغير قبل تملّكه ، اعتماداً على تملّكه فيما بعد . وببالي الاستشهاد في بعض الأحاديث بذلك في مثل هذه المسألة . وهو المعنى في الحديث المعروف: «أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك» وأنّه «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» . كما روى عدم الطلاق قبل الزواج مريداً إنشاء الطلاق بلحاظ ظرف التزوج . وكذا عدم صحّة العتق قبل الملك مريداً إنشاء العتق بلحاظ ظرف التملّك المتأخّر .
وبالجملة : هذه الإنشاءات مبنيّة على التعليق على أمر متأخّر بنحو الشرط المقارن ، فعدم صحّة الإنشاء لذلك ، لا لانتفاء الملك ، على نحو لو باع مال الغير لنفسه بإذن المالك لم يصحّ ، فهو من قبيل ما ورد في عدم صحّة البيع قبل التملّك إلاّ إذا كان المشتري لو شاء أخذ وإن شاء ترك ، وما ورد في عدم جواز البيع قبل التملّك في بيع العينة .
وربّما يتوهّم أنّ ملك المملك مأخوذ في حاق التمليك ، فلا تتأتّى حقيقة التمليك من فاقد الملكيّة; نظراً إلى أنّ فاقد الشيء لا يعطي ، ويعتبر هذا وجهاً مستقلاًّ لعدم صحّة بيع الأعضاء .
ويردّه أنّ المعتبر في حقيقة التمليك هو الولاية عليه لا الملكية الاعتبارية . ويؤكّده أنّ الله يملِّك من يشاء بملكيّة اعتبارية ، ولا يشترط في ذلك أن يكون مالكاً اعتباراً ، بل هو الوليّ على كلّ شيء يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد .
الوجه الثالث : قد يستدلّ لعدم جواز المعاوضة على الأعضاء بحديث: «ثمن
(الصفحة229)
الميتة سحت» كما في موثّقة السكوني(1) ومرسلة الصدوق وروايته ورواية التحف(2) .
فإنّ العضو المبان ميتة; ولذا يحكم عليها بالنجاسة ، فلا يجوز أخذ العوض عنها ، وتكون المعاوضة عليها كالمعاوضة على الخمر التي ورد فيها: «ثمن الخمر سحت» .
وبالجملة ماليّة الميتة ملغاة شرعاً وإن كان لها ماليّة في المتعارف .
ويرد عليه: ـ مضافاً إلى ما حقّقناه في بعض المقامات ـ من عدم المنافاة بين المالية وبين كون ثمنه سحتاً; لعدم التلازم بين كون ثمن الشيء سحتاً ، وبين عدم ضمانه بغير المعاوضة كالإتلاف وإن كان ظاهرهم التلازم بينهما; ولذا ذكروا عدم ضمان الخمر بإتلافها لعدم الماليّة ، استناداً إلى حديث «ثمن الخمر سحت» .
وقد ذكرنا أنّ المتيقّن ممّا هو متفاهم من أحاديث السحت في الأثمان ، هو عدم جواز بذل الأعواض عنها في المعاملات; فإنّ الأثمان كناية عن ذلك ، وأمّا أخذ العوض عنها في مثل موارد الحيلولة والإتلاف، فلم يعلم اندراجه في مفاد هذه الأحاديث إلاّ بدعوى صدق الثمن على العوض المأخوذ على الإطلاق; أنّ الميتة لا تصدق حقيقة على العضو المبان من الحيّ ـ كما أسلفنا لك ـ لكون العضو جزء الميتة لا أنّه هي .
وما تضمّن التعبّد بكون العضو المبان ميتة فإنّما ورد في المبان من الحيوانات غير الإنسان ، أوّلاً; وذاك بلحاظ التذكية لا بلحاظ منفعة الترقيع ، ثانياً .
ولا موجب للتعدّي إلى أعضاء الإنسان إلاّ بالقياس المحظور .
مضافاً إلى ما قد يدّعى من كون المنساق من حديث «ثمن الميتة سحت» هو
- (1) الوسائل 12: 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 8 و 9 .
- (2) نفس المصدر 12: 56 ، الباب 2 ممّا يكتسب به، الحديث 1 .
(الصفحة230)
أخذ الثمن بإزائها باعتبار المنافع المتوقّعة منها مع الغضّ عن كونها ميتة ، والمنفعة المترقّبة من اللحوم هي الأكل ، فلا يجوز بيع الميتة باعتبار هذه المنفعة ، أمّا بيعها باعتبار المنافع المحلّلة فلا مانع منه كبيعها للتسميد .
وكان شيخنا المنتظري يدّعي أنّ أخذ العوض بإزاء رفع اليد دون نفس الشيء مهزلة لا ينبغي إسنادها إلى الشارع ، وعلى أساسها كان يدّعي أنّه كلّما جاز الانتفاع بشيء جاز بيعه لذلك ، وأنّه ليس للشارع تعبّد في مثل هذه الاُمور .
وإن كان هذا الكلام مجرّد احتمال لا يساعده برهان ، وتخرّص لا يعمده بيان تام ، واستحسان إليه لا يصار ، ما لم يرجع إلى دعوى انصراف دليل المنع من البيع إلى بيعه للمنفعة المترقّبة المحرّمة ، وهي بحاجة إلى مؤونة إثبات .
أدلّة صحّة المعاملة على الأعضاء للترقيع
حيث إنّه لم يتمّ دليل على المنع من بيع الأعضاء ، فيكفينا لتصحيح بيعها والمعاملة عليها إطلاق أدلّة المعاملات مثل قوله تعالى : {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ}(1) .
فإنّه لا ريب في صدق المال على الأعضاء حتّى على تقدير عدم كونها ملكاً . ويكفي لإضافتها المأخوذة في الآية أدنى ملابسة وإن لم تكن الإضافة بالملك .
كما أنّ الأعضاء لاشتمالها على المنافع المباحة لا تعدّ باطلاً عند العرف ، الذي هو المناط بحسب الإطلاق . هذا بناءً على كون المراد من الآية غير السبب ، وكذا إذا كان هو المراد . والظاهر أنّ الاستثناء على التقديرين منقطع .
- (1) سورة النساء الآية 29 .
(الصفحة231)
الاستدلال بحديث الصلح على صحّة كلّ معاملة
من جملة العمومات ما دلّ على جواز الصلح بمعنى نفوذه; وقد قرّبنا في محلّه دلالة الحديث هذا على صحّة كلّ المعاملات; بناءً على كون الصلح في الحديث بمعناه اللغوي ، وهو صادق على البيع والإجارة والمضاربة وغيرها; فإنّها صلح بالحمل الشائع فإنّ التصالح بمعنى التوافق ، وهو مرادف للتوافق أو هو توافق بعد نزاع ، ومن الواضح أنّ سبق النزاع لا دخل له في صحّة المعاملات .
ثمّ إنّ هذا الذي ذكرناه من تطبيق الصلح على المعاملات لعلّه المعنيّ بما اُفيد من أنّ الصلح إذا وقع على الأعيان لنقلها وأفاد فائدة البيع ، فهو بيع ، وكذا في سائر المعاملات كلّما أفاد فائدة نوع منها فهو متّحد معها ، فلا يرد عليه ما ذكروه من أنّ الصلح عقد برأسه ، حقيقته التوافق ، ومجرّد إفادته فائدة البيع لا يصيّره كذلك .
ومن جملة ما يمكن الاستدلال به لجواز المعاملة والبيع في الأعضاء ما دلّ على «أنّ الله فوّض إلى المؤمن أموره كلّها عدا إذلال نفسه» فإنّ بيعه لأعضائه من جملة اُموره وشؤونه فهو مفوّض إليه .
ومن جملة المؤيّد لصحّة بيع الأعضاء رواية التحف عن الصادق (عليه السلام) وفيها : «وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه وشرائه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته» فتأمّل .
الفرع الثالث: وجوب حفظ حياة المسلم بالترقيع
إذا توقّف حفظ حياة مسلم أو دفع ضرورته ، على صرف مال أو ترقيعه بعضو لغيره ، ففي وجوبه إشكال ; فإنّ الدليل على وجوب حفظ نفوس المسلمين ، في غير موارد الهجوم عليهم من ناحية الكفّار أو الظَلَمة ، والذي الدليل على وجوبه حينئئذ أدلّة وجوب الجهاد ، إنّما هو أحد أمرين :
(الصفحة232)
الأوّل : دعوى معرفة ذلك عن مذاق الشرع المقدّس ، المعلوم بارتكازه في أذهان المتشرّعة .
والثاني : هو حديث وجوب إجابة المضطرّ وإغاثته «من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» .
وهذا الثاني ـ كما سبق مفصّلاً ـ لا يختصّ بحفظ الحياة ، بل يعمّ دفع كلّ ضرورة حيث تصدق ، كما أنّ مورد الرواية لا يختصّ بضرورة المسلم بل يعمّ غيره .
وكيف كان فالأوّل دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقّن ، والثاني لا إطلاق له لوجوب الإجابة فيما إذا كانت الإجابة بارتكاب فعل محرّم ، فكما لم يحتمل فقيه وجوب الإجابة بما يشمل المحرّم حيث لا تنحصر الإجابة بفعل الحرام بدعوى إطلاق وجوب الإجابة ، والنسبة بينها وبين حرمة كذا هو العموم من وجه ، فكذا لا نحتمل إطلاقه في موارد الانحصار .
والسرّ في ذلك كلّه هو ما أسلفناه من أنّ أدلّة الأحكام الثانوية من قبيل استحباب الوفاء بالوعد ووجوب برّ اليمين والنذر والعهد ، لا إطلاق فيها لإثبات حلّ موضوعاتها كالموعود والمنذور ، وإنّما مساقها الاستحباب والوجوب فيما كان الموضوع حلالاً ، فيستحبّ بالإيعاد ويجب بمثل اليمين ، ومن هذا السنخ من الأدلّة استحباب إجابة المؤمن وقضاء حاجته وإنجاح طلبته . ومن هذا القبيل وجوب إجابة المضطرّ .
والفرق بين إجابة المؤمن وإجابة المضطرّ بالوجوب والاستحباب كالفرق بين الوفاء بالوعد والوفاء بالنذر ، لا يكون فارقاً فيما هو المنساق من موضوع الدليل والمتفاهم منه .
فالمتحصّل: أنّ دليل إجابة المضطرّ لا يعمّ فرض حرمة الفعل في نفسه ، بل يكون دليل الحرمة هو المقدّم ، فضلاً عن أن يزاحمه أو يتقدّم عليه بالأهمّية فيما إذا
(الصفحة233)
كانت الضرورة من قبيل حفظ النفس .
وعليه فإذا كان قطع العضو من الحيّ ـ ولو برضاه ـ حراماً ، لا ينفع في رفع اليد عنه حديث وجوب إجابة المضطرّ; فإنّه لا يعارضه فضلاً عن أن يزاحمه .
نعم ، مقتضى حديث إجابة المضطرّ وجوب رفع الضرورة بكلّ مباح ، من صرف مال أو غيره ، غير أنّ هذا الدليل كسائر أدلّة الأحكام الأوّلية محكوم بأدلّة نفي الحرج والضرر ، ويتقدّر المراد الجدّي منه بغير مواردهما ، فلا يجب رفع ضرورة الغير حيث يستلزم ذلك ضرراً أو حرجاً .
نعم ، بذل المال اليسير ممّا قد يعدّ ضرراً عند العرف بحسب المعنى الدقيق للكلمة ، لا يمنع من وجوب إجابة المضطرّ; وذلك نظراً إلى مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّه إذا وجب رفع الضرورة بضرب أو قتل أو مشي ممّا يتداركه عامّة الناس بصرف مقدار من المال حتّى لا يباشروها ، كشف ذلك عن كون هذا المقدار من الضرر المالي أو الحرج اليسير غير رافع للحكم وإلاّ عاد الحكم لغواً .
نعم ، لو زاد المال الرافع للضرورة عن مثل هذه المقادير ، كما لو توقّف رفع الضرورة على بذل مسكنه وليس له مأوى سواه ، لم يجب سيّما إذا استلزم ذلك العسر والحرج .
نعم ، عدم وجوب صرف المال الكثير حيث لا حرج فيه ، إنّما يتمّ بناءً على حكومة «لا ضرر» بمعنى تقييد الأحكام بغير ما يستلزم الضرر ، وأمّا بناءً على ما أشرنا إليه من احتمال عدم صدق الضرر في موارد النقص المالي المتدارك بالأجر الاُخروي، فلا يكون في موارد صرف المال في سبيل الواجبات مصداق للضرر ، فينحصر المانع في وجوب إجابة المضطرّ بموارد الحرج .
ثمّ لا ريب أنّه في عامّة موارد بذل العضو لحفظ حياة أو دفع ضرورة الغير ، حرج يسقط الأحكام الشرعيّة ، كوجوب الوضوء والصلاة ، بما هو دون ذلك
(الصفحة234)
بمراتب . فيا ترى إنّ فقيهاً يحكم بوجوب الوضوء حيث يستلزم فساد عضو كالعين أو اليد أو الأنملة ، فإذا عدّ تلف الأنملة حرجاً مانعاً من وجوب الواجبات، فكيف لا يعدّ قطع العضو لترقيعه بالغير حرجاً ؟!
ثمّ إنّ ممّا ذكرنا من عدم وصول النوبة إلى التزاحم ، تعرف دفع ما اُفيد في المقام في بعض المسطورات . ومن الغريب إنّه بعد دعوى التزاحم ، حكم بأهمّية حفظ النفس ، فيؤخذ عضو الغير قهراً حيث لا يوجد متبرّع وإن كان أخذه مضموناً بقيمته العرفية . واستشهد لأهمّية حياة الغير بما دلّ على أنّ التقيّة إنّما جعلت لحفظ الدم، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ، بضميمة ما دلّ على أنّ التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم; فإنّه يقتضي أنّ حفظ الدم أهمّ من كلّ واجب أو حرام ، فإنّه إذا جاز لأجل التقية مخالفة كلّ واجب أو حرام إلاّ سفك الدم كشف عن أهمّية الدم بالنسبة إلى كلّ الوظائف الشرعية .
أقول : ليت شعري إذا كانت أهمّية حرمة قتل الغير وسفك دمه أزيد من عامّة الأحكام ، فهل يعني هذا أنّ التحفّظ على حياة الآخرين عن ضرورة حدثت بغير سبب من المكلّف أهمّ من سائر الأحكام ؟! فإنّ معنى الحديث المتقدّم هو أنّ التقيّة تجوّز كلّ مخالفة للتكليف عدا حرمة القتل ، وأين هذا ممّا ادّعاه هذا القائل ؟! ولعمري ما ذكرناه جدّ واضح لمن ألقى السمع وهو شهيد .
الفرع الرابع: الترقيع بأجزاء الجنس المخالف
بعد الفراغ عن أصل جواز الترقيع بأجزاء بدن الغير ، ربما يشكل جواز الترقيع في بعض الموارد:
1 ـ الترقيع بأجزاء المرأة الأجنبية للرجل وبالعكس ، أعني الترقيع بأجزاء الرجل للمرأة .
(الصفحة235)
2 ـ الترقيع بأجزاء الكافر وغيره من الأعيان المحكومة بالنجاسة ، كالترقيع بأجزاء بعض الحيوانات المحكومة بالنجاسة كالخنزير .
أمّا الترقيع بأجزاء المرأة للرجل وبالعكس فالإشكال فيه من ناحية عدم جواز النظر واللمس لكلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر الأجنبي .
والحقّ أنّه لا بأس بالترقيع في المسألة.
أوّلاً: لما حقّقناه من بعض المسائل من أنّ الأجزاء المبانة لا تعدّ أجزاءً بالفعل لما أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس فعلاً; نعم يطلق على الجزء المنفصل أنّه كان جزءً قبل الانفصال . وإطلاق الجزء بالفعل على مثله لا يكون إلاّ مجازاً .
فما دلّ على حرمة النظر إلى الجنس المخالف في الذكورة والاُنوثة وكذا حرمة لمسه لا يعمّ الجزء المفصول منه .
نعم، قام الدليل على حرمة النظر والتغسيل للجنس المخالف الميّت ، وهذا ليس لصدق الرجل والمرأة على الجسد بعد الموت فإنّ العنوانين متقوّمان بالحياة .
وثانياً: لو سلّمنا صدق الجزء على الأعضاء المفصولة فلا عموم في دليل النهي عن النظر واللمس لها لا للانصراف حتّى يرد بالمنع ، بل لعدم الإطلاق من الأساس.
فإنّ ما دلّ على حرمة نظر الرجل إلى المرأة لا يعمّ فرض موتها لتقوّم عنوان المرأة كما تقدّم بحياتها كالرجل .
كما أنّ ما دلّ على حرمة مصافحة الأجنبيّة مطلقاً وما دلّ على حرمة مسّها للمعالج بدون ضرورة وما شاكل ذلك، فما هو الدليل على حرمة مسّ الأجنبيّة ، لا دلالة فيها على الحرمة في الأعضاء المفصولة كما لا يخفى .
وثالثاً: هذا كلّه بغضّ النظر عن تحقيق الضرورة أحياناً والتي تحلّ المحرّمات ومن جملة مواردها الترقيع لحفظ حياة أو غيره ممّا تحلّه الضرورة .
(الصفحة236)
ورابعاً: ربما يكون الترقيع بالأجزاء الباطنة وقد تقدّم منّا الإشكال في حرمة النظر إلى الأجزاء الباطنة للمرأة كالمعدة والكلية ونحوهما، بل الإشكال في حرمة مسّها أيضاً، فإنّ الحكم بحرمة مسّها موقوف على إلغاء الخصوصيّة من مثل المصافحة وهو كما ترى .
وخامساً: إنّ الترقيع بالأجزاء الباطنة ربما لا يستلزم نظراً أو لمساً من الذي يرقع به، فإنّ مثل الكلية إذا رقعت بالرجل فهل يلزم لمسه أو النظر إليه .
وعلى هذا الأساس فلا بأس بالنظر إلى شعر المرأة بعد انفصاله عنها . ومنه يظهر أنّه لا بأس بوصل شعر المرأة بشعر الرجل أو بوصل شعرها بشعر امرأة اُخرى تريه الرجل الأجنبي عمن اُخذ منها الشعر .
كما ولا بأس للرجل الأجنبي أن ينظر إلى مثل ذلك الشعر .
وفي القواعد: «إنّ في حرمة نظر الرجل إلى العضو المبان من المرأة إشكالاً» .
ولا أدري أنّه يرمي بإشكاله إلى ما ذكرناه من كون الموضوع لتحريم النظر هو المرأة، والعضو المبان منها لا يعدّ جزءً وعضواً لها حقيقة أو إلى غيره .
وقد وجه الإشكال في الإيضاح وجامع المقاصد والجواهر بوجه آخر واستقرب الأوّلان حرمة النظر وكذا الأخير على ما ببالي .
وفي العروة الجزم بحرمة النظر إلى العضو المبان من المرأة ، ووجّهه في المستمسك باستصحاب التحريم الثابت قبل الانفصال . واعتبر الاتصال والانفصال من الحالات غير المقوّمة، بناءً على أنّ العبرة في الاستصحاب بالموضوع حسب النظر العرفي لا حسب ما يستفاد من دليل الحكم .
وردّ عليه سيّدنا الاستاذ في المستند بالمنع من الاستصحاب لتعدّد الموضوع مع عدم جريان الاستصحاب على مسلكه في الشبهات الحكميّة .
وسادساً: إنّ الأعضاء المفصولة بعد ترقيعها تعدّ أجزاء للذي رقعت به;
(الصفحة237)
وتزول النسبة عن السابق جزماً لو سلّم نسبتها قبل الترقيع .
وسابعاً: ربما يكون التجنّب عن الجزء بعد ترقيعه بإيجاب فصله أو نحوه حرجاً ، فلو سلّم حرمة الترقيع ولكن لا موجب لحرمة الإبقاء عليه .
نعم ، ربما يقال: بأنّ دليل نفي الحكم الحرجي لا يشمل مورد الوقوع في الموضوع الحرجي اختياراً وبسوئه .
ولكنه مجرّد دعوى لا شاهد لها سوى الانصراف أو الاغترار بإمكان جعل الحكم الحرجي على من أدرج نفسه بسوء اختياره في ذاك الموضوع; أو أنّ مثله لا يستأهل المنّة برفع الحكم.
وتمام هذه تخرّصات لا دليل عليها بعد عموم أدلّة الرفع وإطلاقها والله العالم .
(الصفحة238)
(الصفحة239)
الباب الثاني :
مسائل تتعلّق بالنطفة والحمل
وجملة من أحكامهما
(الصفحة240)
(الصفحة241)
المسألة الأولى : لا يجوز للاُمّ إسقاط ما في بطنها من حمل حتّى النطفة بعد العلوق حال الاختيار; وإن كان يجوز للرجل العزل ، وللمرأة إلقاء الماء عن رحمها قبل العلوق(1) .
(1) أمّا جواز العزل فهو المشهور . وفي الجواهر: «نقلاً وتحصيلاً وإن ذهب إلى الحرمة ـ فيما حُكي ـ الشيخان وجماعة وادّعى الشيخ عليه الإجماع»(1) .
ومحلّ الكلام ما إذا كانت المرأة منكوحة بنكاح دائم وكانت حرّة ، وأمّا الأمَة والمتمتّع بها فكأنّه يجوز العزل عنها قولاً واحداً . كما أنّ محلّ الكلام ما إذا لم تأذن المرأة ولم يشترط عليها ذلك ، وإلاّ جاز عندهم بلا كلام .
وكيف كان فقد استدلّ لحرمة العزل بأُمور لا مجال للاعتماد عليها في مقابل ما صرّح فيه بالجواز ، بل هي قاصرة في أنفسها أيضاً .
- (1) الجواهر 29: 112.
(الصفحة242)
أدلّة جواز عزل النطفة
ويدلّ على الجواز جملة من الروايات المعتبرة مع وضوح دلالتها :
1 ـ كصحيح ابن مسلم وقد رواه المشايخ الثلاثة وإن كان سند الصدوق مجهولاً ، وقد جزم والد المجلسي (قدس سرهما) بأنّ روايات الصدوق في مثله عن كتاب ابن مسلم فلا يحتاج إلى سند في الاعتماد . وكيف كان فيكفي سند الكليني والشيخ .
قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العزل ؟ فقال : «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء»(1) .
ونحوه موثّق عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، با بني فضّال و بكير ، إلى قوله : «الرجل»(2) .
2 ـ وصحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء»(3) .
3 ـ وصحيحه الثالث وإن كان في السند القاسم بن محمّد ـ والظاهر أنّه الجوهري ـ بناءً على أنّه معروف لم يرد فيه قدح ، وهذا يكفي في إثبات الوثاقة .
قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الرجل تحته الحرّة أيعزل عنها ؟ قال : «ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل»(4) .
4 ـ وموثّق أبي بصير ، بإسحاق ، المروي في البصائر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : «كان عليّ (عليه السلام) لا يعزل ، وأمّا أنا فأعزل» فقلت : هذا خلاف ، فقال : «ما ضرّ داود إن خالفه سليمان والله يقول :
- (1) الوسائل 14: 105 ، الباب 75 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 4 .
- (4) نفس المصدر 14: 106 ، الباب 75 من مقدّمات النكاح ، الحديث 5 .
(الصفحة243)
{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}»(1) .
5 ـ خبر عبد الرحمن الحذّاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام)لا يرى العزل بأساً ، يقرأ هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ}»(2) .
6 ـ ويدلّ على مفروغية حلّ العزل معتبرة رفاعة الآتية في مسألة إسقاط النطفة.
وعلى الكراهة المصطلحة يُحمل صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): إنّه سُئل عن العزل فقال : «أمّا الأمَة فلا شيء ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها»(3) .
وإن كانت الكراهة في مصطلح الروايات أعمّ من الحرمة ، بل ربما كانت ظاهرة في الحرمة بقرينة ما ورد «إنّه لم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال»(4).
وإن كان تقدّم منّا توجيه هذا الخبر، فإنّ عليّاً (عليه السلام) كان يكره المكروهات المصطلحة أيضاً بلا ريب .
وحاصل ما قدّمناه: أنّ المراد من الحلال هو المباح غير المكروه ، والاستشهاد بكراهة علي (عليه السلام) في مورد الخبر للتحريم; لعدم احتمال الكراهة المصطلحة ودوران الأمر بين الإباحة والحرمة .
ومثل الصحيح المتقدّم صحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام) وقال في حديثه : «إلاّ أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»(5) .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ جواز العزل هو مقتضى الأصل .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 6 . والآية في سورة الأنبياء الآية 79 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 . والآية في سورة الأنبياء 172 .
- (3) نفس المصدر ، الباب 76 ، الحديث 1 .
- (4) نفس المصدر 12: 447 ، الباب 15 من الربا ، الحديث 1 .
- (5) نفس المصدر 14: 106 ، الباب 76 من مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
(الصفحة244)
أدلّة حرمة العزل وردّها
وأمّا التحريم فقد استدلّ له بما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى أن يعزل عن الحرّة إلاّ بإذنها ، والنبويّ الآخر إنّه الوأد الخفي(1) ، وبما روي من وجوب الدية فيمن أفزع مجامعاً فعزل(2) ، وبأنّه تفويت للغرض من النكاح وهو الاستيلاد .
ويردّ على الأوّلين ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ أنّهما محمولان على الكراهة بقرينة ما تقدّم .
وعلى الأخيرين: أمّا الدية ـ فمع عدم استلزامها الحرمة ـ أنّ موردها تسبيب الغير إلى العزل لا مباشرة الزوج به.
وأمّا الغرض فبمنع كون الإستيلاد تمام الغرض من النكاح .
والمتحصّل : أنّه لا ينبغي الارتياب في جواز العزل ، وظنّي أنّ مذهب بعض العامّة هو التحريم ، ومن هنا يحتمل الخبر المانع التقيّة .
حكم إسقاط النطفة قبل العلوق
وأمّا إسقاط النطفة فالظاهر جوازه قبل العلوق إن سمّي إسقاطاً، فلا مانع للمرأة من شرب دواء يمنع من العلوق أو إفراغها النطفة من رحمها قبل الانعقاد . ويكفي في الجواز الأصل حيث لا دليل على المنع .
وما تضمّن الزجر ظاهر في غيره ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
- (1) مستدرك الوسائل 14: 233 ، الباب 57 من مقدّمات النكاح .
- (2) الوسائل 19: 238 ، الباب 19 من ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
- رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) :
- وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خُمس المائة ، عشر دنانير ، الحديث .
- وفي نسختي من الوسائل وعن الجواهر: يفرِغ ، بالراء المهملة ، وهو سهو .
(الصفحة245)
قال في الجواهر : «عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه ، فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك; للأصل وغيره»(1) انتهى .
وأمّا بعد العلوق فالظاهر حرمة الإسقاط حتّى قبل ولوج الروح وإن كان مقتضى الأصل لولا النصّ جوازه; حيث لا يصدق عليه القتل .
نعم ، بعد ولوج الروح يصدق عليه القتل ، ومحلّ الكلام مباشرة الاُمّ في إسقاط حملها ، وأمّا إقدام الأجانب فلا ريب في حرمته ، فإنّه جناية على الاُمّ وعدوان عليها ، وورد تفصيل دية الحمل في الأخبار .
وممّن صرّح بحرمة إسقاط الحمل على المرأة ولو نطفة صاحبُ الوسائل في عنوان الباب 7 من قصاص النفس .
أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق
إحداهما : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : «لا» فقلت : إنّما هو نطفة ! فقال : «إنّ أوّل ما يخلق نطفة»(2) .
والظاهر أنّ مورد الرواية شرب المسقط عند احتمال الحمل ، فتدلّ الرواية على وجوب الاحتياط عند احتمال الحمل ، وعدم جريان البراءة .
وعلى أساسه يحتمل عدم جواز عمل يحتمل كونه موجباً لقتل نفس ، كأن يرمي مع احتمال إصابة إنسان أو جعل شيء في مكان يوجب القتل عند المرور عليه حيث يحتمل مرور إنسان عليه وهكذا . لا أقول: ذا قياساً على النطفة ليورد عليه
- (1) الجواهر 29: 115 .
- (2) الوسائل 19: 15 ، الباب 7 من قصاص النفس، الحديث 1 .
(الصفحة246)
بالمنع ، بل الذي يحمل على المصير إلى ما ذكرناه هو التعليل في الخبر . ونحوه التعليل في الخبر الآتي ، بل هو أوضح . فإذا دلّ الخبر على حرمة إسقاط الحمل مع احتماله ، دلّ على التحريم عند الجزم بلا ريب .
ويحتمل أن يكون المراد من الخبر الخوف من الحمل المنعقد جزماً ، وعلى التقديرين فالخبر دالّ على المدّعى .
ثانيتهما : معتبرة رفاعة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم، فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، فيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : «لا تفعل ذلك» فقلت له : إنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : «إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء الله ، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه»(1) .
والتعليل في الفرق بين العزل والإسقاط يقتضي تخصيص تحريم إتلاف النطفة بما إذا كانت على مرتبة من القابليّة للتحوّل إلى إنسان ، مفقودة قبل العلوق في الرحم; فإنّ النطفة في الرحم إذا علقت ببويضة المرأة كان لها تلك القابليّة لا بدونه .
حرمة إتلاف النطفة العالقة في غير الرحم
- (1) الوسائل 2: 582 ، الباب 33 من الحيض، الحديث 1 .
(الصفحة247)
الأرحام الطبيعيّة .
وقد تشكل دلالة التعليل المتقدّم بأنّ من المحتمل كون ذلك تعليلاً لحرمة الإسقاط من الرحم ولو بغير شرب الدواء لا لمطلق إتلاف النطفة ولو في غير الرحم .
ونظيره ما قد يقال في التعليل الوارد في طهارة البئر بالنزح بأنّ له مادّة; فإنّ المتيقّن منه كون المادّة علّة لطهارة البئر بالنزح الملازم للمزج; فلا يكون الحكم بطهارة البئر بدون المزج بالأخذ من مائه بغير النزح مقتضى التعليل .
وعلى أساسه يشكل الحكم بطهارة الماء المحقون بمجرّد اتّصاله بالمادّة بدون المزج; نظراً إلى عموم التعليل .
ويردّه: ما تكرّر منّا من أنّ التعليلات منزّلة على المفهوم منها بحسب المناسبات العرفيّة لتصلح علّة ومقرّباً للحكم; وإلاّ فحملها على اُمور تعبّديّة لا يناسب مقام التعليل والاستدلال .
وعليه فإنّ المتفاهم من موثّق إسحاق أنّ تمام العلّة لحرمة الإسقاط هو كون النطفة عالقة منشأ ومبدأً لخلق إنسان ، ومعه فلا يفرق بين كون النطفة في رحم أو غيرها .
وأمّا ملازمات المعلَّل ـ كالمزج في النزح ـ فإن كان دخيلاً بحسب الفهم العرفي والمناسبات في الحكم ولو احتمالاً كما هو غير بعيد في مورد البئر فهو ، وإلاّ فيلغى ولا يحكم بدخله في الحكم ، ويكون عموم التعليل بحسب الفهم العرفي نافياً وملغياً له . ولولاه لغى التعليل في كلّ مورد .
ألاترى أنّ المفهوم من تعليل حرمة الخمر بإسكارها هو حرمة مطلق المسكر; ولو بنى على احتمال دخل ملازمات المعلّل ، كأن يكون لإسكار الخمر خصوصيّة لم يكن التعليل صالحاً للاستدلال وتفهيم العلّة .
(الصفحة248)
نعم، في دلالة مثل هذا التعليل المتقدّم لطهارة البئر المتغيّر بالنزح ، على الطهارة في غير البئر بمجرّد الاتّصال بالمادّة إشكال آخر تعرّضنا له فيما تقدّم. وحاصله أنّ هذا تعليل لطهارة البئر الموصوف بكونه منزوحاً منه ، فإلغاء النزح يكون من قبيل إلغاء الأكل في لا تأكل الرمّان لحموضته ، فراجع . كما استشكلنا في دلالة تعليل حرمة الإسقاط على حكم أجنة الأنابيب أيضاً .
ثمّ إنّ هذه الرواية رواها في الوسائل عن الكافي بسنده إلى رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) وقد روى صاحب الوسائل في باب بعد هذا رواية عن الكافي بعين هذا السند عن رفاعة بن موسى النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها ؟ . . .
ثمّ ذكر أنّ الصدوق رواها مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) .
والظاهر وحدة الروايتين ، وإنّما وقع التقطيع فيها لتوزيعها على الأبواب المناسبة في الكافي أو قبله .
وحكي عن والد المجلسي في روضة المتّقين أنّه بعد نقل مضمون الخبر الأوّل لرفاعة بعنوان ماتنه ، ذكر أنّه رواه الكليني في الصحيح عن موسى بن جعفر (عليهما السلام); فلا يبعد أنّ نسخة المجلسي من الكافي كانت متضمّنة نقل الخبر الأوّل عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) وإن كانت نسخة الحرّ غيره .
الاستدلال بوجوه عليلة لحرمة إسقاط النطفة
الأوّل: ما دلّ على تأخير الحدّ عن الزانية حتّى تضع كما في موثّق عمّار(1) .
- (1) الوسائل 18: 380 ، الباب 16 من حدّ الزنا ، الحديث 4 .
(الصفحة249)
وفيه: أنّ مدلولها حرمة إسقاط الأجانب لا حرمة مباشرة الاُمّ .
الثاني: قد يستدلّ لذلك بما دلّ على ثبوت الدية في إسقاط الجنين حتّى النطفة(1) .
ولكن المنساق منه على تقدير الدلالة على الحرمة من جهة التلازم بين الدية والحرمة ، هو الحرمة على الجاني ولو خطأً ، وهو من تثبت الدية عليه; وكون إسقاط الاُمّ جناية غير ثابت ، نظير ما ذكرناه في العزل من أنّ ثبوت الدية على من أفرغ الرجل عن امرأته حتّى عزل عنها لا يستلزم ثبوتها على نفس الرجل لو باشر العزل بغير سبب .
الثالث: قد يستدلّ لتحريم الإسقاط على الاُمّ ، بما دلّ على حرمان الاُمّ من إرث دية حملها; معلّلاً بأنّها قتلته كما في صحيحة أبي عبيدة(2) ; وذلك بتقريبين:
أوّلهما: ما تقدّم قبيل هذا من دلالة الدية على الحرمة; وما أشكلنا هناك فلا يرد على هذا الخبر .
ولكن يدفعه أوّلاً: عدم التلازم بين الدية والحرمة ، وقد أفتى غير واحد في العزل بالدية مع الفتوى بجواز العزل كما في الشرائع وغيره . هذا في العامد .
وثانياً: مع ما في ثبوت الدية في الخطأ من الدلالة على عدم استلزامها الحرمة حيث لا حرمة على الخاطئ .
ثانيهما: التعليل بالقتل.
ويردّه: أنّ مفاد التعليل كون قتل النطفة كقتل غير الجنين من موانع الإرث إلاّ أنّ هذا لا يقتضي حرمة قتل النطفة ، ومجرّد صدق القتل لا ينبغي أن يدفع بالفقيه للإفتاء بالتحريم وإلاّ كان قتل الحيوانات وتذكيتها أيضاً محرّماً .
- (1) نفس المصدر 19: 169 ، الباب 21 من ديات النفس ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر 17: 390 الباب 8 من موانع الإرث ، الحديث 1 .
(الصفحة250)
ولعمري إنّ بعض التعابير فيها من الإرعاد والإبراق ما لا ينبغي أن نتوقّع منها الندى فضلاً عن الإمطار .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من جواز إسقاط الاُمّ للنطفة قبل العلوق إنّما هو بلحاظ الحكم الأوّلي; وأمّا لو شرط عليها ولو بالارتكاز عدم الإسقاط فلايجوز الإسقاط; لوجوب الوفاء بالشرط.
وعلى هذا الأساس قررنا حقّ الزوج في الاستيلاد بعد ما ذكرنا من أنّ حقّه بحسب الحكم الأوّلي هو الاستمتاع خاصّة دون الاستيلاد. وما تضمّن كون النساء حرثاً، وذلك باعتبار حرث النطفة في الأرحام ، فمع احتمال كونه ناظراً إلى الشأن التكويني للمرأة مع الرخصة فيه شرعاً لا يستفاد منه كون ذلك حقّاً للرجل; بل يمكن إشارته إلى السير الطبيعي والسائغ في الأنكحة.
(الصفحة251)
المسألة الثانية : إذا أضرّ الحمل بالاُمّ فقد يكون الإضرار في حدّ القتل ، وقد يكون دون ذلك ، كما أنّ دفع الضرر بالإسقاط قد يكون قبل ولوج الروح ، وقد يكون بعده ، وفي جواز إجهاض المرأة بحملها تفصيل بين الصور(1) .
(1) إذا كان الحمل مضرّاً بالحامل بما لا يندفع ضرره إلاّ بالإسقاط ، فتارةً يكون الفرض قبل ولوج الروح في الجنين ، وقد يكون بعد ذلك .
أمّا في الفرض الأوّل فالظاهر جواز إسقاط الحمل ، بلا فرق بين كون الضرر المتوجّه إلى الاُمّ من ناحية الجنين هو موتها بسببه أو مرض في تحمّله مشقّة ، بل بدونها; بناءً على أنّ حديث «لا ضرر» ناف لمثله .
ويدلّ عليه: أوّلاً: دليل نفي الحرج ، فإنّ نهاية ما يقتضيه دليل حرمة الإسقاط هو حرمته في الفرض بالإطلاق ، وهو محكوم كغيره من إطلاق أدلّة الأحكام الأوليّة بدليل نفي الحرج . وقد تقدّم منّا عدم الفرق في حكومة دليل نفي الحرج بين الواجبات والمحرّمات ، خلافاً لما نسب إلى بعض ومال إليه آخر من اختصاص الواجبات بالحكومة وقصور الدليل عن الحكومة على المحرّمات .
وثانياً : يدلّ على ذلك دليل نفي الضرر بالتقريب المقرّر لدليل نفي الحرج ، فإنّ الحامل تتضرّر بإلزامها بترك الإسقاط وتحريمه عليها فهو منفي عنها ، إلاّ أن يكون
(الصفحة252)
حديث نفي الضرر كناية عن حرمة الإضرار ، فيكون حكماً تكليفيّاً لا غير ، ومعه فلا حكومة له على شيء من أدلّة الأحكام الأوّلية .
وثالثاً : قد يكون المنساق من دليل حرمة الإسقاط هو ذلك في غير موارد الحرج ، فلا إطلاق فيه كي يحتاج في تقييده إلى دليل نفي الحرج ، فيكفي الأصل في إثبات جوازه .
بل يدلّ على عدم الحرمة دليل نفي الحرج بلا حاجة إلى الأصل ، فإنّه لا موضوع له مع الدليل الاجتهادي ، والسرّ في ذلك أنّ دليل نفي الحرج كما ينفي ما يكون من الأحكام إطلاقه حرجيّاً كذلك ينفي بإطلاقه ما يكون أصل الحكم حرجيّاً ، وإنّما لا يُحكّم على دليل يكون مضمونه من الأساس حرجاً; حذراً من اللغويّة في دليل الحكم الحرجي ، فلا مانع من نفيه الحكم الحرجي فيما لم يكن لإثباته من الأساس دليل .
وبمثل هذا البيان قرّرنا نفي دليل لا ضرر للحكم الذي يكون من أصله ضرريّاً; بناءً على كون مفاد دليله نفي الحكم الضرري .
الإشكال في حكومة لا حرج ولا ضرر على أدلّة الأحكام ، ودفعه
(الصفحة253)
هذا، وقد أجبنا عن هذا الإشكال سابقاً بأنّ المستفاد من بعض الأخبار المعتبرة هو تقدّم دليل نفي الحرج على إطلاق أدلّة الأحكام ، كمعتبرة عبدالأعلى المتضمّنة لحكومة لا حرج على دليل الوضوء; معلّلاً بأنّه «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله»(1) فإنّه بقرينة التعليل يحكم بحكومة دليل الحرج على غير دليل الوضوء .
هذا ، مضافاً إلى إمكان أن يُقال : إنّ المتيقّن من دليل نفي الحرج في قوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج}(2) هو الأحكام المجعولة في لسان الأدلّة بالأمر والنهي .
ومرجع هذا البيان إلى أنّ ملاك الحكومة في دليل نفي الحرج هو غير اللغويّة ، وكون الدليل بلسانه ناظراً إلى سائر الأدلّة .
إسقاط الحمل بعد ولوج الحياة
غير أنّه يمكن تقريب جواز الإسقاط بوجوه :
الوجه الأوّل : إطلاق دليل حلّ المحرّمات بالاضطرار إليها ، وليس لسانه امتنانياً كما في دليل نفي الحرج ، فالقتل من جملة المحرّمات ، وما من محرّم إلاّ وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه .
- (1) الوسائل 1: 327 ، الباب 39 من الوضوء ، الحديث 5 .
- (2) سورة الحجّ الآية 78 .
(الصفحة254)
وقد يقال : إنّ القتل مستثنى من حديث حلّ المحرّمات عند الإضطرار ، لحديث «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة»(1) فإنّ التقيّة من أسباب الاضطرار ، وقد صرّح في الحديث بأنّها لاتحلّ القتل .
ويمكن الإجابة عن ذلك بأنّ حديث الاضطرار عامّ وقد خرج منه مورد التقيّة في الدم ، فلا يحلّ الدم بالاضطرار بالتقيّة ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب آخر غير التقيّة فلا موجب لخروجه عن عموم الحديث .
وإن شئت فقل: إنّ مناط تشريع التقيّة يختلف عن مناط تشريع قاعدة الاضطرار وإن كانت التقيّة من مصاديق الاضطرار ، إلاّ أنّه اضطرار خاصّ شرعت لحقن الدماء ، فإذا استلزمت إراقة دم نافت ملاك تشريعها ، فلا تجوز التقيّة بقتل الغير ، وهذا بخلاف الاضطرار لمرض ونحوه فلا بأس بإحلاله كلّ محرّم حتّى الدم .
هذا ، ولكن يرد عليه ـ كما يرد على أصل الاستدلال ـ ما سبق منّا مكرّراً من أنّ حديث حلّ المحرّمات بالاضطرار ناظر إلى رفع الضرورة ، وكان تشريع هذه القاعدة لهذه الغاية ، وهو يتنافى مع تحويل الضرورة إلى شخص آخر ، وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع .
وإن شئت فقل : إنّ المنساق من القاعدة إزالة الضرورة ، وهي إنّما تكون حيث لا تسبّب ضرورة اُخرى أشدّ أو مثلها ، فإنّ التسبيب إلى ضرورة اُخرى هدم للغرض من تلكم القاعدة .
الوجه الثاني: تطبيق بعض نصوص الدفاع عن النفس على قتل الجنين المضرّ باُمّه ، والعمدة في المقام روايتان :
- (1) تهذيب الأحكام 6: 172 ، الحديث 335 .
(الصفحة255)
إحداهما : معتبرة أبي بصير والمعلّى فقد رواها الصدوق في الصحيح عن جعفر بن بشير ، عن المعلّى أبي عثمان كما في موضع من الوسائل والمعلّى بن عثمان كما في موضع آخر ، والظاهر صحّة كلا العنوانين ، وأنّه المعلّى بن عثمان ، وكنية المعلّى هي أبو عثمان كما عن النجاشي والشيخ ، وهو ثقة كما صرّح به النجاشي .
وروى هذه الرواية الشيخ بسندين: أحدهما معتبر والآخر ضعيف بالقاسم بن محمّد ، والظاهر أنّه الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة; وبين الموردين اختلاف يسير في الألفاظ وإن ذكر في الوسائل تماثلهما .
والرواية بالسند الأوّل للشيخ هكذا : قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: «ليس الذي زجر بضامن إنّما زجر عن نفسه» .
وزاد في النقل الآخر: «وهي الجبار»(1) .
والرواية لاشتمالها على التعليل تشمل ما نحن فيه .
والجبار بمعنى الهدر كما يلوح من موارد استعمالها في الحديث كثيراً .
ثانيتهما: معتبرة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال: «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [فقتله] فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين . . .» الحديث(2) .
ومورده وإن كان قتل المجنون ولا يبعد إلغاء الخصوصيّة بل إشعار الخبر بل دلالته على كون الدفع عن النفس تمام الموضوع .
وهناك بعض النصوص في جواز الدفاع عن النفس والمال ولو بقتل المهاجم
- (1) الوسائل 19: 42 ، الباب 21 من قصاص النفس ، الحديث 3 .
- (2) نفس المصدر: 52 ، الباب 28 من قصاص النفس ، الحديث 1 .
(الصفحة256)
المعتدي والسارق ، وفي بعضها: «اقتله وأنا شريكك في دمه» . ولكن التعدّي من موردها إلى مثل ما نحن فيه قياس لو لم يكن مع الفارق .
الوجه الثالث: جواز قتل الاُمّ الجنين دفاعاً للتزاحم أو للتعارض بين الأدلّة ، يمكن أن يستدلّ لجواز دفاع الحامل عن نفسها ولو بإسقاط الحمل بعد حلول الحياة فيه ، بالأصل بعد تزاحم حرمة القتل مع وجوب التحفّظ والتوقّي عن المهالك ، المدلول عليه بقوله تعالى : {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(1) وغيره ، حيث لا يحتمل أهمّية أحدهما بعينه ، فيدور الأمر بينهما ولم يثبت مرجّح لأحدهما .
ويردّه: أنّ مناط التزاحم بين الحكمين إنّما يكون حيث يصحّ التكليف بهما على وجه الترتّب ، وهذا لا يكون في مورد التركيب الاتّحادي بين متعلّقي الأمر والنهي ، والمفروض أنّ الإسقاط هو بعينه ما يكون به التوقّي عن الهلاك ، فلا يصحّ اجتماع الحكمين فيه حتّى بنحو الترتّب .
وإن شئت قلت : إنّه لا مناص من سقوط أحد الحكمين في المورد جزماً بعد عدم المندوحة وعدم تمكّن المكلّف من الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال . واشتراط الحكم الآخر بعصيان الأوّل من تحصيل الحاصل في مورد التركيب الاتّحادي .
هذا مع أنّه لو فرض كون الإسقاط مقدّمة لحفظ النفس لا مصداقاً للواجب فلا تصل النوبة إلى التزاحم ، بناءً على ما اختاره بعض مشايخنا من انصراف المقدّمة المطلوبة للواجب إلى المحلّل ولا تعمّ المقدّمات المحرّمة .
نعم، بناءً على غير هذا المبنى يحكم بعد تعارض دليلي حرمة القتل ووجوب
- (1) سورة البقرة الآية 195 .
(الصفحة257)
حفظ النفس وسقوطها بالتخيير; وذلك للأصل لا بملاك التزاحم بل للتعارض، وهذه نفس النتيجة المبتغاة من الدليل. ولا ترجيح لدليل حرمة القتل على دليل وجوب حفظ النفس بعد كون الدالّ على وجوب حفظ النفس أيضاً هو الكتاب المتضمّن للنهي عن إلغاء النفس في التهلكة.
وقد يجاب عن الاستدلال بأنّ حرمة القتل ، رعايتها أهمّ من حفظ النفس، بل ما دلّ على «أنّ التقيّة إنّما جعلت لحقن الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقيّة» حاكم على سائر الأدلّة ، ومنها حفظ النفس بدعوى أنّ التقيّة لا تختصّ بالتقيّة من المخالفين ، بل هي بمعنى التحذّر عن كلّ ما يخاف منه كمرض أو غيره.
ويؤكّده ما ورد من أنّ التقيّة في كلّ ضرورة أو في كلّ ما يضطرّ إليه ابن آدم ، ولا تلحظ النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم .
ويحكى عن سيّدنا الأستاذ أنّه جوّز قتل الغير إذا اُكره عليه; نظراً إلى التزاحم بين وجوب حفظ النفس وحرمة قتل الغير ولم ير حكومة لا تقيّة عليه في المقام ، نظراً إلى أنّ المقصود من نفي التقيّة هو عدم وجود ملاك التقيّة والحكم من جهتها في مورد الدم ، وهذا لا ينافي وجود ملاك آخر لجواز القتل ، كالتزاحم المقتضي للتخيير بين المتزاحمين وأحدهما جواز القتل ، فيكون جواز القتل بملاك غير ملاك التقيّة .
وإن شئت قلت : إنّ الحديث ناظر إلى حيثيّة خاصّة ، وإنّ التقيّة ملاكها خاصّ بغير ما تؤدّي بالقتل ، فلا ينافي وجود ملاك آخر لجواز القتل .
قال في كتاب القصاص المسألة 17 : «ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه كان عليه القود
(الصفحة258)
وعلى المكره الحبس المؤبّد .
وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الاُولى، ولكنّه مشكل ، ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية .
أمّا وجه المشهور فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل .
وفيه: أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله إلاّ أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً ، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم; إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك ، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير ، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتّب عليه القصاص ولكن تثبت الدية; لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً» (1) .
أقول : دعوى كون نفي التقيّة في الدم حيثيّاً لا ينافي جواز القتل بملاك غير التقيّة ، خلاف ظاهر الحديث جدّاً; فإنّ هذا إنّما يجوز إذا لم يكن التزاحم ـ الملاك الآخر لجواز القتل ـ ثابتاً في تمام موارد التقيّة; ومعه فحمل نفي التقيّة الظاهر في عدم جواز القتل على النفي الحيثي خلاف الظاهر .
إلاّ أن يقال : إنّ التزاحم ليس مقتضياً لجواز القتل دائماً ، بل ربما كانت حرمة القتل أهمّ من وجوب حفظ النفس ، فكانت حرمة القتل بملاك أهمّيته مع التزاحم .
ثمّ إنّ دعوى التزاحم إنّما تتمّ حيث يكون قتل الغير مصداقاً لحفظ النفس أو مقدّمة له، ولكن قلنا بوقوع التزاحم بين التكاليف النفسيّة والغيريّة; وأمّا على مسلك بعض مشايخنا من اختصاص وجوب المقدّمة بالمباح منها فلا مزاحم
- (1) مباني تكملة المنهاج 2: 13 ـ 14 ، وراجع التنقيح 5: 259 .
(الصفحة259)
لحرمة القتل حيث إنّ وجوب حفظ النفس الموقوف على قتل الغير ساقط عن المكلّف بعجزه عن مقدّمته بسبب حكم الشارع بتحريمه .
وبالجملة فوجوب حفظ النفس لا يدعو إلى المقدّمة المحرّمة فلا مزاحم لحرمتها .
الوجه الرابع: ربما يستدل لجواز الدفاع عن النفس ببناء العقلاء على ذلك ، حيث لم يثبت ردع من الشارع عن ذلك .
ومثله ما لو تشبّث الغريق بغيره وتوقّفت نجاة الغير على دفع الغريق وقتله; فإنّه لا يبعد بناء العقلاء على جواز الدفاع عن النفس ولو بقتل الغير في مثل المقام .
هذا، ولكن البناء المتقدّم غير ثابت ، وربما كان ثبوته في بعض الموارد بملاك التزاحم فلا يكون للدفاع موضوعيّة .
نعم ، بناء العقلاء على دفع المعتدي والعامد في عدوانه ، وهذا خارج عن محلّ الكلام . وربما كانت مسألة الغريق من هذا القبيل ، فإنّه لا يحقّ له التشبّث بغيره لإنجاء نفسه حيث استلزم قتل الغير ، فلو فعل كان عادياً حلّ دفعه كاللصّ .
تكملة: قد ظهر من الكلام في المسألة حكم قتل الجنين المنفوخ فيه الروح، إذا كان الضرر المتوجّه إلى الاُمّ بسببه دون النفس.
ومحصّل الكلام فيه: أنّ الذي يدلّ على جواز دفاع الاُمّ عن نفسها في هذا الفرض اُمور:
الأوّل: النصّ الدالّ على جواز الدفاع عن النفس، فإنّه لايختصّ بالدفاع عن الحياة، بل يعمّ دفع الأذى والضرر دون الموت أيضاً. حيث تضمن جواز دفع الضرر بقوله: «إنّما زجر عن نفسه» وهذا كما يصدق في مورد دفع الإضرار بالموت يشمل ما دونه.
وكذا إطلاق الرواية الأخرى: «إن كان المجنون أراده...» بناءً على إلغاء
(الصفحة260)
خصوصيّة المجنون; فإنّ إرادته شاملة لإرادته لما دون القتل من ضرب أو جرح ونحوهما.
الثاني: لو تعارض دليل حرمة القتل ودليل وجوب دفع الضرر عن النفس غير النصّ الخاصّ، بل آية النهي عن إلقاء النفس في التهلكة ونحوها، كان المرجع أصالة البراءة من حرمة القتل كاقتضاء الأصل عدم وجوب حفظ النفس.
إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى قاعدة الاحتياط في الدماء عدم انتهاء النوبة إلى أصل البراءة فيها فيما يكون الأصل فيه البراءة لولا كونه دماً، فلاحظ.
وكذا الكلام على تقدير التزاحم بين الحكمين بعد عدم إحراز أهمّية حرمة القتل، لو كان المورد من موارد التزاحم إلاّ أن يقال بكفاية احتمال أهمّية أحد الحكمين، ولكنّه موقوف على اختصاص حرمة القتل باحتمال الأهمّية وعدم احتمال أهمّية وجوب حفظ النفس عن المهلكة.
الثالث: لايبعد عموم بناء العقلاء المقرّر فيما تقدّم لمثل الفرض سيما إذا كان الضرر المتوجّه إلى النفس جسيماً غير يسير، فإنّ بناءهم على الدفاع عن النفس مهما استلزم إضرار الغير.
وليعلم أنّ إسقاط الحمل حيث جاز بدليل الدفاع عن النفس وجب لوجوب حفظ النفس بدليل آية التهلكة وغيرها.
نعم، لو كان الدليل على جواز الإسقاط هو الأصل بعد تعارض دليلي حفظ النفس وحرمة قتل الغير أو تزاحمهما، لم يكن الإسقاط واجباً وإنّما يجوز.
فتحصّل من جميع ما تقدّم: جواز إسقاط الاُمّ حملها في جميع فروض المسألة بلا فرق بين كون الضرر المتوجّه إلى الاُمّ قتلاً أو دونه كمرض أو جرح ونحوهما ممّا يصدق معه الدفع عن النفس. وبلا فرق بين كون ذلك قبل ولوج الحياة في الجنين أو بعده.
(الصفحة261)
وربما ظهر ممّا تقدّم حكم دفع الضرر والحرج والمشقّة بالإسقاط إذا كان الحرج والمشقّة بغير المرض والموت ونحوهما ، كما لو كانت المشقّة والأذى بسبب نقص الجنين ومرضه الموجبين لتحمّل الأذى أو نحو ذلك، أو كان تكوّن الجنين من الزنا ويصدق في إسقاطه الدفاع عن النفس، فتأمّل; حيث يمكن أن يقال: إنّه لا يتعيّن على الاُمّ رعاية ولدها حيث أمكنها التخلّص عن الحضانة وإحالتها لغيرها، فلاحظ.
(الصفحة262)
المسألة الثالثة: هل يجوز إسقاط الحمل المشتمل على مرض أو نقص في العضو؟(1) .
(1) لا يجوز إسقاط الحمل بحسب الحكم الأوّلي للأبوين فضلاً عن غيرهما . غير أنّه يعد إسقاط غير الأبوين ، بل وإسقاط غير الاُمّ جناية على الاُمّ زائداً على الحمل بخلاف مباشرة الاُمّ للإسقاط ، فإنّه جناية عى الحمل خاصّة .
وإنّما يقع الكلام في إسقاط الحمل لغرض عقلائي ، وقد تقدّم الكلام في موارد الخوف على الاُمّ الحامل ، ويقع الكلام في موارد تتعلّق بمرض الحمل ونقصه .
وتفصيل الفروض:
1 ـ حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير
لا يجوز إسقاط الحمل حتّى النطقة لمرض بسيط في الحمل أو نقص يسير ممّا لا يكون في تحمّل ذلك مشقّة وحرج على الاُمّ ، سواء كان المرض قابلاً للعلاج أو لم يكن .
فلو تشخّص في أيّام الحمل ضعف في بصر الحمل أو قصر في قامته أو نحو ذلك من أنحاء النقص اليسير ، بل والمتعارف ، لم يحلّ إسقاط الحمل; كلّ ذلك لإطلاق دليل حرمة الإسقاط .
(الصفحة263)
2 ـ حكم إسقاط الحمل المريض بالأمراض الصعبة الشاقّة
إذا تشخّص ابتلاء الحمل بمرض صعب كزمانة ونحوها ممّا يشقّ على الاُمّ حضانة مثل ذلك الولد ، فهل يجوز لها الإسقاط ؟
أمّا إذا كان الحرج متوجّهاً إلى الأب فلا يجوز له إسقاط الحمل لا مباشرة; لأنّه جناية على الحمل وعلى الاُمّ ، ولا يقتضي دليل نفي الحرج حِلّها بعد كون دليل الحرج امتنانيّاً لا يجري فيما استلزم جريانه خلاف المنّة .
نعم ، لو بلغ الأمر حدّ الضرورة ولم يستلزم ضرراً على الاُمّ سوى الإسقاط ، ولم يكن ولجت الروح في الحمل ، فلا يبعد جواز الإسقاط للأب مباشرة .
ولا يجوز مباشرة غيره لذلك حتّى الاُمّ ، إلاّ على احتمال تقدّم .
ويدلّ على جواز الإسقاط للأب حينئذ قاعدة الاضطرار المتقدّمة ، ولكنّه مجرّد فرض; فإنّ الحمل من قبيل جزء الحامل ، ولذا يعدّ إسقاطه جناية على الاُمّ كالجناية على سائر أعضائها ، ومعه فالاضطرار إلى إسقاط الحمل من قبيل الاضطرار إلى أخذ عضو من أعضاء الغير .
وقد تقدّم الإشكال في حلّه; نظراً إلى قصور قاعدة الاضطرار عن مثله بعد كون تشريعها لرفع الضرورات لا تحويلها إلى الغير بإيجاد الضرورة في محلّ آخر . هذا إذا لم يكن ولجته الروح وإلاّ لم يجز إسقاطه قطعاً فإنّه قتل نفس محترمة .
3 ـ حكم إسقاط الاُمّ لحملها المبتلى بمرض شاقّ قبل ولوج الروح وبعده
هل يجوز للاُمّ إسقاط الحمل فيما كان الصبر على الطفل الناقص حرجاً عليها؟
يقع الكلام تارةً بعد ولوج الروح في الحمل ، واُخرى قبله:
أمّا بعد حياة الطفل فحكمه حكم غير الحمل من الأحياء ، والمعروف أنّ الضرورة لا تحلّ القتل فضلاً عن الحرج; لحديث «أنّ التقيّة إنّما شرّعت
(الصفحة264)
لحقن الدماء وأنّها إذا بلغت حدّ الدم فلا تشرع التقيّة» كما في صحيح محمّد بن مسلم(1) .
وحيث إنّ التقيّة المصطلحة عبارة عن الخوف من إنسان عامّي أو كافر أو غيرهما ، كان تسرية الحكم إلى سائر موارد الخوف:
إمّا بإلغاء الخصوصيّة ، وأنّ مطلق الضرورات لا تحلّ القتل ، والتقيّة منها ، وهذا تخرّص لا يمكن تحصيل الجزم به .
وإمّا بدعوى عموم التقيّة لمطلق الخوف من دون اختصاص له بالخوف من إنسان فضلاً عن خصوص العامّة ، فالخوف من المرض ونحوه أيضاً من مصاديق التقيّة .
وعلى هذا تترتّب ثمرة مهمّة هي أنّه بناءً على استفادة الإجزاء من أخبار التقيّة ـ مضافاً إلى الحكم التكليفي ـ ينبغي الحكم بصحّة العمل الناقص في مطلق موارد التقيّة حتّى غير المصطلحة .
ونحن وإن لم نستبعد دلالة بعض أخبار التقيّة على الإجزاء بعد دلالة كلّها على الحكم التكليفي ، غير أنّ من المحتمل جدّاً أن تكون التقيّة في اصطلاح الأخبار بمعنى خاص هو التقيّة من المخالفين أو منهم ومن الكفّار أو من مطلق الإنسان بما يشمل طوائف الشيعة ، خلافاً لما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) بل وغيره من أنّ مدلول أخبار التقيّة إنّما هو مجرّد الحكم التكليفي ، وأنّه عند التقيّة يجوز ارتكاب المحرّمات ، بل ويجب ، وأمّا صحّة العمل الناقص في ظرف التقيّة فلا ، وإنّما استند (قدس سره) للإجزاء في بعض موارد التقيّة إلى بعض الأدلّة الخاصّة مع قصور إطلاقات التقيّة عن ذلك فيها كغيرها .
- (1) الوسائل 11: 483 ، الباب31 من الأمر والنهي ، الحديث 1 .
(الصفحة265)
ما يدلّ على إجزاء العمل الصادر على وجه التقيّة
ثمّ إنّ الخبر الذي استندنا إليه في الإجزاء هو معتبرة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقيّة فأنتم منه في سعة»(1) .
بتقريب: أنّه شامل لفعل شيء أو تركه ، وأنّ مطلق ذلك لا ينبغي أن يكون منشأ لضيق على المكلّف ، فلو سجد المكلّف عند التقيّة على بساط لم يُجزِ السجود عليه اختياراً ، فلا ينبغي أن يكون ذلك منشأ لبطلان صلاته; لأنّه مناف للسعة الثابتة في مورد التقيّة .
فإن قلت : قد ورد نظير هذا التعبير في أخبار البراءة ، وهو قوله : «الناس في سعة ما لم يعلموا»(2) ، مع أنّه لم يستند إليه أحد فيما نعلم للإجزاء في موارد الإتيان بالعمل الناقص جهلاً .
قلت : هذا قياس مع الفارق; فإنّ الجهل إذا تبدّل بالعلم فقد ارتفع موضوع حديث السعة ، وما دام الجهل باقياً فالتحقيق هو الإجزاء ، حيث إنّ موافقة الأمر يقتضيه ما دام موضوعه منحفظاً ، وهذا بخلاف حديث السعة عند التقيّة فإنّ موضوعه هو التقيّة في ظرف العمل ، وهذا محفوظ حتّى بعد ارتفاع التقيّة .
وكيف كان فإطلاق الحديث لما لا يحتمل فيها الحرمة تكليفاً ، يقتضي حمل السعة فيها على الأعمّ من الحكم الوضعي ، فتأمّل .
وبالجملة : فالعمدة في الدلالة على الإجزاء ـ على ما يلوح لي ـ هو هذا الحديث ، وأمّا غيره ففي دلالته منع أو تأمّل ، وتمام الكلام في غير المقام .
وكيف كان فالذي تقتضيه القواعد هو أنّ صعوبة الصبر على الحمل الناقص والمريض ، إذا لم يبلغ حدّ الضرورة لاتُجوّز إسقاطه وإن كان مستلزماً للحرج ،
- (1) الوسائل 16: 134 ، الباب 12 من الأيمان ، الحديث 2 .
- (2) مستدرك الوسائل 18: 20 ، الحديث 21886 .
(الصفحة266)
لقصور دليل نفي الحرج عن الحكومة على دليل حرمة الإسقاط بعد كونه امتنانيّاً .
وإذا بلغت حدّ الضرورة ، لم يجز إسقاطه أيضاً حتّى لقاعدة الاضطرار المتكرّرة والتي مدركها غير حديث الرفع الامتناني ، وقد سبق منّا تفصيل الكلام فيه ، ومجمل القول فيه أنّ هذه القاعدة شرّعت لرفع الضرورة لا لتحويلها أو أشدّ منها إلى الآخرين .
هذا كلّه إذا نفخ فيه الروح ، وأمّا قبل ذلك فإطلاق دليل حرمة الإسقاط وإن كان شاملاً له وقاضياً بحرمة الإسقاط فيه ، إلاّ أنّ هذا الإطلاق كسائر إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية محكومة لدليل الحرج وقاعدة الاضطرار .
والمانع من جريان القاعدتين قبل حلول الحياة هو تضرّر إنسان آخر بجريانهما ، والحمل قبل الحياة لا يعدّ إنساناً ، بل هو قطعة لحم وإن صلح للتحوّل إلى إنسان حيّ كامل .
(الصفحة267)
المسألة الرابعة: الظاهر عدم جواز إسقاط المرأة لحملها المتكوِّن من زنا ، على إشكال(1) .
(1) في جواز إسقاط الاُمّ حملها المتكوّن من زنا ، إشكال ينشأ من دعوى إطلاق ما دلّ على حرمة إسقاط الحمل ولو نطفة لمثله ، ولكنّه مشكل .
والذي ينبغي القول به في المقام هو أنّ الموضوع تارةً يفرض قبل ولوج الحياة واُخرى بعده .
أمّا في الأوّل فإنّ عمدة الدليل على حرمة إسقاط مثل النطفة هو معتبرتا إسحاق ورفاعة ، وموردهما هو غير الزنا . وخصوصيّة المورد وإن كانت لا تمنع من الإطلاق ، ولكنّ المنساق من إطلاقهما هو أنّ خصوصيّة النطفة لا تمنع من حرمة الإسقاط، وأمّا حرمته مطلقاً فغير معلومة .
وإن شئت فقل: إنّه لا إطلاق فيهما لكلّ نطفة ، فتأمّل .
وأمّا بعد ولوج الحياة فحكمه حكم الطفل المتولّد من حيث صدق القتل ممّا يعدّ ظلماً ، مضافاً إلى الدليل اللفظي على حرمة القتل ، بل هو قتل ولد المسلم فيما كان أحد الوالدين مسلماً فإنّه ولد لهما عرفاً ، ولا اصطلاح للشارع في الأنساب سوى ما للعرف .
(الصفحة268)
ثبوت نسب ولد الزنا ، شرعاً
إنّ ما اشتهر من نفي ولد الزنا وإنّه لا يلحق بالزاني فهو خلط لا دليل عليه . وكأنّه نشأ ممّا روى من: «أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر» مع أنّ المراد به هو مورد الشكّ في كون الولد من الفراش أو الزنا وأنّه لا يلحق بالزاني .
نعم ، ورد نفي الإرث في الجملة في مورد الزنا و«أنّ الولد لغية لا يرث أو لا يورث»(1) وهذا لا يستلزم قطع النسب . وكم له من نظير! فإنّ القتل والكفر من موانع الإرث ولا يوجب قطع النسب ، فليكن الزنا مانعاً كذلك .
نعم ، ربّما يستند في حرمة إسقاط الحمل المتكوّن بالزنا إلى بعض الأخبار .
فقد روى المجلسي (قدس سره) في البحار عن المنتهى مرسلاً قال: روي أنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار; خوفاً من أهلها ولم يعلم بها غير اُمّها ، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ـ إلى أن قال: فقال الصادق (عليه السلام) :ـ «إنّ الأرض لا تقبل هذه; لأنّها كانت تعذِّب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها من تربة الحسين (عليه السلام) » الحديث(2) .
لكن في دلالته تأمّل .
وليعلم أنّ حرمة إسقاط الحمل المتكوّن من الزنا ، قبل ولوج الروح ، لو قيل بها فهو مبنيّ على إطلاق المستند المتقدّم ، ولو سلّم هذا فإنّما يتمّ حيث لا يكون الصبر على مثل هذا الحمل حرجاً وإلاّ ـ كما هو الظاهر في غير المتجاهر بالزنا ممّا يكون ظهوره منشأً للفتن وإراقة الدماء والطلاق وغير ذلك ـ فلا مانع من جواز الإسقاط حينئذ .
- (1) الوسائل 17: 567 ، الباب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 2 .
- (2) بحار الأنوار 79: 45 ، كتاب الطهارة ، الباب 55 ، الحديث 31 .
(الصفحة269)
المسألة الخامسة: إذا علم الرجل بكون المولود منه مريضاً ، لخلل في نطفته أو عيب في المرأة التي تحمل أو عدم التئام نطفته مع الرحم الخاص ، ففي جواز إحباله لتلك المرأة إشكال (1) .
(1) المرض الملمّ بالحمل: تارةً يكون صعباً مميتاً أو نحوه ممّا لا يتحمّل بحسب العادة ، وقد يكون أمراً يسيراً كنقص في إصبع أو ضعف يسير في البصر .
وعلى التقديرين فقد يكون المرض قابلاً للعلاج بعد تولّد الحمل أو قبله أثناء الحمل ، وقد لا يكون قابلاً للعلاج .
وعلى التقادير قد يكون العيب والنقص محتملاً ، وقد يكون قطعيّاً .
الصورة الاُولى : أن يكون المرض في الحمل صعباً لا يقبل العلاج مع كونه قطعيّاً .
وليعلم أنّ الأصل يقتضي حلّ الاستيلاد في الفرض ، ويكون المنع بحاجة إلى دليل يوجب رفع اليد عنه . نعم ، على مسلك الأخباري القائل بالاحتياط في الشبهات التحريمية ، يكون الاستيلاد ـ في فرض احتمال حرمته ـ ممنوعاً احتياطاً ، ولكن المبنى ممنوع .
بل قد يقال: بجواز التسبيب إلى مرض الحمل ، اختياراً بشرب دواء يوجب خللاً في النطفة يقتضي نقصاً في الحمل; لكون الممنوع هو الجناية على الإنسان
(الصفحة270)
والنطفة ليس بذلك وإن كان فيه قابليّة التحوّل إلى إنسان، فإنّ عدم جواز الجناية وإسراء النقص على الغير لا يلازم حرمة إيجاده ناقصاً من الأوّل .
كما أنّه لاينبغي الريب في صحّة مثل عقد النكاح هذا بعد شمول عمومات النكاح وغيره ، لمثله حيث لا مخصّص لها بغير الفرض .
(الصفحة271)
ولاية الحاكم الشرعي
حدّ ولاية الحاكم في العقود من حيث الحكم التكليفي والوضعي
بناءً على ولاية الحكّام وعمومها ، لا بأس للحاكم أن ينشأ منع التزويج في مثل هذه الموارد أو منع الاستيلاد ، ونتيجة ذلك حرمة ذلك تكليفاً . وليس له إنشاء بطلان عقد النكاح في مثل هذه الموارد ، فإنّه لا ولاية للحاكم على تشريع الأحكام الوضعيّة بخلاف ما جعله الشارع من أحكام .
فليس للحاكم اعتبار البيع فاسداً ولو في بعض الموارد ، ولا أن يعتبر شيئاً ملكاً لشخص بدون الأسباب الشرعية المعهودة ، ولا اعتبار بيع الربا مملكاً ، ولا اعتبار صحّة سائر المعاملات الفاسدة صحيحة ، ولا اعتبار الشيء الطاهر نجساً ولا النجس طاهراً وهكذا .
وعلى هذا الأساس ليس له اعتبار نكاح خاصّ مشمول للإطلاقات فاسداً ، كما ليس له اعتبار نكاح فاسد صحيحاً ، بل قصارى ما يحقّ له هو المنع من النكاح الصحيح وتحريمه وإن صحّ على تقدير المخالفة .
والسرّ في ذلك هو أنّ نهاية ما يمكن إثباته للحاكم في هذه الأعصار هو مقدار من الولاية دلّ عليه قوله تعالى : {النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}(1) ،
- (1) سورة الأحزاب الآية 6 .
(الصفحة272)
ومقتضى ولاية المؤمنين على أنفسهم والتي النبيّ (صلى الله عليه وآله) أولى بثبوتها على المؤمنين من أنفسهم ، هو غير ما تقدّم من أنحاء التشريعات .
فإنّه لا ولاية للمؤمنين على اعتبار نكاح باطلاً ولا على تصحيح نكاح فاسد ، ولا على اعتبار البيع ملغى عن التأثير فيما كان مؤثّراً في اعتبار الشرع كما في موارد عدم الفسخ والتقايل ، ولا على اعتبار البيع الفاسد مؤثّراً كما في بيع الخمر والربا والغرر .
نعم ، للمؤمن إنشاء الطلاق; لكونه آخذاً بالساق ، وللنبيّ (صلى الله عليه وآله) ـ لكونه أولى منه بما للمؤمن الولاية عليه ـ أن ينشئ طلاق امرأة المؤمن . وأيضاً للمؤمن بذل ماله بهبة ونحوه ، فللنبيّ بذل مال المؤمن بتلك الأسباب قضيّة لأولويّته ; وحيث تثبت الولاية للحاكم غير المعصوم كان له مثل هذه الاُمور .
ولاية الناس على نصب الحكّام
وعلى أساس تطبيق آية الولاية على نصب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «ألستُ أولى بكم من أنفسكم» علمنا أنّ للمؤمنين ولاية نصب الولي والحاكم على أنفسهم; ولكن حيث أعمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) أولويّته فيما كان لهم ، بنصب علي (عليه السلام) إماماً ووليّاً من بعده ، لم يحقّ لهم التخطّي عمّا عيّنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
وقد كان نصب النبيّ (صلى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السلام) بأمر من الله ، ولم يكن له (صلى الله عليه وآله) أيضاً التخطّي عمّا عيّن الله; غير أنّه (صلى الله عليه وآله) أنشأ نصب عليّ (عليه السلام) وليّاً لا أنّه أخبر عن ذلك . فنصبه (صلى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السلام) كسائر وصاياه ممّا لو لم ينشأها لم تتحقّق .
والفرق بين إنشائه نصب عليّ (عليه السلام) وسائر إنشاءاته أنّه ربّما كان في سائر الإنشاءات مختاراً لا إلزام له فيها، بخلاف هذا الإنشاء فإنّه كان موظّفاً بذلك .
وآية الغدير وإن تضمّنت الأمر بالتبيلغ إلاّ أنّه ربّما كان المراد تبليغ أمر الله له (صلى الله عليه وآله)
(الصفحة273)
بإنشاء نصب عليّ (عليه السلام) لا تبليغ إمامة عليّ (عليه السلام) بلا حاجة إلى نصب ، فلاحظ الفرق بينهما ، وقد فصّلنا بعض القول في ذلك في بعض رسائلنا .
ولاية الحكّام على الأمر والنهي
ولكن أين هذا من ولاية الحاكم على اعتبار النكاح فاسداً أو الفاسد صحيحاً ؟
فذلكة حدود اختيارات الحاكم
أحدهما : ولاية الأمر والنهي .
والثاني : ولاية ما للمؤمن الولاية عليه .
نعم ، هنا أمر ثالث له الولاية عليه وضابطه الأمور الحسبيّة التي يُعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها; وكثير من موارد هذا القسم من قبيل الولاية على القصّر ، راجع إلى القسم الثاني; فإنّ أولوية النبيّ (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين عامّ لما كان لهم من الولاية على غيرهم .
- (1) سورة النساء الآية 59 .
(الصفحة274)
ولاية التشريع للنبيّ (صلى الله عليه وآله) وغيره
نعم ، ربّما تثبت للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ولاية التشريع على ما يلوح من أخبار تشريع الركعتين الأخيرتين في الرباعيات ، وغير ذلك ممّا سنّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
ولكن مع احتمال دلالة بعض الأخبار على أنّ ما سنّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) من الركعتين الأخيرتين كان مجرّد اقتراح أمضاه الله وأوجبه ، وأنّ سننه (صلى الله عليه وآله) ربما كانت من هذا القبيل ; كلّ ذلك نظراً إلى قوله تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى}(1) ، فكلّ ما ينطق به (صلى الله عليه وآله) فهو وحي ، لا عن هوى نفسه وإرادته ، فتأمّل .
وكيف كان فالولاية على التشريع لو ثبتت للنبي (صلى الله عليه وآله) في مثل الحكم ببطلان عقد حكم الله بصحّته أو صحّة عقد حكم الله ببطلانه ، بحيث كانت ولاية النبيّ (صلى الله عليه وآله) على التشريع من قبيل ولايته من قبل الله تعالى على نسخ أحكامه تعالى ، لو دلّ دليل على ذلك لالتزمنا به ، إلاّ أنّه لا دليل على ثبوت مثل ذلك للحاكم غير المعصوم جزماً; فإنّ ولاية جعل الحكم لله تعالى ثمّ لغيره بمقدار ما جعله الله له .
وقد قيل باختصاص ولاية التشريع بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) وعدم ثبوتها حتّى للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فضلاً عن غيرهم وذلك ، لحديث: «حلال محمّد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» . وفي ذلك كلام ليس هذا محلّ تفصيله .
ومرجع جعل الولاية لغيره على جعل حكم على خلاف ما جعله الله ، إلى تفويض ولاية النسخ إلى ذلك الشخص أو تخصيصه تعالى أحكامه بغير ما إذا أنشأ الوليّ حكماً على خلاف عامّ أو مطلق ، والذي مرجع الأوّل إليه أيضاً لبّاً ; فإنّ النسخ بحسب الحقيقة تخصيص على ما اشتهر من أنّ النسخ تخصيص في الأزمان ، كما أنّ التخصيص تخصيص في الأفراد وإن كان هذا لا يخلو عن نظر; فإنّ النسخ
- (1) سورة النجم الآيتان 3 و 4 .
(الصفحة275)
رفع والتخصيص دفع .
ودعوى أنّ النسخ بحسب الجدّ دفع وإنّما هو رفع بحسب الظاهر ، يدفعها أنّه لا موجب لذلك إلاّ توهّم أنّ النسخ الحقيقي لا يتصوّر في حقّ الله تعالى ، مع أنّ النسخ الحقيقي إنّما هو متقوّم برفع الحكم المجعول مع كون إنشاء الاستمرار جدّاً وإن كان هذا الإنشاء والجعل لا بداعي المجعول ، بل في نفس الجعل الحقيقي ، داع وحكمة ، وليس في موارد التخصيص جعل جدّي وإنّما هو صورة الجعل .
توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً
إن قلت : إذا جاز للأفراد كراهة عقد وعدم رضاهم بمضمونه بحيث لو أُنشئ العقد كذلك كان لا عن رضا فيبطل ، فلتكن كراهة النبيّ (صلى الله عليه وآله) للعقد ، المعلومة بنهيه عن ذلك العقد; لأولويّته من نفس المؤمن ، مانعاً من صحّة ذلك ، فيكون له بهذا الدليل ولاية على الوصلة إلى الأحكام الوضعيّة كفساد العقود المشروعة لولا كراهته لها .
قلت : بطلان العقد في فرض كراهة الأفراد ليس بملاك الكراهة ، بل بملاك عدم الرضا الموجب لكونه مثلاً بيعاً غير مستند إلى المالك أو كونه بيعاً غير مستند إلى رضا المالك .
ولا شكّ أنّ عدم رضا النبيّ (صلى الله عليه وآله) بمعاملات الناس لا يوجب بطلانها ، حيث لم يؤخذ في صحّة بيوعهم إنشاء النبيّ (صلى الله عليه وآله) رضاه بها، بحيث لو أنشأت بدون رضاه كان كإنشاء البيع بدون رضا المالك بدليل كونه كالافراد أو أولى منهم . فإذا لم يكن عدم إنشاء النبيّ (صلى الله عليه وآله) رضاه بالمعاملة موجباً لفساده ، فأيّ موجب لكون نهيه وكراهته (صلى الله عليه وآله) موجباً لفساد المعاملة بعد وحدة الملاك فيما يتوهّم اقتضاء كراهته (صلى الله عليه وآله) لفساد المعاملة ؟!
(الصفحة276)
على أنّ نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) وكراهته لمعاملة لا يزيد على نهي الله عن معاملة ، فإنّ أولويّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) من فروع ولاية الله ، مع أنّ النهي في المعاملات لا يوجب فسادها بلا ريب ما لم يرجع إلى الإرشاد إلى بطلان المعاملات .
مع أنّ بطلان المعاملة في فرض كراهة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لها لو سلّم فليس بملاك الولاية على التشريع ، بل ملاكه الولاية على موضوع حكم الشارع ، فهو كصحّة المعاملة في فرض مباشرة الولي لبيع مال الغير .
نعم ، لو رجعت كراهته (صلى الله عليه وآله) لمعاملة إلى كراهة نفوذها وصحّتها ، لا كراهة إنشائها ، وأثّرت كراهته في فساد المعاملة ، ككراهة الله للمعاملة ، كان من الولاية على التشريع ، ولكن ليس للمؤمن ولاية على تلك الكراهة بحيث تؤثّر كراهته في بطلان المعاملة ما لم ترجع إلى كراهة الإنشاء الراجعة إلى عدم طيب النفس .
ولا ملازمة بين كراهة صحّة المعاملة وبين كراهة إنشائها ، فإنّ الإنشاء موضوع الصحّة ، وبين الحكم وموضوعه تباين لا يلزم سراية الكراهة من أحدهما إلى الآخر .
ضابط آخر لحدّ ولاية الحكّام
وحيث انجرّ الكلام إلى مسألة ولاية الحاكم فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى ضابط آخر لمواردها فنقول:
المتيقّن من موارد ولاية الحاكم ـ فيما ثبتت ـ هو غير المحرّمات; وذلك فإنّ مقتضى آية ولاية النبيّ (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى : {النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}(1)هو أنّ ما ثبت للمؤمنين من الولاية فالنبيّ (صلى الله عليه وآله) أولى بها منهم ، ومن الواضح إنّه
- (1) سورة الأحزاب الآية 6 .
(الصفحة277)
لا ولاية للمؤمنين على فعل المحرّمات فلا تدلّ الآية هذه على ثبوت هذه الولاية .
نعم، للمؤمنين ارتكاب المحرّمات عند الاضطرار; ولا يوجب هذا ولاية الحاكم على ارتكابها بدون تحقّق الموضوع ، وإنّما للحاكم ـ بناءً على ثبوت ما للنبي (صلى الله عليه وآله) من ولاية له ـ ما للمؤمنين من ولاية على بيع مالهم وطلاق أزواجهم ، بل وصرف أموالهم فيما يراه صلاحاً للاُمّة مجّاناً إذا اقتضته المصلحة ، وعزل وكلائهم ونصبهم ، وما إلى ذلك من أنواع التصرّفات والولايات الثابتة للناس على أموالهم وغيرها من أموال صبيانهم والمولى عليهم .
وأمّا فعل المحرّمات وترك الواجبات فلا ولاية للناس على شيء من ذلك ، فلا موجب لثبوت الولاية على ذلك للحكّام . فليس لهم أن يمنعوا من فعل الصلاة والصوم والحجّ ، ولا أن يرتكبوا المحرّمات بذريعة صلاح الاُمّة ، فيرخّصوا في شرب الخمر وفعل الفواحش ، أو إبطال الوقوف العامّة والخاصّة كالمساجد وغيرها حتّى إذا كان في ارتكاب الحرام مصلحة في الظاهر للاُمّة كتوسعة الشوارع والطرقات وتسهيل الأمر على الناس والسماحة لهم .
ولو ثبتت للمعصوم (عليه السلام) ولاية على فعل بعض المحرّمات لمصلحة الأمّة فلا دليل على ثبوت تلك الولاية لغيره من الحكّام .
وبالجملة: فالحكّام كغيرهم مكلّفون بترك المحرّمات وفعل الواجبات ، ولا يسوّغ تسنّم منصب الحكم الخروج عن قيد العبودية ، وعن إطلاق الأحكام وعمومها .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المتوقّع من الحاكم هو إدارة شأن الاُمّة ورعاية مصالحهم وإرغاد عيشهم وتهيئة سُبل المعيشة الهنيئة للناس ، وإن شئت فقل: هذه الاُمور شأن الحاكم عند العرف ، فلو تيسّر له الوصول إلى هذه النتائج بالأسباب المباحة فهو وإلاّ فيصدق عنده الاضطرار إلى المحرّمات ، بحيث لو بقيت المحرّمات
(الصفحة278)
على حرمتها صدق التحريم عند الضرورة عرفاً; وحديث حلّ المحرّمات بالاضطرار لا قصور فيه عن شمول مثل ذلك ، كشموله لغير الحكّام من موارد الاضطرار .
وإن شئت فقل : إنّ الاضطرار عنوان عامّ ، ويكون مصداقه مختلفاً ومتعدّداً بحسب الموارد . فربما تصدق الضرورة لأحد عند شيء بدون أن تصدق لغيره عند ذلك الشيء بعينه . ولا غرابة في ذلك ، فقد يكون الشخص ممّن يعدّ سبّه هتكاً لا يتحمّل بحسب العادة ، فيجوز له ارتكاب كذبة توجب التخلّص من ذلك; لحديث الاضطرار; وربما لا يتأثّر غيره عند التعرّض للسباب بأضعاف ذلك فضلاً عن كونه خارجاً عن تحمّله ، بحيث لا يعدّ إلزامه بالتحمّل أيّ حرج ، فلا يجوز له ارتكاب الكذب; كلّ ذلك لاختلاف شؤون الأشخاص .
وربما يكون نوع لباس أو مسكن أو مركب من شأن شخص ، بحيث يكون تركه هتكاً له لا يتحمّله المتعارف ، فيصدق أنّه مضطرّ إلى ذلك; فلو توقّف شراؤه ماء الوضوء أو فعله لبعض الواجبات على بيع شيء من ذلك لم يجب ، لصدق الاضطرار إلى ترك الواجب مع أنّه لا يصدق الاضطرار في حقّ غيره .
فإذا كان للحاكم أيضاً شأن خاص بحسب بناء العرف ، بحيث يعدّ التخلّف عن ذلك غير متوقّع منه ، وكان في رعاية بعض المحرّمات تخلّفاً عن ذلك الشأن ، يصدق أنّ الحاكم مضطرّ إلى فعل الحرام فيعمّه حديث الاضطرار .
وعلى هذا الأساس يمكن توجيه ولاية الحاكم على هدم المساجد والأوقاف لتوسعة الشوارع والطرقات ممّا فيه صلاح الأمّة وحاجتها ، بحيث تصدق ضرورة المجتمع عرفاً إلى ذلك .
فللمجتمع ضرورة كما للفرد ، وهذه الضرورة تختلف باختلاف الأعصار والأزمنة والمواقع من الأمصار والقرى وغيرها ، فحاجة البلاد إلى الشوارع
(الصفحة279)
الوسيعة غير حاجة القرى إليها ، فلا تصدق الضرورة إلى هدم المسجد في القرية مع صدقها في بعض البلاد ، والحاكم هوالقيّم على المجتمع والمتصدّي لزمام أمرهم ورعاية شأنهم فهو النائب عنهم والمتكفِّل بمباشرة أمورهم .
وعلى هذا الأساس فلو فرضنا أنّ تشريح الميّت كان حراماً مطلقاً إلاّ أنّه كان تتوقّف عليه الخبرة في الطب ممّا تتطلّبها ضرورة المجتمع ، جاز للحاكم الترخيص في ذلك; لقاعدة الاضطرار بالتقريب المتقدّم .
أوترى أنّه لو اضطرّ إنسان في حفظ حياته إلى أخذ عضو من الميّت للترقيع ، أو تقطيع بدن الميّت ليطّلع على مرضه فيعالج نفسه ، يجوز له ذلك ، ثمّ لا يجوز للمجتمع ـ وهم في معرض الوقوع في مثل ذلك المرض ـ فعل ذلك دفعاً له عن أنفسهم ، ولا تكون هذه ضرورة تبيح المحظورات؟!
(الصفحة280)
عود إلى أصل البحث
ثمّ إنّ دعوى كون الجزم بالعيب في الحمل ممّا لا يتيسّر عادةً ، ليس من شأن الفقيه; فإنّ تنقيح صغريات الأحكام ليس وظيفته وإنّما شأنه بيان الحكم على تقدير الموضوع .
مع أنّ المنع من حصول الجزم بتعيّب الحمل في مثل هذه الأزمنة ، حيث تطوّرت فيها وسائل الطبّ والمختبرات ، مجازفة .
أدلّة حرمة الإحبال مع الجزم بعيب الحمل
وكيف كان فما يمكن أن يكون دليلاً لتحريم الإحبال والمنع منه في الفرض وجوه :
الوجه الأوّل : دعوى كون المتفاهم العرفي من أدلّة حرمة الجناية على الإنسان ، هو حرمتها بالمعنى الأعمّ من الاسم المصدري ، فليس الممنوع هو خصوص إحداث الجناية بل المنع بلحاظ أثره ، فإذا نهى المولى عبده من جعل ولده أعمى أو أعرج أو مجنوناً ، ألا نفهم منه المنع من إحداث ولد بهذه الأوصاف ؟ وإذا نهى المولى عبده من جعل مائه أو غذائه مرّاً أو مالحاً، ألا يفهم العبدُ المنع من إيجاد ماء وغذاء لأكله وشربه كذلك ؟
وبالجملة : فلا يبعد كون المتفاهم العرفي من عموم أدلّة حرمة العدوان والجنايات ، هو حرمة ما يثمر آثارها . أو فقل: إنّ مدلولها حرمة آثارها مباشرة أو تسبيباً .
(الصفحة281)
الوجه الثاني : إنّه إذا وجب رفع مثل ذاك المرض ، فيما كان واقعاً في الخارج بغير استناد إلى شخص خاصّ ، فكيف لا يجب دفعه؟!
وإن شئت فقل : إنّ ما يقتضي وجوب معالجة المضطرّ برفع الضرورة ، يستدعي وجوب دفع الضرورة ، فإنّ المتفاهم من دليل وجوب إجابة المضطرّ هو عدم رضا الشارع ببقاء الناس في الضرورات ، مع وجود من يتمكّن من صرف ضروراتهم . فإذا كان كذلك فهل يحتمل ترخيص الشارع في إيجاد الضرورة أوّلاً؟!
واحتمال أنّه يجوز إيجاد الضرورة ثمّ يجب رفعها من قبيل فعل المجانين .
وعلى هذا الأساس يمكن الاستدلال للمدّعى ولوجوب معالجة المرضى ـ مع عجزهم المالي عن المباشرة ـ بما دلّ على أنّ الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء ، ولو علم أنّه لا يفي بهم لزادهم ، وأنّ العلّة في تشريع الزكاة رفع حاجة الفقراء(1) .
فإنّ من جملة مؤونة الفقير والذي يجب رفعه بدفع الزكاة ، مؤونة علاج مرضه . ومن وجد كلّ مؤونته عدا مؤونة العلاج عدّ فقيراً . فهلاّ ينافي ما دلّ على وجوب تمكين المريض من الزكاة لعلاج نفسه ، مع جواز التسبيب إلى مرض لا يتمكّن من رفعه ؟!
الوجه الثالث: وقد يستدلّ لجواز التسبيب إلى الحمل المعيوب بما ورد من كراهة جملة من كيفيّات الجماع ، معلّلاً باقتضائها عيباً في الحمل الناشئ منه . من
- (1) قد يتوهّم دلالة مثل هذه الأحاديث على وجوب بذل غير الزكاة على الغني عند حاجة الفقير وتخلّف بعض الأغنياء عن أداء ما عليهم من الزكاة ، لوجوب رفع حاجة الفقير .
- ويردّه: أنّ هذا الوجوب انحلالي ، فعلى كلّ غني رفع بعض الحاجات بما عليه من الزكاة ، وأنّ رفع حاجة الفقراء علّة هذا الجعل المنحلّ والمتعدّد ، لا أنّ هناك جعل بسيط واحد حتّى لا يمتثل إلاّ بموافقة الكلّ . ويشهد لما ذكرنا سيرة المتشرّعة من متديّني الأغنياء على عدم بذل عامّة أموالهم والاكتفاء لأنفسهم بمقدار الضرورة .
(الصفحة282)
جنون أو عمى أو خرس أو غيرها .
بل ورد أنّ بعض الأفعال منشأ لسقط المولود ، ولم يحتمل فقيه كون ذلك الفعل محظوراً; لكون السقط المعلول له محرماً .
ففي رواية عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمّد العسكري ، عن آبائه (عليهم السلام)في حديث : «من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد»(1) .
ونحوه خبر الجعفري(2) .
وهل هناك مجال لاحتمال ضمان الفاعل ، في هذه الموارد لكونه سبباً للإسقاط وغيره ممّا يعدّ جناية لو وقعت بعد انعقاد الحمل والولد ؟!
قلت : أمّا حديث الضمان فلو كان مثل السقط مستنداً بطور الجزم إلى الشخص فغير بعيد.والغرض من الجزم بالاستناد هو كون الفاعل هو العلّة والسبب في وقوعه، ولم يحتمل دخل شيء آخر في تحقّقه بما يوجب سلب الاستناد إلى هذا المكلّف .
ويتفرّع عليه أيضاً استناد فعل الحرام إلى المكلّف وإن كان ظرف تحقّقه منفصلاً عن زمان تحقّق السبب ، حيث لا يشترط في استناد فعل الحرام وقوعه مقارناً لفعل المكلّف . ألا ترى أنّ من نصب كميناً لقتل نفس محترمة فقتله بعد سنة اقتصّ منه وكان الحرام مستنداً إليه .
غير أنّ استناد هذه الآثار الواردة في الأخبار إلى المكلّف، بنحو استناد أسباب الضمان وغيرها ، غير معلوم; وذلك لاحتمالين :
الأوّل : كون الأفعال المكروهة منشأً لوقوع الآثار الخاصّة بما لا يستند إلى الفاعل بل إلى شخص آخر ، كالذي يصطلح عليه في العرف بالأثر الوضعي ، من
- (1) الوسائل 14: 80 ، الباب 54 من مقدّمات النكاح ، الحديث 3 .
- (2) نفس المصدر: 90 ، الباب 63 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
(الصفحة283)
قبيل ما يقال: من زنى بامرأة الغير وُطئ فراشه . أفهل ترى أنّ زناه يوجب استناد زنا الثاني إليه ؟!
أو يُقال : من ظلم يتيماً ظلم في أيتامه ، أفهل ترى أنّ ظلم الثاني يستند إليه؟!
فليكن الارتباط بين الأفعال الواردة في النصّ والآثار والعيوب المترتّبة عليها من هذا القبيل .
ويؤكّده ما ورد من أنّ «من جامع في محاق الشهر كان الولد عشّاراً أو عوناً للظالمين ويكون هلاك فئام على يده»(1) .
فهل ترى استناد جنايات الولد في العرف إلى أبيه حينئذ مع كونه مختاراً ؟
الثاني : قوّة احتمال كون تأثير ما ورد في الأفعال الخاصّة من بعض العيوب ، من قبيل المعدّ والمقتضي دون العلّة التامّة ، فكانت الآثار غير مستندة عرفاً تمام الإستناد إلى الفاعل بما يوجب الضمان ونحوه .
توضيح للأخبار المتضمّنة للآثار الوضعيّة وحكم تخلّف بعضها
هذا باب يتّضح به الكلام في جملة من الأخبار الواردة في تأثير بعض الاُمور في بعض الأشياء ، كتأثير بعض الأفعال في طول العمر أو قصره أو وقوع بعض الحوادث; فإنّه ربما يشكل على الناس الأمر عند تخلّف هذه الآثار عن تلك الأفعال .والحلّ: هو أنّ التأثير إنّما هو بنحو المقتضي أو بعضه ، فلا ينافي التخلّف أحياناً . مثلاً ربّ معصية توجب بلاءً للمكلّف ، إلاّ أنّ المكلّف ربما تصدّق بعده أو عمل عملاً آخر ، أوجب عدم وقوع ذاك البلاء .
- (1) الوسائل 14: 90 الباب 63 من مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
(الصفحة284)
ومن قبيله ما ربما أخبر به بعض الأنبياء (عليهم السلام) من وقوع بعض الاُمور أو العذاب فيما يأتي مع تخلّف ذلك عن أخبارهم لتوبة أو غيرها كما في قوم يونس (عليه السلام) .
ويؤكّد ما ذكرنا: ما ورد في الجماع في محاق الشهر من تسليمه لسقط الولد ، مع ما ورد من أنّه إن قضي له ولد كان عشّاراً أو كذا(1) .
دلالة الحديث على عدم جواز التسبيب إلى الحمل المعيوب
يمكن أن يقال : إنّه لا موجب لحمل بعض النواهي من هذا القبيل في الأخبار على الكراهة وإن كان مشهوراً; وذلك مثل ما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : «لا ، ولكن إن كانت عنده مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها»(2) .
فأيّ مانع من الالتزام بحرمة استيلاد المجنونة بعد ظهور الدليل؟!
بل ظاهره حرمة التزويج بالمجنونة بل فساده; فإنّ استعمال «لا يصلح» في الأخبار بمعنى التحريم والفساد شائع .
أو ترى أنّ المشرّع الإسلامي مع حثّه على اختيار الزوجة الكريمة الأصل المحمودة الصفات والترغيب في الاختيار للنطف ، لكون الخال أحد الضجيعين والتحذير من خضراء الدمن ـ المرأة الحسناء في منبت سوء ـ والتدليل على أنّ الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في البربر والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا
- (1) راجع الوسائل 14: 90 ، الباب 63 من مقدّمات النكاح .
- (2) الكافي 5: 354 باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ، الحديث 3 .
- الوسائل 14: 57 الباب 34 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
(الصفحة285)
لنطفكم ، فهو مع رعايته لصفات الأولاد الموروثة ، لا يرعى تمام الأعضاء ولا يحذر من تعريض الأولاد بالعيوب والنقائص والجنون وما شاكله !
وعلى هذا الأساس ربما يدّعى العلم بمذاق الشارع وعدم رضاه بمثل ذلك; والكاشف عنه هذه الطوائف من الأخبار الناهية ولو بنحو الكراهة عن جملة من الاُمور التي ذكرنا أنّ تأثيرها في العيوب من قبيل المعدّ لا الجزم وتمام السبب ، وهذا ثالث الوجوه للدلالة على تحريم الاستيلاد في المسألة .
وكيف كان فلا تنافي هذه الأخبار ، على الأقلّ ، حرمة هذا القسم من الاستيلاد .
الوجه الرابع: ممّا يمكن الاستدلال به لحرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب هو كونه مصداقاً للفساد في الأرض الذي هو مبغوض للمشرّع الإسلامي منهيّ عنه; قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِى الاَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ}(1).
والآيات الدالّة على ذلك غير قليلة في الكتاب ، وفي بعضها: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الاَْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ}(2)، وفي اُخرى خطاباً لقارون: {وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَْرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} إلى قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الاْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى الاَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(3). إلى غير ذلك من الآيات.
وهذا الدليل ممّا يمكن الاستدلال به لحرمة تعييب النطف قبل التلقيح، كما يمكن الاستدلال به لحرمة التصرّف في أعضاء البدن بما يوجب الفساد كقطع اليد أو
- (1) سورة البقرة الآيتان 11 و 12.
- (2) سورة البقرة الآية 205.
- (3) سورة القصص الآيات 77 ـ 83 .
(الصفحة286)
الرجل أو ما شاكل ذلك ما لم يكن لغرض عقلائي كالترقيع بالغير ونحوه.
كما وبه يمكن الاستدلال لحرمة تضييع الأموال والأشياء وإن لم تكن مالاً عرفاً، كتلويث الهواء وقطع الأشجار بلا غاية مطلوبة، وكإهدار المعادن وتلويث البحار والأنهار وسائر المياه الصالحة للشرب وغيره من الاستعمالات.
ففي رواية الصدوق عن أبي هشام البصري الذي جزم الصدوق (قدس سره) بنسبتها إليه إلاّ أنّ هشاماً مجهول، عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى»(1).
وفي موثّق إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى الإسراف، فقال: «ثوب صونك تبتذله ، وفضل الإناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا وهكذا»(2).
وفي الموثّق عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز في حديث: «إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن»(3)، ونحوه قوية إسحاق عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (4).
وفي قوية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ، فقال: «لا بأس; إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد» الحديث(5).
وفي مرسلة الكليني عن عبد الرحمن بن الحجّاج ـ الذي استظهر في روضة المتّقين أنّه أخذه من كتابه واتّحاد سنده مع سند صحيحه ـ ويقوى عندي صحّة
- (1 ، 2) روضة المتّقين 6 : 454 .
- (3) نفس المصدر : 455 .
- (4) نفس المصدر : 456 .
- (5) نفس المصدر : 455 ـ 456 .
(الصفحة287)
الخبر وإن لم يثبت ما استظهره المجلسي(1)ـ قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت; فقلت له: إنّ النّاس يكرهون ذلك; قال: «لا بأس به»(2).
قال المجلسي (قدس سره) بعد ذكر الأخبار المتقدّمة وغيرها: «ظهر من هذه الأخبار أنّ الإفساد إسراف سيّما إذا أضرّ بالبدن، وإذا نفع البدن فليس فيه إسراف. أمّا إذا لم ينفع ولم يضرّ كالأكل زائداً على الضروري ومثل التنباكو الذي اشتهر في هذا الزمان واعتاد النّاس به، وأمثالهما ممّا لا يحصى (ففيه ـ ظ) نظر»(3).
- (1) قد استظهرنا صحّة ما جزم به الثقاة من المراسيل وأسندوها إلى الإمام كالمسانيد بلا فرق بين مراسيل الصدوق وغيره من مراسيل الكليني والشيخ في النهاية وغيرها وابن إدريس وسائر السابقين ممّن يحتمل كون جزمهم بالخبر مبنيّاً على الحس لا الحدس، وقد استدللنا لذلك بوجوه:
- منها: إطلاق ما دلّ على اعتبار أخبار الثقات عن المعصومين (عليهم السلام).
- ومنها: عموم بناء العقلاء على حجّية خبر الثقة لمثله; بناءً على أصالة الحسّ عند تردّد الخبر بين كونه حسّياً أو حدسيّاً.
- ومنها: أنّه لولا ذلك لم يكن أخبار المزكّين كالشيخ والنجاشي حجّة لبنائها على الإرسال عادةً.
- ومنها: غير ذلك، وسنوافيك بتفصيل ذلك وتحقيقه فيما يأتي من الجزء الثاني من هذه الموسوعة إن شاء الله تعالى.
- (2) روضة المتّقين 6 : 455 .
- (3) نفس المصدر: 456.
(الصفحة288)
المسألة السادسة: تجب مداواة الحمل في الجملة(1) .
(1) إذا مرض الحمل ففي وجوب مداواته تفصيل:
فقد يفرض المرض مميتاً أيّام الحمل أو بعد الولادة ، وقد لا يوجبه .
وعلى الثاني: فإمّا أن يكون ترك مداواته موجباً لثبات المرض وعدم إمكان مداواته فيما بعد ، وقد لا يكون كذلك .
وعلى الأوّل فقد يكون المرض من الأمراض الصعبة الموجبة للعمى ونحوه من الزمانات ، وقد يكون يسيراً كحمّى ونحوه .
وعلى التقادير فقد يكون الابتلاء بالمرض قبل حلول الروح في الحمل وقد يكون بعده .
كما وعلى كلّ الفروض قد يكون المرض بسبب مكلّف ونحوه، وقد لا يكون مستنداً إلى شخص على وجه مضمون .
ثمّ السبب قد يكون هو الاُمّ وقد يكون غيرها :
تسبيب غير الأم لمرض الحمل ووجوب علاجه عليه
الظاهر إنّه كالتسبيب إلى المرض في غير الحمل ، فلو وجبت المداواة هناك وجبت هنا حيث تطالب الاُمّ ، بل وبدون المطالبة على ما يأتي إن شاء الله تعالى ،
(الصفحة289)
فينبغي ملاحظة الحكم في غير الحمل .
والذي يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة هو وجوه أشرنا إليها على الإجمال فيمن قطع عضوه بجناية وأنّه هل يجب مداواته وترقيعه ؟
والظاهر عند الفقهاء أنّ الجناية بقطع عضو أو تمريض موجب للأرش في الحيوانات من الماليات وكذا في العبيد والمماليك .
وأمّا في الحرّ فليس ببالي التعرّض له في كلماتهم ، ومقتضى بعض ما قدّمناه من الوجوه في المسألة الثالثة من الباب الأوّل هو وجوب المعالجة ، بل تقدّمها على الدية وإن زادت نفقتها على الدية .
دليل وجوب المعالجة على الجاني
ويؤكّده بناء العقلاء على تغريم الجاني نفقة مداواة الجناية حيث أمكنت .
ولا فرق في وجوب المداواة حينئذ بين أنواع الأمراض المتقدّمة ، ولا بين الطفل الحيّ والذي لم تلجه الحياة .
نعم ، في المملوك من إنسان أو غيره ربما كان المتعيّن عندهم الأرش لا قيمة المداواة ، فإنّها ربما تبلغ قيمة الأصل أو أكثر ، فإنّ قصارى ما يضمنه الجاني هو قيمة الجناية في المماليك كسائر الأعيان المملوكة .
عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه
- (1) الوسائل 19: 303 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
(الصفحة290)
وكان يمكن ترميمه ببذل ضعف قيمته لم يجب وانحصر حقّ المالك في قيمة متاعه . وكذا لو تعيّب بساط وكان يمكن رفع العيب عنه ببذل مال كثير أكثر من ثمن الأصل فيما كان للمالك غرض في نفس العين ، فإنّه لا يجب على الجاني إجابته في ذلك ، فتأمّل .
نعم ، احتملنا سابقاً وجوب رفع أثر الجناية حيث أمكن ، بناءً على أنّ القيم بدل ولا تصل النوبة إلى الأبدال مع إمكان تسليم نفس الأشياء .
نعم ، هنا شيء ، وهو أنّ ظاهر الفقهاء تعيّن حقّ المالك في المطالبة بالأرش ، وظاهر بعض النصوص إلزام الجاني بدفع قيمة العين بعد ردّ العين على الجاني ، ومقتضى المجموع هو تخيير المالك بين الأمرين; جمعاً بينه وبين ما دلّ على تعيّن الأرش .
ففي رواية عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها؟ قال : «يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها ، وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به فإنّه يلزمه أكثر الثمن; لأنّه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها»(1) .
ونحوه الحديث 6 ممّا ذكره صاحب الوسائل في الباب ويأتي .
والظاهر أنّ التعليل بالإفساد ولاستفسادها ، لأخذه بالأكثر من الثمن المسمّى والقيمة السوقية ، فهو من قبيل ما اشتهر أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ممّا لم نعثر فيه على نصّ خاص ، ولعلّه متصيّد من هذا الخبر ونحوه .
- (1) الوسائل 18: 390 ، كتاب الحدود ، الباب 22 من حدّ الزنا ، الحديث 4 .
(الصفحة291)
ومورد الخبر هو عيب خاص هو الثيبوبة أو لزوم العدّة ، والظاهر هو الأوّل; بقرينة التعليل بأنّه أفسدها على البقيّة ، ولم يُفصّل بينها وبين سائر العيوب ، فلا يبعد إلغاء الخصوصيّة وإلاّ فما ورد من الأرش في العيوب أيضاً مورده خاصّ .
إلاّ أن يحتمل خصوصيّة في الوطئ كما في الصحيح عن عمرو بن عثمان عن عدّة من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطأها قبل أن يقسم ، قال: «تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحطّ له منها ما يصيبه من الفيء ويجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها» فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره؟ قال: «لأنّه وطأها ، ولا يؤمن أن يكون ثمّ حبل»(1) .
هذا ولكن الظاهر أنّه لا ينافي عموم الحكم لغير الوطئ .
ويمكن التعدّي عن مورد الخبر إلى سائر العيوب بالتعليل الوارد في رواية ابن سنان فإنّه وإن كان لأخذ الواطئ بأكثر القيميتين، ولكن يلوح منه أنّ منشأ أخذه بالقيمة هو الإفساد أيضاً; حيث إنّه موجب لأخذه بالقيمة وزيادة .
وربما كان مورد الخبر هو الإحبال ، فيكون الإفساد على الشركاء بمعنى الانعتاق عليهم قهراً حيث تكون الأمَة أُمّ ولد للواطئ فتنعتق حصّته ، ويسري العتق إلى البقيّة بالسراية .
ويؤيّده رواية إسماعيل الجعفي(2) . ومعه فتكون الرواية أجنبية عن المدّعى .
- (1) نفس المصدر ، الحديث 6 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 8 .
(الصفحة292)
(الصفحة293)
الباب الثالث :
مسائل في التلقيح الصناعي
(الصفحة294)
(الصفحة295)
المسألة الأولى: هل يجوز تلقيح النطفة بغير رحم الزوجة ومن بحكمها كالمملوكة؟ وهل يجب على المرأة التجنّب عن نطف الأجانب؟ في المسألة تفصيل(1) .
(1) من جملة المسائل المعاصرة المطروحة أخيراً بشيوع قضيّة تلقيح النطف بغير الصورة الطبيعيّة المألوفة ، أعني الجماع . والبحث عمّا يتعلّق به من أحكام من الحلّ وغيره ، والآثار من النسب وغيره .
وقبل التعرّض للحكم لابدّ من بيان الموضوع وأقسامه; تمهيداً للتعرّض لحكم المسألة فنقول وعلى الله التكلان :
أقسام تلقيح النطفة
قد يكون تلقيح النطفة بالأرحام ، وقد يكون بغيرها من الأنابيب الصناعيّة ، وعلى التقديرين قد تكون النطفة الملحقة مأخوذة من إنسان ، وقد تؤخذ من غيره من حيوان أو شجر أو غيرهما ، كما أنّ البويضة الملقّحة قد تكون مأخوذة من إنسان وقد تؤخذ من غيره من حيوان أو شجر أو غيرهما لو أمكن .
والرحم التي تلقحها النطفة قد تكون من الفروج المحلّلة بالزوجيّة أو ملك اليمين وغيرهما ، وقد لا تكون فرجاً محلّلاً كالمحارم والأجنبيّة ، كما أنّه بعد التلقيح في
(الصفحة296)
الرحم قد يستمرّ تربيتها في ذلك الرحم ، وقد تنقل منها إلى رحم أو أنبوب صناعي .
وفي موارد التلقيح خارج الرحم ، قد يستمرّ تربية اللقاح خارج الرحم ، وقد ينقل بعد تلقيح النطفة بالبويضة إلى رحم .
كما أنّ النطفة الملقّحة للبويضة خارج الرحم قد تنقل إلى الرحم بمجرّد التلقيح قبل التحوّل إلى مرحلة العلقة وغيرها ، وقد يكون النقل في المراحل المتأخّرة .
مقتضى الأصل في تلقيح النطف
غير أنّ هناك أصلان ربما يدّعى مزاحمتهما للأصل الأوّلي بما يقتضي الحكومة أو الورود عليها في الجملة ، ولابدّ من التعرّض لهما وملاحظة تماميتهما وموارد جريانهما :
الاُولى : أصل الاحتياط في الفروج .
والثانية : حفظ الأنساب من الاختلاط .
أصالة الاحتياط في الفروج ودعوى الإجماع عليها
(الصفحة297)
بل ويظهر من صاحب الجواهر مخالفته في وجوب الاحتياط صريحاً ، قال في ردّ الاستناد إليه في بطلان المتعة مع انفصال المدّة عن العقد : «وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أوّلاً ، وعدم تماميّتها في القول بالبطلان ثانياً »(1)انتهى .
ويظهر من ملاحظة سائر كلماته (قدس سره) ـ في موارد عدّة أيضاً ـ أولويّة الاحتياط في الفروج لا وجوبها ، ولم يستند ولا في مورد واحد لإثبات حكم إلزامي إلى القاعدة فيما حضرني وعثرت عليه من كلماته .
نعم ، قال في جامع المقاصد في توجيه حرمة بنت الزنا على أبيه وإن لم يثبت النسب: «لأنّ حلّ الفروج أمر توقيفي فيتوقّف فيه على النصّ، وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحلّ ، فلا يكفي في حلّ الفروج عدم القطع بالمحرم; لأنّه مبنيّ على كمال الاحتياط»(2) .
وفي الوسائل عنون الباب 157 من مقدّمات النكاح هكذا :
وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره . ثمّ ذكر بعض ما تعرّضنا له من الأخبار ثمّ قال : «وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جدّاً يأتي بعضها في القضاء» .
الاستدلال لأصل الاحتياط في الفروج بمذاق الشرع
أمّا الاستناد في ذلك إلى معرفته من مذاق الشرع فهو نوع تهجّس لا يصلح مستنداً للحكم ما لم يتحقّق ذلك بمراجعة الأدلّة اللفظية الحاكية عن ذلك بنوع من الحكاية . هذا مع أنّ تعبيرهم عن القاعدة في مقامات الاستشهاد ربما يوحي
- (1) الجواهر 30: 178 .
- (2) جامع المقاصد 12: 192 .
(الصفحة298)
بأخذها مؤيّداً لا دليلاً .
والمنساق من بعض كلمات الجواهر أيضاً كون الاحتياط في الفروج مستحبّاً لا واجباً إلاّ أنّ استحبابه هنا آكد من سائر الموارد .
نصوص أصل الاحتياط في الفروج
وكيف كان فالعمدة مراجعة النصوص وهي عدّة :
1 ـ معتبرة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى وأنا اُختك من الرضاعة وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : «إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها; وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك» .
وفي رواية الصدوق مثله إلاّ أنّه قال : «فليحتط وليسأل عنها»(1) .
وقد تضمّن هذا الخبر الأمر بالاحتياط في بعض فروض النكاح ممّا يكون مجرى أصل موضوعي حاكم بالحلّ ، أعني استصحاب عدم الرضاعة وعدم الحمل وعدم العدّة . والظاهر أنّ الاُمور المذكورة في النصّ من باب المثال ، وغرض الراوي أنّ المرأة أخبرت بما يوجب حرمة النكاح والفرج على الرجل ، ففصّل (عليه السلام) في الجواب بين ما بعد الدخول ، فلا أمر بالاحتياط وأمّا قبله فهو مأمور بالاحتياط .
2 ـ صحيح العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وكّلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل فقَبِلَ الوكالة ، فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوّجها ، ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها
- (1) الوسائل 14: 223 ، الباب 18 من عقد النكاح ، الحديث 1 .
(الصفحة299)
عزلته ؟ فقال : «ما يقول من قِبَلكم في ذلك ؟» قال : قلت يقولون: ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوّجها فالتزويج ثابت على ما زوّج الوكيل وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة» .
قال: ثمّ قال: «يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟!» .
قلت: نعم، يزعمون أنّها لو كانت وكّلت رجلاً وأشهدت في الملأ ، وقالت في الخلأ (الملأ . يب): اشهدوا أنّي قد عزلته (و ـ خ) ، أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة; وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون: المال ، منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد . فقال (عليه السلام) : «سبحان الله ، ما أجور هذا الحكم وأفسده! إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد . . .» الحديث .
ثمّ استشهد (عليه السلام) بقضيّة من أمير المؤمنين أثبت فيها الوكالة في النكاح فيما لم يعلم الوكيل بالعزل(1) .
ومورد الخبر الاحتياط في الشبهة الحكمية كما هو ظاهر ، وليس شأن الإمام (عليه السلام) الاحتياط فيها لكونه ناشئاً عن الجهل ، والإمام (عليه السلام) عالم بالأحكام ، وكأنّ جواب الإمام (عليه السلام) ناظر إلى إلزام العامّة وأنّه إذا كان منشأ الفتوى عندهم الاحتياط ، فأحرى أن يكون الاحتياط في الفتوى في باب الفروج ومسائلها .
وبالجملة : لا يدلّ الخبر على لزوم الاحتياط في الفروج ، وإنّما هو دالّ على أنّ الاحتياط حيث يكون مطلوباً لزوماً أو بدونه فهو في الفروج آكد .
- (1) الوسائل 13: 286 ، الباب 2 من الوكالة ، الحديث 2 .
(الصفحة300)
ثمّ إنّ هناك كلاماً في تفسير الخبر من حيث تطبيق الاحتياط فيه على مورد النكاح مع أنّ أمر النكاح دائر بين محذورين.
وربما اُفيد أنّ المنظور فيه هو كون الحكم بصحّة النكاح أقلّ محذوراً من الحكم بفساده على تقدير المخالفة للواقع; فإنّ نهاية ما يقتضيه الحكم بالصحّة في فرض الفساد هو مجامعة الرجل مع المرأة الخالية من البعل ، بينما أنّ الحكم بالفساد في فرض الصحّة واقعاً يستدعي الترخيص في مجامعة المرأة ذات بعل مع الأجنبي .
والخبر مورد تعرّض المحدّثين والفقهاء، فقد ذكره الشيخ الأنصاري في بحث الفضولي من المكاسب وتبعه المعلقّون .
3 ـ معتبرة شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل من مواليك يقرئك السلام ، وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : «هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها»(1) .
ومورد الخبر أيضاً الشبهة الحكميّة ، مضافاً إلى أنّ المطلّقة على غير السنّة إذا كانت من موارد قاعدة الإلزام فيصحّ تزويجها، وفي غيرها فهي ذات بعل كما علم من سائر الأدلّة ، وعليه فالاحتياط بالمعنى المصطلح غير لازم ، بل غير معقول من العالم بالحكم وهو الإمام (عليه السلام) .
وكأنّ التعبير بالاحتياط مبنيّ على التقيّة; حيث إنّ العامّة يعترفون للإمام (عليه السلام) بالفقه ، فكان حكمه (عليه السلام) في المورد وتعبيره مبنيّاً على مبانيهم في الفتاوى والأحكام ، وإن كان تعبيرهم للجهل بالأحكام ، والإمام (عليه السلام) عالم .
- (1) الوسائل 14: 193 ، الباب 57 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
(الصفحة301)
والمعنى: إنّه لمّا كان أمر الفرج شديداً فحيث لا جزم للفقيه بالحلّ لابدّ له من الاحتياط .
ويمكن أن يقال : إنّه يستفاد من الخبر ـ بغضّ النظر عن تطبيقه على المورد الخاصّ ـ قاعدة كلّية هي لزوم الاحتياط على الأقلّ في الشبهات الحكمية للفروج وإن كانت هذه القاعدة لا مصداق لها في حقّ الإمام (عليه السلام) لعلمه ، فيكون التطبيق للتقيّة أو غيرها ، وأمّا الكبرى فهي حكم واقعي مبنيّ على لزوم الاحتياط دون الاستحباب ، بقرينة النهي عن التزويج مبنيّاً على تلك القاعدة الظاهر في التحريم والإلزام .
إلاّ أن يكون الخبر ناظراً إلى الشبهات قبل الفحص كما هو مورد أحكام أهل السنّة آنذاك ، ومعه فتكون الرواية قاصرة عن إثبات المدّعى ، فتأمّل .
ثمّ إنّ كون أمر الفرج شديداً ، كأنّ المراد به أنّه معرض الهلكة والخطر والمفسدة المهمّة وفساد الولد ممّا يستدعي الاحتياط ، أو المراد كون الفرج منشأ الولد ، فهي معرض اختلاط الأنساب بسبب المواقعة بدون رعاية العدّة والطلاق الصحيح .
4 ـ معتبرة مسعدة بن زياد ، عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة . يقول : إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها وأنّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»(1) .
والإنصاف أنّ هذا الخبر كالخبر الأوّل في وضوح الدلالة بل أوضح ، حيث فرض الموضوع فيه الشبهة ، وهي تصدق في موارد اشتباه الحكم والموضوع ، وقد أمر بالتوقّف عن المضيّ والعمل عند الشبهة كناية عن الاحتياط ، فلو تمّ هناك دليل
- (1) نفس المصدر ، الحديث 2 .
(الصفحة302)
عام على البراءة في الشبهات ، خصّ بغير النكاح; جمعاً بين العامّ والخاصّ .
نعم ، لابدّ من رفع اليد عن ظهور الخبر في لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة للنكاح; جمعاً بينه وبين ما دلّ بالخصوص على عدم وجوب الاحتياط في مثلها ، كمعتبرة مسعدة بن صدقة المتضمّنة لقاعدة الحلّ وتطبيقها على مثل ذلك في قوله : «وذلك مثل الثوب عندك ولعلّه سرقة، والمرأة تحتك ولعلّها اُختك أو رضيعتك»(1) .
نعم ، هناك شيء ، وهو أنّه لولا تطبيق الإمام القاعدة على الشبهات الموضوعية في رواية مسعدة بن زياد ، لم نحكم بكراهة ترك الاحتياط; حيث إنّ مقتضى التخصيص خروج الخاصّ عن العام بالمرّة . وظهور العامّ في الحكم الإلزامي; وحيث خرج الخاصّ عنه فثبوت حكم من قبيل الكراهة بحاجة إلى دليل .
ولكن تطبيق الإمام (عليه السلام) القاعدة على المورد ، يقضي بعدم خروج هذا الخاصّ عن تلك الكبرى; وحيث إنّ الحكم في الخاصّ ليس إلزاميّاً فقد يتوهّم سراية حكم الخاصّ إلى العامّ ، وكون المراد من النهي العامّ عن الجماع عند الشبهة الكراهة ، وإلاّ لم يكن معنى لتطبيق الحكم الإلزامي على مورد غير إلزامي; ولا أقلّ من الإجمال حيث يدور الأمر بين كون النهي للكراهة عموماً أو اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة .
ولكن هذا التوهّم فاسد; فإنّ تطبيق العموم على المورد لا يستلزم أيّ إجمال ولا قصور في الدلالة على المدّعى ; والسرّ في ذلك أنّ النهي منحلّ بعدد الموارد ، فللشبهة الموضوعية نهي وللحكميّة نهي آخر ، بل ولكلّ مورد من الشبهات
- (1) انظر نصّ الرواية في الكافي 5: 313 ، الحديث 40 .
(الصفحة303)
الحكمية والموضوعية نهي مستقلّ ، فإذا حمل بعض هذه النواهي على غير الإلزام لم يكن موجب لحمل البقيّة على مثله; حيث لا يكون التطبيق مفيداً للحصر ولا هو بصدده .
فهذا من قبيل الأمر بأشياء قام الدليل من الخارج على عدم وجوب بعضها، كما لو قال : اغتسل للجمعة وللجنابة وللمسّ ويوم العيد ، فهل أنّ عدم وجوب بعض هذه الأغسال يقلب ظهور الأمر من الأساس في هذا المورد إلى غير الوجوب أو يسقط ظهوره في الوجوب عن الحجّية رأساً ؟!
إن قلت : كما أنّ الجمع يتحقّق بحمل النهي في بعض الموارد ـ كالأمر ـ على غير الإلزام ، يتحقّق بحمل النهي على غير الإلزام من الأساس ، وإن شئت فقل : لابدّ إمّا من التصرّف في ظاهر النهي بحمله على الكراهة أو في ظاهر متعلّقه بحمله على غير العموم وحيث لا مرجّح يعود الكلام مجملاً .
قلت : المرجّح موجود; وذلك لأنّ الجمع لابدّ أن يكون في موضع المنافاة والاختلاف ، ولمّا كان النهي منحلاًّ بعدد الموارد وقام الدليل على عدم الحكم الإلزامي في بعض الموارد لم يكن مناص من حمل النهي على غير ذلك المورد قضيّة للتخصيص ، ولكن حيث دلّ الدليل على شمول النهي العامّ لذلك المورد لم يكن مناص من حمل النهي في مورده على الكراهة ، فافهم واغتنم .
موارد قاعدة الاحتياط في الفروج
تظهر ثمرة قاعدة الاحتياط في الفروج فيما كان مقتضى القاعدة لولاها ، البراءة والحلّ . وفي موارد الشبهة الحكميّة إمّا يكون هناك عموم أو إطلاق يقتضي حلّ المشتبه أو حرمته ، فلا مجال للقاعدة معه بعد حكومة العمومات والإطلاقات على أدلّة الاُصول العملية التي منها الاحتياط ; أو لا يكون.
(الصفحة304)
فإن كان الشكّ في صحّة النكاح فالأصل فيه كسائر المعاملات الفساد كما هو المعروف . وإن كان الشكّ في جواز الجماع كما في موارد اشتباه الدم بالحيض بشبهة حكميّة: فإن كان للمرأة حالة سابقة من طهارة أو حيض وقلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة أو لم نقل ففي تقدّم قاعدة الاحتياط وعدمه إشكال .
أمّا إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فالظاهر تقدّم القاعدة على عموم دليل البراءة; لكون القاعدة أخصّ من دليل البراءة حتّى المختصّة بالشبهات الحكميّة فإنّ موردها النكاح .
وأمّا مع جريان الاستصحاب ففي تقدّم القاعدة على الاستصحاب أو العكس أو التساقط ، احتمالات .
وحكم القاعدة في تقدّمها على الاستصحاب هو حكم أصل البراءة; والمعروف تقديم الاستصحاب في الشبهات الحكميّة أيضاً ، غير أنّ تقديم الاستصحاب ربما يوجب إلغاء قاعدة الاحتياط فينبغي تقديم الاحتياط .
هذا ، ثمّ إنّ المتيقّن من الاحتياط في الفروج هو ما كان احتمال حرمة الفرج ناشئاً من عدم صحّة النكاح والعقد . وأمّا إذا كان ناشئاً من جهة اُخرى كاحتمال الحيض ففي عموم دليل الاحتياط المؤكّد في الفروج لمثله إشكال ، بل لعلّه ممنوع .
إشكال قاعدة الاحتياط في الفروج ودفعه
قد يشكل في المقام بأنّ قاعدة الاحتياط في الفروج لا مورد لها في الشريعة بتقريب: أنّ مورد الشكّ إمّا أن يكون الشكّ في صحّة النكاح بشبهة حكمية ، كالشكّ في حرمة امرأة رضعت عشر رضعات، فهو مورد عموم {وأُحِلَّ لَكُمْ مَا
(الصفحة305)
وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(1) وبدونه فالمرجع أصل الفساد، كما في موارد الشبهة المفهوميّة في الاُمومة كالأرحام المستأجرة .
أو يكون الشبهة في الموضوع فهوموردالأصل المنصوص بالخصوص في الأخبار التي منها خبر مسعدة وغيره من معتبر الأخبار إن كان الشكّ في الأخوة ونحوها; وإن كان الشكّ في الزوجيّة فالأصل عدمها; فلا يبقى مورد للاحتياط بنحو اللزوم .
وإن شئت فقل : إنّ أصل الاحتياط إنّما يرجع إليه حيث يحتمل الرجوع إلى أصل البراءة ولا مورد في النكاح والفروج ، تصل النوبة إلى أصل البراءة ، ليكون أصل الاحتياط محكّماً بدليل خاصّ .
ويردّه: أنّ هناك موارد يشكّ في صحّة النكاح بشبهة حكميّة أو موضوعيّة ليس فيها أصل أو عموم مرخِّص .
أمّا الشبهة الموضوعيّة فكموارد توارد الحالتين من زوجيّة وطلاق مع الشكّ في السابق منهما .
وأمّا الشبهة الحكميّة فكموارد الشكّ في صدق بعض العناوين المحرّمة للشبهة في المفهوم ، كالشكّ في صدق الاُمّ على خصوص الحامل للولد مع كون النطفة من امرأة اُخرى ، والشكّ في صدق الولد بالنسبة إلى من أخذت منه خليّة مولّدة غير المني ولقّحت به البويضة .
مضافاً إلى ما تضمّنه النصّ المتقدّم من التفصيل بين ما قبل الجماع وبعده حيث عرض الشكّ في حلّ المرأة بشبهة موضوعيّة .
هذا ، مع أنّ وجود أصل فساد النكاح الموافق لأصل الاحتياط ـ في بعض الفروض ـ لا يمنع من جريان أصل الاحتياط .
- (1) سورة النساء الآية 24 .
(الصفحة306)
وبالجملة: يكفينا لتوجيه الاحتياط في الفروج موارد النصّ المتقدّم .
مضافاً إلى أنّه قد يكون المورد من توارد حالتين في الشبهات الموضوعيّة ، بحيث لولا الاحتياط كان المرجع أصل البراءة; كما لو علم بنكاح وطلاق وشكّ في السابق منهما والمتأخّر وتعارَض الاستصحاب في كلّ منهما فالمرجع لولا الاحتياط حلّ الفرج; فإنّ التمسّك بحصر سبب حلّ الفرج في الزوجيّة وملك اليمين لحرمتها ، تمسّك بالعام فى الشبهة المصداقّية .
هذا وإذا كان الاحتياط في الفرج غير مختصّ بالوطء المشكوك وجرى فيما لو شكّ في جواز التلقيح بنطفة بعد الوطئ ، كان هذا مورداً آخر لأصل الاحتياط في الفروج .
هذا كلّه إذا قلنا بوجوب الاحتياط في الفرج ; وأمّا إذا قلنا باستحبابه كما صرّح به في موضع من الجواهر(1) فلا إشكال من الأساس . ولم نعثر حتّى الآن على مورد في كلمات القدماء يستفاد منه كون الاحتياط في الفروج أمراً واجباً، وإنّما شاع هذا في كلمات مثل العلاّمة ومن تأخّر عنه .
وربما يقال في دفع إشكال لغوية قاعدة الاحتياط في الفروج بأنّها ناظرة إلى وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة أكثر ممّا يجب في سائر الموارد، فلا تلغو بغضّ النظر عن الموارد المتقدّمة .
ولكنّه مجرّد احتمال لم يقم شاهد عليه . والعمدة ما قدّمناه .
الروايات المؤيدة لقاعدة الاحتياط في الفروج
- (1) الجواهر 30: 178 .
(الصفحة307)
منها : ما ورد من الأمر بالسؤال عن المرأة إذا أراد التمتّع بها ، ففي المعتبرة عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) إنّه سُئل عن المتعة فقال : «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ ، واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهنّ»(1) .
وموردها الشبهة الموضوعيّة ، وقد حملت على استحباب السؤال; بقرينة ما دلّ على النهي عن السؤال والفحص .
ففي الصحيح عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : «نعم ، هي المصدّقة على نفسها»(2) .
إلاّ أن يقال: إنّ لسان معتبرة أبي مريم لسان التخصيص والحكومة .
وفي موثّق إسحاق بن عمّار ، عن فضل مولى محمّد بن راشد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : «ولِمَ فتّشت؟» .
ونحوها مرسل مهران ورواية محمّدبن عبدالله الأشعري(3) .
وكيف كان فقد أورد في الوسائل في الباب روايتين فى إحداهما : «فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» وفي الاُخرى «لا ينبغي لك أن تتزوّج إلاّ بمأمونة» .
ونحوها في الحثّ على الفحص ، ما في الباب 8 من المتعة ، سيما صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : «يتعرّض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل» .
- (1) الوسائل 14: 451 الباب 6 من المتعة ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، الباب 10 ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر 14: 457 ، الباب 10 من المتعة ، الحديث 3 .
(الصفحة308)
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيِّنة ؟ قال : «إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس»(1) .
وفي معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في الرجل يشتري الأمَة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها؟ فقال : «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»(2) .
ونحوه خبر أبي بصير .
وفي خبر ابن حكيم: نفى البأس إذا ضمن مولاها .
وفي صحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : «يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت ـ يئست خ ل ـ » قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : «إن كان عندك أميناً فمسّها»وقال : «إنّ ذا الأمر شديد ، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفّظ لاتنزل عليها»(3).
وفي الصحيح على الظاهر لابن بزيع قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزي ذلك أم لابدّ من استبرائها ؟ قال : «يستبرئها بحيضتين» قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : «نعم ، ولا يقرب فرجها»(4) .
وفي خبر أبي بصير في حديث: إنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء ، يستبرئها ؟ قال : «أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها»(5) .
- (1) نفس المصدر ، الباب 31 من المتعة الحديث 4 وراجع الباب 33 ، الحديث 2 .
- (2) نفس المصدر 14: 503 ، الباب 6 من نكاح العبيد ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (4) نفس المصدر ، الحديث 5 .
- (5) نفس المصدر ، الباب 3 ، الحديث 9 .
(الصفحة309)
إلاّ أنّ في موثّق زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنّه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال : «هوذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود»(1) .
وجوب حفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه
كما ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد من التهويل بادّعاء نسب ليس له أو التبرّئ من نسب ثابت .
وبما ورد من الأمر بنسبة الأشخاص إلى آبائهم في قوله تعالى : {اُدْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}(2) .
وبما تقدّم من بعض الأخبار الحاثّة على الاحتياط في الفروج; لأنّ منه الولد ، بناءً على أنّ المراد به كون الفرج منشأ الولد ومحلّ انعقاده ، فيكون ترك الاحتياط منشأ لاختلاط النسب . وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما يتعلّق بالأنساب من حرمة التسبيب إلى جهالتها .
- (1) نفس المصدر ، الباب 7 ، الحديث 2 .
- (2) سورة الأحزاب الآية 5 .
(الصفحة310)
إذا تمهّد ما أسلفناه فهنا فروع :
الفرع الأوّل : تلقيح ماء الرجل بزوجته بوجه غير الجماع
الظاهر أنّه لا بأس به; للأصل بعد عدم دليل على المنع ، بل يدلّ عليه بعض عمومات أو إطلاقات الحثّ على الاستيلاد مثل : «تناكحوا تناسلوا . . .»(1) .
نعم ، ربّما يستلزم التقليح حراماً آخر كالنظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه ولمسه ، وهذا لا يستلزم حرمة التلقيح; لعدم سراية الحكم من الملزوم .
ثمّ إنّ المتيقّن من أدلّة حرمة النظر واللمس إنّما هو ذلك بالنسبة إلى الظواهر للأبدان، وأمّا النظر واللمس بالنسبة إلى جوف البطن مثلاً والأمعاء فلم يعلم حرمة ذلك .
الفرع الثاني : إذا انحصر الاستيلاد للزوجين في التلقيح وفرض استلزامه لمحرم من نظر أو لمس ، ففي جواز التلقيح تفصيل:
فقد يكون الصبر على ترك الاستيلاد حرجاً ومشقّة كما في كثير من الموارد ولو لاستلزامه تزوّج الرجل بامرأة اُخرى ممّا يكون حرجاً على المرأة غالباً وعلى الرجل كثيراًما،فلاينبغي الشكّ في جوازه حينئذ; لأدلّة نفي الحرجوقاعدة الاضطرار.
وأمّا بدون الاضطرار ففي جوازه إشكال; والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ الاستيلاد بالتلقيح قد لا يكون مصداقاً للعلاج ، وذلك كما إذا لم ينحصر الاستيلاد في التلقيح ، فلا وجه لجوازه حيث استلزم محرّماً .
وأمّا إذا صدق عليه العلاج ففي جوازه إشكال ، والحكم بالجواز مبتن على جواز المعالجة بملاكها لا بملاك الضرورة ، فلابدّ من ملاحظة أدلّة المسألة ، أعني العلاج وقد تقدّمت في المسألة الثالثة .
- (1) مستدرك الوسائل 14: 153 .
(الصفحة311)
والذي يمكن الاستدلال به لجواز العلاج بل وجوبه كما سبق اُمور ـ وشيء منها لا يقتضي مباشرة العلاج للجنس المخالف ـ :
الأوّل : حديث: «من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين . . .» .
ودعوى أنّ استنجاد المريض بمعالجة يستدعي وجوب إجابته فضلاً عن جوازه ، وإطلاقه شامل لما إذا استلزم ذلك ارتكاب محرّم ، ممنوعة . ولو سلمت فهي محكومة .
الثاني: حديث: «ما دون السمحاق أجر الطبيب» بناءً على أنّ ما فوق السمحاق مفروض كون غرامته وديته زائداً على أجر العلاج .
الثالث: أنّ ترك المداواة ظلم ، كما أنّ أصل التسبيب إلى حدوث المرض ظلم ، فإنّ الظلم إنّما هو بلحاظ أثر الجناية ، ولا فرق فيه بين الحدوث والبقاء ، فتأمّله .
والسرّ في التأمّل هو أنّ إطلاق أدلّة الأحكام محكومة على المعروف بأدلّة نفي الحرج والضرر ، ومهما كان حكم ضرريّاً يكون منفيّاً بتلك الأدلّة .
إن قلت: هذا إذا لم يكن الحكم من أساسه ضرريّاً أو حرجيّاً .
قلت: نعم ، ولكن فيما كان دليل الحكم لفظيّاً لئلاّ يلغو ، وأمّا إذا كان دليل الحكم هو حكم العقل فلا بأس برفعه من الأساس ، وذلك فيما حكم العقل معلّقاً على عدم ورود ترخيص بخلافه من جهة الشارع ، ومعه فلا موضوع لحكم العقل كما إذا رخّص الشارع في ضرب أو جرح ، وتمام الكلام في غير المقام .
الرابع: بناء العقلاء على لزوم تدارك الجنايات . وحكمهم بالأبدال إنّما هو في فرض عدم إمكان المبدل نفسه وإلاّ فلا تصل النوبة إلى البدل .
وهذا هو العمدة في الحكم هنا وفي الحكم بضمان التوالف من الأعيان والأوصاف . وقد ذكر سيّدنا الاُستاذ أنّ الاستدلال لضمان التالف بحديث الإتلاف
(الصفحة312)
ضعيف; لعدم السند له ، وعمدة الدليل هو بناء العقلاء وسيرتهم الممضاة بعدم ردع الشارع وإن كان فيما ذكره (قدس سره) إشكال; فإنّ حديث «من أتلف . . .» وإن لم يثبت بهذا اللفظ ، ولكن الأدلّة اللفظيّة غير قاصرة عن الدلالة على ضمان التالف ، وتمام الكلام في محلّه .
وكيف كان فدعوى بناء العقلاء على لزوم تدارك وصف السلامة بالعلاج مع الإمكان بحسب المتعارف غير مجازفة .
وقصور هذه الوجوه عن إثبات جواز معالجة الجنس المخالف بالذكورة والاُنوثة واضح .
الخامس: بعض النصوص الدالّة على جواز تعرّض المرأة للعلاج بالخصوص مع كون المعالج أجنبيّاً ، ففي معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت»(1) .
ولو تمّ إطلاق الخبر لحكمنا بجواز تعرّض المرأة لمعالجة الأجنبي لها ولو بدون ضرورة ، ولكنّه مقيّد باضطرارها، فتأمّل .
هذا مع إطلاق النهي عن معالجة الرجل للمرأة وبالعكس(2) .
- (1) الوسائل 14: 172 ، الباب 130 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر ، بقيّة أحاديث الباب وغيرها .