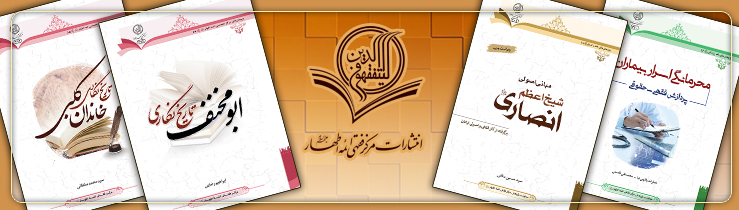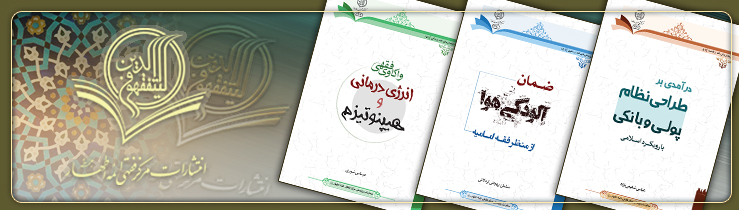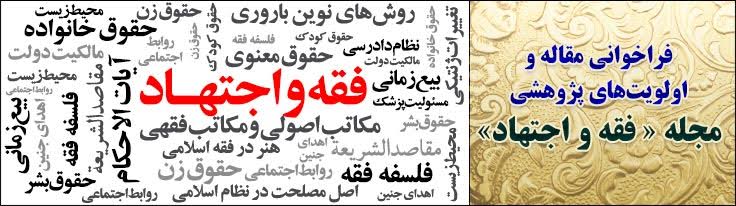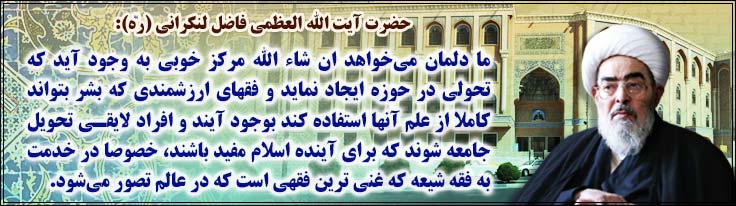(الصفحة6)
الـمـبـسـوط في فقه المسائل المعاصرة
المسائل الطبّية
حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد بن محمّد الحسين القائني
(الصفحة7)
بسم الله الرحمن الرحيم
تأليف
علم الفقه في مسير التطوّر والتكامل :
فإذا رجعنا إلى ما طرحه الصدوق والشيخ المفيد من المباحث الفقهيّة في عصرهم ـ الذي يعتبر عصر نشوء الاجتهاد وتبلوره ـ وقارنّاه مع ما هو مطروح من أبحاث فقهيّة في عصرنا الحاضر ، نرى البون الشاسع بينهما .
وحينئذ يُطرح هذا السؤال : ما هو السبب أو الأسباب التي أدّت إلى تطوّر علم الفقه عبر القرون المتمادية؟
وهذا بحث يحتاج إلى دقّة متنهاية وتتبّع كامل ومفصّل ، ولكنّا هنا نشير على نحو الإجمال إلى بعض هذه الاُمور :
1 ـ إنّ علم الفقه يتكفّل برفع الحاجات الأساسيّة الفرديّة والاجتماعيّة ، فدائرته تتّسع وتكبر كلّما اتّسعت وكبرت تلك الحاجات ، وبموازاة التوسّع في الحاجات الفرديّة والاجتماعيّة يتّسع نطاق علم الفقه ، فكلّما واجه الناس مشاكل كثيرة ، كلّما كثرت الأسئلة وأجاب عنها الفقهاء .
فالتفاعل الحاصل ممّا يستجدّ من الحاجات الكثيرة للناس وتساؤلهم
(الصفحة8)
والحلول والأجوبة المطروحة من قبل فقهاء الإسلام ، صار ذلك سبباً في توسّع علم الفقه وتطوّره .
وبعبارة اُخرى : أنّ من أسباب تطوّر علم الفقه هو وجود المسائل المستحدثة في كلّ عصر ، الأمر الذي يؤدّي إلى تطوّر الاجتهاد ونموّه في إطار ذلك العصر .
2 ـ الدقّة وتجديد النظر في الأبحاث الفقهيّة القديمة ، ونحن نرى أنّ الرجوع إلى المباحث السابقة يقتضي ولادة نتائج جديدة في كلّ زمان ، حيث يضيف المجتهد اللاحق نظرات جديدة على مباحث المجتهدين الذين سبقوه .
3 ـ إنّ الممارسة الفقهيّة تصل بالمجتهد إلى مرتبة يقدر معها على ابتكار القواعد الاُصوليّة والقواعد الفقهيّة الجديدة وتطبيقها على الفروع الكثيرة ، فكما أنّ العالم في سائر العلوم يطرح نظريات جديدة بسبب استكشاف قواعد جديدة ، فكذلك الفقيه يستفيد قواعد اُصوليّة أو فقهية جديدة بسبب تضلّعه وإحاطته بالنصوص الشرعية والفقهية .
4 ـ انتقال علم الفقه إلى الآخرين كان سبباً لفهم جديد لبُعد من أبعاده التي لم تتّضح للفقهاء السابقين ، فمثلا لم يستفد الفقهاء سابقاً مفهوم الولاية المطلقة والعامّة للفيقه من الروايات الواردة في شأن العلماء ، بينما استفادها الفقيه الأكبر والمحقّق الأعظم ، الإمام الخميني (قدس سره) ، وبنى عليها كثيراً من الاُمور التي منها تأسيس الحكومة الإسلامية ووجوب ذلك .
ونتيجة لما تقدّم ينبغي الاهتمام بهذا العلم ، وتأسيس المراكز المختصّة به من أجل التعمّق في أبعاده المختلفة ، وإيجاد فضلاء متخصّصين في علم الفقه ، بل في كلّ مجال من مجالاته المختلفة ، فنحتاج إلى الفقيه المتبحّر في الفقه القضائي ، كما نحتاج إلى الفقيه الماهر في الفقه السياسي ، وأيضاً في الفقه الإجتماعي ، كما هو المطلوب في فقه العبادات والمعاملات .
(الصفحة9)
ومركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ـ الذي أسّس برعاية المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(دام ظلّه العالي) ـ يعدّ أوّل مركز قد أسّس لهذا الغرض المذكور آنفاً ، وقد تربّى فيه إلى الآن عدد كثير من الأفاضل ، وصدرت الرسائل العلميّة المختلفة في المباحث المتنوّعة .
والكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم هو أثر من آثار اللجنة المختصّة بالمسائل المستحدثة ، وقد بحث وألّف سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد القائيني دامت بركاته ، في المسائل المستحدثة بحثاً وافياً شاملا لجميع الأدلّة والاحتمالات ، فجزاه الله خير جزاء المحسنين .
وقد اُعدّ هذا الكتاب في مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) بيد الفضلاء الأماجد حجج الإسلام :
الشيخ محمّدحسين مولوي : تقويم النصّ.
الشيخ عباد الله سرشار الطهراني والسيّد عبدالحميد أحمد الرضوي : المقابلة .
الشيخ حسين الواثقي : الإشراف على إعداد الكتاب وطبعه .
وفي نهاية المطاف نشير إلى نكتة ; وهي أنّه ينبغي الانتباه إلى أنّ الاجتهاد الصحيح هو السرّ الأساسي لبقاء علم الفقه وأحكامه ، وهذا الأمر يحتاج إلى مجانبة الإفراط والتفريط ، فنحن نرى ما أحدثه الإفراط في تغليب الجانب العقلي في الفقه في بعض العصور السابقة من دخول اُمور خارجة عن حقيقة الفقه ، كما أنّ الاقتصار على النقل المحض ونكران دور العقل صار سبباً لجموده في بعض الأزمنة ، كما ينبغي أن نعلم أنّ الإفراط والتفريط ـ في زماننا هذا ـ قد أُلبس ثوباً جديداً ربما أدّى ـ والعياذ بالله تعالى ـ إلى اضمحلال الفقه والشريعة .
مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام)
(الصفحة11)
مقدّمة المؤلّف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة على محمّد وآله سادات العرب والعجم ، واللعن على أعدائهم قديماً وحديثاً ، وإلى الأبد .وبعد : هذه ـ إن شاء الله ـ رسالة في المسائل الطارئة ممّا حدث الإبتلاء بها لتطوّر الزمن ، أكتبها تذكرة لنفسي وعسى أن تفيد غيري فأنتفع بها في حشري ، وعلى الله توكّلي وبه استعانتي وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكّلت وإليه أنيب .
ولمّا كانت جلّ هذه المسائل وفقهها بكراً افتضضتها ، وشريعتها حديث ابتلاء وأنا من سابقي وردها ، فإن كان وقوعي عليها وصدوري منها مصيباً فذاك من فضل ربّي يؤتيه من يشاء إنّ ربّي واسعٌ كريم.
وإن أخطأت فيها واشتبه الأمر عليَّ عندها ، فلست بدعاً ولا ختماً ، بل أشكو بثّي وحزني في فقد المعصوم إلى الله .
غير أنّي لا آلو جهداً في الوصول إلى الحجج ، ولا أدع مسلكاً أرجو أن يأخذ بي إلى سبيل ربّي فإن اهتديت فبما اُلهمت وإن ضللت فإنّما أضلّ على نفسي . وأرجو منه تعالى بحرمة ساداتي محمّد (صلى الله عليه وآله) وابن عمّه وابنته وسبطيه والتسعة الطاهرين (عليهم السلام) من ذرّيته أن يأخذ بيدي ويلهمني الهداية ويقيني الضلالة إنّه خير موفّق ومعين آمين آمين .
(الصفحة12)
وقد كنت أضبط هذه المباحث أثناء إلقائها على ثلّة من الطلاّب الأعزّاء في قم المقدّسة في المركز الفقهي للأئمّة الأطهار (عليهم السلام) المؤسَّس برعاية سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه ، وقد قام بنشرها هذا المركز .
وقد سمّيته بالمبسوط مجاراة لشيخ الطائفة (قدس سره) في كتابه المبسوط ، حيث ألّف كتابه بغية التعرّض للمسائل غير المنصوصة بالخصوص ممّا تعرّض لها أهل السنّة وعيّروا فقه الشيعة بقصوره عنها .
وفي الختام أقدّم جزيل الشكر لكلّ من وازرني على هذا العمل وساعدني في هذا المجال ، بمقال حملني على مزيد النظر والتحقيق في المطالب ، أو تعديل في المضمون أو تصويب في العبارة، ومن أعان على إخراج الكتاب بهذه الحلّة في المركز الفقهي المذكور أعلاه ، سيّما أخانا حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين الواثقي . سائلا من العليّ القدير لجميعهم عظيم الثواب وجزيل الأجر . ربّنااغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا إنّك غفور رحيم . وأخيراً أرجو من الربّ الجليل أن يتقبّل منّي هذا القليل ويجعله ذخراً لنا ، إنّه أرحم الراحمين.
العبد المفتقر إلى ربّه الغنيّ
محمّد بن محمّد الحسين القائني
محمّد بن محمّد الحسين القائني
(الصفحة13)
المدخل
وفيه جهات:
الجهة الاُولى: توقيفيّة المعاملات كالعبادات .
الجهة الثانية: ضابطة المسألة المستحدثة وبيان أنواعها .
الجهة الثالثة : بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة .
(الصفحة14)
(الصفحة15)
الجهة الاُولى:
توقيفيّة المعاملات كالعبادات
قبل الولوج في المقصود نتعرّض لبحث مرتبط بالمسائل المعاصرة وحاصله أنّه: هل هناك ضرورة لتعرّض الشارع لمسائل المعاملات والحكومات والسياسات والضابط ما عدا العبادات التي هي توقيفيّة لا ينال تفصيلها الفهم العرفي بدون تبيانه من المشرِّع .
وربما يقال: إنّ المعاملات محوّلة إلى العرف ما لم يثبت للشارع في مورد حكم خاص كما ثبت في الربا والغرر وغيرهما . فلا يتوقّف الحكم بصحّة معاملة وترتيب الآثار عليها على نص من الشارع ما لم يثبت الردع .
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه; فإنّ المسائل المعاصرة ربما لاتنحصر في المعاملات بالمعنى المتقدّم، بل ربما ترتبط بالعبادات كالصلاة في الكرات الاُخرى غير الأرض وعلى متن الطائرات والصيام في البقاع التي تطول أيّامها شهوراً أو تقصر بضع ساعات وغير ذلك من مسائل .
على أنّ البحث عن ضرورة تعرّض الشارع لكافّة المسائل التي ترتبط بشتّى أنحاء الحياة أمر ، ووقوعه أمر آخر . والمدّعى تعرض النصوص الشرعيّة بعموم أو
(الصفحة16)
إطلاق أو اُصول عمليّة لكلّ المسائل، والتي من جملتها مسائل المعاملات بالمعنى المتقدّم .
نعم ، ربما يكون سكوت الشارع عن ردع معاملة إمضاءً لها; وهذا بملاك آخر غير ما تقدّم; فلذا يكون مشروطاً بشروط التقرير، والتي من جملتها كون السيرة بمرأى من الشارع، فلا يجري في السير ولا المعاملات المستجدّة . كما ولا يختصّ ـ حيث تحقّق ـ بالمعاملات، بل يجري في العبادات أيضاً .
(الصفحة17)
الجهة الثانية:
ضابطة المسألة المستحدثة
ينبغي الكلام في ضابطة المسألة المستحدثة وإن كان لا ثمرة في البحث عن هذا التحديد بعدما حقّقناه ـ على ما يأتي إن شاء الله ـ من عدم قصور العمومات والإطلاقات في النصوص الشرعيّة عن شمولها ، وعدم كونها موضوعاً لحكم ، ولا مأخوذاً في نصّ شرعي; ولكن لابدّ من ذلك لأمرين:
الأوّل : ظهور الثمرة على الوجه الآخر .
والثاني : إفرازها ، لاختلاف المسائل غير الحادثة عنها في وضوح الحكم المستنبط وعدمه ، وإن اشتركتا في أصل ثبوت الحكم والاندراج في الحجّة; فإنّ ثلّة من المسائل لا تندرج في المسائل المستحدثة وإن كانت في معرض توهّم الاندراج فيها .
كما أنّ بعض المسائل وإن لم تكن بصورها الموجودة فعلاً موجودة سابقاً ولكنّها كانت بوجه مشترك بين السابق واللاحق; فمثلاً الأقارير والشهادات وما شاكلهما ممّا تؤدّى باللسان والإشارة ، لم يكن لها موضوع وقوعها ضمن الأفلام والأشرطة المسجّلة والأجرام الاُخرى التي تسجّل الأصوات والصور على متنها
(الصفحة18)
وتخزنها في داخلها وتبدي ذلك كلّه كلّ حين بإذن صاحبها ، ولكن هناك جامع بينها وبين مثل الكتابة . واحتمال التحريف والدسّ فيها مثل الكتابة بلا فرق .
وبالجملة : فتمام ما يحتمل مانعاً من قبول الأقارير المسجّلة بالوسائل الحديثة موجود في التسجيل بالكتابة ، بلا زيادة بل ربما نقصت الموانع المحتملة في الأقارير بالوسائل الحديثة . لا أقول بالقياس حاشا من ذلك ثمّ حاشا ، وإنّما أقول: إنّ المتفاهم من الحكم في الكتابة إسراء الحكم إلى مثل الصور الملتقطة عبر الوسائل الحديثة، فإنّ هذه صور كصورة الكتابة ومثلها وإن كانت صورتهما مختلفة ، فلاحظ .
فنقول : ربما تكون المسألة غير متعارفة الوقوع في الأزمان السابقة ، ولذا لم يقع عنها السؤال في الأحاديث والنصوص ، ومع ذلك لا ينبغي حسبانها مسألة حديثة ، بعدما كان موضوعها بحيث لو وجد في السابق أو رآه بعض أهل تلك الأزمنة لعبّر عنه بالتعبير الوارد في النصّ ، والذي هو الضابط في الاندراج تحت المطلقات ، دون الاصطلاحات الحادثة ممّا تكون ناشئة عن وضع جديد كما لايخفى .
وبالجملة : عدم تعارف الوجود شيء ، واستحالته بالنظر العرفي شيء آخر . فمثلاً المتعارف في الأعصار السابقة هو طيّ مقدار من المسافة في اليوم كثمانية فراسخ ، ونهاية ما يمكن من السير آنذاك هو ضعف ذلك فرضاً أو قريباً منه ، وأمّا طيّ مسافة تكون ألف ضعف لذلك فلم يمكن حتّى يُسأل عنه أو يفرض; لا لاستحالته عقلاً بل لقصور الوسائط الموجودة ، ولكن العرف كان يؤمن بإمكانه; وعلى أساسه كان المسلم يعتقد إسراء النبيّ (صلى الله عليه وآله) ليلاً وفي زمان يسير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بل وإلى السماء .
وعليه فالسفر بالوسائط الحديثة بل وبأحدث منها وأسرع ، كان نظيره واقعاً
(الصفحة19)
في عصر التشريع وبعده فأيّ قصور عن شمول إطلاق النصّ في المسافر ـ بغضّ النظر عن جهة اُخرى ـ للأسفار الحديثة ؟!
نعم ، مع انطواء الأرض بدون سير مباشر أو راكباً ، لا يُنسب سفر إلى المكلّف وإن كان معه لا يعدّ الشخص حاضراً وعند أهله .
وبالجملة : فأيّ فرق بين السفر بالبراق والسفر بمركب سريع السير في عصرنا في صدق عنوان السفر .
وأوضح من ذلك العقود الحديثة ممّا لم تكن موجودة سابقاً ، فإنّ ذلك لا يوجب اندراجها في مسائل يكون شمول العمومات لها مشتملاً على إبهام ، كعقد التأمين والسرقفليّة وبيع الفصول وما شاكلها ، فإنّها كانت قابلة للتصوّر وإن لم تقع أو لم تتصوّر بالتفصيل .
إذن فالذي ينبغي أن يعدّ ضابطاً للمسائل المستحدثة هو كون الموضوع ممّا لم يعقل وجوده خارجاً في عصر النصّ كي يبحث عن شموله له; وذلك مثل ترقيع اليد وتركيبها على فاقدها فإنّه لم يكن أمراً متصوّراً ـ أعني ممكناً في أنظارهم ـ ولذا لم يقع السؤال في النصّ عنه وعن أمثاله ، فهل يحكم بإطلاق ما دلّ على نجاسة القطعة المبانة من الحيّ لنجاسة مثله بعد الترقيع حيث يرد ؟
وإن شئت فقل : إنّ عدم تعقّل إمكان الشيء وما شابهه وما يقرب منه أو يضاهيه ، هل يوجب انصراف المطلق إلى غيره بدعوى انسياق النصّ ، سيما في موارد السؤال ، إلى المسائل الابتلائية والقابلة للوقوع في شأن المكلّف ؟
ومن قبيله قطع أعضاء الميّت لغرض الترقيع بالأحياء سيّما مع توقّف حياة الشخص على الترقيع، فهل يعدّ ما دلّ على النهي عن المُثلة بالمسلم ، واحترامه بعد موته بمثل حرمة حياته شاملاً لما إذا قطع لداعي إنقاذ حياة مريض والترقيع به ممّا لم تكن هذه الحالة محلّ ابتلاء المكلّفين جزماً في عصر النصوص; لعدم كفاءة العلوم
(الصفحة20)
الطبّية لمثل هذه الأعمال آنذاك ؟!
هذا بغضّ النظر عن قصور الإطلاق من جهة اُخرى ، بل يفرض الإطلاق بحيث لو كانت هذه الحالة واقعة في تلك الأعصار ، شاملاً لمثلها بلا حاجة إلى دليل آخر، وإنّما المانع عن الشمول هو عدم إمكان هذه الحالة المستجدّة والطارئة فعلاً ، في الأزمنة المعاصرة للنصوص .
ومن هنا تعرف أنّ سبر النصوص للعثور على نظائر المسائل المستحدثة يعين على ظهور المطلقات في شمولها لتلك المسائل .
هذه ضابطة المسألة الحادثة بلحاظ ما قد يستشكل فيها من التمسّك بإطلاق النصوص .
ولو اُريد بيان ضابطة المسائل الحادثة بغضّ النظر عن ذاك الإشكال ، فنقول وعلى الله الاتّكال: بعد أن لم يكن هذا الموضوع موضوعاً لحكم شرعي ولا ذا أثر في الشريعة سوى ما سنبيّنه إن شاء الله في طيّ بحث اُصولي تبتني هذه المسائل عليه ، يمكن تنويع المسائل المستحدثة إلى ثلاثة أنواع :
الأوّل: الموضوعات أو المتعلّقات التي لم يُلتفت إليها بالخصوص حتّى يُسأل عن حكمها بعد أن كان أمراً ممكناً في عصر التشريع وصدور النصوص بنظر الناس لو التفتوا إلى المسألة; وذلك مثل تزريق الدم داخل العروق ، والصلاة والصوم في مثل القطبين وغيرهما من الأمكنة التي تختلف عن ما نحن فيه ، وغير ذلك ممّا كان منشأ عدم التعرّض لها بالخصوص عدم الالتفات إليها; لعدم كونها محل ابتلائهم .
الثاني: الموضوعات والمتعلّقات غير الممكنة في تصوّراتهم في تلك الأعصار حتّى على تقدير الالتفات ، فلعدم إمكانها لم يقع التعرّض لأحكامها في النصوص بالخصوص ، وذلك كترقيع بعض الأجزاء المأخوذة من الميّت بالحيّ ، والغرض التمثيل ولا مناقشة في المثال، فإنّه قد ورد ترقيع الاُذن بعد قطعها في بعض النصوص.
(الصفحة21)
الثالث : عدم تعرّض الفقهاء للشيء مع تعرّض النصوص له بالخصوص ، إمّا للغفلة أو غيرها ، كحكم جواز تمكين من يحدّ بجلد وغيره من تخدير النفس أو العضو بما يمنع من الإحساس بالألم(1) .
فذلكة المسائل المستحدثة: يجمع كلّ الأنواع عدم تعرّض الفقهاء للمسألة
- (1) وكم من له نظير! فهناك مسائل صرّح الفقهاء فيها بعدم النصّ; واستندوا فيها إلى الإجماع ، مع أنّ المسألة منصوصة ، وكذا هناك مسائل ورد النصّ بها مع سكوت الفقهاء عن التعرّض لها حتّى كان عنوان المسألة غريباً على الأذهان حيث تطرح ، وقد أشرنا إلى عدّة من ذلك في محلّه .
ومن جملتها: مسألة الوفاء الربوي; وذلك فإنّه لا ريب في حرمة الربا في البيع; وعليه ضرورة الإسلام بل الظاهر أنّه لا ينبغي الإرتياب في حرمة الربا في غير البيع من المعاملات ، ولعلّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه.
ولكن يبدو لي حرمة الربا في غير المعاملات أيضاً ، من الوفاء بالدين ويدلّ عليه صحيح هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة ، قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة; ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .
ونحوه معتبرة الحلبي في الباب ، بل وإطلاق صحيح عبد الرحمن وغيره . وكيف كان ففي الأوليين كفاية .
غير أنّه قد يشكل الأمر في الأخبار ، من ناحية أنّه لا ريب في جواز الوفاء في الديون ، بزيادة إذا لم تكن مشروطة ، فكيف يحكم بحرمة الربا في الوفاء في مفروض الخبر ؟!
ويردّه: أنّ الجائز هو الوفاء بالزيادة إذا لم يكن المؤدّي لها ، ملتزماً وملزماً بذلك; وفي مورد الخبر ، أدائه للزيادة ليس بعنوان التبرّع ورعاية استحباب الوفاء بالزيادة ، كما يوفي المديون بعشرة ، عشريناً ، وإنّما هو بعنوان الالتزام ، تفادياً لفسخ المعاملة أو غيره .
ثمّ إنّ هذه الروايات بمقتضى التعليل الوارد فيها ، تدلّ على عدم جواز الوفاء متفاضلاً فيما إذا كان مديوناً بكيل من حنطة ولم تكن عنده ، وإنّما عنده نوع آخر أردء فلا يجوز الوفاء بكيلين مكان كيل في مثله أيضاً .
ثمّ إنّ الإشكال المتقدّم مبني على كون الوفاء ولو بغير الجنس معدوداً من الوفاء ، وأمّا إذا قلنا إنّ الوفاء بغير الجنس معاوضة وعقد لا إيقاع ، ولذلك يتوقّف على رضا الطرفين فمورد الأخبار المتقدّمة هو الربا المعاوضي ولكن في غير البيع، والله العالم .
(الصفحة22)
بمستوى تعرّضهم لعامّة أبواب الفقه ، وحتّى لو وقع البحث عنها كان بنحو من الإجمال والإشارة العابرة ولم تستوف المسألة حقّها من البحث . وربما نتعرّض لبعض المسائل القديمة ، لا لغرض تكرار ما أسّسه الفقهاء فيها من كلام; بل لما خطر عندي من نظر أو نكتة لم أرَ من سبقني فيها أو تعرّض قبلي لها فيما أعلم .
(الصفحة23)
الجهة الثالثة :
بحوث تمهيديّة عامّة للمسائل المستجدّة:
وفيها فصلان
لا مناص قبل الولوج في صلب المسائل من تحقيق مبانيها الأصوليّة ، والتي نسبة هذه المسائل إلى تلك نسبة الفرع إلى الأصل والبناء إلى الأساس ، حيث يكون التكلّم فيها قبل تنقيح تلك الأصول كالنقش في الهواء أو على الماء ، ولمّا يثبت .
وإن شئت فعبّر عن هذه المقدّمة ببحث أصولي عامّ يحوي التعرّض لكلّ مسائل الأصول المقرّرة في علم الأصول على نحو الإجمال، وأنّه هل تجري نتائج تلك المسائل عند أربابها في المسائل والموضوعات المستجدّة ؟ فلنشر إجمالاً إلى ذلك فنقول :
هل يجري الحكم المقرّر في البحث عن المشتقّ ، من كونه حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ في مصاديقه الحادثة ممّا لم يكن في عصر التشريع وبيان الروايات وصدورها من مصدر الوحي ، فالمسافر الموضوع للقصر والإفطار يعمّ المسافر بالوسائط الحديثة مثلاً؟
وأيضاً حجّية الإطلاق والعموم هل تعمّ المصاديق المعاصرة ، فالسفر المحكوم
(الصفحة24)
عليه بأحكام منها القصر في الصلاة والصوم يشمل السفر بوسائط النقل الحديثة ممّا يكون السير بها في زمان قليل أضعاف ما كان السير بوسائط النقل القديمة في زمان طويل ؟
والأمر بالصوم هل يُمتثل بإمساك لحظات يسيرة لمن قطن مكاناً من الأرض أو غيرها من كرات سماوية يكون ما بين الفجر والمغرب فيها ذلك القدر ؟
فإطلاق الموضوعات ومتعلّقات الأحكام وعمومهما يشملان ما كان مصداقاً حقيقيّاً لذلك فعلاً ممّا لم يكن أمراً ممكناً أو متصوّراً في عصر التشريع .
وإلى هذا البحث ترجع عامّة الأبحاث الأصولية بالنسبة إلى المسائل المستجدّة من أوّل مباحث الألفاظ إلى آخر بحوث الأصول العملية وغيرها .
فمثلاً هل تجري أصالة الحلّ المستندة إلى حلّ كلّ شيء مشكوك في الأشياء الجديدة كالتدخين بالسجائر والصعود إلى الأقمار وصنع التلفاز وآلات التصوير الحديثة ؟ أضف إلى ذلك حكم البراءة العقليّة في المسائل الحديثة .
وكيف كان ، ففي المقام فصلان:
الفصل الأوّل: في أنّ البحث الأساسي والأصولي في المسائل الحديثة هو أنّه كما أنّ الموضوعات المستجدّة هي مصاديق حقيقيّة للعناوين العرفيّة ، فيعدّ السفر بالوسائط الفعليّة مصداقاً للسفر العرفي حقيقة وبلا عناية ، فهل العناوين المأخوذة موضوعاً أو متعلّقاً للحكم في متون الآيات والأخبار المتضمّنة للأحكام الشرعية تشمل هذه المصاديق المستجدّة بعمومها وبإطلاقها أو لا؟
الفصل الثاني: في العرف المحكّم والمعتبر في تشخيص المصاديق والمفاهيم .
(الصفحة25)
الفصل الأوّل:
حجّية العمومات والإطلاقات في المسائل الحديثة
وفيه نقاط من البحث :
النقطة الاُولى: في تقريب حجّية العمومات والإطلاقات في المصاديق الحديثة والمعاصرة
أمّا الانصراف فتقريبه: دعوى أنّ المتفاهم من مثل «المسافر يقصر» هو ما تعارف من المتلبّس بالسفر في عرف المعاصرين للخطابات والنصوص ، ولكنّها مجرّد دعوى لا يعضدها برهان .
ولزيادة التوضيح نقول : إنّ المتفاهم من الأدلّة هو كونها من قبيل القضايا الحقيقيّة ممّا يكون الموضوع فيها عنواناً كلّياً وإن لم يوجد له مصداق حين إنشائه ويكون الحكم فيها منصبّاً على الموضوع الذي فرض وجوده ، وإن كانت القضيّة بلسان القضية الخارجيّة . وهذا أمر مسلّم مفروغٌ عنه ، فلذا لا نحتاج في سراية الحكم إلى غير المخاطب به ـ ممّن يشترك معه في النوع ـ إلى دليل خارجي ، بل
(الصفحة26)
إطلاق نفس القضيّة متكفّل لإثبات ذلك .
وإن شئت فقل : إنّ العرف يلغي خصوصيّة المخاطب ويفهم كونه مجرّد مورد للخطاب لا قيداً في متعلّقه وموضوعه هذا .
أنحاء القضايا في النصوص الشرعيّة والفقهيّة
إنّ القضايا الشرعية والنصوص المتكفّلة للأحكام على أنحاء ـ شمول الحكم للموضوعات المستجدّة في بعضها ممّا لا يرتاب فيه ، وإنّما الشكّ في بعض آخر ـ :
النحو الأوّل: النصوص المعلّلة للأحكام، ونذكر في الضمن الفرق بين العلّة والحكمة. وفي هذا النحو تكون القضيّة متكفِّلة للتعليل بما يكون شاملاً للموضوع قديماً وحديثاً ، كتعليلهم (عليهم السلام) حرمة الخمر بأنّها من جهة الإسكار لا الاسم ، ممّا يعطي أنّ هذه العلّة مهما تحقّقت سرى الحكم وإن لم يكن ذاك الموضوع مسمّى بالخمر فضلاً عمّا إذا كان خمراً مستجدّاً ومصنوعاً بوسائل حديثة; فلذا لا يرتاب أحد في عدم اختصاص التحريم بخمر دون خمر بل وبمسكر دون غيره . وهذا النحو خارج عن محلّ الكلام والإبهام بلا ريب ، ومتى كانت القضيّة من هذا القبيل لا نتوقّف في الحكم بإطلاق الحكم وعمومه للموضوع مهما كان .
ومن هنا تتبيّن أهمّية النصوص المشتملة على التعليلات والتي كان جمعها مورد اهتمام السابقين حتّى أنّ الصدوق (رحمه الله) ألَّف كتاباً في ذلك بعنوان «علل الشرائع» وكذلك غيره .
والإشكال المهمّ في ذلك هو أنّ مضامين هذه النصوص هي حكمة الأحكام لا عللها; لعدم اطّراد ما ذكر فيها من علّة .
ويردّه أوّلاً: أنّ الحكمة كالعلّة في عدم جواز تخصيصها بموارد نادرة .
(الصفحة27)
والفرق بين العلّة والحكمة سريان الأوّل في كلّ الموارد; والثاني في عامّة الموارد وإن تخلَّفت عن بعضها .
وثانياً: لا منافاة بين العلّية وبين التخصيص; فإنّ التعليلات محمولة على ظواهرها من العلّيّة التامّة; ومجرّد قيام الدليل فيها على التخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظهورها في غير ذلك المورد; نظير العامّ الذي هو حجّة في غير مورد التخصيص ، ومجرّد قيام دليل على التخصيص لا يوجب إلغاءه رأساً .
وإن شئت فقل: إنّ المتفاهم من التعليلات هو أحكام عامّة; فالمفهوم من حرمة الخمر معلّلة بالإسكار هو حرمة كلّ مسكر; فلو قام دليل على حلّ مسكر ، لا ينثلم به اعتبار حرمة المسكر في غير مورد الدليل كما لا ينثلم اعتبار عموم العام في غير مورد الدليل على التخصيص في غير المقام .
وبالجملة: فحكم العموم المستفاد من التعليل هو حكم العام الصادر ارتجالاً وابتداءً فكما لا يسقط عموم كلّ مسكر حرام عن الاعتبار في غير مورد الدليل على التخصيص فكذا لو استفيد ذلك من التعليل، فلاحظ .
تبصرة وتكملة: تتقدّر الأحكام سعةً وضيقاً بموضوعاتها ، وتتقدّر موضوعاتها بعلل الأحكام; بمعنى اتّساع الحكم حيث تحقّقت علّة الحكم كما أنّها تتضيّق عند قصور العلّة عن التحقّق في مورد . والموضوع في الحقيقة هو الذي تحدّده العلّة لا ما هو مذكور في المورد وهذا واضح .
ومن جملة الإشكالات على التعليلات الواردة في النصوص والموجبة لحملها على الحكمة في كلماتهم هو: ملاحظة عدم دوران الحكم مدار تلك العلّة; وذلك مثل التعليل المعروف في تشريع العدّة من كونها لحفظ الأنساب من الاختلاط والاشتباه; مع ثبوتها في مورد الأمن من ذلك حسب ما أفتوا به; فيوجب ذلك سقوط التعليل عن الاعتبار، فلا تتمّ العلّة علّة للحكم.
(الصفحة28)
وقد يكون هذا الإشكال صياغة اُخرى لما تقدّم من الإشكال، ويردّه ما أوردناه سابقاً ويكون ما أوردناه هنا من الإشكال زائداً على ما تقدّم.
وكيف كان ، فيردّه: أنّ الإشكال ناشئ من الخلط بين العلّية وبين العلّية المنحصرة; والمدّعى هو الأوّل ، بينما أنّ المتوهّم هو الثاني.
بيان ذلك: أنّ مقتضى تعليل العدّة بحفظ الأنساب هو ثبوتها حينما يلزم من عدمها محذور اختلاط النسب; بل مقتضاه وجوب حفظ النسب من الاشتباه ولو بغير العدّة ، كتحريم نسبة الناس إلى غير آبائهم واُمّهاتهم إذا توقّف عليه حفظ النسب; فإنّ المتفاهم من هذا التعليل كون اختلاط النسب ملاكاً تامّاً للحكم ، وكونه مبغوضاً للشارع بحيث يجب التوقّي عنه بكلّ ما يوجبه; ولايلزم من هذا كون علّة العدّة منحصرة في ذلك; بل لا ينافي هذه العلّة وجود علّة اُخرى لتشريع العدّة بحيث لو غضّ عن العلّة السابقة استقلّت هذه بالتأثير، فتكون كلّ من العلّتين ملاكاً تامّاً للحكم وعلّة تامّة له; ولذا ثبت وجوب العدّة مع الأمن من اختلاط النسب في الوفاة. وعليه فوجود علّة اُخرى للعدّة تقتضي ثبوت العدّة حتّى مع انتفاء العلّة الأولى، لا يمنع من علّية الأولى ولا من استقلالها بالتأثير حيث وجدت ولا ينافيه. نعم، هو مانع من انحصار العلّة وهذا غير المنافاة لأصل العلّية.
وعليه فالمتفاهم من تعليل حكم بشيء هو ثبوت الحكم بثبوت تلك العلّة، وأمّا انتفاؤه بانتفائها فلا; وذلك فإنّه يشترط في انتفاء الحكم انتفاء كلّ علله وعدم نيابة علّة مناب غيرها; وهذا لا يتحقّق بمجرّد انتفاء علّة واحدة.
ولا بأس بتوارد علل متعدّدة على معلول واحد في الاُمور الاعتبارية كما اتّضح في محلّه. وقياس المقام على الاُمور الحقيقيّة التي يمتنع فيها توارد أكثر من علّة واحدة على معلول وتأثيره فيه، مردود.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ ظاهر تعليل الحكم بشيء هو انحصار علّته في ذلك،
(الصفحة29)
وعليه فللقضيّة المعلّلة ظهوران:
أحدهما: كون مضمونه علّة تامّة في مقابل جزء العلّة.
والثاني: انحصار العلّة في مضمونه، وعدم تأثير شيء آخر في ذلك الحكم. والأوّل معناه العلّية التامّة، والثاني معناه انحصار العلّة.
ثمّ لو قام الدليل على علّية شيء آخر كالأولى كان ذلك منشأ لسقوط الظهور الثاني عن الاعتبار والحجّية بمقدار ما دلّ عليه الدليل، كما في علّة عدّة الوفاة وأنّها لحرمة الزوج فيحكم بثبوت العدّة ولو مع العلم بانتفاء العلّة الأولى، أعني اختلاط النسب، ولكن بمقدار ما دلّ عليه الدليل. نظير قيام الدليل على ثبوت عدل للواجب الموجب لكون الواجب تخييريّاً; حيث يقتصر في رفع اليد عن ظهور القضية في الوجوب التعييني بمقدار ما قام الدليل على كونه عدلاً للواجب ، فيحكم بكون الواجب أحد الأمرين لا ثالث لهما. وفيما نحن فيه يحكم بكون العلّة كلّ من العلّتين ولا ثالث لهما وهكذا. وهذا لايوجب رفع اليد عن ظهور الدليل في انحصار العلّة رأساً.
كما أنّه مع قيام الدليل على اشتراط شيء آخر في العلّية وعدم استقلال ما علّل به الحكم في التأثير، يرفع اليد عن ظهور الدليل في كونه علّة تامّة مستقلّة بالتأثير، ولكن بمقدار ما قام الدليل عليه، فتكون العلّة المنصوصة مؤثّرة بشرط ضمّ ما تضمّنه الدليل الآخر خاصّة مع عدم اشتراط تأثيرها بشيء آخر; نظير ما يقال في الواجب بعد ظهور دليله في عدم اشتراط وجوبه بشيء; لإطلاق الأمر به ، فإذا تمّ دليل على اشتراط الوجوب بشيء يقتصر في رفع اليد عن ظهور الدليل في إطلاق الوجوب بمقدار ما دلّ الدليل الآخر على اشتراط الوجوب به ، ويحكم بالإطلاق بملاحظة سائر الخصوصيات المحتمل دخلها في الوجوب.
(الصفحة30)
الاشتباه في تشخيص العلّة المنصوصة:
إنّ تحديد العلّة بحاجة إلى عناية فربما يتوهّم غير العلّة علّة وربما يكون المستظهر من تركيب في مورد ما لا يستظهر منه في مورد آخر; فإذا قيل: لا تشرب الخمر لإسكارها فيستظهر منها كون العلّة السكر لا شرب المسكر فيحرم الإسكار ولو بغير الشرب كالشمّ وغيره . بينما إذا قيل: لا تأكل الرمّان لحموضته ، كان الظاهر منها أو المتيقّن ، كون العلّة أكل مطلق الحامض لا مطلق الاستعمال غير الأكل .
والسرّ في الاختلاف هو أنّ من جملة ما يحدّد المقصود والظهور هو المناسبات بين الأحكام والموضوعات; ولذا ترى استظهار علّية الإسكار ولو بغير الشرب للتحريم حتّى إذا كانت العلّة المذكورة في النصّ هكذا: لأنّه شرب مسكر; مع أنّ المستظهر من المثال الثاني كون العلّة أكل الحامض خاصّة ولو قيل في التعليل: لأنّه حامض بدل أكل حامض .
وربما يكون الكلام مجملاً من ناحية تحديد العلّة فيقتصر على المقدار المتيقّن .
والدقّة في استظهار ما هو المناط والعلّة للحكم ، لها دخل كبير في ناحية الاجتهاد . ولا بأس بالتنبيه على بعض التطبيقات تتميماً للفائدة فنقول:
أمثلة للعلل المنصوصة: من جملة النصوص المشتملة على التعليل للحكم هو ما ورد من تعليل حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق بأن أوّل ما يخلق نطفة ، فإنّ المفهوم منه أنّ المحرّم هو إسقاط حمل يكون مبدءً لخلق إنسان مع قابليّة فعليّة غير متحقّقة قبل العلوق; فلذا يجوز العزل كما نبّه على ذلك وعلى عدم تحقّق العلّة المتقدّمة في نصّ آخر .
غير أنّ الظاهر أو المتيقّن من التعليل هو حرمة كلّ إسقاط لحمل موصوف
(الصفحة31)
بالوصف المتقدّم، لا حرمة اعدام كلّ موصوف بذلك الوصف وإن لم يكن حملاً ولا صدق عليه الإسقاط . وعليه فلا يمكن التعدّي بلحاظ هذا التعليل إلى الأجنّة المغروسة في غير الأرحام من الأنابيب الطبّية، فلاحظ .
ومن جملة التعليلات هو التعليل المعروف المبارك والذي يحلّ مشكلات معاصرة كثيرة ألا وهو تعليل طهارة البئر بالنزح بأنّ لها مادّة; وعلى أساس هذا التعليل يحكم بعصمة المياه المتّصلة بالبيوت عبر المجاري المتعارفة الآن; فالعلّة لطهارة البئر إذا تنجّس ماؤها بالتغيّر ثمّ زال التغيّر بالنزح هو اشتمالها على المادّة كما في النصّ . وربما يتمسّك بإطلاق التعليل لعدم اشتراط المزج في الماء إذا اُريد تطهيره بكرٍّ بل يكفي مجرّد اتّصاله بالمادّة .
ويردّه: أنّه لا إطلاق في التعليل; نظراً إلى أنّ العلّة لطهارة البئر المتغيّرة بعد النزح هي اشتمالها على المادّة; والنزح ملازم للمزج .
وإن شئت فقل: إنّ النصّ في قوّة أن يقال: النزح مطهّر لاشتمال البئر على المادّة ، فيفيد أنّ النزح وما بحكمه ـ والمفروض ملازمته للمزج ـ في كلّ ما له مادّة يطهّر . والتمسّك لطهارة ما له مادّة ، بغير النزح والمزج ، من قبيل التمسّك للمنع من غير أكل الحوامض من سائر الاستعمالات بالتعليل في المثال السابق .
وعلى هذا الأساس لا يمكن التمسّك بمثل هذا التعليل لطهارة الماء المنفعل بغير التغيّر بمجرّد الاتّصال بالمادّة والكرّ; فإنّ النزح يلازم فصل شطر كبير من الماء النجس فلا يلزم من علّية المادّة للطهارة حينئذ العلّيّة بدون فصل شيء وبمجرّد الاتّصال بالمادّة . نعم ، للحكم بالطهارة وجه آخر ليس هذا محلّ ذكره .
ومن جملة التعليلات: ما ورد في تحديد المسافة الموجبة للقصر في الصلاة بأنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه وأنّ كلّ يوم بعد هذا فهو كسابقه، فلو لم يوجب مسيرة يوم للتقصير لما أوجبه مسيرة ألف سنة . وعلى أساس هذا التعليل
(الصفحة32)
المؤيّد ببعض النصوص الاُخر يمكن أن يُقال: بأنّ الموضوع ليس هو الفراسخ الثمانية دائماً بل العبرة بمقدار من المسافة يشغل يوماً حيث يقع السير بالوسائل المتعارفة ، فالعبرة في كلّ عصر بوسائط النقل المتعارفة في ذلك العصر والله العالم .
النحو الثاني : أن يكون الحكم فارغاً عن التعليل كما إذا ورد: المسافر يقصر . وهذا داخل في محلّ الكلام ، والظاهر عدم قصور العموم والإطلاق في مثله .
نعم ، هنا شيء وهو أنّ الموضوع في ظرف الحكم بسعته ـ لا لمجرّد ظرف الصدور ـ إذا كان ملازماً لقيد بحسب الخارج وكان ذلك القيد دخيلاً في ثبوت الحكم ، لا يلزم الحكيم بيانه; فإنّ الغرض من البيان هو إيصاله إلى المكلّف ، ومع تحقّق هذا الغرض ولو من جهة اشتمال المكلّفين عليه لا ضرورة ، بل ولا حاجة إلى بيانه; فلذا لا موضوع للتمسّك بالإطلاق في مثل هذه القيود الملازمة للموضوع اتّفاقاً دائماً . والمراد من الملازمة الاتّفاقية عدم التلازم عقلاً .
مثلاً لو كان الموضوع للتقصير هو السفر المقيّد بطيّ المسافة من المسافر في مقابل السفر المتحقّق بانطواء المسافة والأرض ، ولكن السفر للمخاطب بالحكم لا ينفك عن طيّ المسافة; لعدم تمكّنه من التسبيب إلى انطواء الأرض ، فلا حاجة إلى أن يقيّد السفر بالقيد بل ربّما يكون لغواً ، ولا إطلاق للحكم في مثله مع عدم التقييد; لعدم استلزامه إيقاعاً للمكلّف فيما يخالف الواقع ولا تفويتاً لغرض عليه . ومن قبيله دخل معاصرة المعصوم (عليه السلام) في ثبوت الحكم .
غير أنّ هذا إنّما يتمّ في القيود الملازمة للموضوع في تمام أعصار ثبوت الحكم ، وأمّا إذا كان قيدٌ ملازماً للموضوع في بعض الأعصار فأيّ قصور في مقدّمات الحكمة أو وضع العمومات عن شمول الموضوع الخالي عن القيد في زمان وإن كان القيد مقارناً وملازماً له في آخر ، مثاله أنّ السفر الموجب للتقصير في عصر
(الصفحة33)
التشريع كان ملازماً ـ نوعاً ـ لنوع من التعب والمشقّة، فهل يعني هذا عدم إطلاق السفر والمسافر للمنفكّ عن ذلك في عصر آخر ؟
النحو الثالث : أن تتضمّن القضيّة لخطاب يختصّ بالمخاطب كما لو ورد: إذا سافرت فقصّر ، فهل يمكن التمسّك بمثله لوجوب التقصير في هذه الأعصار مع الفرق بيننا وبين المخاطبين في مقارنات السفر أو ملازماته؟
ومن قبيله ما احتمل من الخطابات دخل قيد معاصرة المعصوم (عليه السلام) في ثبوته كالخطاب بصلاة الجمعة وغيرها .
كان قد خطر ببالي في زمان بعيد الإشكال في ذلك; لا لأنّ القضيّة في مثله ليست حقيقيّة ، وأنّها لتضمّنها الخطاب تكون خارجيّة ، كلاّ! فإنّ الحكم المتقدّم يعمّ غير شخص المخاطب في تلك الأعصار ممّن يشترك مع المخاطب في ملازمات الموضوع ، وهذه آية كون القضيّة حقيقيّة ، بل لأنّ ثبوت الحكم الثابت في حقّ المخاطب ، لغيره لا يكون بالإطلاق ، وإنّما يكون بدليل آخر غير الخطاب مرّة وبإلغاء خصوصيّة المخاطب بحسب التفاهم العرفي مرّة أُخرى ، فإنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة عدم اختصاص الأحكام بالأشخاص من حيث كونهم مسمّين بزيد وعمرو أو كونهم أبناء فلان وفلان .
قاعدة الاشتراك في الأحكام ومقتضاها
بناءً على ما تقدّم لو كنّا نحن ـ أبناء الموضوعات المستجدّة ـ معاصرين للخطاب عمّنا الحكم كما يعمّ سائر الناس من الحاضرين غير المخاطبين بلا حاجة إلى دليل من خارج ، بل نفس الدليل المتكفّل للحكم كاف في ثبوته لغير المخاطب في الجملة بضمّ القرينة المتقدّمة .(الصفحة34)
ولكنّ الكلام هو أنّ تلك القرينة قاضية بشمول الحكم لمن يشترك مع المخاطب في النوع والصنف دون غيره ، فلا يكون دليل التقصير في السفر قاضياً بالتقصير في الحضر في حقّ غير المخاطب ، كما هو أوضح من أن يخفى على أحد .
وحيث يحتمل أن تكون بعض ملازمات الموضوع ومقارناته في حقّ المخاطب دخيلاً في الحكم ، فلا يكون ثبوت الحكم في حقّ غير المخاطب ممّن لا يوجد عنده ذاك الأمر مقتضى قاعدة الاشتراك المتقدّمة المستندة إلى القرينة العرفيّة .
نعم ، يلغي العرف بعض الملازمات فلا يرى دخلاً للطول والقصر والرجولة والاُنوثة واللون وما شاكلها في الحكم ، وأنّى له إلغاء كلّ القيود !
وإن شئت فقل : إنّ ثبوت الحكم في حقّ غير المخاطب يكون من قياس مقبول شأنه شأن الظهور . وإلغاء كلّ قيد بحاجة إلى إثبات وكلفة يكفي له الظهور ، فمهما جزم العرف بعدم دخل قيد فهو ، وبدونه فلا يمكن التعدّي .
ففي مثل السفر كيف يجزم بأنّ الموضوع للتقصير هو مطلق السفر دون ملازماته النوعية في الأعصار السابقة؟! هلاّ يحتمل أنّ الموضوع هو السفر المتعب للنوع الملازم له آنذاك لا المتعب لكلّ شخص ؟ فلاحظ .
وإنّما كنّا نلغي القيد في النحو السابق من القضايا ـ التي تكون مثل: المسافر يقصر ـ بالإطلاق ، وأمّا إلغاؤه فيما نحن فيه ممّا تكون القضيّة بلسان الخطاب فلا يكون بالإطلاق جزماً وإنّما يكون بالجزم بعدم الفرق ، وأنّى لنا إثبات ذلك فإنّه تخرّص على الغيب وقول بغير علم ، حُظرنا عنه ومُنعنا من ذلك . ولا يمكن الجزم إلاّ بدعوى رجوع هذا النحو من القضيّة في المتفاهم العرفي إلى النحو السابق، بأن يكون المفهوم منه كون الموضوع هو مطلق السفر ، وهذا ليس واضحاً
(الصفحة35)
عندي جدّاً(1).
نعم، يمكن أن يتمسّك لذلك بالاحتجاج في الأخبار والآيات ، بالمطلقات التي خُوطب بها جمع، على غيرهم ممّن لا يشتركون معهم في بعض القيود . وعدم صحّة الاعتذار باحتمال الاختلاف في الصنف ، وهذا لو ثبت يكون دليلاً على تماميّة الظهور المتقدّم ولكنه بحاجة إلى إثبات .
بل المتراءى من بعض الأخبار أنّ الأئمّة (عليهم السلام) ربما أجابوا عن مسألة السائل المطروحة بعنوان قضيّة عامّة ، على مقتضى حاله وما هو مورد ابتلائه من قيد خاص وإن كان سؤاله خالياً عن ذلك .
فعن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : «بانت منه» قال: فذهب ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «تطليقة» وجاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «ليس بشيء» ثمّ نظر إليّ فقال: «هو ما ترى» قال: قلت:
- (1) ونظير ما ذكرناه هو ما أفاده سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) في مسألة وجوب السجدة الفاقدة لشرائطها الاختياريّة ، عند الاضطرار ، معلّلاً ذلك بإطلاق الأمر بالسجدة; وما دلّ على اشتراط عدم كون المسجد أرفع من مقام المصلّي بأزيد من لبنة لا إطلاق فيه بالنسبة إلى المعذور; لكونه بلفظ الخطاب حيث قال (عليه السلام): «إذا كان موضع سجودك أرفع قدر لبنة فلا بأس» .
نعم ، لو كان دليل الشرطيّة بغير الخطاب كان إطلاقه مقيّداً لإطلاق الأمر بالسجدة.
وهذا الكلام منه في مسألة السجدة وإن كان قابلاً للدفع ، لقوّة دعوى عدم الفرق بين الصيغتين في إفادة الشرطيّة ، وهو من التفنّن في التعبير; ولذا يصحّ خطاب العاجز به كالمتمكِّن.
إلاّ أنّه في المقام موجّه; للفرق بين المقامين .
نعم ، ربما تكون القيود الملازمة للمخاطب مغفول عنها مع كونها في معرض الفقد كالمعاصرة للمعصوم (عليه السلام) ، فيكون الإطلاق المقامي نافياً لمثله وإن كان الإطلاق اللفظي قاصراً عن نفيه .
ويؤكّد ذلك ما تضمّن الحثّ على نقل الأحاديث لتصل إلى الناس حتّى مَن تأخّر عن زمان المعصومين (عليهم السلام) .
(الصفحة36)
كيف هذا؟
قال: «هذا يرى أنّ مَن طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه; وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء»(1) .
ونحوه خبرا ابن أشيم(2) .
إلاّ أن يقال: إنّ مثل هذا الجواب مخصوص بما إذا علم أنّ السائل لا ينقله إلى غيره; فلذا لمّا كان في المجلس غيره نبّه الإمام (عليه السلام) أبا أيّوب أو غيره على الحكم لئلاّ يغترّ فيغرى .
بل يمكن أن يقال : إنّ فهم أبي أيّوب وغيره التهافت بين الأحكام مبنيّ على فهم الإطلاق وعدم احتمال دخل الخصوصيّات الملازمة للسائل في الحكم ، وهذه تشكّل قرينة على حجّية الإطلاق وإلغاء الخصوصيّات في سائر المقامات . هذا ، ولكن فهم الإطلاق في هذه الموارد كان مبنيّاً على الجزم بعدم دخل الخصوصيّات المقارنة البارزة من السائل في الحكم ، وكذا الخصوصيّة الخفيّة المغفولة عادةً ، وأين هذا ممّا إذا كانت خصوصيّة بارزة يحتمل دخلها في الحكم ؟
على أنّه يمكن أن يكون التعجّب والسؤال ناشئاً من اختلاف الحكم في الشريعة في موارد يكون بينها تشابه في الملاك بالنظر المسامحي العرفي وإن كان الموضوع مختلفاً بالنظر الدقيق ، نظير ما ورد في ردّ القياس ردّاً على سؤال أبان حينما اعترض على اختلاف حكم قطع أربع أصابع من المرأة عن حكم قطع الثلاث بنقص الدية ، علماً بتعدّد الموضوع ، ولكن التعدّد ما كان يستأهل اختلافاً في الدية بالنقص مع زيادة الجناية في نظر أبان ، فلاحظ وتأمّل .
- (1) الوسائل 15 : 315 مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 16 .
(2) نفس المصدر: 318 ، الحديث 27 و28 .
(الصفحة37)
النحو الرابع : إلغاء العرف المتشرّع لبعض الخصوصيّات فيما تكون القضيّة من قبيل الخطاب لشخص مشتمل على بعض الخصوصيّات ، ولكن العرف يجزم بعدم دخل شيء منها في الحكم ، لا جزماً بالحكم ارتجالاً بل جزماً به استناداً إلى فهمه من الخطاب . كما إذا ورد: الرجل يشكّ في صلاته ، فإنّك ترى العرف لا يتوقّف بسماعه في تسرية الحكم إلى غير الرجل من المرأة بل الصبي والصبيّة . ونعني بالعرف هذا عرف المتشرّعة وإلاّ فالعرف العام لا يكاد يجزم بمثل هذا بعد علمه باختلاف الرجل والمرأة وغير البالغين مع المكلّفين في الأحكام اختلافاً واسعاً وإن كانت مشتركاتهم أيضاً كثيرة ، ولكن هذا العلم لا يمنع المتشرّعة من إلغاء الخصوصية إلاّ في مورد العلم باعتبارها . وإن كان منشأ الاستظهار هذا ـ أعني إلغاء الخصوصيّة ـ هو اشتراك الأصناف في عامّة الأحكام ، بحيث كان الباقي ممّا اختلفوا فيه يسيراً بالنسبة إلى ما اشتركوا فيه .
وبالجملة : فمثل إلغاء الخصوصيّة هذا يختلف باختلاف القيود المحتملة والأشخاص ، فربما يلغى قيد من قبيل الرجولة ، وربما لا يلغى قيد ، وربما يختلف الفهم فيه .
تنبيهات ثلاثة:
التنبيه الأوّل: توجيه العمل بقياس الأولويّة بعد عموم النهي عن العمل بالقياس
يرجع قياس الأولويّة إلى إلغاء القيد بالنحو المتقدّم ، فإنّ المتفاهم من حرمة التأفّف هو حرمة الشتم والضرب أيضاً ، فلا يتقيّد الحكم بلحاظ المراتب الشديدة بالنسبة إلى التأفّف وإن احتمل التقيّد بلحاظ المراتب الدانية بالنسبة إلى التأفّف لو كانت ، ما لم يكن التأفّف كناية عن مطلق الأذى ولو دون التأفّف; والتعبير به
(الصفحة38)
لتعارفه ، ومع احتمال التقيّد لا يتحقّق إطلاق وشمول ، فإنّه يكفي الشكّ هذا في الجزم بعدم الإطلاق .
وأمّا القياس الممنوع فهو مندرج فيما يحتمل كون المورد قيداً للحكم ، ويكون التعدّي عنه تخرّصاً غير مفهوم من اللفظ ، وهذا يغاير قياس الأولويّة ممّا يكون مستنداً إلى ظهور اللفظ; نظراً إلى إلغاء القيد بالنظر العرفي بلحاظ مورد الأولويّة كإلغاء قيد الرجولة في عامّة الموارد التي رتّب الحكم فيها، ويفهم منها عدم الاختصاص ، فلا يعمّه عموم القياس وإطلاق النهي عن العمل به . والتعبير عنه بالقياس مسامحة .
فإن قلت : كيف لا يصدق القياس على ما يصطلح عليه بقياس الأولويّة ، وقد ورد التهويل عن العمل به في معتبرة أبان ، حيث قاس قطع الأصابع الزائدة من المرأة على الناقصة ، ومع ذلك ردّ عليه بأنّه قياس وأنّه إذا أُخذ به محق الدين . وقد صرّح الشيخ الحرّ العاملي (قدس سره) في بعض أبواب اُصول الفقه من كتابه «الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة» بحرمة العمل بكلّ أنواع القياس حتّى قياس الأولويّة .
ولو سلّم عدم صدق القياس على هذا القسم لكفت معتبرة أبان في بطلانه والمنع من العمل به.
قلنا : لو سلّم إطلاق القياس عليه فهو أعمّ من الحقيقة . والردّ عليه في مورد الخبر فلأنّه قياس في مورد النصّ على خلافه ; فإن شئت قل: إنّه اجتهاد في قبال النصّ ; فإنّ دلالة اللفظ على مورد الأولويّة غايتها الظهور، فلا ينافي قيام الدليل على خلافه فيطرح في مورده .
وهذا كما يلغى قيد الرجولة في النصوص على العموم; ولا ينافيه الأخذ به في بعض الموارد حيث يدلّ عليه دليل خاصّ ، وهذا واضح . وبهذا أجبنا عن هذا الإشكال في غير المقام سابقاً .
(الصفحة39)
التنبيه الثاني: الفرق بين موارد الاستحسان وموارد الإلغاء المقبول للخصوصيّات
إنّ ذريعة عدم دخل القيد بحسب المتفاهم العرفي وإلغائه لا ينبغي أن يغرّر بالفقيه في رفع اليد عن النصوص والتعدّي عنها بالتشهّيات والهواجس والظنون، والتي تشترك في النتيجة مع الاجتهاد في الأحكام بالخرص والتخمين والاستحسان والقياس وما شاكلها من مدارك العامّة، ممّا نهينا عن الوقوع فيها والأخذ بها; أعاذنا الله من تسويلات الشياطين .
التنبيه الثالث: عدم حجّية الأدلّة على الأحكام مع الجزم بمخالفتها للواقع عبر العلوم الحديثة
ينبغي التنبّه لنقطة هامّة، هي أنّ ما نتوصّل إليه عبر الأدلّة والنصوص من الأحكام لا ينبغي الجزم بأنّها أحكام الله والشريعة ، وإنّما غاية ما يمكن في كثير من الموارد هو الظنّ ، ومع ذلك فهو حجّة ونجزم بذلك .
فلو تحقّق في مورد عبر العلوم الحديثة حصول الجزم بما يخالف بعض الأحكام المستنبطة من الحجج والأدلّة ـ وأنّى يمكن ذلك بعد تغيّر العلوم الحديثة؟! إلاّ للمتسرِّع العجول ممّن لا يبتني رأيه على أساس وثيق ولا تستند أفكاره إلى ركن محكم، بل يتأرجح بين النظرات وتتحربأ أنظاره في الآنات ـ فلا يكاد يمسّ كرامة المشرّع الإسلامي نقص ولا جهل ، حاشاه ثمّ حاشاه; فإنّ الأمارة حجّة حيث لا قطع بخلافه من وجدان أو برهان ، فإنّ مصلحة جعل الطريق لا تنحصر في إصابته دائماً بل يكفي لها الإصابة نوعاً بل احتمالاً بل وهماً، فلا تغفل .
غير أنّه ينبغي الالتفات إلى أمر آخر ، هو أنّه لا ينبغي التسرّع إلى ردّ الأحكام والأدلّة ، بمخالفتها لعقل أو لعلم ، فإنّ هذا العقل الموجود لدينا كان موجوداً لدى
(الصفحة40)
غيرنا ممّن هو أعلم وأفقه وأدرى ، ومع ذلك فقد انصاعوا للأدلّة وأذعنوا لها ولم يمنعهم عن ذلك أوهام ربما نسمّيها بالعقول ، وجهالات قد نسمّيها بالعلوم ، فقد رأيت من يدّعي استحالة تكليف الصبيّة في التاسعة من عمرها عقلاً ، فلو كان مبنى ردّ الأحكام مثل هذه الدعاوى والعقول فقد رفعنا اليد عن الكبرى المتقدّمة من عدم حجّية الأحكام والأمارات مع الجزم بخلافها ، فإنّ دين الله لا يُصاب بالعقول كما ورد في نصوص أئمّة ذوي الألباب عليهم صلوات خالق العقل وربّ الألباب .
(الصفحة41)
النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها
الوجه الأوّل: دعوى الانصراف ـ كما تقدّم ـ .
ويردّها أنّ الانصراف بدويّ لا شاهد له . نعم ، على مسلك الآخوند الخراساني من قصور الإطلاق عند وجود متيقّن له في مقام التخاطب ، ربما يشكل التمسّك بالإطلاق في مثل الموضوعات الحديثة .
لكنّه مع عدم جريانه في العمومات مردود عند المحقّقين في الإطلاقات أيضاً ، بل لم يعلم التزامه (قدس سره) بذلك في الفقه وإن شيّده وبنى عليه في الاُصول .
الوجه الثاني: وبالبيان المذكور في ردّ الوجه الأوّل ظهر وجه آخر لعدم شمول المطلقات للموضوعات الحديثة ، زيادة على ما تقدّم من دعوى الانصراف ، مع ردّه .
(الصفحة42)
الوجه الثالث: كما أنّه قد يوجّه ذلك بوجه آخر : ويُقال بناءً على عدم جواز التمسّك بالإطلاق بعد إحراز كونه في مقام البيان من جهة ، لسائر الجهات التي يشكّ في كونه بصدد البيان لها ، فإنّه واضح كون المطلقات بصدد بيان الأفراد والموضوعات المعاصرة للخطابات ، فإنّها من قبيل ما هو مورد في الخطاب والسؤال ، والتي لا يمكن تخصيص النصّ بغيره جزماً ، وأمّا الموضوعات الحديثة فكون المطلق بصدد بيانها مشكوك .
لكنّ المبنى غير واضح وإن تبنّاه سيّدنا الأستاذ (قدس سره) . وما بناه على ذلك من المثال والحكم في قوله تعالى: { فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1) حيث لا يحكم بطهارة موضع عضّة الكلب; لكون الآية بصدد بيان حصول التذكية ، ولم يعلم كونها بصدد بيان الطهارة الفعليّة في مقابل النجاسة العرضيّة فلا يبتني عليه خاصّة بل يتلاءم مع خلافه ، لكون دعوى الجزم بعدم كون الآية بصدد بيان الحكم من جهة النجاسة العرضيّة بحيث لو لم يتمّ دليل على النجاسة كنّا بحاجة إلى دليل غير الآية لإثبات الطهارة ـ ولو كان أصلاً عمليّاً كأصالة الطهارة ـ غير مجازفة .
الوجه الرابع: قصور العمومات عن شمول المصاديق الحديثة، إنّ قصارى ما تقتضيه العمومات هو الشمول والعموم لما هو مصداق ما وضع له اللفظ ، فمعنى الشعراء هو كلّ من يصدق عليه الشاعر ووضع له لفظه; والألفاظ هي موضوعة للمعاني المتصوّرة للواضع ، ولمّا كانت المصاديق الجديدة غير متصوّرة له بل وغير معقولة عنده أحياناً ، كان وضعه للألفاظ مختصّاً بغير المصاديق الجديدة .
ألاترى أنّ لفظة الأمّ موضوعة للتي تحمل الولد في بطنها بعد نشوء الولد من مائها; ولمّا لم يتصوّر الواضع نشوء الولد من ماء امرأة وحمل امرأة أخرى له ، لم تكن مثل هذه الاُمومة والولادة مورد وضع اللغوي القديم; ومعه فقصور عموم الأمّ عن
- (1) سورة المائدة الآية 4 .
(الصفحة43)
مثل هذه المرأة في مثل قوله تعالى في عداد المحرّمات: {أُمَّهَاتُكُمْ}(1) وكذا {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(2) إنّما هو سالب بانتفاء الموضوع لا أنّها أُمّ والعموم قاصر عن شمولها .
وحكم العرف الفعلي بكون هذه المرأة أُمّاً ، يكون وضعاً جديداً للّفظ; وسيأتي إن شاء الله أنّ العبرة بالعرف المعاصر للخطابات ، وأنّ العرف الحديث راجع إلى وضع جديد لا موجب لحمل الألفاظ عليه كما لا يخفى .
وعلى أساسه ذكرنا أنّ العرف القديم لو اعتبر الميّت الدماغي حيّاً ترتّبت أحكام الحيّ عليه، ولاعبرة باعتبارالعرف الفعلي موته كما لا عبرة بالعرف الخاصّ.
نعم ، الوضع الجديد للفظ الأمّ ربما كان بمناسبة وضع القديم ، بحيث لو كان العرف القديم حاضراً لوضع اللفظ بإزاء ما وضعه العرف الفعلي; لشدّة المناسبة بين المعنى القديم والفعلي ، ولكن أين هذا من الوضع بالفعل من العرف القديم؟
ولعلّ أقوى وجه يمكن أن يقرّر به قصور العمومات عن شمول المصاديق الحديثة هو هذا .
ومع ذلك فهو مردود أوّلاً: بأنّ المصاديق الجديدة ربما تكون متصوّرة للواضع القديم ولو إجمالاً أو احتمالاً ، فيضع اللفظ للجامع .
ألاترى أنّ عدم وجود بعض الأشياء فعلاً لا يمنعنا من وضع لفظ لها على تقدير وجودها .
وثانياً: أنّ هذا البيان مبتن على أن يكون الوضع بلحاظ مصاديق المعنى من قبيل الجمع في اللحاظ ، فإذا لم تُلحظ بعض المصاديق خرج عن حدّ الوضع .
مع أنّ من القريب جدّاً كونه من قبيل رفض القيود على نحو ما يقرّر به الإطلاق في بحث المطلق والمقيّد; فمثل كلمة النور موضوعة لما يضيء ولم يلحظ معه كون الإضاءة بدهن أو نفط وغيرهما من الوقود القديم أو كونها بكهرباء أو قوى
- (1، 2) سورة النساء : 23 .
(الصفحة44)
حديثة أو لم تحدث بعد .
فالميتة هي ما عدمت الحياة سواء كان ذلك بذبح بسكّين أو بقنابل ذرّية أو أسلحة فتّاكة أخرى لم تحدث بعد .
ياترى أنّ العرف القديم لا يعتبر ـ بناءً على نفس وضعه ـ لفظة «الميتة» شاملة لمثل هذه المصاديق الحديثة ويرى وضعه قاصراً عن شمولها؟ ما أظنّك تحتمل ذلك فضلاً عن أن تظنّ .
وقس على ما ذكرنا بقيّة موارد الأوضاع والألفاظ والمصاديق تجد صدق ما ادّعيناه .
نعم ، ربما يشكّ في شمول بعض الألفاظ لبعض الموارد كالأمّ لذات الرحم المستأجرة; ولكن ليس هذا لمجرّد كون هذه مصداقاً جديداً ، بل لكون المعنى الوضعي للأمّ هو ما يقصر عن شمول مثل هذه ولو احتمالاً .
الوجه الخامس: هو أنّ شمول العموم والإطلاق لفرد هو فرع إمكان التخصيص والتقييد بغيره ، وهو موقوف على عدم كون التخصيص مستهجناً ، مع أنّ تخصيص العمومات بغير المصاديق الجديدة مستهجن ، وهو يستلزم قصور العمومات عن شمولها .
ألاترى أنّه من المستهجن أن يقول الشارع في عصره: المسافر بغير السيّارات والطائرات ثمانية فراسخ يقصّر ، فيما كان الحكم الواقعي مقيّداً .
وفيه: أوّلاً : إمكان التقييد وعدم استهجانه فيما إذا أخبر بوجود وسائل حديثة للسفر .
وثانياً: إمكان الوصول إلى النتيجة ببيان آخر، كأن يقول: المسافر مسيرة يوم يقصّر ، وهذا شامل للأسفار القديمة والحديثة فيما كان الموضوع ذلك .
(الصفحة45)
الوجه السادس : قصور إطلاق حرمة الأعيان عن تحريم ما ناسبها حديثاً وكذا الكلام في قصور إطلاق حلّ الأعيان:
قد يقال: إنّ من جملة المحرّمات في الشريعة هي الأعيان; وتحريمها بمعنى تحريم الفعل المناسب لها; فكيف يتمسّك بإطلاق حرمة العين لتحريم الاُمور التي حدثت مناسبتها للعين في زمان متأخِّر؟! ومنه يظهر الكلام في إطلاق حلّ الأعيان كحلّ بهيمة الأنعام .
ويرد عليه: أنّه لا منافاة بين ما سبق منّا ويأتي إن شاء الله تعالى ـ وقد أصررنا عليه ـ من حجّية الإطلاقات في الموضوعات الحديثة وبين تخصيص حرمة الأعيان، كآلات اللهو بخصوص المنافع المقصودة من تلك الأعيان كالآلات في عصر التشريع وجواز الانتفاع بها في المنافع الحديثة، وأنّ حرمتها مخصوصة بالاستفادات الشائعة في تلك الأعصار; كلّ ذلك للفرق بين الملاكين . ومن بيان الكلام في حرمة الأعيان يظهر ما ينبغي القول به في حلّها .
بيان ذلك: أنّ ملاك حجّية الإطلاقات في الموضوعات الحديثة هو شمولها لها فإطلاق «المسافر يقصر» يشمل المسافر بالوسائط الحديثة لشموله للسفر بالدواب والنعم ومجرّداً عن أيّ مركب.
وأمّا تحريم الأعيان فلمّا لم يكن له معنى إلاّ حرمة الأفعال المناسبة عرفاً لتلك العين لعدم تعقّل حرمة العين بدون حرمة الأفعال المناسبة لها لم يكن مناص عن توجيه الحكم بالحرمة بذلك . فحرمة الاُمّهات بمعنى حرمة نكاحهنّ لا التكلّم معهنّ، بل ولا النظر إليهنّ ولا الإنفاق عليهنّ وهكذا; وحرمة الخمر بمعنى حرمة شربها; وحرمة الميتة تحريم لأكلها ، وهكذا .
غير أنّ نكتة توجيه حرمة الأعيان بما ذكرناه، هي أنّ التكليف لا يتعلّق إلاّ بما هو مقدور; والمقدور هو الأفعال المناسبة لها . ومعنى حرمة العين هو الحرمان منها
(الصفحة46)
والمنساق منه هو المنع من الاُمور المترقبة من موردها; وليست إلاّ الأفعال المناسبة لها .
الأفعال المرتبطة بالأعيان على أقسام خمسة:
أحدها: ما ناسب العين في عصر التشريع وكانت المناسبة معلومة للعرف .
ثانيها: الاُمور التي حدث استكشاف مناسبتها متأخِّراً.
ثالثها: وهي التي حدثت مناسبتها للعين في زمان متأخّر عن صدور الحكم; لا ما حدث العلم بمناسبتها متأخّراً . وسيأتي إمكان حدوث المناسبة كإمكان زوالها . والبحث في هذا القسم تارةً من ناحية المناسب الجديد واُخرى من ناحية المناسب القديم إذا زالت المناسبة فعلاً . وأمّا إذا كانت المناسبة باقية فلاريب في بقاء حكمه السابق . وإن شئت قسمت هذا القسم إلى قسمين; فإنّ البحث عن حكم الفعل المناسب القديم إذا زالت مناسباته فعلاً لا يختصّ بما إذا حدثت مناسبة جديدة ، وعليه فـ
القسم الرابع: الأفعال المناسبة في عصر التشريع مع زوال المناسبة فعلاً .
وقسم خامس: وهي الاستعمالات التي لا تناسبها; كاتّخاذ الدف مكيالاً والمزمار عصا ونحو ذلك .
ولاشكّ أنّ تحريم العين لا يدلّ على تحريم مثل هذه الأفعال غير المناسبة خلافاً لما يستفاد من كلام النراقي (قدس سره) في المستند ، في بحث آلات اللهو من كتاب الشهادات .
كما ولا يدلّ وجوب إتلاف العين على حرمة مثل هذه الأفعال في موردها; فإنّه لا ملازمة بين وجوب الإتلاف وبين حرمة الانتفاع بالعين منفعة غير مقصودة ، فلا يكون المنتفع بالعين حينئذ مرتكباً لمعصية زائدة على معصية عدم إتلاف العين واقتنائها من دون أن يكون الفعل غير المناسب حراماً آخر . بل ولا ملازمة بين وجوب إتلاف العين وبين حرمة المنافع المقصودة إلاّ بنوع من الملازمة العرفيّة . كما
(الصفحة47)
ولا ملازمة بين حلّ الانتفاع بالعين وبين جواز إبقائها إلاّ بنوع من الملازمة العرفيّة; دون الاستلزام العقلي .
نعم ، مقتضى الأصل فيما جاز الانتفاع به جواز إبقائه وصنعه واقتنائه; ولكن لو دلّ دليل على وجوب الإتلاف لا يستلزم إلغاء كلّ منافعها من حيث الحكم التكليفي وإن استلزم إلغاء منافعها من حيث التأثير في جواز إبقاء العين .
وإن شئت فقل: ربما كان تحريم المنافع المقصودة دليلاً على عدم جواز صناعة تلك العين وإبقائها إلاّ أنّه ليس في المنع من صناعة العين والأمر بإتلافها دلالة على تحريم منافعها المقصودة عقلاً ، فضلاً عن غير المقصودة .
نعم ، لا تكون المنافع مورد ترخيص فعلي; لأنّ المنافع من لوازم الوجود والمفروض كون الوجود في العين مبغوضاً . وملازم المبغوض وإن لم يكن مبغوضاً ولا محكوماً بحكمه إلاّ أنّه لا يمكن الحكم عليه فعلاً بما يضاد الملزوم وإن كان حكمه في نفسه مغايراً لحكم الملزوم إلاّ بنحو الترتّب .
وبالجملة: فالأفعال غير المناسبة للأعيان ليست محرّمة لا بدليل حرمة العين ولا بدليل وجوب إتلافها فيما كان يجب .
وإن شئت فقل: إنّ قصور إطلاق حرمة العين عن حرمة الأفعال غير المناسبة لها إمّا للانصراف وإمّا لعدم صدق حرمة العين بملاحظتها; فكما أنّ حرمة المنفعة غير المقصودة لا تستلزم صدق حرمة العين بل ولا ينافي صدق حلّها ، كذلك حلّ المنفعة غير المقصودة لا ينافي صدق حرمة العين . فالمنافع غير المقصودة خارجة عن إطلاق الموضوع المتعلّق للحكم حلاًّ وحرمة خروجاً موضوعيّاً بلا حاجة إلى الانصراف .
وعلى هذا الأساس ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) أنّه يشترط في صحّة البيع أن يكون المبيع مشتملاً على منفعة مقصودة ولو نادرة; وأنّه لا تكفي المنفعة غير المقصودة;
(الصفحة48)
والمراد بالمقصودة ما نعبّر عنه بالفعل أو الأمر المتناسب . كما أنّه بما ذكرناه اتّضح ضابط كون الشيء من المحرمات لئلاّ يجوز بيعها وأنّه ما لم يحرم جميع منافعه المقصودة لا يصدق حرمته بقول مطلق .
وأمّا الأفعال المناسبة فيمكن أن تكون ملحوظة بوجهين:
أحدهما: لحاظها على وجه الموضوعيّة وبملاك المناسبة.
ثانيهما: أن تكون ملحوظة على وجه الإشارة .
وبالجملة: لمّا كان تحريم العين بمعنى تحريم الفعل المناسب لها فكما يمكن لحاظ الفعل المناسب بما أنّه مناسب ، موضوعاً للحكم حتّى أنّه إذا هجر ذاك الفعل بالنسبة إلى تلك العين زال الحكم عنه وكان كالأفعال غير المناسبة أصلاً خارجاً عن موضوع الحكم ، كذلك يمكن لحاظ الفعل المناسب في عصر التشريع بشخصه موضوعاً للحكم حتّى لو زالت المناسبة بقي الحكم لكون الموضوع والعين من قبيل العنوان المشير، وتكون مناسبة الفعل للعين مصحّحة لإرادة الفعل من تحريم العين ويكفي في صحّة ذلك ، المناسبة حين استعمال اللفظ وإن زالت بعده .
مثال ذلك هو: أنّ المناسب للدم في عصر التشريع هو أكله فتحريمه تحريم لأكله، فإذا تعارف استعمال الدم في غير الأكل وصار الأكل مهجوراً عند الناس لا بما هم متشرّعة بل بما هم عرفيّون فاستعملوه في تزريقه في العروق، فإن كان الدم عنواناً مشيراً إلى الأكل حرم أكل الدم حتّى في عصر هجر أكله وجاز استعماله تزريقاً في العروق.
وإن كان استعمال الدم له موضوعيّة فيكون التحريم في كلّ عصر متعلِّقاً بما يناسب الدم من وجوه الاستعمال . والاستعمال غير المناسب لا يكون محكوماً بالحرمة وإن كان في بعض الأزمنة السابقة مناسباً .
وعليه فلا يجوز تزريق الدم في عصر تعارفه وهجر أكله ولا يكون أكله حينئذ
(الصفحة49)
محرّماً بدليل حرمة الدم . نعم، جوازه بملاك الضرورة شيءٌ آخر.
ومن قبيله ما إذا حكم بحرمة اللعب بآلة القمار وفرض خروج الآلة القمارية عن كونها كذلك في عصر، فإن كان لآلية القمار بالفعل موضوعيّة في الحكم بالحرمة فإذا زالت الآلية في زمان زال الحكم بتبعه; وإذا كانت آلة القمار عنواناً مشيراً لمصاديقها المعاصرة للخطاب بقى الحكم بعد انقضاء آليتها للقمار .
القضايا الشرعيّة حقيقيّة لا مشيرة:
ولكن الأمر في المثال هذا أهون; لأنّ الظاهر ـ بمقتضى كون القضايا الشرعيّة حقيقيّة ـ كون آلية القمار دخيلة في الحكم يبقى الحكم ببقائها ويزول بزوالها .وربما كانت فتوى بعضهم بجواز اللعب بآلة الشطرنج إذا خرجت عن كونها آلة قمار عند العرف واستعملت لتحديد الذهن وجودته مبنيّاً على هذا الأساس . وإن كان يرد عليه أنّ حرمة الشطرنج موضوعها الشطرنج وهو باق بعد انقضاء آليتها للقمار عرفاً . نعم ، لو كان الموضوع هو آلة القمار كان الحقّ كما في الفتوى المتقدّمة .
كما أنّ الشطرنج إذا كان اسماً لنفس اللعب بالآلة الخاصّة لم يكن تحريمه من تحريم العين بل تحريم للفعل الاختياري مباشرة .
واحتمال دخل آلية القمار عرفاً في حرمة اللعب بالشطرنج ، يدفعه إطلاق المنع عن الشطرنج .
ومجرّد تعارف اللعب بالشطرنج قماراً لا يصلح مقيّداً لإطلاق الحكم; شأن سائر التعارفات الخارجيّة .
ومن هذا القبيل حرمة الملاهي لا بعنوانها بل بعناوينها الخاصّة كحرمة المزمار فإنّها لا تزول بخروج المزمار عن كونه آلة لهو واستعماله في غير الملاهي .
نعم ، لو كان الموضوع هو الملهى كان حرمة المزمار حدوثاً وبقاءً دائرة مدار
(الصفحة50)
كون المزمار آلة لهو حدوثاً وبقاءً .
وعلى هذا الأساس يمكن الحكم في سائر المقامات بمقتضى كون القضايا في النصوص الشرعيّة منزلة على القضايا الحقيقيّة; فحرمة كلّ عين بمعنى حرمة ما يناسبها من الأفعال في كلّ عصر بحسبه . فيكون استعمال العين على الوجه المناسب لها في كلّ عصر هو موضوع الحكم . فيتغيّر موضوع الحكم بحسب الانطباق خارجاً باختلاف الاستعمالات المناسبة .
والأولى أن يُقال: إنّ كون القضيّة عنواناً مشيراً على خلاف الأصل والظاهر، من كون الموضوع الواقعي مطابقاً لما اُخذ في القضيّة موضوعاً للحكم; وإن كان المشير لا ينافي كون القضيّة حقيقيّة .
كما أنّ ما ذكرناه ـ من كون حرمة الشيء بمعنى حرمة الاُمور المناسبة معه ـ لاينافي قيام القرينة على كون موضوع الحرمة هو شيء خاصّ لا مطلق ما يناسبه وإن كانت القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع; فإنّ ما ذكرناه هو مقتضى إطلاق الحكم وبدونه فالمتبع القرينة .
ففي الدم ما دام الاستعمال المتعارف هو الأكل فهو الموضوع للحرمة; وإذا هجر الأكل وتعارف استعمال آخر تبدّل موضوع الحكم مصداقاً، وكان المحرم هو غير الأكل من الاستعمال المناسب فعلاً . وأمّا الأكل فلا يكون حراماً لمجرّد دليل حرمة الدم .
نعم ، لو كان هناك دليل بعنوان حرمة أكل الدم حرم وإن هجر أكله خارجاً .
وبالجملة فرق في الحكم بين أن يكون التحريم متعلّقاً بعنوان الدم فتكون حرمة أكله دائرة مدار كون الأكل منفعة مقصودة للدم حدوثاً وبقاءً ، وبين كون التحريم متعلِّقاً بعنوان أكل الدم فيكون الأكل حراماً سواء كان منفعة مقصودة أو لم تكن أو كان كذلك حدوثاً لا بقاءً .
(الصفحة51)
وربما يمكن القول بأنّ العبرة في تحريم الأعيان بما يعدّ استعمالاً متعارفاً ومقصوداً لتلك العين في عصر التشريع وصدور النصوص وعرفه الناس آنذاك . فإنّ المخاطب بحرمة الدم هو سلمان ومقداد وغيرهما . فما يكون استعمالاً متعارفاً للدم في عرف سلمان فهو المحرم عليه; ويحرم علينا ذلك أيضاً بقاعدة الاشتراك . وبهذايقرّر قصورإطلاق حرمة الأعيان عن مناسباتهاالحديثة في الأعصار المتأخّرة .
ويمكن الإجابة على ذلك بأنّه: كما يحتمل ذلك ، يحتمل كون حرمة الاستعمالات المناسبة للدم في عرف سلمان عليه بعنوان كونها استعمالات مناسبة; وهذا العنوان غير متحقّق في تلك الاستعمالات في عرفنا، فلا موجب لتسرّي حكمها إلينا بقاعدة الاشتراك ، بل لو ثبت تحريمها كان بدليل آخر مفقود فرضاً .
الاستعمالات المناسبة للعين إذا كانت مجهولة قديماً
ينبغي التفطّن لنقطة هي: أنّ حرمة العين وإن كانت بمعنى حرمة الاستعمالات المناسبة لها; ولكن ربما يكون الاستعمال المناسب مجهولاً لأشخاص، وهذا لا ينافي اندراجه في عموم التحريم . فلو كنّا نحن ودليل حرمة الدم كان مقتضاه بالغضّ عن الاضطرار حرمة الاستفادة منه حتّى في تزريقه في العروق لمعالجة المرضى وإن كان هذا الاستعمال مغفولاً في عصر التشريع وصدور النصوص .فحرمة الاستعمالات المفهومة من حرمة الأعيان يُراد بها الاستعمالات المناسبة لا المتعارفة خارجاً . ولو عبّر بالاستعمال المتعارف فالمراد به ما ذكرناه . ويقابله الاستعمال غير المناسب، وإن تعارف فإنّه لا يدخل في حرمة العين . فالتسميد باللحوم المقصود بها الأكل خاصّة وإن تعارف إلاّ أنّه استعمال غير مقصود من اللحم وغير مناسب له، وإنّما يصير إليه المتشرّع لمنعه عن الاستعمال المناسب للحم، فلاحظ ولا تخلط .
(الصفحة52)
ضابط المكيل والموزون الذين يحرم الربا فيهما مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فيهما
ونحوه الكلام فيما إذا كان شيء مكيلاً أو موزوناً في مكان أو بلد ، غير موصوف بالوصفين في بلد آخر .
ويظهر من بعض كلماتهم أنّ العبرة في الوصفين بما كان كذلك في عصر الشارع; ولكن للإجماع; على خلاف القاعدة .
قال في الجواهر: «وحيث عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقّق الربا في المعاوضة فينبغي أن يعلم أنّ الاعتبار في ذلك بعادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) بنى عليه حكم الربا إجماعاً محكياً في التنقيح إن لم يكن محصّلاً وإن تغيّر بعد ذلك; بل فيه أيضاً: إنّه ما علم أنّه غير مكيل ولا موزون في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) فليس بربوي إجماعاً; ومقتضاه وإن كيل أو وزن بعد ذلك; وكأنّ الوجه في الأمرين بعد الإجماعين المعتضدين بالتتبّع ، الاستصحاب السالم عن معارضة قاعدة «دوران الحكم المعلّق على الوصف مداره وجوداً وعدماً» بعد تخصيصها بغير المقام ولو للإجماع السابق; أو لأنّها حيث يكون التعليق على الوصف المعلوم مناسبته; أو لأنّ المراد منها زوال الحكم عن الفرد الفاقد للوصف
(الصفحة53)
من أصله لا الذي تلبّس به ثمّ زال عنه . أو لغير ذلك ممّا يشترك في كون المدار هنا على ما عرفت، من أنّ وجود الكيل والوزن في ذلك العصر كاف في تحقّق الربا كما أنّ الجزافية مثلاً فيه تكفي في تحقّق عدمه»(1) .
أقول: إنّما ذكرنا عبارة الجواهر هنا استشهاداً بما جعله مقتضى القاعدة من دوران الحكم المعلّق على وصف مدار الوصف وجوداً وعدماً، والتي تجري في المقام أيضاً من كون حرمة العين بمعنى حرمة ما يناسبها من الأفعال، والتي تدور مدار بقاء المناسبة فتحرم معها وتزول الحرمة بزوالها .
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من وجوه تخصيص القاعدة في مسألة الربا فالإجماع منها إن تمّ ـ ولا نظنّه ـ فهو وإلاّ فبقيّة ما ذكره (قدس سره) فهي غريبة من مقامه (قدس سره) لا تليق بمن هو دونه سيّما الأخير منها فإنّه هدم للقاعدة ونقض لها; ولكنّ الجواد قد يكبو; عصمنا الله من الزلّة يوم العثرة .
والذي ينبغي أن يقال في مسألة الربا هو أنّه إذا اختلفت الأزمنة في اعتبار شيء موزوناً أو مكيلاً أو مبيعاً جزافاً أو معدوداً أو اختلفت الأمكنة في ذلك كما هو المشهود في جملة من الاُمور فالحكم مختلف.
أمّا مع اختلاف الأزمنة فالعبرة في كلّ زمان بما تعارف اعتبار الشيء به من كيل أو جزاف; فإن كان مكيلاً أو موزوناً جرى حكم الربا فيه; وإن كان مبيعاً جزافاً أو معدوداً ـ والضابط غير مكيل ولا موزون ـ فلا يجري فيه حكم الربا; كلّ ذلك لكون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فعلاً بالمبدأ مجازاً في المنقضى عنه أو المتلبّس بالمبدأ فيما بعد .
وأمّا مع اختلاف الأمكنة فالمعروف هو أنّ العبرة في كلّ بلد بالمتعارف فيه،
- (1) الجواهر 23: 362 ، كتاب التجارة ، الربا .
(الصفحة54)
فيختلف جريان حكم الربا باختلاف البلدان في ذلك الجنس، فيحرم الربا فيه في البلد الذي يعتبر الجنس فيه بالكيل والوزن ولا يحرم في غيره .
ثمّ وقع الكلام بينهم فيما إذا كان المتعاملان من بلدين، فالعبرة ببلد أيّهما أو أنّ العبرة ببلد المعاملة . ثمّ يقع الكلام فيما إذا وقعت المعاملة بمثل المخابرة أو المكاتبة . والمعاملة اسم لمجموع طرفي العقد ، فلا يصدق على أيّ البلدين أنّه بلد المعاملة بل هو بلد شطر المعاملة من خصوص الإيجاب أو القبول .
ولكن الذي تقتضيه القاعدة هو كفاية كون الشيء مكيلاً أو موزوناً في بلد متعارفاً في حرمة الربا فيه في كلّ البلاد; بل لو بيع ذلك في بلد واحد على الوجهين حرم الربا فيه على الإطلاق.
والوجه في ذلك كلّه هو صدق الطبيعي بصدق فرد وتحقّقه; فيصدق على الشيء أنّه يُكال ويوزن ويعتبر بهما إذا كان كذلك في بعض البلاد أو في بلد أحياناً . فهو نظير ما ورد من منع السجود على المأكول والملبوس حيث اكتفوا في الحكم ذلك بتعارف الأكل في بعض البلاد وإن لم يعمّ أكله في كلّ الأصقاع . فلا يجوز السجود على ما يأكله أهل بلد واحد حتّى في بلد لا يأكلون ذلك; لتنفّرهم منه .
نعم ، قد يقال: كما أنّ صدق المكيل والموزون يستدعي حرمة الربا ، كذلك صدق عدم كونه مكيلاً أو موزوناً لكونه مباعاً جزافاً أو معدوداً أيضاً يستلزم صحّة بيعه بالتفاضل وعدم جريان حكم الربا فيه .
ولكنّه لو لم يكن من قبيل تعارض المقتضي واللامقتضي ، لما أن كون الشيء معتبراً بغير الكيل والوزن لا يستدعي حرمة الربا لا أنّه يقتضي صحّة المعاملة.
يرد عليه: أوّلاً أنّه يكفي في صدق الطبيعي وجود فرد ولا يكفي في انتفائه إلاّ انتفاء كلّ الأفراد; فيصدق كون الشيء يكال أو يوزن ـ على ما في النصّ ـ إذا كان كذلك في بعض الأمكنة ولا يصدق أنّه لا يكال ولا يوزن إلاّ إذا لم يكن يوزن أو
(الصفحة55)
يكال أصلاً ، ففي معتبرة منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث: «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»(1) .
نعم ، لو تضمّن دليل جواز الربا في المعدود ونحوه بعنوانه لا بعنوان أنّه لا يكال ولا يوزن وقع التعارض .
وما في بعض النصوص من جواز الربا في الشاة والبيضة ونحوهما فلعلّه من جهة كونها مصداقاً لما لا يكال ولا يوزن، على ما في صحيح منصور المتقدّم بعد السؤال عن البيضة بالبيضتين والثوب بالثوبين لا من جهة صدق المعدود ونحوه، فلاحظ .
وبالجملة: فإنّي لم أظفر عاجلاً على نصّ معتبر دالّ على جواز الربا بعنوان المعدود ونحوه، وإنّما الذي وجدته هو جواز الربا في غير المكيل والموزون . وكلام الفقهاء ناظر إلى ما هو معدود بالحمل الشائع .
وثانياً: أنّ نهاية الأمر هو تعارض مقتضي صحّة البيع وفساده من النصوص الخاصّة، فيرجع إلى العموم الفوقاني السليم عمّا يصلح مخصّصاً له، وهو ما دلّ على صحّة التجارة عن تراض ونحوه; خرج منه المكيل والموزون في كلّ البلاد وبقي المختلف فيه تحته .
هذا إن لم نقل بتقديم ما وافق القرآن ممّا دلّ على صحّة البيع الربوي في غير المكيل والموزون الذي يكفي في صدقه عدم كون الشيء مكيلاً ونحوه في بعض البلدان .
وقد يدفع ذلك بأنّ: مقتضى عموم الكتاب وإطلاقه حرمة الربا; خرج منه ما
- (1) الوسائل 12: 448 ، الباب 16 من الربا ، الحديث 3 .
(الصفحة56)
كان غير مكيل ولا موزون في كلّ مكان وبقي المختلف فيه تحته .
وإذا تعارض دليل حرمة الربا ودليل صحّة البيع، فلو لم نقل بحكومة الأوّل على الثاني للنظّارة فيحكم بالتساقط والأصل في المعاملات يقتضي الفساد .
إلاّ أن يقال بعدم كون آية حرمة الربا في مقام البيان ، كما أنّها ليست في مقام البيان بلحاظ البيع; ومع عدم الإطلاق يكون المرجع ما دلّ من الآيات على نفوذ المعاملات مرجعاً أو مرجّحاً لما دلّ على صحّة البيع من غير الآيات على تقدير تعارض نصوص بطلان الربا مع نصوص صحّة البيع .
ومن الغريب أنّ سيّدنا الأستاذ (قدس سره) فصّل بين المأكول الذي منع من السجود عليه، فاكتفى في المنع بما يؤكل في بعض البلاد وبين المكيل ونحوه، فاعتبر لكلّ بلد حكماً غير ما للآخر; مع أنّه إن كان يصدق في المأكول كون الشيء مأكولاً للإنسان إذا كان مأكولاً لبعضهم لزمه صدق كون الشيء مكيلاً إذا كان مكيلاً عند بعض; فاعتبار كون الشيء مكيلاً عند الكلّ دون بعض البلاد في صدق كونه مكيلاً دون المأكول فلا يعتبر في صدقه الأكل عند الكلّ تحكم .
وقد اتّضح بما بيّناه في مسألة الربا حكم اشتمال العين على منافع مناسبة في بعض البلدان دون بعض وكذلك في زمان دون آخر، والاختلاف بين الأزمنة والأمكنة في المنفعة المقصودة . وقبل توضيح ذلك لا مناص من بيان:
ضابط المنافع المناسبة للأعيان:
قد تقدّم وتكرّر منّا ومن غيرنا أنّ تحريم العين، بمعنى تحريم ما يناسبها من الأفعال الاختيارية القابلة لتعلّق التكليف; والعبرة بالفعل المناسب هو ما ناسب العين عرفاً لا ما عيّنه الشارع كما هو الشأن في غير المقام .
ثمّ إنّ المناسبة لا تكون جزافيّة; بل للعرف ضابط لتحديد المناسبات ، والذي يلوح لي من ضابط المناسبة هو اشتراطها بأمرين:
(الصفحة57)
الأوّل: أن يكون بين العين بما لها من الخصوصيّات ـ ومنها الغلاء والرخص وإن كانا ناشئين من جهات اُخرى ـ وبين الفعل المتعلّق بها ربط مقبول عند العرف يعبّر عنه بالمناسبة; فلا عبرة بمثل إحراق القصب الغالي المتّخذ عند الناس لصنع المزامير ونحوها من الآلات; ولا يعدّ ذلك استعمالاً مناسباً لمثل القصب ذاك . كما ولا عبرة بالتسميد باللحوم المعدّة للأكل عرفاً كلحم الأنعام ونحوها، ولا يعتبر التسميد فعلاً مناسباً لها عرفاً .
كما ولا عبرة بالاستعمالات حال الضرورة إلاّ فيما كان الشيء معدّاً لحال الاضطرار كالأدوية . وعليه فمثل أكل شيء عند الضرورة كعام المجاعة لا يصيّره من المأكول; كما أنّ سائر الضرورات لا تصير الأفعال مناسبة وإن جاز الفعل بل وجب . فمن اضطرّ لوقاية نفسه أو غيره من البرد إلى إحراق ثوبه وما شاكل ذلك لا يكون فعله مناسباً لتلك العين وإن كان مضطرّاً إليه . وعليه فالمدار في المناسبة على الاستعمال في غير حال الضرورة إلاّ فيما اُعدّ للضرورات; ومنه اتّضح أنّ وجوبه لا يجعل الفعل مناسباً للعين بقول مطلق .
الثاني: أن لا يكون للعين غرض أهمّ وفعل أنسب بحيث يعدّ الفعل هذا من قبيل الفعل غير المناسب; بل ويعدّ صرف العين في تلك المنفعة سفهاً عند العقلاء كإطعام اللحوم المتّخذة لأكل الناس للكلاب وغيرها من الجوارح .
وعلى ما ذكرناه في ضابط الأفعال المناسبة فلكثرة العين تلك وقلّتها وغير ذلك من الأوصاف دخل في تحديد المناسبات .
فربما تكون العين لكثرتها يقصد منها أمران: أهمّ ومهمّ; بل وغير مهمّ; وقد تكون لقلّتها لا يقصد منها إلاّ المهمّ بل الأهمّ فلا يكون غير المهمّ ، بل حتّى المهمّ أمراً مناسباً لتلك العين; بخلاف القسم الأوّل فإنّ العين لكثرتها لما ناسبت الأهمّ والمهمّ وغيرهما كان تحريم العين تحريماً لكلّ مناسباتها .
(الصفحة58)
مثلاً تحريم التراب يفهم منه تحريم صرفه في طمّ الحفر وبناء الجدران والتطيين به وما شاكل ذلك; وأمّا تحريم أكله فلا يفهم من هذا وإن قام دليل آخر عليه; وهذا بخلاف تحريم الذهب على الرجال فلا يفهم منه حرمة طمّ الحفر به عليهم وما شاكل ذلك وإنّما يفهم منه تحريم التزيين به مثلاً .
كما أنّ العلم والجهل بالمناسبات ربما يكون لهما دخلٌ في تحديد المناسبات . فمن لا يعلم بوجود مناسبة بين نبات وبين علاج يكون المناسب لذاك النبات في عرفه مثل إطعام الحيوانات وإن كان المناسب للعالم بكونه معالجاً لمرض هو غيره .
نعم ، العلم لا يحدث التناسب، وإنّما يكشف عنه وإن كان يوجب زوال التناسب عن شيء آخر أحياناً .
إذا تمهّد ما ذكرنا فنقول: إنّ تحريم العين لمّا كان بمعنى تحريم مناسباتها فمع اتّحاد الأزمنة والأمكنة في مناسبات العين كما هو المشهود في كثير من الأعيان فالأمر واضح .
وأمّا مع اختلاف الأزمنة كما إذا افترضت العين مناسبة لأكل الناس والحيوانات في زمان لكثرتها جدّاً ، ثمّ فرضت مناسبة لأكل الإنسان خاصّة لقلّتها وعزّتها في بعض الأزمنة، فالتحريم في كلّ زمان يصرف إلى الفعل المناسب لتلك العين في ذلك الزمان; مثلاً حرمة الخمر بمعنى حرمة شربها وإسقائها للغير فيما كانت الخمر محدودة في الكم خارجاً ، وأمّا إذا كثرت حتّى صارت في الخارج كالمياه المطلقة في الشيوع ـ وهو مجرّد فرض ـ فنفس تحريم الخمر يقتضي تحريم إسقائها للحيوانات لأنّ الخمر لشيوعها بهذا الحدّ تناسب فرضاً إسقائها الحيوانات فضلاً عن الإنسان .
وعلى هذا الأساس إذا حرم اللعب بآلة القمار لم يجز اللعب بآلة هي وسيلة القمار فعلاً وإن لم يكن كذلك سابقاً أو لاحقاً; كما أنّه لا يقتضي هذا الدليل حرمة
(الصفحة59)
اللعب فعلاً إذا كانت الآلة حينئذ غير مقصود بها القمار عادةً بل تستعمل متعارفاً لغرض آخر .
وإنّما قلنا بقصور هذا الدليل تحرّزاً عمّا إذا كان الدليل على تحريمه بعنوان آخر كعنوان الشطرنج الصادق حتّى مع خروج الآلة عن الإعداد للمقامرة، فإنّه يحرم اللعب به لذلك وإن لم يعد ذلك لعباً بآلة القمار بل بما كان كذلك سابقاً; وهذا ليس بمحذور .
وأمّا مع اختلاف مناسبات العين باختلاف الأمكنة فمقتضى القاعدة مراعاة كلّ مكان في الحكم; فإذا كان المناسب للعين في بلد شيء وفي بلد آخر غيره كان تحريم العين بلحاظ أهل كلّ بلد ما ناسبها عندهم من الفعل .
كلّ ذلك لأنّ معنى تحريم العين هو تحريم ما ناسبها من الفعل; ومناسبة الحكم والموضوع يقتضي تحريم ما ناسبها في نظر المكلّف لا ما ناسبها في نظر غيره .
وبهذا يفترق عن مثل تحريم السجود على المأكول، حيث يحمل على كلّ مأكول ولو لطائفة، فلا يجوز السجود لغيرهم على ذلك أيضاً; ولا يخصّ بخصوص ما يأكله المكلّف المحكوم عليه بحرمة السجود . وذلك لإطلاق المأكول لمثله; وكذلك في تحريم العين، فإنّ الفعل المناسب للعين وإن صدق على ما يناسبها عند طائفة دون غيرهم; ولكن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي تحريم الفعل المناسب على خصوص من يرى المناسبة لا غيره .
وبالجملة: فالمحرم هو ما يكون استعمالاً للعين بنظر المستعمل ولا يكون كذلك إلاّ مع المناسبة عند المستعمل; ولا يكفي لذلك ثبوت المناسبة في نظر غيره من الناس والطوائف ، فلاحظ وتأمّل . إذ لا فرق بين مثل حرمة السجود على المأكول والملبوس الذي يقال بكفاية الأكل واللبس في بعض الأصقاع للمنع من السجود ، وبين مثل حرمة عين لها منفعة خاصّة في بعض الأصقاع; فإنّ ذلك يكفي في الحكم
(الصفحة60)
بتحريم تلك المنفعة حتّى لمن لا ينتفع بتلك العين ولا يتعارف عندهم ذلك .
وبالجملة: فمصحح التعبير عن حرمة الفعل بحرمة العين هو مناسبة الفعل الخاص للعين المعيّنة عند طائفة; فلا يكون لمناسبة الفعل عند كلّ طائفة مدخل في تحريم ذاك الفعل عليها، بل الموضوع هو الفعل المناسب عند بعض فيحرم على الكلّ، فلاحظ .
ثمّ إنّه يمكن أن يفصل في إطلاق حكم الأعيان لمناسباتها الحديثة، بل المعلوم مناسبتها جديداً بين ما إذا كان الحكم صادراً من مصادر التشريع ابتداءً وبين ما إذا كان صادراً بعد السؤال ، ففي الثاني ينصرف الحكم إلى خصوص المناسبات القديمة بل المعلوم مناسبتها سابقاً، فإنّه الذي يقع مورداً للسؤال لأنّه مورد الابتلاء . وأمّا المناسبات الحديثة بل المعلومة حديثاً فليس منظوراً للسائل . وبهذا يمتاز الحكم القرآني بل الأحكام الصادرة من الأئمّة (عليهم السلام) ابتداءً عن غيرها.
ولكن الظاهر عدم الفرق في اعتبار الإطلاق بين المسبوق بالسؤال وغيره ما لم تقم قرينة خاصّة على ذلك; فإنّ السؤال وإن قارن الاعتقاد بعدم اندراج مورد خاصّ تحته لخروجه عن الموضوع المفروض، ولكنّه لا يوجب تقييد السؤال بغير ذلك المورد ، فهو كما لو سأل عن حكم النهار معتقداً دخول الليل وانقضاء النهار أو بالعكس. وهكذا سائر الموضوعات ممّا لا أثر لاعتقاد تحقّقها أو انتفائها في ترتّب الحكم، وإنّما للعقيدة تأثير في انكشاف اندراجها في موضوع الحكم وعدمه. فلو سأل عن حكم الحيّ معتقداً كون زيد ميّتاً بذبح ونحوه، لا ينافي ذلك اندراج زيد تحت حكم السؤال لمن اعتقد حياة زيد; لعدم كونه مذبوحاً بنظره. فكذا لو سأل عن حكم الحيّ معتقداً لموت الميّت الدماغي ، فإنّه لاينافي ترتّب ذاك الحكم على هذا المورد.
وبالجملة: فموارد الاشتباه في المفهوم كموارد الاشتباه في الموضوع لا تؤثّر في
(الصفحة61)
منع الإطلاق، والله العالم .
ولصاحب العناوين في العنوان السادس (تبعيّة الأحكام للأسماء) بعض ما يناسب المقام، وقد عثرنا عليه أخيراً بعدما حقّقنا البحث وفرغنا عنه وإن كان بعض ما أفاده محلّ إشكال بل منع، فراجعه إن شئت .
ثمّ إنّ في مسألة الربا في المكيل والموزون نقاطاً نتعرّض لها استطراداً:
1 ـ العبرة في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً بكونه كذلك عرفاً . فلو كان شيء مكيلاً عرفاً وفرض جواز بيعه شرعاً جزافاً لم يجز الربا فيه; وذلك كما في غير المورد من الاستعمالات الشرعيّة، فإنّها لا تكون إلاّ بلحاظ العرف . فمعنى المكيل ما يكون مكيلاً عرفاً لا ما يجوز بيعه أو يتعيّن بيعه كذلك شرعاً .
وعليه فلو فرض جواز بيع بعض الأشياء في بعض الحالات خرصاً شرعاً ولم يكن بيعه كذلك معهوداً عرفاً حرم الربا فيه ولو في حال بيعه خرصاً .
بل يحتمل إطلاق ما يُكال ويُوزن لما يباع جزافاً أحياناً عرفاً لصدق كون الحنطة أو التمر مثلاً موزوناً أو مكيلاً مع بيعهما عرفاً بالخرص قبل الحصاد والجذاذ .
نعم، لو كان الموضوع ما كيل أو وزن بالفعل لم يشمل ما بيع خرصاً، فلاحظ وراجع . ولكن الظاهر أنّ العبرة في كلّ صنف من نوع به; فما كان صنف منه مكيلاً لا يعدّ صنفه الآخر كذلك على حساب الصنف الأوّل . ولا يعدّ النوع مكيلاً على الإطلاق على حساب بعض أصنافه .
2 ـ العبرة في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً هو كونه كذلك في نفسه; لا مع كون الكيل والوزن عبرة لغيرهما من العدّ ونحوه . فما تعارف من وزن النقود المسكوكة التي يعسر عدّ الكثير منها ، ولكن التوزين مقدّمة للتحقّق من عدد خاص، وإلاّ فمادّة تلك النقود ليس كالذهب والفضّة ممّا له ماليّة ذاتيّة ، لا يوجب كون مثل ذلك
(الصفحة62)
موزوناً يحرم الربا فيه .
3 ـ قد ورد في بعض النصوص: «أنّ الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين جائز» فظاهر النصّ هو جواز التفاضل في ذلك لعدم كونهما من المكيل والموزون، بل هما من المعدود . ولكن إذا فرض تعارف توزينهما وخروجهما من المعدود كما في بعض أصناف البيض في زماننا ، لم يجز الربا فيهما .
4 ـ ظاهر النصّ ومجرى السيرة هو بيع بعض الأشياء بالمشاهدة والعدّ، كما في الحيوانات حتّى التي يقصد أكلها فضلاً عن غيرها; والمقصود في مثل الأنعام لحمها فتباع بلا توزين مع تردّد وزنه وعدم تعيّنه للمشتري.
مع أنّ ظاهر الفقهاء هو عدم جواز بيع اللحم بالمشاهدة عند تردّد وزنه بما كان مردّداً به قبل الذبح.
فإمّا أن يكون الفرق من جهة تخصيص قاعدة النهي عن بيع الغرر في بعض الفروض أو يكون من جهة عدم صدق الغرر والخطر بمثل هذا التردّد في الحيوان الحيّ; وحيث لا خصوصية لذلك فينبغي التعدّي إلى الحيوان المذبوح لكون إقدام الناس على المعاملة في فرض التردّد في الوزن بهذا المقدار ، حاكياً عن عدم تحقّق خطر بل هو ممّا يتسامح فيه ولا يعدّ خطراً; فإنّه لا فرق في صدق الخطر بين كون الحيوان حيّاً أو مذبوحاً، فلاحظ .
وإن شئت قلت: إنّ هذا التشديد في فتوى الفقهاء في لزوم الكيل والوزن وعدم جواز التسامح بما تعارف التسامح به في شيء أو في أمثاله ، مع كون عمدة الدليل على لزوم الكيل حديث الغرر ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، والله العالم .
الوجه السابع: ثمّ إنّك حيث عرفت أنّ مصداق المحرم والمحلّل فيما حرمت العين أو حلّت ربما يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الفعل المناسب للعين في كلّ عصر
(الصفحة63)
إذا لم يكن هناك انصراف إلى تحريم فعل مناسب في زمان خاصّ أو تحليله إلى الأبد ، فربما يشكل الاعتماد على النقل فيما إذا احتمل أنّ الراوي في مقام حكايته الحديث كان قاصداً للمعنى لا حاكياً لعين لفظ المعصوم (عليه السلام) أو ما يرادفه من الألفاظ .
مثلاً لو احتملنا أنّ الإمام (عليه السلام) حكم بحرمة الطين الخاص، ولكن لمّا كان الأكل هي المنفعة المناسبة له في ذلك الزمان عبّر عنه الراوي بحرمة أكل الطين لما أنّ مصداق حرمة الطين في عصره هو ذلك ، والمفروض أنّ النقل بالمعنى جائز فكيف يجوز لنا التمسّك لحرمة أكل الطين ذاك بمثل نقله هذا في عصرنا مع أنّ الأكل ليس منفعة مناسبة لذلك أصلاً فرضاً .
وهذا البيان مع كونه إشكالاً في حجّية الخبر في بعض الموارد يصحّ أن يقرّر إشكالاً في حرمة المنافع المتجدّدة للأعيان; وذلك بالنظر إلى أنّ حكاية حرمة العين أو حلّها ربما كانت على أساس النقل بالمعنى; وإلاّ كان الذي ذكره المعصوم (عليه السلام) هو حرمة الفعل الخاصّ; ولمّا لم تكن للعين تلك منفعة مناسبة أو فعل مناسب سوى الأمر الخاص، فلذا غيّر الراوي التعبير بما لم يكن في زعمه مغيّراً للمعنى فعبّر عن مثل حرمة أكل الميتة المنحصرة فائدتها في تلك الأعصار في الأكل بحرمة الميتة; مع أنّ حرمة أكل الميتة لا تستلزم حرمة غير الأكل من المنافع المناسبة للميتة حديثاً; فكيف يمكن الحكم بحرمة المنافع الحديثة للميتة على أساس أنّ حرمة العين تقتضي حرمة كلّ أمر مناسب للعين وإن تجدّدت في العصر المتأخّر؟! ومنه يظهر الكلام في حكاية حلّ العين .
والمفروض في الإشكال هذا كون الفعل الخاصّ هو القدر المتيقّن في الحكم، وأنّه سواء كان موضوع التحريم هو العين أو الفعل الخاص كان ذلك الفعل محرّماً مع أنّه لا حرمة للفعل الخاص على تقدير كون موضوع الحكم هو العين ما لم يكن
(الصفحة64)
الفعل الخاص باقياً على المناسبة للعين; فإنّه مع ذهاب المناسبة يزول التحريم عنه .
وكيف كان ، فنتيجة هذا الإشكال هو قصور إطلاق حرمة العين حيث ترد ، وكذا حلّها عن قابليّة التمسّك لإثبات حرمة الأفعال المناسبة للأعيان أو حلّها مع حدوث المناسبة وإن كان جواز التمسّك به لإثبات حرمة الفعل المناسب للعين قديماً أو حلّها مع زوال المناسبة فعلاً أيضاً مشكلاً لعدم إحراز صدور النص بعنوان تحريم ذلك الفعل أو حلّه ، فلعلّ الصادر من المعصوم (عليه السلام) هو تحريم العين أو حلّها بقول مطلق .
أصالة عدم الخطأ في موارد النقل بالمعنى ودليلها
وإن شئت فقل: إنّ مرجع هذا الاحتمال إلى عدم ضبط الراوي في مقام النقل وخطأه في الحكاية; لعدم انحصار الاشتباه والخطأ في النقل بالمباين، وتطبيق أصالة الضبط وعدم الخطأ في مثل هذه الموارد ممّا كان المعنى المنقول منطبقاً على عصره لا يخلو عن إشكال بعد كون مدركها بناء العقلاء، وهو دليل لبّي ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن عند الشكّ .وما ورد من الترخيص في النقل بالمعنى وعدم الاقتصار على النقل باللفظ، فإنّما ورد لجواز النقل بالمرادف لا النقل بالمغاير وإن ظنّه الناقل مرادفاً .
ولكن يمكن أن يقال: إنّ الترخيص في النقل بالمعنى وإن كان كسائر العناوين يقتضي إرادة المعنى الواقعي لا الخيالي، ولكن لمّا كان نظر الناقل طريقاً إلى ذلك فكأنّ الشارع اكتفى بما كان نقلاً بالمعنى في حسبان الناقل طريقاً إلى النقل بالمعنى حقيقةً وإلاّ لم يكن هناك عادة طريق إلى معرفة مطابقة نقل الناقل بالمعنى لواقع النقل بالمعنى .
وإن شئت فقل: إن لم يكن الإطلاق اللفظي لأدلّة الترخيص في النقل بالمعنى
(الصفحة65)
الدالّة على حجّيته، كحجّية النقل بعين الألفاظ دالاًّ على جواز الاعتماد على ما حسبه الناقل نقلاً بالمعنى ، ولكن الإطلاق المقامي يقتضي حجّية نظر الناقل وطريقيّته في تعيين كون ما نقله هو النقل بالمعنى لا النقل والحكاية بالمغاير، فلاحظ.
فكان عمدة الدليل على أصالة الضبط في مثل موارد النقل بالمعنى ممّا يحتمل مغايرة المنقول للواقع باعتبار اختلاف مصداق اللفظ مع اختلاف الزمان ، هو النصوص لا بناء العقلاء، فتأمّل جيّداً .
هذا إذا لم نقل بكون النصّ المرخّص في النقل بالمعنى راجعاً إلى إمضاء ما هو الدارج بين العقلاء في ذلك وإلاّ فيشكل الأمر حينئذ في الموارد المتقدِّمة.
ولكن الظاهر ـ كما تقدّم ـ عدم قصور الإطلاق المقامي عن إثبات حجّية النقل بالمعنى في الموارد هذه .
ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس»(1) . ونحوه غيره .
بل لا يبعد إطلاق بناء العقلاء لمثل المقام فإنّ بناءهم وإن كان دليلاً لبّياً ولكن الاقتصار على المتيقّن في مثله إنّما هو مع الشكّ لا مع الجزم ببنائهم على أصالة الضبط مطلقاً .
ثمّ إنّ الدليل على جواز النقل بالمعنى لا ينحصر في النصوص المتضمّنة لذلك بالخصوص، بل إطلاقات حجّية الخبر شاملة لموارد النقل بالمعنى كشمولها لموارد النقل بعين الألفاظ; وذلك لكون بناء العقلاء على عدم الاقتصار في مقام الحكاية على نقل عين الألفاظ; فكلّ وجه وكيفيّة للنقل عند العقلاء ـ والذي منه النقل بالمعنى ـ مندرج تحت إطلاق أدلّة حجّية الخبر .
- (1) الوسائل 18: 54 ، الباب 8 من صفات القاضي ، الحديث 9 .
(الصفحة66)
حكم القرينة المحتملة غير اللفظيّة
فينحصر مورد الأصل النافي للقرينة فيما كانت القرينة المحتملة ممّا لابدّ من ذكرها وعدم جواز الاعتماد على الارتكاز فيها ـ سالبة بانتفاء الموضوع ـ فكانت عدم ذكرها إمّا عمداً وهو ينافي وثاقة الراوي أو سهواً وهو مناف لضبطه . فكانت أصالة الضبط هي الحاكمة بأصالة عدم القرينة . ولكنّها تجري ببناء العقلاء في غير القرائن الارتكازية أو المحتملة لذلك . والأمر كما ذكره من قصور أصالة الضبط.
وبتعبير آخر أصالة عدم القرينة عن نفي القرائن المحتملة ارتكازها; لقصور بناء العقلاء عن مثل ذلك . ولكن تقدّم منّا توجيه أصالة الضبط في موارد النقل بالمعنى من الموارد الخاصّة ، بالدليل اللفظي وإلاّ فربما كان بناء العقلاء قاصراً عن ذلك كقصوره عن نفي القرينة الارتكازية المحتملة وإن لم نستبعد ثانياً ثبوت البناء العقلائي على الضبط فيما صوّرناه .
غير أنّه يمكن توجيه نفي القرائن الارتكازيّة عند احتمالها بأصل غير أصالة عدم القرينة أو الضبط; وذلك نفيها بأصالة عدم النقل أو ما يشبهها، فإنّ احتمال القرينة الارتكازيّة راجع إلى احتمال كون معنى اللفظ سابقاً والمفهوم منه ولو بمساعدة القرينة غير اللفظيّة المرتكزة هو معنى غير ما نفهمه الآن; وبناء العقلاء في مثل ذلك على أصالة عدم النقل واتّحاد المفهوم من اللفظ سابقاً مع ما هو المفهوم فعلاً عند الشكّ . بلا فرق بين مناشئ اختلاف المفهوم من اللفظ; فإنّه تارةً يكون
(الصفحة67)
لاختلاف الوضع والمعنى الحقيقي واُخرى يكون من جهة وجود قرينة عامّة مرتكزة أو غيرها مفقودة فعلاً .
وعلى هذا الأساس لو كان المفهوم من اللفظ فعلاً بمساعدة قرينة ارتكازيّة شيء ولم يعلم كون الارتكاز حادثاً أو سابقاً يحكم بأصالة عدم النقل ونتيجته سبق الإرتكاز .
وبالجملة: فأصالة عدم القرينة المصطلحة نافية لخصوص القرائن التي يتعهّد العقلاء بنقلها في مقام الحكاية . فعدم جريانها في سائر القرائن من جهة قصور الأصل موضوعاً عنها ، فإنّ دلالة اللفظ على المعنى قد يكون بسبب الوضع وقد يكون بسبب القرينة ، والقرينة قد تكون من التي تعهّد الناس بنقلها وقد تكون من المرتكزات التي لا تعهّد بنقلها كما لا تعهّد بنقل القرائن المطابقة لظهور الألفاظ .
فمن استعمل لفظاً وأراد معناه الحقيقي وزاد على ذلك نصب القرينة ، لا يجب على الحاكي نقل القرينة; بل لو اقتصر على نقل أصل اللفظ جاز; كما لا يجب نقل التأكيد في سائر الموارد ممّا يكون المؤكّد المجرّد عن التأكيد دالاّ على المقصود . وربما يكون منشأ عدم التعهّد بنقل القرائن الارتكازيّة البناء على استمرار ارتكازها والغفلة عن احتمال زواله .
فإذا كان الدال على المقصود نفس اللفظ بمعناه الوضعي واحتمل اختلاف الوضع سابقاً عن الوضع الفعلي، فهذا ما يصطلح في مورده بأصالة عدم النقل المثبت لسبق الوضع . وإذا كان الدال اللفظ واحتمل اختلاف المفهوم سابقاً عمّا هو المفهوم فعلاً ولكن للقرينة الخارجة عن الوضع فهذا على قسمين:
أحدهما: القرينة التي هناك تعهّد بنقلها كالقرائن غير المرتكزة.
وثانيهما: القرائن الارتكازيّة . ففي القسم الأوّل يحكم بعدم القرينة; وذلك لفرض عدم نقل الراوي لها، فهو إمّا خاطئ وغافل والأصل عدمهما وإمّا خائن
(الصفحة68)
وهو ينافي وثاقته . فمجموع الوثاقة وأصالة الضبط تثبتان خلوّ الكلام عن القرينة الخارجيّة غير المرتكزة; وهذا المورد هو الذي اشتهر في كلماتهم بأصل عدم القرينة . فهذا الأصل عبارة اُخرى عن أصالة عدم الخطأ والضبط أو هي مع الوثاقة; لا أنّه أصل ورائها; وهذا معنى ما ذكرنا من أنّ هذا الأصل لا موضوع له في القرائن الارتكازية; فإنّ عدم نقلها ليس ناشئاً من الخطأ بل من عدم التعهّد .
وأمّا في القسم الثاني وهو الذي تكون القرينة على تقدير وجودها ممّا لا تعهّد بنقلها ، فهذا ما قلنا فيه أيضاً بأصالة عدم القرينة ونفينا ارتكاز شيء سابقاً على خلاف ما هو المفهوم فعلاً، ولكن بملاك أصالة عدم النقل وبناء العقلاء على أنّ المفهوم من اللفظ سابقاً هو المفهوم فعلاً وأنّه لا قرينة ارتكازيّة على خلاف ما هو المفهوم فعلاً .
ومنه يظهر الكلام في القسم الرابع: وهو ما لو كان فعلاً ارتكاز على خلاف المعنى الوضعي واحتمل عدم سبق هذا الارتكاز وحدوثه، فإنّ الأصل يثبت ببناء العقلاء عدم حدوث الارتكاز وأنّه سابق كما لو احتمل كون اللفظ موضوعاً سابقاً لمعنى مغاير للمعنى الوضعي الفعلي والله العالم ، ولعلّ المراد بأصالة عدم القرينة لنفي القرينة الارتكازيّة المحتملة هو هذا وإن اختلف التعبير عنه .
ثمّ إنّ هنا شيئاً يناسب عامّة المسائل، وهو الإشكال في جريان أصالة الضبط في اُمور لا يرجع الاختلاف بينها إلى الاختلاف في المعنى العرفي وإن كان لاختلافها تأثير شرعاً باعتبار الاُصول التعبّديّة كالاستصحاب وما شاكله .
مثال ذلك أنّ العرف لايرى فرقاً بين التعبير بالمرأة غير القرشيّة وبين التعبير بالمرأة إذا لم تكن قرشيّة، فيعبّرون بأحد التعبيرين مكان الآخر وإن كان الفرق بينهما اصطلاحاً هو أنّ أحدهما معدولة المحمول والآخر سالبة محصّلة أو نحوها; ولكن هذا الفرق لا يكون فارقاً بينهما في مقام الحكاية .
(الصفحة69)
نعم ، يكون بين التعبيرين فرق في مقام جريان الأصل العملي كاستصحاب العدم فلا يجري على الأوّل لإثبات كون المرأة غير قرشيّة لعدم حالة سابقة للمرأة بالوصف بينما يجري على الثاني إذا كان الموضوع ملحوظاً بنحو التركيب لا التقييد; بناءً على اعتبار مثل هذا الأصل . ولكن إذا شكّ في كون التعبير الصادر عن المعصوم (عليه السلام) أيّهما فلا يمكن الاعتماد على أصالة الضبط في الراوي لإثبات أنّ التعبير الصادر عن المعصوم هو الذي حكاه الراوي بعد أن كان التعبيران بنظر العرف ومنه الراوي بمعنى واحد .
وأصالة الضبط معتبرة بنكتة الكاشفيّة المنتفية فيما إذا احتمل التوافق بين التعبيرين صدفة من دون أن يكون الناقل متعهِّداً بشيء .
وهذا البحث له ثمرة مهمّة وسيعة في الفقه ، والبناء العملي من غير واحد منهم سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) على أصالة الضبط في مثل هذه الموارد وهو مشكل والله العالم . ولا ينافي ما ذكرناه من الإشكال ما تضمّن جواز النقل بالمعنى كما لا يخفى، فلاحظ .
الوجه الثامن: بقي الكلام في شبهة: وهي أنّ المنساق من بعض النصوص ربما كان اختصاص الإطلاقات أو العمومات بالمصاديق المعاصرة للنصوص.
ففي معتبرة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: «وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل; وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك؟ فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز; فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : أقول لك: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرّة; وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
(الصفحة70)
فوقّع (عليه السلام) : كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » الحديث(1) .
ونحوه مرسلة القمّاط عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلاّ أنّه فيها مكان الاُرز ، الذرة . ففيها: فقال السائل: والذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثمّ قال: «كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك;» فقال: إنّهم يقولون: إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ; وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك . فغضب وقال: «كذبوا فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان; ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا; فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»(2) .
ولكن ليس في شيء من نحو هذه الرواية دلالة على قصور العمومات عن الأعصار المتأخِّرة والمصاديق المتجدّدة; وذلك فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) بوجود الأرز ونحوه في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يعني أنّها لو لم تكن في عهده لم يكن عموم العفو عمّا سوى التسعة نافياً لوجوب الزكاة فيما عدا التسعة من أرز وغيره .
وإنّما بيّن الإمام (عليه السلام) بطلان زعمهم بثبوت الزكاة على الأرز ونحوه استناداً إلى عدم وجودها في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، بأنّها كانت موجودة في عهده; فلا ينافي هذا بطلان زعمهم بوجه آخر وهو أنّها لو لم تكن موجودة أيضاً عمّها العفو .
وبالجملة فردّ الإمام (عليه السلام) على زعمهم بعدم وجود الأرز في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا يستلزم أنّه لو كان قصر العفو عنه .
هذا مع أنّ العفو عمّا سوى التسعة لو كان عفواً عمليّاً فهو لا يعني ثبوت الزكاة في غيرها ولا عدمه; ولا وجود شيء سوى التسعة في الخارج ولا عدمه . فقول الإمام (عليه السلام) حسب الرواية: وهل يكون العفو إلاّ عن شيء كان ، يُعطي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) أفاد العفو عمّا سوى التسعة بلفظ يدلّ عليه أو غيره; ولا يكون العفو إلاّ فيما يمكن
- (1) الوسائل 6: 34 ، الباب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، الحديث 6 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 3 .
(الصفحة71)
فيه الوضع; ولا يكون الوضع إلاّ في شيء موجود وإلاّ فلا يكون الوضع فعليّاً بمجرّد الفرض .
وبالجملة: فكون النبيّ (صلى الله عليه وآله) عفا في عصره عن أهل عصره يستلزم وجود الأشياء التي عفا عن جعل الزكاة فيها ، والله العالم .
فقد تحصّل ممّا قدّمناه عدم وجود وجه مقبول; لقصور القضايا الحقيقيّة ـ من قبيل الذي قدّمناه ـ عن شمول المصاديق المستجدّة ، والله العالم .
(الصفحة72)
النقطة الثالثة : الوجوه المؤيّدة لحجّية العمومات في المسائل المستجدّة
إذا تحقّق ضعف ما سردناه من وجوه قصور العمومات والإطلاقات عن المصاديق الجديدة والمتأخِّرة عن عصر التشريع وعرفت حجّية العمومات فيها فنذكر جملة من الوجوه هي مؤيّدة لحجّية العمومات في المستجدّات من المسائل زيادةً على ما تقدّم:الوجه الأوّل: جملة من النصوص الوافرة فاقت حدود التواتر أضعافاً مضاعفة دلّت على اشتمال الكتاب والسنّة على حكم كلّ شيء يُحتاج إليه إلى يوم القيامة; ومن جملة السنّة كتاب عليّ (عليه السلام) الذي هو إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فلق فيه وخطّ علي (عليه السلام) ; وقد عبّر في النصوص عنه مرّة بالصحيفة واُخرى بالجامعة وثالثة بالجفر وانّها تشتمل عل كلّ حلال وحرام، ونصوص هذه الصحيفة أيضاً متواترة وقد رآها بعض أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) .
1 ـ ففي معتبرة حمّاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة»(1) .
- (1) الفصول المهمّة 1: 480 ، الباب 7 من اُصول الفقه ، الحديث 1 .
(الصفحة73)
2 ـ وفي معتبرة سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أصلحك الله ، أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: «نعم ، وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة»; فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: «لا ، هو عند أهله»(1) .
أقول: كونه عند أهله لا ينافي أنّ أهله (عليهم السلام) قد بيّنوه للناس وللشيعة ، والضمير في أهله إمّا راجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو إلى العلم الذي أتى به النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
3 ـ رواية مرازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء; حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد; حتّى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا أُنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله الله فيه»(2) .
4 ـ وفي معتبرة عبد الأعلى بن أعين في الكافي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «قد ولدني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أعلم كتاب الله; وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء والأرض وخبر الجنّة والنار وخبر ما كان وما هو كائن; أعلم ذلك كأنّي أنظر إلى كفّي; إنّ الله يقول: (فيه تبيان كلّ شيء)»(3) .
وفي تعليقة الفصول نقلاً عن تعليقة الكافي: لا توجد هذه الآية في القرآن ولعلّه (عليه السلام) نقل بالمعنى قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَىْء}(4) .
ونحوه في اشتمال القرآن على تبيان كلّ شيء معتبرة أيّوب بن الحرّ(5) .
5 ـ وفي معتبرة سماعة في الكافي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أكلّ
- (1) نفس المصدر، الحديث 2 .
(2) نفس المصدر، الحديث 4 .
(3) نفس المصدر، الحديث 7 .
(4) سورة النحل الآية 89 .
(5) نفس المصدر، الحديث 8 .
(الصفحة74)
شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله) أو تقولون فيه؟ «فقال: بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله) »(1) .
أقول: لا يبعد كون المراد بكون كلّ شيء في الكتاب والسنّة المشعر بعدم اشتمال القرآن خاصّة على كلّ شيء; هو الردّ على من يزعم الغنا عن السنّة مدّعياً: حسبنا كتاب الله . وربما كان هذا التعبير قول حقّ لكن يُراد به الباطل، فإنّ الكتاب يدعو إلى الأخذ بالسنّة حيث يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . . .}(2) ، وقد قال (صلى الله عليه وآله) : «إنّي تارك أو مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» وقد اُمرنا بالتمسّك بهما فمن يزعم كفاية الكتاب أرادها ذريعة لترك السنّة والعترة المأمور بالأخذ بهما في الكتاب والسنّة . مع أنّ الكتاب وإن كان فيه تبيان كلّ شيء ولكنّه لا يعرف ذلك إلاّ بواسطة السنّة وبيان أهله، فكلّ شيء في الكتاب والسنّة لعامّة الناس وكلّ شيء في الكتاب للمحيط بعلم الكتاب .
وأمّا نصوص كتاب عليّ (عليه السلام) والذي عبّر عنه بالصحيفة والجامعة والجفر والتي قلنا إنّها متواترة فهاكها:
6 ـ ففي معتبرة أبي بصير في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «علّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السلام) ألف باب يفتح كلّ باب منها ألف باب» إلى أن قال: «فإنّ عندنا الجامعة; صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإملائه من فلق فيه وخطّ عليّ (عليه السلام) بيمينه; فيها كلّ حلال وحرام; وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش» . وضرب بيده إليّ فقال لي: «تأذن لي يا أبا محمّد؟» قال: قلت: جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت; قال: فغمزني بيده ثمّ قال: «حتّى ارش هذا
- (1) نفس المصدر، الحديث 10 وهو متّحد مع الحديث 55 .
(2) سورة الحشر الآية 7 .
(الصفحة75)
كأنّه مغضب»(1) .
7 ـ ونحوه رواية الصيرفي في الصحيفة: «إنّ عندنا كتاباً إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ عليّ (عليه السلام) صحيفة فيها كلّ حلال وحرام;» الحديث(2) .
8 ـ وعبّر عنها في معتبرة أبان عن أبي شيبة بالجامعة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً; فيها الحلال والحرام» الحديث(3) .
9 ـ وفي معتبرة أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث إنّه سُئل عن الجامعة ، فقال: «تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج; فيها كلّ ما يحتاج إليه الناس; وليس من قضيّة إلاّ وهي فيها حتّى أرش الخدش»(4) .
10 ـ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: «إنّ الحسين (عليه السلام) دفع إلى ابنته فاطمة كتاباً ثمّ دفعته إلى عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ، قال: ثمّ صار والله ذلك الكتاب إلينا يا زياد» قال: قلت: فما في ذلك الكتاب؟ قال: «فيه والله ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدُّنيا; والله إنّ فيه الحدود حتى أنّ فيه أرش الخدش»(5) .
11 ـ وفي معتبرة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إنّ عندنا لصحيفة سبعين ذراعاً إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط عليّ (عليه السلام) بيده ، ما من حلال ولا حرام إلاّ وهو فيها ، حتّى أرش الخدش»(6) .
- (1) نفس المصدر، الحديث 11 .
(2) نفس المصدر: الحديث 14 .
(3) نفس المصدر، الحديث 15 .
(4) نفس المصدر، الحديث 16 .
(5) نفس المصدر، الحديث 21 .
(6) نفس المصدر، الحديث 36 .
(الصفحة76)
12 ـ ونحوه رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلاّ أنّه قال: «فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج الناس إليه حتّى الأرش في الخدش»(1) .
13 ـ ونحوه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) إلاّ أنّه قال: «لو ظهر أمرنا لم يكن شيء إلاّ وفيه سنّة نمضيها»(2) .
14 ـ وفي معتبرة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إنّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط عليّ (عليه السلام) بيده وإنّ فيها لجميع ما يحتاج إليه ، حتّى أرش الخدش»(3) .
15 ـ ومعتبرة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إنّ عندنا لصحيفة يقال لها: الجامعة ، ما من حلال وحرام إلاّ وهو فيها ، حتّى أرش الخدش»(4) .
وقريب من مضمونها عدّة من النصوص في الجامعة والصحيفة واشتمالها على كلّ ما يحتاج إليه كرواية عبدالله بن أبي يعفور ومحمّد بن عبد الملك وبكر بن كرب وعمرو بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي عبدالله والفضيل بن يسار(5) .
وقد عبّر عن الصحيفة هذه بالجفر في نصوص:
16 ـ كمعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) وقد ذكر له وقيعة ولد الحسن وذكر الجفر فقال: «والله إنّ عندنا لجلدين ماعز وضأن ، إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط عليّ (عليه السلام) بيده وإنّ فيها لجميع ما يحتاج إليه الناس حتّى أرش الخدش»(6).
- (1) نفس المصدر، الحديث 37 .
(2) نفس المصدر، الحديث 38 .
(3) نفس المصدر، الحديث 41 .
(4) نفس المصدر، الحديث 42 .
(5) نفس المصدر السابق .
(6) نفس المصدر، الحديث 50 .
(الصفحة77)
ومرسل أبي القاسم الكوفي عن بعض أصحابه قال: ذكر الجفر ولد الحسن ، فقالوا:ما هذا؟ فذكر ذلك لأبي عبدالله (عليه السلام) فقال: «نعم ، هما اهابان ماعز وضأن مملوان علماً ، كتب فيهما كلّ شيء حتّى أرش الخدش»(1) .
17 ـ ونحوه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ويحكم وتدرون ما الجفر؟! إنّما هو جلد شاة وليست بصغيرة ولا كبيرة ، فيها خطّ عليّ (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فلق فيه ، ما من شيء يحتاج إليه إلاّ وهو فيها حتّى أرش الخدش»(2) .
ونحوها في الجفر رواية محمّد بن مسلم ورواية عليّ بن سعيد ولعلّه محرّف علي بن معبد(3) .
18 ـ وفي معتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: «للإمام علامات ، يكون أعلم الناس ... إلى أن قال: ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً ، فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم; ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر اهاب ماعز واهاب كبش ، فيهما جميع العلوم حتّى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة » الحديث(4) .
19 ـ وفي رواية الاحتجاج عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل ، إنّه قال لطلحة: «إنّ كلّ آية أنزلها الله على نبيّه عندي بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها على محمّد (صلى الله عليه وآله) وكلّ حلال وحرام أو حدّ أو حكم أو شيء تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة ، مكتوب بإملاء
- (1) نفس المصدر، الحديث 51 .
(2) نفس المصدر، الحديث 52 .
(3) نفس المصدر، الحديث 53 و 54 .
(4) نفس المصدر، الحديث 60 .
(الصفحة78)
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط يدي» فقال: كلّ شيء من صغير وكبير أو خاصّ أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: «نعم ، وسوى ذلك أسرّ إليّ في مرضه ألف باب يفتح كلّ باب ألف باب»(1) .
20 ـ وفي رواية سليم عن الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في حديث قال: «نحن أهل البيت نقول: إنّ الأئمّة منّا وإنّ العلم فينا ونحن أهله وهو عندنا مجموع بحذافيره كلّه وانّه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلاّ وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط عليّ (عليه السلام) بيده»(2) .
21 ـ وفي المعتبرة عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في حديث طويل قال: «أبى الله أن يكون له علم فيه اختلاف» إلى أن قال: «أمّا جملة العلم فعند الله وأمّا ما لابدّ للعباد منه فعند الأوصياء» إلى أن قال: «أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة ليس في أرضه من حكمه قاض بالصواب في تلك المصيبة; ثمّ قال: أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود ليس تفسيره في الأرض»(3) .
ولا يبعد أن يكون المراد وجود تفسيره في الأرض بما يكون قابلاً لنيل الناس والوصول إليهم ولو ببيان الفقهاء الذين أخذوا الأحكام عنهم (عليهم السلام) .
22 ـ ونحوها رواية الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إنّ الأرض لا تترك إلاّ بعالم يحتاج إليه ولا يحتاج إلى الناس يعلم الحلال والحرام»(4) .
23 ـ وفي مرفوعة عبد العزيز بن مسلم في الكافي عن الرضا (عليه السلام) في حديث
- (1) نفس المصدر، الحديث 75 .
(2) نفس المصدر، الحديث 77 .
(3) نفس المصدر، الحديث 17 .
(4) نفس المصدر، الحديث 63 .
(الصفحة79)
طويل قال: «إنّ الله لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له الدِّين وأنزل عليه القرآن ، فيه تبيان كلّ شيء ، بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا ، فقال عزّوجلّ: {مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْء}(1) وأنزل عليه في حجّة الوداع وهي آخر عمره (صلى الله عليه وآله) : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىوَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلاَمَ دِيناً}(2) وأمر الإمامة من تمام الدين» إلى أن قال: «وما ترك شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلاّ بيّنه ، فمن زعم أنّ الله لم يكمل دينه فقد ردَّ كتاب الله ومن ردَّ كتاب الله فهو كافر به»(3) .
24 ـ وفي مرسلة الكليني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ الله لم يترك شيئاً يحتاج إليه إلاّ علّمه نبيّه (صلى الله عليه وآله) » الحديث(4) .
25 ـ وفي معتبرة ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إنّما هلك من قبلكم بالقياس وإنّ الله لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما يحتاجون (تحتاجون ـ ظ) إليه في حياته وتستغنون به وبأهل بيته بعد موته وإنّه مخفي عندأهل بيته، حتّى أنّ فيه لأرش الكف» الحديث(5).
26 ـ وفي معتبرة سماعة، عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: «ليس شيء إلاّ وقد جاء في الكتاب والسنّة»(6) .
27 ـ وفي رواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «أتاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما اكتفوا به في عهده ، واستغنوا به من بعده»(7) .
- (1) سورة الأنعام الآية 38 .
(2) سورة المائدة الآية 3 .
(3) نفس المصدر، الحديث 20 .
(4) نفس المصدر، الحديث 25 .
(5) نفس المصدر، الحديث 40 .
(6) نفس المصدر، الحديث 56 .
(7) نفس المصدر، الحديث 64 .
(الصفحة80)
28 ـ وفي معتبرته الاُخرى ، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) : «إذا جاءكم ما تعلمون ، فقولوا ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون ، فها أنا ووضع يده على فيه» . فقلت: ولِمَ ذلك؟ قال: «لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة»(1) .
29 ـ وفي معتبرة محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «إنّ الله اختار محمّداً فبعثه بالحقّ وأنزل عليه الكتاب وليس من شيء إلاّ وفي كتاب الله تبيانه»(2) .
30 ـ وفي معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبة الوداع: أيُّها الناس اتّقوا الله ، ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّ وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به»(3).
31 ـ وفي رواية عبدالله بن حمدويه وكتبت من رقعته: إنّ أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم ، إلى أن قال: ويزعمون أنّ الوحي لا ينقطع وأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن عنده كمال العلم ، ولا كان عند أحد من بعده ، وإذا حدث الشيء في أيّ زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان ، أوحى الله إليه وإليهم؟ فقال (عليه السلام) : «كذبوا لعنهم الله وافتروا إثماً عظيماً» الحديث(4) .
32 ـ وفي رواية عمر بن قيس في الكافي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «ياعمر بن قيس ، أشعرت أنّ الله أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه وجعل له دليلاً يدلّ عليه وجعل لكلّ شيء حدّاً ولمن جاوز الحدّ
- (1) نفس المصدر، الحديث 72 .
(2) نفس المصدر، الحديث 65 .
(3) نفس المصدر، الحديث 70 .
(4) نفس المصدر، الحديث 74 .
(الصفحة81)
حدّاً؟» قال: قلت: أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلاً يدلّ عليه وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ولمن جاوز الحدّ حدّاً؟ قال: «نعم» الحديث(1) .
ونحوها في صدرها رواية عمر بن قيس الماصر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ الله لم يدَع شيئاً تحتاج إليه الاُمّة إلاّ أرسله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل له دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»(2) .
33 ـ وفي رواية أبي اُسامة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن ، فقال: «ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلاّ وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنّة ، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها» فقال له رجل: فما السنّة في دخول الخلاء ، الحديث(3) .
34 ـ وهناك نصوص كثيرة ذكر بعضها صاحب الفصول في الباب 7 من اُصول الفقه تضمّنت أنّ لكلّ شيء حدّاً يعني حكماً لا يجوز تعدّيه . وهذا ردّ على من يزعم أنّ شأن الشارع بيان العبادات ، وأمّا كثير من المعاملات وكثير من الشؤون فليس للشارع فيها حكم بل الأمر فيها محوّل إلى الناس .
35 ـ وفي رواية هشام التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب هشام ابن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم التفريع»(4) .
36 ـ ونحوه رواية السرائر نقلاً من كتاب البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (5) .
- (1) نفس المصدر، الحديث 31 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 32 .
- (3) نفس المصدر، الحديث 33 وهو متّحد مع الحديث 71 المروي عن المحاسن .
- (4) نفس المصدر: الباب 26، الحديث1. ورواهافي الوسائل 27: 61، الباب6 من صفات القاضي، الحديث 51.
- (5) نفس المصدر، الحديث 2 . وكذا في الوسائل، الحديث 52 .
(الصفحة82)
37 ـ وفي معتبرة زرارة في الكافي ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلال والحرام ، فقال: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة; وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره» الحديث(1) .
38 ـ وفي معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث: «حتّى جاء محمّد (صلى الله عليه وآله) بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» الحديث(2) .
وقد يتأمّل في دلالة هذا الحديث بالخصوص والذي قبله بما يأتي في قاعدة الاشتراك إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّه ذكر صاحب الفصول بعد ذكر الأخبار المتقدِّمة وغيرها التي جاوز بها السبعين قوله: أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى . وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية(3) .
نعم ، هناك طائفة من النصوص دلّت على قصور الأفهام عن نيل ما حواه القرآن من حقائق وأحكام وعدم تمكّنهم من استنباط الأحكام من القرآن مع اشتماله عليها; والظاهر أنّ المراد عدم الإحاطة بما تضمّنه الكتاب لا عدم فهم شيء .
39 ـ ففي معتبرة ثعلبة بن ميمون عمّن حدّثه عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(4) .
40 ـ وفي مرسل مسعدة بن صدقة في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : قال: قال
- (1) نفس المصدر: الباب 51 ، الحديث 1 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 2 .
- (3) الفصول المهمّة 1: 516 ، آخر الباب 7 من اُصول الفقه .
- (4) نفس المصدر الباب 7، الحديث 5 .
(الصفحة83)
أمير المؤمنين (عليه السلام) : «أيها الناس! إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول وأنزل إليه الكتاب بالحقّ ، إلى أن قال: فاستنطقوه ولن ينطق لكم; ولكن اُخبركم عنه وإنّ فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة; وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم»(1) .
وأمّا ما في معتبرة خيثمة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : يكون شيء إلاّ فيه كتاب أو سنّة؟ قال: «لا» قلت: فإن جاء شيء؟ قال: «لا يجيء» فأعدت مراراً ، قال: «لايجيء» ثمّ قال: «ياخيثمة يوفق ويسدّد وليس حيث تذهب»(2) .
فالظاهر أنّ المراد أنّه ليس شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة يعرفها عامّة الناس، بل علمه والإحاطة به مخصوص بالأئمّة (عليهم السلام) وهم يبيّنونه للناس .
41 ـ ويؤكّد ذلك معتبرة سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : بأيّ شيء يفتي الإمام؟ قال: «بالكتاب» قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: «في السنّة» قلت: فما لم يكن في الكتاب والسنّة؟ قال: «ليس شيء إلاّ في الكتاب والسنّة» قال: فكرّرت مرّة أو مرّتين ، قال: «يسدّد ويوفّق ، فأمّا ما تظنّ فلا»(3) .
ولعلّ المراد من التسديد والتوفيق هو ذلك عند مراجعة مواريثهم المشتملة على قواعد الأحكام مثل كتاب عليّ (عليه السلام) ; والمراد من ما ظنَّ ، هو الأخذ بالرأي والتظنّي والاستنباطات الظنّية من قبيل الاستحسان ونحوه ممّا تعارف عند أهل السنّة .
والمتحصّل من هذه النصوص أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا عالمين بكلّ ما تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة من الوظائف التي لا تخلو قضيّة أو حادثة منها، لما أنّ لكلّ
- (1) نفس المصدر، الحديث 6 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 59 .
- (3) نفس المصدر، الحديث 58 .
(الصفحة84)
شيء حدّاً ولمن جاوز الحدّ حدّ كما صرّح به في النصوص، وبطبيعة الحال أنّ ممّا تحتاج إليه الاُمّة هو العلم بوظيفتها في مسائلها المعاصرة والحادثة بعد العصور الاُولى من التشريع وأنّ أولياء الدين دعوا الناس إلى معرفتها بهذا اللسان لا أنّهم كانوا بصدد مجرّد ادّعاء معرفة الأحكام لتكون مخزونة إلى يوم القيامة; كما ودعوا الناس إلى تعلّم الأحكام المبتلاة لهم ولغيرهم بما تأتي من نصوص اُخرى وغيرها، ومن جملتها آية النفر للتفقّه وقد انساق الناس والعلماء إليهم من كلّ حدب وصوب وحضروا عليهم لمعرفة تلك المعارف . فهذا أبان أثبت من الأحاديث كذا ألف حديث وذاك أخوه زرارة مثله ونظيرهما محمّد بن مسلم وأبو بصير وفضيل بن يسار وغيرهم في طبقتهم وسابقاً عليهم ومن لحقهم من الأسماء المعروفة المشرقة والذين لهم مواقف مشرّفة مشهودة في حفظ الأحاديث من الاندراس والذهاب مع ما بلوا به من مصاعب ومشاقّ; وبحسبك ما يروى أنّه حضر على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) في برهة أربعة آلاف راوي كلٌّ يقول: حدّثني جعفر ابن محمّد .
وهؤلاء العلماء ألّفوا الألفيات على أساس أنّ للصلاة كذا ألف حدّ وحكم وهذا زرارة كما في النصّ المعتبر يقول: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلني الله فداك أسألك في الحجّ منذ أربعين عاماً فتفتيني! فقال: «يا زرارة بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى أو تفتى مسائله في أربعين عاماً»(1) .
فهؤلاء نابوا عنّا في الحضور والسؤال من الأئمّة (عليهم السلام) إذ كنّا محرومين من حضور مجالسهم والتشرّف بحضرتهم لمعرفة الوظائف فجزاهم الله عنّا خير الجزاء; ولا يبقى لنا بعد هذا كلّه علم بوجود حكم واقعي محجوب عنّا في أيّ واقعة تحدث
- (1) الوسائل 8: 8 ، الباب 1 من وجوب الحجّ، الحديث 12 .
(الصفحة85)
عندنا . أضف إلى ذلك أنّ في التعاليم والمعارف هو حكم ظرف الشكّ في الحكم الواقعي من براءة أو استصحاب أو نحوهما من القواعد الاُصوليّة وكذا الفقهيّة من حديث لا تعاد المعروف وغيره من القواعد الفقهيّة المقرّرة والتي هي ـ أي الاُصول ـ أيضاً أحكام واقعيّة في ظروفها .
ثمّ إنّ هناك طائفة من النصوص دلّت على اشتراك الأحكام بين جميع الخلق بل اشتراكها بين النبيّ والاُمّة إلاّ ما اختصّ بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) .
ونحن لم نستدلّ بهذه النصوص لحجّية العمومات والإطلاقات في هذه الأعصار لما استجد من المصاديق; لكونها بصدد إثبات ما ثبت في فرد من صنف من الاُمّة في حقّ تمام ذلك الصنف; والبحث الآن في اتّحاد الصنف في المصاديق الجديدة مع المصاديق القديمة .
بيان ذلك: أنّ مفهوم قاعدة الاشتراك هو أنّه لو ثبت في حقّ المسافر بشرائط خاصّة أنّه يقصر في صلاته عمّ الحكم هذا كلّ مسافر بتلك ا لشرائط ولا يختصّ الحكم بالمشافه به ولا بالحاضر في عصر التشريع .
وأمّا إذا ثبت حكم في حقّ شخص ولم يعلم كون ثبوته بأيّ ملاك وأيّ مناط ليعمّ غيره ، من الصنف المشترك معه في الخصوصيّات ، لم يكن ثبوته في حقّ الآخرين مقتضى قاعدة الاشتراك .
ومن يحسب اختصاص العمومات بالمصاديق المعاصرة للتشريع ولا تشمل المستجدّات من المصاديق لا يرى وحدة في الصنف بين المصداقين .
مثلاً من يخص حكم المسافر ثمانية فراسخ بالأسفار السابقة التي كانت تقع بالوسائط المناسبة لتلك الأعصار ، يرى كون المسافر بالوسائط الحديثة مغايراً لذاك مغايرة المسافر ثمانية فراسخ مع المسافر أربعة فراسخ . ولا قاعدة تقتضي الاشتراك في الحكم بين الأصناف المتغايرة .
(الصفحة86)
هذا ومع ذلك فلا بأس بالإشارة إلى بعض نصوص قاعدة الاشتراك فإنّها لا تخلو عن مناسبة للبحث الذي نحن فيه وإن اختلفت عنه بما بيّناه ، بل ربما يتوهّم اختصاص إطلاقات التكاليف وعموماتها بالأفراد المعاصرة لصدورها وعدم شمولها للأفراد المحدثين في الأعصار الجديدة والأخيرة، كما يلوك هذا الوهم بعض الضعفة ويتشدّق به بعض الجهلة ظانّاً أنّه أتى بما يعجز عنه الأفهام السابقة ووصل إلى ما يقصر عنه عقول غيره .
ويكفي للدلالة على القاعدة قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الاْخِرَ . . .}(1) .
1 ـ وفي رواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل في شرائط الجهاد وصفات المجاهدين ، قال: «فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله عزّوجلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فقد أذِن له في الجهاد ، كما أذن لهم; لأنّ حكم الله عزّوجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلاّ من علّة أو حادث يكون . والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأوّلون ويحاسبون عمّا به يحاسبون»(2) .
2 ـ وفي معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «اطلع رجل على النبيّ (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله) : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت بالمشقص حتّى أفقأ به عينيك; فقال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك ، أقول لك: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ، وتقول: ذاك لنا»(3) .
- (1) سورة الأحزاب الآية 21 .
- (2) الفصول المهمّة 1: 644 ، الباب 52 من اُصول الفقه .
- (3) نفس المصدر: الباب 54 ، الحديث 1 .
(الصفحة87)
3 ـ وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث حجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحجّ في عامه هذا ، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا لحجّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنّما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون فيتّبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه»(1) .
4 ـ وفي صحيح زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحلال والحرام؟ فقال: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره» الحديث(2) .
5 ـ ونحوه معتبرة سماعة بن مهران وقد تقدّمت(3) .
إلى غير ذلك من النصوص التي تعرّض لها الشيخ الحرّ (قدس سره) في الفصول المهمّة عند التعرّض للروايات المتقدِّمة وغيرها .
بل قد ذكرنا في غير المقام أنّ قاعدة الاشتراك لا يتوقّف إثباتها على نصّ خاصّ; فإنّ نفس أدلّة الأحكام وإطلاقها يقتضي ثبوتها في غير مورد الخطاب . وخصوصيّة الحضور والمشافهة، بل المعاصرة للمعصوم ونحو ذلك ينفيها الإطلاق ومع الشكّ فلا يبعد إلغاء العرف المتشرّع في فهمهم للنصوص لتلك الخصوصيّات كإلغائهم لخصوصيّة الرجولة ونحوها ، ومع الغضّ عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق المقامي . وقد سبق في المباحث ما يفيد في ذلك، فراجع .
الوجه الثاني : ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر وأنّه لا يبلى
- (1) نفس المصدر، الحديث 2 .
- (2) نفس المصدر: الباب 51 ، الحديث 1 .
- (3) نفس المصدر، الحديث 2 .
(الصفحة88)
وأنّه مقرّر لجميع الأزمنة وأنّ من مصاديق مفاهيم القرآن ما لم يكن سابقاً .
1 ـ ففي رواية محمّد بن موسى الرازي عن أبيه المروي عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) قال: ذكر الرضا (عليه السلام) يوماً القرآن فعظّم الحجّة فيه والآية المعجزة في نظمه فقال: «هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى; المؤدّي إلى الجنّة ، والمنجي من النار; لا يخلق من الأزمنة ولا يغث على الألسنة; لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان وحجّة على كلّ إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد»(1) .
2 ـ وفي رواية إبراهيم بن العبّاس المرويّة عن العيون عن الرضا (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : إنّ رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلاّ غضاضة؟
فقال: «لأنّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس ، فهو في كلّ زمان جديد وعند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة»(2) .
3 ـ وفي رواية الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية: ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن؟ قال: «ظهره وبطنه تأويله; ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن; يجري كما تجري الشمس والقمر; كلّما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء; قال الله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ}(3) نحن نعلمه»(4) .
4 ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر; فإذا جاء تأويل شيء منه وقع ،
- (1) بحار الأنوار 17: 210 ، الباب 1 من معجزاته (صلى الله عليه وآله) ، الحديث 16 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 18 .
- (3) سورة آل عمران الآية 7 .
- (4) الوسائل 18: 145 ، الباب 13 من صفات القاضي ، الحديث 49 .
(الصفحة89)
فمنه ما قد جاء; ومنه ما يجيء»(1) .
وأمّا ما ورد في بعض النصوص من اختصاص علم القرآن بأهله فهو يعني عدم جواز الاكتفاء بالقرآن حسب ما ادّعي ـ حسبنا كتاب الله ـ الذي هو ربما كان قول حقّ لكن اُريد به الباطل; أعني ترك متابعة أهل البيت (عليهم السلام) الذين اُمرنا بطاعتهم واتّباعهم في القرآن فضلاً عن الأحاديث . فليس المنع من الاكتفاء بالقرآن من جهة قصور عمومه وإطلاقه عن المصاديق المستجدّة ، بل من جهة اشتمال القرآن على مخصّص ومقيّد لا يعلم إلاّ من ناحية عدل القرآن والثقل القرين له في قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «إنّي مخلّف أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» .
الوجه الثالث: ما ورد من الحثّ الأكيد على نقل الروايات وضبطها للأقوام الآتية ممّن يأتون بعد زمان المعصومين (عليهم السلام)، وحضورهم فيأنسون بهذه الروايات ويعتمدون عليها; فلولا حجّية هذه النصوص في المصاديق الحديثة لتلك النصوص ـ ولو للإطلاق المقامي في روايات ضبط النصوص للمتأخّرين ـ كان ذلك إغراءً بالجهل; فلنذكر بعض هذه الروايات ونماذج منها:
1 ـ ففي رواية المفضّل قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : «اكتب وبثّ علمك في إخوانك; فإن مِتَّ فأورث كتبك بنيك; فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم»(2) .
2 ـ وفي رواية الصدوق في الفقيه وإكمال الدين بإسناده المعروف إلى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم السلام) في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله)
- (1) البحار 23: 79 ، باب وجوب معرفة الإمام الحديث 13 . والذي قبله رواه في ص197 ، الحديث 27 ، باب أنّهم (عليهم السلام) أهل علم القرآن .
- (2) الوسائل 18: 56 ، الباب 8 من صفات القاضي ، الحديث 18 .
(الصفحة90)
لعليّ (عليه السلام) قال: «يا علي أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً ، قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبيّ (صلى الله عليه وآله) وحجب عنهم الحجّة فآمنوا بسواد على بياض»(1) .
3 ـ والرواية المرويّة بأسانيد عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : اللهمَّ ارحم خلفائي ـ ثلاث مرّات ـ فقيل له: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) ! ومَنْ خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون عنّي أحاديثي وسنّتي فيعلّمونها الناس من بعدي»(2) وبمضمونه غير واحد من النصوص .
4 ـ النصوص المتضمّنة للترغيب في حفظ الحديث على الاُمّة، وأنّ من حفظ أربعين حديثاً كان له من الأجر كذا . وهذا المضمون رواه الخاصّة والعامّة وعلى أساسه ألّف الفريقان رسائل بعنوان الأربعينات(3) .
وفي بعضها: «أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدّاً .
ومفاد هذه الأحاديث أمران:
أحدهما: حفظ أربعين حديثاً ولو بالحفظ عن ظهر القلب; والمنساق من الحفظ في ذلك هو الحفظ عن فهم ودراسة لا مجرّد حفظ الألفاظ كما يؤمي إليه ما ورد من أنّ «من حفظ أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً» .
ثانيهما: حفظها على الاُمّة، وهذا لا يتحقّق إلاّ بمثل كتابتها ونشرها لتصل إلى الاُمّة وبدونه فلا يصدق حفظها على الاُمّة .
5 ـ وهناك طائفة من النصوص دلّت على عموم الأحكام لكلّ أهل الأرض وعدم اختصاصها بالشاهد والحاضر في مجلس الخطاب; حتّى اُمر الحضّار بإبلاغ
- (1) نفس المصدر، الحديث 51 .
- (2) نفس المصدر، الحديث 35 .
- (3) نفس المصدر، الأحاديث 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 64 وغيرها في الباب . وغيره .
(الصفحة91)
الغُيّب وإخبارهم بما سمعوه وخوطبوا به . روى في البحار عن منية المريد قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «ليبلغ الشاهدالغائب; فإنّ الشاهد عسى أن يبلّغ من هو أوعى له منه»(1).
وروى بإسناده عن الحسين بن سعيد بسنده المعتبر عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لمّا كان يوم فتح مكّة قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس! ليبلغ الشاهد الغائب إنّ الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهليّة والتفاخر بآبائها وعشائرها; أيّها الناس إنّكم من آدم وآدم من طين; ألا وإنّ خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له .
ألا وإنّ العربيّة ليست بأب والد ولكنّها لسان ناطق ، فمن قصر به عمله لم يبلغه رضوان الله حسبه; ألا وإنّ كلّ دم أو مظلمة أو إحنة كانت في الجاهلية فهي تطلّ تحت قدمي إلى يوم القيامة»(2) .
وروى عن عدّة الداعي: قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «أوصي الشاهد من اُمّتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسير سنة فإنّ ذلك من الدِّين»(3) .
ونحوه المعتبرة عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن الباقر (عليه السلام) المروي في الكافي(4) .
وفي خطبة النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حجّة الوداع المرويّة في عدّة من الكتب ما يؤكّد ذلك وإن اختلفت نسخه ونحن نرويها عن موضع من البحار رواه عن تحف العقول
- (1) البحار 2: 152 ، الباب 19 من كتاب العلم ، الحديث 42 .
- (2) البحار 70: 293 ، الباب 133 من مساوئ الأخلاق من الإيمان والكفر ، الحديث 24 .
- (3) نفس المصدر 71: 105 ، باب صلة الرحم من العشرة ، الحديث 68 .
- (4) نفس المصدر: الحديث 73 عن الكافي ، 2: 151 .
(الصفحة92)
فإنّه ـ على ما روى ـ بعدما ذكر مواعظ ونصائح وأحكاماً عدّة من حرمة الدماء والأعراض وأداء الأمانات وأنّ ربا الجاهلية موضوع وأنّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، وأنّ العمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية والتهويل بالنسيئة والتأكيد على حقوق النساء وبيان حقّ الرجال عليهنّ وحرمة أموال المؤمنين إلاّ بطيبة أنفسهم، والنهي عن قتل المؤمنين بعده بعضهم بعضاً بالرجوع إلى الكفر والتأكيد على التمسّك بالكتاب والعترة، وأخذ الإقرار من الناس بأنّه بلّغ قال: «أيّها الناس إنّ ربّكم واحد وإنّ أباكم واحد كلّكم لآدم وآدم من تراب إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلاّ بالتقوى ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم; قال: فليبلّغ الشاهد الغائب . أيّها الناس إنّ الله قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لمورث وصيّة أكثر من الثلث» الحديث(1) .
الوجه الرابع: هو وجود أشياء مناسبة لهذه المصاديق الجديدة في عصر التشريع والسابق عليه، بحيث لم يكن المصداق الجديد غريباً عن الأذهان بالمرّة . وإن كانت تلك الأشياء وجدت بإعجاز ونحوه أو بصورة طبيعيّة إلاّ أنّه يساعد على شمول الإطلاقات لمثله حيث وجد .
وذلك مثل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي صرّح به القرآن; ومثل طيّ الأرض; ومثل بساط سليمان (عليه السلام) الذي كان يطير به مع جمع، فإنّها تناسب إطلاق نصوص السفر للسفر بالوسائط الحديثة السريعة أضعاف ما كان يقع السير بحسب المتعارف والعادة .
ومثل إحياء الموتى بإذن الله، فإنّه يناسب مسألة ترقيع العضو وإطلاق دليل
- (1) البحار 73: 350 ، الباب 67 جوامع مناهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، كتاب الآداب والسنن ، الحديث 13 .
(الصفحة93)
طهارة الحيّ لجزئه الترقيعي . وكذا ما ورد في بعض النصوص ـ ولو بسند ضعيف ـ من ترقيع يد السارق بعد قطعه . وما ورد من ترقيع شحمة الاُذن.
ومثل وجود نسيب الميت بعد موته كحفيده المتولّد بعد سنين من موته، فإنّه يناسب حرمان ولد الميّت الصلبي إذا انعقدت نطفته المجمّدة في البرّادات والبنوك المعدّة لذلك بعد موت أبيه .
ومثل وجود الأنهار المتّصلة بالمادّة، فإنّها تناسب إطلاق عصمة ما له مادّة لمياه الأنابيب الحديثة المتّصلة بالمخازن المشتملة على مياه وافرة .
ومثل وجود يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يساعد على إطلاق اليوم والنهار لما إذا كان النهار في مكان قريباً من عشرين ساعة ، بل نفس اختلاف النهار في الفصول المختلفة يساعد على ذلك .
وإن شئت فعبّر عن هذا الوجه بتقريب آخر، وهو أنّ الاعتقاد بوقوع المعاجز والكرامات بل والسحر ونحوه يعطي البناء على عدم انحصار سنّة التكوين الإلهي فيما هو المتعارف من الأسباب والعلل الطبيعيّة وإمكان وجود اُمور مغايرة كيفيّة أو سبباً أو نحو ذلك مع ما هو المألوف والمعتاد .
بل وجود اكتشافات ولو محدودة أيضاً تناسب ذلك; فإنّ الاكتشافات الحديثة وإن كانت قفزة في الصناعة والعلوم الطبيعيّة ولكن أصل عدم ثبات الحياة وكونها في تحوّل وتقدّم كان أمراً معهوداً لدى الناس .
أضف إلى ذلك كلّه ما ورد في بعض النصوص المخبرة عن المستقبل من حدوث أعاجيب لم تكن مألوفة في تلك الأعصار .
الوجه الخامس: إنّ نصوص الأحكام من عمومات ومطلقات لو كانت صادرة من شخص عادي لأمكن دعوى قصورها عن المصاديق غير المألوفة له;
(الصفحة94)
ولكنّها صدرت من المعصومين (عليهم السلام) ، الذين هم محيطون بما في العالم من بدئه إلى نهايته; فضلاً عمّا هو صادر عن الله تعالى مباشرة وهو القرآن; وأنّه تعالى عالم ومحيط بكلّ شيء.
فهب أنّ المصاديق الجديدة للمفاهيم هي غير مألوفة للأشخاص العاديّين ولكنّها ليست غريبة عن علاّم الغيوب وعمّن اُلهم علم الغيب; ومعه فلا موجب لقصر العمومات على غير المصاديق الجديدة للمفاهيم .
ولذا ترى أنّ المركوز في أذهان الفقهاء حتّى من أهل السنّة المفروغيّة عن حجّية العمومات وإن كان المصداق الذي صدر العام في مورده مغايراً مع ما يتمسّك بالعموم فيه أو مجهولاً ، ففي معتبرة الحسين بن محمّد عن السيّاري قال: روى عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصماً له ، فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ، وزعمت أنّه لم يكن لها قط; قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به; فما الذي كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به!
قال: اصبر حتّى أخرج إليك; فإنّي أجد أذى في بطني; ثمّ دخل وخرج من باب آخر فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً؟ فقال محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه; ولكن حدّثني أبو جعفر ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّه قال: «كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليلى: حسبك; ثمّ رجع إلى القوم; فقضى لهم بالعيب(1) .
فقد تحصّل من ما قدّمناه أنّ اللفظ بمفهومه اللغوي والعرفي إذا كان شاملاً
- (1) الوسائل 12: 410 ، الباب 1 من أحكام العيوب من كتاب التجارة .
(الصفحة95)
للمصاديق الحديثة اقتضى ذلك شمول الحكم المترتّب على ذاك اللفظ للمصداق الجديد من مفهومه كالمصاديق القديمة; وأنّ مجرّد حدوث المصداق لا يكون مانعاً عن شمول الحكم لمثله; وهذا لا يعني عدم قصور الحكم أحياناً عن المصداق الجديد لنكتة اُخرى كمناسبة الحكم والموضوع وغيرها ممّا قد توجب قصور الحكم عن بعض المصاديق غير الحديثة أيضاً; وإنّما الغرض أنّ مجرّد حدوث المصداق ليس مقتضياً لقصور العموم والإطلاق عن شموله .
نعم ، ربّما يكون حدوث بعض الاُمور منشأً للشكّ في سعة مفهوم اللفظ بحسب اللغة والعرف القديم لمثله، فلا يحكم بشمول الحكم له لكن لا بملاك الحدوث بل بملاك قصور المفهوم ولو احتمالاً عن مثله . ولعلّ هذا الأمر هو الذي يخالج الذهن في مقام التشكيك في شمول الإطلاقات للاُمور الحديثة .
وقد ذكرنا أنّه لو تحقّق مفهوم اللفظ فعلاً وشكّ في كون المفهوم كذلك لغةً أو أنّ المفهوم اللغوي يغاير المفهوم بالفعل فمآله إلى احتمال النقل في اللفظ والأصل عدمه، فراجع .
(الصفحة96)
(الصفحة97)
الفصل الثاني:
تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعته
وفيه نقاط :
النقطة الأولى: أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه من حيث الابتناء على الدقّة والتسامح:
قد يحكم العرف ارتجالاً على فعل بلزوم أو ترك ، فهذا ما لم يرجع إلى حكم العقل أو لم يصر منشأ له أو لم تتحقّق فيه شرائط السيرة فلا يلزم متابعته .وقد يحكم في المفاهيم من الألفاظ وتحديد معانيها ، وهذا هو المقصود بالبحث وهو الذي يهمّ الفقيه . وهذا تارةً يرجع إلى تشخيص المفهوم ، واُخرى إلى تعيين المصداق . والفرق بينهما بحاجة إلى بيان، فإنّ جملة من الموارد ممّا قد يتوهّم كونه من باب تعيين المصداق راجع إلى تحديد المفهوم ممّا يكون العرف هو المحكَّم فيه .
وقد اشتهر الفرق بين الموردين وأنّ حكم العرف في تشخيص المفهوم هو المعتمد دون حكمه في تعيين المصداق ، وهذا حقّ إلاّ أنّه لابدّ من تبيينه; لئلاّ يختلط الأمر على سامعه وعلى أساسه يخبط في الحكم فنقول : قد يكون حكم العرف راجعاً إلى حدّ المعنى وبيان المفهوم منه ، كما في حكمه بأنّ الوزن الكذائي حدّه كذا
(الصفحة98)
وأنّ الماء حدّه كذا والحنطة كذا ; وقد يرجع حكمه إلى أنّ هذا المعنى المبيّن متحقّق في مورد كذا ، مثلاً : الكيل الكذائي كالمنّ أو الكيلو الذي هو عبارة عن كذا مثقال وقيراط متحقّق في هذه الحنطة الخارجية ، وهذا على قسمين :
القسم الأوّل : أن يكون الحكم مبنيّاً على الدقّة في التطبيق .
القسم الثاني : أن يكون مبنيّاً على المسامحة في ذلك ، كأن يحكم على ما يقلّ عن المنّ بمثقال بأنّه مَنّ مسامحة في نقص المثقال والغضّ عن ذلك بلحاظ المنّ وإن كان لا يتسامح عن المثقال بلحاظ المثقالين ، فهذه أقسام ثلاثة لحكم العرف .
والأوّل هوالحجّة بلاريب; لأنّ العرف هوالمتولّي للوضع،فكأن تعيين الموضوع له اللفظ بيده. وفي مثله لاعبرة بنظرالفقيه في مقام التقليد، إذا أمكن العامّي تشخيص المعنى . فلو تخيّل الفقيه نجاسة شيء لتخيّله ملاقاته مع النجس برطوبة خاصّة وكان العامّي جازماً بعدم كفاية ذلك في السراية أو شاكّاً لم يجز التقليد في مثله .
نعم، اتّباع الفقيه بملاك إخباره شيء آخر غير متابعته بملاك فقاهته واستنباطه.
فلو اعتقد الفقيه تحقّق الموت في موارد الموت الدماغي لانطباق ضابط الموت في مورده ـ وكان العامّي معتقداً خلاف ذلك ـ لم يجز تقليده; كما لا يجوز تقليده لو تخيّل الفقيه موت زيد بذبح وكان العامّي يعلم خلافه أو يشكّ، ويعبّر عنه بالشبهة الموضوعيّة كما يعبّر عن سابقه بالشبهة المفهوميّة .
وأمّا القسم الأوّل من القسمين الأخيرين فالحكم فيه راجع إلى الشهادة والإخبار، فإن كان مورده أمراً محسوساً كان خبر الثقة أو الموثوق بخبره حجّة بناءً على اعتبار خبر الثقة ونحوه في الموضوعات وعدم اشتراط البيِّنة .
وإن كان المورد من الاُمور الحدسية كان قول الخبير الثقة حجّة فيه .
وأمّا الثاني من القسمين الأخيرين فلا موجب لحجيّة حكم العرف في مثله لأنّ مسامحاته ما لم ترجع إلى تعيين المفهوم لا عبرة بها; وذلك أنّ مسامحاته قد
(الصفحة99)
توجب التوسعة في مفهوم اللفظ كالمنّ مثلاً، فيعدّ الجامع بين ما يقلّ بمثقال وما لا يقل ، منّاً ، فهذا راجع إلى ما قدّمناه من تعيين المفهوم والذي يتحكّم نظر العرف فيه; وقد لا يوجب ذلك ويعدّ المفهوم شيئاً معيّناً ثمّ يتسامح في تطبيق ذاك المفهوم على ما لا ينطبق عليه حقيقة ، وهذا بحسب الحقيقة راجع إلى التنزيل في الحكم .
وإن شئت فعبّر عنه بالحكومة ، فيعطى لما ينقص عن المنّ بمثقال حكم المنّ ، لا أنّه يوسع مفهوم المنّ له فيحكم بالبراءة على من اشتغلت ذمّته بمنٍّ بأداء ما نقص عنه بيسير .
ومن الواضح أنّ حكم العرف بالأحكام التكليفيّة والوضعيّة ما لم يرجع إلى إمضاء الشارع له لا عبرة به . وهذا معنى أنّ مسامحات العرف في التطبيق لا عبرة بها وأنّ العبرة بالعرف الدقيق; مع أنّ مسامحاته في تعيين المفهوم هي مبنى تعيين المفاهيم ، فلا تغفل .
لا يقال : كما أنّ تحديد العرف لمفهوم اللفظ يكون محكّماً في تشخيص مفاهيم الألفاظ المستعملة في كلمات الشارع ، كذلك سيرة العرف على المسامحة عند التطبيق تكون ممضاة ما لم يتحقّق الردع بملاك واحد .
فإنّه يقال : إنّ العرف لا يرى نفسه ملزماً بالمسامحة وإن كان يتسامح ، فلا سيرة على لزوم المسامحة .
ثمّ إنّ ممّا يؤكّد أنّ التسامح في التطبيق لا يوسّع في مفهوم الدوالّ عادة ، هو عدم تسامحهم في لفظ واحد في موارد مع تسامحهم في مصداق ذاك اللفظ بعينه في موارد اُخر .
ألا ترى تسامحهم بمثقال وأزيد في بيع منّ أو مدّ أو صاع من تراب بما لايتسامحون به بل بدونه ، في بيع منّ وغيره من ذهب ونحوه . ولا ريب أنّ مفهوم الأوزان والمكاييل لا يختلف باختلاف الموزونات والمكيلات .
(الصفحة100)
النقطة الثانية: ضابط ما يجوز التقليد فيه من العرفيات
وأمّا في مصاديق الألفاظ فلا عبرة بنظر الفقيه; لعدم احتياج معرفتها إلى الخبرة ، لعدم كون ذلك من الحدسيات بل من الحسّيات .
فلو حكم الفقيه على عين بعدم ضمان غير قيمتها لعدم اطّلاعه على اشتمالها على منافع فإنّه لا عبرة بحكمه هذا ، بل هو ملتزم بقضيّة كبرى هي ضمان المنافع زيادة على العين ولكنّه جهلاً بالمصداق حكم بعدم الضمان .
كما أنّه لو عيّن مفهوم لفظ بحسب اللغة كمفهوم الغناء وكان المقلِّد يرى غير ذلك، فإنّ نظر المقلِّد هو المقدّم فيما كان موضوع الحكم هو ذلك اللفظ بما له من المفهوم والمعنى حقيقة . ولا يعتبر قول المجتهد في حقّ غيره وإن احتمل الغير مطابقة نظر مجتهده للواقع صدفة مع فساد دليله المفروض; فإنّ اعتبار قول الخبير عند العقلاء إنّما هو بنكتة الكاشفيّة وهي مفقودة في مثل المورد المتقدّم .
وعلى هذا الأساس نمنع حجّية الخبر أيضاً فيما علم فساد مدرك المخبر في جزمه بالخبر وإن احتمل مصادفة خبره للواقع صدفة .
وإنّما قيّدنا تقديم نظر المقلِّد في الفرض بما ذكر; لأنّه قد يكون عدول الفقيه عن ذلك المفهوم لجهة اُخرى، ككون الموضوع للحكم ولو للمناسبة هو مفهوم خاصّ وإن غاير المعنى الحقيقي; فإنّه في مثل ذلك لا يكفي جزم العامّي بالمعنى الحقيقي ، وذلك كما لو أفتى الفقيه بحرمة الغناء المشتمل على الباطل; لتطبيق آية اللهو وهي
(الصفحة101)
قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ . . .}(1) ، وقوله تعالى : {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ}(2) ، وقوله (عليه السلام) : «إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل» فإنّ جزم المقلِّد بصدق الغناء عرفاً ولغةً على غير المشتمل على الباطل ، لا يوجب الحكم بحرمة ذلك .
وبالجملة : إذا أحرز المقلِّد أنّ موضوع الحكم ، هو اللفظ بمفهومه ومعناه الحقيقي ، واختلف مع الفقيه في تعيين ذلك فالعبرة لكلّ بنظره .
ولكن لا يتيسّر عادةً إحراز ذلك بحسب ما هو الموجود من الكتب والرسائل العملية . نعم ، يمكن الوصول إلى ذلك عبر السؤال والمشافهة .
كما أنّه على أساس النكتة المتقدّمة ـ أعني الكاشفيّة ـ يمكن الاستدلال لاعتبار قاعدة اليقين في بعض فروضها بما دلّ على حجّية خبر الثقة أو فحواه; فإنّ الثقة إذا أخبر بشيء مع عدم العلم بصدقه فكيف يقصر عنه ما إذا قطع نفس الإنسان بأمر ثمّ تردّد فيه لا للترديد في اقتضاء مدرك قطعه للقطع مع كون المدرك معلوماً بالفعل فإنّه في مثل هذا لا مجال لقاعدة اليقين .
والسرّ في ذلك: أنّ قاعدة اليقين إنّما تعتبر ببناء العقلاء بنكتة احتمال مطابقة اليقين للواقع فيما لم تكن مطابقة الاحتمال صدفة لا على أساس برهان، فلو قطع بمجيء زيد لإخبار ابنه بذلك ثمّ بان أنّ المخبر كان قد أخبر بمجيء غير زيد لم يكن اعتبار القطع المبني على أساس الوهم المتقدّم قابلاً للاعتبار في نظر العقلاء بنكتة الكاشفيّة وإن احتمل مطابقة القطع للواقع صدفة وجزافاً .
وكذا إذا كان مدرك القطع بتفصيله موجوداً وشكّ في اقتضائه للقطع .
وأمّا إذا كان قاطعاً بأمر وتردّد فعلاً في ذلك لنسيانه لمدرك قطعه، ولكنّه
- (1) سورة لقمان الآية 6 .
- (2) سورة الأنبياء الآية 16 .
(الصفحة102)
يحتمل تجدّد قطعه بذاك الأمر لو تذكّر مبنى قطعه فهو من قبيل ما لو أخبره ثقة بشيء ولا يدري فعلاً مدرك الخبر .
وبالجملة فيعتبر اختلاف حالات القاطع من قبيل تعدّد الشخص المخبر ـ بالكسر ـ والمخبر ـ بالفتح ـ وإن شئت فقل: إنّ درجة الوثوق الحاصل بقاعدة اليقين لا تقلّ عن الوثوق الحاصل بخبر الثقة فلو كان مبنى حجّية خبر الثقة هو ذاك المقدار من الوثوق حيثما تحقّق كانت القاعدة حجّة بلا ريب ولكن الشأن في إثبات المبني .
ويمكن أن يقرّر اعتبار القاعدة هذه بوجه آخر وهو إطلاق أدلّة حجّية الخبر في حقّ الآخرين على تقدير تردّد المخبر بعد إخباره للتردّد فيما كان منشأ خبره ـ وهو الفرض الذي قدّمناه ـ بحيث لا يمكنه الاخبار فعلاً لعدم بقاء الجزم; ونتيجة هذا أنّ ملاك اعتبار الخبر هو أن يكون المخبر جازماً في زمان وإن تردّد فيه في زمان آخر .
فإذا كان هذا الخبر حجّة في حقّ الآخرين فهل لا يكون حجّة في حقّ نفسه أيضاً؟ وهذا راجع إلى دعوى وحدة المناط .
ومن قبيله كتب الشخص الروائية فإنّها تعتبر بعنوان الرواية للآخرين وإن كان حين نقل الرواة عنها صاحب الكتاب متردّداً أو مجنوناً فضلاً عمّا إذا كان ميّتاً . نعم ، إذا كان تردّده راجعاً إلى الجزم بفساد مدرك قطعه بالخبر أو نحوه لم يجز الاعتماد عليه حسب بناء العقلاء .
ويمكن أن يستدلّ لقاعدة اليقين في الفرض المتقدّم بالنكتة المشار إليها في قاعدة الفراغ وأنّه حين العمل أذكر منه حين يشكّ .
(الصفحة103)
النقطة الثالثة: توجيه التقليد في المفاهيم العرفيّة مع كون العرف هو المرجع للفقيه
بل أقول : تعيين كثير من مفاهيم الألفاظ أصعب من استنباط كثير من الأحكام ; وقد وقع علماء اللغة وأجلّتهم في الخلط الكثير والخبط بين المفاهيم والمصاديق فعدّوا للّفظ معاني عدّة ، ربما يرجع الكلّ إلى واحد أو اثنين وكانت من قبيل المصداق للمفهوم الواحد . فإذا كان هذا شأن فقهاء اللغة فما ظنّك بالعامّي .
فإنّ الفقيه لدقّته واجتهاده وإعماله للمنبّهات يستخرج المفاهيم من ارتكاز العرف العامّي ممّا لا يتيسّر ذلك لكثير من الفضلاء فضلاً عن المبتدئين ، فكيف بالعوامّ .
نعم ، ربما يكون دقّة الفقيه وأُنسه بالمباحث العقلية منشأً لخطأه في تشخيص بعض المفاهيم العرفية المبنيّة على المسامحات المقبولة .
ثمّ إنّ خطأ الفقيه في تشخيص المصاديق هو المبرّر لجواز مخالفة الإجماع أحياناً; فإنّ حكم الفقهاء بعدم جواز بيع مثل الدم ـ معلّلين ذلك صريحاً أو ارتكازاً بأنّه لا منفعة محلّلة فيه ـ لا يوجب على فقيه اطّلع على منافع محلّلة مقصودة للدم ، الحكمَ بعدم جواز البيع ، بل ولا يوجب متابعة المقلِّد إذا اعتقد ذلك وتحقّق له أنّ حكم مقلَّده مبنيّ على ذلك .
(الصفحة104)
النقطة الرابعة: نفوذ الاستفتاءات في الموضوعات، كالوصايا ونحوها على المقلّد
نعم، يمكن أن يُقال: إنّ الاستظهار في مثل الوصايا ونحوها راجع إلى الشهادة في الأمر المحسوس وليس من قبيل الحدسيات فيكون اعتبار نظر المفتي فيها بملاك الإخبار لا الفتوى ، فمع كفاية الخبر الواحد وحجّيته في الموضوعات كان نظر الفقيه حجّة في ذلك أيضاً .
ومن الواضح أنّه لا فرق في بناء العقلاء على حجّية خبر الثقة بين خبره في الموضوعات وغيرها بل المتيقّن من بنائهم هو الموضوعات وعلى أساسه يتعدّى إلى الاخبار عن الأحكام; فإنّ الإخبار عن قول الإمام المتضمّن لبيان الحكم ، إخبار عن موضوع هو القول . كما أنّه لا فرق في بنائهم بين كون الشخص قادراً على تحصيل العلم وعدمه فيعتمدون على خبر الثقة وإن أمكن استطلاع الأمر بالمباشرة .
فلو أخبر الواسطة عن أمر شخص بعمل فلا يتوقّف حجّيته على عجز الشخص عن الوصول إلى الآمر والسؤال منه بالمباشرة .
(الصفحة105)
فلا يشكل في حجّية ظواهر الوصايا باخبار الفقيه عنها مع تمكّن الوصي من ملاحظة الوصيّة بنفسه .
نعم ، لو تردّد الوصي بعد ملاحظة الوصيّة بنفسه فيما استظهره الفقيه منها أشكل بل منع من اعتبار نظر الفقيه في حقّه; كما لو نقل شخص عين خبر وزاد عليه استظهاراً خاصّاً فإنّ حجّية الخبر لا تعني حجّية الاستظهار ، وإن كان لو اقتصر الناقل على استظهاره ولم يكن أصل الكلام واصلاً وملحوظاً للمنقول إليه كان الاستظهار حجّة بناءً على حجّية النقل بالمعنى .
وعليه فلا بأس للعربي مثلاً أن يعتمد على تفسير الفقيه للوصية الفارسيّة ، كما يجوز نقل الكلام العربي للغير فارسيّاً ويكون حجّة بملاك الإخبار على المنقول إليه; فلاحظ في أطراف ما ذكرناه فإنّه حريّ به . نعم ، إذا كان مثل الوصيّة الخاصّة مشتملاً على صورة لا يتمكّن غير الفقيه من تشخيص المراد منه كان من قبيل اللغات المشكلة كالمفهوم من الغنا ونحوه ممّا يجوز التقليد فيه .
اشتراط اجتهاد الفقيه في اللغة لجواز تصدّيه للفتوى
على أساس ما ذكرنا في محلّه أنّ الفقيه لابدّ أن يكون مجتهداً في اللغة أيضاً فليس له التقليد من علماء اللغة; فإنّه بغضّ النظر عن عدم كون اللغويّين عادةً أهل خبرة باللغة وإنّما هم خبراء بموارد الاستعمال خاصّة ، لا دليل على جواز التقليد ممّن يعتمد في فتواه على أهل الخبرة ، بل جواز اعتماد الفقيه في مجال عمل نفسه على فتواه فيما اعتمد في تعيين مفهوم لفظ على الخبير باللغة مشكل ما لم يثق بالمعنى .
وهذا غير التجزّي في اصطلاح الاُصوليّين، فإنّ ذاك عبارة عن التجزّي بلحاظ المسائل مع كون اجتهاد الشخص بلحاظ مبادئ المسألة الخاصّة اجتهاداً مطلقاً . وأمّا هذا فهو تجزّي باعتبار مدارك المسألة الواحدة فيكون مجتهداً في بعض
(الصفحة106)
مقدّمات المسألة أو كلّ المسائل دون تمام المقدّمات; كما لو كان مقلّداً في فنّ الرجال أو اللغة أو نحو ذلك ، كالبراءة في الارتباطي من المركبات أو إمكان الترتّب وما شاكل ذلك . وتمام الكلام مع توجيه جواز الإفتاء لعمل نفسه بل وجواز تقليد الغير له محوّل إلى غير المقام .
(الصفحة107)
النقطة الخامسة: العبرة بالعرف المعاصر للمشرّع لا المعاصر لنا
والعبرة إنّما هي بالوضع المعاصر للتشريع دون المتأخّر .
كما أنّ العبرة في معاني الألفاظ بمعانيها في لغة العرب ولا عبرة بالأوضاع غير العربيّة للألفاظ المستعملة في لغة العرب .
وعلى هذا الأساس فلو كان لفظ الاُمّ موضوعاً في اللغة قديماً لمن تولّد الجنين من مائها بعد حملها له فالعبرة بذلك فيما ورد من أخذ الاُمّ موضوعاً لحرمة النكاح أو وجوب الإنفاق وغير ذلك .
ولو فرض وضع هذه اللفظة في عصرنا لمن حملت بالجنين مع كون النطفة من امرأة اُخرى أيضاً ـ وهي التي يصطلح عليها بالأرحام المستأجرة ـ لم يكن موجب لحمل النصوص على مثل هذا المعنى أيضاً .
وإن كان بين هذا المعنى ـ على تقدير كونه معنى حقيقيّاً فعلاً ـ وبين المعنى القديم مناسبة; بحيث كان استعمال اللفظ فيه مجازاً عند اللغة القديمة لا غلطاً .
ولعلّ اللغوي القديم لو كان حاضراً لوضع تلك اللفظة لهذا المعنى كالمعنى القديم ، إلاّ أنّه لعدم ابتلائه وعدم اطّلاعه على المعنى الجديد لم يضع اللفظ هذا له . والوضع فرع العلم والاطّلاع .
وقد قدّمنا في بعض ما تقدّم تصوير شمول الألفاظ بمعانيها ومفاهيمها القديمة للمصاديق الجديدة مع كون الالتفات إلى المعنى مقوّماً للوضع، فراجع .
إلاّ أنّ هذا غير صدق اللفظ على المعنى الجديد فلا تغفل .
(الصفحة108)
أصالة عدم النقل لإثبات عموم الوضع للمصاديق الجديدة:
ثمّ لو تحقّق صدق اللفظ بمفهومه على مصداق جديد ولم يعلم كونه بوضع جديد أو أنّه استمرار للوضع القديم ، جرى أصالة عدم النقل المثبت لكون المعنى في اللغة هو ما عليه الآن .
ومجرّد عدم تصوّر شخص الفرض لا يكون فارقاً في جريان أصالة عدم النقل بعدما كان وضع اللفظ بإزاء مفهوم يعمّ هذا المورد ممكناً بل واقعاً; وإن لم يكن المورد بشخصه متصوّراً وملحوظاً للواضع، فلاحظ وتأمّل .
النقطة السادسة: تحكيم العرف المعاصر لنا أحياناً
قد تحقّق بما أسلفناه أنّ العبرة في معاني الألفاظ بالمفاهيم عند العرف المعاصر للمشرّع، وهذا إنّما هو بملاحظة الألفاظ التي وصلت إلينا في كتب الحديث المعروفة كالكتب الأربعة وغيرها . وذلك بالنظر إلى أنّ أصحاب هذه الكتب حكوا لنا متون الأحاديث التي وصلت إليهم من السابقين عليهم، بل ورووا عين الألفاظ المرويّة عن الاُصول والكتب المعاصرة للمعصومين (عليهم السلام) والتي تلقّاها أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)من المعصومين بألفاظها أو بمرادفاتها ومعانيها .
ولو فرض أنّ كتاباً اُلّف في مثل هذه الأعصار بانياً على نقل الأحاديث بالمعنى ـ سواء كان بلغة العرب أو غيرها ـ فالعبرة في مثله بالعرف المعاصر لنا لا العرف القديم وهذا أيضاً ظاهر .
النقطة السابعة: العرف المحكّم في تحريم الأعيان وحلّها
قد يشكل ما ذكرناه من أنّ العبرة في تشخيص مفاهيم الأحاديث التي وصلتنا بالعرف المعاصر للمعصومين في جملة من التراكيب التي منها تحريم الأعيان; فإنّ
(الصفحة109)
حرمة العين بمعنى حرمة الاستعمال المتناسب معها وإلاّ فلا معنى لحرمة العين سوى ذلك .
فإذا فرض عدم كون الاستعمال المناسب للعين في عصر المعصوم باقياً على المناسبة وصار الاستعمال المناسب شيء آخر ، فينبغي أن يكون الحكم متحوّلاً إلى الاستعمال المناسب فعلاً وارتفاعه عن الاستعمال السابق بتبع زوال الموضوع; ومعه فتكون العبرة في مصبّ الحكم بالعرف في كلّ زمان لا بعرف قديم ثابت .
ويردّه: أنّ هذا لا ينافي ما سبق; فإنّ العبرة في مثل تحريم العين أيضاً بالمفهوم منه في عصر المعصوم; والمفهوم منه عنده هو حرمة الاستعمال المتناسب بعنوانه لا بعنوان مثل أكل أو شرب ونحوهما; ثمّ الاستعمال المتناسب يختلف باختلاف الأعصار والأزمان والأمكنة ويتبدّل وربما يثبت; وهذا من اختلاف المصداق لا المفهوم .
نعم ، لو صار المفهوم في عرفنا من حرمة العين حرمة الاستعمالات غير المناسبة للأعيان كان هذا من اختلاف المفهوم في العرفين والعبرة بالعرف السابق حينئذ . وتقدّم ما يناسب هذا البحث عند ذكر الحجج على قصور العمومات عن المصاديق الجديدة، فراجع .
النقطة الثامنة: العرف المحكّم عند اختلاف عرف المتكلِّم والمخاطب
قد يكون بين عرف المتكلِّم والسامع اختلاف; ومن قبيله ما ذكر في الكرّ الذي ورد تحديده بستّمائة رطل وألف ومائتين وأنّه كان بين رطل مكّة وغيرها اختلاف وأحدهما كان ضعف الآخر ، فهل العبرة بعرف المتكلِّم أو السامع ؟
ومرجع هذا البحث إلى أنّ المتكلّم هل هو موظّف برعاية عرف السامع أو أنّه موظّف برعاية عرفه؟ وأنّ السامع هل هو ملزم بحمل اللفظ على المفهوم عند
(الصفحة110)
المتكلِّم أو عنده؟
ولمّا كان العرف مشتركاً بين السامع والمتكلّم عادةً حتّى ترى أنّ صيغة الأمر بلفظ العرب وغيرهم ظاهرة في الوجوب فضلاً عن اللفظ العربي بين الأقوام العربية المختلفة ، لم يوُلوا هذا البحث كثير عناية . فإنّه قلّما يتّفق لفظ فاقد للقرينة وقع الخلاف في معناه بين عرف الإمام (عليه السلام) وعرف سامعه .
وكيف كان فالظاهر أنّ المتكلِّم يتكلّم بما يعرف للألفاظ من المعاني إلاّ إذا علم بأنّ مخاطبه يفهم غير ذلك .
وأيضاً يفهم السامع من الكلام ما يكون معهوداً في عرفه إلاّ إذا علم أنّ المتكلِّم له عرف آخر ووضع مغاير . ومع علم المتكلّم والسامع باختلاف العرفين يعود الكلام مجملاً لا يدرى أنّ المتكلّم راعى عرفه أو عرف السامع ، وكذا السامع .
ومع الشكّ في علم المتكلّم فليس هناك أصل معيّن ، والله العالم .
النقطة التاسعة: في بيان الفرق بين التسامحات العرفيّة والتطبيقات الخاطئة
هناك تسامحات للعرف وهناك تطبيقات خاطئة له، وقد أشرنا إلى الأمرين سابقاً، بل وفصّلنا القول في التسامح العرفي والفرق بين التسامح المقبول وغيره. ومع ذلك فينبغي التنبيه الخاصّ على نقطة الفرق بين التسامح والخطأ في التطبيق، فنقول: مرجع التسامح إلى سعة الجعل أو ضيقه، فإن كان التسامح في صدق اللفظ فهو راجع إلى سعة الجعل، وإذا كان التسامح في عدم الصدق فمآله إلى ضيق الوضع.
ثمّ التسامح كثيراً ما يكون مورداً للالتفات ومع ذلك لا يؤثّر في التراجع عن ما وقع العزم عليه، كما أنّه قد يكون التسامح لخفائه مغفولاً عنه فيتخيّل كون البناء على أساس الدقّة مع كونه مبنيّاً واقعاً على المسامحة، ولكنه بحيث لو نبّه لم
(الصفحة111)
يؤثّر في التراجع.
وقد ذكرنا أنّ التسامح العرفي قد يكون في المفهوم الذي وضع له اللفظ فيعتبر مفهوماً وسيعاً مثلاً أمراً واحداً، ولا يلحظ الاختلاف بين أفراد المفهوم مؤثراً في التعدّد، كما يُعتبر الإنسان مفهوماً واحداً لا يعدّده اختلاف الأفراد في الطول والقصر ونحوهما، وهو راجع إلى نوع استحسان في مقام الجعل والوضع، كما وقد يعتبر مفهوماً مغايراً لغيره وإن كان يمكن اعتبار وحدة بينهما في مقام الوضع والاعتبار كاعتبار الإنسان للأعمّ ممّا وضع له فعلاً ولبعض الحيوانات التي تمشي على قدمين مستويتين، وكيف كان فمثل هذه التسامحات مقبول من العرف لرجوعه إلى تحديد المعنى الذي يضع اللفظ بإزائه; والواضع حرّ في ذلك مختار وإن كان وضعه عادةً على أساس مناسبات بين المصاديق للمفهوم الذي اعتبره واحداً.
وقد يكون التسامح في التطبيق بعد الفراغ عن الوضع بما لا يرجع إلى التصرّف في الوضع والحكومة فيه، فبعدما وضع لفظ الكيلو لألف غرام يتسامح في تطبيقه على تسعمائة وتسعة وتسعين غراماً، فهذا التسامح ذكرنا أنّه لا عبرة به لكونه راجعاً إلى ما لا يحقّ للعرف الحكومة فيه; فإنّ مجال حكومة العرف هو الأوضاع لا الأحكام، والمفروض أنّ تسامح العرف في المثال المتقدّم راجع إلى الحكم مثلاً بالبراءة فيمن وفّى دون ألف غرام مكان الكيلو، ولا اعتبار بحكمه في مثله ما لم يرجع إلى السيرة بشروطها.
وقد نبّهنا على أنّ الشاهد على تسامح العرف في التطبيق هو عدم انصياعه للحكم المتقدّم بشكل عامّ، فهو ولو حكم بكفاية تسعمائة وتسعة وتسعين غرام في الاُمور الرخيصة، ولكنّه لا يحكم بها في الأمور الغالية مع أنّ المفهوم واحد حسب المتفاهم العرفي لا يحتمل التعدّد باختلاف مثل رخص مصداقه وغلائه وما شاكلهما، فلاحظ.
(الصفحة112)
وأمّا التطبيقات الخاطئة للعُرف لا المسامحيّة، فلا عبرة فيها بنظر العرف أصلاً، بل العرف لو نبّه على خطأه لتراجع عن صدق اللفظ بما له المفهوم على المورد.
والفرق بين التطبيقات الخاطئة وبين المسامحات هو أنّ العرف ملتفت عادةً ـ لا دائماً كما سبق ـ إلى مسامحاته ولو ارتكازاً، ولكنّه يحكم بلزوم المسامحة، بينما في موارد الخطأ في التطبيق لا يلتفت العرف إلى خطأه، ولو التفت لم يكن ملزماً لرعاية ما أخطأ والجري على مقتضى الخطأ، بل يرجع عن تصميمه الأوّل، مثال ذلك أنّه يجب السجود عند سماع قراءة آية السجدة، فلو استمع الشخص الآية من مثل الإذاعة والتلفاز فربّما يعتبر العرف ذلك سماعاً للقراءة ولكنّه مبنيّ على خطأه في التطبيق، فإنّ القراءة عبارة عن الصوت المعتمد على الفم، وهذا حدّ سماعه محدود بشعاع خاصّ، فمن بُعد عن الصوت بمقدار لا يكاد يسمعه، وأمّا الآلات التي يكون السماع بسببها فلّما كان يتخيّله العرف البسيط وسيطاً لنقل الصوت، فيتخيّل أنّ نفس الصوت الصادر من القارئ ينتقل إلى السامع، مع أنّ ما ينتقل عبر الآلة هو صوت آخر مشابه للصوت الأصلي نوعاً ما شأنه بالنسبة إلى الصوت الأصلي شأن الصورة المنقوشة بالنسبة إلى ذي الصورة.
وهذا يتّضح جدّاً في مثل الأصوات المسجّلة على الأقراص الخاصّة التي تخزّن الصوت ـ وإطلاق الخزن مسامحة ـ وتبديه كلّما اُريد، فإنّ المغايرة بين الصوت هذا وبين صوت صاحبه ـ و ربما مات صاحب الصوت قبل سنين ـ جليّة جدّاً.
فهذا التطبيق لمّا كان مبنيّاً على خطأ للعرف لا يعتبر; ولذا لو نبّه العرف عليه والتفت إلى خطأه في تحليل ما تصوّره رجع عن الحكم بالوحدة.
ولو فرض إصرار العرف على صحّة تطبيقه كان هذا راجعاً إلى وضع جديد وجعل القراءة للأعمّ من صوت القارئ وصوت آخر يشبهه بنحو ما هو الموجود في هذه الأعصار، ولا عبرة بالأوضاع الجديدة للألفاظ في الاستعمالات القديمة لها
(الصفحة113)
كما سبق، وهو واضح.
وعلى أساس عدم الاعتبار بالتطبيقات العرفيّة ترى غير واحد من الفقهاء منعوا أو استشكلوا في وجوب السجدة بسماع القراءة من المسجّلات، وقد عنون المسألة صاحب العروة بعنوان السماع من صندوق حبس الصوت، وربما فصل بعض في هذه الأعصار بين موارد البثّ المباشر للصوت ـ حسب الاصطلاح ـ وبين غيرها; وقد ذكرنا في محلّه ـ وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض أجزاء هذه الموسوعة ـ عدم الفرق بين الموارد بعدما تحقّق عدم كون المسموع هو نفس الصوت الصادر من القارئ.
كما أنّه بناءً على ما تقدّم منعنا من صدق صوت المرأة على المسموع عبر الآلات، وإطلاق صوت المرأة عليه فهو باعتبار مبدأ تكوّنه وصدوره لا نفسه، كإطلاق صوت زيد على المسموع عبر الآلات.
كما أنّ إطلاق المكبّرة على بعض الآلات يعنون به أنّ تلك الآلة تكبّر الصوت أيضاً مسامحة، فلا تخلط.
وظنّي أنّ عدم الاعتبار بالتطبيقات العرفيّة في غاية الوضوح، أوترى أنّ واحداً لو حسب حمرة دماً يحكم عليه بذلك لمن يرى خلاف ذلك.
ثمّ اعتبر الحاكم بالحسبان أكثر من واحد وقس على حكمه. كمتخيّل نار مستديرة عند رؤية نار تدار بسرعة ياترى أنّه يصحّ أن يعبّر بما يدلّ على حركة الشمس حول الأرض وسكون نفس الأرض لمجرّد تخيّل العرف العامّ ذلك ويكون كلاماً صادقاً، كما يصدق الكلام في موارد المسامحات العرفية فيما يرجع إلى المفهوم وحدّه، واستعمال الطلوع في الشمس حسبما ورد في الكتاب العزيز لا ينافي ما ذكرناه، فإنّ الطلوع بمعنى الظهور وتخيّل العرف تحقّق الطلوع وظهور الشمس بحركتها لا بحركة الأرض لا يوجب كون محقّق الطلوع داخلاً في المعنى، فإنّ أسباب
(الصفحة114)
المعنى ليست جزءً من المعنى، ألاترى أنّ الموت له مفهوم خاصّ، وكونه بالسيف وغيره لايوجب دخول تلك الأسباب في مفهومه، فكذلك الطلوع معناه ظهور الشيء بلا دخل لأسبابه في مفهومه وإسناده إلى الشمس، من قبيل إسناد الموت إلى زيد، فكما أنّ الاشتباه في أسباب الموت لا يرتبط بمفهومه فكذلك طلوع الشمس.
والسرّ في ذلك كلّه أنّ التطبيق لا يرجع إلى حدّ المعنى ومفهومه; والعرف إنّما يحكم في تحديد المفاهيم والمعاني خاصّة، وحكم العرف بالتطبيق راجع إلى أنّ ذاك المفهوم المعيّن المبيّن منطبق على المورد الكذائي، وليس هذا الانطباق أمراً تعبّدياً فرضيّاً ليحكم العرف فيه، بل لو كان الانطباق قهريّاً فهو وإلاّ فلا مجال لفرض الانطباق.
نعم، ربما تكون مناسبات الأحكام موجبة لشمولها لغير الموضوعات المفروضة في النصوص، وهذا شيء آخر غير ما نحن بصدده من تحديد المفاهيم بالمعنى الدقيق للكلمة; ولذا ترى أنّه قد يعمّم الحكم لمفهوم مغاير قطعاً للمفهوم من لفظ مأخوذ في موضوع الحكم على أساس مناسبة الحكم والموضوع، فيحكم مثلاً بحرمة النظر إلى صورة الأجنبيّة ونقشها مع كون النقش غير الشخص بلا ترديد. فلاحظ وتأمّل في أطراف ما ذكرنا، ولا تعجل بالردّ عليه فإنّه حريّ بالدقّة.
فقد تحصّل بما قدّمناه عدم العبرة بالمسامحات في التطبيق، التي ربما يُصر العرف عليها ولا التطبيقات الخاطئة التي يتراجع العرف عن حكمه بعد التنبّه لها.
(الصفحة115)
الباب الأوّل:
مسائل تتعلّق بترقيع الأعضاء
(الصفحة116)
(الصفحة117)
المسألة الاُولى : لا يجوز قطع عضو من الحيّ المحترم ، ولو لغرض الترقيع حيث يستلزم قتل المقطوع (1) .
المسألة الثانية : هل يجوز قطع عضو للترقيع من المهدور بقصاص أو رجم أو حدّ ؟ فيه تفصيل (2) .
(1) يدلّ عليه كلّ ما دلّ على حرمة القتل والجناية على النفس; ولا ولاية للإنسان على قتل نفسه ، ولا يحلّ بالإذن أيضاً .
(2) إذا كان هدر الشخص لكفر فالظاهر عدم البأس بذلك; فإنّه لا احترام لدمه ، ولا معيّن لكيفيّة قتله عدا ما تأتي الإشارة إليه من حرمة المُثلة ولو بالكلب العقور .
وأمّا المهدور لقصاص فهدره مخصوص بوليّ الدم لا يجوز لغيره الاقتصاص . ويعدّ التعدّي عليه من غير الوليّ جناية موجبة للقصاص .
نعم ، يجوز لوليّ الدم التسبيب إلى القصاص ولا يتعيّن عليه المباشرة; لإطلاق دليل القصاص وخصوصه على كلام في كفاية إطلاق دليل القصاص .
ثمّ إنّه لا يجوز لوليّ الدم المُثلة بالجاني وإنّما الجائز له القتل ، وقد ورد في النصّ أنّه يجاز عليه بالسيف .
(الصفحة118)
إن قلت : هل يجوز القصاص بشتّى أنحائه ، ومن جملتها التسبيب إلى قتل الجاني بقطع أعضائه لإطلاق دليل القصاص؟
قلت : مع الشكّ في صدق القصاص بمثله فيما إذا لم يكن الجاني قطع عضواً من المجنيّ عليه ، فإنّه عبارة عن متابعة الجاني وأثره ، فكأن الجاني يُؤمّ ويتبع أثره ، إنّه إنّما يجوز الأخذ بإطلاق دليل القصاص لو تمّ ، إذا لم يعارض بدليل حرمة المُثلة .
والتعارض وإن كان بالعموم من وجه إلاّ أنّ دليل التحريم مقدّم; لكون التعارض بين حكم إلزامي وهو تحريم المُثلة وحكم ترخيصي وهو جواز الاقتصاص بوجوه مختلفة ، حيث لا يتعيّن القصاص بنحو خاص بدليله ، وفي مثله يقدّم دليل الحكم الإلزامي ، نظير التعارض بين إطلاق حرمة الغصب وإطلاق وجوب الصلاة الشامل للمكان الغصبي لو كان .
والسرّ في ذلك أنّ العرف لا يرى تعارضاً بين الحكم الإلزامي وغيره بل يرى الإلزام مقدّماً ، فهو من قبيل تعارض المقتضى واللاّ مقتضى .
هذا مضافاً إلى ما ورد من عدم جواز المُثلة بالقاتل خصوصاً وإن كان هو ممثّلاً بالمجنيّ عليه .
وأمّا المهدور في حدّ شرعي فإن كان حدّه قطع عضوه كالمحارب فلا كلام في الجواز وإلاّ لم يجز التعدّي عمّا حدّ له من رجم أو غيره ; للأصل; بل إطلاق حرمة التمثيل.
ولو قتل بقطع عضو فيما كان حدّه القتل ، ففي جواز القصاص له إشكال . مقتضى القاعدة ذلك إلاّ أن يستفاد من دليل الحدّ أنّ الكيفيّة الخاصّة معيّنة على سبيل تعدّد المطلوب كواجب مستقلّ ، فيكون أصل قتله واجباً والكيفيّة المعيّنة كذلك ، ولو خُولفت الكيفيّة أثم خاصّة .
(الصفحة119)
المسألة الثالثة: لو بان عضو من الحيّ بالجناية ، فإن أمكن ترقيعه بالمجنيّ عليه فهل يجب ذلك على الجاني أو لا ؟ ولو فعل ففي ثبوت القصاص والدية إشكال . ومع عدم الإمكان ففي اختصاص المجنيّ عليه ، به فلا يجوز أخذه منه قهراً إشكال . فلو رقع به الغير ففي جواز استرداده بالقطع لصاحبه الأصلي إشكال . وكذا إذا كان ترقيعه بالمجنيّ عليه ممكناً فلم يفعل ورقع به غيره (1) .
(1) إذا جنى شخص على غيره فقطع منه عضواً فقد يقال بوجوب ترقيعه عليه مع الإمكان; نظراً إلى أنّ المتفاهم من دليل حرمة الجناية هو الحرمة حدوثاً وبقاءً ، ومع التمكّن من رفع الجناية يجب كما كان الدفع أوّلاً واجباً .
ثمّ إن لم يفعل ثبت القصاص أو الدية باختلاف الموارد . هذا إذا لم يتمكّن المجنيّ عليه من رفع الجناية بالمباشرة ، وأمّا مع تمكّنه ففي ثبوت ذلك إشكال ، بل تفصيل; وذلك، فإنّه ربّما لا تنسب الجناية إلى الجاني كما إذا قطع الجاني عرقاً ، مع تمكّن المجنيّ عليه من شدّه وقطع الدم فإنّه بالترك يعدّ مفرطاً .
وإن شئت فقل: إنّ الموت مستند إلى السبب المتأخّر ، وهو ترك قطع الدم لا إلى الجزء السابق وهو قطع العرق .
وقد تنسب كما لو قطع الجاني شحمة الاُذن وكان المجنيّ عليه متمكِّناً من جعله على الموضع وكان يلتحم في زمان بسيط ، ففي الحكم إشكال .
ولكن لا ريب في استناد القطع أوّلاً إلى الجاني وإن كان بقاء الحرمان منه ،
(الصفحة120)
مستنداً إلى المجنيّ عليه ، فيثبت القصاص بالقطع حينئذ . وبه يفترق عن المثال السابق; حيث إنّ الموت لا يستند إلى مجرّد قطع العرق الواقع من الجاني ، فالمجنيّ عليه متمكِّن من دفع الجناية بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجناية واقعة ويتمكّن المجنيّ عليه من رفعه .
فقد تحصّل: إنّ ما ذكرناه ليس في الحقيقة تفصيلاً في ثبوت القصاص والدية مع استناد الجناية ، بل عدم القصاص والدية في الفرض الأوّل; لعدم استناد الجناية الخاصّة ، كما لايخفى .
وجوب علاج المجنيّ عليه على الجاني:
ثمّ إنّه يقع الكلام في وجوب ترقيع العضو المبان بالجناية ، حيث يتمكّن الجاني من ذلك .
قد يقال بعدم الوجوب; للأصل ، بل لظهور أدلّة القصاص والدية في تعينهما . ووجوب شيء آخر يدفعه الإطلاق .
هذا لو احتمل بدلية العلاج عن القصاص . ولو احتمل وجوب العلاج زائداً على القصاص وغيره أمكن التمسّك لنفيه بالإطلاق المقامي .
ويمكن أن يُقال بوجوبه; نظراً إلى أنّ المتفاهم عرفاً من دليل حرمة الجناية هو حرمتها حدوثاً وبقاءً ، فمع التمكّن من رفع الجناية يجب كما كان الدفع واجباً أوّلاً ، بل يمكن أن يقال : إنّ ترك الترقيع والإبقاء على الجناية بنفسه ظلم .
بل قد يقال: بعدم جواز القصاص حيث رقع الجاني عضو المجنيّ عليه; بناءً على التعليل الوارد في موثّق إسحاق من «أنّ القصاص من أجل الشين» فإذا زال أو اُزيل فلا موضوع للقصاص ولا موجب له .
بل أفاد سيّدنا الأستاذ وفاقاً لبعض آخر ، سقوط القصاص إذا باشر المجنيّ عليه بنفسه الترقيع قبل استيفاء القصاص; استناداً إلى هذا التعليل .
(الصفحة121)
أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه
يمكن تقريب وجوب العلاج هنا ، بل وفي غير المقام أيضاً ولكن في الجملة ، بوجوه:
الأوّل: أنّ تركه تعريض للنفس للقصاص ، فإذا كان التحفّظ على الأعضاء واجباً ولا يتمّ إلاّ بإخراج النفس عن موضوع القصاص ـ بناءً على سقوط القصاص بالترقيع كما استظهرناه من بعض مشايخنا ـ وجب العلاج . وعلى هذا الأساس لو طالب المجنيّ عليه بالدية للعفو وجب بذله لذلك .
وعليه حيث يجب التحفّظ على النفس من الهلاك ، يجب بذل أضعاف الدية عند مطالبة الوليّ . وهذا الوجه خاصّ بمعالجة المجنيّ عليه .
الثاني: دلالة حرمة الجناية على حرمتها بمعنى الاسم المصدري فلا يختصّ التحريم بحدوث الجناية ، بل بقائها المستند إلى الجاني كحدوثها محرم .
الثالث : عدّ بقاء الجناية ظلماً عقلاً كحدوثها ، فيجب تداركها بالرفع كما يجب تدارك الحدوث بالدفع .
الرابع : ويمكن أن يضاف إلى ذلك كلّه بناء العقلاء على لزوم رفع الجنابة حيث أمكن كما يجب الدفع أوّلاً ، وانّما ينتقل الأمر إلى البدل حيث لا يمكن رفع الجناية .
وعلى أساسه يمكن القول بوجوب العلاج على تقدير كون الجناية خطأً أيضاً حيث يتمكّن الجاني من رفعها ، فإنّ رفع الجناية حيث كان مبنى العقلاء فلا يفرّق فيه بين موارد العمد في الجناية والخطأ ، وإنّما الفرق بينهما في خصوص الإثم وعدمه .
وما قرّر من الدية في الجنايات فهي من قبيل بدل التالف ممّا لا يتيسّر إعادته فهي من قبيل بدل الحيلولة .
الخامس : ويضاف إلى ما قدّمنا دعوى أنّ المنساق من أدلّة الديات أنّ ثبوتها
(الصفحة122)
بعنوان العوض والبدل عن الجناية; والأعضاء والمنافع الذاهبة بالجناية; وإنّما يثبت البدل في بناء العقلاء ، عند تعذّر أداء المبدل وتسليمه ، وأمّا مع التمكّن من ذلك فلا تصل النوبة إلى البدل . فمع التمكّن من العلاج والترقيع فهو من قبيل تسليم نفس الشيء .
وإن شئت قلت : إنّ تشريع الدية بعنوان البدل ناظر إلى تحديد البدل حيث تصل النوبة إليه ، لا في مقام تعيّن البدل ولو مع التمكّن من تسليم العين .
وبالجملة : ليس دليل الدية ناظراً إلى مورد الدية ، بل مساقه حدّ البدل حيث تثبت(1) .
نعم ، لا منافاة بين القصاص على تقدير عدم العلاج والترقيع ، وبين عدم وجوب الترقيع إلاّ من جهة وجوب التحفّظ على الأعضاء حيث أمكن ولو برفع موجب تلفها ، ويلزمه وجوب دفع أضعاف دية العضو حيث طالب المجنيّ عليه عمداً بذلك .
كما ولا يبعد وجوب دفع ما تمكّن الجاني من دفعه ، بدلاً عن العفو في قصاص النفس; نظراً إلى وجوب حفظ النفس ما أمكن . ولا ينافيه دليل نفي الضرر; فإنّه إنّما ينفي الضرر إذا لم يستلزم نفيه الوقوع في ضرر أشدّ ، وأيّ منّة في نفي ضرر يستعقب الموت .
وإن شئت قلت : إنّ ما يبذل بإزاء حفظ النفس لا يعدّ ضرراً ، فإنّ الضرر هو الخسارة ، ولا خسارة أعظم من ذهاب النفس .
وعلى هذا الأساس يتعيّن على القاتل عمداً دفع ما طالب به الوليّ ، فراراً عن القصاص وتحفّظاً على النفس; وفاقاً للنهي عن إلقاء النفس في التهلكة ، فإنّ
- (1) وقد عثرت أخيراً على كلام لشيخنا المنتظري احتاط في وجوب المعالجة حتّى مع زيادة قيمة العلاج عن الدية .
(الصفحة123)
التعرّض للقصاص تعرّض للهلاك ، لكنّه يجب حيث طالب الولي به متعيّناً; وحيث خيّر الولي بينه وبين البدل تعيّن أداء البدل مع التمكّن عقلاً مهما كان فيه الحرج والضرر ، وإن كان ظاهر الفقهاء عدم وجوب ذلك; حيث ذكروا أنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص ، وأنّ الدية تثبت صلحاً ، ولا يتعيّن على القاتل قبولها فضلاً عمّا إذا طولب بزيادة عن الدية . نعم ، نسب إلى غير واحد وجوب بذل الدية وغيرها ممّا طالب به الولي(1) . هذا .
ولكن في صحيح ابن سنان : «فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف . . .» .
ولا يبعد حمل القيد على الغالب فلا مفهوم له ، فيبقى إطلاق حرمة التعرّض للهلكة بلا معارض .
وما في الجواهر من: «أنّه لا دليل على وجوب حفظ النفس في المقام بعد تعلّق حقّ الغير بها والأمر بإعطاء القصاص» .
فيردّه: أنّ دليله هومطلق مادلّ علىوجوب حفظ النفس، ولاينافيه دليل القصاص;فإنّه حيث عيّنه الوليّوبدونه فلاتعيّن .وحيث كان البدل في اختيار الجاني ، تعيّن عليه حفظ النفس ببذل ما يسقط معه القصاص وإن كان بدونه ولو حراماً ، يجوز القصاص . فهو نظير وجوب التمام على الحاضر وإن كان السفر واجباً إلاّ أنّه بدونه يتعيّن الإتمام في الصلاة والصوم وإن كان التلبّس بالحضر حراماً تكليفاً .
التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية
- (1) راجع الجواهر ، كتاب القصاص 42 : 279 .
(الصفحة124)
هو القصاص أو الدية . وحمل الدية على فرض الصلح إلغاء للعنوان، حيث إنّ الصلح لا يتعيّن وقوعه على مقدار الدية بل يجوز على الزائد والناقص ; ولذا استشكلنا في تقييد نص الدية بفرض الصلح وإن ورد من بعض النصوص تقييد الدية بما إذا أحبّ ذلك القاتل; حيث لم نستبعد كونه من قبيل القيد الغالب الذي لا مفهوم له .
وكيف كان فهذا الاختلاف بيننا وبين المشهور لا أثر له في المقام .
وعلى هذا الأساس يجب على الجاني بذل ما ترتفع به الجناية من ثمن الترقيع وإن زاد على الدية(1) .
- (1) ومن غير البعيد أيضاً عدم تعيّن الأرش في موارد إتلاف الأوصاف في الأعيان حيث أمكن تدارك التالف بإعادته ، سواء كان التالف وصف الصحّة والسلامة أو سائر الأوصاف .
- فلو عيّب شاةً أو حيواناً آخر أو جعلها مريضة وأمكنه العلاج لم يتعيّن عليه دفع الأرش ، بل لا يبعد عدم إجزائه بدون رضا المالك . كما أنّه لو باشر الجاني وعالج جنايته بما جعله كالصحيح لم يكن للمالك أيّ حقّ سوى قيمة الوصف مدّة فقده لو كان له قيمة لطول المدّة ونحوه .
- لا يقال: ربما تكون نفقة العلاج أضعاف قيمة الأصل ، فيكون شأن الفرض أصعب من متلف الأصل .
- فإنّه يقال: هذا مجرّد استبعاد ، ألاترى أنّ من أتلف عبداً ضمن قيمته ، مع أنّه لو كان العبد هذا مريضاً مضطرّاً ، يجب معالجته حيث أمكن ولو ببذل أضعاف قيمته لحفظ حياته فتأمّل .
- وبالجملة: هنا أمران:
- الأوّل: كفاية تدارك الوصف التالف بالعلاج .
- الثاني: تعيّن ذلك إلاّ مع رضا المالك بدونه . ولئن كان شكّ في الثاني فليس في الأوّل منهما إشكال سوى عدم القائل به فيما أعلم ، وهذا ليس مانعاً من الالتزام به .
- والسرّ في عدم تعيّن الأرش على الجاني هو أنّه بدل عن التالف; وإعادة نفس التالف أولى بالكفاية عن البدل; وإنّما لا يصار إليه لصعوبته أو عدم إمكانه عادةً .
- وإن شئت فقل: إنّ القِيم والأروش بدل عن الحيلولة دائماً; وإن كان هذا الاصطلاح يستعمل في موارد خاصّة ، ولا حيلولة مع إعادة المبدل فلا موضوع للبدل .
- هذا كلّه في موارد إتلاف الأوصاف ، وأمّا في موارد بيع المعيوب ففيه كلام آخر ، ولتمام التحقيق في المقامين محل آخر فإنّ المسألة بحاجة إلى تعقيب ، والله العالم .
(الصفحة125)
نعم ، لا يجب عليه بذل الثمن للمجنيّ عليه وإنّما عليه رفع أثر الجناية ، إلاّ إذا رضى المجنيّ عليه ببذل الثمن أو أقلّ .
السادس: ويؤيّده ما في معتبرة غياث عن جعفر، عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «ما دون السمحاق أجر الطبيب» .
بتقريب أنّ افتراض زيادة الدية فيما زاد على السمحاق كان مفروغاً عنه .
السابع: وممّا يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة في موارد الجنايات هو أنّ الجناية إفساد، وهو مبغوض على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث حرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب، فإذا حرم الإفساد اقتضت مناسبة الحكم والموضوع وجوب رفع أثر الإفساد، ولا يكون إلاّ بالعلاج.
(الصفحة126)
المسألة الرابعة: في جواز أخذ أعضاء الميّت الدماغي والمعاملة مع مثله معاملة الميّت ، وفيه تفصيل (1) .
(1) الإنسان حال حياته محكوم بأحكام موضوعها متقوّم بعنوان الحياة، وتزول تلك الأحكام بزوالها ، وتنوب عنها أحكام اُخرى تضادّ سابقتها ، بيدَ أنّ الكلام في تحديد الحياة هذه فهل هي الحياة الشاعرة الدرّاكة أو النامية أو غير ذلك ؟
لا ريب أنّ هناك جملة من الأحكام لا يكفي في ترتّبها الحياة الحيوانية بل تنوط بالحياة العاقلة ، فلا تثبت للمجنون بل ولا للسفيه ، كنفوذ المعاملات الماليّة وكذا التكاليف في الأوّل . كما وهناك أحكام تمام موضوعها الحياة الحيوانيّة كحرمة القتل ، أعني بتمام الموضوع ، ذلك بلحاظ خصوصيّات الحياة من عقل ونحوه . وهناك أحكام موضوعها مقيّد بقيود مضافاً إلى قيد الحياة، فلابدّ من تشخيص دقيق لمعنى الحياة بما هي موضوع للأحكام الشرعيّة . هذا للفقيه; ويتّضح بسببه موضوع الحياة في الأحكام العرفيّة أيضاً فنقول :
موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها
(الصفحة127)
الشرعي في كثير من أبواب الفقه وكتبه :
1 ـ في كتاب الاجتهاد والتقليد أخذت موضوعاً لجواز التقليد وحرمته ولجواز العدول وعدمه .
2 ـ في كتاب الطهارة في :
أ ـ طهارة البدن في الإنسان ، وكلّ حيوان ذي نفس ، وللحكم بالنجاسة .
ب ـ ولوجوب التجهيز والدفن ، ولوجوب غسل المسّ بعد البرد .
3 ـ وفي كتاب الصلاة موضوعاً لوجوب قضائها في الجملة ، ونعني بالإجمال احتمال كون الموضوع أخصّ من الحياة; كالفوت الذي هو ملزوم التكليف المشروط بالعقل وغيره ، ممّا يوجب انتفائه انتفاء الحكم ولو مع بقاء الحياة فلا يدور الحكم مدارها .
وأيضاً لا يجب قضاء ما فات حال الإغماء مع وجوب تدارك ما فات حال النوم .
4 ـ وفي كتاب الصوم موضوعاً لصحّته ، فيصحّ من النائم الذي لا قصد له حينه وإن كان صومه عن قصد سابق ، ولوجوب قضاء الفائت منه في الجملة .
5 ـ وفي كتاب الخمس والزكاة موضوعاً لملك النصاب والفائدة .
6 ـ وفي المكاسب والتجارات وكثير من العقود موضوعاً للملكيّة في الجملة ، فلا يصحّ التصرّف في ملك شخص بدون إذن سابق أو ولاية ; وبموته ينتقل المال إلى وارثه ، فلا بأس يتصرّف الوارث حينئذ ، ويبطل إذن الميّت بانعدام موضوع إذنه وهو ملكيّته .
وعلى هذا الأساس تبطل المضاربة وغيرها من العقود الإذنيّة ببطلان موضوعها المتقوّم بالملك المتقوّم بالحياة .
وأيضاً موضوعاً لفسخ الوكيل والولي; إذ لا يجوز لهما الفسخ بعد موت الموكّل
(الصفحة128)
والمولّى عليه لبطلان الوكالة والولاية ، إلاّ أنّ هذا الحكم من فروع أخذ الحياة موضوعاً في الوكالة أيضاً .
7 ـ وفي كتاب الوكالة موضوعاً لها فتبطل الوكالة بموت الموكّل ، وكذا موت الوكيل وأثره في فرض وكيل الوكيل ظاهر .
وربما كان الموضوع هنا أخصّ من الحياة ; فلذا كان المشهور بطلان الوكالة بالإغماء مع كونه حيّاً بلا ريب .
8 ـ وفي كتاب النكاح موضوعاً لبقاء الزوجيّة ، وبتبعها موضوعاً لوجوب الإنفاق على الزوجة ، ولصحّة طلاق المرأة فلا يصحّ طلاق المرأة الميّتة ، وأمّا طلاق الرجل بلحاظ صحّة طلاق وكيله فمندرج فيما أشرنا إليه من كتاب الوكالة .
وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجية ، لعدم جواز نكاح الخامسة ، ولجواز الاستمتاع ، فلا يجوز الاستمتاع بالميّتة لبطلان الزوجيّة بالموت على ما هو المعروف بخلاف النائمة والمغماة فلا بأس بالتمتّع بهما لزوجهما .
وأيضاً موضوعاً بتبع الزوجيّة لجواز الفسخ بالعيوب المجوّزة لذلك ، وأيضاً موضوعاً في ولاية أولياء النكاح فلا يجوز للأب والجدّ تزويج الصبي الميّت .
وكذا حياة الأب أخذ موضوعاً لولاية الجدّ على التزويج على قول .
9 ـ وفي كتاب الطلاق موضوعاً لصحّته بتبع تقوّم الطلاق بالزوجيّة المتقوّمة بالحياة .
10 ـ وفي كتاب العتق موضوعاً لصحّته ، حيث لا موضوع للعتق بعد الموت .
11 ـ وفي كتاب الاستيلاد موضوعاً لانعتاق الاُمّ ، فبموت السيّد تنعتق الاُمّ من نصيب ولدها الحيّ .
12 ـ وفي كتاب التدبير موضوعاً لانعتاق المدبّر ، حيث ينعتق العبد بموت سيّده .
(الصفحة129)
13 ـ وفي كتاب الصيد والذباحة موضوعاً للذكاة .
14 ـ وفي كتاب الميراث موضوعاً لبقاء الملك ، على الأموال والحقوق; ولانتقال ذلك إلى الوارث وللإرث ، فلا يملك الميّت ولا يرث بعد موته بموت نسيب أو مسابب له ، وإن أمكن ملكه بسبب آخر كدية وما شاكلها ممّا يكون سببه بعد الوفاة كالجناية على أعضاء الميّت . وموضوعاً في الحبوة للولد الأكبر الحيّ .
15 ـ وفي كتاب الحدود موضوعاً لقتل المفسد والمحارب وبعض الفواحش ، حيث لا يثبت شيء من الحدود بالموت .
إلاّ أن يثبت عدم جواز الحدّ مع مطلق الحياة فلا يجوز قتل هؤلاء حال الإغماء مثلاً ، فيكون الموضوع أخصّ من الحياة .
16 ـ وفي كتاب القصاص موضوعاً لجواز القصاص من الجاني فلا يقتصّ من الميّت ، وموضوعاً للقصاص في المجنيّ عليه فلا يقتصّ للجناية على الميّت بقطع عضو منه وإن ثبتت الدية كما لا يقتصّ من الميّت الجاني في حال حياته ، فالحياة في المجنيّ عليه حال الجناية شرط في جواز القصاص له من الجاني ، وفي الجاني حال القصاص مقوّم للقصاص .
وفي كون الموضوع في قصاص النفس أصل الحياة أو الحياة المستقرّة وكذا في قصاص الأطراف أو كون الموضوع الحياة الشاعرة إشكال .
وظنّي أنّ الفقهاء يرخّصون في قتل المجنون قصاصاً أو حدّاً إذا كان موجبه حال الإفاقة . وينبغي عليه جواز ذلك حال الإغماء أيضاً بعد اشتراكهما في انتفاء التكليف .
إلاّ أن يكون الغرض من الحدّ الردعَ لخصوص الجاني ، فلا موضوع للحدّ فيمن لا إفاقة له من الإغماء لاستمراره حتّى الموت; ومن القصاص الاستشفاء ، فلا موضوع له فيمن لا يفيق من إغمائه حتّى الموت أو يكون الغرض هو المجموع .
(الصفحة130)
17 ـ وفي كتاب الديات موضوعاً لتعيّن الدية فيما إذا مات الجاني أو جنى الحيّ على ميّت .
18 ـ والحيّ المأخوذ موضوعاً في وجوب حفظ النفس المحترمة ، بالانفاق .
19 ـ والهدي المأخوذ جزءً من مناسك الحجّ وغيره وواجباً في الكفّارات فإنّه متقوّم بالحياة فلا يصحّ ذبح الميتة .
20 ـ والأنعام الثلاثة المأخوذة موضوعاً لوجوب الزكاة ومصداقاً للزكاة التي تؤدّى; فإنّها متقوّمة بالحياة على الظاهر ، فلا يجب على مَن ملك لحومها بعد الذبح سنة شيء بعنوان الزكاة ، ولا يجزي على الظاهر دفع لحومها بعنوان الزكاة .
ويشهد لاشتراط النصاب بالحياة التفصيلُ في النصوص بين السائمة والمعلوفة .
فلابدّ من تحديد الحياة وبيان أنّها في تمام هذه الأحكام بمعنى واحد وحدٍّ فارد ، أو يختلف باختلافها ، فالحياة المأخوذة موضوعاً لصحّة الصوم بمعنى شامل لحال الإغماء ، والتي أُخذت موضوعاً لصحّة الوكالة تزول بالإغماء .
والحياة المشروطة في صحّة التقليد تجامع حالة الإغماء مع عدم كفايتها في وجوب قضاء ما فات المكلّف من الصلاة .
وأيضاً بقاء الملكيّة والزوجيّة حال الإغماء وصحّة الطلاق عنده فيما كانت المرأة هي المغمى عليها ، ونفوذ فسخ النكاح معه يستلزم عدم كون الموضوع فيها مطلق الحياة ، بل هي مع مرتبة من الشعور المتحقّق حال النوم دون حال الإغماء بل وحال الجنون .
فربّما نقول بعدم صحّة طلاق المرأة حال احتضارها ، مع وجوب الإنفاق عليها ، ممّا يستلزم كون الموضوع لوجوب النفقة متحقّقاً دون الطلاق . ولا نريد الآن دعوى ذلك بل ما ذكرناه مجرّد فرض ، للتنبيه على أنّ كلّ باب لابدّ من ملاحظته مستقلاًّ عن غيره; ولا يستلزم الحكم في مورد الحكمَ في الآخر .
(الصفحة131)
وأيضاً ربما يحكم على الحيوان بعدم النجاسة بموت دماغه ، ومع ذلك يحكم بعدم جواز تذكيته بالذبح ونحوه في تلك الحالة ، ممّا يستدعي كون الحياة المأخوذة موضوعاً لكلّ من الحكمين تختلف عن المأخوذة في الآخر .
ضابط صدق الحياة
فعند ثبوت الحواسّ الخمس ولو بعضها ، من إبصار أو سمع أو لمس وإحساس ، يحكم بالحياة بلاريب . والمعنيُّ بثبوت الحواسّ قابليّتها بما لا ينافي عدم فعليّتها حال النوم وما شاكله .
كما وهناك موارد ، يكون فيها صدق الموت واضحاً، كما لا يخفى .
وهناك موارد أخرى وإن كان صدق أحد الأمرين خفيّاً إلاّ أنّه بالدقّة والمنبّهات ربما يتّضح الأمر فيها ثبوتاً ونفياً .
حكم الشبهة المفهوميّة للحياة
ثمّ حيث تبقى هناك حالة رابعة لا يدرى فيها الصدق وعدمه ـ فإنّ لمفاهيم الألفاظ حتّى في فرض الوضوح والبداهة فضلاً عن سائر الفروض ، إجمالاً في بعض الموارد ـ يكون المرجع فيها بعد قصور الأدلّة اللفظيّة الأصولَ العملية ، عقلية وشرعيّة . ومفاد الأصل يختلف باختلاف الموارد ، ولابدّ من التعرّض لذلك بالتفصيل .
ولا مجرى للاستصحاب في الموضوع ، حيث إنّ الشبهة مفهوميّة ، فكما
(الصفحة132)
لا يجري الاستصحاب لإثبات بقاء اليوم بعد سقوط القرص ، مع الشكّ في صدق اليوم قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، لا مجال لاستصحاب الحياة في موارد الشكّ في صدقها ، لا من جهة اشتباه الموضوع ، فإنّ الاستصحاب لا يتكفّل إثبات الوضع .
ثمّ إنّ الرجوع إلى الاُصول إنّما يكون في فرض عدم وجود عامّ أو مطلق غير مقيّد بقيد الحياة على وجه الاتّصال ، وإلاّ فحيث تصير الحياة مجملاً في بعض الموارد ، فالمرجع هو المطلق والعامّ لا غير ، كما هو واضح .
فلو فرض إطلاق في دليل القصاص بالنسبة إلى الجناية على الميّت ، وكان خروج الجناية على الميّت بدليل خارجي ، فيتمسّك بإطلاق دليل القصاص حيث يشكّ في مفهوم الحياة والموت . هذا بناءً على ما هو المعروف في هذا الباب من الاُصول وإلاّ فلا فرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل في سقوط العامّ والمطلق عن صلاحية الاستدلال في الشبهات المفهوميّة للمخصّص .
بيان مفهوم الحياة على الجملة
بيدَ أنّ في موارد ذهاب الشعور والحركة الإراديّة وعدم إمكان عوده حيث تشخّص ، تارةً يكون التنفّس الطبيعي موجوداً ، بمعنى أنّ استنشاق الهواء اللاإرادي متحقّق بلا حاجة إلى وسيلة وآلة ، ففي هذه الموارد يحكم بالحياة .
كما أنّه في موارد التنفّس الاصطناعي ، بمعنى إدخال الهواء في الرئة عبر آلة واستخراجها عبر اُخرى ، والتسبيب إلى جريان الدم في العروق عبر الأدوات الطبّية لا يحكم بالحياة; وإن كان بعض آثارها ، من النموّ وعدم فساد البدن ، باقياً; فإنّ ذلك لا يعدّ من الآثار الخاصّة للحياة الإنسانيّة ، بل يعدّ أثراً للحياة النباتيّة أوّلاً والتي هي منتفية أيضاً إذا استندت إلى أدوات خارجيّة ـ أعني من خارج البدن ـ ثانياً . ألا ترى أنّه في موارد التبريد والتجميد لا يفسد البدن أو لا ينتن ومع
(الصفحة133)
ذلك لا يحكم بالحياة .
ونعني بانتفاء الحياة أنّ المتفاهم من اشتمال الشيء على الحياة النامية هو استنادها إلى نفسه لا إلى سبب من الخارج .
كما وينبغي الالتفات إلى نقطة ، هي أنّه ربما لا تكون قابليّة العيش والرجوع إلى الحياة مانعاً من صدق الموت ، ويكون رجوع الحياة من قبيل عودها بمعجز كإحياء المسيح للموتى أو حياة الآخرة المجدّدة أو حياة الرجعة وما شاكلها ممّا ورد في القرآن الإشارة إليه في قضيّة عزير وحماره وقضيّة {الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ}(1) .
وبالجملة : ربما كان المرتكز في الأذهان أنّ قابلية عود الحياة تكشف عن استمرار الحياة ووجودها غير أنّها تبرز بعد الخفاء ، وهذا وإن كان ممكناً في كثير من الموارد إلاّ أنّه لا مانع عقلاً، بل ولا وقوعاً من الالتزام بوقوع الموت لحظات ، نظير موارد وقوع الإغماء ـ لا أنّ الإغماء مصداق الموت ـ ثمّ تجدّد الحياة; ونتيجة ذلك أنّ البدن في تلك اللحظات ميّت ثمّ يكون حيّاً بعدها .
ثمّ يقع الكلام في أنّ الموت الموضوع للأحكام هل يشمل مثل هذا الموت الواقع في برهة قصيرة فيحكم بنجاسة البدن وبوجوب الغسل من مسّه ، ثمّ بعد عود الحياة لابدّ من تطهيرها بالغَسل; لأنّ المطهّر منحصر في الماء وليس تجدّد الحياة من المطهّرات ، أو لا يشمله؟!
بيدَ أنّا لا ننكر كون الحياة في جملة من الموارد من قبيل الظهور بعد الاختفاء ، بمعنى عدم انعدامها في شيء من الزمان ، ويكون زمان الاختفاء من قبيل زمان احتباس النَفَس بضع ثواني ممّا تكون الحياة باقية عندها جزماً .
- (1) سورة البقرة الآية 243 .
(الصفحة134)
ثمّ يشكّ في بعض الموارد أنّه من أيّ القبيلين بشبهة موضوعيّة ، ويكون المرجع فيها استصحاب الحياة حيث لا يكون الشكّ في المفهوم ، وإلاّ فالمرجع استصحاب الحكم لو جرى في الشبهة الحكميّة ، وبدونه فالمرجع سائر الاُصول العملية من براءة أو غيرها .
إطلاق بعض النصوص للميّت الدماغي
ففي رواية عليّ بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكّة سنة من السنين صواعق كثيرة مات من ذلك خلقٌ كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) فقال مبتدءاً من غير أن أسأله:
«ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثاً لا يدفن إلاّ أن يجيء منه ريح تدلّ على موته .
قلت: جعلت فداك كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياء؟
فقال: نعم يا عليّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلاّ في قبورهم»(1) .
والمنساق منه عدم كفاية ذهاب الأمارات المتعارفة للحياة ـ كالتنفّس والحركات ـ في الحكم بالموت; وإنّ ضابط الموت عدم إمكان حياته بصورة طبيعيّة ولو بعد زمان; وكفاية عدم تغيّر بدنه بريح ونتن تدلّ على الموت ، أو مضيّ ثلاثة أيّام في ترتيب آثار الحياة .
ويؤكّد هذا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «خمس ينتظر بهم إلاّ (إلى ـ خ) أن يتغيّروا: الغريق والمصعوق والمبطون
- (1) الوسائل 2: 677 ، الباب 48 من الاحتضار ، الحديث 5 .
(الصفحة135)
والمهدوم والمدخّن»(1) .
وفي موثّق إسحاق بن عمّار ، قال: سألته ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ عن الغريق أيغسل؟ قال: «نعم ويستبرأ . قلت: وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن . وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت»(2) .
وفي بعض أسانيده بعد قوله: أن يدفن: «إلاّ أن يتغيّر قبل فيغسل ويُدفن» .
وفي صحيحة هشام عن أبي الحسن (عليه السلام) في المصعوق والغريق ، قال: «ينتظر به ثلاثة أيّام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك»(3) .
وفي موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «الغريق يحبس حتّى يتغيّر ، ويعلم أنّه قد مات ثمّ يغسل ويكفّن . قال: وسُئل عن المصعوق؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسل ويكفن»(4) .
والمتحصّل من هذه النصوص الحكم بالموت عند أحد أمرين:
الأوّل: مضيّ ثلاثة أيّام خالياً عن الحركات المتعارفة الدالّة على الحياة المدركة لعامّة الناس ، ومن جملتها التنفّس وإن لم يتغيّر .
والثاني: تغيّر بدنه بما يدلّ على بطلان حياته النامية .
ثمّ لا يبعد استفادة ما قرّرناه من الحكم بموت من مات دماغه ولا تستند حركاته التنفّسية وغيرها إلى نفسه ـ وكأنّه الذي يصطلح عليه بالموت الدماغي ـ من هذه النصوص; حيث حكمت بالموت ولو بعد ثلاثة أيّام وإن لم يتغيّر ، مع فرض انتفاء العلامات المتعارفة للحياة التي كانت مدركة للعرف آنذاك مثل
- (1) نفس المصدر ، الحديث 2 .
- (2) نفس المصدر ، الحديث 3 .
- (3) نفس المصدر ، الحديث 1 .
- (4) نفس المصدر ، الحديث 4 .
(الصفحة136)
التنفّس . فكأنّ موضوع هذه النصوص هو من لم يتحرّك ولم يتنفّس فهذا ينتظر به ثلاثة أيّام أو زماناً دون ذلك ثمّ يحكم بموته وإن كانت أعضائه قابلة للترقيع .
المتحصّل في ضابطة الحياة
فقد تحقّق ممّا ذكرناه في موت الدماغ أنّه: إذا كانت حياة القلب والتنفّس مستنداً إليهما وإن كان بواسطة آلة من خارجهما تكون كالمعدّ لعملهما ، نظير إعداد الغذاء لذلك ، ونظير إعداد تزريق المواد الغذائية في الدم ، ونظير تأثير القوّة الكهربائية التي توصل بالجسم المشلول في قابلية التحرّك، ممّا لا يوجب انتساب نفس حركة العضو إليها وإنّما تنسب لها القابلية ، فلو بطش المريض والمشلول المستفيق بالقوّة الكهربائية بغيره ضمن ، ولا يعدّ من قبيل أخذ شخص بيد غيره وبطشه بها .
وبالجملة : ففي مثل هذا يعدّ الشخص حيّاً وإن كانت حياة قصيرة . ولعلّ السرّ في بقاء هذه الحياة مع أنّ نظام البدن متقوّم بمركز الدماغ ومنفعل منه هو وجود قوّة وحياة في الأعضاء أو بعضها منفصلة عن الدماغ يمكنها إدارة العضو برهة حتّى أنّه إذا اختلّ الدماغ أحياناً زماناً يسيراً قام نفس العضو بعمل الدماغ .
ويشهد لذلك أنّ من قطع رأسه يتحرّك بدنه وينبض قلبه ويتنفّس زماناً ، وربما يطول كما هو المشاهد في بعض الحيوانات عند ذبحها ، وربما قام ومشى خطوات ، فالروح تكون بعدُ متلبِّسةً بالبدن ولم تنفصل تماماً وإن كان تلبّسه ليس على حدّ تلبّس الروح بالبدن في غير هذه الحالة .
إن قلت : إذا كانت حياة القلب والتنفّس كافية في صدق الحياة ، وعدّ المذبوح حال اضطرابه حيّاً بعد لم يمت ، فهل تترتّب على مثل المقطوع رأسه آثار الحياة فيقتصّ ممّن يخمد هذه الحياة دون الذابح ، حيث يستند القتل إلى السبب المتأخّر
(الصفحة137)
عند توارد سببين، كما لو أشربه شخص سمّـاً قاتلاً بعد ساعة وذبحه غيره قبل الأمد ، وكما لو جرحه شخص بما يسري إلى نفسه بعد يوم أو أيّام ثمّ عجّل به شخص آخر بآلة اُخرى .
قلت : من الواضح أنّ استناد تمام الموت إلى السبب المتأخِّر في تمام هذه الموارد المفروضة ، فلو فرّق بينها كان تفصيلاً بينها في الحكم لا في الصدق والانتساب . ويؤيّد ما ذكرنا من تحقّق الحياة فيما فرضنا ، فتوى سيّدنا الأستاذ (قدس سره) على ما ببالي من أنّ الحيوان إذا ذبح من غير الموضع المقرّر شرعاً ثمّ ذبح من الموضع الخاص قبل موته كفى في الحلّ .
نعم ، ربما يصدق القتل في مورد الذبح وإن لم تذهب الحياة بعد ولم يتحقّق الموت دون مورد الجرح الساري إلى النفس بعد زمان كشهر ، ويكون سبب القصاص السابق من أحد أمرين: القتل أو الموت المستند إلى جان . وعليه فيجوز الاقتصاص من الجاني بمجرّد الذبح ولا يجوز القصاص من الجارح الساري جرحه قبل موت المجنيّ عليه .
هذا ، ولكن ربما كان صدق القتل في الذابح بعناية المجاز والأول والمشارفة وإلاّ فلو أمكن ترقيع الرأس بالبدن قبل انسلاخ الروح وانتزاعه، فهل يصدق مع ذلك أنّه مقتول ما لم يمت تمام الموت؟ فهل يعدّ ترقيع الرأس حيث استمرّت الحياة من قبيل الإحياء المجدد؟ أو يعدّ بقاءً للحياة السابقة؟ نظير ما لو شدّ العرق النازف دماً بعد الجناية بفتحه ممّا لو لم يسدّ آلَ به إلى الموت; ولكن حيث كان سدّ العرق أمراً ممكناً عند العرف يكون صدق الحياة في مورده واضحاً بخلاف قطع الرأس ممّا لا يمكن بحسب نظر العرف ترقيعه بالبدن .
كما ربما يفصل في موجب القصاص بين السبب القريب من قبيل الذبح وبين السبب البعيد من قبيل الجرح الساري بعد شهر; فيكون السبب القريب تمام
(الصفحة138)
الموجب للقصاص فلا يقتصّ من السبب المتأخّر عنه ، بخلاف السبب البعيد فيكون إيجابه للقصاص منوطاً بعدم تأخّر سبب آخر عنه ، من دون فرق بين السببين في نسبة القتل إليهما على تقدير تأخّر سبب آخر .
حكم القصاص في قتل المحتضر
إنّ تحقّق الحياة ربما لا يلازم اعدامها القصاص وإن حرم; فلو أجهز شخص على المحتضر أو الجريح المشرف على الموت ربما لا يثبت معه القصاص وإن صدق في مورده القتل; لا لانصراف القتل عن مثله بل لتعليل القصاص بأنّ فيه حياة للناس كما في الآية، فكأنّ القصاص منشأ استمرار حياة الناس كما أنّ عدمه منشأ عدم استمرار الحياة; ففي مورد لا يكون منشأ عدم استمرار الحياة عدم القصاص بل عدم المقتضي لاستمرار الحياة، فقد لا يكون هناك موجب للقصاص . وما دلّ على أنّ النفس بالنفس فقد يكون ناظراً إلى عدم جواز أخذ النفس قصاصاً عن ما دون النفس ، ولا التعدّي على أكثر من نفس الجاني عند الجناية على النفس ، وأمّا جواز أخذ النفس عن كلّ نفس فهو بحاجة إلى مزيد مراجعة وهذا الذي ذكرناه مجرّد احتمال .
وربما يؤيّده دعوى عدم صدق القصاص بحقيقته في مثل المقام فإنّه عبارة عن متابعة الجاني في فعله لا التعدّي عن مقدار الجناية والزيادة عليه .
ونفس الجاني مع استقرار حياته زائد على نفس المجنيّ عليه المشرف على الموت ، فهو نظير الاقتصاص من اليد الصحيحة بقطع اليد الشلاّء وقد منعه الفقهاء .
نعم ، ثبت عدم التفاوت بين النفوس من ناحية اختلافها في العلم والسيادة والشرف والصغر والكبر، فلا تخلط .
(الصفحة139)
مسائل ستّ في الميّت الدماغي:
وإذ قد تحقّق صدق الحياة عند موت الدماغ مع بقاء حياة القلب والتنفّس بما لا يستند إلى غير الشخص مباشرة فهناك مسائل:
1 ـ هل يجب المحافظة عليها على المسلمين كما يجب حفظ حياة عامّة المسلمين؟
2 ـ وكذا هل يجب على نفس المكلّف التسبّب إلى حفظ هذه الحياة حيث أمكن؟
3 ـ وعلى تقدير عدمه ، هل يجوز رفع الأدوات التي تحافظ على بقاء هذه الحالة وهذه الحياة ؟
4 ـ ثمّ هل يثبت في مورده القصاص على الجاني على تقدير عدم جواز رفع الآلات ، فيقتل الفاعل قصاصاً؟
5 ـ وهل يثبت القصاص في قطع أعضائه؟
6 ـ وعلى تقدير عدمه ، هل يحرم تكليفاً قطع أعضائه بناءً على جواز قطع أعضاء الميّت لغرض الترقيع؟
هذه أسئلة ستة ، وتجري هذه الأسئلة في القسم الآخر من الموت الدماغي أعني ماتستند فيه حياة القلب والتنفّس إلى الأدوات مباشرة سيّما الأوّلان والأخير.
دليل وجوب حفظ نفوس المسلمين
أمّا وجوب المحافظة عليها على المسلمين فعمدة الدليل على وجوب المحافظة عليهم هو التعرّف على الذوق الشرعي والذي لا يمكن إيحائه إلى الشخص بسهولة . ودعوى العلم بذلك في مثل الفرض لا شاهد لها ولا يمكن إثباتها .
وأمّا الأدلّة اللفظية فربما يستدلّ لذلك بحديث: «من سمع مسلماً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» بدعوى عدم اختصاصه بطلب العون في مقابل الظالم، بل هو شامل لطلب المعونة في مقابل المرض ونحوه .
(الصفحة140)
نعم ، صدق عنوان النصّ في مورد الموت الدماغي ممّا تستند حياة القلب إلى الأدوات مباشرة ، إمّا منتف قطعاً أو مشكوك بشبهة مفهوميّة . وأمّا في القسم الآخر فغير بعيد; بناءً على ما قرّرناه من أنّ الحديث كناية عن الاضطرار والاستئصال ولا خصوصية للنداء .
ومنه يعلم الإشكال في وجوب التسبيب لحفظ مثل هذه الحياة على المكلّف نفسه، وأنّه لابدّ فيه من التفصيل بين القسمين. كما يعلم من ذلك الإشكال في حرمة رفع الآلات الحافظة لهذه الحياة، وأنّه ينبغي التفصيل فيه أيضاً بين القسمين.
وعلى أساسه فلا قصاص حيث جاز رفع الآلات الموجب لزوال الحياة النامية المتقدّمة، كما لا قصاص في الطرف أيضاً بعد فرض الموت على التفصيل المتقدّم.
حكومة دليل نفي الحرج على دليل وجوب حفظ نفس الغير
غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ وجوب حفظ النفس كسائر التكاليف ، محكومة على المبنى المعروف بل المنصور لأدلّة نفي الحرج والضرر ، فإذا استلزم حفظ حياة مسلم التضرّر أو كان فيه حرج لا يتحمّل عادةً ، لم يجب .
ودعوى أهمّية حفظ النفس المحترمة يدفعها أنّ الأهمّية مرجّحة في مورد التزاحم لا في مورد التعارض أو الجمع العرفي ، فلاحظ .
قطع العضو من الميّت للترقيع
إذا تمهّد ما حقّقناه في ضابطة الحياة والموت يقع الكلام في المسألة التي عقدنا لأجلها البحث هذا ، وهي مسألة أخذ أعضاء الميّت بموت الدماغ لغرض ترقيعها بالأحياء فنقول:
إنّه يمكن الاستدلال ـ بعد البناء على عدم جواز أخذ الأعضاء من الميّت للترقيع كحكم أوّلي ، وسيأتي التعرّض له في المسألة الآتية ـ لجوازه في موارد الموت الدماغي حيث لا يستند التنفّس إلى الشخص ، بوجوه: