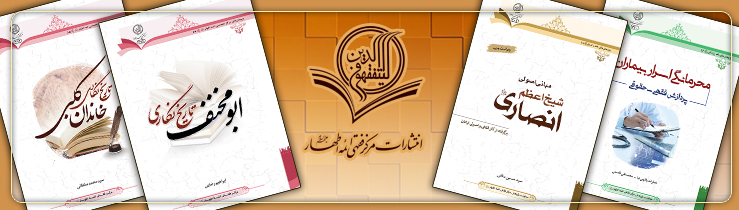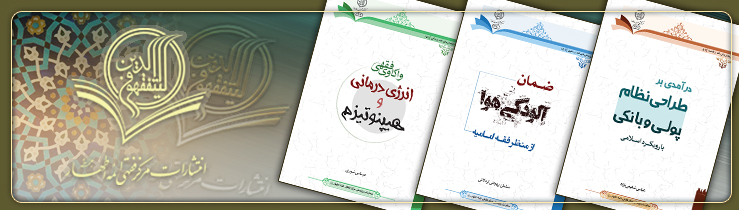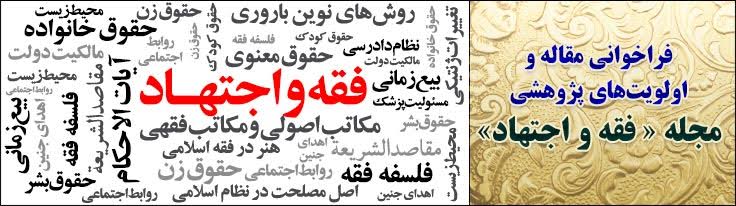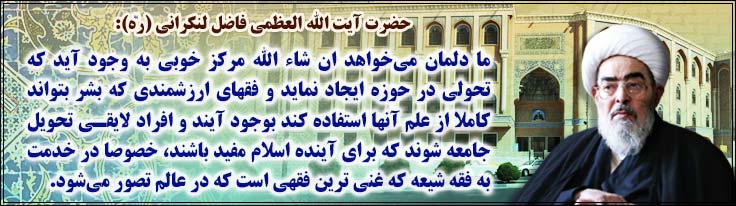ب ـ الولاية على القبض
ذهب المالكيّة إلى أنّه يشترط الحيازة والقبض لتمام الوقف ولزومه . ومعنى الحيازة رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره(1) .
قال ابن رشد : «ومن شرط تمامه القبض والحيازة كالهبة والصدقة ،
فإن لم يقبض عنه ولا خرج عن يده حتّى مات فهو باطل ويكون موروثاً عنه»(2) .
وجاء في تبيين المسالك : «الحوز شرط في كلّ التبرّعات ومنها الوقف . . . ولا تتمّ هبة ولا صدقة ولا حبس إلاّ بالحيازة ، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث»(3) .
وكذا في حاشية الدسوقي(4) والذخيرة(5) وعقد الجواهر الثمينة(6) .
على هذا، إذا وقف للصبي فلأجل أنّ الصبيّ ليس من أهل التصرّف فلا يعتبر قبضه بل يقبض عنه وليّه .
ولذلك قال في القوانين الفقهيّة : «ويقبض الوالد لولده الصغير والوصيّ لمحجوره»(7) .
وفي جواهر الإكليل : «إذا وقف على من هو في حجره من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه ، فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه». وقال أيضاً : «فإن حازه وليّ الصغير وقبل فلا يبطل»(8) .
-
(1) جواهر الإكليل 2 : 206 .
(2) المقدّمات الممهّدات 2 : 419 .
(3) تبيين المسالك 4 : 259 و 260 .
(4) حاشية الدسوقي 4 : 81 .
(5) الذخيرة للقرافي 6 : 318 .
(6) عقد الجواهر الثمينة 3 : 39 .
(7) القوانين الفقهيّة : 388 .
(8) جواهر الإكليل 2 : 206 مع تصرّف يسير .
وقال الحطّاب : «إذا وقف على صغار ولده أو من في حجره، فهو الذي يتولّى حيازة وقفهم والنظر لهم»(1) .
وكذا في التاج والإكليل(2) والشرح الصغير(3) وتبيين المسالك(4) .
وذهب جمهور الحنابلة والشافعيّة إلى أنّه لا يشترط للزوم الوقف وصحّته إخراج الموقوف عن يد الواقف ، فلا يعتبر قبض الموقوف عليه وحيازته .
قال في الإنصاف : «قوله: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين . وهو المذهب، وعليه الجمهور . قال المصنّف وغيره : هذا ظاهر المذهب . واختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الخلاصة والوجيز . وقدّمه في المحرّر والفروع والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق وغيرهم و . . .
قال الزركشي : هو المشهور ، والمختار المعمول به من الروايتين»(5) .
وكذا في مطالب أُولي النّهى(6) ومنتهى الإرادات(7) والحاوي الكبير(8). وروي عن أحمد أنّه يشترط أن يخرجه عن يده(9) .
وأمّا الحنفيّة، ففي هذه المسألة على قولين :
-
(1) مواهب الجليل 7 : 637 .
(2) التاج والإكليل مع المواهب الجليل 7 : 638 .
(3) الشرح الصغير مع بلغة السالك 4 : 15 .
(4) تبيين المسالك 4 : 259 .
(5) الإنصاف 7 : 35 .
(6) مطالب اُولي النّهى 6 : 30 .
(7) منتهى الإرادات 3 : 343 .
(8) الحاوي الكبير 9 : 372 .
(9) الإنصاف 7 : 35 .
الأوّل : عدم اشتراط القبض والتسليم
قال السرخسي : «إن جعل أرضاً له مسجداً لعامّة المسلمين . . . عند أبي يوسف يصير مسجداً إذا أبانه عن ملكه وأذن للناس بالصلاة فيه وإن لم يصلِّ فيه أحد ، كما في الوقف على مذهبه ; لأنّ الوقف يتمّ بفعل الواقف من غير تسليم إلى المتولّي» ـ إلى أن قال : ـ «هذه إزالة ملك لا تتضمّن التمليك فتتمّ بدون القبض كالعتق . . . ولأنّ القبض إنّما يعتبر من المتملّك أو من نائبه ليتأكّد به ملكه . . . والصدقة الموقوفة لا يتملّكها أحد، فلا معنى لاشتراط القبض فيها»(1) .
وبه قال في الهداية(2) ومختصر اختلاف العلماء(3) .
الثاني : اشتراط القبض والتسليم
قال به محمّد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى ومشايخ البخاري .
جاء في المبسوط : «وعلى قول محمّد لا يتمّ إلاّ بالإخراج من يده والتسليم إلى المتولّي ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وحجّته في ذلك أنّ إزالة الملك بطريق التبرّع ، فتمامه بالتسليم كما في الصدقة المنفذة »(4) .
وكذا في البناية(5) ومجمع الأنهر(6) والبحر الرائق(7) وفتح القدير(8) .
-
(1) المبسوط للسرخسي 12 : 34 ـ 36 .
(2) الهداية 3 : 16 و 21 .
(3) مختصر اختلاف العلماء 4 : 157 .
(4) المبسوط للسرخسي 12 : 35 .
(5) البناية 7 : 69 .
(6) مجمع الأنهر 2 : 572 .
(7) البحر الرائق 5 : 323 .
(8) فتح القدير 5 : 419 .
المبحث الخامس : الولاية على قبول الوصيّة(1) للصغير
اختلفت الفقهاء في لزوم القبول للموصى له وعدمه على أقوال .
قال الشيخ : «ينتقل الملك إلى الموصى له بشرطين : بوفاة الموصي وقبول الموصى له ، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول»(2) .
وفي الجواهر : «إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : أنّ القبول تمام السبب الناقل كباقي العقود ، والثاني : كونه شرطاً في الملك كاشفاً ، والثالث : كونه شرطاً في اللزوم ، وقد يحتمل عدم مدخليّته أصلاً في ملك ولا لزوم، وإنّما الردّ مانع ، بل قد يحتمل عدم مانعيّة الردّ أيضاً .
إلاّ أنّ كلام الأصحاب كأنّه متّفق على خلاف الأخيرين ، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم ، وأنّ المعتدّ به القولان الأوّلان، كما أنّ المشهور منهما الثاني الذي قد عرفت كونه أقواهما»(3) .
ولكن اشتراط القبول على القول به مختصّ بالوصيّة التمليكيّة . وأمّا الوصيّة العهديّة فلا تحتاج إلى القبول .
-
(1) الوصيّة في اللغة الإيصال ، مأخوذ من وصّيت الشيء . أوصى الرجل; أي عهد إليه ، وسمّيت وصيّة لاتّصالها بأمر الميّت . لسان العرب 6 : 451 .
وعرّفها المحقّق بأنّها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة. ويفتقر إلى إيجاب وقبول . . . وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له . شرائع الإسلام 2 : 243 .
وفي المجموع بأنّ الوصيّة شرعاً تبرّع بحقّ مضاف ولو تقديراً لما بعدالموت . المجموع شرح المهذّب 16 : 292.
(2) المبسوط للطوسي 4 : 28 .
(3) جواهر الكلام 28 : 252 ـ 253 .
وفي تحرير الوسيلة : « لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول . . . وأمّا الوصيّة التمليكيّة، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصيّة للفقراء والسادة . . . لا يعتبر فيها القبول . وإن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، والظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، فلا يتملّك قهراً . فالوصيّة من الإيقاعات لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض »(1) .
وبه قال في تفصيل الشريعة، إلاّ أنّه قال : « حصول الملكيّة للموصى له يتوقّف على عدم الرّد بحيث يكون الردّ مانعاً; لظهور الإجماع(2)، ولولاه لم يتوقّف عليه أيضاً »(3) .
وبالجملة: بعد ثبوت اعتبار القبول في الوصيّة فالوليّ يتولّى القبول للصبيّ .
. . . قال العلاّمة في التذكرة : «إذا أوصى للحمل صحّت ، وكان القابل للوصيّة أبوه أو جدّه أو من يلي اُموره بعد خروجه حيّاً ، ولو قَبِلَ قبل انفصاله حيّاً ثمّ انفصل حيّاً ففي الاعتداد بذلك القبول إشكال»(4) .
وفي التحرير : «ولو كان فيهم ـ أي الورثة ـ مولّى عليه ، قام وليّه مقامه في القبول والردّ ، وإنّما يفعل ما للمولّى عليه الحظّ فيه ، فلو كان الحظّ في القبول فردّ لم يصحّ ، فكان له القبول بعد ذلك ، ولو كان الحظّ في الردّ فقبل لم يصحّ»(5) .
وقال الشهيد الثاني : «والمتّجه اعتبار القبول في الوصيّة للحمل مطلقاً ، فيقبله
-
(1) تحرير الوسيلة 2 : 90 ، كتاب الوصية مسألة 5 .
(2) غنية النزوع : 306 ، رياض المسائل 9 : 429 .
(3) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 140 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 461 ، الطبعة الحجريّة .
(5) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 333 .
وليّه ابتداءً ووارثه هنا»(1) .
وفي الروضة : «وقيل : يعتبر قبول وليّه»(2) .
والدليل لولاية الوليّ على قبول الوصيّة للصغير عموم ولايته، كما تقدّم في أمثال المقام .
وأمّا قبض الموصى به، فلا يعتبر في صحّة الوصيّة; لعدم الدليل على اعتباره(3) .
وإن كان مقتضى كلام الشيخ أنّ القبض شرط في اللزوم أو الصحّة، حيث قال : «الثالثة : أن يردّها بعد القبول والقبض; فإنّه لا يصحّ الردّ ; لأنّ بالقبول تمّ عليه ملكه، وبالقبض استقرّ ملكه... الرابعة: أن يردّها بعد القبول وقبل القبض; فإنّه يجوز... ـ إلى أن قال : ـ والصحيح أنّ ذلك يصحّ ، لأنّه وإن كان قد ملكه بالقبول لم يستقرّ ملكه عليه ما لم يقبضه»(4) .
ولقد أجاد في الردّ على هذا القول في مفتاح الكرامة، حيث قال : «إنّ إطباق الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين والموت وعدم الردّ في البين يقضي بعدم اعتبار القبض ، مضافاً إلى الأصل المستفاد من عمومات الباب وغيرها . وخصوص الصحيح الذي رواه العبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ؟ قال : اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ، قال : اجهد على أن تقدر له على وليّ ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجدّ فتصدّق بها(5) . إلاّ أنّه مضمرٌ ، لكن رواه
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 236 .
(2) الروضة البهيّة 5 : 25 .
(3) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 657 .
(4) المبسوط للطوسي 4 : 33 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 409 الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح2.
العيّاشي(1) والصدوق(2) مسنداً إلى أبي عبدالله(عليه السلام)، ومثله خبر محمّد بن عمر الباهلي
وغيره(3) . وقد عقد له ولمسألة أُخرى في الوسائل باباً سرد فيه أخباراً كثيرة .
وكان من خالف أو توقّف ، غفل عنها ; إذ ليس لمن ظفر بها أن يعدل عنها مع عدم المعارض لها ، فالمسألة من القطعيّات»(4) .
وقد مضى في الباب الأوّل في البحث عن حقوق الحمل ما يرتبط بالمقام ، فراجع .
وأمّا الولاية على قطع الدعاوي واستيفاء القصاص عن الصغير فسنذكرها في الباب الذي نبحث فيه عن جنايات الصغار والجناية عليهم إن شاء الله .
الولاية على القبول في الوصيّة للصغير عند فقهاء أهل السنّة
لا يشترط عندهم في صحّة الوصيّة ولزومها قبض الموصى به كما في الحاوي الكبير(5) والمبسوط(6). وفصّلوا بين الوصيّة لغير معيّن، كالوصيّة للفقراء والمساكين فقالوا بعدم اشتراط القبول فيها ، وبين الوصيّة لمعيّن، كالوصيّة لرجل مسمّىً أو قوم محصورين، فلابدّ من القبول عن الموصى له(7) .
-
(1) تفسير العياشي 1 : 77 ح171 .
(2) الفقيه 4 : 159 ، ح542 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 409 و 410 الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح3 وغيره .
(4) مفتاح الكرامة 9 : 372 ـ 373 .
(5) الحاوي الكبير 9 : 405 .
(6) المبسوط للسرخسي 28 : 49 .
(7) البيان 8 : 171 ، أسنى المطالب 3 : 43 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 334 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 63 ، الكافي 2 : 270 ، كشّاف القناع 4 : 416 ، مطالب أُولي النهى 6 : 189 ، الإقناع 3 : 51 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 410 ، مواهب الجليل 8 : 517 ، التاج والإكليل 8 : 517 ، المقدّمات والممهّدات لابن رشد 3 : 120 .
وحيث إنّ الصبيّ ليس من أهل التصرّف يتولّى عنه وليّه، ولنذكر شطراً من كلماتهم في هذا المقام .
ففي منهاج الطالبين في مذهب الشافعيّة :
«إن وصّى لغير معيّن كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعيّن اشترط القبول»(1). وكذا في الوجيز(2) .
وفي التهذيب : «ولو أوصى لصبيّ أو مجنون يصحّ ويقبله وليّه»(3) .
وفي نهاية المحتاج : «إن أوصى لمعيّن . . . اشترط القبول منه إن تأهّل... وإلاّ فمن وليّه»(4) . وكذا في حاشية الخرشي(5) .
وقال ابن قدامة في الفقه الحنبلي : «ولا يملك الموصى له الوصيّة إلاّ بالقبول في قول جمهور الفقهاء إذا كانت لمعيّن يمكن القبول منه ; لأنّها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعيّن، فاعتبر قبوله كالهبة والبيع . قال أحمد : الهبة والوصيّة واحد . فأمّا إن كانت لغير معيّن كالفقراء والمساكين ومن لا يملك حصرهم كبني هاشم وتميم، أو على مصلحة كمسجد أو حجّ ، لم يفتقر إلى قبول ولزمت بمجرّد الموت»(6) .
وقال الفقيه المالكي في حاشيته على الشرح الكبير : «وقبول الموصى له البالغ الرشيد المعيّن شرط في وجوب الوصيّة وتنفيذها بعد الموت»(7) .
-
(1) منهاج الطالبين 2 : 364 .
(2) الوجيز 1 : 452 .
(3) التهذيب في فقه الشافعي 5 : 73 .
(4) نهاية المحتاج 6 : 66 .
(5) حاشية الخرشي 8 : 460 .
(6) المغني 6 : 440 ، الشرح الكبير 6 : 442ـ 443 .
(7) الشرح الكبير ، المطبوع في هامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 424 ، الشرح الصغير المطبوع مع بلغة السالك 4 : 318 .
وفي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي : «وله ـ أي الوليّ ـ أن يقبل الهبة والصدقة والوصيّة ; لأنّ ذلك نفع محض فيملكه الوليّ»(1) .
وبالجملة : فهذا قول جمهور الفقهاء، إلاّ أنّه خالف في ذلك بعض الحنابلة، فقالوا بعدم اشتراط القبول .
ففي الإنصاف : «وقال في القواعد الفقهيّة : نصّ الإمام أحمد في مواضع على أنّه لا يعتبر للوصيّة قبول فيملكه قهراً كالميراث ، وهو وجه للأصحاب، حكاه غير واحد ، وذكر الحلواني عن أصحابنا: أنّه يملك الوصيّة بلا قبوله كالميراث»(2) .
-
(1) بدائع الصنائع 4 : 351 .
(2) الإنصاف 7 : 191 .
الفصل الخامس
في الوصية بالولاية
تمهيد
من جملة التصرّفات التي يجوز فيها للوليّ أن يوصي إلى شخص أن يتولّى اُمور الصغار بعد موته ، ويعبّر عنها في كلمات الفقهاء بـ «الوصيّة بالولاية» وهل هذا الحكم مطلق; بمعنى أنّه يجوز للأب الوصيّة بالولاية حتّى مع وجود الجدّ، أو يشترط في صحّتها فقد الجدّ وكذا من طرف الجدّ ؟ وأيضاً هل يصحّ هذا من غير الأب والجدّ، مثل الوصي والحاكم وغيرهما من الأولياء، أم يشترط صدورها من الأب والجدّ فقط، وهكذا هل تصحّ هذه الوصيّة من الاُمّ أيضاً، أم مختصّة بالأب والجدّ ؟ وبالجملة: أيشترط في صحّتها وجود شرائط خاصّة في الوليّ، وما هي هذه الشرائط ، أم لا يشترط فيها شيء ؟
للبحث عن المسائل التي أُشير إليها وغيرها المرتبطة بها ، عقدنا هذا الفصل ، وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : تعريفها وأركانها
أ ـ تعريفها
قال في القواعد : «الوصيّة بالولاية : استنابةٌ بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ; من قضاء ديونه واستيفائها ، وردّ الودائع واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه»(1) . وكذا في الروضة(2) .
ولقد أجاد المحقّق الثاني في شرحه : «بأنّ قوله : والولاية على أولاده . ينبغي أن يُراد بالأولاد ما يعمّ أولاد الأولاد ، ليندرج في الوصيّة بالولاية وصيّة الجدّ بها. ولمّا كانت «من» بياناً لقوله : «الذين له الولاية عليهم» كان في العبارة قصوراً، من حيث إنّه لم يذكر السفهاء ، مع أنّ الولاية ثابتةٌ عليهم للأب والجدّ له إذا كان السفه متّصلاً بما قبل البلوغ ، استصحاباً لما كان واستدامةً للحجر الثابت المستمرّ»(3) .
فنقول : إنّ الوصيّة بالولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والسفهاء ثابتةٌ ظاهراً .
ب ـ أركانها
وهي أربعة : الموصي، والوصيّ، والموصى فيه، والصيغة .
أمّا الموصي، فهو كلّ من له ولايةٌ على مال أو على أطفال أو مجانين أو سفهاء ،
-
(1) قواعد الأحكام 2: 562.
(2) الروضة البهيّة 5 : 66 .
(3) جامع المقاصد 11 : 258 .
شرعاً كالأب والجدّ له .
ويشترط في الموصي بالولاية أن تكون ولايته على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرع ، لامتناع الاستنابة وإثبات الولاية ممّن لا ولاية له .
ببيان آخر : لابدّ أن تكون ولايته على الأطفال ابتداءً من الشارع لا بالتفويض من الآخر ; بأن يكون أباً أو جدّاً .
قال في التذكرة : « الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ من الأب أو الجدّ وإن علا ، ولا ولاية لغيرهم من أخ ، أو عمّ ، أو خال ، أو جدٍّ لاُمّ ; لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم ، فكيف يثبت لهم ولاية ; فإنّ الوصيّ نائبٌ عن(1) الموصي ، فإذا كان الموصي لا ولاية له ، فالموصى إليه أولى بذلك ، وأمّا الاُمّ فلا ولاية لها عندنا»(2) . وكذا في غيرها »(3) .
وأمّا الوصيّ، فهو واضحٌ لا يحتاج إلى بيان.
وأمّا الموصى فيه، فهو متعلّق الوصية بالولاية من التصرّف فيما كان للموصي التصرّف فيه ، ومنه الولاية على أولاده والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم من المصلحة والغبطة .
وأمّا الوصيّة بالولاية على تزويج الصغار، فاختلف فيها الأصحاب رضوان الله عليهم ، وقد تقدّم التحقيق فيها في باب الولاية على النكاح ، فراجع .
وأمّا الصيغة; فلابدّ فيها من إيجاب وقبول ، والإيجاب أن يقول الموصي : أوصيتُ إليك ، أو فوّضت إليك اُمور أولادي ، أو أنت وصيّي في التصرّف في أموال أطفالي والقيام بمصالحهم .
-
(1) في المصدر: على الموصي .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة .
(3) قواعد الأحكام 2 : 563 ، إرشاد الأذهان 1 : 457 ، جامع المقاصد 11 : 264 .
وأمّا القبول، فلا يشترط أن يكون بالنطق ، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه كان قبولاً ، ولا يشترط وقوعه في حياة الموصي كما في التذكرة(1) .
ويرى جمهور الفقهاء من أهل السنّة أنّ هذه الاُمور الأربعة تُعدُّ أركاناً كلّها(2) ، إلاّ أنّ الأحناف يقصرون الركن في الصيغة، وما عداه لوازم لها(3) .
إيضاح
لابدّ في الإيجاب من تفصيل متعلّق الوصيّة وبيان عمومها أو خصوصها ، كأن يقول الموصي لشخص : أنت وليٌّ وقيّمٌ على أولادي القاصرين في جميع الشؤون المتعلّقة بهم وجميع التصرّفات في اُمورهم .
فهذه الوصيّة عامّة ومطلقة في المسائل التي يتصرّف فيها عادةً لرعاية أُمور الصبيّ ; من حفظ نفوسهم وتربيتهم ، وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم ، واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات ، جرياً على مقتضى عموم الوصيّة .
وإذا قيّد الولاية لجهة دون جهة; بأن يقول له : أنت وليٌّ على ولدي في إدارة أمواله ، أو في إدارة شؤونه التربويّة، أو إدارة شؤونه الصحيّة أو غيرها ، فإنّ على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيرها من الجهات .
ولو جعل له النظر والتصرّف في المال الموجود للطفل ، لم يكن له النظر
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 508، الطبعة الحجريّة .
(2) الوجيز 1 : 461 ، مغني المحتاج 3 : 74 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 : 422 ، الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك 4 : 316 ، كشّاف القناع 4 : 418 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 427 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 268 .
(3) ردّ المحتار 6 : 650 .
في متجدّدات أمواله .
ولو أطلق له النظر في ماله، دخل فيه المتجدّد .
قال في القواعد : «ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل : لتتصرّف في أموال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرّد الحفظ والتصرّف»(1) .
وفي التذكرة : «لو قال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرّفات، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم والتصرّف»(2) .
وقال بعض الأعلام : « لو أطلق وقال : فلان قيّم على أولادي . ولم يعيّن جهة خاصة وتصرّفاً مخصوصاً، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار . . . منها: إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين ، ومنها: إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس ; لأنّه ليس مجرّد تكليف ، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة، أو الكُلّي في المعيّن، أو غيرهما »(3) .
-
(1) قواعد الأحكام 2 : 562 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 508، الطبعة الحجريّة .
(3) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 197 .
المبحث الثاني :
ولاية الأب والجدّ في الوصيّة بأُمور أولادهم
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يصحّ للأب وكذا الجدّ أن يوصي إلى شخص بأن يتولّى اُمور أولاده الصغار .
قال الشيخ في النهاية : « إذا أمر الموصي الوصيَّ أن يتصرّف في تركته لورثته ويتّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزاً، وحلال له نصف الربح »(1) .
وفي المبسوط: «إن كان الأولاد صغاراً; فإنّه يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم; لأنّه يملك التولية في حال الحياة ، وكذلك له أن يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته»(2).
وبه قال القاضي ابن البرّاج(3) .
وفي الشرائع : « لاتصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال ، إلاّ من الأب أو الجدّ للأب خاصّة ، ولا ولاية للاُمّ ، ولا تصحّ منها الوصيّة عليهم ، ولو أوصت لهم بمال ونَصَبَتْ وصيّاً ، صحّ تصرّفه في ثلث تركتها وفي إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض على الأولاد »(4) .
وبه قال العلاّمة(5) والشهيدان(6) .
-
(1) النهاية للطوسي : 608 .
(2) المبسوط للطوسي 4 : 53 .
(3) المهذّب لابن البرّاج 2 : 118 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 245 .
(5) قواعد الأحكام 2 : 563 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 337ـ 381 ، تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة ، إرشاد الأذهان 1 : 457 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 321 ، اللمعة الدمشقيّة : 106 ، الروضة البهيّة 5 : 66 .
ففي المسالك : «لمّا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل ; إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره بغير إذنه . . . وجب الاقتصار في نصب الوليّ على الأطفال على محلّ النصّ أو الوفاق ، وهو نصب الأب والجدّ له»(1) .
واختاره أيضاً المحقّق الثاني(2). وكذا في الرياض(3) والجواهر(4) والعروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء(5) .
وفي تحرير الوسيلة : « يجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب ، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتى الاُمّ »(6).
وكذا في تفصيل الشريعة، وعللّه بقوله : « وذلك لأنّه على تقدير وجود الآخر تكون الولاية الشرعيّة له ، ولا تصل النوبة إلى الحاكم فضلا عن غيره »(7)وغيرها(8) .
وبالجملة : أنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة وسائر الأدلّة أنّ للأب والجدّ التصرّف في جميع شؤون الأطفال الصالحة لهم ، سواء كانت تلك الاُمور صالحة لهم في حال حياة الأب والجدّ أو في حال مماتهما .
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 144 .
(2) جامع المقاصد 11 : 264 .
(3) رياض المسائل 6 : 299 .
(4) جواهر الكلام 28 : 277 .
(5) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 .
(6) تحرير الوسيلة 2 : 101 ، كتاب الوصية مسألة 54 .
(7) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 195 .
(8) الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 61 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 427 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 590 ، مهذّب الأحكام 22 : 172 .
ولا شكّ في أنّ نصب القيّم الثقة لإصلاح اُمورهم وتدبير شؤونهم بعد موتهما من التصرّفات الصالحة لهم ، فلذلك يصحّ للأب والجدّ من طرف الأب الوصيّة بذلك وتكون نافذة(1) .
أدلّة جواز الوصيّة بالولاية
ويمكن الاستدلال لجواز الوصيّة بالولاية باُمور :
الأوّل : الإجماع، قال في الجواهر : « ولا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلاّ من الأب أو من الجدّ للأب خاصّةً ، الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجه لهما الوصيّة بها نصّاً وفتوىً، بل إجماعاً بقسميه »(2) .
وحكاه عنه في المستمسك(3). وادّعاه في المهذّب(4). ومباني المنهاج(5) .
وفي المسالك : أنّه محلّ النصّ أو الوفاق(6) .
وقال السيّد الخوئي : «هذا الحكم متسالم عليه ، ولم ينسب الخلاف إلى أحد»(7) .
الثاني : السيرة، قال السيّد الفقيه السبزواري : «هذا هو الذي يسمّى بـ «القيّم» عند المتشرّعة ، وتدلّ عليه السيرة المستمرّة قديماً وحديثاً»(8) .
-
(1) القواعد الفقهيّة للبجنوردي 6 : 253 .
(2) جواهر الكلام 28 : 276 ـ 277 .
(3) مستمسك العروة الوثقى 14 : 590 .
(4) مهذّب الأحكام 22 : 172 .
(5) مباني المنهاج 9 : 349 .
(6) مسالك الأفهام 6 : 144 .
(7) مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح 2 : 427 ـ 428 .
(8) مهذّب الأحكام 22 : 172 .
وفي مباني منهاج الصالحين : «إنّ السيرة جارية على الوصيّة على اليتيم وجعل القيّم له بلا إنكار من المتشرّعة ، وهذا آية الجواز»(1) .
الثالث : النصوص الكثيرة وهي العمدة :
1 ـ موثّقة محمّد بن مسلم، وقد يعبّر عنها بالصحيحة(2)ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : «لا بأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيٌّ»(3) .
وهذا الحديث أوضح تعبير في الولاية الشرعيّة بالنسبة إلى الصغير من جهة وصيّة الأب ; لأنّ مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة ، وشموله لكلّ ما كان له التصرّف فيه في حياته .
قال الإمام الخميني(قدس سره) : « دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير; سواء كان في حال حياته; بأن يوكّل من يعمل ذلك ; أو كان بعد مماته بالإيصاء والإجازة ، فيظهر منها أنّ له التصرّف . . . وأنّه وليّ الطفل، وأنّ تصرّفاته نافذة ; سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل
-
(1) مباني منهاج الصالحين 9 : 350 .
(2) لأنّ المراد من أحمد بن محمّد هو العاصمي الكوفي، وعليّ بن الحسن هو ابن فضّال، والحسن بن علي هو الحسن بن علي بن يوسف ، كما قال السيّد البروجردي في الموسوعة الرجاليّة بترتيب أسانيد الكافي 1 : 149 .
وأمّا المثنّى بن الوليد، فقال الكشّي : قال محمد بن مسعود : قال علي بن الحسن : سلاّم، والمثنّى بن الوليد والمثنّى عبد السلام كلّهم حنّاطون ، كوفيّون ، لا بأس بهم ، اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي» : 338 الرقم 623 ، فلا وجه لما استشكل في مباني المنهاج من أنّ الرواية ضعيفة بحسن بن عليّ ، مباني منهاج الصالحين 9 : 349 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح1 .
إليه بعد مماته »(1) .
2 ـ رواية خالد بن بكير ـ التي رواها أيضاً المشايخ الثلاثة ـ قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يابني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عَلَيَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن .
فدخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى؟ فقال : «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين الله ـ عزّوجلّـ فليس عليك ضمان»(2) .
فهذه الرواية من جهة الدلالة صريحة في الوصيّة على الولاية في مال
اليتيم .
وأمّا سنداً، فقد استشكل عليه من جهة أنّ خالد بن بكير مجهول الحال ، ولكنّ الأظهر أنّ في السند ابن أبي عمير وهو ممّن اُجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، قال الشيخ في العدّة : «محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عُرِفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون
إلاّ ممّن يوثق به»(3) وأيضاً قصور سندها لو فرض كونها مجهولة مجبور بالشهرة
العظيمة .
3 ـ صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن اليتيمة
-
(1) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 436 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(3) عدّة الاُصول 1 : 386 ـ 387 .
متى يُدفع إليها مالها؟ قال : «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تُضيّع» ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها»(1) . وكذا مرسلة محمّد بن عيسى(2) ، وخبر سعد بن إسماعيل(3) .
وقال الشهيد(رحمه الله)(4): «وفي مكاتبة الصفّار للعسكري(عليه السلام)(5) دلالةٌ ما على الجواز» .
فرع
قال في تحرير الوسيلة : « يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك ، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال »(6).
وكذا في تفصيل الشريعة، وزاد: «والأنسب التعبير بالقيّم مكان الوصيّ»(7) .
آراء فقهاء أهل السنّة في الوصيّة بالولاية
أ ـ الشافعيّة
يشترط عندهم في الوصيّة بالولاية على الأطفال أن تكون الولاية من جهة الشرع .
ففي المهذّب للشيرازي : «من تثبت له الولاية في مال ولده ولم يكن له وليّ
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 432 الباب 45 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(2) نفس المصدر 13 : 435 الباب 46 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(3) نفس المصدر 13 : 436 الباب 47 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(4) الدروس الشرعيّة 2 : 322 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 438 الباب 50 من كتاب الوصايا ح1 .
(6) تحرير الوسيلة 2 : 102 ، كتاب الوصية مسألة 57 .
(7) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 198 .
بعده جاز له أن يوصي إلى من ينظر في ماله»(1) .
وكذا في المجموع(2) والبيان(3) .
وقال الماوردي : «إن كانت الوصيّة بالولاية على أطفال، اعتبر في الموصى بها ستّة شروط ، لا تصحّ الوصيّة منه إلاّ بها . . .
الخامس : أن يكون ـ الموصي ـ ممّن يلي على الطفل في حياته بنفسه ; لأنّه يقيم الوصيّ مقام نفسه ، فلم تصحّ إلاّ ممّن قد استحقّ الولاية بنفسه ، وذلك في الوالدين دون غيرهم من الإخوة والأعمام . . . وإذا كان هكذا فالذي يستحقّ الولاية في حياته ويوصي بها عند وفاته هو الأب وآبائه»(4) .
وقال الرافعي : «أمّا ـ إن كانت الوصاية ـ في اُمور الأطفال، فيشترط مع ذلك أن يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداء من الشرع، لا بتفويض وشرط»(5) .
وبه قال النووي(6) والخطيب الشربيني(7) .
ب ـ الحنفيّة
جاء في حاشية ردّ المحتار : «الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ، ثمّ وصيّ وصيّه ولو بعد ، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ، ثمّ وصيّه ، ثمّ وصيّ وصيّه ، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه ، ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابناً صغيراً ـ فوصيّ الجدّ وصيّ لهم ـ يصحّ بيعه عليه، كما
-
(1) المهذّب للشيرازي 1 : 449 .
(2) المجموع شرح المهذّب 16 : 298 .
(3) البيان 8 : 149 .
(4) الحاوي الكبير 10 : 190 .
(5) العزيز شرح الوجيز 7 : 272 .
(6) روضة الطالبين 5 : 374 .
(7) مغني المحتاج 3 : 76 .
صحّ على أبيه في غير العقار»(1) ، وكذا في تبيين الحقائق(2) .
وقال السمرقندي : «ثمّ وصيّ الأب أولى من الجدّ ، فإن لم يكن فالجدّ ، ثمّ وصيّ الجد ، فإن لم يكن فالقاضي ووصيّ القاضي»(3) .
وفي المبسوط : «إذا أوصى إلى رجل بماله فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا»(4) .
وكذا في مختصر اختلاف العلماء(5) .
ج ـ الحنابلة
تصحّ عندهم الوصيّة بالولاية على الأطفال للأب.
ففي كشّاف القناع : «فأمّا الوصيّة بالنظر إلى ورثته في أموالهم ، فإن كان الموصي ذا ولاية عليهم في المال كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يعلم رشده منهم ، فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرّف لهم فيها بما لهم الحظّ فيه ، لقيام وصيّه مقامه»(6) .
ولا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إلاّ للأب ووصيّه ، وإذا
سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان ولا ولاية لغيرهم ، ومن تثبت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه ، كما في الكافي في فقه أحمد(7) .
-
(1) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 .
(2) تبيين الحقائق 6 : 213 .
(3) تحفة الفقهاء 3 : 220 .
(4) المبسوط للسرخسي 28 : 26 .
(5) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 .
(6) كشّاف القناع 4 : 484 .
(7) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 و267 .
وكذا في المقنع(1) والمبدع(2) والإقناع(3) والفروع(4) ومنتهى الإرادات(5)والإنصاف(6) .
د ـ المالكيّة
جاء في حاشية الخرشي : إنّ الوصيّة على الأولاد وإقامة من ينظر في حالهم مختصّ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد والإخوة . . . لكن بشرط أن يكون الأب رشيداً . أمّا الأب المحجور عليه; فإنّه لا يوصي على ولده ;
إذ لا نظر له عليه ، وكذا لو بلغ الصبيّ رشيداً ثمّ حصل له السفه، فليس للأب الإيصاء عليه وإنّما الناظر له هو الحاكم(7) . وكذا في المدوّنة الكبرى(8) وبلغة السالك(9) وحاشية الدسوقي(10) ومواهب الجليل(11) وغيرها(12) .
إيضاح
قال في تحرير الوسيلة : « يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة
-
(1) المقنع : 179 .
(2) المبدع 6 : 106 .
(3) الإقناع 3 : 80 .
(4) الفروع 4 : 539 .
(5) منتهى الإرادات 3: 497.
(6) الإنصاف 7 : 280 .
(7) حاشية الخرشي 8 : 503 .
(8) المدوّنة الكبرى 6 : 16 ـ 17 .
(9) بلغة السالك على الشرح الصغير 4 : 332 .
(10) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 : 452.
(11) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 8 : 555 .
(12) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .
ليس ببعيد »(1).
وأوضحه في تفصيل الشريعة بقوله : « لأنّ مرجع الأوّل ـ أي اعتبار ما اشترط في الوصيّ على المال ـ في صورة كون النصب من قبل الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصيّة ; لأنّ القيمومة هي الوصاية على الأطفال في مقابل الوصيّ على المال، فلا معنى لاحتمال كونه أهون منه ـ إلى أن قال ـ : ولعلّ الوجه في عدم اشتراط العدالة أنّ اعتبار العدالة التي هي مرتبة تالية من العصمة في الوصيّ والقيّم يوجب الوقوع في الحرج الشديد ، وعدم تحقق الوصيّ والقيّم في كثير من الموارد ; لقلّة من كان واجداً لصفة العدالة، وكثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيّم ، فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العدالة ... ولذا نفى البعد عن الاكتفاء بالوثاقة في الوصيّ والأمانة ووجود المصلحة في القيّم . . . ، ويؤيّده أنّه ربما لا يكون العادل حاضراً بقبول الوصاية أو القيمومة »(2). وسيأتي في هذا الفرع زيادة توضيح في المبحث العاشر من هذا الفصل .
-
(1) تحرير الوسيلة 2 : 101 ، كتاب الوصية مسألة 55 .
(2) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 196 .
المبحث الثالث : ولاية الوصيّ في المقام
من لم تكن ولايته ثابتة بأصل الشرع(1) كوصيّ الأب أو الجدّ ، هل يجوز إذا حضرته الوفاة أن يوصي إلى غيره بالولاية على الأطفال وأموالهم أم لا؟
يتصوّر في المسألة ثلاث صور :
الاُولى : لو أذِن الموصي الأوّل ـ الأب أو الجدّ ـ للوصيّ أن يوصي إلى غيره أو أمره بذلك ، فتصحّ هذه الصورة بلا خلاف، بل إجماعاً كما في الشرائع(2) والتحرير(3)والجواهر(4) والحدائق(5) وغاية المراد(6) والرياض(7)، وادّعاه أيضاً الشيخ الأعظم(8) .
أدلّة الصورة الاُولى
ويمكن أن يستدلّ لحكم الصورة الأولى بوجوه :
الأوّل : الإجماع كما تقدّم
الثاني : ما ورد عنهم (عليهم السلام) في باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها وعدم جواز تبديلها :
-
(1) كالأب والجدّ; فإنّ ولايتهما في جميع الاُمور ثابتةٌ بأصل الشرع ، بخلاف الوصيّ; فإنّه نائب ومفوّض إليه القيام بالاُمور بحسب الاستنابة والتفويض. م ج ف.
(2) شرائع الإسلام 2: 257.
(3) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 382 .
(4) جواهر الكلام 28 : 427 .
(5) الحدائق الناضرة 22 : 587 .
(6) غاية المراد 2 : 503 .
(7) رياض المسائل 6 : 290 .
(8) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 131 .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : «أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، إنّ الله ـ عزّوجل ـ يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)(1) »(2) .
ووجه الاستدلال بالصحيحة: أنّ الإمام(عليه السلام) علّل إنفاذ الوصيّة وعدم جواز تغييرها بقول الله عزّوجلّ ، ومقتضى عموم هذه العلّة أنّ الوصيّ لو لم يوصِ بعد موته إلى الغير ، وقد أمره الموصي بذلك ، فقد بدّل الوصيّة فإنّما إثمه عليه(3) .
ومنها : معتبرة عليّ بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر(عليه السلام) إلى جعفر وموسى : «وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاةٌ لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكُما ، وبَرٌّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ; لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه في الوصيّة : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)»(4) .
ألا ترى أنّ الإمام(عليه السلام) حذّرهما من أن يُبدِّلا وصيّة أبواهما ، وأن يُغيّرا من حالها ، واستشهد بقول الله عزّوجلّ ، وهذه العلّة موجودة في مسألتنا هنا .
ومنها : حسنة عليّ بن يقطين ـ التي رواها أيضاً المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّاً؟ فقال : «يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصبيّ ، فإذا بلغ الصبيّ
-
(1) سورة البقرة 2 : 181 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 411 الباب 32 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(3) هذا البيان يدلّ على وجوب إيصاء الوصي، مع أنّ الرواية إنّما هي دالّة على الوصية بالمال فقط. مجف.
(4) وسائل الشيعه 13 : 412 الباب 32 من كتاب الوصايا ، ح2 .
فليس له أن لايرضى إلاّ ماكان من تبديل أو تغيير; فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»(1) .
فإنّها أيضاً تدلّ على عدم جواز تبديل الوصيّة وتغييرها عمّا أوصى به الميّت .
ولعلّ يشعر بذلك إطلاق نصوص وردت في باب جواز الوصيّة للوارث(2) ; فإنّ إطلاقها يشمل وصيّة الأب أو الجدّ للوصيّ أن يوصي إلى غيره حين الوفاة .
إلاّ أنّ الظاهر ورود هذه الأحاديث لبيان حكم جواز الوصيّة بالمال للوارث ، فتكون هذه النصوص بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصيّة الوصيّ إلى الغير أجنبيّة.
ومنها: مكاتبة الصفّار الآتية فحوىً أو منطوقاً على ما فهمه جماعة(3) .
عدم جواز الوصيّة بالولاية:
الصورة الثانية : أنّه إذا نهى الموصي الوصيَّ ومنعه أن يوصي إلى الغير بالولاية على أولاده ، فالمشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً ـ كما ادّعاه في غاية المراد(4) والرياض(5) ـ عدم صحّة الوصيّة .
قال المفيد(رحمه الله) : «وليس للوصيّ أن يوصي إلى غيره إلاّ أن يشترط له ذلك الموصي ، فإن لم يشترط له ذلك لم يكن الإيصاء (الإمضاء خ ل) في الوصيّة ،
فإن مات كان الناظر في اُمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصيّة على حسب ما كان يجب
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 439 الباب 50 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(2) نفس المصدر 13 : 373 الباب 15 من كتاب الوصايا .
(3) نفس المصدر 13 : 438 الباب 70 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(4) غاية المراد 2 : 503 .
(5) رياض المسائل 6 : 290 .
على الوصيّ أن ينفذها ، وليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان
العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الأبواب ـ كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولّوا ما تولاّه السلطان ، فإن لم يتمكّنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه»(1) . وتبعه أبو الصلاح(2) وابن إدريس(3) واعتمد عليه العلاّمة(4) .
وفي غاية المراد : «الموصي إمّا أن يمنع الوصيّ من الإيصاء، فلا يجوز إجماعاً، أو يأمره به، فيجوز إجماعاً»(5) .
وبه قال سلاّر(6) وابنا زهرة(7) وحمزة(8) والفاضلان(9) والشهيدان(10) . وكذا في المهذّب البارع(11) وجامع المقاصد(12) والحدائق(13) والجواهر(14) ومستمسك العروة(15) وغيرها(16) .
-
(1) المقنعة : 675 ـ 676 .
(2) الكافي في الفقه : 366 .
(3) السرائر 3 : 185 و 191 ـ 192 .
(4) مختلف الشيعة 6 : 354 .
(5) غاية المراد 2 : 503 .
(6) المراسم العلويّة : 207 .
(7) غنية النزوع : 306 .
(8) الوسيلة : 373 .
(9) شرائع الإسلام 2 : 257 ، المختصر النافع : 191 ، تذكرة الفقهاء 2 : 509، الطبعة الحجريّة ، مختلف الشيعة 6 : 354 ، إرشاد الأذهان 1 : 464 ، قواعد الأحكام 2 : 563 .
(10) الدروس الشرعيّة 2 : 321 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الروضة البهية 5 : 66 .
(11) المهذّب البارع 3 : 121 .
(12) جامع المقاصد 11 : 265 .
(13) الحدائق الناضرة 22 : 587 .
(14) جواهر الكلام 28 : 427 .
(15) مستمسك العروة الوثقى 14 : 592 .
(16) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني 2 : 773 .
ويمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم أوّلاً: بالإجماع كما تقدّم .
وثانياً : بأنّ ولاية الوصيّ تابعة لاختيار الموصي ، والمفروض أنّه نهاه عنها .
وثالثاً : بأنّ الأصل عدم جواز تسليط الغير على الأطفال وأموالهم إلاّ ما خرج بالدليل ، والمفروض عدم وجود دليل في المقام .
إطلاق الوصيّة
الصورة الثالثة: أن يطلق الموصي الوصيّة ; بأن لم يأذن للوصيّ أن يوصي إلى غيره بعد موته ولم يمنعه بل سكت عن ذلك ، فهل يجوز للوصيّ في هذا الفرض أن يوصي بالولاية على الأطفال أم لا؟ قولان :
القول الأوّل ـ وهو الحقّ ـ : ما هو المشهور ، وعليه أكثر أصحابنا المتأخّرين بل عامّتهم: أنّه لا يجوز ذلك .
قال المفيد(رحمه الله) : «وليس للوصيّ أن يوصي إلى غيره إلاّ أن يشترط له
ذلك الموصي ، فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (الإمضاء خ ل) في الوصيّة»(1) .
وتبعه أبو الصلاح(2) وابن إدريس(3) واختاره الفاضلان(4) والمحقّق والشهيد الثانيان(5) والشيخ الأعظم(6) .
-
(1) المقنعة : 675 .
(2) الكافي في الفقه : 235 و 366 .
(3) السرائر 3 : 185 و191 ـ 192 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 257 ، المختصر النافع : 191 ، قواعد الأحكام 2 : 563 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 382 ، مختلف الشيعة 6 : 354 ، إرشاد الأذهان 1 : 464 ، تذكرة الفقهاء 2 : 509، الطبعة الحجريّة .
(5) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 264 ، الروضة البهيّة 5 : 66 .
(6) الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 131 .
وكذا في الحدائق(1) والرياض(2) والعروة(3) والمستمسك(4) .
ويمكن الاستدلال لهذا القول باُمور :
الأوّل : عدم دليل الشرعي لولاية الوصيّ على الأطفال بعد الموت ، فكيف يصحّ له جعلها لغيره ؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك كما في الجواهر(5) والمستمسك(6) .
الثاني : المتبادر من الاستنابة في التصرّف ، وهو تصرّف الوصي بنفسه . أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلادليل عليه(7) .
الثالث : الاقتصار في التصرّف في مال الغير ـ الممنوع منه ـ على مورد الإذن كما في الرياض(8) .
وفي المختلف : « لنا : الأصل سقوط ولايته بعد موته ، وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال .
ولأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي ، وهو مقصور عليه ، إذ التقدير ذلك ، فالتخطّي مناف لمقتضى الوصيّة »(9) . وكذا في غاية المراد(10) .
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 588 .
(2) رياض المسائل 6 : 291 .
(3) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 .
(4) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
(5) جواهر الكلام 28 : 427 .
(6) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
(7) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الحدائق الناضرة 22 : 588 .
(8) رياض المسائل 6 : 291 .
(9) مختلف الشيعة 6 : 354 .
(10) غاية المراد 2 : 504 .
جواز الوصيّة بالولاية
القول الثاني : أنّه يجوز للوصيّ أن يوصي إلى الغير بالولاية على الأطفال والنظر في أموالهم وإن لم يأذن له الموصي .
اختاره الشيخ في النهاية(1) والخلاف(2) وتبعه ابن البرّاج(3)، وبه قال أيضاً ابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف(4) .
واستدلّ لهذا القول بوجوه :
الأوّل : أنّ الموصي لمّا أقام الوصيّ مقام نفسه(5) فيثبت للوصيّ من الولاية ماثبت له ، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت .
الثاني : أنّ الاستنابة من جملة التصرّفات التي يملكها حيّاً بالعموم كما يملكها بالخصوص ، فكذا الاستنابة بعد الموت(6) .
واُجيب عنه بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة ممّا يملكها الوصيّ ، وهل هو إلاّ عين المتنازع فيه ، فيكون مصادرةً ، فإنّ رضا الموصي بتولية الوصيّ مباشرةً لا يقتضي رضاه بفعل غيره ; لاختلاف الأنظار والأغراض في ذلك ، ولأنّه لا يتبادر من إطلاق الوصيّة إلاّ تصرّف الوصيّ بنفسه ، وأنّ الموصي لم يقم الوصي مقام نفسه مطلقاً حتّى في نصب وليّ بعده على الطفل ، بل أقامه في التصدّي لأفعال الطفل مباشرةً، من دون أن يكون له حقّ نصب وليّ بعده ، وإنّما يحمل اللفظ عند إطلاقه
-
(1) النهاية للطوسي : 607 .
(2) الخلاف 4 : 162 .
(3) المهذّب 2 : 117 .
(4) مختلف الشيعة 6 : 354 .
(5) نعم إنّه أقام مقام الموصي بنصب الوصيّ، فدائرتها إنّما هي محدودة بما حدّده الموصي. وبالجملة: أنّ الوصاية كالوكالة، فكما أنّه ليس للوكيل توكيل الغير وإن أقام مقام الموكّل، فكذلك الوصيّ. م. ج. ف.
(6) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الروضة البهيّة 5 : 66 ، جواهر الكلام 28 : 427 .
على المتبادر منه ، وبموته يسقط التصرّف بالمباشرة ، وتفويض التصرّف إلى غيره يحتاج إلى دليل(1) .
وقال الشهيد في غاية المراد في بيان الاستدلال للقول الثاني: بأنّه «يجوز للوصيّ أن يوكّل غيره في التصرّف في أموال الطفل وشؤونه، فكذا الإيصاء :
ولأنّ الوصيّ ملك ما ملكه الجدّ من التصرّف ، فكما جاز للجدّ الإيصاء فكذا له .
وأجاب بأنّا لا نسلّم أنّه ملك ما ملكه الجدّ ، سلّمنا ، لكن ملكه في الحياة فلِمَ قلتم ببقائه مع انقطاعه بالوفاة»(2) .
الثالث : الاستدلال بما رواه الصدوق والشيخ(رحمهما الله) في الصحيح ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد(عليه السلام) أنّه كتب إليه : رجل كان وصيّ رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب(عليه السلام) : «يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء الله»(3) .
وتقريب الاستدلال بها بأن يُقال : الظاهر أنّ المراد بالحقّ هنا حقّ الإيمان(4) ، فكأنّه قال : يلزمه إن كان مؤمناً وفاءً لحقّه عليه بسبب الإيمان ; فإنّه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه ، ومن أهمّها إنفاذ وصيّته(5) .
جاء في الدروس : «في مكاتبة الصفّار للعسكري(عليه السلام) دلالة ما على الجواز»(6) .
-
(1) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 264 ، الروضة البهيّة 5 : 66 ، الحدائق الناضرة 22 : 588 ، رياض المسائل 6 : 292 .
(2) غاية المراد 2 : 504 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 460 الباب 70 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(4) وهذا التفسير مكابرة جدّاً. م ج ف
(5) مختلف الشيعة 6 : 354 ، مسالك الأفهام 6 : 264 ، جامع المقاصد 11 : 265 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 321 .
وفي الجواهر : «أو أنّ المراد ، يلزم الوصيّ الثاني أن ينفذ وصيّة الموصي الأوّل بسبب حقّه الذي على الوصيّ الثاني ; لأنّه كان له ـ أي للأوّل عليه ـ أي على الوصيّ الثاني ـ حقّ من حيث الوصيّة ، فيجب على الثاني إنفاذ كلّ حقّ على الأوّل . فينبغي قراءة(1) أن بفتح الهمزة حتّى يكون منصوباً بنزع الخافض على الوجه الذي ذكرناه»(2) .
ويرد على الاستدلال بها : أنّه يحتمل حمل الحقّ فيها على حقّ الوصيّة إلى وصيّ الأوّل، كما في المختلف(3) وجامع المقاصد(4) والمسالك(5) وغيرها(6) .
بمعنى أنّ الوصيّة تلزم الوصي الثاني بحقّ الأوّل(7) ، إن كان له أي للأوّل قبله ، يعني قبل الوصيّ الأوّل حقٌّ ; بأن يكونَ قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حقّ الوصيّة ، فإذا أوصى بها لزمت الثاني ، وهذا الاحتمال إن لم يكن أرجح فلا أقلّ يكون مساوياً ، ومع هذا التردّد في المراد وتعدّد الاحتمال تكون الرواية في غاية الإجمال ، يُرَدُّ علمها إلى أهلها ، وبه يسقط الاستدلال بها في هذا المجال .
بل في الرياض : أنّ الذي يظهر منها ـ بعد تعمّق النظر فيها ـ كون المراد
-
(1) في المصدر قرءتها، والأصحّ ما أثبتناه.
(2) جواهر الكلام 28 : 425 .
(3) مختلف الشيعة 6 : 353 .
(4) جامع المقاصد 11 : 265 .
(5) مسالك الأفهام 6 : 264 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 321 ، غاية المراد 2 : 504 ، الحدائق الناضرة 22 : 588 ، جواهر الكلام 28 : 428 .
(7) وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية، فكأنّه قال: يلزم الوصيّ الثاني بحقّ الوصيّ الأوّل إن كان للأوّل قبل الإيصاء حقّ، وهذا الشرط بمعنى أنّ الوصيّ الأوّل كان مأذوناً من الموصي الأوّل بالنسبة إلى الإيصاء إلى الثاني فافهم، وبناءً على ذلك يكون أصل الجواز ـ أي جواز الإيصاء مع إذن الموصي ـ مفروغاً عنه، وإنّما كان السؤال عن اللزوم وعدمه، وعلى هذا تكون الرواية ظاهرة الدلالة ولا إجمال فيها. م ج ف.
بالسؤال أنّ الوصيّ أوصى إلى الغير فيما يتعلّق به وجعله وصيّاً لنفسه ، فهل تدخل في هذه الوصيّة وصيّة الموصي الأوّل ، فيلزم الوصي الثاني العمل بها أيضاً، أم لا؟
فكتب(عليه السلام) الجواب بما مضى ، فلا وجه للاستدلال بها أيضاً ; لكونها على هذا التقدير مجملة ، ومقتضاها حينئذ أنّه إن كان للموصي الأوّل قبله ـ أي الموصي الثاني ـ حقّ من جهة وصيّته إليه بالإيصاء لزمه الوفاء به، وإلاّ فلا ، ويكون المراد بالحقّ حقّ التوصية إلى الوصيّ الثاني ; بأن صرّح له بالوصيّة فيرجع حاصل الجواب إلى أنّ وصيّة الأوّل لا تدخل في إطلاق وصيّة الموصي الثاني إلاّ أن يصرّح به، وهو كما ترى غير مورد النزاع»(1) .
على هذا لابدّ من الأخذ بمقالة المشهور من عدم جواز إيصاء الموصي الثاني إلاّ بإذن صريح من الموصي الأوّل .
آراء فقهاء أهل السنّة في الوصية بالولاية من الوصيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه إذا أوصى الأب إلى رجل ، وأذن له أن يوصي إلى من يشاء ، صحّ له أن يوصي إلى من شاء ; لأنّه رضي باجتهاده واجتهاد من يراه ، فصحّ كما وصّى إليهما معاً .
وأمّا إن أوصى إليه وأطلق، فعندهم قولان :
قال مالك وأبو حنيفة : صحّ له أن يوصي إلى من يشاء، بأن يتولّى اُمور الصغار ، ولكنّ الشافعيّة والحنابلة قالوا بأنّه ليس له الإيصاء إلاّ أن يؤذن له .
فإليك نصّ كلماتهم :
قال في المقنع : «وليس للوصي أن يوصي إلاّ أن يجعل ذلك إليه»(2) .
-
(1) رياض المسائل 6 : 292 ، جواهر الكلام 28: 425 ـ 426.
(2) المقنع : 179 .
وفي المغني والشرح الكبير : «إذا أوصى إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من
يشاء نحو أن يقول : أذنت لك إلى أن توصي إلى من شئت . . . صحّ ... وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الشافعي في أحد قوليه أنّه قال : ليس له أن يوصي ; لأنّه يلي بتولّيه ، فلا يصحّ أن يوصي كالوكيل .
ولنا : أنّه مأذون في الإذن في التصرّف ، فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل . . . فأمّا إن أوصى إليه وأطلق فلم يأذن له ولم ينهه عنه ، ففيه روايتان :
إحداهما : له أن يوصي إلى غيره ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ، لأنّ الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الوصيّة كالأب .
والثانية : ليس له ذلك... وهو مذهب الشافعي وإسحاق . . .»(1) .
وفي الكافي : «إذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز ، وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصيّة ، لأنّه رضي باجتهاده وولاية من ولاّه ، وإن نهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصي، كما لو نهى الوكيل عن التوكيل ، وإن أطلق ففيه روايتان :
إحداهما : له أن يوصي ; لأنّه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب .
والثانية : ليس له ذلك . . . لأنّه يتصرّف بالتولية ، فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل»(2) .
وقال في المبدع ـ في شرح كلام الماتن في المقنع : وليس للوصي أن يوصي ـ : «إذا أطلق على المذهب ; لأنّه قصر في توليته فلم يكن له التفويض كالوكيل ، إلاّ أن يجعل ذلك إليه »(3) ومثّل بما مرّ في كلام المغني . ومثل ذلك في منتهى الإرادات(4)
-
(1) المغني : 6 / 574 ـ 575 ، والشرح الكبير : 6 / 588 .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 292 .
(3) المبدع في شرح المقنع 6 : 105 .
(4) منتهى الإرادات 3 : 496 .
والإنصاف(1) وكشّاف القناع(2) والإقناع(3) .
وفي المهذّب : «ولا يجوز ـ أي للوصي ـ أن يوصي إلى غيره ; لأنّه يتصرّف بالإذن فلم يملك الوصيّة كالوكيل»(4) .
وفي البيان : «وإن أوصى إلى رجل ولم يأذن الموصي للوصيّ أن يوصي ، فللوصيّ أن يتصرّف ما عاش ، وليس له أن يوصي إلى غيره به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال الثوريّ ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : للوصيّ أن يوصي . . .»(5) .
وكذا في الوجيز(6) ومغني المحتاج(7) ومنهاج الطالبين(8) وغيرها(9) .
-
(1) الإنصاف 7: 278.
(2) كشّاف القناع 4 : 483 .
(3) الإقناع 3 : 79 .
(4) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 464 .
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي 8 : 310 ـ 311 .
(6) الوجيز 1 : 461 .
(7) مغني المحتاج 3 : 76 .
(8) منهاج الطالبين 2 : 377 .
(9) روضة الطالبين 5 : 375 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 273، تكملة البحر الرائق 9 : 320 .
المبحث الرابع :
عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا ولاية للحاكم على الوصيّة بالولاية على الأطفال بعد وفاته .
ففي الشرائع : «لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلاّ من الأب والجدّ للأب خاصّة»(1) .
وقال في المسالك : «لمّا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل ، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره بغير إذنه أو في معناه(2)، وجب الاقتصار في نصب الوليّ على الأطفال على محلّ النصّ أو الوفاق ; وهو نصب الأب والجدّ له ، فلا يجوز للحاكم ـ وإن كان وليّاً عليهم ـ أن ينصب بعده عليهم وليّاً ; لأنّ ولايته مقصورة عليه حيّاً ، وإذا مات ارتفع حكمه وإن جاز له أن يوكّل حيّاً عليهم; لأنّ له الولاية حينئذ»(3) . وكذا في الجواهر(4) .
وفي العروة : «لا يصحّ ذلك ـ أي الوصيّة بالولاية على الأطفال ـ لغيرهما ـ أي الأب والجدّ ـ حتّى الحاكم الشرعي ; فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً ،
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 245 .
(2) وجاء في ذيل رواية الاحتجاج : «فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ». وسائل الشيعة 6 : 377 الباب 3 من أبواب الأنفال ، ح6 .
(3) مسالك الأفهام 6 : 144 .
(4) جواهر الكلام 28 : 277 .
وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته ، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر»(1) . وأضاف في المستمسك : «بلا خلاف ظاهر»(2) .
أدلّة عدم جواز الوصيّة بالولاية للحاكم
ويمكن الاستدلال لهذا الحكم باُمور :
الأوّل : ما ذكره في الجواهر : من أنّه لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال من الحاكم ; لأنّه تثبت ولايته عليهم من حيث الحكومة منهم(عليهم السلام) المقيّدة بزمن الحياة ، فهو شبيه الوكيل عن الإمام(عليهم السلام) بالنسبة إلى ذلك ، فينعزل بالموت(3) .
الثاني : عدم الدليل على ولاية الحاكم بعد الموت ، فكيف يصحّ له جعلها لغيره ؟ لأنّ العمدة في الأدلّة على ولاية الحاكم مقبولة ابن حنظلة(4) المتضمّنة جعل الحاكم الشرعي حاكماً ، الموجبة لثبوت أحكام الحكّام له ، ومنها تولّي الأيتام وشؤونهم ، ولم يثبت أنّ للحاكم ولاية نصب الوليّ بعده ، فالمرجع أصالة عدم ترتيب الأثر ، كما أشار إليه في المستمسك(5) .
الثالث : قصور أدلّة ولاية الحاكم الشرعي عن إثبات ولايته على الوصيّة إلى غيره بالولاية بعد وفاته ; لأنّها إنّما تثبت له من باب كون الفعل ممّا لابدّ من تحقّقه في الخارج ويرغب الشارع في حصوله ، وهو يحتاج إلى من يقوم به ، والقدر
-
(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 ـ 675 .
(2) مستمسك العروة الوثقى 14 : 592 .
(3) جواهر الكلام 28 : 277 .
(4) الكافي 1 : 67 ح10 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 ح845 ، الفقيه 3 : 5 ، وسائل الشيعة 18 : 75 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح1 .
(5) مستمسك العروة الوثقى 14 : 592 .
المتيقّن منه هو الحاكم الشرعي; فإنّه يختصّ بحال حياته ، وما دام حاكماً شرعيّاً،
فلايشمل إيصاءه لغيره بالولاية بعد مماته(1) .
الرابع : ما ذكره السيّد الفقيه السبزواري من «أنّه مع وجود حاكم شرعي آخر لايتحقّق موضوع الوصاية أصلاً; لأنّولاية حكّام الشرع نوعيّة صنفيّة ، لا أن تكون فرديّة شخصيّة ، وحينئذ تكون وصاية من مات من الحاكم الشرعي مع وجود الآخر كوصاية كلّ واحد من الأب والجدّ مع وجود الآخر ، حيث إنّه لا أثر لها»(2) .
وفي الجواهر : «. . . بعد أن كان نصب القيّم للصنف الذي ثبت في حقّ الشخص باعتبار اندراجه فيه ، فإذا انعدم فرد قام مقامه فرد آخر ممّا حلّ فيه طبيعة الصنف الذي قد نصبه إمام الأصل ، ولنحو ذلك لم يصحّ الوصيّة من الأب والجدّ له بالولاية مع وجود الآخر»(3) .
فرع
جاء في تعليقة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء على العروة : «إذا نصب الحاكم قيّماً على الأطفال تبقى ولايته عليهم ولو بعد موت الحاكم . نعم ، لو نصب وكيلاً سقطت وكالته بموت موكّله»(4) .
إيضاح
بحسب تتبّعنا لم نظفر في كلمات فقهاء أهل السنّة على رأي صريح في هذه
-
(1) مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 429 .
(2) مهذّب الأحكام 22 : 173 .
(3) جواهر الكلام 28 : 277 .
(4) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 674 .
المسألة وإن استفيد من إطلاق بعض كلماتهم: أنّه صحّ للحاكم الوصيّة بالولاية في اُمور الأيتام ، مثل قوله في الكافي : «ومن صحّ تصرّفه في المال صحّت وصيّته; لأنّها نوع تصرّف»(1) . ولكن يحتمل قويّاً انصرافه عن الحاكم ، والمقصود منه هو الأب والجدّ والاُمّ و . . . الذين هم مقدّمون في الولاية على الحاكم .
- (1) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 267 .
المبحث الخامس : عدم تولّي الاُمّ الوصيّة بالولاية
لا خلاف بين الفقهاء ـ بل الإجماع بينهم ـ في أنّه لا تلي الاُمّ للوصيّة بالولاية على الأطفال وإن لم يكن لهم أب ولا جدّ .
قال الشيخ في المبسوط : «امرأةٌ لها أطفالٌ ، فأوصتْ إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمَن قال : لها الولاية بنفسها ، قال : وصيّتها إلى الأجنبي صحيحةٌ ; لأنّها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل ، كذلك هي مثله ، وعندنا أنّ الوصيّة تبطل ; لأنّها لا تَملِكُ شيئاً»(1) .
وأشار إلى ذلك أيضاً في الخلاف(2) .
وفي الشرائع : «لا تصحّ الوصية بالولاية على الأطفال إلاّ من الأب أو الجدّ للأب خاصّة ، ولا ولاية للاُمّ ولا تصحّ منها الوصيّة عليهم»(3) .
وقال العلاّمة : «وليس للاُمّ أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جدّ»(4) .
وفي التذكرة : «الوصيّة بالولاية إنّما تصحُّ من الأب أو الجدّ للأب وإن علا ، ولا ولاية لغيرهم من أخ أو عمّ أو خال أو جدّ لاُمّ ; لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم فكيف يثبت لهم ولاية ، فإنّ الوصي نائب عن الموصي (على الموصي خ ل )(5) فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلك . وأمّا الاُمّ فلا ولاية
-
(1) المبسوط للطوسي 4 : 55 .
(2) الخلاف 4 : 162 .
(3) شرائع الإسلام 2 : 245 .
(4) قواعد الأحكام 2 : 563 .
(5) في المصدر: على الموصي ، والأولى : عن الموصي .
لها عندنا أيضاً»(1) .
وكذا في التحرير(2) والمختلف(3) والإرشاد(4) والدروس(5) وجامع المقاصد(6)والجواهر(7) والعروة(8). وبه قال أيضاً الشيخ الأعظم(9) وسادة الفقهاء الحكيم(10)والخوئي(11) والسبزواري(12). وكذا في الوسيلة(13) وتحريرها(14) وتفصيل الشريعة(15) .
وقال الشهيد الثاني في شرح كلام المحقّق : «هذا الحكم داخل في السابق
الدالّ على عدم صحّة الوصيّة عليهم لغير الأب والجدّ له ، وإنّما خُصّ الاُمّ
بالذكر بعد دخولها لإثبات ابن الجنيد(16) الولاية لها مع رُشدها بعد الأب ، وهو
شاذّ»(17) .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة .
(2) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 337 ، 381 .
(3) مختلف الشيعة 6 : 368 .
(4) إرشاد الأذهان 1 : 457 .
(5) الدروس الشرعيّة 2 : 323 .
(6) جامع المقاصد 11 : 269 .
(7) جواهر الكلام 28 : 277 .
(8) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 675 .
(9) الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 62 .
(10) مستمسك العروة الوثقى 14 : 593 .
(11) مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 429 .
(12) مهذّب الأحكام 22 : 173 .
(13) وسيلة النجاة : 568 .
(14) تحرير الوسيلة 2 : 101 ، كتاب الوصية مسألة 54 .
(15) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة ، : 195 .
(16) مختلف الشيعة 6 : 368 .
(17) مسالك الأفهام 6 : 144 .
ويدلّ على هذا الحكم الإجماع كما هو ظاهر كلام الشيخ(1) والعلاّمة(2). وكذا الأصل بعد عدم دليل على ثبوت الولاية لها في عرض الأب والجدّ أو في طولها(3) .
فرع
جاء في الشرائع : «ولو أوْصَتْ ـ الاُمّ ـ لهم ـ أي للأطفال ـ بمال ونَصَبَتْ وصيّاً ، صحَّ تصرّفه في ثلث تركتها وفي إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تُمضَ على الأولاد»(4) .
وقال العلاّمة : «ولو أوصت لهم بمال ونَصَبَتْ وصيّاً صحّت الوصية بالمال من ثلث تركتها، وبطلت الولاية على الأولاد»(5) . وكذا في الدروس(6). وبه قال الشيخ الأعظم(7) .
وفي المسالك : «هذا الحكم واضح بعدما سَلَفَ من عدم ولايتها عليهم . ونبّه بتخصيصه على أنّ تبعّض وصيّتها ـ إذا اشتملت على اُمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع ـ غير مانع من نفوذ المشروع منها ، وحينئذ فتصحُّ وصيّتها لهم بالمال ولا يصحّ إيصاؤها ، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليّهم الخاصّ أو العامّ»(8) .
-
(1) المبسوط للطوسي 4 : 54 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة .
(3) مستمسك العروة الوثقى 14 : 593 ، مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح 2 : 429 ، جواهر الكلام 28 : 277 ، مهذّب الأحكام 22 : 173 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 245 .
(5) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 337 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 323 .
(7) الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 62 .
(8) مسالك الأفهام 6 : 144ـ 145 .
آراء فقهاء أهل السنّة في الوصية بالولاية للاُمّ
إنّهم في هذه المسألة على قولين :
الأوّل : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة من أنّه لاتصحّ الوصاية في أمر الأطفال للاُمّ .
ففي روضة الطالبين : «ليس لغير الأب والجدّ الوصاية في أمر الأطفال ولا للاُمّ»(1) .
وفي مختصر اختلاف العلماء : «لمّا لم يكن للاُمّ والأخ ولاية في مال الصغير كذلك وصيّهما ، وقد اتّفقوا على أنّ وصيّهما لا يتصرّف فيما لم يرثه الصغير عنهما»(2) .
وهكذا صرّح في البيان : بـ «أنّ الاُمّ لا ولاية لها بالنظر في مال ولدها»(3) . وكذا في مغني المحتاج(4) وكشّاف القناع(5) .
وقال ابن عابدين : «وأمّا وصيّ الأخ والاُمّ والعمّ وسائر ذوي الأرحام . . . لهم بيع تركة الميّت لدينه أو وصيّته... لا بيع عقار الصغار ; إذ ليس لهم إلاّ حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرّف فيما يملكه الصغير . . . مطلقاً ; لأنّهم بالنظر إليه أجانب»(6) .
الثاني: ما ذهبت إليه المالكيّة، فإنّهم قالوا بصحّة الوصاية في أمر الأطفال للاُمّ بشروط ثلاثة ذكرت في كلماتهم .
ففي حاشية الخرشي : «إنّ الاُمّ يجوز لها أن توصي على الصغير بشروط ثلاثة :
-
(1) روضة الطالبين 5 : 376 .
(2) مختصر اختلاف العلماء 5 : 71 .
(3) البيان في مذهب الشافعيّ 8 : 150 .
(4) مغني المحتاج 3 : 76 .
(5) كشّاف القناع 4 : 484 .
(6) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 .
الأوّل : أن يكون المال الموصى فيه قليلاً كستّين ديناراً .
الثاني : أن لا يكون للصغير وليّ ولا وصيّ .
الثالث : أن يكون المال موروثاً عن الاُمّ»(1) .
وكذا في حاشية الدسوقي(2) وبلغة السالك(3) ومواهب الجليل(4) وعقد الجواهر الثمينة(5) .
وجاء في المدوّنة الكبرى : «لا تجوز وصيّتها في مال ولدها إذا كانوا صغاراً ولهم أبٌ ، فإن لم يكن لهم والد جازت وصيّتها في مال نفسها . . . وأ نّ مالكاً يخفّف ذلك ويجعله وصيّاً في الشيء اليسير . . . وأمّا في الشيء الكثير فلا ، وينظر السلطان له في ذلك»(6) .
-
(1) حاشية الخرشي على مختصر خليل 8 : 504 .
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 .
(3) بلغة ا لسالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 4 : 333 .
(4) مواهب الجليل والتاج والإكليل 8 : 555 و 556 .
(5) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .
(6) المدوّنة الكبرى 6 : 16 ـ 17 مع تصرّف يسير .
المبحث السادس : نصب القيّم مع وجود الجدّ
هل يجوز للأب نصب الوصيّ والقيّم على ولده الصغير مع وجود الجدّ أم لا ؟ أقوال :
الأوّل ـ وهو الأصحّ ـ : بطلان الوصيّة مطلقا ; بمعنى أنّه إذا أوصى الأب إلى الأجنبي تبطل وصيّته بالنسبة إلى زمان كون الجدّ موجوداً وبعد موته أيضاً .
قال الشيخ في الخلاف : «لا يجوز ـ أي للأب ـ أن يوصي إلى أجنبيٍّ، بأن يتولّى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصحّ الوصيّة ; لأنّ الجدّ أولى به»(1) .
وكذا في المبسوط(2) .
وفي الشرائع : «ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبيّ وله أب ، لم يصحّ ، وكانت الولاية إلى جدّ اليتيم دون الوصيّ ، وقيل : يصحّ ذلك في قدر الثلث ممّا ترك وفي أداء الحقوق»(3) .
وبه قال في التذكرة(4) والتحرير(5) وجعله أحد الاحتمالين في الدروس(6) .
وفي المسالك : «أنّ ولاية الجدّ وإن علا على الولد مقدّمة على ولاية وصيّ الأب ، فإذا نصب الأب وصيّاً على ولده المولّى عليه مع وجود جدّه للأب وإن علا لم يصحّ ; لأنّ ولاية الجدّ ثابتةٌ له بأصل الشرع ، فليس للأب نقلها عنه ولا إثبات
-
(1) الخلاف 4 : 161 .
(2) المبسوط للطوسي 4 : 54 .
(3) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة .
(5) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 381 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 322 .
شريك معه . ومعنى عدم صحّتها أنّها لا تقع ماضية مطلقاً»(1) .
وكذا في جامع المقاصد(2) والحدائق(3). وادّعى في الجواهر الإجماع عليه(4) . واختاره في العروة وكذا في التعليقات عليها(5) .
واستظهره في المستمسك من كلمات الأصحاب، حيث قال : «فالذي يظهر منهم المفروغيّة عن عدم صحّة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجدّ»(6).
وبه قال في الوسيلة(7) وتحريرها(8). وكذا في تفصيل الشريعة(9) .
أدلّة هذا الحكم
ويمكن أن يستدلّ على هذا باُمور :
الأوّل : الإجماع كما ادّعاه في الخلاف(10) والمبسوط(11) والجواهر(12) .
الثاني : الأصل ، قال في المستمسك : «وهو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الإطلاق الشامل للصورة المذكورة ، بل ذكرنا في «نهج الفقاهة» في
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 267 .
(2) جامع المقاصد 11 : 268 .
(3) الحدائق الناضرة 22 : 595 .
(4) جواهر الكلام 28 : 429 .
(5) العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 .
(6) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
(7) وسيلة النجاة : 2 / 151 .
(8) تحرير الوسيلة 2 : 100 مسألة 54 .
(9) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 195 .
(10) الخلاف 4 : 2 مسألة 43 .
(11) المبسوط للطوسي 4 : 54 .
(12) جواهر الكلام 28 : 277 .
مبحث الولاية الإشكال في وجود إطلاق في دليل ولاية الأب في حال حياته فضلاً
عن المقام . وعليه: فلا مجال للتأمّل في عدم الوصيّة بالولاية من الأب على الولد مع وجود الجدّ»(1) .
وكذا في الجواهر، وأضاف بأنّ «ما دلّ على ولاية الجدّ والأب ممّا هو ظاهر في انحصار أمر الطفل فيهما مع وجودهما أو أحدهما على وجه ينافيه ولاية أحدهما مع وصيّ الآخر»(2) .
الثالث : أنّ الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجدّ وصلاحيّته للولاية ، فإذا انقطعت ولاية الأب بموته لم تقع ولاية وصيّه ، فإذا مات الجدّ افتقر عود ولاية الأب ، ـ لتؤثّر في نصب الوصيّ ـ إلى دليل ، إذ الأصل عدم عودها، فلا تصحّ في حياة الجدّ ولا بعد موته ، كما في المسالك(3) وجامع المقاصد(4) .
وقال السيّد الفقيه الخوئي : «الأولى أن يستدلّ له بأنّ ولاية الأب والجدّ بمقتضى دليلها ولاية مطلقة وغير مقيّدة .
ومن هنا لا ينسجم جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحد منهما في عرضه ، حيث إنّ مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرّف ذلك الغير قبل تصرّفه .
فهو نظير ما ذكرناه في باب الأوامر من أنّ مقتضى إطلاق الأمر كونه تعيينيّاً لا تخييريّاً ، باعتبار أنّ جعل البدل له ينافي إطلاقه . ففيما نحن فيه إطلاق الدليل ينافي كون الوليّ هو الجامع بين الباقي منهما ووصيّ الآخر ، بل مقتضاه كون الباقي هو الوليّ لا غير»(5) .
-
(1) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
(2) جواهر الكلام 28 : 429 .
(3) مسالك الأفهام 6 : 267 .
(4) جامع المقاصد 11 : 268 .
(5) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 428 ـ 429.
بطلان الوصيّة في زمان ولاية الجدّ
القول الثاني : بطلان الوصيّة في زمان ولاية الجدّ خاصّة ; بمعنى أنّه لو أوصى الأب إلى أجنبيّ فإنّ ولايته تبطل ما دام الجدّ موجوداً ، وبعد موت الجدّ تعود الولاية إلى الوصيّ ; لأنّ ولاية الأب شاملة للأزمنة كلّها إلاّ زمان ولاية الجدّ ، فيختصّ البطلان بزمان وجوده(1) . كما هو الظاهر من كلام العلاّمة في القواعد، حيث قال : «ولا يجوز له نصب وصيٍّ على ولده الصغير أو المجنون مع الجدّ للأب ، بل الولاية للجدّ ، وفي بطلانها مطلقاً إشكال . نعم ، تصحّ في إخراج الحقوق»(2) .
وقد ظهر ممّا تقدّم جوابه ; لأنّ انقطاع ولاية الأب بموته مع وجود الجدّ الصالح للولاية أمر معلوم ، وعودها بعد موت الجدّ يحتاج إلى دليل . ودعوى أنّ ولاية الأب ثابتة في جميع الأزمان المستقبلة ـ التي من جملتها ما بعد زمان الجدّ ـ غير معلوم ، بل هو محلّ البحث والنزاع كما لا يخفى ، وإنّما المعلوم انقطاع ولايته بعد موته مع وجود الجدّ بعده لا ثبوتها بعد موت الجدّ(3) .
صحّة الوصيّة في الثلث
القول الثالث: أنّه تصحّ وصيّة الأب للأجنبيّ مع وجود الجدّ في الثلث خاصّة ; لأنّ له إخراج الثلث عن الوارث ، فيكون له إثبات ولاية غيره بطريق أولى . اختاره الشيخ في موضع من المبسوط(4). واستجاده العلاّمة في المختلف(5) .
-
(1) جامع المقاصد 11 : 269 ، مسالك الأفهام 6 : 267 ، الحدائق الناضرة 22 : 594 .
(2) قواعد الأحكام 2 : 563 .
(3) مسالك الأفهام 6 : 267 ، الحدائق الناضرة 22 : 594 .
(4) المبسوط للطوسي 4 : 52 .
(5) مختلف الشيعة 6 : 336 .
جاء في المسالك : «وفيه منع الأولويّة بل الملازمة ; فإنّ إزالة الملك يقتضي
إبطال حقّ الوارث منه أصلاً، وهو الأمر الثابت له شرعاً ، وأمّا بقاؤه في ملك الوارث; فإنّه يقتضي شرعاً كون الولاية عليه لمالكه ، أو وليّه الثابت ولايته عليه بالأصالة ، فلا يكون للأب ولاية عليه بالنسبة إليه أصلاً» (1) .
وكذا في جامع المقاصد(2) والحدائق(3) والجواهر(4) .
هذا كلّه في أمر الأطفال . وأمّا في قضاء الديون وإخراج الحقوق وتنفيذ الوصايا ، فيجوز للأب أن يوصي إلى غير الجدّ ; إذ لا ولاية للجدّ هنا أصلاً وإن لم ينصب وصيّاً ، فأبوه أولى بقضاء الديون وأمر الأطفال(5) .
قال الشهيد الثاني : «واعلم أنّ قوله ـ : في القول الأخير : إنّها تصحّ في أداء الحقوق ـ أجنبيٌّ من المسألة التي هي موضع النزاع ; لأنّ موضوعها الوصيّة بالنظر في مال ولده وله أب ، لا وصيّته في ماله ليخرج منه الحقوق ; فإنّ ذلك ثابت بالإجماع ».
ثمّ قال : «ويمكن أن يفرض لجواز الوصيّة في إخراج الحقوق فائدةٌ ، وهي: أنّ وصيّة الإنسان مع وجود أبيه في إخراج الوصايا وإن كانت جائزةً لكن لا تخلو من إشكال ; لأنّ وصيّة الولد إنّما تصحّ بما لا ولاية للأب فيه ، ولهذا لم تصحّ الوصيّة على الأطفال مع وجود الأب .
وإذا كان كذلك فلو لم يوصِ الولد بقضاء الدين وإنفاذ الوصايا مع وجود أبيه
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 267 .
(2) جامع المقاصد 11: 269.
(3) الحدائق الناضرة 22 : 595 .
(4) جواهر الكلام 28 : 429 .
(5) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة ، جامع المقاصد 11 : 269 .
كان الأب أولى بذلك من غيره حتّى الحاكم ، كما هو أولى بالأطفال كما نبّه عليه في التذكرة(1)»(2) .
آراء فقهاء أهل السنّة في نصب القيّم مع وجود الجدّ
يستفاد من كلماتهم في هذه المسألة أنّهم على قولين :
الأوّل: ذهب الشافعيّة إلى أنّه لا يجوز للأب أن يوصي إلى غيره في أمر الأطفال مع وجود الجدّ .
ففي المهذّب : «وإن كان له ـ أي للولد ـ جدّ لم يجز ـ للأب ـ أن يوصي إلى غيره ; لأنّ ولاية الجدّ مستحقّة بالشرع، فلا يجوز نقلها عنه بالوصيّة»(3) .
وفي البيان : «وإن كان للصغير جدّ من أبيه يصلح للنظر، فأوصى الأب إلى غير الجدّ كان الجدّ أولى بالنظر . . . لأنّها ولاية يستحقّها الجدّ بالقرابة ، فكان مقدّماً على وصيّ الأب، كولاية النكاح»(4) .
وكذا في المجموع(5) ومغني المحتاج(6) وروضة الطالبين(7) .
الثاني: أنّه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة والمالكيّة خلافاً للشافعيّة إلى أنّه لا ولاية للجدّ ، وقالوا بجواز وصاية الأب ولو كان الجدّ موجوداً بصفة الولاية .
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 268 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 510، الطبعة الحجريّة .
(3) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 449 .
(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي 8 : 149 .
(5) المجموع شرح المهذّب 16 : 299 .
(6) مغني المحتاج 3 : 76 .
(7) روضة الطالبين 5 : 376 .
ففي الدرّ المحتار : « ووصيّ أبي الطفل أحقّ بماله من جدّه ، وإن لم يكن وصيّه فالجدّ » ، وقال ابن عابدين في شرحه : « الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ثمّ وصيّ وصيّه ولو بعد ، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب »(1) .
وفي مختصر اختلاف العلماء : «قال أصحابنا : وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجدّ ـ أب الأب ـ فإذا لم يكن أب ولا وصيّه ، فالجدّ بمنزلة الأب في ذلك»(2) .
ويستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسي في المبسوط حيث قال : «وإذا أوصى إلى رجل بماله ، فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا»(3) .
وفي الكافي : إنّ ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثمّ وصيّه بعده; لأنّه نائبه ... ثمّ الحاكم; لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان(4).
وكذا في الإقناع(5) ومنتهى الإرادات(6) وكشّاف القناع(7) .
وفي حاشية الدسوقي في فقه المالكي : إنّ الوصيّة على الأولاد المحجورين عليهم خاصّ بالأب أو وصيّه دون الأجداد والأعمام والإخوة(8) .
وفي حاشية الخرشي : «إنّ الوصيّة على الأولاد وإقامة من ينظر في حالهم
-
(1) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 ـ 715 .
(2) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 .
(3) المبسوط للسرخسي 28 : 26 .
(4) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 .
(5) الإقناع في فقه الإمام أحمد : 80 .
(6) منتهى الإرادات 3 : 497 .
(7) كشّاف القناع 4 : 484 .
(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 .
مختصّ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب ومن الأجداد»(1) . وكذا في مواهب الجليل(2) .
وفي عقد الجواهر الثمينة : «ويجوز نصب الوصيّ في حياة الجدّ ; إذ
لا ولاية له»(3) .
-
(1) حاشية الخرشي على مختصر خليل 8 : 503 .
(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 8 : 556 .
(3) عقد الجواهر الثمينة 3 : 429 .
المبحث السابع :
الطرق المعتبرة لإثبات الوصيّة بالولاية
والبحث عنها يقع في مقامين :
الأوّل : إذا لم يكن بين الورثة والوصيّ اختلاف في مورد الوصيّة .
الثاني : إذا اختلفوا في ذلك .
إثباتها عند عدم الاختلاف
تثبت الوصيّة بالولاية ـ فيما إذا لم يكن هناك اختلاف ـ كغيرها بعدّة اُمور نذكرها على الترتيب التالي :
أ : العلم، تثبت الوصيّة بالولاية بالعلم الوجداني ; لأنّ الموضوعات التي تعلّقت بها الأحكام إنّما يراد بها الاُمور الواقعيّة، كما هو مقتضى مدلولات الألفاظ، والطريق إلى الواقع هو العلم ، ولما حقّق في محلّه من أنّ العلم حجّة بذاته ، والردع عن العمل على طبقه أمرٌ غير معقول ، فلو علم الوصيّ أنّ الموصي أوصى له بذلك وقبلها وجب عليه إنفاذ الوصيّة فيما أوصى به إليه .
ب : إقرار الورثة، كذلك تثبت الوصيّة بالولاية بإقرار الورثة وتصديقهم للوصيّ . قال في التذكرة : «لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية تثبت فيما لا تفتقر إلى الشهادة»(1) أي لا يكون اختلاف بين الورثة والوصيّ .
وقال في موضع آخر : «إذا ثبتت الوصيّة إمّا بالإشهاد أو بالإقرار فإنّ
- (1) تذكرة الفقهاء 2 : 522، الطبعة الحجريّة .
حكمها يثبت»(1) .
وفي التحرير : «لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بهذه الوصيّة»(2) .
وفي منهاج الصالحين : «تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم»(3) .
ويدلّ عليه بناء العقلاء على قبول الإقرار في هذا المقام، ولم يثبت ردع من الشرع .
ج : البيِّنة; لأنّه قام الإجماع من الفقهاء على حجّية البيِّنة مطلقا; سواء كان في باب القضاء أو غيره ; لأنّ من لاحظ كلماتهم في الأبواب المختلفة يستظهر منها أنّ اعتبار البيّنة متسالم عليه بين الأصحاب في باب القضاء، وكذلك في سائر الموضوعات، ولا يبعد أن يكون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم أو الدليل المعتبر ، فلا شبهة في ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين ، ولم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في ذلك .
د : خبر الثقة، يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال »(4) .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2: 453، الطبعة الحجريّة.
(2) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
(3) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 228 .
(4) الكافي 7 : 64 ح27 ، تهذيب الأحكام 9 : 237 ، الفقيه 4 : 175 ، وسائل الشيعة 13 : 482 الباب 97 من كتاب الوصايا ، ح1 .
فإنّها تدلّ(1) على حجّية قول الثقة في الموضوعات ـ كما استقرّت السيرة العقلائية على ذلك(2); فإنّ الرجل المسلم الصادق أخبر عن رجوع الموصي عن الوصيّة ، وحكم الإمام(عليه السلام) باعتبار هذا الخبر وقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال » ـ (كما أمرك خل) .
ومورد الرواية وإن كان في الوصيّة بالمال ، ولكن لا فرق بين المال والولاية في أنّهما يثبتان بخبر العدل الواحد .
إثبات الوصيّة بالولاية بالكتابة
التحقيق في هذه المسألة يتوقّف على ذكر مقدّمة ; وهي أنّه لا خلاف في صحّة الوصيّة بالكتابة والعمل بها في حال الضرورة وعدم إمكان التلفّظ مع وجود القرينة الدالّة عليها ، كما في التنقيح الرائع(3) وادّعى عليه الإجماع في الإيضاح(4) ، وفي جامع المقاصد : نفى الشكّ فيه(5) .
وبه صرّح في الجامع للشرائع(6) والتبصرة(7) والتذكرة(8) والتحرير(9)
-
(1) وقد أثبتنا في محلّه في كتاب الاجتهاد والتقليد عدم حجّية خبر الواحد الثقة أو العدل في الموضوعات وإنّما هو حجة في الروايات والأحكام، وبناءً على ذلك يمكن أن يقال باحتفاف قول الرّجل بالقرائن المفيدة للعلم، سيّما مع تعبيره بالمسلم الصادق. م ج ف.
(2) دروس في فقه الشيعة 2 : 60 ، بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 86 ، مصباح الاُصول 2 : 196 ، التنقيح في شرح العروة 2 : 167 .
(3) التنقيح الرائع 2 : 364 .
(4) إيضاح الفوائد 2 : 473 .
(5) جامع المقاصد 10 : 20 .
(6) الجامع للشرائع : 498 .
(7) تبصرة المتعلّمين : 128 .
(8) تذكرة الفقهاء 2 : 452، الطبعة الحجريّة .
(9) تحرير الأحكام الشرعيّة 3: 383.
والدروس(1) والروضة(2) وغيرها(3) .
ويدلّ عليه ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «دخلت على محمّد بن عليّ بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصيّة فلم يُجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خطّ بيدك ، فخطّ وصيّته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة»(4) .
وإنّما الكلام في أنّه هل يكتفى بصرف الكتابة في حال الاختيار والقدرة على التلفّظ ، أم لا يصحّ ذلك ؟ فيه قولان :
الأوّل : وهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء عدم الاكتفاء بالكتابة في حال الاختيار .
ففي التذكرة : «لا تنعقد الوصيّة إلاّ باللفظ مع القدرة عليه ، فلو كتب بخطّه: إنّي قد أوصيت لفلان بكذا ، لم ينفذ إذا كان الشخص ناطقاً»(5) .
وفي الدروس : «ولو كتب القادر على النطق أو أشار لم يجب العمل به»(6) .
بل في السرائر نفى الخلاف فيه(7) ، وبه قال فخر المحقّقين(8) والشهيد والمحقّق
-
(1) الدروس الشرعيّة 2 : 295 .
(2) الروضة البهيّة 5 : 18 .
(3) كنز الفوائد 2 : 194 .
(4) الفقيه 4 : 146 ح505 ، تهذيب الأحكام 9 : 241 ح934 ، كمال الدين : 36 ، وسائل الشيعة 13 : 436 الباب 48 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(5) تذكرة الفقهاء 2 : 452 الطبعة الحجريّة .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 295 .
(7) السرائر 2 : 176 .
(8) إيضاح الفوائد 2 : 473 .
الثانيان(1) ، والشيخ الأعظم(2). وكذا في التنقيح الرائع(3) .
الثاني : صحّة الاكتفاء بالكتابة مطلقاً ولو مع القدرة على النطق .
احتمله في التذكرة(4) ، وهو الظاهر من عبارة النافع، حيث قال : «ولا تكفي الكتابة ما لم تنضمّ القرينة الدالّة على الإرادة»(5) .
ويمكن أن يستظهر ذلك من عبارة اللمعة أيضاً(6) .
وفي الرياض : «ولا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة; لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادةً ، مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص»(7) (8).
واختاره في الجواهر(9) والحدائق(10). وذهب إليه السادة الفقهاء الاصفهاني(11) والخوئي(12) والإمام الخميني(13) والسبزواري(14) والحكيم(15) قدّس الله أسرارهم . وكذا في العروة والتعليقات عليها إلاّ تعليقة السيّد الفقيه
-
(1) الروضة البهيّة 5 : 19 ، جامع المقاصد 10 : 20 .
(2) الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 28 .
(3) التنقيح الرائع 2 : 363 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 452، الطبعة الحجريّة .
(5) المختصر النافع : 188 .
(6) اللمعة الدمشقيّة : 104 .
(7) وسائل الشيعة 13 : 352 الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح5 ـ 7 .
(8) رياض المسائل 9 : 434 .
(9) جواهر الكلام 28 : 249 .
(10) الحدائق الناضرة 22 : 637 .
(11) وسيلة النجاة 2 : 144 .
(12) منهاج الصالحين 2 : 208 ، مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح 2 : 409 .
(13) تحرير الوسيلة 2 : 90 مسألة 3 .
(14) مهذّب الأحكام 22 : 163 .
(15) مستمسك العروة الوثقى 14 : 578 .
البروجردي(1). واختاره الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة(2) .
والقول الثاني هو الراجح عندنا. والأدلّة على هذا الترجيح ما يلي :
الأوّل : إطلاقات أدلّة الوصيّة; فإنّها غير مقيّدة باللفظ ، بل مقتضاها اللزوم وحرمة التبديل بمجرّد صدق الوصيّة كيف ما تحقّقت . ودعوى تقييد الإطلاقات بالإجماع على احتياج العقود إلى اللفظ، مدفوعة بأنّه لو تمّ فهو إنّما يختصّ بالعقود اللازمة .
وأمّا العقود الجائزة التي منها الوصيّة ـ بناءً على كونها عقداً ـ فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيها ، كما في مستند العروة(3) .
الثاني : أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بقوله(عليه السلام) : «ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه»(4) . وكذا نحوها(5) .
بل يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) : رجل كتب كتاباً بخطّه ، ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي، ولم يقل : إنّي قد أوصيت ، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب(عليه السلام) : « إن كان له وُلد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره »(6) .
وفي مباني العروة : « وطريق الشيخ ضعيف بعمر بن علي . . . حيث لم يرد فيه
-
(1) العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 670 .
(2) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 138 .
(3) مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح 2 : 409 .
(4) المقنعة : 666 ، وسائل الشيعة 13 : 352 الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح7 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 379 الباب 16 من كتاب الوصايا ح10 وص 387 الباب 18، ح7 ، مستدرك الوسائل 14 : 88 ، ح6 و2 : 116 ، ح2 و 5 ، سنن ابن ماجة 4 : 268 ، ح2699 ، سنن الترمذي 4 : 432 ، ح2123 .
(6) وسائل الشيعة 13 : 437 الباب 48 من كتاب الوصايا ، ح2 .
توثيقٌ، غير أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى(1) قد روى عنه ، ولم يستثنه ابن الوليد، إلاّ أنّنا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أنّ ذلك لا ينفع في إثبات الوثاقة للرجل فراجع(2) . على أنّ الرواية ـ بطريقيها ـ ضعيفةٌ بإبراهيم إبن محمّد الهمداني نفسه; فإنّه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم(عليهم السلام); لما أوضحناه في مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أنّ الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة الوكيل»(3) .
«نعم ، ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله ، إلاّ أنّها جميعاً ضعيفة السند »(4). وكذا في تفصيل الشريعة(5) .
وجاء في المستمسك : « لكن قصور سندها غير ظاهر ; فإنّ طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ، وأحمد بن زياد ثقة ، وعليّ بن إبراهيم من الأجلاّء ، وأبوه مصحّح الحديث . وأمّا إبراهيم فهو من الوكلاء الثقات »(6) .
وفي قاموس الرجال : « قال المصنّف : يأتي ـ في فارس ومحمّد بن إبراهيم هذا ـ رواياتٌ من الكشّي تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا »(7) .
وفي رجال الكشّي عن أبي محمّد الرازي قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبدالله البرقي بالعسكر ، فورد علينا رسول من الرجل(8) فقال . . . وأيوب بن نوح
-
(1) الظاهر أنّ الصواب محمّد بن أحمد بن يحيى، ولعلّه سهو من المقرّر أو من النسّاخ.
(2) معجم رجال الحديث 15 : 47 الرقم 10156، وفيه: «إذ لعلّه كان يبني على أصالة العدالة» .
(3) معجم رجال الحديث 1 : 75 .
(4) مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح 2 : 410 .
(5) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية 138 .
(6) مستمسك العروة الوثقى 14 : 579 .
(7) قاموس الرجال 1 : 293 الرقم 205 .
(8) وفي الهامش ، المراد بقرينة الروايات هو أبوالحسن العسكري(عليه السلام) .
وإبراهيم بن محمّد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعاً(1) .
نقول : إبراهيم بن محمّد الهمداني عدّه الشيخ من أصحاب الرضا(2) والجواد(3)والهادي(4)(عليهم السلام). وكذا في رجال البرقي(5)، وهو وكيل الناحية ، كان حجّ أربعين حجّة(6) وكتب إليه الجواد(عليه السلام) كتباً تدلّ على عظيم شأنه :
منها : ما رواه الكشّي عن عليّ بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكتب إليّ : « وقد وصل الحساب تقبّل الله منك ، ورضي عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة ، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا ، ومن الكسوة بكذا ، فبارك لك فيه ، وفي جميع نعمة الله عليك ، وقد كتبت إلى النضر : أمرته أن ينتهي عنك ، وعن التعرّض لك وبخلافك ، وأعلمته موضعك عندي ، وكتبت إلى أيّوب : أمرته بذلك أيضاً وكتبت إلى مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك والمصير إلى أمرك وأن لا وكيل لي سواك»(7) .
ومنها: ما روى الشيخ في كتاب الغيبة عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الرازي قال : كنت وأحمد بن أبي عبدالله بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال : «أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمّد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات»(8) وغيرها(9) .
-
(1) رجال الكشّي : 557 و558 .
(2 ـ 3) رجال الطوسي : 352 الرقم 16 وص373 الرقم 2 وص383 الرقم 8 .
(5) رجال البرقي : 54 و 56 و58 .
(6) جامع الرواة 1: 33.
(7) رجال الكشّي: 611 ـ 612 الرقم 1136.
(8) كتاب الغيبة للطوسي : 417 ، البحار 51 : 363 .
(9) تهذيب الأحكام 8 : 57 ، ح186 ، الإستبصار 3 : 394 ، ح1027 ، وسائل الشيعة 15 : 320 الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح1 .
وذكره العلاّمة(رحمه الله) في القسم الأوّل من الخلاصة(1) أيضاً .
فمن مجموع هذه الاُمور خصوصاً كونه وكيلاً للإمام(عليه السلام) تطمئنّ النفس على أنّ إبراهيم بن محمّد الهمداني ثقة ورواياته معتبرة، فلا إشكال في سند الرواية . وأمّا دلالتها على اعتبار الوصيّة بالكتابة في حال الاختيار، فاُورد عليها :
أوّلا: بأنّها لا تصلح دليلا للحكم ، وذلك لما تضمّنته من حجّية هذه الوصية لأولاد الميّت خاصّةً ، ومقتضى مفهومها عدم اعتبار الوصيّة بالكتابة لغير الأولاد ، وهذا التفصيل بين الأولاد وغيرهم من الورثة لم يعرف قائل به ولا يمكن الإلتزام به ، فلابدّ من رفع اليد عن هذا الخبر(2) .
وثانياً: يحتمل أن يكون تنفيذ الوصية بالكتابة من خواصّ الولد ، نظير قضاء الصلاة والصوم ، فتدلّ على عدم حجيّة الكتابة المجرّدة عن القول(3) .
نقول : إنّ الظاهر من الرواية اعتبار الوصيّة بهذا النحو وصحّتها مطلقاً ، فيجب تنفيذها للأولاد وغيرهم ، وليست مختصّة بالأولاد ، بل ذكر الأولاد من باب أنّهم أولى بإنفاذ وصيّة أبيهم ، مضافاً إلى أنّه لو ثبت تنفيذ هذه الوصيّة
للأولاد ثبت لغيرها من الورثة بعدم الفصل ; لأنّه ليس في المسألة إلاّ القولين :
التنفيذ مطلقاً ، وعدم التنفيذ مطلقاً ، ولا وجه لجعل ذلك من مختصّات الولد كقضاء
الصلاة والصوم .
وبالجملة : فإنّ الخبر المذكور معتبر سنداً، واضح متناً ، لا مجال للطعن فيه بوجه ولا معارض له، فالعمل به متعيّن .
الثالث : السيرة المستمرّة من المتشرّعة على الوصيّة بالكتابة .
-
(1) خلاصة الأقوال : 52 .
(2) مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 411 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 138 مع تصرّف .
(3) مستمسك العروة الوثقى 14 : 579 .
الرابع : ما احتجّ به العلاّمة في التذكرة من أنّ الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ ، وقد بيّنا جواز الوصيّة بالكناية التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة ، فإذا كتب وقال : نويت الوصيّة لفلان أو اعترف الورثة بعد موته به ، وجب أن تصحّ(1) .
الخامس : لا شكّ في أنّه يصدق الوصيّة على ذلك عرفاً وعادةً ، ومع فرض تحقّق الوصيّة بالكتابة يترتّب عليه جميع أحكامها ; لأنّ المناط صدق عنوان الإيصاء ، ولا دليل على التقييد باللفظ .
قال في تفصيل الشريعة : «والوجه أنّه لا دليل على كون الوصيّة بأمر خاصّ»(2) .
السادس : ما ذكره في مهذّب الأحكام من أنّ المناط في إبراز المقاصد على الدوالّ الخارجية المعتبرة عند المتعارف ، والمفروض كون الوصيّة بالكتابة كذلك ، فيكون المقتضي للصحّة موجوداً والمانع عنها مفقوداً ، فتصحّ لا محالة(3) .
وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه يكفي في تحقّق الوصيّة مطلقاً ـ الوصيّة بالولاية وغيرها ـ كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كانت كتابةً أو إشارة ، بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه .
ولا مانع من ذلك إلاّ دعوى نفي الخلاف من السرائر وكلمات الأصحاب .
وقال في الجواهر : «ومعقد نفي الخلاف في محكيّ السرائر غير ما نحن فيه . . . ولعلّ مراده عدم صحّة الشهادة عليه بذلك الإجمال»(4) .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 452، الطبعة الحجريّة .
(2) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 138 .
(3) مهذّب الأحكام 22 : 163 .
(4) جواهر الكلام 28 : 249 .
ويمكن أيضاً حمل كلام الأصحاب على صورة عدم الوضوح والصراحة التي يكتفي بهما العرف في المحاورات الدائرة بينهم ، كما في مهذّب الأحكام(1) .
والحاصل : أنّه يمكن حمل كلام الأصحاب على عدم صحّة الوصيّة بالكتابة للإجمال ، أو يكون المراد عدم الاكتفاء بالكتابة في ثبوت الوصيّة ، بمعنى أنّه لا يجب العمل بما يوجد مكتوباً ما لم يثبت بالبيِّنة أو لم تقم القرائن على إرادته الوصيّة بذلك(2) .
وبعد هذه المقدّمة والحكم لصحّة الوصيّة بالكتابة :
نقول : هل تثبت الوصيّة ـ الوصيّة بالولاية وغيرها ـ بصرف كتابتها سواء كتبها الموصي أو غيره ، أم لا ؟
يمكن أن نستفيد تصوير المسألة في كلمات الفقهاء في صور :
الصورة الاُولى : إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت ولم يكن أقرّ بها ولا أشهد عليها ، فهل تثبت الوصيّة بذلك ويجب العمل بها أم لا ؟
فيه ثلاث احتمالات بل أقوال :
الأوّل: ـ هو الذي اعتقد به أكثر الأصحاب ـ أنّه لا تثبت ولا يجب العمل بها على الورثة .
جاء في المختصر النافع : « ولا يجب العمل بما يوجد بخطّ الميّت »(3) . ووافقه
الفاضل الآبي(4) وابن فهد الحلّي(5) .
-
(1) مهذّب الأحكام 22 : 163 .
(2) جواهر الكلام 28 : 248 .
(3) المختصر النافع : 189 .
(4) كشف الرموز 2: 66.
(5) المقتصر : 214 .
وقال العلاّمة : « لا يجب العمل بما يوجد بخطّه(1) » .
وفي التذكرة : «بل لهم ـ للورثة ـ ردّها وإبطالها ; سواء عملوا بشيء منها أو لا »؟(2).
وقال في الدروس : « لم يجب العمل به ولو شوهد كاتباً أو علم خطّه(3) » . وكذا في الروضة(4) .
وجاء في جامع المقاصد : « إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت ولم يكن أقرّ بها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة ; سواء شاهدوه يكتب أم لا ، وسواء اعترفوا بأنّه خطّه أو عرف أم لا ، وسواء قدر على النطق أو لا ، وسواء عمل الورثة ببعض الوصيّة أو لا . واستدلّ بأنّ الكتابة قد لا تكون على قصد الوصيّة(5) ». وكذا في غيرها(6) .
والحقّ ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم . فإذن أمر الصغار إلى الحاكم ، وهو الذي يعيّن القيّم عليهم ، ويأتي الكلام فيه .
القول الثاني : أنّه يثبت ويجوز العمل بها .
قال الشيخ في النهاية : «وإذا وُجدت وصيّة بخطّ الميّت ، ولم يكن أشهد عليها ولا أمر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردّها وإبطالها . فإن عملوا بشيء منها ، لزمهم العمل بجميعها »(7) .
-
(1) تبصرة المتعلِّمين : 128 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 452، الطبعة الحجريّة .
(3) الدروس الشرعيّة 2 : 295 .
(4) الروضة البهيّة 5 : 19 .
(5) جامع المقاصد 10: 19.
(6) إرشاد الأذهان 1 : 464 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 331 ، التنقيح الرائع 2 : 363 .
(7) النهاية : 621 ـ 622 .
وفي الجامع للشرائع : « ويجوز للورثة العمل بوصيّة في كتاب لم يشهد بها وببعضها ، وتركها(1) » .
القول الثالث : التفصيل بأنّه لو ثبت ما وجد بخطّه بإحدى ا لطرق المعتبرة المتقدّمة ـ أي العلم الوجداني، أو إعترف الورثة، أو اُقيم البيّنة، أو الخبر العدل الواحد ـ يجب العمل بها، وإلاّ فلا .
ويحتمل كلام الشيخ في النهاية في أنّ الورثة اعترفوا بصحّة الوصيّة بالاستناد إلى هذا الخطّ، فيجب العمل بالجميع ، كما في التذكرة(2) والمهذّب البارع(3)والإيضاح(4) .
وفي المختلف : «لا منافاة بين الأمرين ـ أي ما ذكره الشيخ في النهاية، وما في السرائر ـ فإنّ قول الشيخ(رحمه الله) يحتمل العمل بما وجدوه من خطّه ; لأنّه أوصى بذلك مستندين إلى هذا الخط عارفين بصحّته ، وحينئذ يجب العمل بالجميع»(5) .
ولعلّ يستفاد ذلك من معتبرة إبراهيم بن محمّد الهمداني المتقدّمة(6) ; لأنّ قوله(عليه السلام) : «ينفّذون» صفة للولد ، وجواب الشرط محذوف تقديره : إن كان له أولاد ينفّذون ما وجدوه في كتاب أبيهم فلهم ذلك .
ولذا قال في الحدائق : «إنّ الرواية المذكورة ظاهرة في وجوب تنفيذ ما يجدونه في وصيّته بخطّه»(7) .
-
(1) الجامع للشرائع : 498 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 452 الطبعة الحجريّة .
(3) المهذّب البارع 3: 95.
(4) إيضاح الفوائد 2 : 473 .
(5) مختلف الشيعة 6 : 377 .
(6) وسائل الشيعة 13 : 437 الباب 48 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(7) الحدائق الناضرة 22 : 636 .
الصورة الثانية : لو كَتَبَ وصيّةً فقال للشهود : إشهدوا عَلَيَّ بما في هذه الورقة ، ولم يطّلعهم على ما فيها ، أو قال : هذه وصيّتي فاشْهدوا عليَّ بها ، لم تثبت الوصيّة بها ولم يجز لهم الشهادة على ذلك حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقرّ به، كما في القواعد(1) والتذكرة(2) والتحرير(3) والدروس(4) والتنقيح(5) والروضة(6) .
وفي جامع المقاصد : «وذلك لأنّ الأمر المبهم لا يعقل تحمّل الشهادة به ; لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله(صلى الله عليه وآله) مشيراً إلى الشمس : «على مثلها فاشهد، أو دع»(7)،(8) .
وفي مفتاح الكرامة : «وقد حكينا في باب القضاء الإجماع عن السرائر في غير موضع على ذلك»(9) .
وفي الجامع للشرائع : «إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً»(10) .
ولعلّه لأنّ الإشهاد مشروط بالعلم ، وهو منفيّ هنا .
-
(1) قواعد الأحكام 2 : 445 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 452، الطبعة الحجريّة .
(3) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 331 .
(4) الدروس الشرعيّة 2 : 296 .
(5) التنقيح الرائع 2 : 363 .
(6) الروضة البهيّة 5 : 19 .
(7) رواها في السرائر 2: 117، وشرائع الإسلام 4: 132، ووسائل الشيعة 18: 251 الباب 20 من كتاب الشهادات ، ح3.
(8) جامع المقاصد 10 : 20 .
(9) مفتاح الكرامة 9 : 381 .
(10) الجامع للشرائع : 530 .
وفي المختلف : « لا يجوز أن يشهد بمجرّد معرفة خطّه »(1) .
وفي مفتاح الكرامة : « وهو قضيّة كلام الأردبيلي أو صريحه في باب القضاء »(2) .
الصورة الثالثة : أن يقرأ الشاهد ما كتب الموصي بعنوان الوصيّة ، فيقول له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد به عليَّ ، ففيه قولان :
الأوّل: الأقرب إثبات الوصيّة وقبولها ، كما يستفاد من القواعد(3) والروضة(4) .
وفي الإيضاح : «هذا اختيار ابن الجنيد; لاعترافه بمعرفته بما فيه ، فيحكم عليه للخبر ، ولأنّه عبّر عنه بما لا يحتمل غيره، فكان نصّاً في الوصيّة والموصى به، فيصحّ»(5) .
وقال المحقّق الثاني في ذيل كلام العلاّمة ـ يجوز في تاء «عرفت» الفتح والضمّ على إرادة الموصي نفسه أو الشاهد ـ : «ولعلّ الضمّ أولى ليكون إخباراً عن علمه بما في الكتاب، وأنّه ليس بمبهم عنده ; فإنّ شرط الإشهاد كون المقرّ عالماً بما أقرّ به .
ووجه القرب : أنّ ذلك جار في الصراحة مجرى ما لو أخبرهم به تفصيلاً ; لأنّ الدلالة على الاُمور المتعدّدة إجمالاً كافية كالدلالة عليها تفصيلاً»(6) .
وفي الروضة : « والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه ، مع اعتراف الموصي بمعرفة ما فيه وأنّه موص به »(7) .
-
(1) مختلف الشيعة 6 : 368 .
(2) مفتاح الكرامة 9 : 381 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 96 .
(3) قواعد الأحكام 2 : 445 .
(4) الروضة البهيّة 5 : 19 .
(5) إيضاح الفوائد 2 : 473 .
(6) جامع المقاصد 10 : 21 .
(7) الروضة البهيّة 5 : 19 .
القول الثاني : عدم الاكتفاء به ، لبقاء الإجمال والإبهام ، وعلّله في الإيضاح بانتفاء الدلالات الثلاث ، إذ الاعتبار بوضع اللغة(1) .
فرع : حكم الوصيّة التي سجّلت في الشريط أو غيره
يمكن أن يسأل إذا أوصى الموصي بوصيّة وسجّلها في شريط المسجّل أو في شريط الفيديو أو غيرهما; كأن يكون عبر الإنترنيت ، فهل تثبت الوصيّة بالولاية وغيرهما بمثل هذه الاُمور أم لا ؟
فنقول : قد تقدّم منّا أنّه إذا لم يكن اختلاف ومخاصمة بين الورثة والوصيّ تثبت الوصيّة بالولاية باُمور، ومنها: العلم الوجداني أو الاطمئنان ، فحينئذ لو كانت الوصيّة التي سجّلت في الشريط أو غيره واضحة مفيدة للعلم أو الاطمئنان بصحّتها ولو بمعونة القرائن، فثبوت الوصيّة بها غير بعيد .
وأمّا إذا لم تكن مفيدة للعلم وكان خوف التزوير فلا تثبت ; لأنّ أجهزة الصوت والتصوير يُحتمل فيها الوضع والتزوير .
ويمكن أن يستدلّ على ثبوت الوصيّة بهذه الاُمور بعموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة ضريس الكناسي ، وكذا موثّقة سماعة ، وصحيحة الحلبي ومحمّد
ابن مسلم ; لأنّ الإمام(عليه السلام) علّل ذلك بأنّه «لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم
ولا تبطل وصيّته»(2) .
ومن الواضح أنّه إذا لم نقل بوجوب إنفاذ الوصيّة التي كانت مسجّلة في الشريط، أو أرسلها الموصي عِبر الانترنيت، يلزم بطلان الوصيّة وتضييع حقّ امرئ مسلم .
-
(1) إيضاح الفوائد 2 : 473 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 390 الباب 20 من كتاب الوصايا ، ح1 و3 و5 .
كما أنّ المناط في إبراز المقاصد الدوالّ الخارجية المعتبرة عند العرف والعقلاء ، والمفروض أنّ أجهزة الصوت والتصوير في هذا العصر من الدوالّ التي يبرز العقلاء مقاصدهم بها وتكون معتبرة عندهم .
إثبات الوصيّة بالولاية مع اختلاف الورثة
المقام الثاني : أ نّه إذا كان بين الورثة والوصيّ اختلاف في مورد الوصيّة فيلزم لإثبات الوصيّة، بالولاية شهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا بشاهد ويمين . واختلف الفقهاء في إثباتها بشهادة أهل الذمّة ، ففي المقام يقع الكلام في جهات :
أ ـ إثباتها بشهادة عدلين
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يثبت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين .
قال المحقّق : « لا تثبت الوصيّة بالولاية إلاّ بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردّد ، أظهره المنع »(1) .
وفي التذكرة: «لاتقبل في الشهادة بالولاية إلاّ شهادة رجلين عدلين مسلمين»(2). وبه قال في القواعد(3).
وفي المسالك : لا شبهة في ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة شاهدين مسلمين عدلين ; لأنّ ذلك ممّا يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني ممّا يتوقّف على أربعة ، وحكم الوصيّة أخفّ من غيرها (4) .
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 251 ، المختصر النافع : 192 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 522، الطبعة الحجريّة .
(3) قواعد الأحكام 2 : 568 .
(4) مسالك الأفهام 6 : 203 .
وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه »(1) .
وبه قال السيّدان الفقيهان الخوئي(2) والإمام الخميني(3).
وجاء في تفصيل الشريعة : « الوصيّة إن كانت متعلّقة بالولاية; سواء كانت هي الولاية على المال، أو القيمومة على الأطفال، فهي لا تثبت إلاّ بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات، ولا منضمّات بالرجال »(4) .
ويستفاد هذا الحكم من الكتاب والسنّة والإجماع :
أمّا الكتاب: فقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ . . .) الآية(5) .
معنى الآية : أنّ الله ـ تعالى ـ أخبر أنّ حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدلين ، فإن تعذّر عليه بأن كان في سفر ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدان ممّن حضره من أهل الكتاب .
أمّا السنّة: فروايات كثيرة مستفيضة :
منها : ما دلّ على عموم حجّية البيِّنة(6)، وأنّه يمكن إثبات كلّ حقّ بإقامتها ، كما رواه في العلل وعيون الأخبار عن الرضا(عليه السلام) أنّه قال : « والعلّة في أنّ البيِّنة في جميع الحقوق على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم لأنّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود; لأنّه مجهول » الحديث(7) .
-
(1) جواهر الكلام 28 : 347 .
(2) منهاج الصالحين 2 : 228 .
(3) تحرير الوسيلة 2 : 103 ـ 104 ، كتاب الوصية مسألة 63 .
(4) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 205 .
(5) سورة المائدة 5 : 106 .
(6) وسائل الشيعة 18 : 167 الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم وص287 باب 40 من كتاب الشهادات .
(7) نفس المصدر 18 : 171ـ 172 الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح6 .
وما رواه الفضل بن شاذان عنه(عليه السلام) قال : « . . . فجعل الأذان شهادتين
شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان»(1) .
ومنها : عموم ما دلّ على حجّية قول شاهدين عدلين بخصوصهما في إثبات الوصيّة ، كما رواه يحيى بن محمّد قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)(2) .
قال : «اللذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب» الحديث(3) .
ومثله ما رواه حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، فإنّه قال(عليه السلام) فيه : «اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب»(4) .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : «نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(5) .
وأمّا الإجماع، فإجماع المسلمين(6) .
ب ـ عدم إثبات الوصيّة بالولاية بشهادة النساء
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا تقبل شهادة النساء في الوصيّة بالولاية
-
(1) نفس المصدر 18 : 173 الباب 5 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح1 .
(2) سورة المائدة 5 : 106 .
(3) (4) (5) نفس المصدر 13 : 390 ـ 392 الباب 20 من كتاب الوصايا ، ح3، 6، 7.
(6) المبسوط للطوسي 8 : 187 ، إيضاح الفوائد 2 : 634 ، غنية النزوع : 440 ، جواهر الكلام 28 : 347 ، مهذّب الأحكام 22 : 233 ، المغني والشرح الكبير 12: 2، مغني المحتاج 4: 426، فتح القدير 6: 447، تبيين الحقائق 4: 207، كشاف القناع 6: 513.
لا منفردات عن الرجال، ولا منضمّات إليهم ; كما في الشرائع(1) والمختصر النافع(2)والتحرير(3) والقواعد(4) وغيرها(5) .
وفي جامع المقاصد : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الوصيّة بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات، ولا منضمّات»(6) .
وفي المسالك : « لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء ، منفردات في الولاية; لأنّها ليست وصيّة بمال ، بل هي تسلّط على تصرّف فيه ، ولا ممّا يخفى على الرجال غالباً ، وذلك ضابط محلّ قبول شهادتهنّ منفردات»(7) .
وقال في الجواهر في باب القضاء : « وأمّا حقوق الآدمي فثلاثة :
الأوّل منها : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ذكرين ، فلا يجزئ فيه النساء منضمّةً فضلاً عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد .
وفي الدروس : ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالاً ولا المقصود منه المال(8) .
وفي كشف اللثام : «وهو ما يطّلع عليه الرجال غالباً ، وما لا يكون مالاً ولا المقصود منه المال»(9) .
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 251 .
(2) المختصر النافع: 192.
(3) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
(4) قواعد الأحكام 2 : 568 .
(5) تذكرة الفقهاء 2 : 522، الطبعة الحجريّة ، مهذّب الأحكام 22 : 233 ، تحرير الوسيلة 2 : 103 ـ 104 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 205 .
(6) جامع المقاصد 11 : 310 .
(7) مسالك الأفهام 6 : 206 .
(8) الدروس الشرعيّة 2 : 137 .
(9) كشف اللثام 10: 326.
ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه »(1) .
وقال في باب الوصيّة: «قلت : كما أنّ ضابط قبولهنّ منضمّـات كون المشهود عليه مالاً لا ولايةً ، لكن يناقش بأنّها قد تتضمّن المال كما إذا أراد الوصيّ أخذ الاُجرة والأكل بالمعروف بشرطه ، وبأنّ الولاية وإن لم تكن مالاً لكنّها متعلّقة به، كبيعه وإجارته وإعارته ونحو ذلك ، ومن ذلك يتّجه القول بالقبول ; لعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر والاُنثى ولو بقاعدة الاشتراك ، اللّهمَّ إلاّ أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ومنضمّـات ، كما هي عساه يشعر في الجملة نفي الخلاف المزبور(2) مؤيّداً بعدم العثور على ما ينافيه»(3) .
ج ـ عدم إثباتها بشهادة العدل الواحد مع اليمين
الظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في أنّه لا تثبت الوصيّة بالولاية بشهادة العدل الواحد مع اليمين .
قال في التحرير : « أمّا الوصيّة بالولاية . . . لا تقبل فيها... الشاهد واليمين(4) » . وكذا في القواعد(5) والتذكرة(6) .
وفي الحدائق : « هو المشهور عند الأصحاب ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلاّ ما يظهر من المحقّق في الشرائع، حيث تردّد في ذلك »(7) .
-
(1) جواهر الكلام 41 : 159 .
(2) مقصوده نفي الخلاف المتقدّم في كلام الشهيد الثاني(رحمه الله) .
(3) جواهر الكلام 28 : 354 .
(4) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
(5) قواعد الأحكام 2 : 568 .
(6) تذكرة الفقهاء 2 : 522، الطبعة الحجريّة .
(7) الحدائق الناضرة 22 : 503 .
وقال الشهيد الثاني : « أمّا ثبوتها ـ أي ثبوت الوصيّة بالولاية ـ بشهادة
الواحد مع اليمين فقد تردّد فيه المصنّف، ثمّ استظهر المنع(1) .
وهو واضح ; لأنّ ضابطه ما كان من حقوق الآدميّ مالاً أو المقصود منه المال(2) . وولاية الوصاية ليست من أحدهما .
ويظهر وجه تردّده ممّا ذكرنا ، ومن أنّها قد تتضمّن المال ، كما إذا أراد أخذ الاُجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه ، ولما فيه من الإرفاق والتيسير ، فيكون مراداً للآية(3) والرواية(4) .
ولا يخفى ما فيه ، وقد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردّد ، ووافقهم المصنّف في مختصر الكتاب(5) على القطع، وأبدل هذا التردّد بالتردّد في ثبوت الوصيّة بالمال بشاهد ويمين ، وكلاهما كالمستغنى عنه ، للاتّفاق على الحكم والقاعدة المقيّدة للحكم فيهما »(6) .
وفي الرياض : «إنّ النصوص المزبورة كاتّفاق المحكيّ في المسالك وغيره متّفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق الماليّة»(7) .
وأشار إلى ذلك في الجواهر، ولكن أضاف في ذيل كلامه : «قلت : بل لعلّ الأصل أيضاً يقتضي عدم ثبوتها بعد قيام الأدلّة على اعتبار التعدّد في الشهادة،
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 151 .
(2) المبسوط للطوسي 8 : 189 .
(3) لعلّ المراد بها قوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة 2: 185.
(4) لعلّ المراد بها الإطلاقات الواردة في قبول الشاهد مع اليمين ، لاحظ الوسائل 18 : 191 الباب14 من أبواب كيفيّة الحكم .
(5) المختصر النافع : 192 .
(6) مسالك الأفهام 6 : 206 ـ 207 .
(7) رياض المسائل 6 : 317 .
وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في المقام ، فتأمّل جيّداً»(1) .
د ـ إثباتها بشهادة عدول أهل الذمّة : هل تقبل لإثبات الوصيّة بالولاية شهادة أهل الذمّة ؟ وجهان ، بل قولان :
الأوّل : عدم القبول ، ففي القواعد : «في قبول أهل الذمّة مع عدم عدول المسلمين نظر ، أقربه عدم القبول»(2) . وكذا في التذكرة(3) . واختاره فخر المحقّقين(4) .
وفي جامع المقاصد : «هل تثبت ـ أي الوصيّة بالولاية ـ بشهادة عدول أهل الذمّة مع عدم المسلمين ؟ فيه نظرٌ ، ينشأ من أنّ الوصيّة المتضمّنة لنقل الملك تثبت بشهادتهما ، فالوصيّة بالولاية التي هي عبارةٌ عن سلطنة التصرّف أولى; لأنّها أحقّ من نقل الملك ، ولأنّ ظاهر الآية(5) لا يأبى ذلك .
ومن أنّ قبول شهادة الكافر على خلاف الأصل ; لأنّه فاسقٌ ، فيجب التثبّت عند خبره ، ولا يجوز الركون إليه ; لأنّه ظالمٌ ، وقبول الشهادة ركونٌ .
والأقرب عند المصنّف عدم القبول; لضعف دليله فإنّ الأولويّة ممنوعةٌ. والنصّ إنّما نزل على الشهادة بالمال ، فلا يتجاوز به ذلك ، وهذا هو المختار»(6) .
وفي الجواهر : « إنّ مقتضى إطلاق الاية والرواية قبول شهادة أهل الذمّة فيها ، ولعلّه لذا ولأصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها في القواعد ، لكن قال : أقربه العدم ، ولعلّه كذلك اقتصاراً فيما خالف الضوابط الشرعيّة على المتيقّن ، ولا إطلاق
-
(1) جواهر الكلام 28 : 354 .
(2) قواعد الأحكام 2 : 568 .
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 522، الطبعة الحجريّة .
(4) إيضاح الفوائد 2 : 637 .
(5) سورة المائدة 5 : 106 .
(6) جامع المقاصد 11 : 310 ـ 311 .
في الأدلّة بحيث تطمئنّ به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال ، فلاحظ وتأمّل»(1) .
وهو الظاهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك(2). واختاره أيضاً في الحدائق(3) .
الثاني : إنّه لا فرق في قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع فقد المسلم بين كونها بالمال، أو بالولاية أو بهما معاً ، وفتاوى كثير من أصحابنا المتقدّمين مطلقة ، ولا اختصاص فيها بالمال، كما أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند عدم المسلمين ولم يقيّده بالمال(4) .
وكذا المفيد في المقنعة(5) والإسكافي(6) والعماني(7) والقاضي(8) وابنا
حمزة(9) وزهرة(10) والحلبي(11) وسلاّر(12) والكيدري(13) والمحقّق في الشرائع في
باب الشهادات(14) . وبه قال السيّد الخوئي(15)، إلاّ أنّ ابن إدريس قيّده
-
(1) جواهر الكلام 28 : 354 ـ 355 .
(2) مسالك الأفهام 6 : 206 .
(3) الحدائق الناضرة 22 : 499 .
(4) النهاية للطوسي : 334 ، المبسوط 8 : 187 ، الخلاف 6 : 272 .
(5) المقنعة : 727 .
(6 ، 7) مختلف الشيعة 8 : 519 مسألة 87 .
(8) المهذّب لابن البرّاج 2 : 557 .
(9) الوسيلة لابن حمزة: 372.
(10) غنية النزوع : 440 .
(11) الكافي في الفقه : 436 .
(12) المراسم العلويّة : 234 .
(13) إصباح الشيعة : 529 .
(14) شرائع الإسلام 4 : 126 .
(15) منهاج الصالحين 2 : 228 .
بالمال(1). وتبعه ابن فهد الحلّي(2). واختاره في الوسيلة(3) وتحريرها(4). وكذا في تفصيل الشريعة(5) .
نقول : مقتضى إطلاق الآية(6) والأخبار قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة بالولاية ، ومن الأخبار :
صحيحة ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : «لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ; لأنّه لايصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته»(7) .
وصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فقال : «إذا (إن خ ل) كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في (على خل) الوصيّة»(8) . . وغيرها(9) .
ومع ملاحظة التعليل الوارد فيها; من أنّ تجويز قبول شهادتهم إنّما نشأ من مراعاة الحقّ عن الذهاب ; فإنّ هذه العلّة موجودة في الوصيّة بالولاية أيضاً ، يلزم
-
(1) السرائر 2 : 139 .
(2) المهذّب البارع 4 : 511 .
(3) وسيلة النجاة 2 : 153 .
(4) تحرير الوسيلة 2 : 104 ، كتاب الوصية مسألة 63 .
(5) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 205 ـ 206 .
(6) سورة المائدة 5 : 106 .
(7) وسائل الشيعة 13 : 390 الباب 20 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(8) وسائل الشيعة 18 : 287 الباب 40 من كتاب الشهادات ، ح3 .
(9) نفس المصدر 13 : 390 ـ 392 الباب 20 من كتاب الوصايا ح3، و6 و7 وج 18/287 ، من كتاب الشهادات .
قبول شهادتهم .
وأيضاً وجود المقتضي ، وهو تعذّر عدول المسلمين المفضي إلى تعذّر إثبات الوصيّة ، وكذا ثبوت الوصيّة بالمال بشهادة أهل الذمّة ، وإثبات الوصيّة بالولاية بها يكون بالأولويّة ، فهذه الوجوه تدلّ على قبول شهادتهم، وأوجه الوجهين هو الوجه الثاني ، وبما أنّ للوجه الأوّل أيضاً وجهاً ، فيلزم أن لا يترك الاحتياط في المسألة .
فرع : يستحبّ الإشهاد على الوصيّة
قال في المقنعة : «وينبغي لمن أراد الوصيّة أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ; لئلاّ يعترض الورثة على الوصي من بعده»(1) .
وظاهر كلامه(قدس سره) استحباب الإشهاد لا وجوبه .
وفي النهاية : «ومن شرط الوصيّة أن يُشهِد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيّين لئلاّ يعترض فيها الورثة ، فإن لم يُشهِد أصلاً وأمكن الوصيّ إنفاذ الوصيّة، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه»(2) .
وصدر كلامه(قدس سره) وإن كان يوهم الاشتراط، إلاّ أنّ ذيله قرينة على عدمه .
نعم ، يدلّ كلامه(قدس سره) على الاستحباب . وبه قال ابن إدريس(3) .
وفي جامع للشرائع : «وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحّته إلى الشهادة سوى الطلاق وتوابعه»(4) . وكذا في مجمع الفائدة(5) .
-
(1) المقنعة : 667 .
(2) النهاية للطوسي : 612 .
(3) السرائر 3 : 207 .
(4) الجامع للشرائع : 543 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 511 .
وبالجملة : ليس الإشهاد من شرط صحّة الوصيّة إلى الموصى إليه ، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً لئلاّ ينازع الوارث فيها، كما في التذكرة(1) والتحرير(2) .
إثبات الوصيّة بالولاية عند أهل السنّة
يستفاد من كلماتهم أنّه مع اختلاف الورثة والوصيّ في مورد الوصيّة ، لا تثبت الوصيّة بالولاية إلاّ بشهادة عدلين ; لأنّه ذهب الجمهور منهم إلى أنّ ما يطّلع عليه الرجال غالباً ممّا ليس بمال ولا يقصد منه المال ، كالنكاح والطلاق والوكالة . . . والوصاية ونحوها ; فإنّه لا يثبت إلاّ بشاهدين، ولا تثبت بشاهد ويمين، ولابشاهد وامرأتين(3) .
ففي التهذيب : الوصاية لا تثبت إلاّ برجلين عدلين(4) .
وقال الغزالي : «ما عدا الزنا ممّا ليس بمال ولا يؤول إلى مال، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق . . . حتّى الوصايا والوكالة فيثبت برجلين ، ولايثبت برجل وامرأتين»(5) .
وجاء في البيان : «وأمّا حقوق الآدميّين، فتنقسم على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما هو مال أو المقصود منه المال ، مثل البيع والرهن والضمان . . .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 521، الطبعة الحجريّة .
(2) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
(3) منهاج الطالبين 3 : 441 ، البيان في فقه الشافعيّ 13 : 330 ، التهذيب في فقه الشافعيّ 8 : 218 ، نهاية المحتاج 8 : 312 ، مغني المحتاج 4 : 442 ، الوجيز 2 : 250 ، حلية العلماء 8 : 276 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 153 ، المغني 12 : 7 ، الشرح الكبير 12 : 90 ، حاشية الخرشي 8 : 50 ، بلغة السالك والشرح الصغير 4 : 121 ، العزيز شرح الوجيز 13 : 48 ، الإقناع 4 : 445 ، كشّاف القناع 6 : 549 ، الإنصاف 12 : 68 .
(4) التهذيب في فقه الشافعي 8 : 218 .
(5) الوجيز 2 : 250 .
والوصيّة له وما أشبهه ، فهذا يثبت بشاهدين أو بشاهد وامرأتين ; لقوله ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْن . . .) الآية(1) .
القسم الثاني : ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطّلع عليه الرجال ، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصيّة إليه . . . فلا تثبت إلاّ بشاهدين ، ولاتثبت بشاهد وامرأتين . وبه قال الزهري والنخعي ومالك»(2) .
وقال الدسوقي : «ودعوى أنّه وصيّ في غير المال، كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج بناته ، لا تثبت إلاّ بعدلين . وأمّا دعوى أنّه وكيل أو وصيّ على التصرّف في المال ، فإن كان نفع يعود على الوصيّ أو الوكيل كفى العدل، والمرأتان مع يمين من أحدهما ، فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلاّ بعدلين، أو عدل وامرأتين»(3) .
وكذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصيّة بالولاية ; لأنّ الأصل في الشاهد أن يكون مسلماً ، فلا تُقبل شهادة الكفّار على المسلم ; لقوله تعالى : (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)(4) وقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ)(5). والكافر ليس بعدل ، وليس منّا ; ولأنّه أفسق الفسّاق ويكذب على الله تعالى، فلا يؤمن منه الكذب على خلقه . وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكيّة والشافعيّة والحنفية(6) .
-
(1) سورة البقرة 2 : 282 .
(2) البيان في فقه الشافعي 13 : 330 .
(3) حاشية الدسوقي 4 : 187 .
(4) سورة البقرة 2 : 282 .
(5) سورة الطلاق 65 : 2 .
(6) أسنى المطالب 4 : 339 ، تبيين الحقائق 4 : 224 ، التهذيب في فقه الشافعيّ 8 : 258 ، منهاج الطالبين 3 : 427 ، البيان 13 : 277 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 349 ، حلية العلماء 8 : 248 ، مختصر المزني : 311 ، مغني المحتاج 4 : 427 ، نهاية المحتاج 8 : 292 .
وجاء في المدوّنة : قلت : «أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحدٌ من أهل الإسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصيّة ؟ قال : لم يكن مالكٌ يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . وقال أيضاً : وقد ردّ شهادة أهل الذمّة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) والتابعين»(1) .
وقال في المغني : « وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تُقبلُ شهادة أهل الذمّة في الوصيّة في السفر ; لأنّ من لا تُقبَلُ شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق،ولأنّ الفاسق لاتقبل شهادته،فالكافرأولى»(2).وكذافي الوجيز(3).
ولكن ذهب الحنابلة إلى أنّه تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصيّة في السفر .
ففي المقنع : «لا تقبل شهادة كافر إلاّ أهل الكتاب في الوصيّة في السفر»(4) .
وجاء في الإقناع: «لا تقبل شهادة كافر ولو من أهل الذمّة ولو على مثله ، إلاّ رجال أهل الكتاب بالوصيّة في السفر ممّن حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم ، فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط»(5) . وكذا في كشّاف القناع(6) والمغني(7)والشرح الكبير(8) والكافي(9) والإنصاف(10) .
-
(1) المدوّنة الكبرى 5 : 156 ـ 157 .
(2) المغني 12 : 51 ، الشرح الكبير 12 : 35 .
(3) الوجيز 2: 248.
(4) المقنع لابن قدامة : 346 .
(5) الإقناع 4 : 436 .
(6) كشّاف القناع 6 : 528.
(7) المغني 12: 51 .
(8) الشرح الكبير 12 : 35 .
(9) الكافي في فقه أحمد 4 : 271 .
(10) الإنصاف 12 : 34 .
وجاء في الجامع لأحكام القرآن : «تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصيّة ، وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرّر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل : أبو موسى الأشعري ، وعبدالله بن قيس ، وعبدالله بن عبّاس»(1) .
- (1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 349 .
المبحث الثامن : الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها
الوصيّة سواءكانت بالمال أو بالولاية، عقدجائز من الطرفين ، ويجوز للموصي والوصيّ الرجوع فيها ، ولكن هناك حالات تلزم الوصيّة فيها ولا يجوز ردّها .
وبتعبير آخر : يستثنى من هذه القاعدة ـ جواز ردّ الوصيّة ـ موارد لا يجوز ردّ الوصيّة فيها . وللتحقيق فيه نقسّم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة نذكرها على الترتيب التالي :
المطلب الأوّل : رجوع الموصي عن الوصيّة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية وغيرها ، فلو أوصى إلى رجل بالقيام باُمور صغاره جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّاً، ويوصي إلى غيره، وأن يُشرك معه غيره .
كما في الوسيلة(1) والسرائر(2) وكشف الرموز(3) والتحرير(4) والدروس(5)والروضة(6) وغيرها(7) .
-
(1) الوسيلة لابن حمزة : 373 .
(2) السرائر 3 : 192 .
(3) كشف الرموز 2 : 80 .
(4) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 383 .
(5) الدروس الشرعية 2: 329.
(6) الروضة البهيّة 5 : 81 .
(7) غنية النزوع: 306، إصباح الشيعة: 354، الكافي في الفقه : 366 ، المختصر النافع : 191 ، شرائع الإسلام 2: 244، الحدائق الناضرة 22: 402، التنقيح الرائع 2 : 368 ، جامع المقاصد 11 : 282 ، مسالك الأفهام 6: 135، تحرير الوسيلة 2 : 102 مسألة 60 ، مهذّب الأحكام 22 : 229 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 226 .
ففي المقنعة : «وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّاً ، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغيّر وصيّته ولا يستبدل بأوصيائه»(1) .
وفي النهاية : «وللإنسان أن يرجع في وصيّته ما دام فيه روح، ويغيّر شرائطها وينقلها من شيء إلى شيء ومن إنسان إلى غيره، وليس لأحد عليه فيه اعتراض»(2).
وفي الشرائع : «الوصيّة عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً; سواء كانت بمال أو ولاية»(3) .
وفي التذكرة : «حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي ، فله الرجوع في وصيّته متى شاء ، كما كان له الرجوع في وصيّته بالمال ، ولا نعلم فيه خلافاً ، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه ، وتخصيص ولايته وتعميمها وإدخال غيره معه ، وإخراج من كان معه»(4) .
وجاء في تفصيل الشريعة : « فله أن يرجع فيها مادام فيه الروح كلاّ أو بعضاً من جهة الكميّة أو الكيفيّة ، كما أنّ له تغيير الوصي والموصى له وغير ذلك ، غاية الأمر أنّه لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ... وكما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في القيّم وفي الاُمور التي يتصدّاها »(5) .
أدلّة جواز الرجوع من الوصيّة
وقد استدلّ لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : الإجماع
-
(1) المقنعة : 669 .
(2) النهاية للطوسي : 609 .
(3) شرائع الإسلام 2 : 244.
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة .
(5) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 201 ـ 202 .
ففي التذكرة : «إنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين ، فللموصي الرجوع في وصيّته; سواءكانت الوصيّة بمال أو منفعة أو ولاية، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك»(1).
وفي المسالك : «لا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته ما دام حيّاً ، لأنّه ماله وحقّه»(2) .
وكذا في الجواهر، وزاد : «بل الإجماع بقسميه عليه»(3) .
الثاني : أنّ الوصيّة من العقود غير اللازمة، فيجوز الرجوع فيها(4) .
الثالث : النصوص المستفيضة :
منها : صحيحة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض»(5) .
ومنها : صحيحة بريد العجلي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً»(6) .
وكذا غيرهما من النصوص الكثيرة بل المتواترة(7) .
ودلالة الروايات على جواز الوصيّة من قبل الموصي ، وأنّ من حقّه الرجوع عنها وتبديلها متى شاء ثابتةٌ بوضوح .
المطلب الثاني : رجوع الموصى إليه عن الوصيّة
لا خلاف أيضاً في أنّه لا يجب على الوصيّ قبول الوصيّة ; سواء كانت الوصيّة
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 514، الطبعة الحجريّة .
(2) مسالك الأفهام 6 : 135 .
(3) جواهر الكلام 28 : 265 .
(4) التنقيح الرائع 2 : 368 .
(5 ، 6) وسائل الشيعة 13 : 386 الباب 18 من كتاب الوصايا ، ح3 و4 .
(7) وسائل الشيعة 13 : 381ـ 389 الباب 17 ـ 19 من كتاب الوصايا .
بالولاية أم غيرها ، بل كان بالخيار في القبول وردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ(1) .
ففي النهاية : «إذا وصّى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها إذا كان الوصيّ حاضراً وشاهداً ، فإن كان الموصى إليه غائباً كان له ردّ الوصيّة مادام الموصي حيّاً»(2) . وكذا في المقنعة(3) .
وقال الصدوق في المقنع : «وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهدٌ فله أن يمتنع من قبول وصيّته»(4) .
وفي الحدائق : «لا خلاف بين الأصحاب رضي الله عنهم في أنّ للوصيّ أن يردّ الوصاية ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه ذلك»(5) .
أدلّة جواز ردّ الوصيّة للوصيّ
وقد استُدِلَّ لهذا الحكم باُمور :
الأوّل : الأصل كما في الروضة(6) والجواهر(7) . وفي المهذّب : «لأصالة عدم
-
(1) الوسيلة لابن حمزة : 373 ، الكافي لأبي الصلاح : 366 ، المهذّب للقاضي 2 : 117 ، إصباح الشيعة : 356 ، السرائر 3 : 191 ، المختصر النافع : 191 ، شرائع الإسلام 2 : 257 ، الجامع للشرائع : 493 ، قواعد الأحكام 2 : 565 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 379 ، تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة ، الدروس الشرعيّة 2 : 325 ، كشف الرموز 2 : 80 ، مسالك الأفهام 6 : 255 ، جامع المقاصد 11 : 282 ، وسيلة النجاة 2 : 149 ، تحرير الوسيلة 2 : 90 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 182 .
(2) النهاية للطوسي : 607 .
(3) المقنعة : 672 .
(4) المقنع : 483 .
(5) الحدائق الناضرة 22 : 574 .
(6) الروضة البهيّة 5 : 81 .
(7) جواهر الكلام 28 : 415 .
الوجوب في كلّ ما لم يثبت وجوبه بدليل معتبر»(1) .
الثاني : إطلاق الفتاوى بعدم الوجوب وإرساله إرسال المسلّمات ، وعدم استنكار عدم القبول عند المتشرّعة في الجملة ، ولو كان واجباً مطلقاً لشاع وبانَ في هذا الأمر العام البلوى(2) .
الثالث : ما ذكره في المسالك من «أنّ الوصاية إذنٌ للوصيّ في التصرّف المخصوص ، فله أن لا يقبل هذا الإذن كالوكالة»(3) .
الرابع : الإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمسالك(4) .
الخامس ـ وهو العمدة ـ : الأخبار الواردة في هذا المقام ، التي تدلّ بظاهرها عليه :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إن أوصى رجلٌ إلى رجل وهو غائبٌ فليس له أن يردّ وصيّته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاءَ قَبِلَ وإن شاء لم يقبل»(5) .
قال في تفصيل الشريعة : « الظاهر أنّ التفصيل بين الغيبة والحضور في البلد إنّما هو بملاحظة إمكان بلوغه الردّ وعدمه ، وإذا كان الأمر في الغيبة كذلك ففي صورة الموت بطريق أولى »(6) .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل يوصي إليه ، قال : «إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره
-
(1) مهذّب الأحكام 22 : 213 .
(2) مهذّب الأحكام 22 : 213 .
(3) مسالك الأفهام 6 : 255 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة ، مسالك الأفهام 6 : 256 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(6) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 183 .
فذاك إليه»(1) .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائبٌ فليس له أن يردّ عليه وصيّته ; لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره»(2) وكذا غيرها(3) .
هذه الروايات تدلّ على جواز ردّ الموصى إليه الوصيّة في حياة الموصي إمّا بالإطلاق أو بالعموم ، وعلى عدم وجوب القبول .
نعم ، يستحبّ ذلك لمن يثق من نفسه بالكفاية والأمانة ; لأنّه من باب التعاون والتناصر .
قال الفاضل المقداد : «لا كلام أنّه مع عجزه وعدم كفايته لا يجب عليه ، بل ولا يستحبّ ; لعدم حصول الغرض، خصوصاً إذا لم يثق من نفسه بالأمانة ; فإنّها تحرم قطعاً»(4) .
المطلب الثالث : موارد عدم جواز ردّ الوصيّة فيها
تمهيد
شرّع الله تبارك وتعالى الوصيّة ليتدارك بها المؤمن ما فاته من فعل الخير ، وليتبرّع بما تيسّر له ممّا أفاء الله عليه من الثروة والمال ، قال ـ تعالى ـ : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ اْلأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(5) وهكذا شرّع الوصيّة اهتماماً بشؤون الأيتام والصغار .
-
(1) تهذيب الأحكام 9 : 159 ح654 ، وسائل الشيعة 13: 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح3.
(3) نفس المصدر .
(4) التنقيح الرائع 2 : 392 .
(5) سورة البقرة 2 : 180 .
بتعبير آخر : الإسلام اهتمّ بأمر الأيتام والصغار أشدّ الاهتمام ، ولم يتركهم بعد موت آبائهم واُمّهاتهم سدىً وبلا وليّ بأيّ حال من الأحوال ، ولذا أوجب قبول الوصيّة والقيمومة للأطفال، وحرّم ردّها على بعض الناس ، حيث إنّ جواز ردّ الوصيّة وعدم قبول قيمومة الصغار في الموارد التي نتلوها عليك قريباً ، كان موجباً لترك الصغار بلا وليّ وقيّم، والإضرار بهم وإتلاف أنفسهم وأموالهم ، وهذا ممّا لا يرضى به الشارع الرؤوف بالأيتام والصغار قطعاً .
وبالجملة : يستثنى من جواز ردّ الوصيّة موارد لا يجوز فيها الردّ، بل يجب للوصيّ القيام بها ، نذكرها فيما يلي :
الأوّل والثاني : عدم جواز ردّ الوصيّة بالولاية من الموصى إليه بعد موت الموصي ، وكذا لا يجوز الردّ إذا كان الردّ في حال حياة الموصي ، ولكن لا يبلغه حتّى مات ; لأنّ جواز ردّ الوصيّة مشروط بأن يكون الموصي حيّاً كما تقدّم ، فإذا كان بين الموصي والوصيّ مسافة ومات الموصي قبل الردّ ، أو امتنع الموصى إليه من قبول الوصيّة في حال حياته ولكن لم يبلغه خبره حتّى مات ، لم يكن للردّ أثر وكانت الوصيّة لازمة ، ويجب على الموصى إليه القيام بها . كما في المقنعة(1)والنهاية(2) والسرائر(3) والشرائع(4) وغيرها(5) .
ونسبه العلاّمة في التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب(6). وفي الحدائق
-
(1) المقنعة : 672 .
(2) النهاية للطوسي : 607.
(3) السرائر 3 : 185 و 191 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(5) الكافي في الفقه : 366 ، الوسيلة لابن حمزة : 373 ، الجامع للشرائع : 493 .
(6) تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة .
إلى المشهور(1) . وبذلك روايات كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة(2); لأنّ المراد من قوله(عليه السلام) : «وهو غائبٌ فليس له أن يردّ وصيّته» أنّه مات الموصي في تلك الغيبة قبل أن يُعلِمَهُ الوصي بالقبول أو الردّ ; فإنّه يجب القيام بالوصاية وإن لم يقبل .
ومنها : صحيحة الفضيل(3) ، والتقريب فيها ما تقدّم في الصحيحة السابقة; بمعنى أنّه مات الموصي بعد البعث وقبل وصول الجواب إليه بالقبول والردّ .
وحاصله : أنّه إذا أوصى إلى رجل وهو غائبٌ عن البلد ثمّ مات ، لزمه القيام بالوصية قَبلَ أو رَدَّ .
وكذا صحيحة منصور بن حازم(4) .
ويؤيّده ما رواه في الفقه الرضوي : «إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصيّة ، وإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ; فإنّ الوصيّة لازمةٌ للموصى إليه»(5) .
وقال في الحدائق : لو لم يبلغ الردُّ الموصيَ ، أو لم يبلغه الخبر إلاّ بعد موت الموصي ; فإنّه ليس له الردّ ، بل يجب عليه القبول ، وحينئذ فالحكم في هذه الصورة كما في الصورة الاُولى ; أعني موت الموصي بعد قبول الوصي ; فإنّه ليس للوصيّ الردّ بعد موته اتّفاقاً(6) .
ولكن ذهب في التحرير إلى جواز الرجوع في حياة الموصي وبعده(7) .
وقال في المختلف : «أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصية إذا لم يعلم الوصيّ
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 576 .
(2 ـ 8 ـ 9) وسائل الشيعة 13 : 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح1 ـ 3 .
(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 298 ، مستدرك الوسائل 14 : 110 الباب 22 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(6) الحدائق الناضرة 22 : 576 .
(7) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 380 .
بها حتّى يموت الموصي ، أو يعلم ويردّ ولما يعلم الموصي بالردّ . . . والوجه عندي: المصير إلى ذلك إن كان قد قبل الوصية أوّلاً ، وإن لم يكن قَبِلَ ولا عَلِمَ ، جاز له الرجوع ـ إلى أن قال : ـ وقد نبّه الشيخ في المبسوط(1) ومسائل الخلاف(2) عليه ، فقال : إذا قبل الوصيّة ، له أن يردّها ما دام الموصيّ حيّاً ، فإن مات فليس له ردّها .
واستدلّ بإجماع الفرقة ، وبأنّ الوصيّة قد لزمته بالقبول»(3) .
ومال إليه المحقّق والشهيد الثانيان(4) .
واستدلّ لهذا الحكم بوجوه :
أ ـ الأصل ; أي عدم لزوم الوصيّة على الموصى إليه .
ب ـ آية نفي الحرج(5)، وحديث لا ضرر(6); بمعنى أنّ إثبات الوصيّة ووجوب القيام بها على الوصي على وجه قهريّ ضرر وحرج عليه(7) ، وهما منفيّان بالآية والحديث .
ج ـ أ نّ تسليط الموصي على إثبات وصيّته على من شاء بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصيّة إلى حين موته ممّا ينافي اُصول المذهب ، ولا يعرف له في الشرعيّات مثل ، كما في جامع المقاصد(8) .
-
(1) المبسوط للطوسي 4 : 37 .
(2) الخلاف 4 : 148 المسألة 21 .
(3) مختلف الشيعة 6 : 299 ـ 300 .
(4) جامع المقاصد 11 : 284 ، مسالك الأفهام 6 : 258 .
(5) سورة الحجّ 22 : 78 .
(6) الكافي 5 : 28 ح4 وص 294 ، ح8 ، الفقيه 3 : 45 ، ح154 وص 147 ح648 ، تهذيب الأحكام 7 : 146 ، ح651 وص 164 ح727 .
(7) والدليلان إنّما يدلاّن على عدم لزوم القيام بالوصيّة في فرض الحرج والضرر، ولكن لا يدلاّن على جواز الرّد، فتدبر. م ج ف.
(8) جامع المقاصد 11 : 285 .
د ـ قال في المسالك : هذه الأخبار ليست صريحة في المدّعى ; لتضمّنها أنّ الحاضر لا يلزمه القبول مطلقاً، والغائب يلزمه مطلقاً، وهو غير محلّ النزاع .
نعم ، في تعليل الرواية المتقدّمة ـ حسنة هشام بن سالم ـ إيماء إلى الحكم، إلاّ أنّ إثبات مثل هذا الحكم المخالف للاُصول الشرعيّة ـ بإثبات حقّ الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر، وتسليط الموصي على إثبات وصيتّه على من شاء، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصيّة إلى حين موته ، ويدخل على الوصيّ الحرج والضرر غالباً ـ بمجرّد هذه العلّة المستندة إلى سند غير واضح بعيد ، ولو حملت هذه الأخبار على سبق القبول، أو على شدّة الاستحباب كان أولى(1) .
نقول : كلام الشيخ(رحمه الله) في المبسوط والخلاف ليس صريحاً في ذلك ، بل أنّه(قدس سره)لم يتعرّض للصورة التي لم يقبل الوصيّ فيها الوصيّة ، أو لم يعلمها حتّى مات الموصي ، ولعلّ إطلاق كلامه يشمل كلتا الصورتين: القبول وعدمه، حيث قال : «وليس له ردّها بعد وفاته» .
أمّا الأصل، فلا مورد له لوجود الدليل .
وأمّا الضرر والمشقّة، فإن أراد بالضرر والمشقّة مطلق المشقّة فلا نسلّم أنّ ذلك موجب للردّ ، فإنّ التكاليف كلّها ملزومة للمشقّة، كما في التنقيح الرائع(2) ، مضافاً إلى أنّا نمنع حصول الضرر والحرج الموجب للردّ بمجرّد الوصيّة إليه .
وإن أراد بالضرر والحرج ما تؤدّي إليه الوصيّة من ضرر دينيّ، أو دنيويّ، أو مشقّة لا يتحمّل مثلها عادةً، أو لزم من تحمّلها عليه ما لا يليق بحاله من شتم ونحوه ـ كما فرضه الشهيد الثاني في آخر كلامه ـ فذلك داخل في قسم العجز، وسيأتي حكمه، ويجوز له الرجوع دفعاً للضرر عن نفسه أو عرضه .
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 258 .
(2) التنقيح الرائع 2 : 393 .
وأمّا ما ذكره ـ أي الشهيد ـ من أنّ إثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعيّة بإثبات حقّ الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر ، فأجاب عنه في الحدائق : بـ «أنّه إذا ثبت ذلك بالأدلّة الصحيحة; فإنّه يجب تخصيص الاُصول التي ذكرها بهذه الأخبار ـ المتقدّمة ، ولا تقاوم مع هذه الأخبار ـ التي عمل بها الأصحاب ـ ولم يبق حينئذ إلاّ مجرّد الاستبعاد العقلي الذي فرضه ـ أي الشهيد الثاني(قدس سره)ـ وهو غير مسموع في مقابلة الأخبار، سيّما مع صحّتها وتكاثرها ووضوح دلالتها»(1) .
وأمّا حمل الأحاديث على سبق القبول; فإنّه غير موجّه ، لأنّه تأويل لا يحتمله لفظ الحديث ، لأنّ الواو في قوله(عليه السلام) : «وهو غائب» للحال ، فيقيّد الإيصاء بغيبة الوصيّ، فلا يتقدّر قبوله قبل الموت بناءً على الظاهر ، وإنّما يتقدّر لو كان حاضراً فأوصى إليه وقبل ثمّ سافر وردّ في غيبته ، لكن ذلك لا يحتمله لفظ الحديثين، كما أشار إليه في التنقيح الرائع(2) .
وأمّا ما ذكره من «أنّ هذه الأخبار ليست صريحة في المدّعى ، لتضمّنها أنّ الحاضر لا يلزمه القبول مطلقاً، والغائب يلزمه مطلقاً ، وهو غير محلّ النزاع»(3) .
ففيه أوّلاً : أنّ الغيبة والحضور كناية عن بلوغ الردّ إلى الموصي وهو حيّ ، للإجماع على مدخلية الردّ الذي يبلغ إلى الموصي(4) .
وقال ابن زهرة: «لا يجوز للمسند إليه ـ الموصى إليه ـ ترك القبول إذا بلغه ذلك
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 578 .
(2) التنقيح الرائع 2 : 393 .
(3) مسالك الأفهام 6 : 258 .
(4) جواهر الكلام 28 : 417 .
بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوّض إليه من ذلك، إذا لم يقبل وردّ فلم يبلغ الموصي ذلك حتّى مات ، بدليل إجماع الطائفة»(1) .
فالمراد بالغيبة والحضور في النصوص إمكان وصول الردّ إليه عرفاً وعدم الإمكان كذلك ، ولا موضوعيّة لنفس الغيبة والحضور من حيث ذاتهما .
وثانياً : مقتضى التعليل الوارد في صحيحة منصور بن حازم بقوله(عليه السلام) : «لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره»(2)أنّ صحّة الردّ مشروطة ببلوغ خبر الردّ إلى الموصي .
وثالثاً : عدم الصراحة لو سلّم لا ينفي أصل الاستدلال ، إذ أكثر الفقه مبنيّ على الظواهر(3) .
ويؤيّده فتاوى الأصحاب وما رواه في فقه الرضوي المتقدِّم، حيث ورد في ذيلها «وإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ; فإنّ الوصية لازمة للموصى إليه»(4) .
وقال في الدروس ـ بعد نقل كلام العلاّمة في المختلف : يجوز الردّ إذا لم يعلم بالوصيّة حتّى مات للحرج والضرر ـ : «ولم نعلم له موافقاً عليه . . . وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الردّ ، فلا عبرة بقبول الوصيّ وعدمه ، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ الموصي، فإن حصل وإلاّ التزم»(5) .
وقال المحقّق الفقيه القمّي ـ بعدما حكى كلام العلاّمة والشهيد الثاني(قدس سرهما) وما استدلاّ به ـ : «وأنت تعلم أنّ الظهور كاف في الاستدلال ، والعمومات والأصل
-
(1) غنية النزوع : 306 .
(2) وسائل الشيعة 13: 398 الباب 23 من كتاب الوصايا، ح3.
(3) جواهر الكلام 28 : 419 .
(4) الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 298 .
(5) الدروس الشرعيّة 2 : 326 .
وغيرهما لا تعارض مع النصوص الخاصّة التي عمل بها الأصحاب ، خصوصاً مع دعوى الإجماع عليه»(1) .
وجاء في المستمسك : ومقتضى تلك الأخبار أنّه يجب العمل بالوصيّة على الموصى إليه إذا لم يردّ، أو إذا ردّ ولكن لم يبلغ الموصي الردّ(2) .
وأمّا ضعف سند رواية منصور بن حازم فغير واضح ; لأنّ طريق الصدوق إلى عليّ بن الحكم صحيحٌ ـ كما في المشيخة ـ وعلي بن الحكم بن الزبير وعلي بن الحكم الأنباري وعلي بن الحكم الكوفي الذي وثّقه الشيخ متّحد ، وهم شخص واحد كما صرّح بذلك الوحيد البهبهاني(3) والسيّد الخوئي(4) والعلاّمة التستري(5) . وذكروا القرائن للاتّحاد ، ولم نذكرها للاختصار .
فالأقرب ما ذهب إليه المشهور من أنّه لا يجوز للوصيّ ردّ الوصيّة بعد وفاة الموصي ; سواء مات قبل الردّ، أو بعده ولم يبلغه الردّ وكانت الوصيّة لازمة للموصى إليه ، ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر والحرج دون غيره ، وأمّا استثناء ما عجز عنه فواضح، كما في الروضة(6) .
وفي المهذّب : «والمنساق من مجموعها ـ بعد ردّ بعضها إلى بعض ـ أنّ القبول بحسب الذات من حقوق الاُخوّة الإيمانيّة بل الإنسانيّة ; لأنّه من مصاديق قضاء الحوائج وفرع قبول الهديّة والعطيّة ، فكما أنّ قضاء حاجة المؤمن وقبول هديّته
وعطيّته راجحة بحسب الذات ، ويتّصف بالوجوب تارةً والحرمة اُخرى لعوارض
-
(1) جامع الشتات 4 : 233 .
(2) مستمسك العروة الوثقى 14 : 536 .
(3) تعليقات على منهج المقال : 231 .
(4) معجم رجال الحديث 11 : 344 ، الرقم 8087 .
(5) قاموس الرجال 7 : 447 ، الرقم : 5118 .
(6) الروضة البهيّة 5 : 82 .
خارجة ، فكذا قبول الوصيّة، فهو راجح بذاته ، وقد يجب إن لزم من ردّها ضرر
وتضييع حقّ الموصي ، وقد يحرم إن لزم من قبولها ضرر على الوصي»(1) .
المورد الثالث : وهو أن لا يستطيع الموصي أن يُوصِي إلى شخص آخر . وبعدما عرفت أنّه يُشتَرَطُ في جواز الردّ في حال الحياة بلوغ الخبر إلى الموصي ، يقع الكلام في أنّه لو بلغه الخبر ، ولكن لم يمكنه إقامة وصيٍّ غيره ، فهل يكفي في جواز الردّ مجرّد بُلوغِ الخبر وإن لم يوجد وصيٌّ غيره ، أو لابدّ من تقييده بإمكان وجود وصيّ آخر؟ فيه وجهان :
الأوّل : أنّه يكفي مجرّد بلوغ الردّ إلى الموصي ، ولا يشترط في جواز الردّ أمر آخر ، وهو ظاهر إطلاق الفتاوى ، حيث إنّها لم تكن مقيّدة بتمكّن الموصي من إقامة وصيّ آخر .
الثاني : أنّه يُشتَرَط ـ مع بلوغ الردّ إلى الموصي ـ إمكانُ إقامته وصيّاً غيره .
وبه قال في المسالك(2) والرياض(3) والجواهر(4) . وقال السيّد الخوئي : «يجوز للموصى إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردُّ ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً»(5) .
وبه قال الإمام الخميني(6). وكذا في تفصيل الشريعة(7) .
وجاء في مباني المنهاج : «هل يجوز الردُّ مع عدم إمكان جعل غيره وصيّاً ؟
-
(1) مهذّب الأحكام 22 : 213 .
(2) مسالك الأفهام 6 : 256 .
(3) رياض المسائل 9 : 493 .
(4) جواهر الكلام 28 : 417 .
(5) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 224 .
(6) تحرير الوسيلة 2 : 98 مسألة 41 .
(7) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 182 .
لايبعد أن يستفاد من نصوص الباب وجوب القبول وعدم جواز الردّ في هذه
الصورة»(1) .
وبالجملة : هذا هو الظاهر من النصوص :
منها : صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : «لا يخذله على هذه الحال»(2) .
قال المحدّث البحراني : ومقتضاها أنّه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الردّ(3) .
نقول : لعلّ مراده(عليه السلام) من قوله : «هذه الحال» حال عدم وجود الغير ، ولكن لا قرينة عليه .
ومنها : صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة ; لأنّ قوله(عليه السلام) فيها : «وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه»(4). وكذا قوله(عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم : «لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره»(5)ظاهران في تعليق جواز الردّ على وجود الغير ، فلو لم يوجد الغير لقبول الوصيّة لم يجز له الردّ .
ونِعم ما قال في المسالك بعد نقل الرواية : «فإنّ العلّة المنصوصة تتعدّى على الأقوى، ولانتفاء الفائدة بدونه ، فعلى هذا لو كان حيّاً ولكن لم يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصحّ الردّ»(6) .
والحاصل : أنّه إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يجعله وصيّاً ، جاز للوصي ردّ الوصيّة ، وأمّا إذا لم يكن هناك شخص آخر يقبل ويتحمّل مسؤولية الوصيّة ،
-
(1) مباني منهاج الصالحين 9 : 326 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 399 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح4 .
(3) الحدائق الناضرة 22 : 580 .
(4 و7) وسائل الشيعة 13 : 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح2 و3 .
(6) مسالك الأفهام 6 : 256 .
أو كان الأشخاص الذين يمكن أن يوصى إليهم لا يمكن الاعتماد بهم ، فالوصيّة هنا تلزم على الوصي ; سواء قبِلها أم لم يَقبلها .
أمّا لو أمكن للموصي نصب وصيّ آخر ولكن كان المنصوب غائباً ، بحيث يتوقّف ثبوت وصايته على البيِّنة ، ولم يحضر الموصي من تثبت به الوصاية ، ففي تنزيله منزلة عدم التمكّن من الوصاية وجهان : من حصول أصل القدرة وتحقّق الشرط ، ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته(1) . وبه قال في الجواهر(2) .
المورد الرابع : أن يكون الموصي أباً وقد أوصى إلى ابنه ، قال الصدوق في المقنع : «وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيّته ، فليس له أن يأبى»(3) .
وفي الدروس(4) : «وقال الصدوق إذا أوصى إلى ولده وجب القبول، وكذا إلى أجنبيّ إذا لم يجد غيره ، وهما مرويّان قويّان»(5) .
ويظهر من المختلف الميل إليه في آخر كلامه ، حيث قال : «وبالجملة: فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله(رحمه الله)»(6). وبه قال أيضاً في الوسائل(7) ومستدرك الوسائل(8) والرياض(9) والحدائق(10). واحتاط وجوباً في تحرير الوسيلة(11) وكذا في
-
(1) نفس المصدر : 256 ـ 257 .
(2) جواهر الكلام 28 : 415 .
(3) المقنع : 479 .
(4) الدروس الشرعيّة 2 : 326 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 398 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح2 وص400 ب24 ، ح1 .
(6) مختلف الشيعة 6 : 362 .
(7) وسائل الشيعة 13: 400 الباب 24 من كتاب الوصايا، ح1.
(8) مستدرك الوسائل 14 : 111 الباب 23 .
(9) رياض المسائل 6 : 277 .
(10) الحدائق الناضرة 22 : 579 .
(11) تحرير الوسيلة 2 : 98 .
التفصيل الشريعة(1) .
واستُدِلّ لهذا الحكم بمكاتبة علي بن الريّان «رئاب خ ل يه» قال : كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع(عليه السلام) : «ليس له أن يمتنع»(2) ; فإنّ قوله(عليه السلام) : «ليس له أن يمتنع» صريح في أنّه لا يجوز للولد ردّ وصيّة والده .
واستدلّ العلاّمة في المختلف بأنّ امتناع الولد عن قبول وصيّة والده نوع عقوق(3) .
وفي الرياض : «وهو كذلك ـ أي لا بأس بقول الصدوق ـ إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، ولا يمكن دعواه ـ أي الإجماع ـ بإطلاق عبائر الأصحاب بجواز الردّ مطلقاً ; لعدم تبادر المقامين(4) منه جدّاً»(5) .
وقد أورد على الاستدلال لهذا القول في الجواهر(6) والمهذّب(7) وغيرهما(8)إيرادات وأطالوا الكلام فيها ، ولكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث ، حيث إنّه
وإن لم يثبت وجوب قبول وصية الأب على الولد بمقتضى الأدلّة التي استندوا بها لإثبات هذا القول ، لكن لا شكّ في أنّه إن أمر الوالد ولده بأن يقبل وصيّته، أو كان عدم قبوله على وجه يؤذيه ، يجب عليه قبولها ولا يجوز ردّه قطعاً ; لأنّ ردّ الوصية
-
(1) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 182 .
(2) وسائل الشيعة 13 : 400 الباب 24 من كتاب الوصايا ، ح1 .
(3) مختلف الشيعة 6 : 362 .
(4) أي في وصيّة الأب لولده، وللأجنبي إذا لم يوجد غيره .
(5) رياض المسائل 6 : 277 .
(6) جواهر الكلام 28 : 416 وما بعده .
(7) مهذّب الأحكام 22 : 214 وما بعده .
(8) الفقه للشيرازي، كتاب الوصيّة: 343.
في هذا الحال نوع عقوق للوالد ، وهو حرام، كما هو ظاهر بعض النصوص أيضاً ، مثل ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر(عليه السلام) إلى جعفر وموسى: «وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما» الحديث (1).
وهذا يدلّ على أنّ إنفاذ وصيّة الأب واجب على الولد مطلقاً; سواء قبل الولد الوصيّة أم لا .
المورد الخامس : من الموارد التي لا يجوز ردّ الوصيّة أن يكون الموصى إليه منحصراً فيه ولم يجد الموصي غيره .
قال الصدوق : «وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لم يجد غيره»(2) .
وفي المختلف : « ومن لم يوجد غيره يتعيّن عليه ; لأنّه فرض كفايةً »(3) .
وفي الدروس : «قال الصدوق : إذا أوصى إلى ولده وجب القبول ، وكذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره ، وهما مرويّان قويّان»(4) . وكذا في الحدائق(5)والرياض(6) .
والدليل على ذلك مفهوم صحيح الفضيل بن يسار(7) ; لأنّ قوله(عليه السلام) : «إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه» يكون مفهومه هكذا : إن لم يوجد في مصر
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 412 الباب 32 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(2) حكاه العلاّمة عنه في مختلف الشيعة 6 : 361، ولكن لم نجده في المقنع المطبوع .
(3) مختلف الشيعة 6 : 362 .
(4) الدروس الشرعيّة 2 : 326 .
(5) الحدائق الناضرة 22 : 579 .
(6) رياض المسائل 9 : 492 .
(7) وسائل الشيعة 13 : 398 و399 الباب 23 من كتاب الوصايا ، ح2.
غيره لم يجز الردّ ووجب عليه قبول الوصيّة .
وكذا ظاهر إطلاق صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : «لا يخذله على هذه الحال»(1)ولعل مراده(عليه السلام) من «هذه الحال» حالة عدم وجود الغير الذي يوصي إليه .
وقال في التذكرة : «يجوز الدخول في الوصيّة ، بل يستحبّ ، بل قد يجب على الكفاية ; لأنّ الإيصاء واجب ، قال الصادق(عليه السلام) : الوصيّة حقّ على كلّ مسلم(2) . وأوصت فاطمة إلى أمير المؤمنين(عليهما السلام)، وبعده إلى ولديها الحسن والحسين(عليهم السلام)»(3) ; وإذا وجب الإيصاء فلابدّ من محلّ له ومن يجب عليه العمل بالوصيّة، وإلاّ لم يكن مفيداً(4) .
-
(1) نفس المصدر والباب: 399 ح4.
(2) نفس المصدر 13: 352 الباب 1 من كتاب الوصايا، ح2 ـ 4 و 6.
(3) بحار الأنوار 43: 185.
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 514، الطبعة الحجريّة .
المبحث التاسع : كون الوصيّ أميناً
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوصيّ أمين ، ولا يضمن ما في يده من أموال الصغار التي صار وليّاً عليها من جهة الوصيّة بالولاية إلاّ مع التعدّي أو التفريط .
جاء في الشرائع : «الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط»(1) . وكذا في المختصر النافع(2) والدروس(3) والتحرير(4)والقواعد(5) .
وبه قال الشيخ الأعظم(6) والسادات الفقهاء : الخوئي(7) والاصفهاني(8)والإمام الخميني(9). واختاره في تفصيل الشريعة(10) .
وفي السرائر : «والوصيّ إذا خالف ما أمر به كان ضامناً للمال»(11) .
وفي المسالك : «وعبّر ـ أي المحقّق ـ عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة ; فإنّه إذا لبس الثوب مثلاً فقد خالف شرط الوصيّة ; لأنّ مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(2) المختصر النافع : 191 .
(3) الدروس الشرعيّة 2 : 326 .
(4) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 381 .
(5) قواعد الأحكام 2 : 565 .
(6) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 130 .
(7) منهاج الصالحين 2 : 223 ، مباني المنهاج 9 : 408 .
(8) وسيلة النجاة 2 : 150 مسألة 49 .
(9) تحرير الوسيلة 2 : 99 مسألة 48 .
(10) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 189 .
(11) السرائر 3 : 192 .
وصرفه في الجهة المأمور بها ونحو ذلك ، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصيّة . . . هذا إذا لم يتعلّق به غرض يعود على ماله فيه الولاية بحيث لا يتمّ بدونه ، كما لو ركب الدابّة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه حيث يتوقّف على الركوب»(1) .
وجاء في جامع المقاصد : «لا خلاف بين أهل الإسلام في أنّ الوصيّ أمين ، ومعناه : أنّه لا يضمن ما بيده من أموال الطفل لو تلف إلاّ بتعدٍّ كما لو لبس الثوب ، أو تفريط كما لو قصر في حفظه ، أو مخالفة لشرط الوصيّة كما لو أوصى إليه أن يصرف شيئاً على وجه ، فصرفه على وجه آخر ; لأنّ الوصاية في معنى الوكالة ، ولأنّ الوصيّ نائب عن الأب والجدّ، وهما أمينان»(2) .
وفي الجواهر : «الوصيّ أمين بلا خلاف أجده فيه»(3) .
وفي الحدائق : «ينبغي أن يكون المدار في التعدّي وعدمه على مخالفة شرط الوصيّة وعدمها ، فلو ركب الدابّة أو لبس الثوب لا لغرض يعود إلى الطفل أو نفع يترتّب عليه ، كان ذلك تعدّياً . . . أمّا لو تعلّق بذلك غرض يعود إلى الطفل ، كأن يركب الدابّة للمضيّ في حوائج الطفل من استيفاء دينه ، أو جمع حواصله أو نحو ذلك ، ولبس الثوب لدفع الضرر عنه باللبس . . . فإنّه لا يكون تعدّياً ، بل ربما صار في بعض الأفراد واجباً عليه إذا علم حصول الضرر بدون ذلك .
وظاهر كلامهم أنّ غاية ما يوجبه التعدّي والتفريط وجوب الضمان مع بقائه على الوصاية ، ولا يوجب ذلك عزله ، مع أنّهم قد صرّحوا بأنّه إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ، والظاهر أنّ التعدّي والتفريط نوع خيانة أيضاً، إلاّ أنّهم لم يصرّحوا بذلك ، بل ربما ظهر من كلامهم في الحكم الأوّل عدم كون ذلك خيانة ،
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 260 .
(2) جامع المقاصد 11 : 285 .
(3) جواهر الكلام 28 : 420 .
فينبغي التأمّل في ذلك»(1) .
نقول : الظاهر أنّ مخالفة شرط الوصيّة أو التفريط فيها لا تكون خيانة ;
لأنّ المراد من التفريط التكاسل في أمر الوصيّة والتهاون فيها ، والخيانة
غيرهما .
وبالجملة : لو شكّ عند إرادة التصرّف في أنّه هل هذا تصرّف حسب المتعارف أم لا ؟ لا يجوز له التصرّف إلاّ بعد إحراز تحقّقه ، فلو عمل والحال هذه فظهر ضرر أو تلف كان ضامناً .
وأمّا إذا كان المتعارف احتمال الضرر ، لكنّ العرف يُقدِمُ ، لم يكن به بأسٌ ، كما إذا كانت التجارة بالمال في البُعد خطيراً ، لكنّ العرف يقدم على ذلك ، وإن تلف لم يضمن .
وكذا إذا كان إجراء العملية الجراحية للطفل بموافقة القيّم أمراً خطيراً ، لكنّ الآباء يقدمون على ذلك من باب الأهمّ والمهمّ ، صحّ له الإقدام ، ولو تلف الطفل لم يضمن ، ولو تلف الطفل بدون تعارف الإقدام فهو ضامن لديته .
أدلّة عدم ضمان الوصيّ
ويدلّ على عدم ضمان الوصيّ اُمور :
الأوّل : إذن الموصي.
بمعنى أنّ إذن الموصي وتسليطه الوصيّ على التصرّف فيما أوصى إليه يقتضي عدم ضمانه فيها .
بتعبير آخر : إذن المالكيّة من طرف الموصي وكذا إذن الشرعيّة ـ حيث إنّه
- (1) الحدائق الناضرة 22 : 581 .
يجوز له التصرّف شرعاً أيضاً ـ يوجبان ذلك ، على هذا يكون في تصرّفه أميناً(1)
فلايضمن ما يتلف في يده إلاّ ما كان عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط، كما هو الحال في كلّ أمين(2) .
وتدلّ على عدم ضمان الأمين أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ؟ فقال : « لو كان أميناً فلا غرم عليه »(3). حيث علّق الإمام(عليه السلام) الحكم بالأمانة ، بمعنى أنّ الأمانة علّة لعدم الضمان .
ومنها : مرسلة أبان، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الّذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»(4) .
قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني دام ظلّه في شرح الحديث : « ومقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة ـ في الجواب على كون الرجل أميناً ـ ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الأمانة، ولو في غير مورد السؤال ، من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكيّة أو شرعيّة »(5) .
ومنها : رواية مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)« أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن
-
(1) والمراد من الأمين هو أن يكون مال الغير في يده بإذن المالك ، أو من الله من غير خيانة له بالنسبة إلى ذلك المال ، من فعل أو ترك يوجب تلفه أو نقصاً فيه . القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 2: 13.
(2) الاقتباس من الجواهر 28 : 422 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 237 الباب 1 من كتاب العارية ، ح7 .
(4) نفس المصدر 13 : 228 الباب 4 من كتاب الوديعة ، ح5 .
(5) القواعد الفقهيّة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : 29 .
وقد جرّبته»(1) ، وكذا رواية اُخرى لمسعدة بن زياد(2) .
ومنها : ما روي عن عليّ(عليه السلام) أنّه قال: «ليس على مؤتمن ضمان»(3) .
ومنها: الخبر المعروف بينهم « ليس على الأمين إلاّ اليمين »(4) .
ولذلك قام الإجماع على أنّ الأمين لا يضمن ; فإنّ الفقهاء رضوان الله عليهم يستندون لعدم الضمان في موارد عديدة بأنّه أمين ، ويرسلونه إرسال المسلّمات من غير إنكار لأحد ، فكان هذه كبرى مسلّمة عند الكلّ، وهي أنّ الأمين لا يضمن(5) ، ولا خلاف فيه بينهم .
الثاني ـ وهو العمدة ـ : النصوص المستفيضة الواردة في الباب ، وهي على ثلاث طوائف :
الاُولى : التي تدلّ على أنّه لو أفرط أو فرّط الوصيّ في المال الموصى به فهو ضامنٌ ، وإلاّ فلا يضمن .
1 ـ مثل صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة عطّر الله مراقدهم ـ قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تُقسّم ؟ فقال : «إذا وجدَ لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامنٌ ـ إلى أن قال ـ : وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفعَ إليه إذا وجد ربّه الذي أُمِرَ بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»(6).
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 229 الباب 4 من كتاب الوديعة ، ح10 .
(2) نفس المصدر: 237 الباب 1 من كتاب العارية ، ح10 .
(3) دعائم الإسلام 2 : 491 ح1755 ، مستدرك الوسائل 14 : 16 ، ح4 .
(4) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 2 : 11، ولم نجده في المصادر الحديثيّة .
(5) نفس المصدر .
(6) وسائل الشيعة 13 : 417 الباب 36 من كتاب الوصايا ، ح1 .
وجه الدلالة : أنّه من كان أميناً لا يضمن فيما بيده من الأموال إلاّ إذا وجد صاحبها الذي اُمر بدفعه إليه فهو له ضامن ; لأنّه فرّط في دفع المال إلى صاحبه، فإذن يكون ضامناً .
2 ـ صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفّى دَينٌ ، فَعَمدَ(1) الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسّم الذي بَقيَ بين الورثة ، فَسُرِقَ الذي للغرماء من الليل ، ممّن يؤخذ ؟ قال : «هو ضامن حين عزله في بيته ، يؤدّي من ماله»(2) .
لأنّه(عليه السلام) علّل الضمان بعزل الوصي الزكاة في بيته ولم يؤدّها للغرماء ، فكأنّه أفرط في تنفيذ الوصية، فهو ضامن ويؤدّي من ماله .
الطائفة الثانية : وهي التي تدلّ على الضمان مطلقاً ; سواء كان بتعدٍّ وتفريط أم لا .
1 ـ مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : « إن فعلَ فهو ضامن»(3) . حيث تدلّ بوضوح على الضمان مطلقاً .
2 ـ وصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»(4) .
والمراد بالعامل هو الوصيّ أو أمين الحاكم; لأنّ الرواية في مورد اليتيم، وهي منصرفة عن الجدّ .
-
(1) عَمَدْتُ إليه : قصدتُ ، المصباح المنير : 428، مادّة عمد .
(2) وسائل الشيعة 13 : 418 الباب 36 من كتاب الوصايا ، ح2 .
(3) نفس المصدر 13 : 418 الباب 36 من كتاب الوصايا ، ح5 .
(4) نفس المصدر 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح1 .
3 ـ ومرسلة أبان قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه ديناً ؟ فقال : «يقضي الرجل ما عليه من دينه ، ويقسّم ما بقي بين الورثة» قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ممّن يؤخذ الدين أمِنَ الورثة أم من الوصيّ ؟ قال : «لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصيّ ضامن لها»(1). وكذا خبر عبدالله الهاشمي(2) وخبر منصور الصيقل(3) وغيرها(4) .
ويستفاد من هذه الأخبار أنّ الوصي ضامن للمال مطلقاً ، ولكن يحمل ذلك على ما إذا فرّط أو أفرط ، كما في الرياض(5) والجواهر(6) .
ويؤيّده ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا اتّجر الوصيّ بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصيّة ، فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم»(7) .
الطائفة الثالثة : الأخبار التي تدلّ على أنّ الوصيّ ضامن بتبديله الوصية وتغييرها ، وهي أيضاً مستفيضة بنفسها :
منها : صحيحة محمّد بن مارد قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصيّ فأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : «أرى أن يغرم الوصيّ ستّمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة»(8) .
-
(1 ، 2) نفس المصدر 13 : 418 الباب 36 من كتاب الوصايا ، ح3 ، 4 .
(3) نفس المصدر 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح7 .
(4) نفس المصدر 12 : 190ـ 191 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح2 ، 3 ، 4 .
(5) رياض المسائل 9: 496 .
(6) جواهر الكلام 28 : 422 .
(7) دعائم الإسلام 2 : 364 ، ح1327 .
(8) وسائل الشيعة 13 : 419 الباب 37 من كتاب الوصايا ، ح1 .
فإنّ الضمان من جهة تبديل الوصية وتغييرها .
ومنها : صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة؟ قال : فقال : «يغرمها ويقضي وصيّته» (1) .
ومنها : خبر أبي سعيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : «يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)»(2) (3) .
وكذا خبر علي بن زيد «فرقد كا»(4). والمستفاد من هذه الطائفة : أنّ الوصيّ قد تعدّى عن الوصيّة ; لأنّ المدار في التعدّي وعدمه على مخالفة الوصيّة وعدمها ، ومن التعدّي تبديل الوصيّة ; وكأنّ المحقّق في الشرائع(5) أراد بمخالفة شرط الوصيّة ما يشمل التعدّي .
وجاء في القواعد: « الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط أو مخالفة لشرط الوصيّة »(6) .
وقال المحقّق الثاني في شرحه : « ولو اقتصر المصنّف على التعدّي لأغنى عن الباقين ; لأنّ المفرط متعدّ »(7) .
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 420 الباب 37 من كتاب الوصايا ، ح3.
(2) نفس المصدر ، ح5.
(3) سورة البقرة 2 : 181 .
(4) وسائل الشيعة 13 : 420 و 419 الباب 37 من أحكام الوصايا ، ح2.
(5) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(6) قواعد الأحكام 2 : 565 .
(7) جامع المقاصد 11 : 285 .
وفي المسالك : « وعبّر ـ أي المحقّق ـ عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة»(1) .
فهذه الطائفة من الأخبار أيضاً تحمل على أنّ الوصيّ قد تعدّى في الأموال فيكون ضامناً ; لأنّ عدم ضمان الوصيّ مشروط بعدم التعدّي والتفريط .
فرع
إذا ضَمِنَ الوصيّ مال اليتيم; بأن أتلفه بالتعدّي أو التفريط ، أو أنفق عليه أزيد من المعروف، أو بتبديله الوصيّة وتغييرها ، فالواجب عليه أن يدفعه إلى الحاكم.
قال في التذكرة : «لا يبرأ عن ضمانه حتّى يدفعه إلى الحاكم ثمّ يردّه الحاكم عليه إن ولاّه ، وأمّا الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه لولده»(2) .
نقول : لم يظهر لنا وجه واضح لهذا الحكم ; لأنّ ولاية الوصيّ إنّما نشأت من ولاية الأب أو الجدّ ، فإذا قال الأب : أوصيت إليك جميع اُمور أولادي ، يكون القبض لمال الضمان من أحد هذه الاُمور ، والفرض أنّ غاية ما يوجب التعدّي والتفريط هو وجوب الضمان، ولا يوجب ذلك عزله ، ويبقى ولايته في مورد الوصاية ، فلماذا نحكم بوجوب دفعه المال إلى الحاكم حتّى يرد الحاكم إليه ثانياً .
ولعلّ مراده(قدس سره) أنّ مورد الوصاية لا يشمل مثل هذا المورد ومنصرف عنه; بأن يوصي الأب للوصي أن يأخذ ما أتلفه نفسه بالإفراط أو التفريط ، فإذن لا ولاية للموصى إليه بقبض مال الضمان .
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 260 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 511 ، الطبعة الحجريّة .
المبحث العاشر : الحاكم وصيّ لمن لا وصيّ له
لا خلاف بين الفقهاء، بل الإجماع على أنّه لو مات شخص ولم يوص إلى أحد، وكان له أموال وأطفال ، وكذا لو مات الوصيّ ولم يأذن له الموصي أن يوصي ، كان النظر في تركته للحاكم الشرعي ، وهو الذي يعيّن القيّم حتّى يحفظ أموال الأطفال، ويفعل ما كان مصلحة لهم من البيع والشراء والمضاربة والإنفاق عليهم وغيرها ، وكذلك ذهب مشهور الفقهاء، بل كلّهم إلاّ قليلاً منهم(1) إلى أنّه لو لم يكن ثَمَّ حاكم يجب على العدول من المؤمنين كفاية أن ينظروا في اُمور الأطفال ويتولّونهم في ذلك .
جاء في المقنعة : «فإن مات ـ أي الوصيّ ـ كان الناظر في اُمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصيّة على حسب ما كان يجب على الوصيّ أن ينفذها ، وليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم ، وإذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الأبواب ـ كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولّوا ما تولاّه السلطان ، فإن لم يتمكّنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه»(2) .
وبه قال في النهاية(3) والوسيلة(4) والكافي(5) والشرائع(6) والمختصر النافع(7)
-
(1) وهو ابن إدريس في السرائر 3 : 194، حيث قال : «فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال ، فإن تولاّه فإنّه لا يمضي شيء ممّا يفعله، لأنّه ليس له ذلك ».
(2) المقنعة : 675 .
(3) النهاية للطوسي : 608 .
(4) الوسيلة لابن حمزة : 374 .
(5) الكافي في الفقه : 366 .
(6) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(7) المختصر النافع: 191.
والإرشاد(1) والمهذب(2) .
وهكذا قال به جماعة من المتأخّرين(3) .
ففي جامع المقاصد : «إنّ الولاية بالأصالة على الطفل ثابتة لأبيه ثمّ لجدّه . . . ومع عدم الجميع فالحاكم ، والمراد به الإمام المعصوم(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، وفي زمان الغيبة النائب العامّ، وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم . . . فإن فقد الكلّ فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به . . . يستفاد الإذن فيه من دلائل الأمر بالمعروف . . .»(4) .
وفي المسالك : «فإن فقد الجميع، فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به ؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس . . . والثاني وهو مختار الأكثر . . . الجواز»(5) .
وقد أشبعنا الموضوع بذكر الأقوال وبيان الأدلّة في البحث عن ولاية الحاكم وعدول المؤمنين على أموال الصغار مفصّلاً ، ولا تفاوت بين المسألتين فلا نعيدها خوفاً من التطويل(6) .
ويترتّب على هذا الحكم أنّه إن ظهر من الموصى إليه عجز أو ضعف في القيام بالوصيّة ، كان للناظر في اُمور المسلمين أن يقيم معه أميناً قويّاً ضابطاً يعينه
-
(1) إرشاد الأذهان 1 : 464 .
(2) المهذّب البارع 3 : 118 .
(3) الروضة البهيّة 5 : 78 ، التنقيح الرائع 2 : 398 ، الحدائق الناضرة 22 : 589 ، رياض المسائل 9 : 509 ، جواهر الكلام 28 : 430 ، كتاب الوصايا ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 131 .
(4) جامع المقاصد 11 : 266 .
(5) مسالك الأفهام 6 : 265 .
(6) راجع الفصل العاشر من الباب الرابع، المبحث الأوّل والرابع .
على تنفيذ الوصيّة، ولم يكن له عزله لضعفه(1) .
وأمّا إذا ظهر منه خيانة بعده ـ أي بعد موت الموصي ـ عزله الحاكم وأقام أميناً مقامه .
وكذا لو جُنّ أو أُغمي عليه(2) ، وكذا لو تغيّر حاله بالفسق ، عزله الحاكم وأقام غيره مقامه على قول بعضهم(3) .
قال في التذكرة : «إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيّرت حالة الموصى إليه ، فإن كان لضعف من كبر أو مرض ، لم تخرج ولايته بذلك عنه ويضمّ الحاكم إليه من يشاركه في النظر ويساعده عليه ، احتياطاً للموصى عليهم. وإن تغيّرت حاله بفسق، فإن كان قبل موت الموصي، فإن قلنا: تشترط العدالة عند الوصاية بطلت وصيّته ، وإن لم يشترط وتجدّدت العدالة حالة الموت صحّت ولايته، وإلاّ بطلت .
وإن كان تغيّره بعد موت الموصي ، إمّا لتعدّيه في المال أو لغير ذلك بطلت ولايته وانعزل عن النظر، ويكون النظر إلى الحاكم أو نائبه ، وإلاّ تولاّه بعض
-
(1 ، 2) المقنعة : 669 ، النهاية للطوسي : 607 ، السرائر 3 : 192 ، المهذّب لابن البرّاج 2 : 117 ، الكافي في الفقه : 366 ، الوسيلة لابن حمزة : 373 ، شرائع الإسلام 2 : 257 ، تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة .
(3) قال المحقّق في الشرائع 2 : 255 : «هل يعتبر ا لعدالة ـ أي من الوصيّ ـ ؟ قيل : نعم ; لأنّ الفاسق لا أمانة له. وقيل : لا ; لأنّ المسلم محلّ الأمانة، كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقّق بتعيّنه ».
وجاء في تحرير الأحكام 3 : 377 «اختيار الشيخ أنّ العدالة شرط فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق وإن كان مؤمناً » ومنعه ابن إدريس ـ «السرائر» 3 : 189 ـ وقال : عندي فيه نظر . وقال في المختلف 6 : 351 ـ 352: شرط الشيخ في المبسوط ـ 4 : 51 ـ والمفيد في المقنعة ـ : 668 ـ . . . عدالة الوصيّ، ومنعوا من الوصية إلى الفاسق ـ إلى أن قال: ـ والأقرب عدم الاشتراط ; لأنّها نيابة، فتتبع اختيار المنوب، كالوكالة . نعم ، إنّه مستحبّ .
المؤمنين مع تعذّر الحاكم ونائبه; لزوال الشرط»(1) .
وفي تحرير الوسيلة « لو ظهرت خيانة الوصيّ ، فعلى الحاكم عزله ونصب
شخص آخر مكانه، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده . وأمّا إن عجز عن التدبير والعمل مطلقاً ـ بحيث لا يرجى زواله كالهرم والخرف ـ فالظاهر انعزاله، وعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه »(2).
وكذا في تفصيل الشريعة، وأضاف بأنّ في الفرع الثالث ـ أي صورة عجز الوصيّ عن التدبير مطلقاً ـ فقدان ما هو المعتبر في صحة جعله وصيّاً يوجب أن ينعزل الوصيّ بنفسه، ولا حاجة إلى عزل الحاكم في هذه الصورة ، بل اللاّزم عليه نصب شخص آخر مكانه(3) .
ثمّ إنّه على تقدير اشتراط العدالة في الوصيّ لو نصب عدلاً، ثمّ ظهر فسقه، وكذا على القول بعدم اشتراط العدالة لو اُوصي إلى العدل من حيث كونه عدلاً ، ثمّ ظهر منه الفسق بعد موت الموصي، فهل يبطل وصايته ؟ فمن قال باعتبار العدالة ابتداءً أبطل الوصيّة هنا، لفوات شرط الوصية ، ومن لم يقل باعتبارها ابتداء أبطل به هنا ; لأنّه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقاً بعدالته ، وقد زالت . ولا تعود ولايته لو عادت العدالة; لزوالها شرعاً .
وفي الجواهر في الأمر الثاني(4): «ينبغي الجزم به... بلا خلاف أجده فيه،
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 511، الطبعة الحجريّة .
(2) تحرير الوسيلة 2 : 99، كتاب الوصيّة مسألة 46 .
(3) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 188 .
(4) الإيصاء إلى العدل بوصف كونه عدلاً .
بل عن المهذّب وشرح الصُّيمري الإجماع عليه(1) إلاّ من الحلّي(2)... لعدم مقتضيها ، ضرورة كون عبارة النصب له من حيث العدالة ، فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب، فلا يكون وصيّاً»(3) .
وجاء في جامع المقاصد : «كأنّه لا خلاف في ذلك عندنا ; لأنّ الموصي إنّما أوصى إليه بهذا الوصف ، وربما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه ، وقد فات . وينعزل من حين الفسق وإن لم يعزله الحاكم لوجود المانع»(4) .
وبه قال أيضاً في المسالك(5) .
آراء فقهاء أهل السنّة في المقام
اتّفق فقهاء أهل السنّة في أنّه إن تغيّرت حال الوصيّ لضعف أو كبر أو مرض لم يعزله الحاكم ، بل يضمّ إليه أميناً يعاونه ، واختلفوا في أنّه هل كانت العدالة شرطاً في الوصيّ حتّى إذا فسق عزله ، أم لا يشترط فيه ذلك ؟ فإليك نصّ بعض كلماتهم :
أ ـ الشافعيّة
ففي المهذّب : «وإن وصّى إلى رجل فتغيّر حاله بعد موت الموصي ، فإن كان لضعف ضمّ إليه معين أمين ، وإن تغيّر بفسق أو جنون بطلت الوصيّة إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه»(6) . وكذا في المجموع(7) .
-
(1) المهذّب البارع 3 : 116 ، غاية المرام 2 : 441 .
(2) السرائر 3 : 198 .
(3) جواهر الكلام 28 : 396 .
(4) جامع المقاصد 11 : 277 .
(5) مسالك الأفهام 6 : 243 .
(6) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 463 .
(7) المجموع شرح المهذّب 16 : 431 .
وفي البيان : «فإن أوصى إلى من جمع الشرائط ثمّ تغيّرت حال الوصيّ بعد موت الموصي ، فإن تغيّر لضعف عن الحساب أو الحفظ لم ينعزل بذلك ، بل يضمّ
إليه الحاكم أميناً يعاونه ; لأنّ الضعف لا ينافي الولاية ، بدليل أنّ الأب والجدّ يليان مال ولدهما وإن كان فيهما ضعف . ولو كان الحاكم هو الذي نصب الأمين فضعف فله عزله ; لأنّه نصبه. وإن فسق الوصيّ أو جنّ انعزل عن الوصيّة ; لأنّ الفسق والجنون ينافيان الولاية»(1) . ومثل ذلك في الوجيز(2) والعزيز(3) ومغني المحتاج(4) .
ب ـ الحنابلة
فقد جاء في المغني : «إذا كان الوصيّ فاسقاً فحكمه حكم من لا وصيّ له ، وينظر في ماله الحاكم ، وإن طرأ فسقه بعد الوصيّة زالت ولايته وأقام الحاكم مقامه أميناً ، هذا اختيار القاضي ، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق ، وعلى قول الخرقي لا تزول ولايته ويضمّ إليه أمين ينظر معه . . . وإذا تغيّرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته وصار كأنّه لم يوص إليه ، ويرجع الأمر إلى الحاكم ، فيقيم أميناً ناظراً للميّت في أمره وأمر أولاده»(5) .
وكذا في الكافي(6) والإقناع(7) وكشّاف القناع(8) والإنصاف(9) .
-
(1) البيان في فقه الشافعي 8 : 306 .
(2) الوجيز 1 : 461 .
(3) العزيز شرح الوجيز 7 : 271 وما بعده .
(4) مغني المحتاج 3 : 75 .
(5) المغني 6 : 572 ـ 573 والشرح الكبير : 585 .
(6) الكافي في فقه أحمد 2 : 291 .
(7) الإقناع 3 : 79 .
(8) كشّاف القناع 4 : 478 .
(9) الإنصاف 7 : 275 .
وفي المبدع : «تصحّ ـ أي الوصيّة ـ إلى الفاسق ويضمّ الحاكم إليه أميناً ... جمعاً بين نظر الموصي وحفظ المال . . .»(1) .
ج ـ الحنفيّة
جاء في البحر الرائق : «ومن عجز عن القيام ضمّ إليه غيره ; لأنّ في الضمّ رعاية الحقّين : حقّ الوصيّ وحقّ الورثة ; لأنّ تكميل النظر يحصل به ; لأنّ النظر يتمّ بإعانة غيره»(2) .
وكذا في البناية(3) وأحكام الصغار(4) .
د ـ المالكيّة
فقد جاء في حاشية الخرشي : «إنّ الفسق إذا طرأ على الوصيّ; فإنّه
ينعزل عن الإيصاء على المشهور ; إذ يشترط في الوصي العدالة ابتداءً
ودواماً»(5) .
وفي عقد الجواهر الثمينة : «ولو ولي العدل ثمّ طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها»(6) أي وجب على الحاكم عزله .
وكذا في حاشية الدسوقي(7) ومواهب الجليل(8) .
-
(1) المبدع شرح المقنع 6 : 101 .
(2) تكملة البحر الرائق 9 : 311 .
(3) البناية 12 : 636 .
(4) أحكام الصغار : 371 ـ 372 .
(5) حاشية الحرشي 8 : 505 .
(6) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .
(7) حاشية الدسوقي 4 : 453 .
(8) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 8 : 557 .
المبحث الحادي عشر : فروع حول الوصيّة للحمل
قد تقدّم ـ في الفصل السادس من الباب الأوّل تحت عنوان حقوق الحمل ـ صحّة الوصيّة له وبيان شرائطها وبقيت فروع لم نتعرّض لها هناك ، وحيث إنّها ترتبط بباب الوصيّة فناسب ذكرها في هذا الفصل ، وهي ما يلي :
الأوّل : قال في القواعد : « لو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من ستّة أشهر استحقّ ـ أي الموصى به ـ فإن ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه ، لتحقّق وجوده وقت الوصيّة »(1) .
وقال المحقّق الثاني في شرحها : « وذلك لأنّهما حمل واحد إجماعاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فراشاً أو لا .
ولو جاءت بالثاني لستّة أشهر فما زاد لم يشارك ; لإمكان تجدّده ، ولا يخفى أنّ ذلك إنّما يتصوّر إذا لم يتجاوز مجموع المدّتين أقصى(2) مدّة الحمل »(3) .
وفي التذكرة : « ولو ولدت أحد التوأمين لأقلّ من ستّة أشهر ، ثمّ ولدت الثاني لأقلّ من ستّة أشهر من الولادة الاُولى صحّت الوصيّة لهما وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستّة أشهر وكانت المرأة فراشاً ; لأنّهما حمل واحد إجماعاً »(4) . وكذا في الرياض(5) ، والحكم واضح لا خلاف فيه .
-
(1) قواعد الأحكام 2 : 453 .
(2) يجيء التحقيق في مسألة أقصى مدّة الحمل في الباب السادس ذيل البحث عن إلحاق الولد بأبيه «الولد للفراش» فانتظر .
(3) جامع المقاصد 10 : 87 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 461 الطبعة الحجريّة .
(5) رياض المسائل 6 : 237 .
وبه قال فقهاء أهل السنّة(1) ، ففي الوجيز في فقه الشافعيّة : « فلو أوصى لحمل ، جاز بشرط أن ينفصل حيّاً لوقت يعلم وجوده عند الوصيّة ، وهو لما دون ستّة أشهر . فإن كان لما فوقه ، والمرأة ذات زوج ، لم يستحقّ; لظهور طريان العلوق ، وإن لم يكن فأظهر الوجهين أنّه يستحقّ ، إلاّ أن يجاوز أربع سنين ; لأنّ طريان وطء الشبهة بعيد »(2) .
وكذا في منهاج الطالبين(3) والحاوي الكبير، وأضاف بأنّه « وإن وضعته لأكثر من ستّة أشهر من وقت الوصيّة ولأقلّ من أربع سنين ، فإن كانت ذات زوج أو سيّد يمكن أن يطأها فحدث ، فالوصيّة باطلة ; لإمكان حدوثه فلم يستحقّ بالشكّ ، وإن كانت غير ذات زوج أو سيّد يطأ، فالوصيّة جائزة ; لأنّ الظاهر تقدّمه ، والحمل يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق، فكذلك في الوصيّة »(4) .
الفرع الثاني : قال الشيخ في المبسوط : « إن أوصى فقال : إن كان الذي في بطنها ذكراً فله ديناران ، وإن كان اُنثى فلها دينار ، فإن أتت بذكر فله ديناران، وإن أتت باُنثى فلها دينار ، وإن أتت بهما فلا شيء لهما . والفرق بين هذه وبين الاُولى
حيث قال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان اُنثى فلها دينار، وقد كان
ذكر واُنثى ، وليس كذلك هاهنا ; لأنّه . . . أراد إن كان كلّ الذي في بطنها ذكراً أو كلّ الذي في بطنها انثى وما وجد تلك الصفة ; لأنّه كان كلّه ذكراً واُنثى»(5). وكذا
-
(1) بدائع الصنائع 6 : 431 ، تبيين الحقائق 6 : 186 ، المقنع : 171 ، المغني 6 : 474 والشرح الكبير 6 : 474 ، كشّاف القناع 4 : 432 ، الفروع 4 : 514 ، المبدع 6 : 35 ، المدوّنة الكبرى 6 : 73 ، بلغة السالك والشرح الصغير 4 : 317 .
(2) الوجيز 1 : 444 .
(3) منهاج الطالبين 2 : 356 .
(4) الحاوي الكبير 10 : 42 .
(5) المبسوط للطوسي 4 : 13 ـ 14 .
في التذكرة(1) .
وبه قال المحقّق(2) والقاضي ابن البرّاج(3) وابن حمزة(4) وكذا الشافعيّة(5)والحنفيّة(6) والحنابلة(7) ولم نجد قولاً من المالكيّة .
الفرع الثالث : قال العلاّمة في التذكرة : «إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكراً واُنثى ، تساويا في الوصيّة لأنّ ذلك عطيّة وهبة ، فأشبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولادتهما . ولو فَصَّل بينهما اتّبع كلامه ، كالوقف .
وإن قال : إن كان في بطنها غلامٌ فله ديناران ، وإن كان فيه جارية فلها دينار ، فولدت غلاماً وجارية، فلكلّ واحد منهما ما وصيّ له به ; لوجود الشرط فيه .
وإن ولدت أحدهما منفرداً فله وصيّته»(8) .
وكذا في الرياض(9) .
وبه أيضاً قال الشافعيّة(10) والحنفيّة(11) والحنابلة(12) .
الفرع الرابع : قال في القواعد : «لو أوصى للحمل فوضعت حيّاً وميّتاً صرف
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 461، الطبعة الحجريّة .
(2) شرائع الإسلام 2 : 250 .
(3) المهذّب لابن البرّاج 2 : 108 .
(4) الوسيلة : 376 .
(5) المهذّب في فقه الشافعي 1: 456، البيان في مذهب الشافعي 8: 167، المجموع شرح المهذّب 16: 375، الحاوي الكبير 10: 43.
(6) بدائع الصنائع 6 : 431 .
(7) الكافي في فقه أحمد 2 : 277 ، الإقناع 3 : 58 ـ 59 .
(8) تذكرة الفقهاء 2 : 461، الطبعة الحجريّة ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 365 .
(9) رياض المسائل 6 : 236 .
(10) المهذّب في فقه الشافعي 1: 456 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 374 ، البيان في مذهب الشافعي 8 : 165.
(11) بدائع الصنائع 6 : 431 ، المغني والشرح الكبير 6 : 477 .
(12) الكافي في فقه أحمد 2 : 277 ، الإقناع 3 : 58 ـ 59 .
الجميع إلى الحيّ مع احتمال النصف»(1) .
وقال المحقّق الثاني في شرحه :
«وجه الأوّل : أنّ الميّت كالمعدوم فيكون الحيّ كأنّه تمام الحمل ، فتكون الوصية له كما في الميراث الموقوف .
ووجه الثاني : أنّ تمام الحمل هو الحيّ والميّت ، وكون الميّت كالمعدوم إنّما هو في عدم ثبوت الوصيّة له لا مطلقاً .
ولو كانا حيّين لكان لكلّ منهما النصف ; لأنّ الحمل مجموعهما ، فيكون كلام الموصي مُنَزّلاً عليهما، فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما ; لأنّ من أوصى لحيٍّ ومن ظُنّ حياتُهُ فتبيّن موته ، لا يُصرَفُ الحصّة التي أوصى بها للميّت إلى الحيّ قطعاً فكذا هنا. والفرق بين الوصيّة والإرث ظاهرٌ; فإنّ الإرث للقريب اتّحد أو تعدّد»(2).
وقال أيضاً في القواعد : «وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوّزنا الوصيّة المبهمة ومات أحدهما قبل البيان»(3) .
وأضاف المحقّق الثاني في شرحه : «أي وكذا الحكم فيما لو أوصى لأحد هذين(4) وجوّزنا الوصيّة المبهمة ومات أحدهما قبل البيان ; فإنّه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع والنصف ; نظراً إلى أنّ الميّت كالمعدوم، فتكون الوصية كلّها للحيّ ، والتفاتاً إلى التردّد في أنّ الحيّ يستحقّ الجميع ; لكونه الموصى له ، أو لا يستحقّ شيئاً ; لكون الموصى له غيره ، فيحكم بالنصف ـ ولقد أجاد
-
(1) قواعد الأحكام 2 : 454 .
(2) جامع المقاصد 10 : 97 .
(3) قواعد الأحكام 2 : 454 .
(4) في المصدر لهذين، والصواب ما أثبتناه.
في الإيراد عليه حيث قال :ـ وفي هذا نظرٌ ; لأنّ الوصيّة لأحد هذين على طريق الإبهام، لا على معنى أيّهما كان يجب أن تكون باطلة ; لأنّ المبهم في حدّ ذاته يمتنع وجوده والعلم به ، فتمتنع الوصيّة له .
وما ذكره من قوله : «ومات أحدهما قبل البيان» يشعر بأنّ الإبهام إنّما هو عند السامع لا عند الموصي ، وحينئذ فلا يجيء الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف ، بل يجب أن يُقال : إن أمكن البيان من الموصي، أو من يقوم مقامه فلا بحث ، وإن تعذّر أمكن القول بالقرعة والبطلان»(1) .
ولم نجد في كلمات فقهاء أهل السنّة قولاً في هذا الفرع إلاّ من الحنفيّة، حيث قال في البدائع : «لو قال : أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، فولدت لأقلّ من ستّة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميّتاً لا وصيّة له . . . ولو ولدت ولدين حيّاً وميّتاً فجميع الوصيّة للحيّ ; لأنّ الميّت لا يصلح محلاًّ لوضع الوصيّة فيه ، ولهذا لو أوصى لحيّ وميّت كان كلّ الوصيّة للحيّ»(2) .
الفرع الخامس : قال الشيخ في المبسوط : « إن كان ـ أي الوصيّة ـ مقيّداً فقال : أوصيتُ لحمل هذه الجارية وهو من فلان ، فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر ولحقه النسب ، فإنّه تصحّ الوصيّة ; لأنّا بيّنا أنّه كان مخلوقاً موجوداً حال الوصيّة ; لأنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر فالحكم على ما مضى في المسألة الاُولى .
فإن كان لها زوج فلا تصحّ له الوصيّة ; لأنّه يجوز أن يكون حدث بعد الوصيّة . وإن لم يكن لها زوج نظرت; فإن أتت به لأقلّ من تسعة أشهر ; فإنّه يلحق النسب وتثبت له الوصيّة، وإن أتت به لأكثر من ذلك; فإنّه لا يلحق النسب
-
(1) جامع المقاصد 10 : 97 .
(2) بدائع الصنائع 6 : 433 .
ولا تصحّ الوصيّة ، فإن أوصى لحمل جارية وقال : هو ابن فلان فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحّت الوصيّة ; لأنّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده ، فأمّا من الأجنبيّ فلا »(1) .
وفي التذكرة : لو قال الموصي : أوصيت لحمل فلانة من زيد ، فكما يشترط العلم بوجوده عند الوصيّة ، يشترط أن يكون ثابت النسب من زيد حتّى لو كانت الوصيّة بعد زوال الفراش فأتت بولد لأكثر من سنة ـ عندنا ـ ومن أربع سنين ـ عند الشافعي ـ من وقت الفراق والأقلّ من ستّة أشهر من يوم الوصيّة ، فلايستحقّ ; لأنّ النسب غير ثابت منه .
بخلاف ما إذا اقتصر على الوصيّة لحمل فلانة ولم يصرّح بأنّه من زيد ، لم يشترط بكونه ثابت النسب من زيد ، ولو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيد ، لكنّه نفاه باللعان أو الإنكار ، فقال بعضهم : لا تصحّ الوصيّة وأنّه لا شيء له ، لأنّه لم يثبت نسبه ، بل نفى نسبه عنه ، وإذا لم يثبت نسبه لم يوجد شرطه .
وقال آخرون : إنّه يستحقّ ; لأنّه كان النسب ثابتاً، إلاّ أنّه انقطع باللعان ، واللعان إنّما يؤثر في حقّ الزوجين خاصّة ، ولهذا لا يجوز لغير الزوج رميها بذلك .
وهذا الخلاف كالخلاف في أنّ التوأمين المنفيين باللعان يتوارثان بإخوة الاُمّ وحدها ، أو بإخوة الأبوين»(2) .
وبه قال الشافعيّة والحنفيّة .
جاء في العزيز: لو قال الموصي : أوصيت لحمل هذه المرأة من زيد ، لم تصحّ الوصيّة له إلاّ بشرطين :
أحدهما : العلم بوجوده عند الوصيّة كما تقدّم .
-
(1) المبسوط للطوسي 4 : 13 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 460 ـ 461 الطبعة الحجريّة .
والثاني : ثبوت نسبه من أبيه المذكور في الوصيّة ، وأن يكون ثابت النسب من زيد ، حتّى لو كانت الوصيّة بعد زوال الفراش ، فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق ، ولأقلّ من ستّة أشهر من يوم الوصيّة ، فلا يستحقّ ; لأنّ النسب غير ثابت منه ، ولو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيد لكنّه نفاه باللعان ، فعن ابن سريح وعامّة الأصحاب : أنّه لا شيء له ; لأنّه لم يثبت نسبه .
وعن أبي إسحاق وأبي منصور أنّه يستحقّ ; لأنّه كان النسب ثابتاً ، إلاّ أنّه انقطع باللعان ، واللعان إنّما يؤثّر في حقّ الزوجين(1) .
وكذا في البيان(2) وروضة الطالبين(3) والمغني والشرح الكبير(4) وغيرها(5) .
الفرع السادس : أنّه إذا أوصى للحمل صحّت الوصيّة ، وكان القابل لها أبوه أو جدّه أو من يلي اُموره بعد خروجه حيّاً ، ولو قَبِلَ قَبْلَ انفصاله حيّاً ثمّ انفصل حيّاً ، ففي الاعتداد بذلك القبول إشكال(6) .
أُشير إلى هذا الفرع في كلام الشافعيّة أيضاً(7) .
نقول : لم نقف في هذه الفروع على نصٍّ ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على ما ذكرناه ; فإنّه لم ينقل هنا خلاف في شيء من هذه الأحكام .
الفرع السابع : عدم صحّة الوقف للحمل، الظاهر لا خلاف في أنّه لا يصحّ الوقف للحمل .
-
(1) العزيز شرح الوجيز 7 : 10 ـ 11 .
(2) البيان 8 : 165 .
(3) روضة الطالبين 5 : 173 .
(4) المغني 6 : 475، الشرح الكبير 6 : 476 .
(5) المجموع شرح المهذّب 16 : 327 ، مغني المحتاج 3 : 41 ، الحاوي الكبير 10 : 44 .
(6) تذكرة الفقهاء 2 : 461، الطبعة الحجريّة .
(7) العزيز شرح الوجيز 7 : 11 ، روضة الطالبين 5 : 174 .
قال الشيخ في النهاية : «ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد ، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلاً»(1) .
وبه صرّح أيضاً في المقنعة(2) والخلاف(3) والمبسوط(4)، والمهذّب(5) والوسيلة(6)وغيرها(7) .
لعدم أهليّة المعدوم للتملّك وهو واضح . وصرّح الفقهاء بأنّ في معناه الحمل أيضاً ; لأنّه وإن كان موجوداً إلاّ أنّه غير صالح للتملّك ما دام حملاً .
ففي المبسوط : «ومن شرط صحّة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءً ممّن يملك المنفعة ، ولا يجوز أن يقف على من لا يملك في الحال . . . أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف»(8) .
وفي الخلاف : «إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد ... يبطل الوقف»(9) .
وبه صرّح ابن حمزة(10) والراوندي(11) والحلّي(12) وابن زهرة(13)
-
(1) النهاية للطوسي : 596 .
(2) المقنعة : 655 .
(3) الخلاف 3 : 544 .
(4) المبسوط للطوسي 3 : 292 .
(5) المهذّب لابن البرّاج 2: 88.
(6) الوسيلة لابن حمزة : 370 .
(7) الجامع للشرائع : 370 ، شرائع الإسلام 2 : 214 ، قواعد الأحكام 2 : 390 ، جامع المقاصد 9 : 38 .
(8) المسبوط للطوسي 3 : 292 .
(9) الخلاف 3 : 544 .
(10) الوسيلة لابن حمزة : 370 .
(11) فقه القرآن 2 : 293 .
(12) السرائر 3 : 156 .
(13) غنية النزوع : 297 .
والفاضلان(1) .
وقال في تحرير الوسيلة : « يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم ومن سيوجد بعد ، وكذا الحمل قبل أن يولد »(2) .
ولم نقف على نصّ في المقام ، إلاّ أنّه مضافاً إلى الاتّفاق في المسألة، بل تسالم الكلّ عليها، حيث إنّ الوقف إمّا تمليك العين والمنفعة ، وإمّا تمليك المنفعة فقط ، فلابدّ من قابليّة الموقوف عليه للتملّك ، والحمل لا يصلح لذلك ، بخلاف الوصيّة، حيث إنّها تمليك في المستقبل ، ولذا اشترطوا فيها وضعه حيّاً ، فلو مات قبل خروجه حيّاً بطلت الوصيّة كما تقدّم .
ولذا جاء في جامع المقاصد : «أمّا الحمل; فلأنّه لم يثبت تملّكه إلاّ في الوصيّة ، ولعدم القطع بحياته . والفرق بين الوصيّة والوقف، أنّ الوصيّة تتعلّق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال»(3) .
وفي المسالك : «تفريع الحمل على المعدوم لا يخلو من تجوّز ; لأنّه في نفسه موجود ، غايته استتاره ، وإنّما يشاركه في الحكم بعدم صحّة الوقف عليه من جهة
اُخرى; وهي أهليّة الموقوف عليه للتملّك ; فإنّها شرط من حيث إنّ الوقف إمّا تمليك العين والمنفعة إن قلنا : إنّ الوقف يملكه الموقوف عليه . وإمّا تمليك المنفعة
إن لم نقل به ، والحمل لا يصلح لشيء منهما»(4) .
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 214 ، قواعد الأحكام 2 : 390 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 297 ، تذكرة الفقهاء 2 : 428، الطبعة الحجريّة .
(2) تحرير الوسيلة 2 : 67، مسألة 35 .
(3) جامع المقاصد 9 : 38 ـ 39 .
(4) مسالك الأفهام 5 : 327 .
وخالف السيّد اليزدي ما ذهب إليه المشهور، حيث قال بصحّة الوقف للحمل لولا الإجماع ، واعتقد أنّه لا إجماع في المسألة، وذكر في تحقيق المسألة ما ملخّصه :
أوّلاً : لا فرق بين الحمل والرضيع خصوصاً مع فصل قليل ، كما إذا كان قبل الوضع بربع ساعة ، واشتراط إرثه بتولّده حيّاً ليس لعدم قابليّته للملكيّة ، بل للدليل الخاصّ، فلا يصحّ القياس عليه .
وثانياً : بالنقض بما إذا كان تبعاً لموجود، فإنّه يجوّزونه ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد منهم، وكما في سائر البطون اللاحقة ، فإنّ تمليك المعدوم لو كان غير معقول لم يكن فرق بين الاستقلال والتبعيّة .
وثالثاً : لا فرق في المعقوليّة وعدمها بين كون المالك معدوماً أو المملوك ، مع أنّهم يجوّزون تمليك الكلّي في الذمّة ، مع أنّه ليس شيئاً موجوداً في الخارج ، وأيضاً يجوّزون بيع الثمار قبل بروزها عامين أو مع الضميمة ، ويجوّزون تمليك المنافع وليست موجودة بل يستوفي شيئاً فشيئاً .
ورابعاً : التحقيق أنّ الملكيّة من الاُمور الاعتباريّة ، فوجودها عين الاعتبار العقلائي . . . فيكفيها المحلّ الموجود في اعتبار العقلاء ، كيف؟ وإلاّ لزم عدم تعلّق الوجوب بالصلاة ، ولا الحرمة بالزنا إلاّ بعد وجودهما في الخارج . نعم ، مبانيها من الحبّ والبغض والإرادة والكراهة أعراض خارجيّة .
وخامساً : أنّ الوقف ليس تمليكاً ، والظاهر عدم الإشكال في جواز الوقف على الحجّاج والزوّار مع عدم وجود زائر أو حاجّ حين الوقف ، وكذا الوقف على طلاّب مدرسة معيّنة مع عدم وجودهم فيها حاله ـ إلى أن قال: ـ إنّه إن تمّ الإجماع على عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي سيوجد، وإلاّ فالأقوى صحّته ، وتحقّق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم(عليه السلام) دونه خرط القتاد»(1) .
- (1) تتمّة العروة الوثقى ، كتاب الوقف 1 : 200 ـ 201 .
نقول : لو لم يكن في المسألة إجماع كان لما أفاده(قدس سره) وجه ، ولكنّ الظاهر
ثبوت الإجماع بل تسالم الفريقين ، ولم تكن في النصوص مستند لهذا
الإجماع حتّى يستشكل بأنّه مدركيّ ، بل غير بعيد أنّ فتوى القدماء ـ مثل
المفيد والمشايخ الثلاثة ـ خصوصاً إذا اتّفقوا على أمر ، يكشف ذلك عن تلقّيهم
ذلك الأمر من الأئمّة(عليهم السلام) ، على هذا قول المشهور هو الأقوى ، وهو المعتمد ،
والله العالم بحكمه .
وقال بعض الأعلام في تفصيل الشريعة في المقام : « إن تمّ الإجماع على عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي سيوجد ، وإلاّ فالأقوى صحّته ، والإجماع ـ على تقديره ـ لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام); لأنّهم يعلّلون بهذا التعليل العليل ، وتوجيه عدم الصحّة من طريق اعتبار القبض في الصحّة ممنوع بعدم اشتراط الفوريّة في القبض ، وبإمكان قبض الحاكم أو المتوليّ»(1) .
هذا إذا وقف على الحمل مستقلاًّ ، أمّا لو وقف على المعدوم والحمل تبعاً للموجود صحّ كما صرّح به في المقنعة(2) والمبسوط(3) والوسيلة(4) والغنية(5)والسرائر(6) والشرائع(7) والتذكرة(8) والتحرير(9) والدروس(10) واللمعة(11) وجامع
-
(1) تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: 50.
(2) المقنعة : 655 .
(3) المبسوط للطوسي 3 : 292 .
(4) الوسيلة لابن حمزة : 370 .
(5) غنية النزوع: 297.
(6) السرائر 3 : 156 .
(7) شرائع الإسلام 2 : 214 .
(8) تذكرة الفقهاء 2 : 428، الطبعة الحجرية .
(9) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 297 .
(10) الدروس الشرعيّة 2 : 269 .
(11) اللمعة الدمشقيّة: 57.
المقاصد(1) والمسالك(2) وغيرها(3) .
قال في تحرير الوسيلة : « ولو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود; بأن يجعل طبقةً ثانية، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده ، صحّ بلا إشكال ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد على التشريك أو الترتيب »(4) .
الوقف على الحمل عند أهل السنّة
ذهب المالكيّة إلى أنّه يصحّ الوقف على مَن هو أهل للتملّك كمن سيولد .
ففي مواهب الجليل : «المشهور المعمول عليه صحّته ـ أي الوقف ـ على الحمل ... وزعم بعضهم أنّه لا يجوز على الحمل ، والروايات واضحة بصحّته»(5) .
وجاء في حاشية الدسوقي : ويصحّ على من سيولد فيعطاها ما لم يحصل مانع من الوجود كموت إلاّ أنّه غير لازم بمجرّد عقده ، بل يوقف لزومه إلى أن يوجد(6) .
وأمّا الشافعيّة، فقد نصّوا على عدم صحّة الوقف على الحمل ; لعدم صحّة تملّكه; سواء أكان مقصوداً أم تابعاً ، حتّى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف
-
(1) جامع المقاصد 9 : 39 .
(2) مسالك الأفهام 5 : 328 .
(3) فقه القرآن للراوندي 2 : 293 ، الجامع للشرائع : 370 ، قواعد الأحكام 2 : 391 ، إرشاد الأذهان 1 : 452 ، تبصرة المتعلّمين : 126 ، التنقيح الرائع 2 : 308 ، الروضة البهيّة 3 : 178 ، الحدائق الناضرة 22 : 189 ، جواهر الكلام 28 : 27 ، مفتاح الكرامة 9 : 48 ، رياض المسائل 9 : 311 ، وسيلة النجاة 2 : 130 ، منهاج الصالحين للخوئي 2 : 240 .
(4) تحرير الوسيلة 2 : 68 كتاب الوقف مسألة 35 .
(5) مواهب الجليل 7 : 632 .
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 77 .
لم يدخل إلاّ إذا انفصل حيّاً; فإنّه يدخل معهم(1) .
ففي الوجيز : «ولا يجوز ـ أي الوقف ـ على الجنين ; لأنّه لا تسليط في الحال»(2) وكذا في فتح الوهّاب(3) .
وجاء في المهذّب : «ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل ; لأنّه تمليك منجّز، فلم يصحّ على من لا يملك كالهبة والصدقة»(4) .
وبه قال الحنابلة ، فقد جاء في المغني : «ومن وقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل لم يستحقّ شيئاً قبل انفصاله ; لأنّه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله»(5) .
وفي الشرح الكبير : «ولا يصحّ على حيوان لا يملك كالعبد القنّ . . . والحمل والملك . . .»(6) .
وكذا في الإنصاف، وأضاف : وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم(7) .
ولم نعثر للحنفيّة فيما استطعنا الوصول إليه من كتبهم في باب الوقف على نصّ خاصّ في هذه المسألة .
-
(1) مغني المحتاج 2 : 379 .
(2) الوجيز في فقه الشافعي 1: 425.
(3) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1 : 441 .
(4) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 441 .
(5) المغني 6 : 205.
(6) الشرح الكبير 6: 198.
(7) الإنصاف 7 : 21 .