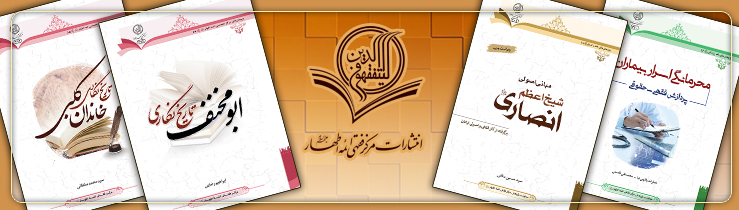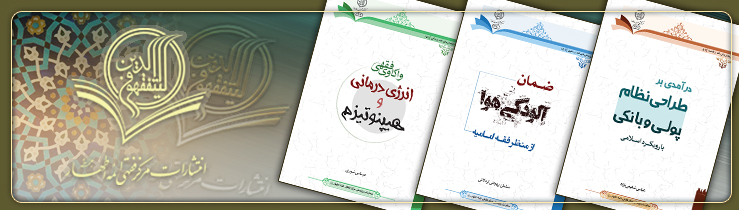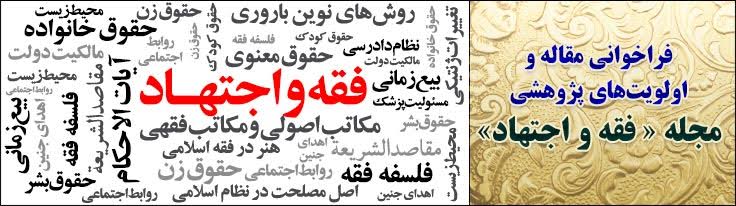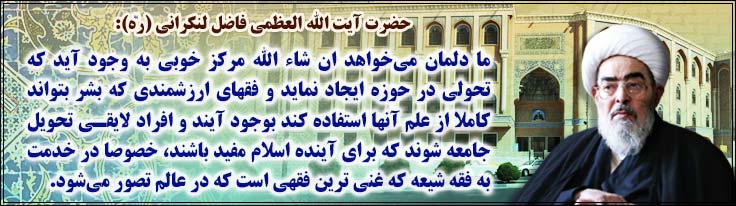إيضاح
الظاهر أنّ ما ذكرنا من حكم نظر الصبيّ إلى المرأة الأجنبيّة جار بالنسبة إلى نظر الصبيّة إلى الرجل الأجنبي أيضاً ; بمعنى أنّه إن كانت فيها ثوران الشهوة وتشوّق ويترتّب على نظرها خوف الفتنة ولو بلحاظ انتهاء ذلك شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه باعتبار ابتلائها بما هو أشدّ منه بعد البلوغ ، فهي كالبالغة في النظر إلى الأجنبي ، فيجب على الوليّ منعها ; لوحدة الملاك، وهكذا في نظر الصبيّة والصبيّ إلى أنفسهما .
د : النظر إلى عورة الصغيرة
إن كانت الصغيرة غير مميّزة فالظاهر أنّه يجوز للرجل النظر إلى عورتها، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل، واختصاص أدلّة المنع بغير الأطفال من البالغين والمميِّزين ـ السيرة القطعيّة، وكذا جملة من النصوص المتقدِّمة التي تدلّ على جواز تغسيل الرجل والمرأة الصبيّة والصبيّ المميّزين .
قال المحقّق النراقي : «إن لم يكونوا مميِّزين فالظاهر الجواز; لإطباق الناس في الأعصار والأمصار على عدم منع هؤلاء عن كشف العورات ونظرهم إليها»(1) .
وأمّا النظر إلى عورة الصغيرة إن كانت مميّزة وفي مظنّة الشهوة، فلا ينبغي الشكّ في عدم جوازه; لإطلاق أدلّة المنع، والأخبارالمتقدِّمة، إذلاموجب لتخصيصها بالبالغ ; فإنّ مقتضى قوله(عليه السلام) : عورة المؤمن على المؤمن حرام(2) ، هو حرمة النظر إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه بالغاً، وأيضاً سائر الأدلّة التي تدلّ على عدم
-
(1) مستند الشيعة 16 : 34 .
(2) بحار الأنوار 75 : 214 ح9 وج 46 : 141 ـ 142 ، وسائل الشيعة 1 : 366 الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، ح1 .
جواز النظر إلى الصغيرة مع تلذّذ وشهوة جارية هنا بالأولويّة ، وهو ظاهر .
وفي الإيضاح : «النظر إلى الصبيّة الصغيرة التي ليست في مظنّة الشهوة الأجنبيّة جائز; لانتفاء دواعي الشهوة ، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها»(1) .
ومثل الصغيرة الصغير; لوحدة الملاك ، فإن كان مميّزاً وفي مظنّة الشهوة لا يجوز للمرأة ولا للرجل النظر إلى عورته .
هـ: نظر المميّز إلى عورة الرجل أو المرأة
الصبيّ أو الصبيّة إن كان غير مميِّزين، فيجوز لهما النظر إلى عورة الرجل أو المرأة; لعدم التكليف بانتفاء موضوعه الذي هو التمييز .
وأمّا إن كانا مميِّزين، فالظاهر أنّه يحرم أن ينظرا إلى عورة الرجل أو المرأة ، وكذا يحرم أن ينظر الصبيّ إلى عورة الصبيّة وبالعكس ، فيجب على الوليّ منعهما عن ذلك .
قال الشيخ الأعظم : «نعم، النظر إلى العورة وتكشّفها عنده مستثنى إجماعاً على الظاهر ، فيجب على الوليّ منعه عن النظر إليها، ويحرم أيضاً للرجال والنساء كشفها عنده»(2) ، وبه قال الفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني(3) .
وقال المحقّق النراقي : «أمّا مع التميّز فلا يجوز نظرهم ـ أي الصبيان ـ إلى العورة ; للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية(4) عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة .
-
(1) إيضاح الفوائد 3 : 8 .
(2) كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 61 .
(3) الأحكام الواضحة : 373 .
(4) سورة النور 24 : 58 .
ثمّ قال : وتؤيّده الروايتان :
إحداهما : والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين(1) .
والاُخرى : في الصبيّ يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن يصف فلا(2) .
وهل المراد بعدم الجواز هنا حرمته ووجوب الاستئذان على الصبيّ نفسه، أو الوجوب على الوليّ أمره ونهيه، أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟
الظاهر هو الأوّل ولا بعد فيه ; لأخصّية دليله عن أدلّة رفع القلم(3)عن الصبيّ»(4) .
نقول: مقصوده(قدس سره) أ نّ قوله ـ تعالى ـ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّات مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْرات لَكُمْ . . . )الآية(5) موجب لتخصيص ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ ، لأنّ الخطاب في الآية الكريمة وإن كان متوجِّهاً إلى المكلّفين، إلاّ أنّ الأمر بالاستئذان متوجّه إلى غير المكلّفين ، كما هو واضح ، فيتحصّل من الآية الكريمة أنّ الصبيان مكلّفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير ويجب عليهم ذلك، وتكون هذه الآية استثناءً وتخصيصاً لحديث رفع القلم(6) عن الصبيان، وبها تُرفع اليد عن إطلاق دليل رفع القلم كما تُرفع إليد عنه في باب الزنا واللواط والسرقة ونحوها .
-
(1) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح، ح4 .
(2) نفس المصدر : 172 الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، ح2 .
(3) نفس المصدر 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح11 .
(4) مستند الشيعة 16 : 35 .
(5) سورة النور 24 : 58 .
(6) وسائل الشيعة 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح11 .
ويجيء في باب جنايات الأطفال زيادة توضيح في هذه المسألة .
وأورد في المستمسك عليه بأنّ الآية الشريفة ليست واردة في تحريم نظر الصبيّ إلى العورة، وإنّما في تحريم التطلّع على بعض الأفعال والأحوال التي يستقبح التطلّع عليها ويستحيى منه . . . فالآية الاُولى ليست واردة في النظر إلى العورة الحرام، ولا في تحريم ذلك على غير البالغ(1) . انتهى ملخّصاً .
وكذا في مباني العروة(2) .
ويرد عليهما أوّلاً : أنّ الحكم بالاستئذان لأجل عدم النظر إلى العورة، وهو أوّل ما يتبادر من هذا الحكم، ولذا يقدّم في كلام العرف عند تعليل الاستئذان ، فإذا قيل: لماذا الاستئذان؟ اُجيب بأنّه لأجل أن لا يرى عورتهما وحالات العرى والجماع ، كما عن بعض المعاصرين(3) .
وثانياً : أنّ إطلاقات الأخبار التي تدلّ على حرمة النظر إلى العورة شاملة للصبيّ المميّز أيضاً، وهكذا النصوص الدالّة على وجوب تستّر العورة الملازم عرفاً لحرمة النظر، وهي ما يلي :
1 ـ معتبرة حنّان بن سدير، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين(عليهما السلام) في حديث قال : «ما يمنعكم من الاُزر; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام» ، الحديث(4) .
فإنّ إطلاقها يشمل غير البالغ المميِّز، لأنّ مقتضى قوله(عليه السلام) : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» هو حرمة نظر المؤمن إلى عورة المؤمن من دون تقييد بكونه
-
(1) مستمسك العروة الوثقى 14 : 40 .
(2) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 87 .
(3) الفقه ، كتاب النكاح 1 : 184 .
(4) وسائل الشيعة 1 : 368 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، ح4 .
بالغاً; فإنّ المميّز من غير البالغين إذا أدرك وجود الله ـ تعالى ـ وآمن به ، صدق عليه عنوان المؤمن، وبذلك يصبح مشمولاً لأدلّة المنع .
2 ـ صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحدٌ ، قال : «لا بأس»(1) .
لأنّ المنع من النظر إلى العورة كان مرتكزاً في ذهن السائل لكلّ أحد . وأجاب الإمام(عليه السلام) بأنّه «لا بأس» ومقتضى كلامه(عليه السلام) لا بأس حيث لا يراه أحدٌ، وهذا العموم يشمل المميّز .
3 ـ صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال : «إذا لم يَرَهُ أحدٌ فلا بأس»(2)ومقتضى مفهوم الشرط أنّه إذا رآه أحدٌ ففيه بأسٌ .
4 ـ معتبرة أبي بصير، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين(عليهم السلام) قال: «إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا»(3) .
وكذا ما رواه الصدوق في الفقيه وثواب الأعمال(4) .
وثالثاً : أنّ هناك أفعالٌ عُلِمَ مبغوضيّة وقوعها في الخارج عند الشارع على كلّ تقدير ، بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبها بالغاً أو غير بالغ، كالزنا وشرب الخمر واللواط ونحوها ، ولعلّ النظر إلى العورة كان من هذا القبيل ; لأنّ
النظر إلى العورة ممّا يستقبح ولو كان من غير بالغ، وأيضاً أنّ نظر الصبيّ إلى العورة
-
(1) نفس المصدر : 370 الباب 11 من أبواب آداب الحمّام، ح1 .
(2) نفس المصدر : 371 الباب 11 من أبواب آداب الحمّام، ح2 .
(3) نفس المصدر 1 : 367 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، ح2 .
(4) من لا يحضره الفقيه 4 : 5 ، ثواب الأعمال : 36 ، وسائل الشيعة 1 : 211 ـ 212 الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، ح2 ، 4 .
ينتهي شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه ، ونتيجته الابتلاء بما هو أشدّ من النظر، فلذلك منعه الشارع منه مطلقاً ، وكَرِهَهُ الإمام(عليه السلام) من كلّ أحد كما في صحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يُصبُّ عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال : «كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد»(1) .
وفي رواية تحف العقول : «ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه»(2) .
ويؤيّده ما جاء في رسالة (المحكم و المتشابه) للسيّد المرتضى (رحمه الله) نقلاً من تفسير النعماني بسنده . . . عن عليّ(عليه السلام) في قوله ـ عزّوجلّ ـ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ )(3) معناه «لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه» الحديث(4) .
ورابعاً : أ نّ المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّه لا يجوز نظر الصبيان المميِّزين إلى عورات الكبار، بل إلى عورات أمثالهم حتّى يعدّ ذلك من المنكرات الواضحة، وأيضاً سيرة المتشرّعة هي المنع الشديد للأطفال من النظر إلى العورات(5) .
والمتحصّل من جميع ذلك أنّ نفس هذا العمل مستقبح ومبغوض عند الشارع، وكرهه الإمام(عليه السلام) ولو صدر من غير البالغين ، ولا ينبغي أن يكون أفراد الناس كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ، فالأظهر ما ذكره الشيخ الأعظم والمحقّق النراقي خلافاً للسيّدين الفقيهين «الحكيم والخوئي» .
-
(1) وسائل الشيعة 1 : 364 الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، ح3 .
(2) نفس المصدر والباب ح5 ، تحف العقول : 5 .
(3) سورة النور 24 : 30 .
(4) وسائل الشيعة 1 : 212 الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، ح5 .
(5) الفقه، كتاب النكاح 1 : 184 .
المبحث الثاني : لمس الصبيّة والصبيّ
لا خلاف في حرمة مسّ ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة .
قال العلاّمة في التذكرة : «كلّ موضع يحرم فيه النظر فتحريم المسّ أولى ; لأنّه أقوى وأشدّ في التلذّذ والاستمتاع من النظر ، ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر ويبطل لو استند إلى الملامسة»(1) .
واختاره ابنه في الإيضاح(2) .
وفي جامع المقاصد : «كلّ موضع حكمنا فيه بتحريم النظر ، فتحريم المسّ فيه أولى ، ولو توقّف العلاج على مسّ الأجنبيّة دون نظرها ، فتحريم النظر بحاله ، وجواز النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها لا يبيح مسّهما ; لأنّ المسّ أدعى إلى الفتنة وأقوى في تحريك الشهوة»(3) .
وكذا في الجواهر، ولكن زاد فيه : «بل لا أجد فيه خلافاً، بل كأنّه ضروريّ على وجه يكون محرّماً لنفسه»(4) .
وقال الشيخ الأعظم : «ثمّ اعلم أنّ المصنّف(قدس سره) لم يتعرّض لحكم اللمس ، لكنّه
اكتفى عن حكمه بالحكم بحرمة النظر، حيث إنّه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً ،
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 575، الطبعة الحجريّة .
(2) إيضاح الفوائد 3 : 9 .
(3) جامع المقاصد 12 : 43 .
(4) جواهر الكلام 29 : 100 .
بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر; للأخبار الكثيرة(1)، والظاهر أنّه ممّا
لا خلاف فيه»(2) .
وكذا في تحرير الوسيلة(3) وشرحه، وزاد « لعدم الدليل على الاستثناء ـ أي جواز النظر إلى الوجه والكفّين ـ بالإضافة إلى المَسّ أيضاً، وعليه: فلايجوز للأجنبي مصافحة الأجنبيّة المستلزمة للمسّ »(4) .
وحكم لمس الصغيرة والصغير أيضاً حكم النظر إليهما ، ففي كلّ موضع يجوز النظر إلى الصغيرة كما إذا لم تكن في مظنّة الشهوة والالتذاذ يجوز لمسها، وما لايجوز كالنظر إلى الصغيرة مع تلذّذ وشهوة وريبة فلا يجوز لمسها، والدليل عليه ما تقدّم في حكم النظر إليها، وكذلك لمس المرأة الصبيّ، لوحدة الملاك وعدم التفاوت بينهما .
قال في التحرير : «المسّ كالنظر في أحكامه من المنع والإذن، ويجوز لحاجة المعالجة كالنظر»(5) .
وجاء في العروة : «غير المميّز من الصبيّ والصبيّة; فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس»(6) .
وقال السيّد الحكيم في شرحها : «هذا في الجملة من القطعيّات . . . وكذلك الحكم في اللمس»(7) ، وبه قال المحقّق الفقيه الفاضل اللنكراني(8) .
-
(1) وسائل الشيعة 14 : 142 الباب 105 من أبواب مقدّمات النكاح .
(2) كتاب النكاح، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 68 .
(3) تحرير الوسيلة 2 : 231، مسألة 20 .
(4) تفصيل الشريعة، كتاب النكاح : 39 .
(5) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 421 .
(6) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 497 .
(7) مستمسك العروة الوثقى 14 : 38 ـ 39 .
(8) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني 2 : 685 .
وفي مهذّب الأحكام : وأمّا اللمس، فيمكن أن يستفاد حكمه من حكم التغسيل(1) .
وقال بعض المعاصرين : عرف ممّا ذكرنا جواز اللمس من الجوانب كلّها ، لمس الصبيّ والصبيّة للرجل والمرأة ، ولمس الرجل والمرأة لهما بدون ريبة(2) .
-
(1) مهذّب الأحكام 24 : 47 .
(2) الفقه، كتاب النكاح 1 : 181 .
المبحث الثالث : تقبيل الرجل الصبيّة والمرأة للصبيّ
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : تقبيلهما قبل أن يأتي عليهما ستّ سنين
يجوز للرجل تقبيل الصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة وفي معرض الفتنة .
قال السيّد في العروة : «لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ، ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة ». وبه قال جميع المحشّين عليها(1) .
وفي المستمسك في ذيله : «هذا في الجملة لا إشكال فيه، وتقتضيه السيرة القطعيّة، مضافاً إلى أصل البراءة»(2) . وكذا في مهذّب الأحكام(3) .
وجاء في مباني العروة : «لا خلاف فيه بين الأصحاب»(4) .
أدلّة هذا الحكم
ويمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : السيرة العمليّة القطعيّة كما تقدّم .
-
(1) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 497 .
(2) مستمسك العروة الوثقى 14 : 41 .
(3) مهذّب الأحكام 24 : 48 .
(4) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 90 .
الثاني : الأصل ، وعدم الدليل على حرمته .
الثالث : النصوص، وهي العمدة .
1 ـ خبر زرارة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي(1) لك أن تقبّلها»(2) .
2 ـ مرفوعة زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين»(3) .
3 ـ مرسلة علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي(عليه السلام)عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبدالله(عليه السلام)، وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن(عليه السلام) أمسكها بيديه ممدودتين وقال : «إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه»(4) .
4 ـ خبر عبد الرحمن بن بحر، عن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها»(5) .
ودلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة; لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيّة جواز تقبيل الرجل الصبيّة التي لم تبلغ ستّ سنين، ويؤيّدها سائر أخبار الباب(6) ،
-
(1) وكلمة لا ينبغي وإن كانت ظاهرة في المرجوحيّة فقط، إلاّ أنّ كثرة الاستعمال في الروايات في الحرمة صارت موجباً لحملها على الحرمة. م ج ف.
(2) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح2 .
(3) نفس المصدر والباب، ح4 .
(4) وسائل الشيعة 14 : 170 و 171 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح، ح6.
(5) نفس المصدر ح7 .
(6) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح .
تمسّك ببعضها في المستمسك(1) وغيره(2) ولكن في سندها إشكال .
قال السيّد الفقيه الخوئي : «إنّ جميع أخبار الباب لا تخلو من ضعف سنديّ أو قصور دلاليّ على سبيل منع الخلوّ»(3) .
نقول : أوّلاً : بعض هذه الأخبار معتبر، مثل ما رواه في الكافي بسند صحيح عن على بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي ـ وأظنّني قد حضرته ـ قال: سألته عن جارية (جويرية خ ل) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واُقبّلها؟ فقال: اذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(4) بن نعمان أباعبدالله(عليه السلام) وذكر نحوه(5) فإنّ قوله «وأظنّني قد حضرته» مشعر على أنّ عبدالله بن يحيى الكاهلي سمع مباشرة السؤال والجواب، إلاّ أنّها مضمرة .
وثانياً : أنّ الصحّة عند المتقدِّمين (رض) على ما صرّح به غير واحد(6) عبارة عن الوثوق والركون لا القطع واليقين(7) .
ولايبعد أن يحصل لنا الوثوق والاطمئنان بصدور مضمون هذه الأحاديث
-
(1) مستمسك العروة الوثقى 14 : 41 .
(2) مهذّب الأحكام 24 : 48 ، الفقه، كتاب النكاح 1 : 186 .
(3) مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح 1 : 92 .
(4) في الفقيه : محمّد بن النعمان.
(5) الكافي 5: 533 ح1، الفقيه 3: 275 ح1307، وسائل الشيعه 14: 169 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1.
(6) منهم: الشيخ البهائي(رحمه الله)، حيث قال : «كان المتعارف بين قدمائنا إطلاق الصحيح على كلّ حديث صحيح اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ». مشرق الشمسين المطبوع في ضمن الحبل المتين ص269 .
(7) فرائد الاُصول 1 : 206 .
من المعصوم(عليه السلام) ; لكثرتها(1) ووحدة مضامينها ، وأيضاً موافقة تلك الأخبار
للسيرة القطعيّة العمليّة قرينة على صحّتها .
قال السيّد حسن الصدر : «وحَبَسَ آخرون نفوسهم على الأخذ بما يحصل به الوثوق من الكتب المعتمدة : كاُصول من أجمعت لهم العصابة . . . والكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها من كتب الإماميّة الإثنى عشريّة، ككتاب الصلاة لحريز وكتب ابني سعيد»(2) . .
وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : «وممّا يوجب الوثوق بالحديث والركون إليه أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها; سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة، ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله السجستاني وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار أو من غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي و . . .»(3) .
ورواية عبد الرحمن بن بحر، عن زرارة هي التي رواها حسين بن سعيد كما في التهذيب(4) .
وثالثاً : قال في روضة المتّقين «إنّ رواية أبي أحمد الكاهلي حسن كالصحيح ، وخبر زرارة من القوي كالصحيح ، ومرسلة هارون بن مسلم من القوي»(5) .
ورابعاً : قال علم الهدى : «إنّه ليس كلّ ما رواه أصحابنا من الأخبار وأودعوه في كتبهم ـ وإن كان مستنداً إلى رُواة معدودين من الآحاد ـ معدوداً
-
(1) عقد في الوسائل 14: 167، كتاب النكاح، باباً لهذا الحكم وذكر فيه ثماني أحاديث من المشايخ الثلاثة .
(2) نهاية الدراية في شرح الوجيزة للسيّد حسن الصدر : 279 ـ 280 .
(3) مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين : 269 .
(4) تهذيب الأحكام 7 : 479 ـ 480، وذكر فيه ثماني روايات متواليات عن حسين بن سعيد، وهذا قرينة ظاهراً على أنّه ذكر الشيخ(قدس سره) في هذه الروايات من كتاب ابن سعيد .
(5) روضة المتّقين 8 : 358 .
في الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواترٌ موجب للعلم»(1) .
وجاء في الوافي : «وقال صاحب (التهذيب) في كتاب العدّة : إنّ ما أورده في كتابي الأخبار إنّما آخذه من الاُصول المعتمدة عليها»(2) .
وفي الفقيه : «إنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمدبن محمّدبن عيسى»(3) .
فلا وجه لما ذكره السيّد الخوئي(قدس سره)(4) من أنّ جميع أخبار الباب ضعيفة سنداً أو دلالةً ; لأنّ جملة من هذه النصوص ظاهرة في جواز تقبيل الرجل الصبيّة قبل ستّ سنين من غير شهوة .
وأمّا إذا كان تقبيل الرجل للصبيّة المشار إليها عن شهوة وتلذّذ فلا يجوز; لإجماع الفقهاء الأعلام وسيرة المتديّنين من العوام، كما في مهذّب الأحكام(5) .
وفي المستمسك : «وأمّا إذا كان عن شهوة فلما عرفت من الإجماع الارتكازي على الحرمة»(6) .
ولا ريب أنّ في ارتكاز المتشرّعة المنع من التقبيل إذا كان كذلك، وأيضاً أنّه ممّا علم بالضرورة مبغوضيّته عند الشارع .
-
(1) رسائل الشريف المرتضى 1 : 26 رسالة التبانيات .
(2) كتاب الوافي 1 : 23 .
(3) من لا يحضره الفقيه 1 : 3 .
(4) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 92 .
(5) مهذّب الأحكام 24 : 48 .
(6) مستمسك العروة الوثقى 14 : 42 .
المطلب الثاني : تقبيلها بعد أن يأتي عليها ستّ سنين
الظاهر أنّه لا يجوز للرجل أن يقبِّل الصبيّة التي ليست له بمحرم بعد أن يأتي عليها ستّ سنين، ويمكن أن يستفاد هذا الحكم من النصوص المتقدِّمة وإن لم يطرح في كلمات الفقهاء، وهي ما يلي :
1 ـ قوله(عليه السلام) في رواية أبي أحمد الكاهلي المتقدِّمة «إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك»(1) .
قال السيّد الخوئي في تقريب الاستدلال : «فإنّ السؤال فيها عن الحمل والتقبيل، إلاّ أنّه(عليه السلام) قد أجاب بالنهي عن وضعها في الحجر إذا أتى عليها ستّ سنين ، وهو يكشف ـ بحسب متفاهم العرفي كما هو واضح ـ عن أنّه(عليه السلام) إنّما أجاب عمّا هو أهون منهما ، فيستفاد منها أنّه لا مانع من التقبيل والحمل ما لم تبلغ الصبيّة ستّ سنين، فإذا بلغت ذلك فلا يجوز وضعها في الحجر فضلاً عن حملها أو تقبيلها ، إلاّ أنّ الرواية ضعيفة بأبي أحمد الكاهلي ، فلا مجال للاعتماد عليها»(2) .
نقول : والظاهر أنّ عبدالله بن يحيى الكاهلي كان حاضراً في المجلس; لأنّه قال : «وأظنّني قد حضرته» فالرواية معتبرة، ولا يضرّ بأنّ أبي أحمد الكاهلي لا توثيق له; لأنّه السائل وعبدالله يسمع، ويؤيّده ما في روضة المتّقين من أنّ هذا الحديث حسن كالصحيح(3)، إلاّ أنّ الرواية مضمرة. وكذا ما في جملة «أظنّني» .
2 ـ صحيحة عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل محمّد بن النعمان أباعبدالله(عليه السلام) فقال له : عندي جويرية ليس بيني وبينها رحمٌ ولها ستّ سنين، قال :
-
(1) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح1 .
(2) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 90 .
(3) روضة المتّقين 8 : 357 .
«لاتضعها في حجرك»(1) .
فإذا نهى الإمام(عليه السلام) عن الوضع في الحجر فالنهي عن التقبيل بطريق أولى، كما في الرواية المتقدّمة ; ولا ريب أنّ مناط الأولويّة وعدمها هو الأهمّية عند الشارع بحسب ترتّب المفاسد عليه ، ومن الواضح أنّ المفسدة التي تترتّب على التقبيل تكون ذات أهمّية أكثر من مفسدة الوضع في الحجر ; لأنّ التلذّذ والاستمتاع في التقبيل أشدّ وثوران الشهوة فيه أكثر ، فلا وجه لما ذكره في مباني العروة من أنّ الأولويّة في رواية أبي أحمد الكاهلي إنّما اُستفيدت من إعراض الإمام(عليه السلام)عن الجواب عن المسؤول عنه، والإجابة ببيان حكم الوضع في الحجر(2) .
3 ـ رواية علي بن عقبة; لأنّه جاء فيها: أنّ أبا الحسن(عليه السلام) قال : «إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجلٌ ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه»(3) .
وكذا سائر النصوص المتقدِّمة من خبر زرارة ومرفوع زكريّا المؤمن وخبر غياث بن إبراهيم ورواية عبد الرحمن بن بحر(4) .
وظاهر هذه النصوص الحرمة ; لأنّ في جملة منها النهي عن التقبيل والضمّ، وهو ظاهر في الحرمة، وكذلك النصوص المشتملة على كلمة «لا ينبغي»; فإنّها أيضاً ظاهرة في الحرمة .
ولكن في المستمسك : «إنّ المستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحرمة . . . وبعض النصوص وإن كان ظاهراً في الحرمة، لكنّه قاصر السند»(5) .
-
(1) من لا يحضره الفقيه 3 : 275 الباب 128، ح2 .
(2) مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 91 .
(3) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح6 .
(4) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح2 و4 و5 و7 .
(5) مستمسك العروة الوثقى 14 : 41 .
وتبعه في ذلك السيّد السبزواري(1) .
نقول: ويظهر ممّا تقدّم أنّ جملة من النصوص تكون صحيحة .
والعجب من السيّد الخوئي، حيث قال : ليس في المقام رواية واحدة صحيحة السند ، وتامّة الدلالة يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحكم، وعليه: فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز»(2) .
وقال المجلسي : «قوله(عليه السلام) : فلا تضعها. ظاهره الحرمة ، وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة، كما هو ظاهر خبر الثاني، والاحتياط في الترك»(3) .
وفي وسيلة النجاة وتحريرها : «الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين»(4) .
وتبعهما في ذلك الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني(5) .
نقول : لا وجه لهذا الاحتياط ولا الحمل على الكراهة ; لأنّه لا قصور في دلالة النصوص على الحرمة، ولم تكن هناك قرينة على الخلاف; وإنّما نوقش في سندها، وقد عرفت أنّه يحصل لنا الوثوق بصدور جملة من هذه النصوص من المعصوم(عليه السلام) ، فتلك الروايات تامّة الدلالة والسند في إثبات هذا الحكم .
إيضاح
واعلم أنّ ما ذكرنا في هذا المبحث من حكم تقبيل الصبيّة في كلتا الصورتين
-
(1) مهذّب الأحكام 24 : 48 .
(2) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 93 .
(3) مرآة العقول 20 : 371، ح1 .
(4) وسيلة النجاة 2 : 233 ، تحرير الوسيلة 2 : 232 ـ 233 .
(5) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 45 ـ 46 .
يجري في الصبيّ أيضاً، لوحدة الملاك(1) .
فالظاهر أنّه يجوز للمرأة تقبيل الصبيّ; للأصل، وعدم الدليل على حرمته، والنصوص المتقدّمة وإن وردت في الصبيّة ولكن يتعدّى منها إلى الصبيّ أيضاً، كما استفاد السيّد الحكيم(2) من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة(3) في التعدّي عن نظر الرجل إلى الصبيّة إلى نظر المرأة إلى الصبيّ .
وأمّا إذا كان للصبيّ أكثر من ستّ سنين وكان تقبيلها عن شهوة والتذاذ ، فلايجوز لها ذلك، والدليل عليه ما ذكرنا في تقبيل الرجل الصبيّة ; إذ لا شكّ أنّ في ارتكاز المتشرّعة المنع منه، وأيضاً هذا ممّا علم مبغوضيّته عند الشارع .
ببيان آخر: حيث إنّ التلذّذ والاستمتاع في التقبيل أشدّ من النظر، وثوران الشهوة أكثر ، فإذا لم يجز للمرأة النظر إلى الصبيّ الذي يأتي عليه ستّ سنين أو أكثر إذا كان عن شهوة والتذاذ ، فلا يجوز لها تقبيله بطريق أولى .
ويؤيّده أيضاً مرفوعة زكريّا المؤمن المتقدِّمة; فإنّ فيها «والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين»(4) .
أنظار فقهاء أهل السنّة في مباحث هذا الفصل
أ ـ الشافعيّة
القول الأصحّ عندهم(5) أنّه يجوز للرجل النظر إلى صغيرة لا تشتهي .
-
(1) لا وثوق لنا بوحدة الملاك في المقام، فمع عدم الرواية الدالّة على ذلك لا وجه للتعدّي. نعم، لاينبغي ترك الاحتياط. م ج ف.
(2) مستمسك العروة الوثقى 14 : 39 .
(3) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 126 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح2 .
(4) نفس المصدر : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح4 .
(5) نهاية المحتاج 6 : 189 ، منهاج الطالبين 2 : 415 .
قال النووي : «الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء لا حجاب منه»(1) .
وفي الوجيز : «لا يحلّ للرجل النظر إلى شيء من بدن المرأة إلاّ إذا كان الناظر صبيّاً . . . أو كانت صبيّة»(2) ، وبه قال غيرهما(3) .
وفي مقابل هذا، قول بالتحريم; لأنّها من جنس الإناث(4) .
وكذا قالوا بتحريم النظر إلى فرج الصغيرة والصغير(5) .
ثمّ إنّهم وإن لم يصرّحوا بحكم لمس الصبيّة، ولكن يستظهر من كلماتهم أنّ حكم لمس الرجل الأجنبيّ للصبيّة حكم نظره إليها .
قال الرافعي : «حيث يحرم النظر يحرم المسّ بطريق الأولى ; لأنّه أقوى في التلذّذ والاستمتاع ، ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال بمجرّد النظر ، ويبطل بالإنزال بالملامسة»(6) . وبه قال أيضاً النووي(7) والخطيب الشربيني (8).
وأمّا نظر الصبيّ إلى المرأة الأجنبيّة فقد جاء في روضة الطالبين :
«أنّ أمر الصبيّ يكون في ثلاث درجات :
إحداها : أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى .
والثانية : يبلغه ولا يكون فيه ثوران الشهوة وتشوّف .
والثالثة : أن يكون فيه ذلك .
-
(1) روضة الطالبين 6 : 16 .
(2) الوجيز 2 : 6 .
(3) العزيز شرح الوجيز 7 : 472 ، المجموع شرح المهذّب 17 : 300 .
(4) مغني المحتاج 3 : 130 ، حاشيتا قلوبى وعميرة : 3 / 318 .
(5) أسنى المطالب 3 : 110 ، روضة الطالبين 6 : 18 ، مغني المحتاج 3 : 130 ، نهاية المحتاج 6 : 190 .
(6) العزيز شرح الوجيز 7 : 480 .
(7) روضة الطالبين 6 : 21 .
(8) مغني المحتاج 3 : 132 .
فالأوّل: حضوره كغيبته ـ وهو كالعدم ـ ويجوز له التكشّف من كلّ وجه .
والثاني: كالمحرم ، والثالث: كالبالع.(1) .
بمعنى أنّه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه ، ويلزم الوليّ أن يمنعه من النظر، كما يلزم أن يمنعه من الزنا وسائر المحرّمات(2) .
هذا كلّه في غير المراهق . وأمّا المراهق :
فقال بعضهم : هو كالرجل البالغ الأجنبي معها ، فلا يحلّ لها أن تبرز له ; لقوله ـ تعالى ـ : ( ...أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) الآية(3) ، ومعناه : لم يقووا على الجماع ، والمراهق يقوى على الجماع ، فهو كالبالغ(4) .
وقال النووي : «لظهوره على العورات»(5) .
وقال بعضهم : المراهق مع الأجنبيّة كالبالغ من ذوي أرحامها، لقوله ـ تعالى ـ : ( وَ إِذا بَلَغَ اْلأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا )(6) ، فأمر بالاستئذان إذا بلغوا الحلم، فدلّ على أنّه قبل أن يبلغوا الحلم يجوز دخولهم من غير استئذان(7)إلاّ في الأوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهنّ ، فلابدّ من الاستئذان . . . فعلى هذا ، فنظره كنظر البالغ إلى المحارم(8) .
ب : الحنفيّة
إنّهم قالوا: إن كانت صغيرة لا يشتهي مثلها فلابأس بالنظر إليها ومن مسّها ;
-
(1) روضة الطالبين 6 : 16 .
(2) روضة الطالبين 6: 16.
(3) سورة النور 24 : 31 .
(4) البيان 9 : 128 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 472 .
(5) روضة الطالبين 6 : 16 ، المجموع 17 : 300 .
(6) سورة النور 24 : 59 .
(7) البيان 9 : 128 ، روضة الطالبين 6 : 16 ، المجموع 17 : 300 .
(8) العزيز شرح الوجيز 7 : 472 .
لأنّه ليس لبدنها حكم العورة ، ولا في النظر والمسّ معنى خوف الفتنة ، ولأنّ العادة الظاهرة ترك التكلّف بستر عورتها قبل أن تبلغ حدّ الشهوة، وأمّا النظرة إلى العورة حرام(1) .
وقال ابن عابدين : «لا عورة للصغير جدّاً وكذا الصغيرة . . . فيباح النظر والمسّ ، ثمّ قال : إذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدّ الشهوة يغسلهما الرجال والنساء»(2) .
وقال بعض آخر : «يشترط لجواز المسّ أن يكون أحدهما مأموناً; لأنّ أحدهما إذا كان لا يشتهي لا يكون اللمس سبباً للوقوع في الفتنة ، كالصغير ; لأنّه لا يؤدّي إلى الانتهاء من الجانبين ; لأنّ الكبير لايشتهي بمسّ الصغير ، ولهذا إذا مات صغير أو صغيرة تغسّله المرأة والرجل ما لم تبلغ حدّ الشهوة ، وكذا يجوز النظر إلى الصغير والصغيرة والمسّ إذا كان لا يشتهي»(3) .
وأمّا بالنسبة إلى إبداء الزينة للطفل ونظره إلى النساء، قال الكاساني : «إذا كان الطفل لم يظهر على عورات النساء ولا يعرف العورة من غير العورة ، فلا بأس لهنّ من إبداء الزينة لهم ; لقول الله ـ عزّوجلّ ـ : ( ...أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ )(4). وهذا مستثنى من قوله ـ تعالى ـ : ( وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . )الآية(5) . . .
وأمّا الذي يعرف التمييز بين العورة وغيرها وقرب من الحلم ، فلا ينبغي للمرأة أن تبدي زينتها له ، ألا ترى أنّ مثل هذا الصبيّ قد اُمر بالاستئذان في بعض
-
(1) المبسوط للسرخسي 10 : 155 ، الفتاوى الهندية 5 : 329.
(2) حاشية ردّ المحتار 1 : 407 وج 6 : 364 .
(3) تكملة البحر الرائق 8 : 353 .
(4 ، 2) سورة النور 24 : 31 .
الأوقات بقوله ـ تعالى ـ : ( وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّات )(1) »(2).
ج : الحنابلة
قالوا: بأنّ الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها بغير شهوة ، ففي المغني والشرح الكبير: قال أحمد في رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبّلها : فإن كان يجد شهوةً، فلا وإن كان بغير شهوة فلا بأس(3) . وكذا في الكافي والفروع(4) .
وقال المرداوي : «وهل هو محدود بدون السبع ، أو بدون ما تشتهي غالباً؟ على وجهين»(5) .
ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلة قبل بلوغ سبع سنوات من العمر ، ولا لمسها نصّاً، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطفل(6) .
وأمّا إذا بلغت الطفلة حدّاً تصلح للنكاح كابنة تسع سنين; فإنّ عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا يقبل الله صلاة حائض إلاّ بخمار»، فدلّ على صحّة الصلاة ممّن لا تحيض وهي مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها في النظر إليها حكم ذوات المحارم بالنسبة لنظر ذوي محارمهنّ إليهنّ(7) . واللمس كالنظر فيحرم حيث يحرم النظر، بل اللمس أولى; لأنّه أبلغ من النظر(8) .
-
(1) سورة النور 24 : 58 .
(2) بدائع الصنائع 4 : 296 .
(3) المغني 7 : 462 ، الشرح الكبير 7 : 357 ـ 358 .
(4) الكافي 3 : 6 ، الفروع 5 : 112 .
(5) الإنصاف 8 : 23 .
(6) كشّاف القناع 5 : 13 ، الإنصاف 8 : 23 ، الإقناع 3 : 159 .
(7) المغني 7 : 462 ، الشرح الكبير 7 : 358 ، كشّاف القناع 5 : 13 .
(8) كشّاف القناع 5: 13.
وكذا في الفروع(1) .
وأمّا في مسألة إبداء الزينة للطفل ونظره إلى النساء، ذهبوا إلى أنّه إذا كان الطفل غير مميّز لم يجب على المرأة الاستتار منه في شيء ، ولها إبداء زينتها له; لقوله ـ تعالى ـ : ( ...أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ )(2) .
وإن كان مميّزاً غير ذي شهوة، فله أن ينظر ما فوق السرّة وتحت الركبة; لأنّه لا شهوة له . .
وإن كان الطفل مميّزاً ذا شهوة ، فحكمه حكم ذي المحرم من المرأة في النظر إليها وفي إبداء الزينة له .
وعن أحمد أنّه كالأجنبيّ ; لأنّه كالبالغ في الشهوة، ومعنى ذلك أنّ المقارب للاحتلام يعتبر كالبالغ(3) .
ذكر في الكافي في المميّز روايتين : إحداهما : هو كالبالغ ، والثانية : كذي المحرم ، لقوله ـ تعالى ـ : ( وَ إِذا بَلَغَ اْلأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ )(4) ففرّق بينه وبين البالغ(5) .
وبحسب تتبّعنا لم نجد في مذهب المالكيّة في كلّ المباحث التي طرحناها في هذا الفصل رأي .
-
(1) الفروع 5 : 112 .
(2) سورة النور 24 : 31 .
(3) المقنع : 206 ، المغني 7 : 458 ، الشرح الكبير 7 : 349 ، المبدع 7 : 10 ، الإنصاف 8 : 23 ، الإقناع 3 : 159 ، كشّاف القناع 5 : 12ـ 13 ، الفروع 5 : 109 .
(4) سورة النور 24 : 59 .
(5) الكافي في فقه أحمد 3 : 6 .
الفصل التاسع
في ولاية الأب والجدّ على أموال الصغار
تمهيد
بحثنا في ما سبق(1) أنّ الولاية على ثلاثة أقسام:
الأوّل : الولاية على النفس; وهي التي تتعلّق بالنفس من قبيل الولاية على التزويج ، وولاية الحضانة وولاية التأديب، والولاية على الإحرام وغيرها ، وقد تقدّم البحث عن بعض هذه الاُمور في الفصول السابقة، ويأتي عن بعضها الآخر في الأبواب الآتية .
الثاني : الولاية على المال; وهي التي تتعلّق بأموال الصغار والمجنون والسفيه; لأنّ الولد الصغير كما يحتاج إلى من يقوم بإرضاعه وحضانته وكفالته، كذلك يحتاج إلى من يراعي مصلحته في أمواله بحسن إدارتها وحفظها من الضياع واستثمارها والإنفاق منها على الاُمور الضروريّة له ; لأنّ الولد الصغير لِصغره ليس أهلاً لتقدير المصلحة، ولا يتصوّر منه الرضا الصحيح ولا القصد والاختيار، فلهذا منع
- (1) ج1 ص534، الفصل الأوّل من الباب الرابع.
من التصرّفات في ماله ، فالحجر على الولد الصغير إنّما كان لعجزه عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة ، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن حجر عليه ، ولكن جعل الولاية في أموال الصغار إلى من يحفظها وينميها لهم .
وأمّا الثالث: وهو الولاية على استيفاء حقوق الصغار، فيأتي البحث عنه في الأبواب الآتية.
وينبغي أن نبحث هنا عن الأولياء الذين لهم الولاية مَنْ هم ؟ وما الدليل على ولايتهم ، وما هو الشرط في إثبات الولاية لهم ؟ يعني هل إثبات الولاية للوليّ مشروطٌ بأن يكون الوليّ عادلاً، أو يكفي أن يكون فعله ذا مصلحة وإن لم يكن عادلاً ، أو لا ذا ولا ذاك، بل يكفي أن لا يكون في فعله مفسدةٌ ؟ وهكذا .
للبحث والتحقيق عن هذه الاُمور عقدنا هذا الفصل ، وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : ثبوت ولاية الأب والجدّ على الأموال وأدلّتها
لا خلاف في ثبوت الولاية للأب والجدّ له على الطفل إلى أن يبلغ الرشد ، وأنّ ولايتهما بجعل إلهيّ ; أي كان كلّ واحد منهما وليّاً إجباريّاً من قبل الشارع .
قال الشيخ (رحمه الله): «من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجدّ، والإمام أو من يأمره الإمام»(1) .
وقال المحقّق : «يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكاً أو وليّاً، كالأب والجدّ للأب والحاكم وأمينه والوصيّ»(2) . وكذا في الوسيلة(3) . وصرّح به العلاّمة في بعض كتبه(4) . وبه قال الشهيد الأوّل(5) ويحيى ابن سعيد(6) ، والمحقّق(7) والشهيد(8) الثانيان ، والمحقّق الأردبيلي(9) .
واختاره جماعة من متأخِّري المتأخِّرين(10) وفقهاء العصر(11) .
-
(1) المبسوط للطوسي 2 : 200 .
(2) المختصر النافع : 146، شرائع الإسلام 2 : 14 .
(3) الوسيلة لابن حمزة : 279 .
(4) قواعد الأحكام 2 : 135 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2: 541 ، التبصرة : 96 ، إرشاد الأذهان 1 : 360 .
(5) اللمعة الدمشقيّة : 62 .
(6) الجامع للشرائع : 246 و282 .
(7) جامع المقاصد 5 : 187 وج 4 : 85 .
(8) الروضة البهيّة 4 : 105 ـ 106 ، مسالك الأفهام 3 : 164 ـ 166 .
(9) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 230 ـ 236 .
(10) رياض المسائل 5:63، المناهل: 105، الحدائق الناضرة 18: 403، شرح تبصرة المتعلِّمين للمحقّق العراقي5:38 ـ 41، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء5:126، كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم16:535،المكاسب والبيع للنائيني 2: 330، حاشية الإيرواني على المكاسب: 153، جامع المسائل للفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني 2:303 ـ 304.
(11) مصباح الفقاهة 5:11، منهاج الصالحين للسيّدالخوئي2:181، كتاب البيع للإمام الخميني(رحمه الله)2:435، إرشادالطالب 3:3.
قال في تحرير الوسيلة: «ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما . . . ومع فقده للحاكم الشرعي . . . ومع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط»(1).وكذا في تفصيل الشريعة(2).
وممّا ذكرنا من كلمات الفقهاء ظهر الترتيب في الولاية على الأموال عندهم أيضاً، وأنّه هو الأب والجدّ للأب وإن علا ، والوصيّ(3) من أحدهما، ثمّ الحاكم الشرعي(4) وأمينه; وهو المنصوب من قبله لذلك أو لما هو أعمّ .
ولقد أجاد في الحدائق في تنقيح ترتيب الأولياء في المقام، حيث قال : «الأولياء هم ستّة على ما ذكره الأصحاب ، وسبعةٌ على ما يستفاد من الأخبار ـ وبه صرّحوا أيضاً في غير هذا الموضع ـ : الأب والجدّ له ـ لا الاُمّ ـ والوصي من أحدهما ـ على من لهما الولاية عليه ـ والوكيل من المالك أو ممّن له الولاية، والحاكم الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدّمة، وأمينه; وهو المنصوب من قبله لذلك أو لما هو أعمّ، وعدول المؤمنين مع تعذّر الحاكم، أو تعذّر الوصول إليه»(5) .
وما استدلّ به الفقهاء أو يمكن أن يستدلّ به لإثبات ولاية الأب والجدّ على أموال الصغار اُمورٌ :
الأوّل : الإجماع ، قال المحقّق الأردبيلي : «كأنّه للإجماع المنقول»(6) ،
-
(1) تحرير الوسيلة 2 : 14، كتاب الحجر مسألة 5 .
(2) تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة والحجر: 299.
(3) لأنّه مع بقاء الموصي لا معنى لجواز تصرّف الوصيّ .
(4) لدلالة الحديث النبوي المنجبر بعمل الأصحاب، وهو «السلطان وليّ من لا وليّ له» سنن أبي داود 2 : 391 ح2083 ، سنن الترمذي 3: 408 ح1103، سنن ابن ماجة 2: 434 ح1879.
(5) الحدائق الناضرة 18 : 403 .
(6) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .
وفي التذكرة: «الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا . . .
إجماعاً»(1) ، وفي الرياض : «ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه»(2) ، وبه صرّح المحقّق النائيني(3) .
وقال السيّد الخوئي : «ولاية الأب والجدّ وثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروريّ الفقه ومورد الإجماع والسيرة المستمرّة القطعيّة»(4) .
وقال المحقّق العراقي: ويدلّ عليه ـ علاوةً على الإجماعات بل السيرة ـ عموم «أنت ومالك لأبيك»(5) (6).
الثاني : السيرة المستمرّة القطعيّة ، كما أشرنا إليها .
الثالث : ـ وهو العمدة ـ النصوص الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة; وهي على طوائف نذكرها على الترتيب التالي :
الطائفة الاُولى: تدلّ على جواز تزويج الأب والجدّ للصغار:
الأخبار الواردة في باب تزويج الأب والجدّ للصغار، وفيها الصحاح والموثّقات، وهي تدلّ بالصراحة على ثبوت ولايتهما على تزويج أولادهما الصغار ، وقد سبق ذكر جملة منها(7) (8) في إثبات ولاية الأب والجدّ على التزويج.
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 :80 ، الطبعة الحجريّة، كتاب الحجر الفصل الرابع .
(2) رياض المسائل 5 : 63 و390 .
(3) المكاسب والبيع 2 : 330 .
(4) مصباح الفقاهة 5 : 11 ، مهذّب الأحكام 21 : 126 .
(5) وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(6) شرح تبصرة المتعلِّمين 5 : 38 .
(7) راجع موسوعة أحكام الأطفال 1/537
(8) وسائل الشيعة 14 : 207 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، وص217 الباب 11 وص220 الباب 12 .
وقد استدلّ في مفتاح الكرامة(1) والرياض(2) وكذا الشيخ الأعظم(3) بفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح .
فقالوا : إذا صحّ ولاية الأب والجدّ على الأولاد الصغار في النكاح وكونهم سبباً في إيجاد التزويج بينهم مع كونه من أهمّ الاُمور، فلا شبهة في جواز ولايتهم ونفوذ أمرهم في سائر العقود، بالفحوى والأولويّة القطعيّة .
الطائفة الثانية : تدلّ على أنّ الولد وماله للأب :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال : في كتاب عليّ(عليه السلام): إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك(4) .
ومنها : معتبرة الحسين بن أبي العلاء ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : «قوته «قوت خل» بغير سرف إذا اضطرّ إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يارسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء، أو كان
-
(1) مفتاح الكرامة 5 : 256 .
(2) رياض المسائل 5 : 391 .
(3) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .
(4) وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح1 .
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)يحبس الأب للابن»(1)؟! ورواه الصدوق في الفقيه ومعاني
الأخبار(2) والشيخ في التهذيب والاستبصار(3) .
ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي(4).
ومنها : رواية الصدوق في عيون أخبار الرضا(عليه السلام) وعلل الشرائع(5) .
وكيفيّة الاستدلال بتلك الأخبار بأن يقال: حرف اللاّم في كلمة «لأبيك» للاختصاص، وفيه احتمالات ثلاث :
الأوّل: أن يكون الاختصاص بنحو الملك والولد وماله ملكاً للأب .
الثاني : أن يكون الاختصاص بنحو الولاية; يعني أنّ ولاية الأب ثابتة على الولد وماله .
الثالث : أن يكون الاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به وبماله، كما أشار إليها المحقّق الاصفهاني(6) .
أمّا الاحتمال الأوّل: فباطل قطعاً ; لأنّه من البديهي أنّ المراد بهذه الروايات ليس ما هو الظاهر منها; من كون الولد وما بيده من متملّكات أبيه ليكون الابن كعبد الأب والبنت كالجارية، بداهة أنّ رقبة الولد غير مملوكة لأحد، وأيضاً ليس المراد بتلك النصوص كون مال الولد للأب حقيقة بحيث يفعل ما يشاء .
وبعد تعذّر الأخذ بظاهرها لابدّ من حملها على معنى كنائيّ، كما يقال في العرف
-
(1) نفس المصدر والباب، ح8 .
(2) الفقيه 3: 109 ح456، معاني الأخبار : 155 ح1 .
(3) تهذيب الأحكام 6 : 344 ح966 ، الاستبصار 3 : 49 ح162 ، الكافي 5 : 136 ، ح6.
(4) وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
(5) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2 : 96 ، علل الشرائع 2 : 524 باب 302 ح1 .
(6) حاشية المكاسب 2 : 373 .
في مورد صحّة تصرّف الغير: إنّ العبد وما في يده لمولاه ، والمعنى الكنائي هو
أن ينزّل الولد وما له بمنزلة الملك للأب .
فنقول : إنّ الأب مالك للولد وما له ، تنزيلاً بأن يعامل معه معاملة مال نفسه وإن لم يكن مالكاً حقيقةً ; لأنّ المتفاهم من هذا التركيب ونحوه من المخاطبات العرفيّة: أنّ المال مال الأب بحسب التنزيل لا حقيقة .
فمقتضى هذه المالكيّة التنزيليّة جواز الانتفاع بماله إذا كان فقيراً ومحتاجاً، كما هو مفاد صحيحتي محمّد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي المتقدّمين، حيث علّل الحكم فيهما بقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «أنت ومالك لأبيك» .
فالمستفاد(1) منهما أنّ للأب السلطنة على جميع التصرّفات الراجعة إلى الولد وماله ، بشرط أن لا يوجب الفساد والإسراف ، ولكنّ الولد الكبير خرج منهما إمّا بالدليل، وإمّا تنصرف أدلّة الولاية عنه(2) .
قال الإمام الخميني(قدس سره): «يظهر من تلك الروايات ومن غيرها حدود جواز الأخذ بلا إذن من الابن، وليس المقصود من قوله(صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك» ولاية الأب على ولده الكبير أو جواز أخذه من ماله كيفما كان . . .»(3).
والحاصل : أنّه يستفاد من تلك الأخبار أنّ للأب التصرّف في مال ولده الصغير ونفسه; لأنّه وماله لأبيه وللجدّ وإن علا .
-
(1) والحق ما ذهب إليه الاصفهاني(قدس سره); من أنّ للأب جواز الانتفاع بمال ولده من غير سرف، وفيما اضطرّ إليه، ولا يستفاد من هذه الروايات ولاية التصرّف والسلطنة على جميع التصرّفات، كما أنّه لا فرق بين الأخذ من مال الولد الصغير أو الكبير. وأيضاً يستفاد منها عدم ضمان الأب فيما استفاد من ماله، وبالجملة: يستفاد منها الحكم التكليفي والوضعي معاً. م ج ف.
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 537 ، المكاسب والبيع للمحقّق النائيني 2 : 331 .
(3) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 439 و440 مع تصرّف .
إيراد المحقّق الاصفهاني والجواب عنه
أورد المحقّق الاصفهاني على الاستدلال بتلك الأخبار في المقام بوجهين :
الأوّل : أ نّ جواز اقتراض الأب من مال الصغير ينافي هذه الملكيّة التنزيليّة، إذ لو كان الولد وماله ملكاً للأب لا معنى للاقتراض; لأنّه لا يقترض الإنسان من ماله .
الثاني : أنّه ورد في الروايات أنّه يجوز للأب أن يُقوّم جارية ابنه أو بنته ويبيعها لنفسه، ولا يعقل أن يقوّم شخص ماله ويشتريه من نفسه ، ووافقه في ذلك تلميذه المحقّق السيّد الخوئي(1) .
ويمكن الجواب(2) عنهما بأن يقال : لو كان هناك ملكيّة حقيقيّة صحّ أن يقال: لا يعقل أن يقترض الإنسان من مال نفسه، أو يشتري من ماله، ولكن قلنا بأنّ للأب ملكيّة تنزيليّة لولايته على أموال الصغير، وباعتبار أنّ الأب مالك تنزيلاً يجوز له أن يُقرض من مال الصغير، وباعتبار أنّه غير مالك واقعاً يستقرض من مال الصغير، وكذلك في الجارية .
فعلى هذا باعتبار أنّ الأب مالك لها تنزيلاً يقوّمها ويبيعها، وباعتبار أنّه غير مالك حقيقةً يشتريها ويملّكها; لأنّ الاقتراض والبيع من الاُمور الاعتباريّة وهي سهل المؤونة، فلا يرد أنّ الأب مقرض ومقترض، أو أنّه بائع ومشتر; لأنّ الأب هنا متعدّد اعتباراً ولو كان واحداً في الواقع .
-
(1) حاشية المكاسب 2 : 374 ، مصباح الفقاهة 5 : 16 .
(2) والجواب مخدوش جدّاً، لأنّ الملكيّة التنزيليّة أثرها كون الأب بمنزلة المالك الحقيقي، وتصرّفه بمنزلة تصرّف المالك الحقيقي. وعليه: لا معنى لكونه مقرضاً ومقترضاً بالاعتبارين; فإنّ الاعتبار وإن كان سهل المؤونة، إلاّ أنّه لا يصحّ اعتبار مناقض لاعتبار آخر، فتدبّر. م ج ف.
إيراد المحقّق الإيرواني والسيّد الخوئي والجواب عنهما
أورد المحقّق الإيرواني على الاستدلال بتلك الأخبار أيضاً، بأنّه ليس عنوان تلك الأخبار نفوذ معاملات الأب في حقّ ابنه، وإنّما عنوانها جواز استيلاء الأب على مال ابنه وأكله منه، وتصرّف الأب في أموال ابنه تصرّف الملاّك في أموالهم، لا التصرّف فيه بعنوان الولاية على الابن، فالأخبار أجنبيّة عمّا هو المدّعى في المقام(1) .
وهكذا أورد السيّد الخوئي أيضاً «بأنّ هذه النصوص راجعة إلى بيان أمر أخلاقيّ ناشئ من أمر تكوينيّ; فإنّ الولد بحسب التكوين موهبة من الله ـ تعالى ـ للأب، ومقتضى ذلك أن لا يعارض في تصرّفاته ويكون منقاداً بأمره ونهيه»(2) .
وقال الاُستاذ الشيخ جواد التبريزي دام ظلّه تبعاً للسيّد الخوئي : «إنّ جواز أخذ الأب مال ابنه للإنفاق على نفسه ودفع اضطراره لا يقتضي ثبوت الولاية له بالإضافة إلى مال ولده»(3) .
والجواب عمّا ذكره المحقّق الإيرواني: أنّ مورد رواية عبيد بن زرارة ـ التي كالصحيحة بل صحيحة على الأصحّ(4) ـ ورواية قرب الإسناد ـ وهي معتبرةٌ أيضاً لاعتبار كتاب علي بن جعفر على قول(5) ـ هو التصرّفات الاعتباريّة، وقد استشهد
-
(1) حاشية الإيرواني على مكاسب الشيخ : 153 .
(2) مصباح الفقاهة 5: 16 .
(3) إرشاد الطالب 3: 4.
(4) لأنّه ليس في سندها من يتأمّل فيه إلاّ سهل بن زياد، والأمر فيه سهل; لأنّ المشهور على وثاقته .
(5) قال الشيخ الحرّ العاملي : «إنّما ذكرنا بعض الطرق تيمّناً وتبرّكاً باتّصال السلسلة بأصحاب العصمة(عليهم السلام)، لالتوقّف العمل عليه; لتواتر الكتب وقيام القرائن على صحّتها وثبوتها . وسائل الشيعة 20: 49.
وأيضاً طريق الشيخ الحرّ إلى الشيخ الطوسي صحيح وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر أيضاً صحيحٌ . معجم رجال الحديث 11 : 289 .
الإمام(عليه السلام) لصحّة نكاح الجدّ بدون إذن الأب بقوله(صلى الله عليه وآله) : «أنت ومالك لأبيك» قائلاً : «فكيف يكون هذا و هو وماله لأبيه، ولا يجوز نكاحه ؟»(1) .
فمن تطبيق الإمام(عليه السلام)(2) هذه القاعدة في مقام إعمال الولاية دون الأخذ والانتفاع يعلم أنّ المراد بهذه القاعدة في سائر الأخبار أيضاً معنى يشمل الولاية بقرينة اتّحاد السياق(3) .
فكيف يدّعي المحقّق الإيرواني أنّ مفادها هو جواز انتفاع الأب من أموال الولد فقط، ولا يدلّ على ثبوت الولاية عليه .
والحاصل : مفاد هذه النصوص ـ على كثرتها واختلافها في الإطلاق والتقييد ـ أنّ كلّ تصرّف اعتباريّاً كان أم خارجيّاً نافذ وجائز ، لكن وردت في التصرّفات الخارجيّة قيودٌ فيؤخذ بها في موردها، ولا حجّة لرفع اليد عن الروايات في غير مورد القيود .
وما أورده السيّد الخوئي من أنّه حكم أخلاقيّ فهو ساقط أيضاً ; لأنّ نفوذ التصرّف الاعتباري ولزوم الأخذ به لا يمكن أن يعلّل بأمر أخلاقيّ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الجدّ والأب في التصرّف في مال الطفل بالبيع والشراء وغيرهما بمفاد هذه الأخبار .
-
(1) وسائل الشيعة 14 : 219 الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح5 .
(2) يمكن أن يقال: إنّ تطبيق الإمام(عليه السلام) لا يدلّ على كون القاعدة بنفسها كليّة عامّاً، وإلاّ فاللاّزم أن يستفاد منها الاختصاص التامّ المالكي كما هو ثابت للابن، مع أنّه لم يذهب إليه أحد، وعلى هذا فالتطبيق يدلّ على دلالتها في هذا المورد، وبما أنّ القاعدة تعبّدية فلا يمكن استفادة حكم كلّي عامّ بالنسبة إلى جميع الموارد. نعم، يمكن الاستناد إلى الأولويّة، لكن مرجع هذا إلى الدليل الأوّل. وعليه: فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الإيرواني ومن تبعه. م ج ف.
(3) كتاب البيع للمحقّق الفقيه الآراكي 2: 9.
الطائفة الثالثة : تدلّ على أنّ للأب تقويم جارية ولده لنفسه:
وردت نصوص ودلّت على أنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ولده ويأخذها لنفسه ثمّ يطأها ، فيمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً في المقام; وهي ما يلي :
1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان . قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله(عليه السلام) ـ ماذا يحلّ للوالد من مال وَلَدِه؟ قال : «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال : ويعلن ذلك ـ إلى أن قال :ـ فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضّها(1) فليقوّمها على نفسه قيمة ، ثمّ ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع»(2) .
2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام); لأنّ في ذيلها في كتاب عليّ(عليه السلام) ... : وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك(3).
3 ـ صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية ووُلده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها(4) .
4 ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) قال : قلت
-
(1) كذا في الاستبصار 3: 50، ح 163; وتهذيب الأحكام 6: 345، ح 968 . والظاهر هو الصواب، ولكن في الوسائل «يقتضيها».
(2) وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح3، رواها في الاستبصار والوسائل عن حسين بن سعيد، عن حمّاد إلخ . ولكن في التهذيب الحسين بن حمّاد.
(3) تهذيب الأحكام 6 : 343 ح961 ، الاستبصار 3 : 48 ح157 ، الكافي 5 : 135 ح5 ، وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح1 .
(4) وسائل الشيعة 14 : 543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1 .
له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على
نفسه بثمنها أحبّ إليّ(1) .
ونحوها صحيحة داود بن سرحان(2) وموثّقة إسحاق بن عمّار(3) ومكاتبة الحسن بن محبوب(4) وصحيحة عبد الرحمن(5) .
ومفاد هذه الأخبار ـ مع قوّة سندها ـ أنّه يجوزللأب تقويم الجارية وبيعها لنفسه وتملّكها بقيمة عدل وعليه ثمنها لولده، وهذا هو معنى الولاية على أموال الصغار.
قال الشيخ (رحمه الله) : «وما تضمّنته هذه الأخبار من أنّ للأب أن يطأ جارية ابنه إذا قوّمها على نفسه ما لم يمسّها الابن، محمول على أنّه إذا كان ولده صغاراً، ويكون الأب هو القيّم بأمرهم والناظر في أحوالهم، فيجري مجرى الوكيل، فيجوز للأب أن يقوّمها على نفسه»(6) .
الايراد على الاستدلال بهذه الأخبار والجواب عنه
أورد المحقّق الإيرواني على الاستدلال بتلك النصوص لولاية الأب والجدّ على أموال الصغار ، بأنّ في بعض هذه الأخبار تقويم جارية الولد البالغ ، كالرواية المتضمِّنة لشكاية الولد إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) وتقديم عقد الجدّ بأنّها وأباها للجدّ ،
والاستدلال بها يقتضي ثبوت ولاية الأب على الولد البالغ وماله ، ولا ريب أنّه
-
(1) نفس المصدر والباب، ح3 .
(2) نفس المصدر والباب، ح4 .
(3) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
(4) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(5) نفس المصدر 13 : 337 الباب 5 من كتاب الهبات، ح4 .
(6) الاستبصار 3 : 51 .
لا ولاية له على ولده البالغ وماله ، ووافقه في هذا الإشكال السيّد الخوئي(قدس سره)
والاُستاذ الفقيه الشيخ جواد التبريزي دام ظلّه(1) .
ويمكن الجواب عنه: بأنّ دلالة هذه الأخبار وغيرها على التصرّفات المعامليّة والتصرّفات الخارجيّة للأب في أموال الصغار واضحةٌ لا شبهة فيها . وأمّا الولد البالغ وابنته البالغة كما في مكاتبة الحسن بن محبوب(2) ، فنقول :
أوّلاً: بأنّ الأخبار تنصرف(3) عن ولاية الأب على البالغين ; لأنّه من المعهود أنّ البالغ مكلّف ومستقلّ في نفسه وماله، ولا سلطنة للغير عليه وعلى ماله، وهو كالضروريّ .
وثانياً : لو قلنا بأنّ الأدلّة مطلقة تشمل الولاية على البالغين أيضاً، ولكن تحمل على المقيّدات ويعمل بها في غير موردها، وهو مورد ولاية الأب والجدّ على مال الطفل ونفسه، كما يستظهر هذا من بعض عبائر الإمام الخميني(قدس سره)(4) .
الطائفة الرابعة: تدلّ على أنّه لو اتّجر بمال الطفل ففيه الزكاة:
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : هل على مال اليتيم زكاةٌ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يتّجر به أو تعمل به »(5) . حيث تدلّ على جواز الاتّجار بمال الطفل، وتثبت الولاية للأب أيضاً بعدم القول بالفصل .
ومنها : صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : في مال اليتيم عليه
-
(1) حاشية الإيرواني على المكاسب 2 : 363 ، مصباح الفقاهة 5 : 16 ، إرشاد الطالب 3 : 4 .
(2) وسائل الشيعة 12: 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح1.
(3) لا يخفى أنّه بعد كون مورد بعض الأخبار هو الولد البالغ فلا وجه لدعوى الانصراف. م ج ف.
(4) كتاب البيع 2 : 439 و 442 .
(5) وسائل الشيعة 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح1 .
زكاة؟ فقال : «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»(1) . ودلالتها كالمتقدّمة واضحة .
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان، والزكاة(2) .
ومنها : خبر محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال : «لايجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه»(3) . وكذا روايات سعيد بن السمّان(4) وأبي العطارد الخيّاط(5)ومنصور بن الصيقل(6) .
وهذه الأخبار مع أنّ فيها الصحاح والموثّقات تدلّ على جواز التصرّفات المعامليّة، كالاتّجار والبيع والشراء بمال الطفل، وأنّ هذه المعاملات صحيحةٌ نافذةٌ شرعاً، فينتج لأجل صحّة هذه التصرّفات إثبات ولاية الأب والجدّ والوصيّ وغيرهم، كأمين الحاكم وعدول المؤمنين، وحيث اقتصر في خبر محمّد بن الفضيل على جواز التصرّف للأب، فيثبت ولايته فقط ، ولكن إطلاق الوارد في سائر النصوص يشمل الجدّ أيضاً وكذلك يطلق الأب على الجدّ، مضافاً إلى إمكان إثبات ولايته بعدم القول بالفصل أيضاً .
الطائفة الخامسة: تدلّ على كفاية قبض الأب في باب الوقف:
وردت في باب الوقف والهبة نصوص تدلّ على أنّ من شرائط الوقف والهبة
-
(1) نفس المصدر : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح1 .
(2) نفس المصدر : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح5 .
(3) (4) (5) (6) نفس المصدر والباب، ح4 ، 2 ، 3 ، 7.
أن يقبضه الموقوف عليه، والموهوب له، أو من يتولّى عنهم، وأنّه يكفي قبض الأب
عن وُلده الصغار إذا كانوا هم الموقوف عليهم .
1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على وُلده وقد أدركوا : «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ; لأنّ والده هو الذي يلي أمره»(1) .
والمراد من الصدقة على الأولاد الوقف عليهم والأب يقبضه، فيتحقّق شرط لزوم الوقف; لأنّ للأب ولاية على مال ولده الصغير .
2 ـ صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: «نعم، إلاّ أن يكون صغيراً»(2). أمّا صحّة الرجوع إلى المال; فلأ نّ الموقوف عليه لم يقبضه، وإذا لم يُقَبّضْهُ الموقوف عليه، أو من يتولّى عنهم لم يصحّ الوقف وكان باقياً على ما كان عليه من الملك(3) . فيصحّ للأب الرجوع من الوقف; لأنّ المال الموقوف قبل القبض باق في ملكه .
وأمّا إذا كان الموقوف عليهم أولاده الصغار جاز الوقف; لأنّ الوالد يُقَبّضْهُ ولاية عليهم، فلا يصحّ الرجوع وقد خرج عن يده وملكه .
3 ـ وكذا صحيحة اُخرى لجميل(4) ورواية عبيد بن زرارة(5) وصحيحة ثالثة لجميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : «نعم، إلاّ أن يكون صغيراً»(6) .
-
(1) نفس المصدر 13 : 297 الباب 4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح1 .
(2) نفس المصدر والباب، ح7 .
(3) النهاية للطوسي : 595 .
(4) وسائل الشيعة 13 : 298 الباب 4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح2 .
(5) نفس المصدر والباب، ح5 .
(6) نفس المصدر 13 : 337 الباب 5 من كتاب الهبات، ح1 .
4 ـ صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال : «إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة; لأنّه يُقَبّضُ لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض» الحديث(1). وكذا موثّقة داود بن الحصين(2).
وهذه النصوص تدلّ بالصراحة على أنّ الأب هو المتولّي لأمر الصغير في الأموال.
5 ـ وكذلك الأخبار التي تدلّ على أنّ من تصدّق على ولده الصغار بشيء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار، ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : «لا بأس» (3) .
وعلّل الإمام(عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر بأنّه «يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ»(4) .
وكذا مرسلة أبان(5)، وأخبار المضاربة في مال اليتيم(6)، وهكذا طوائف اُخرى من الروايات سنذكرها في باب الوصيّة للطفل. وكذا في جواز البيع والمضاربة بماله وغيرها .
والحاصل : أنّ ولاية الأب والجدّ على أموال الصغير من ضروريّ الفقه ومورد للإجماع والشهرة، كما يطّلع عليه من تتبّع الأبواب المتفرّقة في الفقه، مثل
-
(1 ، 2) نفس المصدر والباب، ح5 و 2 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 301 الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات، ح3 .
(4) وسائل الشيعة 13 : 302 الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات، ح5 .
(5) وسائل الشيعة 13 : 334 الباب 4 من كتاب الهبات، ح1 .
(6) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا، ح1 ـ 2 .
كتاب النكاح والمضاربة والحجر والزكوات والوقوف والصدقات والهبات والوصايا وغيرها، بل هذا ممّا قامت به السيرة العقلائية; إذ ليس ذلك مخصوصاً بالشريعة الإسلاميّة، بل جاريةٌ في غيرها من الشرائع أيضاً(1) .
«الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنّة»
أ ـ الشافعيّة
قال النووي: «يلي أمر الصبيّ . . . الأب ثمّ الجدّ، ثمّ وصيّهما، ثمّ القاضي، أو من ينصبه القاضي . . .
ولّي الصبيّ أبوه بالإجماع . قال ابن حزم : الصبيّ يشمل الصبيّة والعبد يشمل الأمة (2). ثمّ الجدّ أبو الأب وإن علا، كما في ولاية النكاح . . . ثمّ الوصيّ; أي المنصوب من جهة الأب أو الجدّ، أو وصيّ من تأخّر موته منهما; لأنّه يقوم مقامه، وشرطه العدالة، ثمّ القاضي أو من ينصبه، ويسمّى: أمينه ، استدلالاً بحديث عائشة قالت : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، مرّتين أو ثلاث مرّات، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له»(3). والقاضي وليّه في النكاح كما هو وليّه في المال(4) . واختاره أيضاً الرافعي(5) والشربيني(6) .
وقال الماوردي : «إذا كان وليّ الطفل أباً أو جدّاً، فهو يستحقّ الولاية عليه
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 11 .
(2) عنه في مغني المحتاج 2: 173.
(3) أخرجه ابن ماجة 2 : 434 ب15 ح1879 وأبو داود 2 : 391 ح2083 والدارمي 2 : 96 ح2180 والبيهقي 10 : 291 ح13894 و 1395 .
(4) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 ، روضة الطالبين 3 : 475 .
(5) العزيز شرح الوجيز 5 : 80 .
(6) مغني المحتاج 2 : 173 .
بنفسه; لفضل حنوّه وكثرة نفقته، وانتفاء التهمة عنه في تصرّفاته ، ألا ترى أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وصف حاله مع ولده فقال : الولد مَجْبَنَةْ محزنة مجهلة. فوصفه بهذه الصفة; لما جُبِل عليه من محبّته»(1) .
وفي هامشه حديث عبدالله بن عثمان بن خثيم(2) قال : أخذ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)حسناً وحسيناً، فجعل هذا على هذا الفخذ، وهذا على هذا الفخذ، ثمّ أقبل على الحسن فقبّله، ثمّ أقبل على الحسين فقبّله، ثمّ قال : «اللّهمَّ إنّي أحبّهما فأحبّهما» ثمّ قال : «إنّ الولد مَجْبَنَةٌ مَبْخَلةٌ مجهلة»(3) .
ب ـ الحنفيّة
قال الكاساني في البدائع : «وأمّا الولاية في الأصل نوعان . . . وأمّا الثاني: فهو ولاية الأب والجدّ أب الأب والوصيّ والقاضي، وهو نوعان أيضاً : ولاية النكاح وولاية غيره من التصرّفات . . . أمّا الأوّل فسبب، هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما الاُبوّة ، والثاني القضاء ; لأنّ الجدّ من قبل الأب أب لكن بواسطة، ووصيّ الأب والجدّ استفاد الولاية منهما، لكان ذلك ولايةُ الاُبوّة من حيث المعنى...
أمّا الاُبوّة; فلأنّها داعيةٌ إلى كمال النظر في حقّ الصغير، لوفور شفقة الأب وهو قادر على ذلك لكمال رأيه وعقله ، والصغير عاجز عن النظر لنفسه بنفسه ، وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع; لأنّه من باب الإعانة على البرّ، ومن باب الإحسان، ومن باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهفان، وكلّ ذلك
-
(1) الحاوي الكبير 7 : 120 .
(2) نفس المصدر .
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 11: 140 ح20143، وابن ماجة في سننه 4: 216 ح3666، والبيهقي 15 : 276 ح21462، والحاكم 3 : 179 ح4771، وأحمد 6 : 178 ح17573، من حديث يعلى العامري .
حسن عقلاً وشرعاً . . ».
ثمّ شرع في بيان شرائطها ، فقال : «وأمّا شرائط الوليّ فأشياء :
الشرط الأوّل : أن يكون حرّاً . . .
الشرط الثاني : أن يكون عاقلاً فلا ولاية للمجنون; لما قلنا .
ومنها : إسلام الوليّ إذا كان المولّى عليه مسلماً»(1) .
ج ـ الحنابلة
إنّهم قائلون أيضاً بولاية الأب والجدّ ، قال ابن قدامة في الكافي : «ويتولّى الأب مال الصبيّ والمجنون; لأنّها ولاية على الصغير، فقدّم فيها الأب كولاية النكاح، ثمّ وصيّه بعده; لأنّه نائبه، فاشبه وكيله في الحياة، ثمّ الحاكم; لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت . . .»(2) وشبيه هذا الكلام في كشّاف القناع(3) .
د ـ المالكيّة
وعندهم الولاية على الصغير ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ للأب ثمّ لوصيّه أو وصيّ وصيّه، ثمّ الحاكم أومن يقوم مقامه، ولاولاية للجدّ ولاللاُمّ ولالغيرهم من الأقارب.
قال في عقد الجواهر : «ووليّ الصبيّ أبوه، وعند عدمه الوصي أو وصيّه، فإن لم يكن فالحاكم، ولا ولاية للجدّ ولا للاُمّ ولا لغير من ذكرنا»(4). وهكذا في شرح الزرقاني(5) .
-
(1) بدائع الصنائع 4 : 349 ـ 350 .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
(3) كشّاف القناع للبهوتي الحنبلي 3 : 521 .
(4) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2 : 630 .
(5) شرح الزرقاني لأبي الضياع 3 : 297 ـ 298 .
المبحث الثاني : تعميم الولاية للأجداد كلّهم
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : عدم اختصاص الولاية بالجدّ الداني
ظاهر كلمات الفقهاء أنّ الولاية لا تختصّ بالجدّ الداني، بل تعمّ العالي أيضاً، كما صرّح به في التذكرة(1) والروضة(2) والمسالك(3) والكفاية(4) والرياض(5) وغيرها(6). وادّعى في المناهل(7) أنّه لا خلاف فيه.
والوجه في ذلك ، أنّ العرف يفهم من التعليل الوارد في معتبرة عبيد بن زرارة ، ومعتبرة علي بن جعفر أنّ الأجداد كالجدّ القريب وكالأب في الولاية ، ولا فرق بين الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا; لأنّه ورد فيها «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً . . . ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ»(8) .
وهكذا إطلاق الجدّ يشمل الجدّ العالي والداني .
قال الشيخ الأعظم : «لا خلاف ظاهراً ـ كما ادّعي ـ في أنّ الجدّ وإن علا
-
(1) التذكرة 2 : 587 ، الطبعة الحجريّة.
(2) الروضة البهيّة 5 : 150 وج4 : 105 .
(3) مسالك الأفهام 4 : 161.
(4) حكاه عنه في المناهل ص105 .
(5) رياض المسائل 5 : 390 .
(6) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 442 مع تصرّف ، مصباح الفقاهة 5 : 28 ـ 29 .
(7) المناهل : 105 .
(8) وسائل الشيعة 14: 218 ـ 219 الباب 11 من أبواب عقد النكاح، ح2، 5، 7، 8 .
يشارك الأب في الحكم، ويدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص وماله ـ الذي منه مال ابنه ـ لأبيه . وما دلّ على أنّ الولد ووالده لجدّه»(1) .
وهكذا مقتضى قوله(عليه السلام) في رواية الكافي وغيره ، يجوز عليها تزويج الأب والجدّ عدم الفرق بين الأجداد .
قال الإمام الخميني(قدس سره) بعد نقل بعض الروايات المتقدّمة وتقريب الاستدلال بها ووجه الجمع بينها ما هذا نصّه: « والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل عدم الفرق بين الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا . . . فإنّه يفهم العرف من التعليل ـ الوارد في الروايات ـ أنّ الأجداد كالجدّ القريب وكالأب في الولاية ـ إلى أن قال: ـ فإنّ جعل الولاية للأب والجدّ وإن علا ليس بجعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)، بل بجعل إلهيّ ، بل لا يبعد أن يكون حكم الله تبارك وتعالى بنفوذ تصرّفاتهم موضوعاً لانتزاع الولاية، لا أنّ المجعول هي بلا واسطة »(2) .
ولكن توقّف في الجواهر وقال : «في تعدّي الحكم إلى أب الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا مع الأب نظر، ولعلّ إطلاق القائل يقتضيه . نعم، قد يتوقّف في تقديمه على من هو أدنى منه; لعدم انسباقه من الأب ، فتأمّل جيّداً»(3) .
الإيراد على الاستدلال والجواب عنه
وربما يستشكل في صحّة هذا الاستدلال بالنبوي على ولاية جدّ الجدّ وإن علا ، بأنّه يلزم منه إثبات الموضوع بالحكم ، نظير الإشكال الذي في حجّية الأخبار مع الواسطة في باب حجّية الخبر الواحد .
-
(1) المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 542.
(2) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 442 .
(3) جواهر الكلام 26 : 102 .
وتقريب الإشكال : أنّ كون الابن وماله لأبيه ثبت بالنبويّ المتقدّم(1) ، فكيف يمكن إثبات كون الأب وماله للجدّ . ومن جملة أموال الأب بحكم هذا النبوي ابنه وماله، وهكذا بالنسبة إلى جدّ الجدّ ، فيلزم أن يتحقّق الموضوع بالحكم ، ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض ، فلا يعقل أن يكون الحكم موجِداً لموضوعه ، لاستلزامه الدور المحال; لأنّ وجود الحكم يتوقّف على الموضوع، ولو توقّف الموضوع على الحكم بحسب الفرض لزوم الدور .
ويندفع هذا الإشكال بأنّ الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه لا إثبات موضوع لحكم آخر; فإنّ هذا بمكان من الإمكان ، والمقام من هذا القبيل; لأنّ ثبوت كون الابن وماله للجدّ بالنبويّ، يوجب تحقّق موضوع لحكم آخر، وهو كون الأب وماله للجدّ; لأنّه يستفاد من النبويّ الكبرى الكلّية القابلة للانحلال عرفاً، وتترتّب هذه الكبرى الكلّية على موضوعات متعدّدة، فالابن وماله للأب بحكم النبويّ ، ويثبت به موضوعٌ لحكم آخر ، وهو أنّ الأب وماله ـ ومن جملة ماله مال الابن ـ للجدّ بحكم هذا النبوي أيضاً.
وهكذا جدّ الجدّ، فكلّ حكم لموضوع يوجب لتحقّق موضوع آخر ويترتّب عليه حكمه الآخر، فتكون موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة، غايته أنّ الأحكام تكون من سنخ واحد، وتعدّد الأحكام إنّما ينشأ من انحلال قضيّة أ نّ كلّ ابن وماله لأبيه، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة، حيث إنّها تنحلّ إلى أحكام متعدّدة حسب ما لموضوعها من الأفراد(2) .
المطلب الثاني : كون الأجداد في مرتبة واحدة
بعدما ثبت أنّ للأجداد ولاية على أموال الصغار فيمكن أن يقع سؤال، وهو أنّه هل يكونوا في مرتبة واحدة، أو تختصّ الولاية بالجدّ الأدنى، وبعده الجدّ العالي،
-
(1) في ص162.
(2) حاشية الإيرواني على مكاسب الشيخ: 154 .
الكريمة على اشتراط العدالة في الولاية ـ وجيهٌ .
والدليل على هذا فهم العرف باختلاف الحيث في المورد ; فإنّهم فرّقوا بين الإخبار من حيث إنّه خبر ويدلّ على واقعة في الخارج، وبين الإخبار من الوليّ من حيث إعمال ولايته على مال الصغير .
الثاني : ما يستفاد من كلام الإمام الخميني (رحمه الله)، وهو أنّه لا إطلاق(1) في الآية الكريمة بالنسبة إلى عدم قبول قول وليّ الفاسق; حيث إنّ ظاهر الآية ـ ولو بملاحظة التعليل الوارد فيها ـ عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق في الوقائع المهمّة، نحو خبر الوليد بكفر بني المصطلق; لأنّ الاعتماد في مثله يوجب تجهيز الجيش وقتال المرتدّين ، وقتل العامّ الموجب للإصباح نادمين ، أيّة ندامة عظيمة!!
ففي مثله لابدّ من التثبّت والتفتيش في الواقعة لا العمل بقول الواحد أو الإثنين، سيّما إذا كان فاسقاً...فالآية أجنبيّة عن الحكم بعدم قبول قول الفاسق مطلقاً(2).
الثالث : أنّ قبول إخبار الملاّك وذوي أيادي والأولياء بالتصرّفات
فيما بأيديهم أو ثبوت ولايتهم عليها ، ممّا جرت عليه السيرة العقلائية من دون
نظر إلى كونهم عدولاً ، والردع عمّا جرت عليه سيرتهم يحتاج إلى النهي
عنه بخصوصه ، ولايصحّ بالعموم والإطلاق ، وتفصيل ذلك في الاُصول في بحث
عدم كون الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم رادعة عن العمل بأخبار
الثقات. أشار إلى هذا الجواب أيضاً الإمام الخميني(قدس سره)(3) وتبعه في ذلك الاُستاذ
-
(1) والظاهر ثبوت الإطلاق; فإنّ كلمة النبأ مطلقة جدّاً، والتعليل بحسب المورد لا يكون مقيّداً، وإلاّ فاللاّزم أن يقال: إنّ التبيين واجب في مورد يكون عدمه موجباً للندامة، ولم يقل به أحد. م ج ف.
(2) كتاب البيع للإمام الخميني(قدس سره) 2 : 451 ـ 452 .
(3) نفس المصدر 2 : 452 .
الشيخ جواد التبريزي(1) .
الدليل الثالث : أ نّ الفاسق سفيهٌ، خصوصاً إذا كان شارب الخمر، والسفيه لا تثبت له الولاية مطلقاً ، وفيه نظر، للمنع من أنّ الفاسق سفيه(2) .
الدليل الرابع : أ نّ الأصل عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ; لأنّ الولاية على خلاف الأصل، فيلزم فيه الاقتصار على المتيقّن(3); وهو صورة ثبوت العدالة لهما .
وفيه نظر; لأنّ الأصل بقاء الولاية لهماإذا كانا عدلين ثمّ فسقا، ولا قائل بالفصل بين الصور على الظاهر، مع أنّ المثبت للولاية مقدّم على النافي لهما، كما لايخفى(4) .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب والجدّ .
إيضاحٌ
قال المحقّق الإيرواني : «ولا مجال لتوهّم دخل العدالة على سبيل الموضوعيّة كما في المقلّد والقاضي والبيِّنة وإمام الجماعة; لعدم الدليل عليه، بل هي طريق للحكم بوقوع تصرّفات الوليّ على طبق ما يعتبر أن يقع عليه من المصلحة أو عدم المفسدة، فلو فرض صدور التصرّف من الفاسق على طبق ما يعتبر نفذ، كما أنّه لو فرض صدور التصرّف من العادل على خلاف ما يعتبر لم ينفذ وفسق بذلك إن كان عن عمد .
-
(1) إرشاد الطالب 3 : 9 .
(2) كتاب المناهل : 106 .
(3) مع وجود الإطلاق في الأدلّة الدالّة على ثبوت الولاية لا مجال لأخذ المتيقّن. م ج ف.
(4) كتاب المناهل: 106 .
وبالجملة: الوليّ في مقدار ما هو وليّ فيه من التصرّفات تصرّفه نافذٌ .
نعم ، طريق معرفة أنّ تصرّفه غير متخطّئ عن ذلك القانون للأجانب هو العدالة»(1) .
ولقد أجاد الاُستاذ الشيخ جواد التبريزي في الردّ عليه، حيث قال : لا وجه لهذا الاعتبار لو كان مستند الحكم النهي عن الركون إلى الظالم . نعم، لو كان المستند آية النبأ لكان الالتزام باعتبارها طريقاً وجيهاً(2) .
عدم اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب والجدّ
القول الثاني: أنّه لا يشترط في ثبوت الولاية للأب والجدّ عدالتهما ، بل تثبت الولاية لهما ولو كانا فاسقين ، كما يظهر من إطلاق كلام المحقّق في الشرائع والنافع(3) . وكذلك في التبصرة(4) والإرشاد(5) والتحرير(6) والقواعد(7) والدروس(8) واللمعة(9)وكنز العرفان(10) والروضة(11) ومجمع البرهان(12). وبه قال جماعة من متأخّري
-
(1) حاشية المكاسب للايرواني 2: 363 .
(2) إرشاد الطالب 3 : 9 .
(3) شرائع الإسلام 2 : 8 ، المختصر النافع : 146 .
(4) تبصرة المتعلّمين : 96 .
(5) إرشاد الأذهان 1 : 360 .
(6) تحرير الاحكام 2 : 541 .
(7) قواعد الأحكام 2: 135.
(8) الدروس الشرعية 3 : 192 .
(9) اللمعة الدمشقيّة: 82 .
(10) كنز العرفان 2 : 49 .
(11) الروضة البهيّة 4: 105.
(12) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
المتأخّرين(1) وفقهاء العصر(2) .
قال العلاّمة : «ويشكل الأمر في الأب الفاسق »(3).
وقال المحقّق الثاني في توضيحه : «وجه الإشكال أنّ ولايته ثابتةٌ بأصل الشرع تابعةٌ لأبوّته، ولم يشترط الشارع في ولايته العدالة، والفرق بينه وبين الأجنبي قائم ; لأنّ شفقته المركوزة في الجبلّة تمنعه من تضييع مصلحة أولاده، ومن حيث إنّ الفاسق لا يركن إليه وليس أهلاً للاستئمان»(4) .
أدلّة قول الثاني
ويمكن الاستدلال على عدم اعتبار العدالة في ولايتهما باُمور :
الأوّل : الأصل ، قال المحقّق الأردبيلي: «إنّ ظاهر أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب والجدّ . . . والأصل يقتضي العدم»(5) .
وحكاه أيضاً عن الكفاية في مفتاح الكرامة(6) . وقال الشيخ الأعظم الأنصاري : «المشهور عدم اعتبار العدالة; للأصل والإطلاقات»(7) ، وكذا في الجواهر(8) .
(1) مفتاح الكرامة 5 : 257 ، جواهر الكلام 26 : 102 ، كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 535.
(2) البيع للإمام الخميني 2 : 444 ، مصباح الفقاهة 5 : 13 ، إرشاد الطالب 3 : 5 ، حاشية الايرواني على المكاسب : 154 ، المكاسب والبيع للنائيني 2 : 330 ، كتاب البيع للأراكي2 : 5 ، تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 301.
(3) قواعد الأحكام 2: 564.
(4) جامع المقاصد 11 : 276 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
(6) مفتاح الكرامة 5 : 257 .
(7) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .
(8) جواهر الكلام 26 : 102 .
وظاهر عطف الثاني على الأوّل ، أنّه لا يكون المراد من الأصل هي الإطلاقات أو القاعدة المستفادة منها، بل المراد منه الأصل العملي، أي البراءة أو الاستصحاب .
وأمّا أصالة البراءة; فإنّ مثل حديث الرفع بناءً على شموله للأحكام الوضعيّة، فلا مانع من التمسّك به ورفع ما يحتمل شرطيّته في تأثير تصرّفات الأب والجد; لكونها مجهولة ويناسبه الامتنان .
قال المحقّق النائيني : «لا إشكال في أنّه عند الشكّ في جزئيّة شيء للمركّب أو شرطيّته تجري فيه البراءة الشرعيّة، ويندرج في قوله(صلى الله عليه وآله) : رفع ما لا يعلمون»(1) وبه قال المحقّق الخراساني(2) .
ولكنّ المرفوع عند الشيخ(قدس سره) في «ما لا يعلمون» هو خصوص المؤاخذة على الأقرب والأظهر، مع إشكال وتأمّل فيه منه(3) .
فيبعد أن يكون المراد من الأصل هو البراءة . وأمّا الاستصحاب، فإن كان المراد به هو الاستصحاب النعتي; بأن يقال : إنّ الولاية كانت في زمان ولم تكن مشروطة بالعدالة، فكذلك الحال، فلا شبهة أنّه لم يكن لذلك حالة سابقة; إذ ليس زمانٌ تكون الولاية ثابتةً ولم تكن مشروطة بالعدالة حتّى نستصحبها، وإن كان المراد منه أصل العدم الأزلي لسلم من إشكال عدم وجود الحالة السابقة، إلاّ أنّ الشيخ الأعظم(قدس سره) لا يقول به(4) . فعلى هذا لا أصل لهذا الأصل الذي ذكره المحقّق الأردبيلي والسبزواري والشيخ الأعظم كما أشار إليه المحقّق الاصفهاني وتلميذه
-
(1) فوائد الاُصول 3 : 354 .
(2) كفاية الاُصول : 417 .
(3، 4) فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25: 28 ـ 29، 59.
السيّد الخوئي(قدس سرهما)(1) .
ولعلّ المراد من الأصل هنا هو الأصل العقلائي; لأنّ العقلاء يلاحظون في تصرّفات الأولياء في أموال الصغار بأن يكونوا اُمناء وموثّقين لحفظ المال والتصرّف لمصلحة الطفل، ولا يعتبرون أزيد من الأمانة والوثاقة، فعدم اعتبار العدالة لهذا الأصل العقلائي، ولا يكون المراد منه الأصل العملي، كالبراءة والاستصحاب وغيرهما .
الثاني : أ نّ العدالة لو كانت شرطاً في ثبوت ولايتهما لاشتهر روايةً; لتوفّر الدواعي عليه ، وإليه أشار في جامع المقاصد بقوله :
«إنّ ولايته ثابتةٌ بمقتضى النصّ والإجماع ، واشتراط العدالة فيه لا دليل عليه»(2) .
الثالث: ـ وهو العمدة ـ إطلاق النصوص ، قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: « إنّ مقتضى إطلاق أدلّة ولاية الأب والجدّ له ثبوت الولاية لهما من غير التقييد بالعدالة ، كما عرفت أ نّه الأحوط في المؤمنين ، فثبوت فسقهما أو عروضه لايوجب بنفسه الخروج عن الولاية ، بحيث لو راعيا المصلحة الكاملة في التصرّف في أموال الطفل لكان التّصرّف بلا وجه وصادراً عن غير وليّ الشرعيّ ، بل تصرّفهما صحيح وصادر عمّن له الولاية »(3) .
وبالجملة: أهمّ النصوص مايلي ، وهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : ما ورد في باب الوصيّة بالمضاربة بمال الولد الصغير ، كموثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بوُلده
- (1) الحاشية على المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 370 ، مصباح الفقاهة 5 : 13 .
(2) جامع المقاصد 11 : 276 .
(3) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 301.
وبمال لهم، وأذِن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : «لابأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذِن له في ذلك وهو حيٌّ»(1) ; فإنّها تدلّ على نفوذ تصرّف الوالد في مال ولده، ولها إطلاق يشمل حالتي الفسق والعدالة من جهتين :
الاُولى : من جهة ترك الاستفصال في صدرها ، الثانية : من جهة إطلاق التعليل; لأنّه(عليه السلام) قال : «من أجل أنّ أباه قد أذِن له في ذلك وهو حيّ» .
وكذا ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير أيضاً دليل على عدم اعتبار العدالة ; فإنّ في ذيلها: « . . . وأمّا فيما بينك وبين الله ـ عزّوجلّـ فليس عليك ضمان»(2) .
الطائفة الثانية : ما ورد في باب الوقف على الولد الصغير، كصحيحة محمّدبن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز; لأنّ والده هو الذي يلي أمره»(3) .
إذ مفاد التعليل أنّ الوالد الذي يلي أمر الصغير يكفي قبضه في صحّة الوقف ولزومه ; لأنّه وليّ الموقوف عليه، وهو قضيّةٌ مطلقة شاملة لحالتي الفسق والعدالة .
ومثلها معتبرة عبيد بن زرارة ; فإنّ في ذيلها: «لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره . . .»(4) أي أمر الصغير .
وكذا معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 478 ، الباب 92 من كتاب الوصايا، ح1 .
(2) نفس المصدر والباب، ح2 .
(3) نفس المصدر 13 : 297 ، الباب 4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح1 .
(4) نفس المصدر والباب، ح5 .
عن رجل تصدّق على ولده بصدقة، ثمّ بدا له أن يدخُل غيره فيه مع ولده، أيصلح
ذلك؟ قال : «نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره»(1) ; فإنّ إطلاق التعليل في قوله(عليه السلام) : «نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ» يدلّ على عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب، ويثبت في ولاية الجدّ بعدم القول بالفصل .
الطائفة الثالثة : ما ورد في باب نكاح الأب أو الجدّ ولده الصغير ، كرواية عبدالله (عبدالملك خ ل) بن الصلت قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) ، عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال : لا، ليس لها مع أبيها أمرٌ ، قال : وسألته عن البكر ، إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيب خ ل)(2) .
فإنّ مقتضى إطلاق الذيل ـ أعني «ليس لها مع أبيها أمرٌ» ـ بل عمومه ـ حيث إنّه نكرةٌ في سياق النفي ـ أنّ اُمورها كلّها مسلوبةٌ(3) عنها ومفوّضة إلى أبيها، وأنّ اُمورها الراجعة إلى نفسها ومالها موكولةٌ إلى الوالد ، وهذا معنى الولاية للأب ، ولم يقيّد بالعدالة .
ومثلها معتبرة زرارة ; فإنّ في ذيلها : «وإن لم تكن كذلك فلا يجوز
تزويجها إلاّ بأمر وليّها»(4); فإنّ الظاهر من الوليّ متولّي الاُمور كلّها في
الأموال وغيرها ، وهو مطلق يشمل حالتي الفسق والعدالة، كما يظهر ذلك من كلام
-
(1) نفس المصدر 13 : 302 ، الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات، ح5 .
(2) نفس المصدر 14 : 208 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح3 .
(3) الظاهر أنّ الرواية تدلّ على أنّه مع تصرّف الأب ليس لها أمر، ولا تدلّ على أنّ اُمورها كلّها مسلوبة عنها.مجف.
(4) وسائل الشيعه 14 : 215 الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح6 .
الشيخ الحائري(قدس سره)(1) .
الرابع : الإجماع ، قال في مفتاح الكرامة : «قد حكى في نكاح التذكرة(2)الإجماع على ولاية الفاسق في النكاح»(3) وفحواه يشمل ولايته على الأموال بطريق أولى» .
والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا يشترط في ولاية الأب والجدّ عدالتهما نصّاً وفتوىً وإجماعاً، وإنّما الكلام في رفع المانع الذي ذكره فخر المحقّقين في الإيضاح، حيث قال : «والأصحّ عندي أنّه لا ولاية له ما دام فاسقاً، لأنّها ولايةٌ على من لايدفع عن نفسه ولا يعرف عن حاله ، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته وإخباراته على غيره مع نصّ القرآن على خلافه»(4) .
وحاصله يرجع إلى أنّ تولية أمره إلى الفاسق تؤول أحياناً إلى تلف مال الصغير ، ولعلّ مراده من نصّ القرآن(5) آية الركون إلى الظالم(6)، كما في جامع المقاصد(7). وفي دلالة الآية نظر يظهر ممّا تقدّم .
وأمّا الوجه العقلي الذي ذكره في الإيضاح ففيه:
أوّلاً: أنّه لا يقتضي اعتبار العدالة، بل غاية ما يمكن أن يقال : هو اعتبار الوثاقة والأمانة، فربما يكون الفاسق أوثق في الأموال من بعض العدول .
وثانياً : أنّ إطلاق الأدلّة المؤيّد بالإجماع دليلٌ قطعي ٌّ على عدم اشتراط
-
(1) كتاب البيع للشيخ الأراكي 2 : 7 ـ 8 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 599، الطبعة الحجريّة .
(3) مفتاح الكرامة 5 : 257 .
(4) إيضاح الفوائد 2 : 628 .
(5) الظاهر أنّ مراده من نصّ القرآن آية النبأ، وهذا بقرينة المتقدِّمة. م ج ف.
(6) سورة هود 11 : 113 .
(7) جامع المقاصد 11 : 275 .
العدالة ، وهو حجّة قطعيّة ، ولا يمكن رفع اليد عن هذه الحجّة إلاّ مع قيام حجّة شرعيّة أو عقليّة قطعيّة التي لا يمكن دفعها، ومع وجود الاحتمال لا يصحّ الأخذ بالدليل العقلي، وفي هذا المورد لو احتملنا أنّ في ترك الولاية للأب والجدّ ـ ولو كانا فاسقين ـ مفسدة غالبة بحيث توجب تلف مال الصغير أحياناً لا دافع لهذا الاحتمال ، ومعه لا يجوز رفع اليد عن تلك المطلقات الكثيرة بمثل هذه الاُمور الظنّية، كما أشار إليه الإمام الخميني(1) .
وأجاب المحقّق الثاني عمّا في الإيضاح أنّه «يندفع هذا المحذور بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للأب عليه ولاية ، عَزَلَه ومَنَعَه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه ، وإن ظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم حاله استعلم بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله»(2).
وقال في تفصيل الشريعة: «حيث إنّ الحكمة بل العلّة في ثبوت الولاية للأب والجدّ رعاية الغبطة والمصلحة للأطفال، بحيث لم يقع منهما تضرّر على المولّى عليه لعدم قدرته . . . فلو ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال ثبوت الضرر منهما على الطفل المولّى عليه، يجب على الحاكم في هذه الصورة ـ وهي صورة الظهور ـ عزلهما ومنعما من التصرّف في أمواله ; لاستلزامه خلاف علّة ثبوت الولاية لهما »(3) .
القول الثالث : التوقّف في المسألة، قال العلاّمة (رحمه الله) : وفي اعتبار العدالة في الوصيّ خلافٌ ، الأقرب ذلك، ويشكل الأمر في الأب الفاسق(4) .
-
(1) كتاب البيع 2 : 447.
(2) جامع المقاصد 11: 276.
(3) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 301.
(4) قواعد الأحكام 2: 564.
ووجه التوقّف أنّ ولاية الأب والجدّ ثبت قطعاً في الشريعة، ولا دليل على اعتبار العدالة ، وفرق واضح بين الأب والجدّ والأجنبي، كالوصيّ والوكيل وغيرهما; لأنّ رأفتهما على الأولاد أكثر من رأفة العادل الأجنبي ; إذ في الأب والجدّ من الشفقة الذاتية والرأفة الطبيعيّة بالنسبة إلى أولادهم ما لا ينكر ولو كان فاسقاً ، وهذه الشفقة الذاتيّة تمنعُهما من تضييع مصلحتهم، ومن أنّ الفاسق لا يركن إليه للاستئمان(1) .
اشتراط العدالة في الولاية على الأموال ، عند بعض أهل السنّة
اشترط الشافعيّة وكذا الحنابلة في الوليّ العدالة ولو في الظاهر .
قال الشربيني من فقهاء الشافعيّة: «ولي الصبيّ أبوه . . . ثمّ جدّه أبو الأب وإن علا كولاية النكاح، وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما، فإن فسقا نزع القاضي المال منهما»(2) .
وقال ابن قدامة بعد بيان ثبوت ولاية الأب والوصيّ على الأموال :
«من شرط ثبوت الولاية ـ على المال ـ العدالة بلا خلاف; لأنّ في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله، فلم يجز، كتفويضها إلى السفيه»(3) .
وكذا في كشّاف القناع ، بل الحنابلة وكذلك الشافعيّة اشترطوا في القاضي الذي تثبت له الولاية أن يكون عدلاً، فقد جاء في كشّاف القناع : ثمّ إن لم يكن أبٌ ولا وصيّه، ثبتت الولاية على الصغير للحاكم بالصفات المعتبرة; ومنها العدالة(4) .
-
(1) اقتباس من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد 11 : 276 .
(2) مغني المحتاج 2 : 173 .
(3) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 .
(4) كشّاف القناع 3: 521.
وفي نهاية المحتاج في فقه الشافعيّة : وليّ الصغير ولو اُنثى أبوه، ثمّ جدّه، ثمّ وصيّهما، ثمّ القاضي العدل الأمين(1) .
وأمّا الحنفيّة والمالكيّة، فلم يتعرّضوا لاشتراط العدالة في الولاية على الصبيّ في أمواله .
المطلب الثاني : اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة
هل يشترط في نفوذ تصرّفات الأب والجدّ توافقها مع المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أو لا يعتبر شيء من ذلك؟ وجوهٌ بل أقوالٌ :
الأوّل : عدم اعتبار شيء من المصلحة أو عدم المفسدة، بل ينفذ ولو مع المفسدة، يدلّ على هذا الوجه إطلاق الأخبار :
1 ـ كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال: في كتاب عليّ(عليه السلام)إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ماشاء(2) ، فإنّ إطلاق قوله(عليه السلام) : «والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء» يشمل نفوذ تصرّفه ولو مع المفسدة .
2 ـ ورواية سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ; فإنّ فيها: «نعم، يحجّ منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد . . .»(3) .
3 ـ وما دلّ على أنّ الولد وماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور المتقدّم(4) .
-
(1) نهاية المحتاج 4 : 373 ـ 374 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 194 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(3) نفس المصدر والباب، ح4 .
(4) نفس المصدر والباب، ح2 .
4 ـ وما في العيون والعلل، عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا(عليه السلام) ، كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله «وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد ; لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله ـ عزّوجلّ ـ : ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ )(1) »(2).
5 ـ وما دلّ على ثبوت الولاية للأب والجدّ على الأولاد الصغار في النكاح; فإنّ إطلاق الأخبار في باب النكاح تمام ، سيّما في موثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام); فإنّ في ذيلها: «ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ»(3); لكونها مطلقةٌ من حيث ثبوت المصلحة في النكاح وعدم ثبوتها ، ووجود المفسدة وعدمها ، وتتعدّى إلى الأموال بالأولويّة القطعيّة; لكون النكاح أهمّ ، بل تلك الأولويّة منصوصةٌ; فإنّه(عليه السلام) بعدما سئل عن قول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «أنت ومالك لأبيك» قالوا : بلى ، قال(عليه السلام) : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟(4)هذا ما يمكن أن يقال في توجيه القول الأوّل .
وفيه: أنّ النصوص المتقدّمة وإن دلّت على إطلاق ولاية الأب حتّى مع المفسدة، إلاّ أنّ النصوص الاُخرى دلّت على أنّه لا يراد هذا الإطلاق .
ببيان آخر: الإطلاق مقيّد بالأدلّة اللفظيّة والعقليّة ، وسنذكرها في الاستدلال للوجه الثاني قريباً إن شاء الله ، والذي يسهّل الخطب أنّه لا قائل بهذا القول كما صرّح به الشهيدي في حاشيته على المكاسب(5) .
-
(1) سورة الشورى 42 : 49 .
(2) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 96، علل الشرائع 524 الباب 302، وعنهما وسائل الشيعة 12 : 197 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح9 .
(3) وسائل الشيعة 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العبد، ح2 .
(4) نفس المصدر والباب، ح5 .
(5) هداية الطالب : 325 .
كون نفوذ تصرّفات الأب والجدّ منوطاً بعدم المفسدة
الثاني: اعتبار عدم المفسدة في تصرّفات الأب والجدّ ، اختاره في الجواهر(1). وكذاشيخه في شرح القواعد(2) والشيخ الأعظم الأنصاري(3) والمحقّق النائيني(4)والسيّدالخوئي(5) والإمام الخميني(6) قدّس الله أسرارهم ، والشيخ الفقيه اللنكراني(7) .
ويدلّ على هذا القول وجوهٌ :
الأوّل : أ نّه لا ينقدح من إطلاق أخبار ولاية الأب والجدّ في ذهن أحد أنّ للوليّ أن يتصرّف في مال المولّى عليه بما يوجب فناءه وتلفه ، وهذا قرينةٌ عقليّةٌ قطعيّة على أنّ إطلاق النصوص المتقدّمة ; أي نفوذ تصرّف الوليّ وشرعيّته، حتّى في صورة المفسدة غير مراد، كما أشار إليه الإمام الخميني(8) .
الثاني : ـ وهو العمدة ـ النصوص، وهي كثيرة :
1 ـ صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(عليه السلام) إ نّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك» ، ثمّ قال أبو جعفر(عليه السلام) : «ما أحبّ (لا نحبّ خ ل) أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ الله لا يحبّ الفساد»(9) .
تقريب الاستدلال بها: أنّ قوله(عليه السلام) : «ما أحبّ» وإن كان لا يدلّ على الحرمة
-
(1) جواهر الكلام 22 : 332 وج 28 : 297 .
(2) شرح القواعد لكاشف الغطاء المخطوط ص71 ، كما حكى عنه في هامش المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 540 .
(3) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 540 .
(4) المكاسب والبيع للنائيني 2 : 331 .
(5) مصباح الفقاهة 5 : 20 .
(6) كتاب البيع 2 : 456 .
(7) جامع المسائل 2 : 303 ، الأحكام الواضحة : 317 .
(8) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 454 مع تصرّف .
(9) وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح2 .
ولكن بضميمة استشهاده(عليه السلام) بقوله ـ تعالى ـ : ( وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ )(1) يدلّ
على الحرمة ; إذ لا شبهة أنّ الفساد ليس على قسمين ، قسم منه مكروه وقسم منه حرام، بل هو متمحّض في الحرمة ، فهي تدلّ على عدم الولاية مع الفساد ، ولايجوز التصرّف في ما فيه مفسدة للطفل .
بتعبير آخر: عموم التعليل في الرواية، أي استشهاده(عليه السلام) بقوله ـ تعالى ـ: ( وَاللهُ لايُحِبُّ الْفَسادَ ) يشمل المورد، فيستفاد من الرواية أنّ تصرّفات الأب والجدّ منوطة بعدم المفسدة، وهو المطلوب.
2 ـ معتبرة الحسين بن أبي العلاء ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : قوته (قوت خل) بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال : فقلت له : فقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : «أنت ومالك لأبيك»، فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يارسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال : «أنت ومالك لأبيك»، ولم يكن عند الرجل شيء، أَوَ كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن»(2)؟!
قال المحقّق النائيني في بيان تقريب الاستدلال بها : «فإنّها أيضاً ظاهرة الدلالة على أنّ الحكم كان في حقّ الأب هو الضمان ، لكن لمّا لم يكن للأب شيء يؤخذ منه للابن، وكان استنقاذ حقّ الابن منه منوطاً بحبسه، قال(عليه السلام) : ما كان رسول الله يحبس الأب للابن، وإلاّ فلو كان صرفه في نفقته بحقّ منه لما كان حكمه الحبس ولو جاز حبس الأب للابن ; إذ التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي ركيك(3) ،
-
(1) سورة البقرة 2 : 205 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 197 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح8 .
(3) والحق أنّه لا ركاكة في ذلك وإن أصرّ عليه النائيني(قدس سره) في الفقه والاُصول; والوجه في ذلك: أنّه قد يكون الاستناد إلى وجود المانع أقرب وأوفق إلى فهم المخاطب مع عدم وجود المقتضي لذلك. م ج ف.
لاستناد عدم الشيء عند عدم المقتضي إليه دون وجود المانع، لكون المعلول مستنداً إلى أسبق علله، كما لا يخفى»(1) .
3 ـ صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال : «يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها»(2) .
والظاهر من هذه الرواية أنّ الوالد له التصرّف الاعتباري بالبيع والشراء وغيرهما في مال ابنه الصغير، لكن لا بما يوجب الفساد ; لأنّ القيمة العادلة هي التي لا فساد فيها(3)، ولو كانت تصرّفات الوليّ نافذةً في حقّ الطفل مطلقاً لم يكن وجهٌ للتقويم بقيمة عادلة، بل كانت القيمة النازلة أيضاً وافية.
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج(4) ، ورواية داود بن سرحان(5) .
4 ـ موثّقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً . . .»(6); فانّها تدلّ مفهوماً على عدم الولاية للجدّ مع الضرر ، فيكون مقيّداً للإطلاقات، كما أشار إليه المحقّق الاصفهاني(7) .
واستشكل عليه السيّد الخوئي ، بـ «أنّ المفهوم وإن كان موجوداً، ولكنّه عدم الولاية مع الضرر ـ أي لا يدلّ على عدم الولاية للجدّ مع الضرر ـ بل المراد به نفي
-
(1) المكاسب والبيع 2 :331 .
(2) وسائل الشيعة 14 : 543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1 .
(3) بل فيها المصلحة. م ج ف.
(4) وسائل الشيعه 14:543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح3.
(5) نفس المصدر والباب، ح4 .
(6) نفس المصدر 14 : 218 الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح2 .
(7) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 373.
أولويّة الجدّ وتقديمه على الأب عند الضرر، وهذا غير مربوط بالرواية، فلا يكون ذلك مقيّداً للإطلاقات في باب النكاح»(1) .
نقول : لعلّ اعتبار عدم الضرر لأصل الولاية لا لأولويّة نكاح الجدّ، ويبعد أن يكون للجدّ ولاية مع الضرر، ولكن عقد الأب يقدّم عليه .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه يكفي في تصرّفات الأب والجدّ عدم المفسدة .
إلاّ أنّه قال في الجواهر : «إنّ الأحوط فيهما ـ أي في ولاية الأبوين ـ وفي غيرهما مراعاة المصلحة ، كما اعترف به الاُستاذ في شرحه، حيث إنّه بعد أن ذكر الاكتفاء بعدم المفسدة قال : والاقتصار على ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق في النظر وأسلم من الخطر»(2).
وهو حسن لما يستفاد من الأدلّة التي سنذكرها للقول الثالث قريباً .
تصرّفات الوليّ مشروطٌ بالمصلحة
القول الثالث : أنّه يعتبر في تصرّفات الوليّ ملاحظة المصلحة زائداً عن اعتبار عدم المفسدة .
وقبل بيان ذلك لابدّ وأن يعلم أنّه يجوز تصرّف الوليّ لأنفسهم في مال الطفل وإن لم يكن فيه المصلحة، ومن هنا يجوز قرض الوليّ من مال الطفل وتقويم جاريته على نفسه مع عدم وجود المصلحة في ذلك للطفل بوجه ، وهذا بالنسبة إلى نفس الأولياء ممّا لا شبهة في جوازه ، وأمّا اعتبار المصلحة في غير ما يرجع إلى شؤونهم ، فهو محلّ النزاع(3) ، فقد صرّح الشيخ في المبسوط بلزومها، حيث قال : «من يلي أمر
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 21 .
(2) جواهر الكلام 22 : 332 ـ 333 .
(3) مصباح الفقاهة 5 : 18 ـ 19 مع تصرّف يسير .
الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ، ووصيّ الأب أو الجدّ، والإمام أو من يأمره
الإمام . . . فكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلاّ على وجه الاحتياط والحظّ للصغير المولّى عليه; لأنّهم إنّما نصبوا لذلك، فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلاً; لأنّه خالف ما نصب له»(1) .
وقال ابن إدريس : «ولا يجوز للوليّ والوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور ـ أي مال الطفل ـ إلاّ بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرّف فيه، وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب»(2) .
وفي القواعد : وإنّما يصحّ بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه(3) ، وصرّح بذلك أيضاً المحقّق(4) والشهيدان(5) والمحقّق الثاني(6) وغيرهم(7) .
وفي مفتاح الكرامة بعد نقل كلمات الأصحاب : «والمحصّل من مجموع كلامهم وما يقتضيه أصول المذهب أنّه يجوز لوليّ الطفل مطلقاً الرهن والارتهان مع كمال الاحتياط بمراعاة المصلحة»(8) .
أدلّة اعتبار المصلحة في تصرّفات الأب والجدّ
قد استدلّ على اعتبار المصلحة في تصرّفات الأب والجدّ بوجوه خمسة :
-
(1) المبسوط 2 : 200 .
(2) السرائر 1 : 441 .
(3) قواعد الأحكام 2 : 135 ، إرشاد الأذهان 1 : 360 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 78 ، 79 و 171 .
(5) اللمعة الدمشقيّة 1 : 80 ، الدروس الشرعيّة 3 : 318 و 403 ، مسالك الأفهام 3 : 166 ، وج 4 : 33 ـ 35 ، وج 5 : 136 .
(6) جامع المقاصد 5: 72.
(7) مجمع الفائدة والبرهان 4: 14، وج 6:77، كفاية الأحكام:89 ، 108، 220، رياض المسائل 5: 358.
(8) مفتاح الكرامة 5 : 111 .
الأوّل: أنّ حكمة جعل الولاية للأب والجدّ تقتضي ذلك; لأنّ جعل الولاية لأجل أن يتصرّف في أموالهم بما فيه المصلحة من التجارة والاستنماء والحفظ والإجارة وغيرها وإلاّ فمجرّد التصرّفات اللغوية بلا وجود ثمرة فيه لا يجوز قطعاً .
وبالجملة: أ نّ حكمة جعل الولاية للأب والجدّ بحسب الطبع هي جلب المنافع للطفل ودفع المضار عنه، وإلاّ فلا يجوز التصرّف في ماله ولو لم يكن فيه مفسدةٌ، كما أشار إليه السيّد الخوئي (رحمه الله)، ولكن استشكل هو(قدس سره) عليه بأنّ «هذا وإن كان بحسب نفسه تماماً، ولكن لا يتمّ في جميع الموارد; لإمكان أن يكون الصلاح في ذلك الجعل راجعاً إلى الوليّ .
وبعبارة أخرى : تارةً يلاحظ في جعل الولاية للأب والجدّ صلاح المولّى عليه فيجري فيه ذلك الحكمة ، واُخرى يلاحظ حال الوليّ، فلا شبهة أنّا نحتمل الثاني أيضاً، فإذن لا دافع للإطلاقات الدالّة على جعل الولاية لهما عليه حتّى في صورة عدم المصلحة في تصرّفهم»(1) .
نقول : هذا الاحتمال ضعيفٌ(2); لأنّه يبعد من حكمة البارئ تعالى أن يجعل الولاية على أموال الطفل لأجل المصلحة الراجعة إلى غيره، لا للطفل .
الثاني: دعوى الإجماع .
في مفتاح الكرامة ـ عند قول العلاّمة: وإنّما يصحّ بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه ـ : «هذا الحكم إجماعي على الظاهر . وقد نسبه المصنّف إلى الأصحاب فيما حكي عنه»(3) .
-
(1) مصباح الفقاهة 5:22 مع تصرّف.
(2) لا ضعف في هذا الاحتمال، سيّما مع ما ورد من أنّ الولد وماله لأبيه، فاحتمل أن يكون لحاظ حال الوليّ لاينافي لحاظ حال المولّى عليه أيضاً، وبالجملة: ثبوت الولاية ليس مختصّاً لحال المولّى عليه فقط. مجف.
(3) مفتاح الكرامة 4 : 217 .
وفي التذكرة : «الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة »(1).
واستظهر السيّد العاملي(قدس سره) منه بأنّه لا خلاف فيه بين المسلمين، حيث قال : وظاهره أنّه ممّا لاخلاف فيه بين المسلمين، وأنّه لا فرق في ذلك بين الأب والجدّ، والوصيّ والحاكم وأمينه(2) .
ولقد أجاد السيّد الخوئي (رحمه الله) في الردّ على هذا الإجماع بـ «أنّ المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه ليس بحجّة; لمخالفة جملة من الأعاظم في ذلك، بل نحتمل استناده إلى الوجوه المذكورة هنا ; لعدم الجعل في صورة عدم المصلحة ، فلا يكون هنا إجماع تعبّدي كاشف عن رأي الحجّة»(3) .
الثالث : قوله ـ تعالى ـ : ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(4) التي هي العمدة في المقام .
وتقريب الاستدلال بها: أ نّ « الأحسن » إمّا اُريد منه التفضيل، أو المجرّد عنه، وعلى الأوّل لا ريب في الدلالة، بل قضيّتها لزوم مراعاة الأصلح ، وعلى الثاني، فالظاهر أنّ المراد من الحسن ما فيه المصلحة لا ما لا مفسدة فيه(5) .
بتعبير آخر : أ نّ المراد بالأحسن: إمّا الأحسن من جميع الوجوه أو من تركه ، ومع عدم المصلحة لا يكون أحسن بشيء من المعنيين(6) .
-
(1) تذكرة الفقهاء، كتاب الحجر 2: 80 ، الطبعة الحجريّة.
(2) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
(3) مصباح الفقاهة 5 : 22 .
(4) سورة الإسراء 17: 34، سورة الأنعام 6: 152.
(5) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، مع تصرّف يسير : 325.
(6) عوائد الأيّام : 560 .
والحاصل : أنّ التصرّف الخالي عن المصلحة في مال اليتيم ليس تصرّفاً حسناً فيحرم; للنهي عن التقرّب إليه، حيث إنّ التقرّب إلى ماله بلا مصلحة فيه ليس
بأحسن، فلا يجوز . وحينئذ لو كان إطلاق اليتيم على من ماتت اُمّه صحيحاً ـ كما أنّه ليس ببعيد ـ فتشمل الآية لكلّ من الأب والجدّ، وإلاّ فتختصّ بالجدّ ويتمّ في الأب بعدم القول بالفصل، إذن نرفع اليد عن الإطلاقات الدالّة على ثبوت الولاية للأب والجدّ مطلقاً حتّى مع عدم المصلحة .
وفي مجمع البيان : «والمراد بالقرب التصرّف فيه، وإنّما خصّ مال اليتيم بالذكر لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله، فيكون الطمع في ماله أشدّ، ويد الرغبة إليه أمدّ، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله وإن كان ذلك واجباً في مال كلّ واحد ( إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) أي بالخصلة أو الطريقة الحُسنى»(1) .
وقال الشيخ في التبيان : «الآية نهي من الله ـ تعالى ـ لجميع المكلّفين أن يقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن، وهو أن يحفظوا عليه ويثمروه، أو ينفقوا عليه بالمعروف على ما لا يشكّ أنّه أصلح له. فأمّا لغير ذلك، فلا يجوز لأحد التصرّف فيه»(2) .
وقال المحقّق الأردبيلي في معنى الآية : «أي لا تقربوا من مال اليتيم; بأن تتصرّفوا وتفعلوا فيه فعلاً، فلا تدنوا إليه بفعلة أصلاً إلاّ بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله بحسب ما يقتضيه عقل العقلاء، كحفظه وتعمير ما هو خراب منه، وتنميته وتثميره ، أو أحسن من تركه . وبالجملة: هو الذي يجده العقل السليم حسناً وأولى من تركه، وهو مقتضى أكثر عقول العقلاء»(3) .
-
(1) مجمع البيان 4 : 183 .
(2) تفسير التبيان 6 : 476 .
(3) زبدة البيان 2 : 501 .
مناقشة الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية والجواب عنه
واستشكل الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه :
الأوّل : أنّه لا دلالة للآية الكريمة على اشتراط المصلحة ، وأشار إليه بقوله : «فلو سلّم دلالتها»(1) .
وقال المحقّق الإيرواني في توضيح هذا الإيراد : «لعلّ منشأ عدم الدلالة هو انصرافها إلى تصرّف الأجانب دون الجدّ، ويمكن التشكيك في صدق اليتيم مع حياة الجدّ، مع أنّ «أحسن» أريد منه معنى الحسن دون التفضيل ، والتصرّف غير المشتمل على المفسدة حسنٌ»(2) .
وفيه نظر; لمنع هذا الانصراف; لأنّ الظاهر من «أحسن» هو التفضيل; لأنّه صيغة أفعل التفضيل، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور ، وأنّه خروج عن ظاهر اللفظ هيئةً ومادّةً من دون قيام قرينة عليه(3) .
الثاني : أنّ الآية بحكم السياق عامّةٌ لجميع الأفراد; سواء كان(4) أباً أو جدّاً أو غيرهما; لأنّ الآية تنهى عن التقرّب لمال اليتيم، وهذا النهي لكلّ أحد، وتخصّص بالروايات الدالّة على جعل الولاية للجدّ ولو مع عدم المصلحة، أشار إلى ذلك بقوله: «فهي مخصّصةٌ بما دلّ على ولاية الجدّ وسلطنته ».
فمفاد الآية يكون هكذا : أ نّ التقرّب إلى مال اليتيم بغير التي هي «أحسن»
-
(1) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 541 .
(2) حاشية الإيرواني على مكاسب الشيخ : 154 .
(3) يمكن أن يقال: إنّ القرينة على ذلك عدم وجود ضابطة خاصّة للتفضيل، فكلّ شيء يُعدّ أحسن يتصوّر شيء أحسن منه، إلاّ أن يقال بأنّ ذلك عرفي موكول إلى تشخيص العرف. م ج ف
(4) التشكيك في صدق اليتيم مع حياة الجدّ موجب لعدم كون الخطاب عامّاً لجميع الأفراد ولا أقلّ الشكّ في عموميّة الخطاب. م ج .
حرام لكلّ أحد إلاّ للجدّ، وليس بينهما عموم من وجه حتّى يعمل بقواعده،
لانحصار الموضوع في روايات الولاية بالجدّ فقط . وأمّا في الآية، فموضوعها عامّ يشمل كلّ أحد وتخصّص بالروايات; لأنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلاً بأنّ البنت وأباها للجدّ(1) . وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «أنت ومالك لأبيك»(2)، خصوصاً استشهاد الإمام(عليه السلام) به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب; ردّاً على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الأمراء(3) ، وغير ذلك ، يدلّ على ذلك .
والحاصل : أ نّ المستفاد من هذه النصوص ولاية الجدّ على نكاح المولّى عليه ولو مع عدم المصلحة والمفسدة ، ويثبت ذلك في الأموال بالأولويّة(4) .
نقول : إنّ نسبة الآية الكريمة وأخبار ولاية الجدّ إن لوحظ مع المستثنى منه فقط عامّ وخاصّ مطلق، كما ادّعاه الشيخ الأعظم(قدس سره) .
وأمّا إن لوحظ مجموع الآية من المستثنى والمستثنى منه، فمفادها ظاهراً أنّ التقرّب بمال اليتيم لا يجوز إلاّ أن يكون ذلك التصرّف على الوجه الأحسن.
ولا يخفى أنّ التصرّف الأحسن هو الذي كان على الطريقة الشرعيّة أو العقلائية وذا مصلحة لليتيم، ولا ريب أنّ تصرّف الأجانب لا يكون كذلك غالباً بمقتضى الضرورة والإجماع والأخبار الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه(5) ، فعلى هذا تكون تصرّفات الأجانب خارجةٌ عن مفاد الآية قطعاً .
-
(1) وسائل الشيعة 14 : 219 الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8 .
(2) نفس المصدر 12 : 195 ـ 197 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ،2 ،8 و9 .
(3) وسائل الشيعة 14: 218 الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح5.
(4) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 541 مع تصرّف وتوضيح .
(5) وسائل الشيعة 3 : 425 ح3 و6 : 337 ح6 وج19: 3 ح3 فإنّه ورد فيها «لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفس منه» و«لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » .
وكذلك تصرّفات الأولياء(1) إذا لم تكن لمصلحة الطفل; لأنّه لا تكون مثل هذه التصرّفات تصرّفاً بالأحسن ، فالآية الكريمة لا تشمل عموم المكلّفين، بل هي خطاب للأولياء ، والنسبة بين الآية والأخبار هي الإطلاق والتقييد، والآية مقيّدة للأخبار .
على هذا لابدّ أن يكون تصرّفات الجدّ في مال الطفل على الوجه الأحسن ولمصلحة الطفل .
مضافاً إلى أنّه لا إطلاق للأخبار; لعدم كونها في مقام البيان من حيث كيفيّة إعمال هذه الولاية; لأنّ ولاية الأمر بمعنى ولاية البيع والشراء والعتق والشهادة والأخذ والإعطاء وغير ذلك، ولم يؤخذ في الأخبار كيفيّة إعمال هذه الاُمور، بل كانت في مقام إثبات أصل الولاية، ولا مساس لها بكيفيّة إعمالها ، فلو قام دليلٌ على اعتبار المصلحة لا يكون تقييداً للأخبار، كما أشار إلى ذلك الشيخ الفقيه الحائري(2) .
وبعبارة اُخرى: يمكن منع تحقّق الإطلاقات حتىّ في باب النكاح; إذ الولاية للأب والجدّ على الأولاد لأجل حفظهم عن وقوعهم بالمضرّات بمالهما من الرأفة الطبيعيّة لأولادهم; بأن يعاملوا معاملة أنفسهم في حفظه وعدم التصرّفات المتلفة فيه ، فأصل جعل الولاية لهذا الموضوع مشعر بهذه الحكمة والعلّة، فلو أوجبت
الولاية توجّه الضرر إليهم، أو(3) عدم المصلحة، فمن الأوّل يمكن القول بعدم جعل
-
(1) ولا يخفى أنّ لزوم كون التصرّف بالتي هي أحسن، لا يوجب تضييق الخطاب; فإنّ الخطاب بعدم جواز التقرّب عامّ يشمل الجميع. نعم، بما أنّ الموضوع هو اليتيم فالخطاب لا يشمل من لا يكون يتيماً، كمن كان له أب أو جدّ. م ج ف.
(2) كتاب البيع للشيخ الفقيه الأراكي 2 : 11 .
(3) هذا بالنسبة إلى توجّه الضرر صحيح. أمّا بالنسبة إلى عدم المصلحة، فقد مرّ احتمال لحاظ الوليّ دون المولّى عليه فقط، فلا يستفاد من أصل جعل الولاية اشتراط المصلحة. م ج ف.
الولاية، وخروجه عن مورد الروايات تخصّصاً، بل هذا هو المتعيّن; إذ لا يمكن
القول بولاية الأب والجدّ على الأولاد كيف شاءا ، إذن فليس هنا إطلاق أصلاً من الأوّل فضلاً عن احتياجه إلى المقيّد(1) .
الثالث : وأشار إليه بقوله : «مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ دون الأب»(2) .
وفيه ما قلنا في الجواب عن الإيراد الثاني فلا نعيد .
وأمّا دعوى الشيخ الأعظم بأنّ عدم القول بالفصل ممنوعة(3) .
ففيها أوّلاً : أنّ اليتيم يطلق على من فقد الاُمّ أيضاً، كما ادّعاه بعضهم(4) .
وثانياً : كما قال في مجمع البيان : «وإنّما خصّ مال اليتيم بالذكر; لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله، فيكون الطمع في ماله أشدّ ويد الرغبة إليه أمدّ»(5)وإلاّ كان رعاية مفاد الآية لازماً في مال كلّ صغير .
وثالثاً : يمكن إدخال غير الرشيد فيه إلى أن يرشد; لاحتمال أن يكون معنى ( حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) يبلغ رشده، أي يبلغ ويرشد، كما صرّح به المحقّق الأردبيلي(6) .
فإذن لا نحتاج إلى القول بالفصل، والآية تشمل الأب والجدّ .
والمتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ نفوذ تصرّفات الأب والجدّ منوطة برعاية المصلحة للطفل، وهذا ما يقتضيه بناء العقلاء ، فاعتبار المصلحة في تصرّف الأب
-
(1) يستفاد هذا من مصباح الفقاهة للسيّد الخوئي(رحمه الله) 5 : 18 ـ 21 .
(2) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 541 .
(3) نفس المصدر 16: 542 .
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1 : 215 .
(5) مجمع البيان 4: 183.
(6) زبدة البيان 2 : 501 .
والجدّ أمر عقلائي، والأدلّة الشرعيّة دليلٌ لإمضائه، كما أشار إليه أيضاً المحقّق الأردبيلي (رحمه الله)(1) .
الوجه الرابع : ما قاله المحقّق الشهيدي : «من أنّ الأصل عدم تسلّط أحد على مال أحد إلاّ مع اليقين بخلافه، وهو صورة وجود المصلحة; إذ ليس في المقام إطلاق يدلّ على عدم اعتبارها»(2) .
الوجه الخامس : ما أشار هو(قدس سره) إليه أيضاً بقوله : «إنّ الظاهر من أدلّة ولاية عدول المؤمنين كما يأتي اعتبار المصلحة في ولايتهم، ومناط الاعتبار هنا ـ وهو قصور الصغير عن التميّز بين صلاحه وفساده ـ موجود(3) في المقام، مع عدم دليل يدلّ على عدم اعتبارها في المقام»(4) .
اشتراط إحراز المصلحة أو عدم المفسدة
بعد الفراغ عن اعتبار المصلحة، أو كفاية عدم المفسدة في نفوذ تصرّفات الأب والجدّ، يلزم أن نبيّن ما هو المدار في المصلحة وعدم المفسدة، فهل يكون هذا الشرط في عالم الإحراز، فلو أحرز عدم المفسدة في مورد فباع مال الطفل فانكشف وجود المفسدة فلا يبطل البيع وينفذ التصرّف .
أو أنّهما شرط في الواقع، فلو كان في مورد مفسدة واقعيّة فلم يحرز فأقدم على البيع فيكون باطلاً، أو أنّهما معاً من الشرائط ؟
الظاهر هو الوجه الأخير، لأنّ من المقيّدات للإطلاقات صحيحة ا لثمالي
-
(1) نفس المصدر .
(2) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب : 325 .
(3) قد مرّ إمكان الفرق بين الأب والجدّ من طرف، وبين سائر الأولياء من طرف آخر. مجف.
(4) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: 325.
المتقدّمة(1); فإنّها اعتبرت عدم الفساد في تصرّفات الأب والجدّ في مال الطفل،
وهو كالمعصية(2) قائم بأمرين : أحدهما: الوجود الواقعي ، وثانيهما: إحرازه، أي تنجّزه .
كما أنّ سفر المعصية يتحقّق بأمرين: أحدهما: أن يسافر لأجل الغرض المعلوم كونه معصية ، والثاني: علم المسافر بذلك وتنجّز التكليف في حقّه ، فلو سافرت المرأة بدون رضاية الزوج، فبان أنّها مطلّقة فلا يكون سفرها معصيةً ، أو سافرت بزعم أنّها مطلّقة فبان خلافها ، فليس سفرها سفر معصية أيضاً ، وإنّما يكون سفر معصية مع اجتماع الأمرين ، وكذلك فيما نحن فيه أنّ التصرّف لابدّ أن يكون عن مصلحة، أو عدم المفسدة فيه، ولا يتحقّق هذا إلاّ بأمرين :
الأوّل : وجود المصلحة الواقعيّة، أو عدم المفسدة كذلك .
الثاني : العلم بذلك وتنجّزه في حقّه .
على هذا يكون المقيّد للإطلاقات المثبتة للولاية للأب والجدّ خصوص كون تصرّفهم مفسداً لحال اليتيم مع العلم به ، وما لم يتنجّز فلا مانع من التمسّك بالإطلاقات والحكم بثبوت الولاية لهما ، ولكنّ السيّد الخوئي قال في منهاجه: « والمدار في كون التصرّف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرّف الوليّ باعتقاد المصلحة فتبيّن انّه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صحّ إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء »(3) .
-
(1) وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
(2) قياس المقام بالمعصية مع الفارق جدّاً، والظاهر في الشرائط كلّها كونها شرطاً واقعيّاً فقط، والزائد يحتاج إلى دليل خاصّ، والمستفاد من ظواهر الأدلّة أيضاً ذلك، وبعبارة اُخرى: كون الشرط علميّاً يشبه جدّاً بعدم الشرطيّة. م ج ف.
(3) منهاج الصالحين 2 : 21 مسألة 80 .
آراء جمهور أهل السنّة في مسائل هذا البحث
اعتبر جمهور الفقهاء من الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة أن يكون تصرّف الأب والجدّ في أموال الصبيّ موافقاً للمصلحة .
قال ابن قدامة : «وليس لوليّه التصرّف في ماله بما لا حظّ له فيه، كالعتق والهبة والتبرّعات والمحاباة; لقول الله ـ تعالى ـ : ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(1). وقوله(عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار(2) من المسند، وفي هذه إضرار، فلا يملكه»(3) .
وفي مغني المحتاج : «ويتصرّف له الوليّ بالمصلحة وجوباً; لقوله ـ تعالى ـ : ( وَلا تَقْرَبُوا . . . ). وقوله ـ تعالى ـ : ( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )(4) . وقضيّة كلامه كأصله أنّ التصرّف الذي لا خير فيه ولا شرّ ممنوع منه; إذ لا مصلحة فيه، وهو كذلك كما صرّح به الشيخ أبو محمّد والماوردي»(5) .
وقال الرافعي : «رهن الوليّ مال الصبيّ والمجنون والمحجور عليه بالسفه، وارتهانه لهم مشترط بالمصلحة والاحتياط ، فمن صوّر الرهن على وجه المصلحة أن يشتري للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله فيجوز . . .
ومنها: إذا كان الزمان زمان نهب، أو وقع حَريق، وخاف الوليّ على ماله ، فله
-
(1) سورة الإسراء 17 : 34 ، وسورة الأنعام 6 : 152 .
(2) يأتي تخريجه قريباً .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
(4) سورة البقرة 2 : 220 .
(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2 : 174 .
أن يشتري عقاراً ويرهن بالثمن شيئاً من ماله . . .
ومنها: أن يستقرض الوليّ له لحاجته إلى النفقة أو الكسوة أو توفية ما يلزمه، أو لإصلاح ضياعه»(1) .
وفي المغني : «قال القاضي ليس لوليّه رهن ماله إلاّ بشرطين: أحدهما: أن يكون عند ثقة، الثاني: أن يكون له فيه حظّ»(2) . وكذا في كشّاف القناع(3) .
وقال ابن شاس : «ولا يتصرّف الوليّ إلاّ على ما يقتضيه حسن النظر»(4) .
ويظهر من كلمات بعض الحنفيّة أنّهم اكتفوا بلزوم عدم المفسدة في تصرّفات الوليّ .
ففي البدائع : «وأمّا الذي يرجع إلى المولّى فيه، فهو أن لا يكون من التصرّفات الضارّة بالمُولّى عليه; لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(5) .
وقال عليه الصلاة والسلام : من لم يرحم صغيرنا ـ ويعرف حقّ كبيرناـ فليس منّا(6). والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في شيء، فليس له أن يهب مال الصغير من غيره بغير عوض; لأنّه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضرراً محضاً»(7) .
-
(1) العزيز شرح الوجيز 4 : 469 .
(2) المغني 4 : 397 .
(3) كشّاف القناع 3 : 521 .
(4) عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 .
(5) مسند أحمد بن حنبل 1: 672 ح2867، سنن ابن ماجة 3: 117 ح2340 و2341، السنن الكبرى للبيهقي 8: 436 ح11571 وج9: 123 ح12098 و12099، المعجم الأوسط 6: 91 ح5189، مجمع الزوائد 4: 110.
(6) سنن أبي داود 5 : 147 الرقم 4943 ، سنن الترمذي 4: 321 ح1924.
(7) بدائع الصنائع 4 : 350 .
المبحث الرابع : ولاية الوصيّ على أموال الصغار
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : ولاية الوصيّ وأدلّتها
المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين والمتأخِّرين، بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار في أموالهم لوصيّ الأب والجدّ مع فقدهما .
قال الشيخ(رحمه الله): «من يلي أمر الصغيروالمجنون خمسةٌ... ووصي الأب أو الجدّ»(1).
وفي الوسيلة : «لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلاّ لأحد ثلاثة: أوّلها: الوليّ وهو الجدّ، ثمّ الوصيّ وهو الذي ينصبه أبوه»(2) .
وبه قال المحقّق(3) والعلاّمة(4) والشهيد(5)ويحيى بن سعيد(6)والمحقّق(7) والشهيد الثانيان(8) والمحقّق الأردبيلي(9)، وجماعة من متأخِّري المتأخّرين(10)
-
(1) المبسوط للطوسي 2 : 200 .
(2) الوسيلة لابن حمزة : 279 .
(3) شرائع الإسلام 2 : 9 ، المختصر النافع : 146 .
(4) تحرير الأحكام الشرعيّة 2: 541. تبصرة المتعلّمين: 96، إرشاد الأذهان 1 : 360، قواعد الأحكام 2: 135.
(5) اللمعة الدمشقيّة : 62 .
(6) الجامع للشرائع : 246 .
(7) جامع المقاصد 5: 187 و 4 : 86 .
(8) الروضة البهيّة 4 : 106، مسالك الأفهام 3 : 165 .
(9) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 234 .
(10) رياض المسائل 5: 391، مفتاح الكرامة 4: 184 و 213 وج 5: 255 ـ 256، المناهل: 105، شرح تبصرة المتعلّمين 5: 41.
وفقهاء العصر(1) .
جاء في الحدائق : «والوصيّ من أحدهما على من لهما الولاية عليه»(2) .
أدلّة ولاية الوصي على أموال الصغار
استدلّوا على إثبات ولاية الوصيّ على أموال الصغار بوجوه :
الأوّل : الإجماع، كما ادّعاه في الرياض(3) ومهذّب الأحكام(4) .
وفيه: أنّه مدركيّ . ولعلّ مستندهم الوجوه الآتية :
الثاني : السيرة المستمرّة بين المتشرّعة(5) .
الثالث : قاعدة أنّ كلّ ما جاز فعله حال الحياة ، جازت الوصيّة به بعد الممات إلاّ ما خرج بالدليل، ولا دليل على الخروج في المقام(6) .
وفي تماميّة هذه القاعدة إشكالٌ سيأتي قريباً .
الرابع : شمول دليل الولاية له، بدعوى أنّه غير مختصٍّ بتصرّفاته في حياته، وعمومه لما يكون متأخّراً عن وفاته أيضاً(7) .
الخامس : إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة ودعوى شمولها لوصيّتهما بالاتّجار بمال الصبيّ بعد موتهما; فإنّ مقتضاها صحّة مثل هذه الوصيّة ونفوذها(8) .
-
(1) العروة الوثقى والتعليقات عليها 5 : 264 و 263 ، مستمسك العروة الوثقى 12 : 446 ، مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة 3 : 212 ، مهذّب الأحكام 21 : 126 ، وسيلة النجاة 2 : 100 ، تحرير الوسيلة 2 : 14 ، تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 299.
(2) الحدائق الناضرة 18 : 403 .
(3) رياض المسائل 5 : 63 .
(4 ـ 6) مهذّب الأحكام 21 : 126 .
(7 و 8) مباني العروة للسيّد الخوئي، كتاب المضاربة 3 : 212 .
(8) نفس المصدر .
واستشكل السيّد الخوئي (رحمه الله) على الدليل الرابع ، بأنّه لا إطلاق ولا عموم يشمل تصرّف الأب والجدّ بعد موتهما، بل لهما التصرّف في مال الصغير ما داما حيّين، وأمّا بعد موتهما فلا ولاية لهما عليه في شيء(1) ، وما ذكره جيّد .
وأورد أيضاً على الدليل الخامس بأنّه «لا يوجد في أدلّة الوصيّة إطلاق يشمل الوصيّة التي لا ترجع إلى الميّت وأمواله; فإنّها وبأجمعها واردة في الوصايا الراجعة إلى الميّت نفسه وأمواله ، ومن هنا لا تنفذ إلاّ في الثلث ممّا يملك. وأمّا الزائد عنه فهو وصيّةٌ في مال الغير على ما دلّت عليه النصوص»(2) .
هذا كلّه ما تقتضيه القواعد ومع قطع النظر عن النصوص الخاصّة .
السادس: ـ وهو العمدة ـ النصوص:
منها: ما روى في الكافي والتهذيب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن يونس (يوسف خل)، عن مثنى بن الوليد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام)أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم ؟ فقال : «لا بأس به من أجل أنّ أباه(3) قد أذِنَ في ذلك وهو حيّ»(4) .
ثمّ إنّ في الفقيه: علي بن الحسين الميثمي(5) بدلاً من علي بن الحسن على ما في الكافي(6) والتهذيب(7) والوسائل ، وهو ابن فضّال الذي يروي عنه أحمد بن محمّد ،
-
(1 ـ 3) نفس المصدر : 212 ـ 213 .
(3) كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل ، ولكن في الوسائل 19: 427 طبع مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) «أنّ أباهم» ولعلّه هو الصواب .
(4) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا، ح1 .
(5) الفقيه 4 : 196، ح 590 تحقيق السيّد الخرسان، ولكن في الفقيه 4: 227 تحقيق علي أكبر الغفاري: علي بن الحسن الميثمي ، وكذا في روضة المتّقين 11: 130 .
(6) الكافي 7 : 62 ح19 .
(7) تهذيب الأحكام 9 : 236، ح 921 .
وهو من سهو نسخة الخرسان جزماً ; إذ لا وجود لعليّ بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال . نعم، روى(قدس سره) في بعض الموارد عن عليّ بن الحسن الميثمي(1) إلاّ أنّه غلط، والصحيح عليّ بن الحسن التيمي .
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المرويّ عنه لعليّ بن الحسن هو الحسن بن عليّ بن يونس، وجعل كلمة «يوسف» نسخة بدل ليونس، وهو من الغلط جزماً، فإنّ الحسن بن عليّ بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضاً، فالصحيح هو الحسن بن عليّ بن يوسف ـ على ما في الكافي والفقيه والتهذيب ـ وهو ابن بقاح الثقة(2) .
وكيف كان، فالرواية معتبرة من حيث السند. وأمّا من حيث الدلالة، فهي واضحة الدلالة; لأنّه(عليه السلام) قال : «لا بأس به» أي لابأس بأن يعمل الوصيّ بمال الصغير.
قال الإمام الخميني(قدس سره): « دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير ; سواء كان في حال حياته; بأن يوكّل من يعمل ذلك ; أو كان بعد مماته بالإيصاء والإجازة »(3) .
ومنها: صحيحة العيص بن القاسم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ
عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنّها لاتُفسِدُ ولا تضيّع. فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد
-
(1) قال السيّد الخوئي: أحمد بن محمد العاصمي، فقد روى عن علي بن الحسن، وعلي بن الحسن فضّال، وعلي بن الحسن التيملي، وعلي بن الحسن التيمي، وعلي بن الحسن السلمي، وعلي بن الحسن الميثمي، وجميع هذه العناوين منطبقة على شخص واحد. معجم رجال الحديث 2: 333 الرقم 947.
(2) مباني العروة ، كتاب المضاربة 3 : 217.
(3) كتاب البيع 2 : 436 .
انقطع ملك الوصي عنها(1) فإنّ ذيل الرواية صريح في ولاية الوصي(2) .
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ : {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال : «المعروف هو القوت، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»(3) .
ويؤيّده خبر أسباط بن سالم(4) وخالد بن بكر(5) الطويل .
ومنها : معتبرة أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟
قال : نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظراً له(6). والدلالة ظاهرة .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ولاية الوصيّ ثابتةٌ إجماعاً ونصّاً وفتوىً .
آراء فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ على أموال الصغار
تثبت الولاية على أموال الصغار للوصي عند جمهور الفقهاء
أ ـ الشافعيّة
قال المزني : «قال الشافعي : وأحبّ أن يتّجر الوصيّ بأموال من يلي ولا ضمان عليه، وقد اتّجر عمر بمال يتيم، وابضَعَت عائشة بأموال بني محمّد بن أبي بكر في
-
(1) وسائل الشيعة 13: 432 الباب 45 من كتاب الوصايا، ح1.
(2) وأيضاً يستفاد من هذه الرواية وهكذا الآتية أنّ الوصيّ له الولاية على مال الأطفال; سواء أوصى بذلك الموصي أم لا. وسواء جعله وصيّاً عليهم أم لا. م ج ف.
(3) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(4) نفس المصدر 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(5) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من أبواب الوصايا، ح2 .
(6) وسائل الشيعة 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح6 .
البحر وهم أيتام»(1) .
وأضاف الماوردي ، بأنّ هذا كان إجماعاً ، ولأنّ الوليّ يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه، فلمّا كان من أفعال الرشيد أن يتّجر بماله ، كان الوليّ في مال اليتيم مندوباً إلى أن يتّجر بماله، ولأنّ الوليّ مندوب إلى أن يثمر ماله من يلي عليه ، والتجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال، ولما روي أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قال : «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»(2)،(3).
وفي مغني المحتاج : «وليّ الصبيّ أبوه ثمّ جدّه ثمّ وصيّهما ثمّ القاضي»(4) .
وفي المهذّب في فقه الشافعي : «وإن لم يكن أب ولا جدّ نظر فيه الوصيّ; لأنّه نائب عن الأب والجدّ، فقدّم على غيره»(5). وكذا في روضة الطالبين(6) والمجموع(7) .
ب ـ الحنابلة
قال في الكافي : «ويتولّى الأب مال الصبيّ والمجنون; لأنّها ولايةٌ على الصغير فقدّم فيها الأب كولاية النكاح، ثمّ وصيّه بعده; لأنّه نائبه»(8) .
وقال ابن قدامة : «إنّ لوليّ اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيباً من الربح أباً كان أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكم، وهو أولى
-
(1) مختصر المزني : 89 .
(2) الموطّأ : 152 ح586، الاُمّ 1: 30، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 66 ح6982، المعجم الأوسط 2: 6 ح1002، سنن الدارقطني 2: 96 ح1958، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 295 ـ 296 ح11143ـ 11145، كنز العمّال 15: 177 ح40484 و 40485.
(3) الحاوي الكبير 6: 443 ـ 444.
(4) مغني المحتاج 2 : 173.
(5) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 2 : 126 .
(6) روضة الطالبين 3 : 475 .
(7) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 .
(8) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 ، كشّاف القناع 3 : 521 .
من تركه، وممّن رأى ذلك ابن عمرو النخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي ثمّ ـ بعدما نقل الخلاف عن الحسن ـ قال : والذي عليه الجمهور أولى; لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من ولي يتيماً له مال فليتّجر له، ولايتركه حتّى تأكله الصدقة»(1) (2) .
ج ـ الحنفية
قال في البدائع في سبب تحقّق ولاية الوصيّ: «ووصيّ الأب قائم مقامه; لأنّه رضيه واختاره ، فالظاهر أنّه ما اختاره من بين سائر الناس إلاّ لعلمه بأنّ شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم، ولولا ذلك لما ارتضاه من بين سائر الناس، فكان الوصيّ خلفاً عن الأب، وخلف الشيء قائم مقامه كأنّه هو، والجدّ له كمال الرأي ووفور الشفقة، إلاّ أنّ شفقته دون شفقة الأب، فلا جرم تأخّرت ولايته عن ولاية الأب، وولاية وصيّه ووصيّ وصيّه أيضاً; لأنّ تلك ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرنا، ووصيّ الجدّ قائم مقامه; لأنّه استفاد الولاية من جهته، وكذا وصيّ وصيّه»(3) .
وقال في المبسوط : «ويجوز لوصيّ اليتيم أن يوكّل في كلّ ما يجوز له أن يعمله بنفسه من اُمور اليتيم»(4) .
وقال في باب الوصايا : «وللوصيّ أن يتّجر بنفسه بمال اليتيم ويدفعه مضاربةً ويشارك به لهم . . . لأنّ الموصي جعله قائماً مقامه في التصرّف في المال . . .»(5) .
-
(1) سنن الترمذي 3: 32 ح640، سنن الدارقطني 2: 95 ح1951، كنز العمّال 15: 177 ح4086.
(2) المغني 4 : 293.
(3) بدائع الصنائع 4 : 349 .
(4) المبسوط للسرخسي 19 : 30 .
(5) نفس المصدر 28: 28 .
وقال في باب القصاص : «وعفو الأب والوصيّ عن قصاص واجب للصغير باطل; لأنّه فوّض إليهما استيفاء حقّه شرعاً لا إسقاطه»(1) .
د ـ المالكيّة
قال ابن شاس : «ووليّ الصبيّ أبوه وعند عدمه الوصيّ أو وصيّه، فإن لم يكن فالحاكم»(2) .
وفي شرح الزرقاني : «ثمّ يلي أبا المحجور وصيّه; أي الذي أوصاه الأب قبل موته على ولده; لأنّه نائبه، فإن مات فوصيّه الذي أوصاه ذلك الوصيّ قبل موته»(3) وكذا في بداية المجتهد(4) والذخيرة(5) .
وفي حاشية الخرشي : «وإن لم يوجد الأب فوصيّه يقوم مقامه وينظر في مصالح اليتيم من بيع وغيره»(6) .
وفي الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : «ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصيّ . . .»(7) .
المطلب الثاني : في بيان شرائطها:
الأوّل : أنّه يشترط في تصرّفات الوصيّ في أموال الصغار مراعاة المصلحة والنظر والغبطة ; للأدلّة التي ذكرنا في ولاية الأب والجدّ ، ولا يجوز له التصرّف
-
(1) نفس المصدر 26 : 161 .
(2) عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 .
(3) شرح الزرقاني لأبي الضياء 3: 298.
(4) بداية المجتهد لابن رشد 2 : 280 ـ 281 .
(5) الذخيرة لابن إدريس القرافي 7 : 162 ـ 163.
(6) حاشية الخرشي لعبد الله بن الخرشي 6 : 243 .
(7) الكافي في فقه أهل المدينة للمالكي ، لابن عبد البرّ : 423 .
في مال الصغير بما لا حظّ فيه، كالعتق والهبة والتبرّعات وغيرها، والبيع والشراء بغبن فاحش .
الثاني : قال في المناهل: «هل يشترط في ثبوت ولاية الوصيّ لأحد الأبوين وجعله وصيّاً على الصغير، أو لا؟ بل يكفي مجرّد صدق كونه وصيّاً ولو كان وصيّاً على الثلث فقط ؟ يظهر من إطلاق عبارات الأصحاب الثاني ، ولكن قد يدّعى انصراف الإطلاقات المذكورة إلى صورة جعله وصيّاً على الصغير، فيلزم الرجوع في غيرها إلى حكم الأصل وهو عدم ثبوت الولاية، فالاحتمال الثاني هو الأقرب»(1) .
اشتراط تصرّفات الوصيّ للمصلحة عند أهل السنّة
يظهر من كلمات فقهاء أهل السنّة التي ذكرناها في نقل آرائهم في ولاية الوصيّ: أنّهم قائلون بولاية وصيّ الوصيّ أيضاً كالوصيّ، فراجع .
وهم أيضاً قائلون بأنّه يشترط في تصرّفات الوصيّ أن تكون موافقة للمصلحة.
قال ابن قدامة(2) من فقهاء الحنابلة : «وليس لوليّه التصرّف في ماله بما لا حظّ له... لقوله ـ تعالى ـ : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ}(3). وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ضرر ولا ضرار»(4) وبمثل ذلك قال ابن شاس من فقهاء المالكيّة(5) .
وفي المبسوط : «الوصيّ يعطي مال اليتيم مضاربةً، وإن شاء أبضعه، وإن شاء
-
(1) المناهل : 106 .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 ، الشرح الكبير 4 : 519 .
(3) سورة الإسراء 17 : 34 ; سورة الأنعام 6 : 152 .
(4) تقدّم في آخر المبحث الثالث.
(5) عقد الجواهر الثمينة 2: 630.
اتّجر إلى غير ذلك وكان خيراً لليتيم فَعل، لقوله تعالى : {قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ...}(1)وقال(صلى الله عليه وآله وسلم) : ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة(2). يعني النفقة . . .»(3) .
وفي مغني المحتاج : «ويتصرّف له الوليّ بالمصلحة وجوباً; لقوله تعالى . . . وقضيّة كلامه كأصله أنّ التصرّف الذي لا خير فيه ولا شرّ ممنوع منه; إذ لا مصلحة فيه . . .»(4) .
واشترط بعض فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ أن يكون عادلاً .
قال ابن قدامة : «ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف ; لأنّ في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله ، فلم يجز، كتفويضها إلى السفيه»(5) .
وقال النووي : «ثمّ الوصيّ أي المنصوب من جهة الأب أو الجدّ، أو وصيّ من تأخّر موته منهما; لأنّه يقوم مقامه وشرطه العدالة»(6) وكذا في مغني المحتاج(7) .
-
(1) سورة البقرة (2) : 220 .
(2) تقدّم عن قريب.
(3) المبسوط للسرخسي 22 : 19 ـ 20.
(4) مغني المحتاج 2 : 174 .
(5) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 .
(6) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 .
(7) مغني المحتاج 2 : 175 .
المبحث الخامس : نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار
لا خلاف في ولاية الوكيل من قبل الأب أو الجدّ على أموال الصغار .
قال المحقّق في الشرائع : « وللأب والجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير . . . »(1).
وفي التذكرة « كلّ من صحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ أن يوكّل فيه »(2). وكذا في التحرير(3) والقواعد(4) والإرشاد(5) وجامع المقاصد(6) ومجمع الفائدة والبرهان(7) ومفتاح الكرامة(8) .
وقال المحدث البحراني: « والوكيل من المالك أو ممّن له الولاية »(9).
وفي الرياض: «أو وكيلا عن المالك أو من له الولاية حيث يجوز له التوكيل»(10).
وقال في تحرير الوسيلة: « يجوز للوليّ كالأب والجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه »(11) .
-
(1) شرائع الاسلام 2 : 197 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 115، الطبعة الحجريّة.
(3) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 29 .
(4) قواعد الأحكام 2 : 351 .
(5) إرشاد الأذهان 1 : 415 .
(6) جامع المقاصد 8 : 189 .
(7) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 490 و494 .
(8) مفتاح الكرامة 7 : 534 وج 5 : 267 .
(9) الحدائق الناظرة 18 : 403 .
(10) رياض المسائل 5 : 63 .
(11) تحرير الوسيلة 2 : 42 مسألة 18 .
وبالجملة يستفاد من كلمات الفقهاء أ نّه كُلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه. وأمّا إذا لم يكن كذلك فإنّه يصحّ فيه التوكيل ، فعلى هذا يجوز للأولياء كالأب والجدّ والوصيّ لهما والحاكم أنْ يوكّلوا غيرهم فيما يتعلّق بالمولّى عليهم ممّا لهم الولاية عليه; لأنّ الغرض من جعل الولاية لهم حفظ أنفسهم وأموالهم من التلف والضرر، وإعانتهم فيما يحتاجون إليه في اُمورهم، وهذا يمكن أن يصدر من الأولياء ومن غيرهم.
والدليل على إثبات ولاية الوكيل على أموال الصغار ما ذكرناه لإثبات ولايته على النكاح(1) ; كعموم بعض النصوص ، مثل:
معتبرة معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أ نّه قال : «من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها »(2) .
وحيث إنّ جواز التصرّف في مال الصبيّ هو أمر من الاُمور، فالوكالة فيه ثابتة .
والحاصل: أنّه لا تفاوت بين البابين، فلا نتعرّض لبيان الأدلّة مراعاة للاختصار ، والحمدلله ربّ العالمين .
-
(1) راجع الفصل السادس من هذا الباب .
(2) وسائل الشيعة 13 : 285 الباب 1 من كتاب الوكالة، ح1 .
الفصل العاشر
في ولاية الحاكم ، والقاضي
وعدول المؤمنين على أموال الصغار
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل : ولاية الحاكم
لا شبهة في أنّ للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط جواز التصرّف في أموال الغيّب والقصّر ، والظاهر أنّه لا خلاف في أصل ولايته على أموالهم، بل الإجماع عليه ، فيجوز بيع مال الصغير ونحوه بشرط المصلحة من الحاكم أو أمينه عند عدم الأب والجدّ ووصيّهما .
إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفه هذا ، هل يكون من جهة النيابة العامّة الثابتة للفقيه عن الإمام(عليه السلام) كما هو المشهور ، أو لكون هذا التصرّف من شؤون القضاء الثابتة له بلا خلاف ، أو من باب اُمور الحسبة ؟.
قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط : «من ولّى مال اليتيم جاز له أنْ يتّجر فيه للصبي
نظراً له ; سواءٌ كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم»(1) . وهكذا في النهاية(2). ومثل هذا في السرائر(3) .
وقال المحقّق (رحمه الله) : «الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا فللوصيّ ، فإن لم يكن فللحاكم»(4) .
وكذا في المختصر النافع(5) . وبه قال بنو حمزة(6) وزهرة(7) وإدريس(8)وسعيد(9)، والفاضل الآبي(10) ، والعلاّمة في أكثر كتبه(11) ، والشهيد الأوّل(12) .
وقال الشهيد الثاني : «إنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً، أو وصايا وحقوقاً وديوناً . فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه، ثمّ لجدّه لأبيه، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية، الأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب، ثمّ وصيّ الجدّ وهكذا، فإن عُدِم الجميع فالحاكم ، والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلين; وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل . وإنّما
-
(1) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
(2) النهاية للطوسي : 361 .
(3) السرائر 3 : 194 و ج 2 : 211 .
(4) شرائع الإسلام 2 : 102 ـ 103.
(5) المختصر النافع : 146 و 170 .
(6) الوسيلة : 279 .
(7) غنية النزوع : 207 .
(8) السرائر 2: 211.
(9) الجامع للشرائع : 246 .
(10) كشف الرموز 1 : 554 .
(11) إرشاد الأذهان 1 : 360 و 397 .
(12) الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
كان حاكماً عامّاً لأنّه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلك الشخص، بل بعموم
قولهم (عليهم السلام) : «اُنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا»(1) »(2) .
وقال المحقّق الكركي في رسالة صلاة الجمعة :
«اتّفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة نائب من قبل أئمّة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل . . . وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن اُحتيج إليه، ويلي أموال الغيّاب والأطفال والسفهاء والمفلّسين، ويتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام(عليه السلام)»(3) .
وقريب من هذه العبارات جاء في كلمات بعض آخر من المتأخِّرين(4) ، ومتأخِّري المتأخِّرين(5) . وهكذا بعض فقهاء العصر(6) .
ويمكن أن يدّعى أنّ ولاية الفقهاء الجامعين للشرائط على أموال اليتامى من ضروريّات فقه الإماميّة :
جاء في الجواهر : «بالجملة: فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة»(7) .
-
(1) الكافي 7: 412 ح5، تهذيب الأحكام 6 : 218 ح514 .
(2) مسالك الأفهام 6 : 264 ـ 265 .
(3) رسائل المحقّق الكركي 1 : 142 .
(4) غاية المراد 2 : 21 و 204 ، اللمعة الدمشقيّة : 62 ، جامع المقاصد 4 : 85 ، زبدة البيان : 501 ، كفاية الأحكام : 113 ، جامع الشتات 2 : 464 ـ 467 .
(5) عوائد الأيّام : 555 ، مفاتيح الشرائع 3 : 186 ، الحدائق الناظرة 18 : 322 ، رياض المسائل 5 : 63 .
(6) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 623 و 673 ـ 675 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 22 و 210 ، الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : 317 .
(7) جواهر الكلام 21 : 397 .
وقال الإمام الخميني (رحمه الله) : «ولاية الفقيه ـ بعد تصوّر أطراف القضيّة ـ ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهان»(1) .
أدلّة ولاية الحاكم على أموال الصغار
يدلّ على ولاية الحاكم على أموال الصغار اُمور :
الأوّل : الإجماع القطعي كما تقدّم في كلام المحقّق الكركي .
قال صاحب الرياض ـ بعد ذكر من لهم الولاية على أموال الصغار من الأب والجدّ والحاكم الشرعي وأمينه المنصوب من قبله، وبيان مراتبهم في ذلك ـ : «ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه، وهو الحُجّة»(2) ، ونقله أيضاً المحقّق الأردبيلي(3) . وادّعاه في الجواهر(4) .
وقال المحقّق القمّي : «والدليل لولاية الحاكم الإجماع المنقول وعموم النيابة التي تستفاد من مثل المقبولة وغيرها»(5) .
وقال الفاضل النراقي : «وحكاية الإجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة»(6) .
وجاء في العناوين للسيّد المراغي : «ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعلّه مستفيضٌ في كلامهم»(7) .
-
(1) كتاب البيع 2 : 467 .
(2) رياض المسائل 5 : 63 .
(3) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
(4) جواهر الكلام 15 : 422 .
(5) جامع الشتات 2 : 465 .
(6) عوائد الأيّام : 555 .
(7) العناوين 2 : 563 .
الثاني : قوله ـ تعالى ـ : ( وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(1) .
وتقريب الاستدلال بها : أنّ الآية إمّا خطاب إلى الأولياء ، كقوله تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ )(2). فالخطاب فيها متوجّه إلى الوصيّ والحاكم وأمينه ولعلّ إلى الجدّ لولا انصرافها عنه ; لأنّها في مورد اليتيم .
وإمّا خطاب لجميع المكلّفين، كما يشهد له سياق الآيات المتقدّمة عليها والمتأخّرة عنها .
وعلى كلا التقديرين تكون الآية بلحاظ الاستثناء دليلاً على جواز التصرّف المقرون بمصلحة الصغير ، فتدلّ على جواز قرب ماله بالتي هي أحسن لكلّ أحد من الناس، والقدر المتيقّن منه الفقهاء فيجوز لهم قطعاً ، وكذلك يجوز قرب غيرهم مع إذن الفقيه ، وأمّا بدون إذنه فجواز قرب مال اليتيم لا يستفاد من الآية(3) ; لجواز أن يكون الأحسن كونه مع إذن الفقيه الذي بيده مجاري الاُمور، وهو المرجع في الحوادث والحجّة والحاكم والقاضي من جانب الإمام، وأمين الرسول ، وكافل الأيتام، وأعلم بوجوه التصرّف ، بل يظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون إذنه ، كما صرّح بذلك الفاضل النراقي (رحمه الله)(4) .
-
(1) سورة الأنعام 6 : 152 ; سورة الإسراء 17 : 24 .
(2) سورة النساء 4 : 6 .
(3) الحقّ أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على من له الولاية على التصرّف، وبعبارة اُخرى: لا تعيّن الأولياء، بل تدلّ على أنّ من له الولاية الثابتة بدليل آخر لا يجوز له التصرّف إلاّ بالّتي هي أحسن، أو تدلّ على أنّ جميع المكلّفين إذا أرادوا التصرّف ولو من جهة اشتراء مال اليتيم لا يجوز إلاّ بالأحسن، فالمشتري لمال اليتيم مخاطب أيضاً مع أنّه ليس وليّاً، وبناءً على ذلك لا تدلّ الآية الشريفة على أنّ الفقيه له التصرّف في مال اليتيم ولاية. نعم لا تدلّ على الحكم التكليفي فقط كما ذهب إليه السيّد الخوئي، بل تدلّ على عدم جواز التصرّف تكليفاً ووضعاً إلاّ بالّتي هي أحسن، فالآية لا تدلّ على الولاية، بل تدلّ على التصرّفات بالنحو الّذي ذكر. م ج ف.
(4) عوائد الأيّام : 555 مع تصرّف .
إيراد المحقّق الخوئي على الاستدلال بالآية والجواب عنه
أورد عليه السيّد الخوئي بأنّ دلالة الآية على ثبوت الولاية ممنوعٌ ، وقال في توضيحه: «إنّ ظاهر الآية هو النهي تكليفاً في التسلّط على مال اليتيم وتملّكه وأكله بالباطل ».
ثمّ قال : «والمراد بالّتي ليس هو التقرّب وإلاّ لما كان وجه للتأنيث ، بل هي إشارة إلى الطريقة الوسطى الإسلاميّة، أو إلى الشريعة الواضحة المحمّدية، كما عبّر عن ذلك في آية اُخرى بالمعروف، ونهى عن أكل مال اليتيم إلاّ بالمعروف، وعليه: فتكون الآية نظير آية التجارة نهياً عن أكل المال بالباطل إلاّ بالطريقة الوسطى وبالأسباب الشرعيّة، فلا تكون مربوطاً بالبيع والشراء وبجهة الولاية»(1) .
وفي كلامه(قدس سره) نظر ; لأنّه لو كان مفادّ آية النهي عن قرب مال اليتيم مثل آية النهي عن التجارة بالباطل كما قال (رحمه الله)، يصير معناها(2) بلحاظ الاستثناء ( حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) هكذا ، إذا بلغ اليتيم أشدّه فيجوز قرب ماله بغير التي هي أحسن وغير الطريقة الإسلاميّة ، وبلوغ اليتيم أشدّه يبيح قرب ماله ويجوز أكله وتملّكه بغير الأحسن، وفساده ظاهر، ومعنى القرب ـ كما جاء في التفاسير ـ التصرّف فيه وحفظه وتثميره والاتّجار به .
قال الشيخ (رحمه الله): «في الآية نهي من الله ـ تعالى ـ لجميع المكلّفين أن يقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن ، وهو أن يحفظوا عليه ويثمروه، أو ينفقوا عليه بالمعروف على ما لا يشكّ أنّه أصلح له، فأمّا لغير ذلك فلا يجوز لأحد التصرّف فيه . . .»(3) .
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 27 و 77 و 79 .
(2) هذا المعنى ممنوع جدّاً; فإنّ الآية بلحاظ الاستثناء تدلّ على أنّ اليتيم إذا بلغ أشدّه فيجوز دفع ماله إليه حتّى يتصرّف فيه بأيّ نحو شاء وأراد، وبعبارة أخرى: جواز القرب وعدم جوازه مختصّ بزمان عدم البلوغ، وإلاّ فبعده لا معنى للقرب أصلا، وهذا يستفاد من الكشّاف أيضاً. م ج ف.
(3) التبيان في تفسير القرآن 6 : 476 .
وكذا في مجمع البيان(1) .
وفي الكشّاف : «ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن ، إلاّ بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم، وهي حفظه وتثميره ، والمعنى احفظوا عليه حتّى يبلغ أشدّه فادفعوا إليه بالقسط»(2) .
ونحو هذا كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(3) .
وفي الدرّ المنثور : «أخرج أبو حاتم عن عطيّة في قوله : ( وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ) الآية ، قال : طلب التجارة فيه والربح فيه»(4) .
على هذا لا وجه لما ذكره(قدس سره) في دلالة الآية من أنّ مدلولها هو النهي تكليفاً في القرب بمال اليتيم، وتملّكه وأكله بالباطل وعلى غير وجه الشرعيّة، وكونها نظير آية التجارة .
وظهر ممّا ذكرنا أيضاً ما في كلام المحقّق الايرواني(قدس سره) من «أنّ الآية بصدد بيان ما يجوز من التصرّف وما لا يجوز ، لا ضابط من له التصرّف ممّن ليس له ، فهي مهملة من هذه الحيثيّة»(5) ; لأنّه لا إهمال في الآية الكريمة، بل هي ظاهرة بلحاظ الاستثناء في جواز التصرّف المقرون بمصلحة الغير ، وحيث إنّ مورد الآية هو اليتيم الذي لا وليّ له، فللحاكم وأمينه أو المأذون من قبله أو الوصيّ للجدّ أو الأب جواز التصرّف ، وحيث إنّ الضرورة والإجماع قائم بأنّه لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلاّ من هؤلاء الخمسة المذكورة .
-
(1) مجمع البيان 4 : 183 .
(2) الكشّاف 2 : 79 .
(3) الجامع لأحكام القرآن 7 : 134 .
(4) الدرّ المنثور 3 : 55 .
(5) حاشية الايرواني على المكاسب : 159 .
فيستفاد من الآية بضميمة الإجماع والضرورة ولاية الحاكم ، وهو المطلوب .
الثالث : سيرة المتشرّعة وارتكازهم
قال السيّد السبزواري : «وسيرة المتشرّعة بالرجوع إلى المجتهدين فيها ; أي في اُمور الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها . . .» ثمّ قال :
«إنّ ولاية الفقيه الجامع للشرائط في مثل هذه الاُمور الدينيّة من مرتكزات المتشرّعة، بل من فطريات أهل كلّ مذهب وملّة الرجوع فيها إلى علماء مذهبهم، وأنّ للعلماء نحو ولاية في مثل هذه الاُمور . . . وفي مثل هذا الأمر الارتكازي للمتشرّعة لا يحتاج إلى ورود التعبّد من الشارع، بل يكفي مجرّد عدم الردع في هذه الاُمور العامّة الابتلاء في جميع الأعصار والأزمان . فلا وجه بعد ذلك للتمسّك بأصالة عدم الولاية; لأنّها ثابتةٌ بنظر العرف، وما ورد من الترغيب في الرجوع إلى الفقهاء ورد في مورد هذا النظر العرفي، فيؤكّده ويثبّته ، فأصل ولاية الفقيه في الجملة ممّا لا ينبغي أن يبحث عنه»(1) .
الرابع(2) : القاعدة الثابتة من بعض الأخبار ومن مذاق الشريعة ; وهي أنّه لاشكّ في أنّ الصغير ممنوع عن التصرّف في ماله شرعاً ، إجماعاً ونصّاً، كتاباً وسنّةً ، فإمّا لم يُنصب من جانب الله سبحانه أحد لحفظ أمواله وإصلاحه والتصرّف فيه فيما يصلحه ، أو نصب .
والأوّل غير جائز على الحكيم ـ تعالى ـ المتقن عقلاً، كما صرّح به في رواية العلل من أنّه «لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة، وذهب الدين، وغيّرت السنن والأحكام ـ إلى أن قال : ـ وكان في ذلك فساد
-
(1) مهذّب الأحكام 1 : 115 .
(2) هذا الوجه وكذا الوجه السابق لا تدلّ على ثبوت الولاية، بل غايتهما الثبوت من باب الحسبة لا الولاية، والفرق بينهما واضح جدّاً. م ج ف.
الخلق أجمعين»(1) .
ويدلّ عليه أيضاً استفاضة الأخبار بأنّ الشارع لم يدع شيئاً ممّا تحتاج إليه الاُمّة إلاّ بيّنه لهم(2) .
ولا شكّ أنّ هذا أشدّ ما يحتاجون إليه، بل يبطله في الأكثر نفي الضرر والضرار، فتعيّن الثاني ، وهذا المنصوب إمّا أن يكون معيّناً أولا على التعيين; أي كلّ من كان، والمردّد لا على التعيين لا ماهيّة له ولا هويّة . وعلى التعيين إمّا يكون هو الفقيه أو الثقة العدل ، وعلى كلا التقديرين يكون الفقيه منصوباً، فهو المتيقّن والباقي مشكوك ، أشار إلى هذا الوجه الفاضل النراقي(قدس سره)(3) .
الخامس: ـ وهو العمدة ـ الأخبار الكثيرة
منها : صحيحة إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثةً صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ; إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي; لأنّهنّ فروج . قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(عليه السلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلاً منّا فيبيعهُنّ ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك؟
قال : فقال: «إذا كان القيّم به مثلك و(4)مثل عبد الحميد فلا بأس»(5) .
-
(1) علل الشرائع 1 : 253 ـ 254 .
(2) الكافي 1 : 59 ح2 و 4 .
(3) عوائد الأيّام : 555 ـ 556 .
(4) في نسخة من التهذيب «أو».
(5) وسائل الشيعة 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح2 .
قال المحقّق العراقي : «صحيحة ابن بزيع خير شاهد على ثبوت هذه التولية العامّة»(1) .
والمهمّ في فقه الحديث هو بيان جهة المماثلة وأنّها في أيّ شيء؟ فقد جعل الشيخ الأعظم(قدس سره) موارد الاحتمالات في المماثلة أربعة ، حيث قال: «إنّ المراد من المماثلة : إمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّاً، أو في الفقاهة ; بأن يكون من نوّاب الإمام(عليه السلام) عموماً في القضاء بين المسلمين ، أو في العدالة»(2) .
أمّا احتمال التماثل في التشيّع فبعيدٌ جدّاً ; إذ الظاهر من الرواية أنّ التشيّع مفروض الوجود ومفروغ عنه، وإنّما السؤال من جهة أنّ نصب القاضي يجوّز التصرّف للقيّم أم لا؟ مع عدم كون القاضي شيعيّاً ولا فقيهاً في مذهبنا ولا عدلاً ، بل ولا ثقةً على الظاهر، وذلك لأنّ فرض السائل كون الرجل من أصحابنا وجعل القاضي عبد الحميد قيّماً .
وأمّا احتمال المماثلة في الفقاهة لكون محمّد بن إسماعيل بن بزيع من فقهاء الشيعة; لأنّه من مشايخ فضل بن شاذان ، وكذلك عبد الحميد على بعض الوجوه، فمعنى الرواية يكون هكذا : إن كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فقيهاً فلا بأس ، وتدلّ على ولاية الفقيه على أموال اليتامى ، وسيأتي زياد توضيح في ذلك قريباً .
قال السيّد الخوئي(قدس سره) : « ربما يقال : إنّ عبد الحميد هذا محتمل بين اثنين: أحدهما ثقة لم تثبت فقاهته وهو ابن سالم، والآخر فقيهٌ لم يثبت وثاقته وهو ابن سعيد، فحينئذ تكون الرواية مجملة من حيث اعتبار الفقاهة ، ولكنّ الظاهر أنّ
-
(1) شرح تبصرة المتعلّمين، كتاب القضاء : 240 .
(2) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 565 .
المراد منه هو عبد الحميد بن سالم كما صرّح به في الرواية، حيث قال : وجعل عبدالحميد بن سالم القيّم بماله كما في التهذيب في باب الزيادة من الوصيّة، وأنّ توثيقه لم ينحصر بهذه الرواية، بل ظاهر عبارة النجاشي في ابنه محمّد بن عبد الحميد بن سالم هو ذلك مع إثبات كتاب له، فيكون فقيهاً»(1) .
ومقصوده(قدس سره) ما قال النجاشي في ترجمة ابنه محمّد بن عبد الحميد ، وهذا نصّه : «روى عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)، وكان ثقةً من أصحابنا الكوفيّين، له كتاب النوادر»(2). فيستفاد من هذا أنّ التوثيق للأب لا للابن ; لأنّه إذا كان الراوي صاحب كتاب أو أصل يستظهر بل يستفاد أنّه فقيهٌ ، كما أشار إليه المحقّق الاصفهاني(3) .
وقال المحقّق التستري بعد نقل ما قال النجاشي في ترجمة الرجل :
أقول : التحقيق أنّه ظاهر في الرجوع إلى هذا; لقوله : «وكان» بالوصل; فإنّه ظاهر في العطف على قوله : «روى» ولو أراد قطع الكلام عن الأب لقال : «كان» بالفصل، كما في قوله بعده: «له كتاب»(4) .
مضافاً إلى أنّه يمكن إثبات فقاهته من حيث إنّه جعل قريناً لمثل ابن بزيع، الذي هو من الفقهاء ومن مشايخ الفضل بن شاذان كما تقدّم . وأمّا لو كان هو عبد الحميد ابن سعيد; لأنّ في نسخة الكافي وبعض نسخ التهذيب لم تكن كلمة «ابن سالم» موجودة(5) ، كما قال الشيخ التستري أيضاً نقلاً عن الوحيد : «لم يجد
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 61 .
(2) رجال النجاشي : 339 الرقم 906 .
(3) حاشية المكاسب 2 : 406 .
(4) قاموس الرجال 6 : 66 الرقم 3958 .
(5) الكافي 5 : 209، وفيه «فصيّر عبدالحميد القيّم بماله ».
في نسخته من التهذيب لفظة «بن سالم» فلعلّ المراد بعبد الحميد فيه عبد الحميد ابن سعيد الآتي; لأنّ هذا من أصحاب الصادق والكاظم(عليهما السلام)، والمسؤول عنه الجواد(عليه السلام)»(1) .
قال النجاشي: وأمّا وثاقته فمن وجهين : من جهة هذه الرواية ، كما قال التستري في ترجمته. «فكونه من أصحاب الجواد(عليه السلام) في غاية القرب، وحينئذ فيدلّ الخبر على وثاقته»(2) .
ومن جهة رواية صفوان عنه، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، قال الشيخ في العدّة : «ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به»(3) .
مضافاً إلى أنّه قيل : إنّهما واحد، وأنّه نسب تارةً: إلى أبيه، واُخرى: إلى جدّه; لتوصيف كليهما بأنّه مولى بجيلة كوفيّ وكليهما بالعطّار، فهو فقيهٌ موثّق، والله العالم(4) .
الإيراد على الاستدلال بالصحيحة والجواب عنه
قال الشيخ الأعظم الأنصاري ـ بعد ذكر الصحيحة وبيان الاحتمالات في المماثلة ـ : «والاحتمال الثالث ـ أي الفقاهة ـ مناف لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره، وهذا بخلاف الاحتمالات الاُخر ـ إلى أن
-
(1) قاموس الرجال 6 : 67 .
(2) رجال النجاشي: 246.
(3) العدّة في الاُصول 1 : 154 .
(4) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 406 ، تنقيح المقال 2 : 135 مع تصرّف .
قال: ـ فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها; وهو العَدل»(1) .
وقال المحقّق النائيني في توضيح هذا الإيراد : «وعلى هذا الاحتمال ـ أي المماثلة في الفقاهة ـ تخرج الصحيحة عن الدلالة على ولاية غير الفقيه ، لكنّه بعيد في نفسه; لاقتضائه بمفهومه ثبوت البأس مع عدم كون المتصدّي فقيهاً، مع أنّ مفروض مورد السؤال هو الأمر الذي يجب القيام به من غير الفقيه عند عدم الفقيه ـ إلى أن قال : ـ فالمتعيّن هو أحد الاحتمالين من الثاني أو الثالث ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فلا جرم يجب الأخذ بالمتيقّن منهما وهو العدالة»(2) .
والمتحصّل من هذا الإيراد : أنّ هذا المفهوم «هو مفهوم الشرط، ويستفاد منه أنّه لو لم يكن القيّم فقيهاً ففيه البأس، وهذا ينافي كون التصرّف في مال اليتيم والقيام بأمره من الاُمور التي لا تسقط بتعذّر إذن الفقيه، ونعلم قطعاً بولاية عدول المؤمنين عند تعذّر الوصول إلى الفقيه، مع أنّ إطلاق ذلك المفهوم يمنع عن ذلك .
وأجاب نفسه(قدس سره) بأنّه يمكن أن يكون المفروض في مورد الرواية صورة التمكّن من الرجوع إلى الفقيه، وأنّ البأس كان في تصدّي غيره لأجل التمكّن من تصدّيه . . .»(3) .
وأظهر منه ما أجاب عنه السيّد الخوئي (رحمه الله) بوجهين :
أوّلاً : النقض بإرادة المماثلة في العدالة; إذ المحذور المذكور وارد على هذا أيضاً، للعلم بوصول النوبة إلى المؤمنين الفاسقين مع تعذّر العدل منهم العياذ بالله، مع أنّ المفهوم ينفي جواز توليتهم على ذلك .
وثانياً : أنّه قد حقّق في محلّه أنّ أصالة عدم التقييد وظهور الإطلاق إنّما يتّبع
-
(1) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 565 .
(2 ـ 3) المكاسب والبيع للنائيني 2 : 339 و 340 .
فيما إذا كان الشكّ في أصل المراد، فبمقتضى ظهور الكلام وإطلاقه نستكشف مراد المتكلّم ويحتجّ به له وعليه . وهذا بخلاف ما إذا علم المراد من الخارج وكان الشكّ في كيفيّة ذلك المراد من المفهوم، فلا يجوز حينئذ التمسّك بأصالة عدم التقييد في بيان كيفيّة المراد حتّى يتوهّم أنّ إطلاق المفهوم ينفي وصول النوبة إلى المؤمنين العادلين، فليس المورد مورداً للتمسّك بأصالة عدم التقييد أصلاً، كما هو واضح(1) ، إذن فلامجال لإشكال المصنّف; إذ هو مفروض التمسّك بأصالة عدم التقييد ، وقد عرفت عدم وصول النوبة إليها(2) .
ثمّ قال(قدس سره) : «والتحقيق أنّ الظاهر إرادة المماثلة من الرواية من(3) جميع الجهات حتّى في العربيّة والكوفيّة، ولكن نرفع اليد عن ذلك في الاُمور التي نقطع بعدم مدخليّتها في الحكم بنحو، كالعربيّة والكوفيّة ونحوهما ، ويبقى الباقي تحت الإطلاق، بل كلّما نشكّ في خروجه ودخوله من جهة مدخليّته وعدمه ، وإنّما الخارج ما نعلم بعدم دخالته في الحكم ، إذن فلا وجه لاعتبار العدالة فقط من جهة أخذ القدر المتيقّن .
وعليه: فلابدّ من اعتبار الفقاهة والوثاقة والعدالة وجميع الخصوصيّات المحسّنة التي تحتمل دخالتها في الحكم في الولاية المجعولة في الرواية، فافهم»(4).
-
(1) والحق أنّ التمسّك في المفهوم في ما نحن فيه إنّما هو بالنسبة إلى أصل المراد، وليس التمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات كيفيّة المراد، فالمفهوم بالإطلاق يدلّ على نفي ولاية غير الفقيه حتّى عدول المؤمنين. نعم، لا استيحاش في ذلك بعد إمكان تقييده بالأدلّة الاُخرى. م ج ف.
(2) مصباح الفقاهة 5: 6.
(3) لا ريب عندي في عدم إرادة المماثلة في جميع الجهات; فإنّه مضافاً إلى ندرتها غاية الندرة أنّ العرف لا يفهم من العبارة ذلك المعنى; فإنّ التعبير بالمثل عند العرف هو من كان شبيهاً أو قريباً إليه في رعاية المصلحة وحفظ الأمانة، وعدم تضييع حقوق الأيتام. م ج ف.
(4) مصباح الفقاهة 5: 60 ـ 61.
ومنها : صحيحة ابن رئاب ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) ، عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم(1) .
ومورد الرواية هو اليتيم الذي لا أب له ولا وصيّ، وكذا الجدّ على الظاهر، وفي هذا المورد قال الإمام(عليه السلام) : «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم وباع عليهم ونظر لهم». فهذه الصحيحة ظاهرةٌ في أنّ الحاكم ينصب فرداً قيّماً وناظراً لهؤلاء الصغار; لأنّ جعل القيمومة منحصر بالحاكم، فهي تدلّ على ثبوت الولاية لغير الأب والوصيّ والجدّ، حيث انتفت هذه الثلاثة في مورد الرواية . أمّا الأب والوصيّ، فصريح الرواية انتفاؤهما . وأمّا الجدّ; فلأنّه لو كان ، لكان هو المتولّي لأمرهم ويذكره الإمام(عليه السلام) ، فتدلّ الصحيحة على إثبات الولاية لغير هؤلاء الثلاثة، والحاكم منهم ، وهو المطلوب ، وسيأتي أنّها تدلّ على ولاية عدول المؤمنين أيضاً .
ومنها : ما أرسله في الفقيه قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : اللّهمَّ ارحم خلفائي ، قيل : يارسول الله ومَنْ خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون من بعدي، يروون حديثي وسنّتي»(2) .
ورواه في عيون الأخبار بطرق ثلاثة ، رجال كلّ طريق يغاير طريق الآخر
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 474 الباب 88 من كتاب الوصايا، ح1 .
(2) الفقيه 4 : 352 الرقم 915 ، وسائل الشيعة 18 : 65 الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح50 .
وفيها : «اللّهمّ ارحم خلفائي ثلاث مرّات»(1) .
وفي معاني الأخبار بسند رابع(2) .
وكذلك في الأمالي وزاد في آخرها : «ثمّ يعلّمونها اُمّتي»(3) .
وذكرها في مستدرك الوسائل نقلاً عن صحيفة الرضا(عليه السلام)(4) .
وكذا في عوالي اللئالي وزاد في آخرها : «أولئك رفقائي في الجنّة»(5) .
وذكره في البحار نقلاً عن منية المريد مع تفاوت يسير(6) . ومثله ما نقل عن الراوندي(7) .
قال الإمام الخميني : «هي روايةٌ معتمدةٌ لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلةً لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير; فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين : أحدهما: ما اُرسل ونسب إلى المعصوم(عليه السلام) بنحو الجزم، كقوله : قال أمير المؤمنين(عليه السلام) كذا . وثانيهما: ما قال : روى عنه(عليه السلام) مثلاً ، والقسم الأوّل من المراسيل المعتمدة المقبولة»(8) .
وأمّا تقريب الاستدلال بها : بأن يُقال : إنّ معنى الخلافة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أمر معهود من أوّل الإسلام ليس فيه إبهام ، والخلافة لو لم تكن ظاهرةً في الولاية والحكومة فلا أقلّ من أنّها القدر المتيقّن منها(9) ، ومنها: الولاية على أموال الصغار.
-
(1) عيون أخبار الرضا 2 : 37 الرقم 94 .
(2) معاني الأخبار : 374 ـ 375 .
(3) الأمالي للصدوق : 247 الرقم 266 .
(4) مستدرك الوسائل 17 : 287 الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح10 .
(5) عوالي اللئالي 4 : 64 .
(6) بحار الأنوار 2 : 25 كتاب العلم الباب 8 ح83 .
(7) مستدرك الوسائل 17 : 300 الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح48 .
(8) كتاب البيع 2 : 468 .
(9) نفس المصدر .
بتعبير آخر : الخلافة بقول مطلق كما ورد في الروايات تفيد استخلاف الخليفة في كلّ ما كان للمستخلف «بالكسر». ففي المقام يستفاد منها أنّ للفقيه ما كان للنبيّ(صلى الله عليه وآله)من الشؤون في اُمور المسلمين، ومنها الولاية على أموال الصغار . نعم، لا يكون له ما استثني من هذا الإطلاق، كالجهاد ابتداءً وتزويج الصغار وغيرهما .
وأورد السيّد الخوئي(قدس سره) على الاستدلال بالرواية بـ «أنّ الظاهر من ذلك خليفتهم في نقل الرواية والحديث(1)، كما قال(صلى الله عليه وآله): يروون حديثي وسنّتي، لا أنّ المراد من الخلافة الخلافة في التصرّف في أموال الناس وأنفسهم»(2) . ويستفاد ذلك أيضاً من كلام المحقّق الاصفهاني(3) والعراقي(4) .
وقال المحقّق الايرواني بعد بيان أنّ الخلافة مقولةٌ بالتشكيك : «والإضافة تفيد العموم في حقّ كلّ من هو خليفة في جهة أو(5) في جهات، والذين يأتون بعده ويروون حديثه يشمل الأئمّة الذين هم خلفاؤه في كلّ الجهات والعلماء والرواة الذين لا يعلم حدّ خلافتهم، فلعلّ خلافتهم مختصّةٌ بنشر الأحكام وإبلاغها كما يناسبه لفظ يروونَ حديثي . . .»(6) .
وفي كلامهم نظر ; لأنّ الخلافة لنقل الرواية والسنّة لا معنى لها; لأنّه(صلى الله عليه وآله) لم يكن
-
(1) ويبعّده التعبير بقوله من بعدي; فإنّ الخلافة في نقل الرواية والحديث كانت من زمن النبي(صلى الله عليه وآله) لا من بعده. هذا، مضافاً إلى أنّ اللاّزم تفسير كلمة الخلفاء مع قطع النظر عن ذيل الرواية بمعنى أنّه لو صدر من لسان الرسول(صلى الله عليه وآله) هذه العبارة فقط، لكان معناه الخلافة في جميع الاُمور ومن يقوم مقامه في كل الشؤون إلاّ ما استثنى. م ج ف.
(2) مصباح الفقاهة 5 : 44 .
(3) حاشية المكاسب للاصفهاني 2 : 386 .
(4) كتاب القضاء للعراقي : 16 .
(5) والخليفة في جهة من الجهات لا يُعدّ عند العرف خليفة; فإنّ الخلافة متقوّم لأكثر من جهة واحدة لو لم نقل بوجود غالب الجهات، فتدبّر. م ج ف.
(6) حاشية المكاسب للايرواني : 156 .
راوياً لرواياته حتّى يكون الخليفة قائماً مقامه في ذلك ، وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «الذين يأتون من بعدي، يروون حديثي وسنّتي» يكون معرّفاً للخلفاء، ولا يكون في مقام تحديد معنى الخلافة حتّى تكون الخلافة في رواية الحديث والسنّة، هذا أوّلاً .
وثانياً : على ما في الرواية أضاف(صلى الله عليه وآله وسلم) الخلفاء إلى نفسه، فقال : اللّهمَّ ارحم خلفائي ، والإضافة ـ كما قال المحقّق الايرواني نفسه ـ تفيد العموم ، فيستفاد منها أنّ كلّ ما كان له(صلى الله عليه وآله وسلم) من الولاية كان لخلفائه إلاّ ما استثني، وهذا المعنى هو ما قلنا في تقريب الاستدلال بأنّ الخلافة بقول مطلق تفيد استخلاف الخليفة في كلّ ما كان للمستخلف «بكسر اللام» .
وعلى هذا لا معنى للقول : بأنّ الظاهر من الحديث خليفتهم في نقل الرواية والحديث، أو يقال: حيث لا يعلم حدّ خلافة الفقهاء، فخلافتهم مختصّةٌ بنشر الأحكام وإبلاغها .
قال في الجواهر : «ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعيّة، يدفعها معلوميّة تولّيه كثيراً من الاُمور التي لاترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين، وغير ذلك ممّا هو محرّر في محلّه، ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء; فإنّهم لايزالون يذكرونولايته في مقامات عديدة لادليل عليهاسوى الإطلاقات»(1).
وقال الإمام الخميني (رحمه الله) : «وتوهّم أنّ المراد من الخلفاء خصوص الأئمـّة (عليهم السلام)في غاية الوهن; فإنّ التعبير عن الأئمـّة (عليهم السلام) برواة الأحاديث غير معهود ، بل هم خزّان علمه تعالى ، ولهم صفات جميلة إلى ما شاء الله(2) لا يناسب للإيعاز
-
(1) جواهر الكلام 15 : 422 .
(2) ورد في حقّهم أنّهم الراسخون في العلم وعالمون بتأويله ، اُصول الكافي 1 : 270 ب22 ، وخزنة علم الله وعيبة وحي الله. نفس المصدر : 249 ب11 ، وهم شجرة النبوّة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة. نفس المصدر : 279 ب31 .
إلى مقامهم (عليهم السلام) «أنّهم رواة الأحاديث» بل لو كان المقصود من الخلفاء أشخاصهم المعلومين لقال : عليّ وأولاده المعصومون (عليهم السلام) لا العنوان العامّ الشامل لجميع العلماء»(1) .
ومنها : الرواية المتقدّمة التي ذكرها في تحف العقول عن سيّد الشهداء، عن أمير المؤمنين(عليهما السلام).
وهي وإن كانت مرسلة ، لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل(قدس سره)، ومتنها موافق للاعتبار والعقل. والرّواية طويلة نذكر بعض فقراتها الّتي دلّت على ما كنّا بصدد إثباته في المقام قال(عليه السلام): «ثمّ أنتم أيّتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة، وبالنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يَد لكم عنده، تشفعون في الحوائج اذا امتنعت من طلاّبها، وتمشون في الطريق بهيئة الملوك، وكرامة الأكابر، أليس كلّ ذلك إنّما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحقّ الله وإن كنتم عن أكثر حقّه تقصّرون، فاستخففتم بحقّ الأئمة. فأمّا حق الضعفاء فضيّعتم، وأمّا حقّكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بذلتموه... لقد خشيت عليكم أيّها المتمنّون على الله أن تحلّ بكم نقمة من نقماته... وأنتم بالله في عباده تكرمون، وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)محقورة... كلّ ذلك ممّا أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون، وأنتم أعظم النّاس مصيبةً لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون، ذلك بأنّ مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إلاّ بتفرّقكم عن
- (1) كتاب البيع 2 : 469 .
الحقّ، الحديث»(1).
ومدلول الجملة الأخيرة هو ثبوت الولاية العامّة ; لأنّ الاُمور جمع محلّى باللاّم، فيستفاد منها العموم، وأنّ الاُمور التي من شأنها الجريان عن نظر الإمام مفوّضةٌ إلى العلماء ، ومنها: رعاية شؤون القاصرين في أموالهم وأنفسهم .
وأورد عليه المحقّق النائيني بأنّ قوله(عليه السلام) : «مجاري الاُمور بيد العلماء» الدالّ بإطلاقه على الولاية العامّة «فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمّة (عليهم السلام) ـ إلى أن قال: ـ فإنّ فيه قرائن تدلّ على أنّ المراد من العلماء فيه : هم الأئمّة (عليهم السلام) ; فإنّهم هم الاُمناء على حلال الله وحرامه»(2) .
وقال المحقّق العراقي : «ومثل هذا العنوان ربما كان مختصّاً بالأئمّة»(3) .
وتبعهما السيّد الخوئي في ذلك(4) . وهكذا قال به أيضاً المحقّق الايرواني(5) ، والمحقّق الاصفهاني(6) . وقال الفاضل الغفاري : «يعني به المعصومين(عليهم السلام); لقوله(عليه السلام) : نحن العلماء»(7) .
ولقد أجاد الإمام الخميني(قدس سره) في الجواب عنهم، حيث قال : «وأنت إذا
تدبّرت فيها صدراً وذيلاً ترى أنّ وجهة الكلام لا تختصّ بعصر دون عصر، وبمصر دون مصر ، بل كلام صادر لضرب دستور كلّي للعلماء قاطبةً في كلّ
عصر، ومصر للحثّ على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل
-
(1) تحف العقول: 237 ـ 238.
(2) منية الطالب 2 : 233 ـ 234 .
(3) شرح تبصرة المتعلِّمين 5 : 41 .
(4) مصباح الفقاهة 5 : 43 .
(5) حاشية المكاسب للايرواني : 156 .
(6) حاشية المكاسب للاصفهاني 2 : 388 .
(7) ذكره في هامش تحف العقول : 238 .
الظَلَمة، وتعييرهم على تركهما طمعاً في الظَلَمة أو خوفاً منهم ـ إلى أن قال: ـ
والعدول عن لفظ «الأئمّة» إلى «العلماء بالله، الاُمناء على حلاله وحرامه» لعلّه
لتعميم الحكم بالنسبة إلى جميع العلماء العدول الذين هم اُمناء الله على حلاله
وحرامه، بل انطباق هذا العنوان على غير الأئمّة أظهر ; إذ توصيفهم (عليهم السلام) بذلك يحتاج إلى القرينة»(1) .
نقول : وفي الرواية قرائن قطعيّة دلّت على أنّها صدرت خطاباً للعلماء، وفيها جمل لا تكون مناسبة لمقام أهل البيت والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، مثل ما قال(عليه السلام) : «أنتم أيّتها العصابة عصابةٌ بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة . . . وبالله في أنفس الناس مهابةٌ . . . تشفعون في الحوائج» .
هذه الجملات لا تكون خطاباً للناس كلّهم; لأنّ كلّ الناس لا يكونون بالعلم مشهورين، وبالخير مذكورين ، وهكذا .
ومثل ما قال(عليه السلام) : «فأمّا حقّ الضعفاء فضيّعتم، وأمّا حقّكم بزعمكم فطلبتم . . . لقد خشيت عليكم أيّها المتمنّون على الله أن تحلّ بكم نقمةٌ من نقماته . . . وأنتم أعظم الناس مصيبةً لما غلبتم عليه من منازل العُلماء لو كنتم تشعرون . . .» .
لا ريب في أنّ هذه الجمل تكون خطاباً للعلماء خاصّة، الذين لا يقومون بوظيفتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و . . .
فإذا قال الإمام(عليه السلام) عقيب هذه الجملات : «ذلك بأنّ مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الاُمناء على حلاله وحرامه» لا يحتمل أن يكون المقصود منها الأئمـّة (عليهم السلام)، وهذا ظاهر لمن تدبّر في هذه الرواية الشريفة .
- (1) كتاب البيع 2 : 487 .
والحاصل: أنّ الإمام (عليه السلام) قسّم العلماء على قسمين : قسم منهم لا يقومون بوظيفتهم فهم أعظم الناس مصيبةً، وقسم آخر قاموا على طريق الحقّ وهم الذين
تكون مجاري الاُمور والأحكام بأيديهم، ويكونون الاُمناء على حلال الله وحرامه .
على هذا يمكن استفادة مرجعيّة الفقيه في الاُمور منها ، كما أنّه يستكشف ذلك من منع الإمام(عليه السلام) من التحاكم إلى قضاة العامّة وإرجاع الشيعة إلى فقهائنا، كما في مقبولة عمر بن حنظلة(1) ومشهورة أو صحيحة أبي خديجة(2); إذ من مثلهما ربما يستفاد كون الفقيه حاكماً في قبال حكّامهم، وأنّ له من الشأن ما لهم من الولاية على الاُمور .
إذن تستفاد الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة من عموم التنزيل وإطلاقه، حيث إنّ الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً وحاكماً كما في مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أو صحيحة أبي خديجة; فإنّ مقتضى الإطلاق فيهما أن يترتّب الآثار المرغوبة من القضاة والحكّام بأجمعهما على الرواة والفقهاء، ومن تلك الآثار تصدّيهم لنصب القيّم والوليّ على القصّر من الصغار والمجانين وغيرهما .
وذلك لأنّه لا شبهة في أنّ القضاة المنصوبين من قبل العامّة والخلفاء كانوا يتصدّون لتلك الوظائف، كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم وعرف سيرهم وسلوكهم، ويشهد لذلك صحيحة ابن بزيع المتقدّمة; لأنّها صريحة في أنّ القضاة كانوا يتصدّون لنصب القيّم، فإذن تدلّ الروايتان على أنّ المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضياً في الشريعة، فتدلاّن بإطلاقهما على أنّ الآثار الثابتة للقضاة والحكّام
-
(1) وسائل الشيعة 18: 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح1.
(2) وسائل الشيعة 18: 4 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5.
بأجمعهما مترتّبةٌ على الفقيه; فإنّ ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضياً في مقابل قضاتهم وحكّامهم .
فتحصّل من الأخبار المتقدّمة وكذلك من روايات كثيرة أُخرى أنّ الفقيه بيده مجاري الاُمور وهو المرجع في الحوادث، والحجّة والحاكم والقاضي من جانب الإمام(عليه السلام) وأمين الرسول وخليفته، وكافل الأيتام، وحصن الإسلام، ووارث الأنبياء وبمنزلتهم، فثبوت ولاية الفقهاء الجامعين للشرائط في أموال اليتامى قطعيٌّ لا شبهة فيها .
قال الشهيد في مسألة وجوب دفع الزكاة إلى الإمام : «وكذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله; لأنّه نائب للإمام كالساعي بل أقوى»(1) .
وبيّن صاحب الجواهر دليل أقوائيّته بقوله : «لنيابته عنه في جميع ما كان للإمام، والساعي إنّما هو وكيل للإمام(عليه السلام) في عمل مخصوص ـ إلى أن قال: ـ إطلاق أدلّة حكومته ـ أي الفقيه ـ خصوصاً رواية النصب(2) التي وردت عن صاحب الأمر(عليه السلام) ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ يصيّره من أُولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم . نعم ، من المعلوم اختصاصه في كلّ ما له في الشرع مدخليّةٌ حكماً أو موضوعاً»(3) .
وقال السيّد السبزواري : «بعد سدّ الرجوع إلى أبواب حكّام الجور وقضاتهم والأخذ منهم، وعدم الميل إليهم بنحو شديد أكيد، مع عموم الابتلاء للاحتياج إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط ، فهل يتصوّر أن يهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة
-
(1) الروضة البهيّة 2 : 53 .
(2) وسائل الشيعة 18 : 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح9 .
(3) جواهر الكلام 15 : 422 .
إلى اُمّته ويذرهم حيارى؟! فالتشكيك في ولاية الفقيه فيما تبسط يده بالنسبة إليها ممّا لاينبغي»(1) .
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم وإن استشكل في ثبوت الولاية العامّة للفقيه في كتاب المكاسب، حيث قال : «وبالجملة: فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام(عليه السلام)إلاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد»(2) .
وقال في موضع آخر : «والمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان الحكم به مشهوريّاً»(3) .
ولكن مال(قدس سره) في كتاب الزكاة إلى ثبوت النيابة العامّة للفقيه; حيث قال : «ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامّة وجوب الدفع; لأنّ منعه ردّ عليه، والرادّ عليه رادٌّ على الله تعالى ، كما في مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة. ولقوله(عليه السلام)في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث، قال : فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»(4) .
وقال أيضاً في كتاب الخمس : «وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد; نظراً إلى عموم نيابته، وكونه حجّة الإمام على الرعيّة وأميناً عنه وخليفةً له، كما استفيد ذلك كلّه من الأخبار .
لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر تلك الأدلّة ولاية الفقيه عن الإمام(عليه السلام) على الاُمور العامّة»(5) .
-
(1) مهذّب الأحكام 1 : 116 .
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 553 .
(3) نفس المصدر 16: 557 .
(4) كتاب الزكاة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 10 : 356 .
(5) كتاب الخمس، ضمن تراث الشيخ الأعظم 11 : 337 .
جواز التصرّف في أموال الصغار حسبةً
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا: إنّ الأخبار المستدلّ بها على الولاية المطلقة للفقيه قاصرة السند أو الدلالة، كما قال به جماعة(1) ، ولكن لأجل أنّ بعض الاُمور الراجعة إلى الولاية ممّا لا مناص أن تتحقّق في الخارج ، وهي المعبّر عنها بالاُمور الحسبيّة(2) ، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له ، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة وغيرهما ; لأنّه علم من الشارع مطلوبيّة وجودها ، والجزم بعدم رضا الشارع بتركها ، فلابدّ من أن يتصدّى شخص لإقامة تلك الاُمور ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أُخرى : الأئمـّة (عليهم السلام) منعوا الشيعة عن الرجوع إلى قضاة الجور مطلقاً ، فيكون الفقيه الجامع للشرائط مرجعاً لهذه الاُمور ; لأنّه القدر المتيقّن ممّن يحتمل له الولاية في تلك الاُمور (3); لعدم احتمال أن يرخّص الشارع فيها لغير الفقيه، كما لايحتمل أن يهملها ، فمع التمكّن من الرجوع إلى الفقيه لا يجوز الرجوع فيها إلى الغير .
ببيان آخر : لا يجوز تعطيل تلك الاُمور أو تأخيرها; لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب، أو انتهاك عرضهم، ويكون الفقيه هو المرجع فيها; لأنّه القدر المتيقّن ممّن يحتمل أن يكون له الولاية في تلك الاُمور .
نعم ، إذا لم يمكن الرجوع إليه في مورد يكون العدول من المؤمنين مرجعاً
-
(1) منية الطالب 3 : 234 ـ 237 ، شرح تبصرة المتعلِّمين كتاب القضاء 5 : 16 ، التنقيح في شرح العروة، كتاب الاجتهاد والتقليد : 419 ـ 427 ، مصباح الفقيه 5 : 49 ، حاشية المكاسب للايرواني : 156 ـ 157 .
(2) تقدّم ذكر معنى الحسبة والدليل عليها في ولاية الحاكم على تزويج الصغار ج1: 687.
(3) إذا جعلناها من الاُمور الحسبية يمكن أن يقال بأنّ الفقيه أولى بالتصرف من غيره، والظاهر عدم وجود دليل على التعيّن في هذا الفرض، فافهم. م ج ف.
ويجوز لهم التصرّف ، وسنذكر مبحثاً لبيان مسائلها قريباً إن شاء الله .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ إثبات الولاية للفقيه في الجملة في عصر الغيبة قطعيٌّ .
قال المحقّق النائيني : «ولا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة، وهكذا ما يكون من توابع القضاء، كأخذ المدّعى به من المحكوم عليه، وحبس الغريم المماطل والتصرّف في بعض الاُمور الحسبيّة، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك»(1) .
وقال المحقّق العراقي : «ويجوز التصرّف المزبور بشرط المصلحة من الحاكم وأمينه عند عدم الأب والجدّ أو من هو بمنزلتهما; نظراً إلى كون مثل هذا الشأن من وظائف قُضاة الجور الثابتة لقضاتنا; لظهور المقبولة المعروفة علاوة عن تحقّق مقدّمات الحسبة في بعض المقامات; للجزم بعدم رضا الشارع بتلف المال، ولابدّية كون حفظه بنظر الرئيس، فيكون للفقيه قدر متيقّن في هذا المقدار ، بل ومع عدمه ربما تنتهي النوبة إلى عدول المؤمنين; للنصّ بعدم البأس مع قيام العدل في مورده»(2) ، وتبعهما في ذلك السيّد المحقّق الخوئي(3) والحكيم(4).
ثمّ لو قلنا بثبوت تصدّي الحاكم من باب الحسبة، فلابدّ من الاقتصار فيها على القدر المتيقّن، ولا يستفاد منها أنّ للفقيه ولايةٌ مطلقةٌ في عصر الغيبة، كالولاية الثابتة للنبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمـّة (عليهم السلام) حتّى يتمكّن من التصرّف في غير مورد الضرورة وعدم مساس الحاجة إلى وقوعها، ولو عبّرنا عنه بالولاية فهي ولاية جزئيّة تثبت في مورد خاصّ; أعني الاُمور الحسبيّة التي لابدّ من تحقّقها في الخارج ، ولذا قال
-
(1) منية الطالب 2 : 232 .
(2) شرح تبصرة المتعلِّمين 5 : 40 .
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 423 .
(4) مستمسك العروة الوثقى 1 : 106 .
المحقّق العراقي: «ولكنّ المقدار الثابت في ذلك هي التصرّفات المقتضية لحفظ مال اليتيم عن التلف، وإلاّ ففي دلالتها على جواز نقلها لمحض الأنفعيّة إشكال»(1) .
ولاية الحاكم على أموال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة
أ ـ الحنفيّة
إنّهم قالوا : وليّ الصغير في باب الأموال أبوه، ثمّ من بعد موته يكون الوليّ من أوصى به الأب، ثمّ من بعد موت وصيّ الأب يكون الوليّ من أوصى به وصيّ الأب، ثمّ من بعد هؤلاء الثلاثة يكون الوليّ الجدّ لأب وإن علا، ثمّ وصيّ الجدّ، ثمّ وصيّ وصيّ الجدّ، ثمّ الوالي; وهو الذي يليه تقليد القضاة، ثمّ القاضي أو وصيّه الذي يقيمه، فأيّهما يتصرّف تصحّ تصرّفاته(2) .
ب ـ الشافعيّة
قال القفّال : «تثبت الولاية في مال الصغير والمجنون للأب ثمّ الجدّ، فإن عدما فالسلطان»(3) ، وفي المجموع شرح المهذّب : «وللناظر في مال الصبيّ أن يتّجر في ماله; سواء كان الناظر أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو سلطاناً أو أميناً من قبل الحاكم»(4) .
وجاء في المهذّب للشيرازي : «وينظر في ماله الأب ثمّ الجدّ . . . وإن لم يكن وصيٌّ نظر السلطان; لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فَثَبَتَتْ للسلطان»(5) .
-
(1) شرح تبصرة المتعلّمين 5: 40.
(2) حاشية ردّ المحتار 6: 174 مع اختلاف يسير، الفقه على المذاهب الأربعة 2: 354 ، تبيين الحقائق 5 : 220.
(3) حلية العلماء 4 : 525 .
(4) المجموع شرح المهذّب 14 : 124 .
(5) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 328 .
ج ـ المالكيّة
قالوا : وليّ الصبيّ أبوه ثمّ الوصيّ وإن تسلسل، وعند فقدهما فالحاكم; أي يأتي بعد الأب وصيّه وإن تسلسل; بأن أوصى الوصيّ غيره، ثمّ أوصى ذلك آخر وهلمّ جرّاً، ثمّ بعد فقدهما . . . الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي(1) .
د ـ مذهب الحنابلة
فقد جاء في المغني لابن قدامة : «ولا ينظر في مال الصبيّ والمجنون ما داما في الحجر إلاّ الأب أو وصيّه بعده، أو الحاكم عند عدمهما»(2) .
وكذا في شرح الكبير(3) وكشف القناع(4) والإقناع(5) والإنصاف(6) والكافي في فقه أحمد(7) .
-
(1) تبيين المسالك 3 : 525 ، مواهب الجليل والتاج والإكليل 6 : 649 ـ 655 ، حاشية الخرشي 6 : 234 ومابعدها ، الشرح الكبير، المطبوع في حاشية الدسوقي للدردير 3 : 299 ـ 300 والشرح الصغير، المطبوع مع بلغة السالك 3 : 246 .
(2) المغني 4 : 526 .
(3) الشرح الكبير لابن قدامة 4: 518.
(4) كشّاف القناع 3 : 521 .
(5) الإقناع 2 : 223 .
(6) الإنصاف 5 : 323 ـ 324 .
(7) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
المبحث الثاني :
اعتبار المصلحة في تصرّفات الحاكم وأمينه
هل يشترط أن يكون تصرّف الحاكم في مال اليتيم مقروناً بالمصلحة
والغبطة ، أو بالأصلح ، أو يكفي عدم المفسدة فقط ، أو لا يشترط شيءٌ من
ذلك ؟ فيه أقوال :
الأوّل : اعتبار المصلحة فقط .
الثاني : اعتبار الأصلحيّة .
الثالث : عدم اعتبار المصلحة .
اعتبار المصلحة في تصرّفات الحاكم
الظاهر من كلمات الفقهاء، بل الإجماع منهم على أنّ تصرّفات الحاكم في أموال الغيّب والقصّر والمجانين منوطة بالغبطة والمصلحة، ولا يجوز أن تكون على غير وجه النظر والمصلحة ، فضلاً عمّا إذا كان فيه المفسدة والضرر .
قال الشيخ في المبسوط: «من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجدّ، ووصيّ الأب أو الجدّ، والإمام أو من يأمره الإمام ».
ثمّ قال : «فكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلاّ على وجه الاحتياط ، والحظّ للصغير المولّى عليه ; لأنّهم إنّما نصبوا لذلك، فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلاً ; لأنّه خالف ما نصب له»(1) .
- (1) المبسوط للطوسي 2 : 200 .
وكذا في موضع آخر منه(1) ، وبمثل ذلك في النهاية(2)، وبه قال ابن حمزة(3). وفي السرائر : الوليّ نصب لمصالح اليتيم واستيفاء حقوقه . ثمّ قال : لا يجوز له ـ أي للوليّ مثل الأب والجدّ والوصيّ والحاكم ـ التصرّف إلاّ فيما فيه مصلحة لهم(4) .
وبه قال الكيدري(5) ويحيى بن سعيد الحلّي(6). وجاء في التذكرة للعلاّمة : «الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة ، فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ، ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له نصيباً من الربح ، ويستحبّ له ذلك ; سواء كان الوليّ أباً ، أو جدّاً له ، أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكم»(7) .
واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين(8).
وفي المبسوط(9) والشرائع(10) والإرشاد(11) وغيرها(12): أنّه يجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسيئة، أو أقرض ماله إذا كان له فيه الحظّ .
-
(1) نفس المصدر: 162.
(2) النهاية للطوسي : 361 .
(3) الوسيلة: 279 ـ 280.
(4) السرائر 2 : 213 .
(5) إصباح الشيعة : 296 .
(6) الجامع للشرائع : 281 .
(7) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة.
(8) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
(9) المبسوط للطوسي 2 : 200 ـ 201 .
(10) شرائع الإسلام 2 : 78 ـ 79 .
(11) إرشاد الأذهان 1 : 392 .
(12) مختلف الشيعة 5 : 66 و 3 : 134 .
وكذلك يجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا ألجأته الحاجة إلى الاستدانة له مع مراعاة المصلحة في ذلك .
ومثله ما في الدروس(1) واللمعة(2) والروضة(3) والكفاية(4) من أنّه يجوز للولي أخذ الرهن لليتيم إذا باع ماله نسيئةً، أو خاف على المال من غرق أو حرق أو نهب، وكذلك رهن ماله إذا استقرض لليتيم بحسب المصلحة .
والمتحصّل من مجموع كلماتهم وما يقتضيه اُصول المذهب: أنّه يجوز لوليّ الطفل مطلق التصرّفات في مال اليتيم مع كمال الاحتياط بمراعاة المصلحة .
وبه قال جمع من متأخِّري المتأخِّرين(5) وبعض أعلام المعاصرين(6) .
أدلّة هذا الحكم
ويمكن الاستدلال لاعتبار المصلحة في تصرّف الحاكم باُمور :
الأوّل : الآيات ـ :
منها: عموم قوله ـ تعالى ـ : ( وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ )(7) بالتقريب المتقدِّم في أدلّة اعتبار المصلحة في تصرّفات الأب والجدّ
-
(1) الدروس الشرعيّة 3 : 318 .
(2) اللمعة الدمشقيّة : 80 .
(3) الروضة البهيّة 4 : 73 ـ 74 .
(4) كفاية الأحكام : 108 .
(5) شرح تبصرة المتعلّمين 5 : 40 ، عوائد الأيام : 560 ، كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 573 ـ 580 ، منية الطالب 2 : 243 .
(6) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 526 وما بعدها ، مصباح الفقاهة 5 : 79 ومابعدها .
(7) سورة الأنعام 6 : 152; سورة الإسراء 17 : 34 .
فلا نعيده .
ومنها: قوله ـ تعالى ـ : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )(1) .
قال الشيخ في التبيان : «المخالطة مجامعة يتعذّر معها التمييز، كمخالطة الخلّ للماء، والماء للماء وما أشبه ذلك ـ إلى أن قال: ـ ومعنى الآية الإذن لهم فيما كانوا متحرّجين منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحرّوا الإصلاح بالتوفير على الأيتام»(2) .
وفي المجمع : «قال ابن عبّاس لمّا أنزل الله: ( وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ) الآية، و ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) انطلق كلّ من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، واشتدّ ذلك عليهم فسألوا عنه ، فنزلت هذه الآية ، ولابدّ من إضمار في الكلام ; لأنّ السؤال لم يقع عن أشخاص اليتامى ولا ورد الجواب عنها ، فالمعنى يسألونك عن القيام على اليتامى والتصرّف في أموال اليتامى قل يا محمّد ( إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) يعني إصلاح لأموالهم من غير اُجرة، ولا أخذ عوض منهم خير وأعظم أجراً ( وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ) أي تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم باُمورهم . . .
( وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) معناه والله يعلم من كان غرضه من مخالطة اليتامى إفساد مالهم أو إصلاح مالهم»(3) .
وقال الجصّاص في أحكام القرآن بعد قوله ـ تعالى ـ : ( قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ): «فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله ، وجواز التصرّف فيه بالبيع والشراء
-
(1) سورة البقرة 2 : 220 .
(2) تفسير التبيان 2 : 215 .
(3) مجمع البيان 2 : 83 ـ 85 .
إذا كان ذلك صلاحاً ـ إلى أن قال: ـ إنّما عنى بالمضمرين من قوله ( وَيَسْئَلُونَكَ )القُوّام على الأيتام الكافلين لهم»(1) .
وقال بعض آخر : «دلّت هذه الآية على جواز التصرّف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح»(2) .
والحاصل : أنّ الآية تدلّ على جواز التصرّف في أموال الصغار وغيرها ممّا يتعلّق بهم إذا كان على وجه المصلحة .
الثاني : النصوص ـ :
منها : صحيحة ابن رئاب المتقدّمة عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) قال فيها : «إن كان لهم وليٌّ يقوم بأمرهم وباع عليهم ونظر لهم ». الحديث(3) .
لأنّ معنى النظر لهم ملاحظة نفعهم ومصلحتهم ، وكذلك مفهوم الشرط في قوله(عليه السلام) : «لا بأس إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم» يدلّ على ثبوت البأس الذي هو العذاب إذا لم يكن البيع فيما يصلحهم ، ولا فرق بين أن يكون «فيما يصلحهم» متعلّقاً «بباع» و «صنع» أو أن يكون متعلّقاً «بالناظر»; لأنّ المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وإنّما التفاوت بينهما بالسلب والإيجاب، ويكفي في انتفاء الحكم انتفاء أحد القيود المأخوذة في المنطوق . والسرّ في ذلك: أنّ المفهوم تابع للمنطوق موضوعاً ومحمولاً ونسبةً، إلاّ أنّ المنطوق قضيّة موجبة أو سالبة والمفهوم عكس ذلك(4) .
-
(1) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 452 .
(2) شرح تفسير آيات الأحكام لمحمّد علي السايس 1 : 126 .
(3) وسائل الشيعة 13 : 474 الباب 88 من كتاب الوصايا، ح1 .
(4) فوائد الاُصول 2 : 485 .
فلا وجه لما ذكره الفاضل النراقي (رحمه الله) من الإشكال على الاستدلال بالرواية والجواب عنه(1) .
ولقد أجاد الإمام الخميني (رحمه الله) في مقام الاستدلال بالرواية، حيث قال : «ضرورة ظهور عناية واضحة في ذلك بتكراره في قوله(عليه السلام) : باع عليهم ونظر لهم. الظاهر في مراعاة صلاحهم ، وفي قوله(عليه السلام) : القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم. الظاهر في أنّ القيمومة لا تكفي للصحّة والنفوذ ، بل لابدّ منها ومن مراعاة المصلحة ، ويظهر منه أنّ القيّم موظّف بالنظر فيما يصلحهم»(2) .
ثمّ إنّ هذه الصحيحة تشمل من عدا الأب ووصيّه من سائر الأولياء، كالفقيه والقيّم من قبله أو عدول المؤمنين .
ومنها : حسنة عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم; فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا » وقال(عليه السلام) : ( بَلِ الاِْنسَـنُ عَلَى نَفْسِهِى بَصِيرَةٌ )(3). فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله ـ عزّوجلّ ـ : ( وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )(4)»(5) .
والظاهر أنّ السؤال عن جواز الدخول في بيت اليتيم والتصرّف في ماله، فأجاب(عليه السلام) بأنّ المجوّز للدخول والتصرّف في أموالهم هو كونه منفعة لهم، كما لو كان
-
(1) عوائد الأيّام : 561 .
(2) كتاب البيع 2 : 534 .
(3) سورة القيامة 75: 14.
(4) سورة البقرة 2: 220.
(5) وسائل الشيعة 12 : 183 الباب 71 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
في دخوله جلب أنظار المحسنين إلى الأيتام، أو كان معه شخص من أهل الإحسان
يريد جلب نظره إليهم، أو يدخل عليهم الشخص المتشخّص بحيث يوجب ذلك عدم جرأة الناس عليهم، أو دخل داره وأراد إهداء هديّة نافعة لهم عرفاً أو غير ذلك .
والحاصل : أنّ من أراد الدخول في بيت اليتيم والتصرّف في ماله إن كان في دخوله منفعة لليتيم جاز، وإلاّ فلا .
وليست الرواية سؤالاً وجواباً ناظرة إلى عوض التصرّفات فضلاً عن عوض المثل، ولا ناظرة إلى الضمان فيما أتلف أو تصرّف فيه ، بل هي ناظرة إلى المنافع الغالبة المترتّبة على الدخول في بيت اليتيم، ولعلّ ذلك لمراعاة حال الأيتام والكفيل لهم والواردين على الكفيل ; فإنّ في المنع مطلقاً ضيقاً على الكفيل والواردين عليه، وفي التجويز مطلقاً تصرّفاً في مال الأيتام بلا وجه وضرراً عليهم ، فأجاز الشارع الأقدس الدخول في بيتهم بشرط كونه منفعة لهم ، بحيث يقال عرفاً : إنّ دخول فلان كان بنفع اليتيم(1) .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وجه لما ذكره الشيخ الأعظم من «أنّ المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك »(2).
وتبعه في ذلك المحقّق الاصفهاني ، حيث قال « الغرض من الرواية أنّه إن كان لدخولكم وقعودكم وأكلكم ما يصل إلى اليتيم ـ لا أنّه لا يتعقّبه شيء ـ فلا بأس ، وإن لم يتعقّبه شيء كان ضرراً محضاً فلا يجوز، كما أنّه إذا لم يتعقّبه ما يوازيه بل أقلّ
-
(1) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 534 ـ 535 مع تصرّف .
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 577 .
منه كان بالإضافة إلى ما بقي ضرراً »(1) .
وبالجملة: لا وجه لما ذكرهما; لأنّه كما تقدّم آنفاً ليست الرواية في مقام بيان الضمان فيما أتلف أو تصرّف فيه، وأنّه لا تكون المنفعة عوض هذه التصرّفات فضلاً على عوض المثل ، بل الرواية ناظرة إلى المنفعة المترتّبة على الدخول في بيت الأيتام ، وأ نّ قوله(عليه السلام) : «إن كان في دخولكم منفعة عليهم» إنّما هو لمراعاة حال اليتيم وحصول النفع له .
ولا شبهة في أنّ من أتلف من مال اليتيم عشرة دنانير ، ثمّ عقب ذلك بإهداء دينار له لا يقال عند العرف : إنّ في دخوله على اليتيم منفعة له ، وكذا لو عقّبه بمثل ذلك ففي أمثال المقام لابدّ من الرجوع إلى العرف، لا التحليلات العقليّة الموجبة للخروج عن فهم الأخبار .
والحاصل: أنّ عموم الرواية تشمل الفقيه والقيّم من قبله كما هو ظاهر .
توهّم التعارض والجواب عنه
ثمّ إنّه ربما يتوهّم أنّ بين مفهومي صدر الرواية وذيلها تعارضاً ـ كما نقله الشيخ الأعظم عن بعض معاصريه ـ وأنّ الصدر دالّ على إناطة الجواز بالنفع، والذيل دالّ على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرّف غير نافع ولا مضرّ(2) .
فمقتضى مفهوم الجملة الشرطيّة الاُولى: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» أنّه لا يجوز مع عدم المنفعة ولو لم يكن ضرر ، ومقتضى مفهوم الجملة
-
(1) الحاشية على المكاسب للاصفهاني 2 : 430 .
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 577 ـ 578 .
الشرطيّة الثانية: «وإن كان فيه ضرر فلا» أنّه يجوز مع عدم الضرر
وإن لم تكن منفعة .
وأجاب عنه بـ «أنّ المراد من المنفعة ما يوازي عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم ، فيكون المراد بالضرر في الذيل : أن لا يصل إلى الأيتام مايوازي ذلك ، فلا تنافي بين الصدر والذيل»(1) حيث أراد(قدس سره) أن يُدخِل ما لا نفع فيه ولا ضرر في قسم ما يوازي ومشمولاً للمنفعة .
وبهذا فسّر كلام الشيخ (رحمه الله)المحقّق الاصفهاني(قدس سره)، لكنّه قال بعد هذا التفسير : «لاتنافي بين صدر الرواية وذيلها; لكون الشرطيّة في كلّ منهما مسوقةٌ على ما هو الغالب من حصول الضرر أو النفع من دخول بيت اليتيم، لندرة الموازاة والمساواة بين ما يتلف عن مال اليتيم بالأكل وما يؤدّي بإزائه، فحينئذ لا معارضة بينهما»(2) .
واستشكل عليه المحقّق الحائري:
أوّلاً: بأنّه مخالفٌ لما أراده الشيخ الأعظم(قدس سره)، وهو بصدد تفسير كلامه وتوضيح مراده; لأنّه ـ على ما فسّره هو(قدس سره)ـ يلزم أن تكون الرواية ساكتة عن الفرض المزبور، ومراد الشيخ على ما صرّح به أنّه يشمل صدر الرواية لهذا الفرض .
وثانياً: أنّ ما ذكره المحقّق الاصفهاني من كون ندرة فرض الموازاة موجباً لخروجه عن كلتا الشرطيتين ، ففيه; أنّ ندرة الوجود إن صار بمثابة يوجب انصراف لفظ المنفعة إلى غيره ، كان ما ذكره تامّاً ، ولكن من المعلوم عدم كونه كذلك . . ».
-
(1) نفس المصدر، مع تصرّف .
(2) الحاشية على المكاسب للاصفهاني 2 : 430 مع تصرّف .
ثمّ قال : «الحقّ في رفع هذا التعارض أن يُقال : المتفاهم عرفاً من أمثال هذه القضايا أنّ الأصل هو ما ابتدأ به المتكلِّم في صدر الكلام، وما عقّبه في الذكر(الذيل ظ )(1) بمثابة التفريع على الجملة الاُولى مقتصراً على بعض الأفراد لنكتة ، إمّا لكونه أخفى، أو الاهتمام بذكره، أو غير ذلك»(2) انتهى كلامه .
ولقد أجاد فيما أفاد(قدس سره) : فالمستفاد من الرواية أنّ وجود النفع ملاك الجواز، وذكر الضرر في طرف الحرمة لكونه أعلى الأفراد .
وأجاب عنه الإمام الخميني بما يقرب ذلك، حيث قال : «وممّا ذكرناه من أنّ كلامه(عليه السلام) سيق لمراعاة حال الأيتام، يظهر عدم التنافي بين مفهومي الشرطيتين ; فإنّ القرينة في المقام قائمة على أنّ المراد من النفع أمر زائد على ما أتلف على اليتيم زيادة يقال معها عرفاً : إنّ في دخوله منفعة ، فعلى هذا يكون الميزان الشرطيّة الاُولى ومفهومها ، فذكر الثانية بيان مصداق من المفهوم ، ولعلّ ما ذكر جار في غير المقام أيضاً ، فتحمل الشرطيّة الثانية على بيان مصداق من مفهوم الاُولى في جميع الموارد إلاّ في ما دلّ الدليل على خلافه ، ولو لم يسلم في سائر المقامات ففي المقام لابدّ من تسليمه ، لقيام القرينة عليه»(3) .
فرعان
الأوّل : أنّ هذه الإجازة للدخول في بيت الأيتام مختصّة بمثل مورد الرواية من الدخول على من تكفّل الأيتام واختلط بهم، كما ورد في الروايات(4) الواردة
-
(1) جاء في المصدر: «في الذكر» ولكن الظاهر «في الذيل» صحيح .
(2) كتاب البيع للأراكي 2 : 43 ـ 44 .
(3) كتاب البيع 2 : 536 .
(4) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به .
في تفسير قوله ـ تعالى ـ : ( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ )(1) .
فأجاز الشارع الأقدس للكفيل الاختلاط بالأيتام في الأكل والشرب ونحوهما، وأجاز للداخل على الكفيل الاختلاط بهم مع حصول النفع لهم . وأمّا إجازة الدخول لغير هذا المورد فمشكل(2) .
الثاني : لا يصحّ إلحاق التصرّفات الاعتباريّة والمعامليّة بالتصرّفات الخارجيّة الواردة في صحيحة الكاهلي، بدعوى الأولويّة.
بتقريب: أنّه لو جاز التصرّف الذي هو لانتفاع المتصرّف دون اليتيم بمجرّد عدم الضرر والمفسدة، لجاز معه التصرّف الراجع إلى اليتيم بالأولويّة ، حيث إنّه ليس فيه إلاّ تحمّل كلفة اليتيم كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني(3); فإنّه مضافاً إلى أنّ تلك الأولويّات الظنّية على فرضها لا يعتمد عليها في الفقه، دعوى الأولويّة غير تامّة ، وإلحاق المشابه بالمشابه قياس باطل، أشار إلى الفرعين الإمام الخميني (رحمه الله)(4) .
ومنها : رواية عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : ياربّ هذا بذا ، فقال(عليه السلام) : «لا بأس»(5) .
لأنّ الغالب كون التصرّف في الطعام المُهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح ; إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وشبهه ممّا لا يمكن حفظه
-
(1) سورة البقرة 2 : 220 .
(2) وهذاخلاف مايستفاد من إطلاق بعض الروايات السابقة، كحسنة عبدالله بن يحيى الكاهلي،فراجع.مجف.
(3) حاشية المحقّق الاصفهاني على المكاسب 2 : 431 .
(4) كتاب البيع 2 : 536 ـ 537 .
(5) وسائل الشيعة 12 : 184 الباب 71 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
في مدّة طويلة سيّما في مثل ذلك الزمان .
وبالجملة: مورد هذه الرواية أيضاً غير المعاملات والتصرّفات الاعتباريّة .
ومنها : ما روي في الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) أنّه قال : «لأيسر القبيلة ـ وهو فقيهها وعالمها ـ أن يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه حظّاً وصلاحاً ، وليس عليه خسران ولا ربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ، وبالله التوفيق»(1) .
ويشعر بذلك أيضاً ما نقل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «لمّا نزلت ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )(2) أخرج كلّ من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في إخراجهم، فأنزل الله : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )»(3) (4).
وهكذا ما ذكره العياشي في تفسيره عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن قول الله في اليتامى : ( وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) قال : «يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح»(5) .
الأمر الثالث : أنّ الحكمة في جعل الولاية على اليتيم ليس إلاّ جلب
المنفعة للطفل ورعاية مصالحه واستيفاء حقوقه(6) ودفع الضرر عنه، وإلاّ
-
(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 333 .
(2) سورة النساء 4 : 10 .
(3) سورة البقرة 2 : 220 .
(4 ـ 5) وسائل الشيعة 12 : 189 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به ح5، و3 .
(6) السرائر 2 : 213 .
تكون لغواً .
قال الشهيد (رحمه الله) : «هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل ; لأنّه منصوب لها»(1).
وفيه: أنّه أوّل المسألة، ولو سلّم ذلك فلا مجال للنزاع(2) .
الأمر الرابع : دعوى الإجماع من غير واحد ، قال في التذكرة : «الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة .
فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ، ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له نصيباً من الربح . . . ولا نعلم فيه خلافاً إلاّ ما روي عن الحسن البصري كراهة ذلك»(3) .
واستظهر في مفتاح الكرامة منه الإجماع تبعاً لشيخه في الحاشية على القواعد(4)، حيث قال : «وظاهره أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، وأنّه لا فرق في ذلك بين الأب والجدّ، والوصيّ، والحاكم وأمينه»(5) .
وفي موضع آخر : «وهذا الحكم إجماعيّ على الظاهر»(6) .
وقال الشيخ الأعظم في مقام قبول هذا الإجماع : «وليس ببعيد»(7) .
-
(1) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 133 .
(2) جامع الشتات 2 : 456 ، حاشية المكاسب للايرواني : 161 .
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة.
(4) حاشية القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط) الورقة 71 ذيل قول العلاّمة: «مع المصلحة للمولّى عليه ، وفيه: وظاهرهم الإجماع على ذلك» نقلاً عن هامش كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 539.
(5) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
(6) نفس المصدر 4 : 217 .
(7) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 539 .
وحكاه أيضاً المحقّق الاصفهاني(1) والسيّد الخوئي(2) .
الأمر الخامس : الأصل، قال الشهيد (رحمه الله) : «لأصالة بقاء الملك على حاله»(3).
وبه قال في نضد القواعد(4) .
وقال الشيخ الأعظم: «ويدلّ عليه... أصالة عدم الولاية لأحد على أحد»(5).
وفي نهج الفقاهة: «المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً أو صريحاً في كلام غير واحد، اعتبار المصلحة في التصرّف في مال اليتيم وإن كان المتصرّف أباً أو جدّاً، فهل يعتبر ذلك في تصرّف الحاكم أو العدل أو الثقة ، أو يكفي عدم المفسدة ؟ مقتضى الأصل الأوّل»(6) .
وقال المحقّق الحائري(رحمه الله) : وإن قلنا بأنّ الثابت ـ في المقام ـ هو الولاية، فالمرجع ـ عند الشكّ في تحقّق الشرط ـ أصالة عدم الولاية . لا يقال : إنّ هذا الأصل محكوم بإطلاق ( وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ونحوه ـ لأنّا نعلم بأنّ إطلاق ( وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )وشبهه قد قيّد بطيب نفس المالك أو من يقوم مقامه، والشكّ في ولاية هذا المتصدّي عند عدم مراعاة المصلحة ، فاستصحاب عدم ولايته منقّح للموضوع، وهو مقدّم على أصالة العموم أو الإطلاق(7) . وبه قال الإمام الخميني (رحمه الله)(8) .
-
(1) حاشية كتاب المكاسب للاصفهاني 2 : 429 .
(2) مصباح الفقاهة 5 : 75 .
(3) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 33 .
(4) نضد القواعد : 378 .
(5) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 574 .
(6) نهج الفقاهة : 309 .
(7) كتاب البيع للأراكي 2 : 37 .
(8) كتاب البيع 2 : 526 .
نقول : لا شكّ في جريان هذا الأصل، ولكنّه ليس دليلاً لاعتبار المصلحة; لكونه مثبتاً إلاّ أن يقال بخفاء الواسطة .
اعتبار الأصلحيّة في تصرّفات الحاكم
القول الثاني: وجوب مراعاة الأصلحيّة وعدم الاكتفاء بالمصلحة .
قال الشهيد : «هل يتحرّى الأصلح ، أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان : نعم ، لمثل ما قلناه»(1); أي يجب تحرّي الأصلح لمثل ما تقدّم في وجوب مراعاة المصلحة من الوجوه الثلاثة» .
قال المحقّق الاصفهاني في تقريبه : «إنّ ترك الأصلح واختيار ما فيه المصلحة ، ترك رعاية المصلحة الزائدة العائدة إلى اليتيم بلا وجه ، مع أنّه منصوب لرعاية حاله وإصلاح ماله . وأنّه مع الشكّ في نفوذ ما فيه المصلحة مع إمكان لزوم البيع بما هو أصلح، فالأصل عدم نفوذه .
وأنّ اختيار ما فيه المصلحة مع تساويه مع الأصلح في أصل طبيعة المصلحة ليس إلاّ لأجل فقده للزيادة ، والعدم لا يعقل أن يكون غاية للوجودي ، بخلاف اختيار الأصلح; فإنّه معمول للمصلحة الزائدة التي هي أمر وجوديّ»(2) .
وفي جميع هذه الوجوه إشكال ; لأنّ جعل الولاية للحاكم لرعاية
المصلحة في معاملاته الواردة على مال اليتيم أوّل الكلام، فلعلّه منصوبٌ
لحفظ ماله(3) لا لتحصيل المنفعة، كما أشار إليه المحقّق القمّي(4). وتبعه في ذلك
-
(1) القواعد والفوائد 1 : 352 قاعدة 133 ، نضد القواعد : 378 ـ 379 .
(2) الحاشية على المكاسب للاصفهاني 2 : 433 ـ 434 .
(3) هذا الفرض لعلّه خارج عن محلّ الكلام;فإنّه في فرض التصرّف قد وقع النزاع في الاشتراط،فتدبّر.مج ف.
(4) جامع الشتات 2 : 456 .
المحقّق الاصفهاني(1) .
وأمّا أصالة عدم نفوذه; فإنّها مسلّمة، إلاّ أنّها ليست دليلاً على اعتبار الأصلحيّة كما هو ظاهرٌ ; لأنّها بالنسبة إليه مثبتةٌ .
وأمّا عدم وقوع العدميّات غاية للوجودي; فإنّه وإن كان كذلك، إلاّ أنّه لا يجب أن تكون غاية الأمر الوجودي راجعةً إلى المولّى عليه دائماً، فلعلّها تكون راجعةً إلى الوليّ، كسهولة حفظ المال وغيره.
فهذه الوجوه التي ذكرها الشهيد (رحمه الله)لمراعاة الأصلح لا تخلو عن إشكال(2) بل منع ، والقول بوجوب مراعاة الأصلحيّة في تصرّف الوليّ لا دليل عليه أوّلاً .
وثانياً: أنّه ممّا لا يتناهى في بعض الأوقات كما أشار إليه الشهيد (رحمه الله)(3) والمحقّق القمّي(4) ; لأنّ الأصلح لا آخر له ، وكلّ تصرّف يفرض كونه صلاحاً يمكن أن يكون تصرّف آخر أصلح وأحسن منه ، أشار إليه في الجواهر ، حيث قال : «لو قلنا بوجوب مراعاة الأصلحيّة التي لا أصلح منها يقتضي ذلك تعطيل مال الطفل; إذ ما من حسن إلاّ و هناك أحسن منه، وغاية ما يعتبر في تصرّف الوليّ أن يكون مقروناً بالصلاح والحسن بما يعدّه أهل العرف مصلحة لليتيم»(5) .
وقال الشيخ الأعظم (رحمه الله) : «الظاهر أنّ فعل الأصلح في مقابل ترك التصرّف رأساً غير لازم; لعدم الدليل عليه»(6) .
-
(1) حاشية المكاسب، للمحقّق الاصفهاني 2 : 433 .
(2) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 434 مع زيادة وتصرّف .
(3) القواعد والفوائد 1 : 352 .
(4) جامع الشتات 2 : 457 .
(5) جواهر الكلام 25 : 161 مع تصرّف يسير .
(6) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 579 .
مضافاً إلى أنّ حسنة الكاهلي وخبر ابن المغيرة المتقدّمين(1) تدلاّن على عدم لزوم مراعاة الأصلح; لأنّ قوله(عليه السلام) في حسنة الكاهلي : «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» يدلّ بإطلاقه على اعتبار المصلحة والمنفعة، لا على اعتبار الأنفعيّة والأصلحيّة .
وكذلك قوله(عليه السلام) : «لا بأس» في خبر ابن المغيرة، فترك الاستفصال عن زيادة العوض يدلّ على عدم اعتبارها، فمقتضى إطلاق الخبرين عدم لزوم مراعاة الأصلح، وكذا صحيحة منصور بن حازم(2); فإنّ مقتضاها جواز استقراض الوليّ من مال اليتيم بلا اعتبار الأصلحيّة، ومثلها معتبرة البزنطي(3)... وكذا روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم تشترط فيها الأصلحيّة(4) .
ومع ذلك كلّه قال الشهيد(قدس سره) : «لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح»(5). وبه قال أيضاً المحقّق الحائري(6) والسيّد الحكيم(7) .
وقال الشيخ الأعظم : «إذا دار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه»(8) .
واستشكله أيضاً في الجواهر، حيث قال : «إنّ في الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسّر الفرد الأعلى مطلقاً إشكالاً، إن لم يكن منعاً»(9) .
-
(1) في ص364 و 369.
(2) وسائل الشيعة 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، ح1.
(3) نفس المصدر، ح2 .
(4) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به .
(5) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 133 .
(6) كتاب البيع للأراكي 2 : 40 .
(7) نهج الفقاهة : 312 ـ 313 .
(8) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 580 .
(9) جواهر الكلام 25 : 161 .
نقول : وما قالوا وجيه; لأنّ الاحتياط حسن في كلّ حال، إلاّ أنّه لا دليل عليه وجوباً كما أثبتناه .
عدم اعتبار المصلحة في تصرّفات الحاكم
القول الثالث : أنّه لا يجب على الحاكم رعاية المصلحة في تصرّفاته في أموال الصغار، وهكذا رعاية الأصلحيّة، بل يكتفى بمجرّد عدم المفسدة .
جاء في مصباح الفقاهة : «ربما قيل: إنّ المناط عدم الضرر فقط وإن لم يكن فيه نفعٌ»(1) .
وقال الشيخ الأعظم : «نعم، ربما يظهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو الضرر، لا أنّ مناط الجواز هو النفع»(2) .
وتردّد فيه في الجواهر في باب التجارة، حيث قال : «بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم وأمينه ; لأنّ التحقيق عمومها في كلّ ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره; إذ هو وليّ من لا وليّ له ، ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرّفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها»(3) .
ولكنّه(قدس سره) اختار في غيره اعتبار المصلحة .
أدلّة هذا القول
ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بروايات :
منها : حسنة الكاهلي المتقدّمة(4) ; واستظهر منها الشيخ الأعظم(قدس سره) «أنّ المراد
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 79 .
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 577 .
(3) جواهر الكلام 22 : 334 .
(4) في ص264.
من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرّفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك»(1) . وتقدّم ما فيه من الإشكال ولا نعيده .
ومنها : رواية علي بن المغيرة المتقدّمة(2) ; فإنّ فيها : فأقول: ياربّ هذا بذا فقال(عليه السلام) : «لا بأس» . وقد ظهر جوابها أيضاً ممّا تقدّم .
وأيضاً أنّ الغالب كون التصرّف في الطعام المُهدى إلى اليتيمة وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح; إذ الظاهر من الطعام المُهدى إليها هو المطبوخ وشبهه .
وربما يتوهّم أنّ روايات باب جواز الاختلاط(3) بأموال الأيتام تدلّ على عدم اعتبار المصلحة ، بل يكتفى بمجرّد عدم المفسدة; لأنّ المراد بالمصلح عدم المفسد ، لكنّه توهّم غير وجيه ; لأنّ نفس كون الأيتام في بيوت من يكفلهم ـ مختلطين بهم غير ممتازين في المأكل والمشرب عنهم وعن أطفالهم بحيث لا يمسُّوا ألم اليُتم ـ مصلحة، بل مصالح كثيرة ربما تترجّح على المصالح المادّية، فإجازة الاختلاط والأكل في مأدبة واحدة كالإخوان والآباء والأولاد إجازة لأمر ذي مصلحة ومنفعة ، فلا وجه لتوهّم أنّ هذه الأخبار تدلّ على عدم اعتبار المصلحة والمنفعة، كما أشار إليه الإمام الخميني(قدس سره) (4).
اعتبار المصلحة في ولاية الحاكم عند فقهاء أهل السنّة
اتّفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنّه يشترط أن يكون تصرّف الحاكم
-
(1) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 577 .
(2) في ص269.
(3) وسائل الشيعة 12 : 188، الباب 73 من أبواب ما يكتسب به .
(4) كتاب البيع 2 : 537 ـ 538 .
في مال اليتيم مقروناً بالمصلحة والاحتياط ، فنذكر شطراً من كلماتهم :
أ ـ الشافعيّة
قال في المهذّب : «ولا يتصرّف الناظر في ماله إلاّ على النظر والاحتياط، ولا يتصرّف إلاّ فيما فيه حظّ واغتباط ، فأمّا ما لا حظّ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه; لقوله ـ تعالى ـ : ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(1) ، ولقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : لا ضرر ولا ضرار(2). وفي هذه التصرّفات إضرار بالصبيّ، فوجب أن لا يملكه ، ويجوز أن يتّجر في ماله; لما روي . . . أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من ولي يتيماً له مال فليتّجر له بماله ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة»(3) (4).
وجاء في شرحه : «فالناظر هو الحافظ، والنظر هو الحفظ، وهو مأخوذ من النظر الذي هو التأمّل والتفكّر في أمر التدبير، أو من الشفقة . . .»(5) .
ب ـ المالكيّة
قال في عقد الجواهر الثمينة : «ولا يتصرّف الوليّ إلاّ على ما يقتضيه حسن النظر»(6) .
وكذا في المدوّنة الكبرى(7) .
ج ـ الحنابلة
فقد جاء في الكافي في فقه أحمد : «وليس لوليّه التصرّف في ماله بما لا حظّ له
-
(1) سورة الأنعام 6 : 152 ; سورة الإسراء 17 : 24 .
(2) تقدّم في ص218.
(3) سنن الدارقطني 2: 95 ح1951، سنن الترمذي 3 : 32 ح640 .
(4) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 328 .
(5) المجموع شرح المهذّب 14 : 123 .
(6) عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 .
(7) المدوّنة الكبرى 5 : 283 .
فيه، كالعتق والهبة والتبرّعات»(1) .
ثمّ استدلّ بالآية والرواية المتقدِّمتان اللّتان استدلّ بهما في المهذّب .
وفي الإنصاف : «ولا يجوز لوليّهما ـ أي وليّ الصبيّ والمجنون ـ أن يتصرّف في مالهما إلاّ على وجه الحظّ لهما»(2) .
د ـ الحنفيّة
إنّهم قالوا أيضاً باشتراط رعاية المصلحة في تصرّفات الولي، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً، كما جاء في بعض كتبهم(3) .
-
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
(2) الإنصاف 5 : 325 .
(3) بدائع الصنائع 4 : 351 ، ردّ المحتار 6 : 177 ، الشرح الكبير لابن قدامة 4 : 519 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 357 وما بعده .
المبحث الثالث : ولاية القضاة
تمهيد
بحثنا في ما سبق عن ولاية الحاكم من حيث إنّه فقيهٌ جامع للشرائط الذي له شؤون مختلفة، ومن جملتها الولاية على أموال الغيّب والقصّر والمجانين ، والآن نبحث عن ولاية القضاة من جهة أنّهم منصوبون من قبل الحاكم ، ويمكن فرضهم فقهاء أيضاً مع كونهم واجدين لبعض الشرائط لا الكلّ، مثل أن يكونوا مجتهدين في باب القضاء فقط، أو لا يكونوا أعلم على نحو الإطلاق الذي هو شرط للمرجعيّة في الفتوى .
على هذا تتفاوت الولاية فيهما وإن كان دليل إثباتهما واحداً، وكذا شرائطهما، ولأجل هذا عنون الفقهاء مبحث الولاية هذا في بابين : في باب ولاية الفقيه، وباب القضاء معاً، ونحن نتّبع آثارهم، فنقول :
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ للقاضي أيضاً ولاية على أموال الغيّب والقصّر والسفهاء والمجانين ، وقد صرّح بعضهم بذلك .
قال الشهيد في المسالك : «ومبدؤه ـ أي القضاء ـ الرئاسة العامّة في اُمور الدين والدنيا . . . وله ولايةٌ على كلّ مولّى عليه مع فقد وليّه، ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله . .»(1) .
وبمثل ذلك قال في الرياض(2) والجواهر(3) .
-
(1) مسالك الأفهام 13 : 325 ـ 326 .
(2) رياض المسائل 9 : 233 .
(3) جواهر الكلام 40 : 10 .
ويستفاد ذلك أيضاً من كلماتهم في تعريف القضاء ، فقد عرّفه الشهيد (رحمه الله)في الدروس : «بأنّه ولايةٌ شرعيّةٌ على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام»(1)وقال به أيضاً المحقّق الآشتياني (رحمه الله)(2) .
ويستفاد هذا أيضاً من كلماتهم في بيان وظائف القاضي ، بتعبير آخر: قد بيّنوا للقاضي شؤوناً مختلفةً ، ومنها: ـ التي لا خلاف فيها ـ الولاية على أموال الغيّب والقصّر و . . .
قال الشيخ في مبحث نظارة القاضي في أمر الأطفال والأوصياء :
«وإنّما قلنا: يقدّم النظر في أمر الأطفال والمجانين ; لأنّ هؤلاء لا يعبّرون عن نفوسهم ولا يمكنهم المطالبة بحقوقهم . . . . وكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقّه أولى . . .»(3) .
وفي الشرائع : «ثمّ يسأل ـ أي القاضي ـ عن الأوصياء على الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية ، إمّا لبلوغ اليتيم، أو لظهور خيانة ، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصيّ عجز .
ثمّ ينظر في اُمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم»(4) .
وفي القواعد : «ثمّ بعد ذلك ينظر ـ القاضي ـ في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين، ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إمّا لبلوغ ورشد، أو ظهور خيانة، أو ضمّ مشارك إن ظهر عجزٌ، ثمّ ينظر في اُمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين . . .»(5) .
-
(1) الدروس الشرعيّة 2: 65.
(2) كتاب القضاء : 2 .
(3) المبسوط للطوسي 8 : 95 .
(4) شرائع الإسلام 4 : 73 .
(5) قواعد الأحكام 3 : 427 .
وهكذا قال أيضاً في إرشاد الأذهان(1) والدروس(2) والمسالك(3) ومجمع الفائدة(4) والجواهر(5) والرياض(6) .
وجاء في كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي :
«قال الفقهاء رضوان الله عليهم: من مسؤوليّة مقام القضاء، القيام بالحكم بين الناس وفصل خصوماتهم ، وتعقيب المجرمين . . . وهكذا النظر في القسمة ونصب القيّم على الأوقاف العامّة والأيتام والقصّر . . .»(7) وشبه هذا في موضع آخر(8) .
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري : «ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الاُمور العامّة، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيّب; لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفاً»(9).
وبه صرّح أيضاً فقهاء العصر(10) . قال في تحرير الوسيلة: « لو رَفَعَ الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى، وإلاّ فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلا في الدعوى أو تكفّل بنفسه »(11)وبه قال في تفصيل الشريعة(12) .
-
(1) إرشاد الأذهان 2 : 139 .
(2) الدروس الشرعيّة 2 : 71 .
(3) مسالك الافهام 13 : 370 ـ 371 .
(4) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 36 ـ 37 .
(5) جواهر الكلام 40 : 75 .
(6) رياض المسائل 9 : 254 .
(7 ـ 8) كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي : 240 و 18 .
(9) القضاء والشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22 : 49 .
(10) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد 1 : 420 ، كتاب القضاء للسيّد الگلبايگاني 1 : 148 .
(11) تحرير الوسيلة 2 : 390 في شروط سماع الدعوى مسألة 1 .
(12) تفصيل الشريعة، القضاء والشهادات : 79 .
فالمتحصّل ممّا ذكرنا من كلماتهم بطوله أنّه لا خلاف بينهم على أنّ من شؤون
القضاء للقاضي الولاية على أموال القصّر والأيتام الذين لم يجعل الأب أو الجدّ لهم وصيّاً ، أو جعلا ومات، أو ثبت عدم توثيقه وائتمانه في حفظ الأموال ، فإذا كان كذلك جاز للقاضي التصرّف في أموال الأيتام بالحفظ والبيع والشراء والإجارة والرهن، وغير ذلك ممّا فيه حظٌّ للأيتام ومصلحةٌ لهم ولأموالهم ، بالمباشرة أو بالتوكيل .
أدلّة ولاية القضاة على أموال الصغار
تدلّ على هذه الولاية اُمورٌ ، وقبل بيانها نذكر مقدّمة، فنقول :
لا شكّ في أنّ القضاء من مناصب النبيّ وأوصيائه (عليهم السلام)(1) ، ويشترط في جوازه عن غيرهم إذنهم في ذلك صريحاً أو بالعموم ، وهذا حكمٌ مسلّمٌ إجماعيّ، بل هو من ضروريّات الفقه .
قال الشيخ في النهاية : «وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين، فلايجوز أيضاً إلاّ لمن أذِن له سلطان الحقّ في ذلك ، وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم . . .»(2) .
وفي الشرائع : «يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام(عليه السلام) أو من فوّض إليه الإمام»(3). وكذا في المسالك(4)، وصرّح في الرياض بأنّه لا يجوز لأحد التصرّف فيه إلاّ بإذنه ـ أي الإمام ـ قطعاً(5) .
-
(1) كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني : 3 .
(2) النهاية : 301 .
(3) شرائع الإسلام 4 : 68 .
(4) مسالك الأفهام 13 : 331 .
(5) رياض المسائل 9 : 244 .
وقال المحقّق الأردبيلي في المقام : «أمّا اشتراط إذن الإمام، أو إذن من نصبه مع إمكانه، فكأنّه إجماعيّ»(1) .
والظاهر أنّ مستنده مثل رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «اتّقوا الحكومة ; فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ (كنبيٍّ خ ل) أو وصيّ نبيٍّ»(2) .
وكذا في الجواهر، وأضاف بأنّه «لا خلاف عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه»(3) . وبه قال الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب القضاء(4) والشيخ ضياء الدِّين العراقي(5) والسيّد الگلبايگاني(6) . وكذا في تحرير الوسيلة(7) وشرحها(8) .
وبعد هذا نقول : إذا كانت ولاية الحاكم والقاضي على القضاء مشروطة بإذن الإمام(عليه السلام) أو من نصبه، ففي زمان الحضور مؤدّى الولاية وتوسعتها أو تضييقها تابعةٌ لإذنهم (عليهم السلام) صريحاً وبنحو خاصّ ; يعني إن كان الإذن دلّ على جواز تصرّفهم في أموال الأيتام والغيّب و . . . فيتّبع، كما أجاز أمير المؤمنين(عليه السلام) ذلك في عهده إلى مالك الأشتر عليه الرحمة، وإلاّ فلا ، وهذا لا كلام فيه .
وأمّا في زمان الغيبة، فلأجل أنّ الفقهاء الجامعين للشرائط كانوا مأذونين من قِبل الأئمّة (عليهم السلام) للقضاوة بطريق العامّ ، فدائرة ولايتهم ـ ومن جملتها الولاية
-
(1) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 16 .
(2) وسائل الشيعة 18 : 7 الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح3 .
(3) جواهر الكلام 40 : 23 .
(4) كتاب القضاء والشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22 : 45 .
(5) كتاب القضاء : 236 .
(6) كتاب القضاء : 53 .
(7) تحرير الوسيلة 2 : 384 .
(8) تفصيل الشريعة، كتاب القضاء والشهادات : 16 وما بعدها .
على أموال الصغار ـ تابعةٌ لما استفدنا من الإذن العامّ الذي دلّت عليه الروايات الواردة في المقام . وبالجملة: فالمتّبع ما يظهر من دليل النصب، وكذا تدلّ عليها دلائل اُخرى أيضاً نذكرها على الترتيب التالي :
منها: الرواية المتقدّمة التي اشتهرت بمقبولة ابن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟
قال : من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت... وقد أمر الله أن يُكفر به، قال الله ـ تعالى ـ : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )(1) قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً; فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله»(2) .
ومنها : مشهورة أبي خديجة المتقدِّمة أيضاً عن الصادق(عليه السلام) قال : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا خ ل) فاجعلوه بينكم; فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه»(3) .
ودلالتهما على ما كنّا في طريق إثباته ـ أي ولاية القضاة على أموال القصّر والغيّب ـ واضحة لا سترة عليها ، حيث إنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو
-
(1) سورة النساء 4 : 60 .
(2) الكافي 1: 67 باب اختلاف الحديث ح10، وسائل الشيعة 18 : 98 الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح1 . إلاّ أنّه جاء فيه وما أمر الله أن يكفر به.
(3) نفس المصدر 18 : 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5 .
المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة : جعلت فلاناً حاكماً عليكم ، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيّاً أو كُليّاً، ومنها جواز التصرّف في أموال الصغار، ويؤيّده العدول عن لفظ الحَكَم إلى الحاكم مع أنّ الأنسب بالسياق حيث قال «فليرضوا به حكماً» أن يقول: فإنّي قد جعلته عليكم حكماً .
وكذا المتبادر من لفظ القاضي عرفاً من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة ، كما هو معلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمـّة عليهم السلام من قضاة الجور(1) .
بتعبير آخر حيث إنّ عمل القاضي في تلك الأعصار لم يكن منحصراً في القضاء وفصل الخصومات فقط ، بل كان هو المرجع أيضاً في الاُمور الحسبيّة التي لا مناص عن إجرائها ، التي منها حفظ أموال اليتامى والتصرّف فيها على نحو المصلحة ، ولا يجوز إهمالها وليس لها مسؤول خاصّ، وكذلك المتعارف في أعصارنا أيضاً كما تراه ، فيستكشف من إرجاع الإمام(عليه السلام) الشيعة إلى القضاة المنصوبين من قبلهم أو من قبل من نصبهم، ثبوت ولايتهم فيها ، بل يجب عليهم القيام بتلك الاُمور ; لأنّه بعد أن سدّ الإمام(عليه السلام) باب الرجوع إلى أبواب حكّام الجور وقضاتهم والأخذ منهم بنحو شديد أكيد مع عموم الابتلاء، فهل يتصوّر أن يُهمل هذه الجهة بالنسبة إلى الشيعة ويذرهم حيارى؟ هذا لا يتفوّه به عاقل، وهو أدلّ دليل على إثبات ولاية القضاة في تلك الاُمور ، وهو المطلوب .
جاء في كتاب القضاء للشيخ ضياء الدِّين العراقي(قدس سره) :
«قال الفقهاء رضوان الله عليهم: من مسؤوليّة مقام القضاء القيام بالحكم بين
- (1) القضاء والشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22 : 48 ـ 49 مع تصرّف يسير .
الناس ـ إلى أن قال : ـ ونصب القيّم على الأوقاف العامّة والأيتام والقصّر . . . وما شاكل من الاُمور العامّة ، كلّ ذلك بدليل قيام القضاة بها أيّام حكومة الجور، قياماً كان من شأنهم القيام بها حسب أنظار المتشرّعة من المسلمين ، وحيث نهينا عن مراجعتهم في هذه الشؤون; لأنّه رجوع إلى الطاغوت ، واُمرنا بالرجوع فيها إلى فقهائنا الأبرار، كان اللاّزم بدلالة الالتزام هو الرجوع إليهم في كافّة الشؤون المذكورة، وبالتالي فلقضاة العدل تولّي هذه الشؤون جميعاً»(1) .
ومنها : صحيحة ابن بزيع(2) المتقدّمة أيضاً ، بالتقريب الذي استفدنا من المقبولة والمشهورة ، وحاصله: أنّ النهي عن مراجعة أولئك في هذه الشؤون يستدعي جواز الرجوع فيها جميعاً إلى قضاة العدل ، فهي وظيفتهم ويجب عليهم القيام بها .
ومنها : خبر إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا(عليه السلام) عن الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبار، أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولاّه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطيب الشراء منه، أم لا؟
فقال : «إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك»(3) .
يظهر من هذا الخبر أنّ التصدّي لاُمور الصغار في تلك الأعصار كان من شؤون القضاة، ويدلّ على ولايتهم أيضاً إن كان المراد بقوله(عليه السلام): «وقام عدل» هو العدل من القضاة ، وأمّا إن كان المقصود منه مطلق العدل، فيدلّ عليها أيضاً بالأولويّة .
-
(1) شرح تبصرة المتعلِّمين ، كتاب القضاء : 240 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2 .
(3) وسائل الشيعة 12 : 269 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1 .
وتدلّ عليها أيضاً أدلّة الحسبة التي ذكرناها دليلاً على ولاية الحاكم بالتقريب المتقدّم .
ولاية القضاة على أموال الأيتام عند فقهاء أهل السنّة
اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّه إذا لم يكن للصغير وليّ من الأب والجدّ والوصيّ لهما، كان للقضاة المنصوبين من قِبل الحاكم ولايةٌ على أموال القصّر والغيّب والمجانين والسفهاء، فنذكر شطراً من كلماتهم :
أ ـ الحنابلة
قال الماوردي في الأحكام السلطانيّة : «ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامّة مطلقة التصرّف في جميع ما تضمّنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام . . . . الثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرّف بجنون أو صِغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظاً للأموال على مستحقّيها». وبه قال القاضي أبو يعلى أيضاً(1) . وكذا في غيره(2) .
ب ـ المالكيّة
فقد جاء في تبيين المسالك: «ثمّ بعد فقدهما ـ أي فقد الأب والوصيّ ـ يأتي الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي»(3) .
ج ـ الشافعيّة
جاء في المنهاج : «وليّ الصبيّ أبوه ثمّ جدّه، ثمّ وصيّهما، ثمّ القاضي»(4) .
-
(1) الأحكام السلطانيّة للقاضي أبي يعلى 1 : 70 ، وللماوردي 2 : 66 .
(2) الإنصاف 5 : 323 ـ 324 ، كشف القناع 3 : 521 ، الإقناع 2 : 223 .
(3) تبيين المسالك 3 : 525 نقلاً عن الشرح الصغير.
(4) منهاج الطالبين 2 : 126 .
وأضاف في شرحه الخطيب الشربيني: «أو أمينه(1) لخبر، السلطان وليّ مَن لا وليّ له»(2).
ومثل هذا في نهاية المحتاج(3) وأسنى المطالب(4) والمجموع شرح المهذّب(5)وغيرها(6) .
د ـ الحنفيّة
قالوا : أولى الأولياء بالولاية الماليّة على الصغار الأب، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ الجدّ الصحيح ـ أبو الأب ـ وإن علا، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ القاضي، ثمّ من نصبه القاضي وهو وصيّ القاضي»(7). وقريب من هذا في حاشية ردّ المحتار(8) وأحكام الصغار(9) والبحر الرائق(10) وغيرها(11) .
تذكرةٌ
يشترط في نفوذ تصرّفات القاضي في أموال الغيّب والقصّر رعاية
الاحتياط، وأن يكون التصرّف مصلحةً لهم ، فلا يجوز لهم الإقدام على أمر
-
(1) مغني المحتاج 2 : 173 .
(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 54 ح2260، سنن أبي داود 2: 392 ذ ح 2083، سنن الترمذي 3: 408 ذح 1103.
(3) نهاية المحتاج 4 : 374 .
(4) أسنى المطالب 2 : 211 و 214 .
(5) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 .
(6) الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 356 .
(7) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 10 : 317 .
(8) حاشية ردّ المحتار 6: 174.
(9) أحكام الصغار : 42 ـ 43 و192 .
(10) تكملة البحر الرائق 8 : 143 .
(11) بدائع الصنائع 4 : 349 و 353 .
يكون ضرراً عليهم أو مفسدةً لهم، أو لم يكن فيه لهم مصلحة ، ويدلّ على لزومها ما ذكرنا في البحث عن اشتراط تصرّفات الحاكم بها أيضاً، فلا نعيده حفظاً للاختصار .
المبحث الرابع : ولاية عدول المؤمنين
هل يكون لعدول المؤمنين ولاية على أموال الصغار أم لا؟ فيه أقوال :
الأوّل : ثبوت الولاية لهم .
الثاني : عدم ثبوتها .
الثالث : التردّد فيها .
المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ثبوت ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام عند فقد الأولياء من الأب والجدّ والوصيّ لهما، والحاكم وأمينه ، وإن اختلفت تعبيراتهم في من له هذه الولاية ، فعبّر بعضهم بالمؤمنين على نحو الإطلاق .
قال الشيخ في النهاية : «فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل فيه الأمانة ويؤدّيها من غير إضرار بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحاً ماضياً»(1) .
وبمثل ذلك قال العلاّمة في المختلف(2) . والقاضي ابن البرّاج في المهذّب(3)والشيخ الأعظم في المكاسب(4) . وهو الظاهر أيضاً من كلام الشهيد في القواعد(5) .
وبعض آخر عبّر بالمؤمنين الثقات : قال في الشرائع : «وكذا لو مات إنسان
-
(1) النهاية : 608 .
(2) مختلف الشيعة 6 : 357 ـ 359 .
(3) المهذّب 2 : 118 .
(4) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 561 .
(5) القواعد والفوائد 1 : 406 قاعدة 148 .
ولا وصيّ له، كان للحاكم النظر في تركته، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاّه
من المؤمنين من يوثق به»(1) . وهكذا في المسالك(2) ومجمع الفائدة(3) والجواهر(4) .
وعبّر ثالث بصلحاء المؤمنين :
كما قال في الجامع للشرائع : «فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاّهم الحاكم ، فإن تعذّر فبعض صلحاء المؤمنين»(5) .
وعبّر رابعٌ بالعدول من المؤمنين :
كما قال في الدروس : «ولو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرّف بما فيه صلاح; لأنّه من باب التعاون على البرّ والتقوى، ولشمول ولاية الإيمان»(6) وكذا في جامع الشتات(7) وبلغة الفقيه(8) والرياض(9) وجامع المقاصد(10) والبيع للإمام الخميني(11) ومصباح الفقاهة(12) وتفصيل الشريعة (13).
وعبّر خامس بالعدل الموثّق :
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(2) مسالك الأفهام 6 : 265 .
(3) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
(4) جواهر الكلام 28 : 427 .
(5) الجامع للشرائع : 492 .
(6) الدروس الشرعيّة 2 : 329 .
(7) جامع الشتات 4 : 234 .
(8) بلغة الفقيه 3 : 290 .
(9) رياض المسائل 6 : 293 .
(10) جامع المقاصد 11 : 266 .
(11) البيع 2 : 501 .
(12) مصباح الفقاهة 5 : 62 .
(13) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 299.
كما في الحدائق; فإنّه عبّر في أوّل كلامه في بيان طرح المسألة بالعدول من المؤمنين، ولكن بعد ذكر أخبار الباب والاستدلال بها على مختاره قال : «وبالجملة فإنّ الروايات المذكورة ظاهرةٌ في جواز قيام العدل الثقة بذلك، وأنّه بهذه الأخبار مأذون في الدخول; سواء وجد الإمام أم لا ، ولا يبعد القول بجواز تولية ذلك أيضاً مع وجود الفقيه الجامع للشرائط وإن كان ظاهر الأصحاب خلاف ذلك»(1) .
وسادس عبّر بالموثّق فقط :
كما هو المستفاد من كلام المحقّق الاصفهاني في حاشيته(2) على مكاسب الشيخ الأعظم (رحمه الله)، والمحقّق الخوانساري في جامع المدارك(3) .
وحيث إنّه لا تفاوت بين العادل الموثّق والمؤمن العادل; لأجل أنّ غير المؤمن فاسق(4) قطعاً، فمن عبّر في المقام بالعدل الثقة مقصوده هو المؤمن العادل، وكذا المقصود من صلحاء المؤمنين هم العدول من المؤمنين ; لأنّ الفاسق ليس بعادل .
وليس مقصود من عبّر بالمؤمنين صرف من كان على اعتقاد حقٍّ وإن كان غير موثّق في عمله وقوله ، وظهر منه الفسق ، بل المقصود من المؤمنين هم العدول والثقات قطعاً وإن لم يذكر في بعض الكلمات صفة العدالة أو الثقة .
وبما أنّ العدل كان أخصّ مفهوماً من الثقة كما يستفاد من كلام بعضهم(5) .
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 589 و 592 .
(2) حاشية كتاب المكاسب 2 : 408 .
(3) جامع المدارك 4 : 92 .
(4) هذا الأمر وإن كان صحيحاً بحسب الكبرى الكليّة، إلاّ أنّ انطباقها على المقام غير معلوم، فبملاحظة الأدلّة السابقة وأيضاً الحكمة الموجودة في تولّي اُمور الأيتام، لا يبعد أن يقال: إنّه لا فرق بين المؤمن بحسب اصطلاحنا وغير المؤمن، وعلى هذا لا يصحّ أن يقال إنّ غير المؤمن فاسق قطعاً، وإلاّ فلا معنى لقيام الفسّاق من المؤمنين مقام العدول، فتدبّر. م ج ف.
(5) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 234 .
فيمكن أن نلخّص كلماتهم في المقام في قولين :
1 ـ ولاية المؤمنين العدول .
2 ـ ولاية المؤمنين الثقات .
وقبل بيان أدلّة إثبات ولاية المؤمن العادل في المقام يلزم أن نذكر أمرين :
الأوّل : أنّه يستثنى من موضع الخلاف ما كان ضروريّاً من اُمور الطفل من الأكل والشرب والألبسة وحفظه من التلف، وهكذا حفظ أمواله إن كانت في معرض التلف ; فإنّه يجب كفاية على كلّ مسلم فضلاً على المؤمن العادل .
قال في المسالك : «ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطرّ إليه الأطفال والدوابّ من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف; فإنّ ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين، فضلاً عن العدول منهم ، حتّى لو فرض عدم ترك مورثّهم مالاً فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجزين عن التكسّب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية ، كإعانة كلّ محتاج وإطعام كلّ جائع يضطرّ إليه ، فمن مال المحتاج أولى . وحيث يجوز لأحد فعل ذلك فالمراد به معناه الأعمّ ، والمراد منه الوجوب; لما ذكرناه من أنّه من فروض الكفايات»(1).
وهكذا في جامع المقاصد(2) والحدائق(3) والجواهر(4) .
الثاني : المقصود في كلماتهم بثبوت الولاية للمؤمن العادل إن لم يكن هناك حاكم ، عدم وجوده في البلد الذي سكن فيه الصغير وفي ناحيته وإن وجد في غيره، إذا توقّفت مراجعته على مشقّة لا تتحمّل عادةً ، ويجب مع وجوده بعيداً الاقتصار
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 266 .
(2) جامع المقاصد 11 : 267 .
(3) الحدائق الناضرة 22: 593.
(4) جواهر الكلام 28 : 429 .
على ما لا بدّ منه، وتأخير ما يسع تأخيره إلى أن يمكن مراجعته، كما أشار إليه
في المسالك(1) .
أدلّة هذا الحكم
تدلّ على ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام اُمورٌ :
الأوّل : الآيات ، كقوله ـ تعالى ـ : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض )(2) ، فإنّ عمومها يشمل المورد . وقوله : ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى )(3) . وقوله : ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل )(4)، كما استدلّ بها الشهيد في الدروس(5)والعلاّمة في المختلف(6). وكذا في جامع المقاصد(7) والرياض(8).
ولقد أجاد المحقّق الاصفهاني في الإيراد على الاستدلال بها، حيث قال : «لوكان كذلك فلا موجب لاختصاصه بالفقيه مع تيسّر التصدّي منه; لأنّ المفروض أنّه معروف وإعانة على البرّ والتقوى، وإحسان على أيّ تقدير، وإذا احتمل اختصاصه بالفقيه فلا يقع معروفاً ولا إعانةً على البرّ والتقوى، ولا إحساناً إلاّ إذا صدر من الفقيه، ففي صورة الشكّ تكون الشبهة مصداقيّة، ولا مجال للاستدلال بالعامّ معها»(9) .
-
(1) مسالك الأفهام 6 : 266 .
(2) سورة التوبة 9 : 71 .
(3) سورة المائدة 6 : 2 .
(4) سورة التوبة 9 : 91 .
(5) الدروس الشرعيّة 2: 329.
(6) مختلف الشيعة 6 : 359 .
(7) جامع المقاصد 11 : 266 .
(8) رياض المسائل 6 : 293 .
(9) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 401 .
الثاني : الضرورة تقتضي ذلك(1) .
الثالث : حكم العقل بذلك، كما في حفظ مال اليتيم من التلف(2) .
قال المحقّق النائيني : «فمع وجود العدل لا شبهة أنّ المتيقّن نفوذ خصوص مايقوم به . نعم ، مع تعذّره يقوم الفسّاق من المؤمنين بعد عدم احتمال تعطيله ; لكونه ضروريّاً، وممّا يستقلّ العقل بلزوم وجوده»(3) .
ولا يخفى أنّ الأخيرين يختصّان بحال الضرورة فقط، فلا تثبت في غيرها .
الرابع : جريان السيرة العقلائيّة بضميمة عدم ردع الشارع عنها(4) .
ولا يخفى أنّ هذا دليل لبيّ، والقدر المتيقّن منها ما كان في مورد الضرورة، فلا تثبت في غيرها أيضاً .
الخامس : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض بقوله : «بل لعلّها إجماع في الحقيقة»(5) .
والظاهر أنّ هذا الإجماع مدركيّ ولا يكون دليلاً مستقلاًّ .
السادس : الأصل الثابت من بعض الأخبار، بالتقريب الذي ذكرناه في الاستدلال به على ولاية الفقيه فراجع ، إلاّ أنّه يلزم في المقام فرض عدم وجود الفقيه; لأنّه في حال كونه موجوداً فهو القدر المتيقّن . وأمّا في حال عدم الفقيه، فيكون العادل أو الثقة هو المنصوب للقيام باُمور الأيتام .
السابع: ـ وهو العمدة ـ النصوص
-
(1) مختلف الشيعة 6 : 359 .
(2) منهاج الفقاهة 4 : 306 .
(3) منية الطالب 2 : 243 .
(4) منهاج الفقاهة 4 : 306 .
(5) رياض المسائل 6 : 293 .
منها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ; لأنّه قال(عليه السلام) فيها: «إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس»(1)بالتقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم، أنّه بناءً على أنّ المراد من المماثلة: إمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة، أو في الفقاهة، أو في العدالة، والاحتمال في الفقاهة مناف لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره، وهذا بخلاف الاحتمالات الاُخر; فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإنْ تعذّر غيرهم، فتعيّن أحدها الدائر بينها، فيجب الأخذ من مخالفة الأصل بالأخصّ منها; وهو العدل(2) .
وقريب من هذا في بلغة الفقيه(3) .
ولكن قلنا فيما تقدّم: إنّ هذا التقريب ليس بتامٍّ، واستدللنا بها على ولاية الحاكم ، فراجع .
ومنها : صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ; فإنّه قال(عليه السلام) فيها : «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم . . .»(4)بناءً على أنّ المراد بالوليّ فيها إنّما هو أحد عدول المؤمنين; لأنّ انتفاء الوصيّ ظاهر من الخبر، وانتفاء الحاكم الشرعي الذي هو أحد الأولياء أيضاً ظاهر; إذ ليس في وقته(عليه السلام) حاكم شرعيّ أصالة سواه، واحتمال الجدّ بعيد من سياق الخبر، كما استدلّ به في الحدائق(5) .
ولكن عدل عن نظره الشريف في كتاب الوصايا، حيث قال : «أمّا صحيحة علي بن رئاب فالوليّ فيها مجمل يجب حمله على ما يدلّ عليه غيرها من الحاكم
-
(1) وسائل الشيعة 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2 .
(2) كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 565 مع تصرّف يسير .
(3) بلغة الفقيه 3 : 291 ـ 292 .
(4) وسائل الشيعة 13 : 474 الباب 88 من كتاب الوصايا، ح1 .
(5) الحدائق الناضرة 18 : 324، كتاب البيع 2: 534.
الشرعي، أو عدول المؤمنين»(1) .
وقال الإمام الخميني (رحمه الله) : «ثمّ إنّها تشمل من عدا الأب خاصّة، أو من عدا الأب ووصيّه من سائر الأولياء، جدّاً كان أو وصيّه القيّم عليهم، أو فقيهاً أو القيّم من قِبَله، أو عدول المؤمنين لو قلنا بولايتهم»(2) .
ولكنّ الإنصاف أنّها لا تدلّ على ولاية عدول المؤمنين; لأنّه ـ كما قلنا في الاستدلال بها على ولاية الحاكم ـ يكون جواز جعل القيمومة والناظر الذي يستفاد من قوله(عليه السلام) : إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر . . . منحصراً بالحاكم(3)، وليس ذلك لعدول المؤمنين، ولا أقلّ نشكّ فيه .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : «إن قام رجلٌ ثقةٌ قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»(4) .
ودلالتها ظاهرةٌ لا سترة عليها ، حيث إنّ الإمام(عليه السلام) رتّب الحكم على جواز تقسيم أموال الصغار الذي يستفاد من قوله(عليه السلام) : «فلا بأس» على قيام الثقة بذلك ، والمعلوم من السياق عدم وجود الجدّ للصغار ، وهكذا لم يكن المقصود من الثقة الحاكم الثقة، بل كان أحد المؤمنين ، وهو المطلوب .
قال الشيخ الأعظم (رحمه الله) : «بناءً على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفاً وإن لم يكن فيه ملكة العدالة»(5) .
-
(1) نفس المصدر: 22 / 592.
(2) كتاب البيع 2 : 534 .
(3) مضافاً إلى أنّ كلمة ولّى ظاهرة في شخص معيّن، مع أنّ الولاية لعدول المؤمنين ليست منحصرة بفرد معيّن. م ج ف.
(4) وسائل الشيعة 13 : 474 الباب 88 من كتاب الوصايا، ح2 .
(5) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 567 .
ولكنّ الظاهر أنّ المراد من الثقة غير ما اصطلح عليه الرجاليون في معنى الوثاقة، بل المقصود من الثقة في الروايات هي التي تكون ملازمة للعدالة ، بل أخصّ منها، إذ ربما يكون العادل غير ثقة في فعله; لعدم التفاته بفعله لبله ونحوه، كما قد ورد في بعض الروايات الدالّة على اعتبار العدالة في إمام الجماعة، بأنّه إذا كان ثقة ترضون دينه، وفي بعض الروايات: أنّ فلاناً ثقة في دينه ودنياه(1) .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري : قال : سألت الرضا(عليه السلام)عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال : «نعم».
وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبار، أيحلّ شراءُ شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : «إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك»(2)فإنّها دلّت على جواز الشراء من أموال الصغار إذا قام عدل في ذلك، ومفهومها عدم الجواز إذا لم يقم به عدل .
قال الإمام الخميني (رحمه الله) : «لا يحتمل في الصحيحة إجازة شخصيّة; لأنّ الظاهر من السؤال والجواب هو التكليف الكلّي ، وأمّا احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير فلا وجه له، لا فيها ولا في غيرها من الروايات ، كما أنّه لا ظهور لها ولا لغيرها إلاّ في أصل الجواز ، لا النصب بالنسبة إلى المال أيضاً لو كان للنصب وجه صحّة بالنسبة إليه .
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 62 مع تصرّف .
(2) وسائل الشيعة 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع، ح1 .
نعم ، يحتمل فيها كغيرها أن يكون الجواز حكماً شرعيّاً، وأن يكون إجازة من الإمام(عليه السلام) ، وقد مرّ أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الإلهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره ، بل هو محتمل ، كما أنّ الإجازة السلطانية أيضاً محتملة(1) .
ثمّ إنّ في قوله(عليه السلام) : «إذا كان الأكابر من ولده معه» إلخ احتمالين :
أحدهما : رجوع ضمير «معه» إلى القاضي الذي تراضوا به ، ويكون المراد أنّ القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به ، فتدلّ على لزوم نظارة العدل في البيع ، أمّا جواز استقلاله لذلك فلا ، إلاّ أن يقال : إنّ القاضي الجائر لا دخالة لفعله في الصحّة ، فهي ناشئة من نظر العدل محضاً ، فتدلّ الرواية التزاماً على الصحّة لو أوقعه بنفسه ، وله وجه لو دلّت على أنّ العدل رضي بذلك ، وهو محلّ تأمّل .
ثانيهما : رجوع الضمير إلى المشتري ، ويكون المراد إلغاء عمل القاضي ، وتوقّف الصحّة في قسمة الأكابر على رضاهم، وفي قسمة الصغير على قيام العدل في البيع ; أي يكون البيع برضا الكبير والعدل ، فتدلّ على أنّ فعل العدل نافذ في حصّة الصغير ، فتتمّ الدلالة ، وهذا أوفق بمناسبة الحكم والموضوع»(2) .
وما قيل: من أنّها تدلّ على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري، والكلام إنّما هو في وظيفة المتصدّي للبيع نفسه(3) .
ففيه : أنّ الظاهر من عنوان «قام عدل في ذلك» اشتراط العدالة فيمن تصدّى للبيع لا من اشترى ، هذا أوّلاً ، وثانياً : على فرض اشتراطها في المشتري ، نقول : جعل العدالة شرطاً للشراء مستلزم لجعلها شرطاً للبيع، وإلاّ فجعل جواز البيع
-
(1) ولا يخفى أنّ لازم هذا الاحتمال، كون ولاية عدول المؤمنين مشروطة بإذن الإمام(عليه السلام) أو من يقوم مقامه مع أنّ ظاهر الفتاوى خلاف ذلك. م ج ف
(2) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 506 ـ 507 .
(3) منهاج الفقاهة 4 : 313 .
للفاسق من غير أن يجوّز لأحد الشراء منه لغو .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه يستفاد من الروايات أنّه جعل الشارع الولاية على أموال الصغار للمؤمنين العدول، كما ذهب إليه المشهور .
قال في الحدائق : «لا يخفى أنّ الظاهر من هذه الأخبار باعتبار ضمّ بعضها إلى بعض، وحمل مطلقها على مقيّدها ومجملها على مفصّلها، هو ما صرّح به الأكثر; فإنّها هو الأقرب منها والأظهر ـ إلى أن قال ـ : وبالجملة: فإنّ الروايات المذكورة ظاهرةٌ في جواز قيام العدل الثقة بذلك، وأنّه بهذه الأخبار مأذون في الدخول»(1) .
وقال السيّد الفقيه الخوانساري : «يستفاد من بعضها جواز التصدّي للعدل وللثقة من بعض آخر ـ إلى أن قال : ـ فاللازم تحقّق أحد الوصفين من العدالة والوثاقة ، والوثاقة إن كان المراد منها الوثاقة في الدين تكون ملازمةً للعدالة»(2) .
وبالجملة : فإنّ النسبة بين الوثاقة والعدالة وإن كانت عموماً من وجه مفهوماً فإمّا أن نقول : إنّ المراد من الوثاقة في الروايات الوثاقة في الدين، فتكون ملازمة للعدل ، أو نقول : العدالة هي الأخصّ من الوثاقة وفي الدوران بين الخاصّ والعامّ ، الخاصّ هو المتيقّن، فتثبت ولاية العادل على كلا الصورتين، وهو المطلوب .
الثامن : دليل الحسبة بالتقريب الذي تقدّم في الاستدلال بها على ولاية الفقيه، ولكن مع فرض عدم الفقيه أيضاً، كما ذكرنا في الاستدلال بالأصل الثابت بالأخبار .
قال المحقّق النائيني (رحمه الله) : «الاُمور التي يعلم من الشرع مطلوبيّتها في جميع الأزمان، ولم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاصّ، فمع وجود الفقيه هو
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 592 .
(2) جامع المدارك 4 : 92 .
المتعيّن للقيام بها : إمّا لثبوت ولايته عليها بالأدلّة العامّة، أو لكونه هو المتيقّن من بين المسلمين، أو لئلاّ يلزم الهرج والمرج، فيعتبر قيام الفقيه به مباشرة أو إذنه أو استنابته ، ومع تعذّره فيقوم به سائر المسلمين ، ولمـّا كان العدل أولى بالحفظ والإصلاح، فمع وجوده هو المتعيّن»(1) .
ومثل ذلك ما قال الإمام الخميني (رحمه الله)(2) .
عدم ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام
القول الثاني : عدم ثبوت ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام .
قال في السرائر ـ بعد نقل كلام الشيخ (رحمه الله) في الخلاف والنهاية ـ : «والذي يقتضيه المذهب أنّه إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك، فالأمر فيه إلى فقهاء شيعته(عليه السلام)من ذوي الرأي والصلاح ; فإنّهم(عليهم السلام) قد ولّوهم هذه الاُمور ، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّي ذلك بحال، فإن تولاّه فإنّه لا يمضي شيء ممّا يفعله ; لأنّه ليس له ذلك بحال»(3) .
والوجه فيه: أنّ إثبات اليد على مال الطفل والتصرّف فيه بالبيع والشراء وغيرهما موقوف على الإذن الشرعي وهو منتف(4) .
وقد ظهر الجواب عنه ممّا ذكرنا في الاستدلال على القول الأوّل ، مع احتمال حمله على ما يوافق قول المشهور; بأن يكون المقصود منه المنع من ولايتهم إذا كان الحاكم الشرعي موجوداً .
-
(1) منية الطالب 2 : 241 .
(2) كتاب البيع 2 : 501 .
(3) السرائر 3 : 193 ـ 194 .
(4) جامع المقاصد 11 : 266 ، مسالك الأفهام 6 : 265 .
قال في الجواهر : «وظنّي أنّه لا يخالف فيه ابن إدريس وإن نفى الولاية عنهم، لكن مراده نفيها على حسب ولاية الأب والجدّ والحاكم لا مطلقاً، وحينئذ يرتفع النزاع»(1) .
وظهر ممّا ذكرنا الجواب عن القول الثالث ، أي الترديد في المسألة ، وهو ما اختاره في الشرائع حيث قال : «وفي هذا تردّد»(2) .
جاء في الرياض : «وخلاف الحلّي كتردّد الماتن في الشرائع شاذّ غير ملتفت إليه، مع احتمال عبارة الأوّل ما يوافق الجماعة بإرادته المنع عن ولايتهم إذا كان هناك حاكم الشريعة»(3) .
يجوز لعدول المؤمنين نصب القيّم للأيتام
بعدما ثبت أنّ لعدول المؤمنين ـ عند فقد الأولياء من الأب والجدّ والوصيّ لهما والحاكم ـ ولاية على أموال الصغار ، وقع البحث في أنّه هل يكون ولايتهم كولاية الآباء والأجداد والحاكم، فيجوز لهم نصب غيرهم وعزلهم أم لم يكن كذلك ، بل المقصود من ولايتهم أنّه يجب عليهم حفظ أموال الصغار وبيعها أو الشراء لهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، والتعبير بالولاية تسامح .
بتعبير آخر : يجب عليهم أو يستحبّ فعل ذلك وهو حكم تكليفي، بخلاف ولاية الحاكم فإنّها مجعولة؟
فيه ، قولان :
ذهب إلى الثاني الإمام الخميني (رحمه الله)، حيث قال : «يحتمل أن يكون المراد
-
(1) جواهر الكلام 28 : 427 .
(2) شرائع الإسلام 2 : 257 .
(3) رياض المسائل 6 : 293 .
من قوله(عليه السلام) : «فصيّر» إلخ ـ في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ الإقامة بأمر
البيع; أي جعله متصدّياً للبيع ، فقوله(عليه السلام) : «لا بأس به» إجازة لمثلهما في البيع ، لا نَصب وَجَعْل ولاية منه حتّى يكون مثلهما وليّاً ـ كالفقيه ـ ليكون له نَصْب غيره وعَزْله ، ولا يكون التصدّي من قبيل الحسبيات حتّى لا يجوز التصدّي إلاّ مع الضرورة .
نعم ، من ترك الاستفصال في المورد يمكن استفادة جواز تصدّي البيع ولو لم يصل إلى حدّ الضرورة ، لكن لا يلزم منه الولاية بالمعنى المذكور ، فغاية الأمر استفادة جواز التصرّف لمثلهما، لا الولاية على الصغير أو على اُموره .
وكذلك الأمر على الشقّ الثاني من السؤال ; وهو قوله : أو قال : يقوم بذلك رجل منّا ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان، لا يستفاد منه أيضاً النصب وجعل الولاية ، بل غاية الأمر دلالته على جواز التصرّف بيعاً وشراءً ونحوهما لمثلهما ولو لم يبلغ حدّ الضرورة»(1) .
وفي مهذّب الأحكام : «هل يكون ما ثبت لعدول المؤمنين بعد فقد الفقيه هو الولاية من سنخ ولاية الفقيه . وبعبارة أُخرى : ما هو الثابت له هو الحكم الوضعي، أو مجرّد الحكم ا لتكليفي من الوجوب والندب؟ الحقّ هو الأخير ; لأنّه المتيقّن من الأدلّة، وغيره يحتاج إلى عناية ، وهي مفقودة .
نعم ، في مثل بيع أموال القصّر ونحو ذلك يلزمها السلطة فعلاً فيصحّ تعبير الولاية من هذه الجهة، فهي تابعة للحكم التكليفي في جملة من الموارد ، ولعلّ تعبير الفقهاء بالولاية من هذه الجهة أيضاً»(2) .
-
(1) كتاب البيع 2 : 503 و 504 .
(2) مهذّب الأحكام 16 : 380 ـ 381 .
ولكنّ الحقّ هو(1) الأوّل ، وهو الظاهر من كلام المشهور أيضاً ; لأنّ
المستفاد من الروايات أنّهم وليّ كالآباء والأجداد والحاكم ويجوز لهم القيام باُمور الصغار . فإنّ الظاهر من قوله(عليه السلام) : «لا بأس بذلك إذا باع، عليهم القيّم
لهم الناظر فيما يصلحهم»(2) في صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة. وكذا ظاهر قوله(عليه السلام) : «إذا كان القيّم به مثلك»(3)في صحيحة ابن بزيع، أنّه يجوز له القيام باُمور الأيتام بنفسه أو بنصب غيره وهو الناظر فيه، وكذا له عزله إذا خالف عمّا هو
الحقّ .
نعم، من قال بأنّه لا يستفاد من الأدلّة ولاية عدول المؤمنين، بل يجب أو يندب لهم الدخول في اُمور الأيتام من باب الحسبة والتعاون والإحسان مباشرةً، فلا يجوز لهم نصب الغير أو عزله .
عدم ثبوت الولاية على أموال الصغار للفسّاق
إذا تعذّر العدول فهل تثبت الولاية لغيرهم من الفسّاق، فيكون واجباً كفائيّاً على كلّ من يقدر عليه وإن كان فاسقاً؟ أم لا .
قال في الجواهر : «لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل»(4) .
وفي بلغة الفقيه : «الظاهر جواز توليته ـ الفاسق ـ مع المصلحة ومراعاة
-
(1) الحقّ ما ذهب إليه السيّد الإمام الخميني(قدس سره); فإنّ التعبير بالقيمومة وحتّى التعبير بالولاية لا تدلّ إلاّ على ثبوت الولاية وهو لا يلازم جواز نصب من يقوم مقامه أو عزله، بل هو تابع لدليل الولاية، وفيما نحن فيه لا يستفاد من الأدلّة ذلك، فتدبّر. م ج ف.
(2) وسائل الشيعة 13: 474 الباب 88 من كتاب الوصايا، ح1.
(3) نفس المصدر 12 : 270 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2 .
(4) جواهر الكلام 28 : 427 .
الغبطة، توصّلاً إلى ما يريد الشارع إيجاده للمصلحة المترتّبة على وجوده، كتجهيز الميّت الواجب كفايةً على كلّ من يتمكّن منه مع عدم وليّ له مطلقاً، حتّى الحاكم وعدول المؤمنين»(1) .
والظاهر أنّه لا يمكن إثبات الولاية للفسّاق وإن تعذّر وجود العدول، وذلك لأجل أنّه ثبت بالأدلّة القطعيّة عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه .
فإذا فرض احتياج ذلك المال إلى التصرّف ولم يكن الإذن من صاحبه، فدار الأمر بين أن يتصرّف كلّ شخص أعمّ من الفاسق والعادل، أو خصوص العادل، أو غيره بإذنه، فالمتيقّن هو الثاني، ومجرّد الشكّ في ذلك يكفي في عدم الجواز وضعاً وتكليفاً، لإطباق الأدلّة على عدم الجواز، والخارج منها قطعاً هي صورة الإذن من العدول، أو تصدّيهم بنفسهم على التصرّف .
نعم ، قد يكون شيء مفروض المطلوبيّة للشارع غير مضاف إلى أحد، فيجب على الفسّاق كالمؤمنين تكليفاً الإقدام بذلك من باب الحسبة .
قال الشيخ الأعظم (رحمه الله) : «نعم، لو فرض المعروف على وجه يستقلّ العقل بحسنه مطلقاً، كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، صحّ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة، أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحد»(2) .
والظاهر أنّ من قال بالولاية للفسّاق فمقصوده في هذا المورد الخاصّ .
قال في الجواهر : «لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل ، وإن كان الظاهر تقييدها بما إذا كان المقام مقام الحسبة لا مطلقاً»(3) .
-
(1) بلغة الفقيه 3 : 294 .
(2) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 563 .
(3) جواهر الكلام 28 : 427 .
آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة
أ ـ الشافعيّة
جاء في نهاية المحتاج : «قال الجرجاني : وإذا لم يوجد أحدٌ من
الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم وتولّي حفظه
لهم ـ إلى أن قال : ـ ويؤخذ من كلام الجرجاني السابق ـ مع ما مرّ ـ أنّه لو لم يوجد إلاّ قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم، وهو متّجهٌ»(1) .
ب ـ المالكيّة
إنّهم قالوا : تثبت هذه الولاية ـ أي الولاية على المال ـ للأب ثمّ لوصيّه ثمّ للقاضي أو من يقيمه ثمّ لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاض(2) .
ج ـ الحنابلة
قال في كشّاف القناع : «فإن لم يوجد حاكم بالصفات المعتبرة فأمين يقوم به، أي باليتيم»(3). وكذا في الإنصاف(4) والإقناع(5) .
د ـ الحنفيّة
بحسب تتبّعنا لم نظفر في كلماتهم من قال بهذه الولاية ، بل الظاهر منهم عدم جعل الولاية في المقام .
قال في البدائع : «فأولى الأولياء الأب، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ الجدّ ثمّ
-
(1) نهاية المحتاج 4 : 374 ـ 375 .
(2) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 750 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 356 .
(3) كشّاف القناع 3 : 521 .
(4) الإنصاف 5 : 324 .
(5) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2 : 223 .
وصيّه، ثمّ القاضي ثمّ من نصبه القاضي; وهو وصيّ القاضي ـ إلى أن قال : ـ وليس لمن سوى هؤلاء من الاُمّ والأخ والعمّ وغيرهم ولاية التصرّف على الصغير في ماله»(1) . وهكذا في غيره(2) .
-
(1) بدائع الصنائع 4 : 353 .
(2) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 6 : 174 ، المفصل في أحكام المرأة 10 : 317 .
المبحث الخامس : شرائط ولاية عدول المؤمنين
لمّا أثبتنا الولاية لعدول المؤمنين، ينبغي أن نذكر الاُمور التي كانت شروطاً لها، وهي ما يلي :
الأوّل : رعاية المصلحة.
قد ذكرنا أقوالهم عند البحث عن اشتراط المصلحة في ولاية الحاكم فراجع; إذ لافرق في هذا بين الحاكم وغيره من الأولياء .
قال في التذكرة : «الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة، فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ويدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيباً من الربح، ويستحبّ له ذلك، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً له أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكم»(1) .
واستظهر في مفتاح الكرامة من هذا نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين(2) .
ونقل المحقّق الاصفهاني أيضاً في ذلك دعوى الإجماع من غير واحد(3) .
على كلّ حال تدلّ على اشتراط لزوم رعاية المصلحة من جانب عدول المؤمنين في تصرّفاتهم في المقام الأدلّة التي ذكرناها دليلاً على اشتراطها في تصرّفات الحاكم، فراجع .
قال المحقّق النائيني في المقام : «يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ ولاية الفقيه والعدل ومطلق المؤمن ليس كولاية الأب والجدّ حتّى يكون لهم التصرّف مطلقاً ،
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة.
(2) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
(3) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 429 .
بل الظاهر منها إناطة جواز التصرّف بما كان صلاحاً لليتيم»(1) .
الأمر الثاني : فقد الحاكم.
هل يشترط في ولاية العدول من المؤمنين فقد الإمام أو الحاكم، أم أنّهم مأذونون ولو مع وجود الفقيه الجامع للشرائط ؟ قولان :
الأوّل: الظاهر من كلمات كثيرهم أنّه يشترط في ولايتهم فقد الحاكم ; لأنّهم قيّدوا ولايتهم بتعذّر الفقيه .
قال المحقّق النراقي : «وحكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرّف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه»(2) .
وفي بلغة الفقيه : «ضرورة تقدّمهم عليهم إن وجدوا ، نصّاً وفتوىً بل ضرورة»(3) .
وفي مهذّب الأحكام : «هذا الترتيب ـ أي تقديم ولاية الحاكم على عدول المؤمنين ـ من ضروريّات فقه الإماميّة»(4) .
واستدلّوا لهذا القول بوجوه :
الأوّل : كونها ضرورة فقهيّة كما ادّعاها في البلغة ومهذّب الأحكام(5)، والظاهر عدم ثبوتها، بل أقصى ما يمكن أن يُقال: إنّ هذا هو المشهور بين الفقهاء .
الثاني : عدم كون تصرّفهم أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه .
الثالث : الاستدلال بما في الفقه الرضوي: «روي أنّ لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه حظّاً وصلاحاً، وليس عليه خسران
-
(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج2 : 243 .
(2) عوائد الأيّام : 559 .
(3 و 4) بلغة الفقيه 3 : 290 ـ 291 .
(5) مهذّب الأحكام 16 : 380 .
ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم وعليه»(1) .
ذكرهما المحقّق النراقي في العوائد(2) .
والجواب عن الثاني: أ نّ إطلاق الروايات يحكم بأنّ التصرّف من غير الفقيه أيضاً يكون أحسن .
وأمّا عن الثالث ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ : لم يثبت عدم جواز التصرّف من غير الفقيه بدليل آخر .
الرابع : كونها موجبةً للهرج والمرج .
جاء في مهذّب الأحكام : «أنّ موضوع ما يتصدّيه المؤمنون إنّما هو ما علم بتشريعه وترغيب الشارع إليه مطلقاً، لكنّه جعلها مربوطة بإذن الفقيه دفعاً للهرج والمرج»(3) .
والجواب عنه : أنّ تصرّفهم منوط برعاية المصلحة، وهذا يوجب المنع عن الهرج والمرج ، وتحققّهما في بعض الأحوال خارج عن الفرض .
ببيان آخر : هذا الدليل أخصّ من المدّعى; لأنّ ولايتهم لا توجب الهرج والمرج مطلقاً، بل يمكن تحقّقهما في بعض الأحوال .
الخامس : ما ادّعاه بعض بأنّ مقتضى إطلاق نصوص الباب وإن كان إثبات ولايتهم مطلقاً، إلاّ أنّه من جهة كونها من مناصب القضاة، وقد جعل الشارع الفقيه قاضياً وحاكماً، فمع وجوده لابدّ من تصدّيه لذلك(4) .
والجواب عنه : أنّ إطلاق الروايات دليل على إذن الشارع في ذلك لغير الفقيه
-
(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 333 .
(2) عوائد الأيّام : 559 .
(3) مهذّب الأحكام 16 : 380 .
(4) منهاج الفقاهة 4 : 315 مع تصرّف يسير .
أيضاً، والفرض أنّه لا دليل للمنع عن غيره، فالحكم بأنّ هذا كان من مناصب
المختصّة للقضاة لا دليل عليه، وهو ظاهر .
عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذّر الإذن من الفقيه
القول الثاني: ـ وهو الحقّ ـ أنّه لا يشترط في ولاية عدول المؤمنين تعذّر الإذن من الفقيه ، بل لهم ولاية ولو مع وجوده .
قال المحقّق الأردبيلي : «الظاهر ثبوت ذلك ـ أي الولاية على أموال الأيتام ـ لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذّر ذلك كلّه ـ إلى أن قال : ـ من غير قيد تعذّر الحاكم ولا شكّ أنّه أولى مع إمكانه، وإلاّ فالظاهر أنّ لغيره ذلك»(1) .
وكذا في الحدائق(2). وقال به أيضاً المحقّق الاصفهاني(3) والسيّد الخوانساري(4)والسيّد الخوئي(5) .
ويدلّ على هذا الحكم وجوه :
الأوّل : أنّها من الاُمور التي يمكن قيام آحاد المؤمنين بها، كصلاة الميّت وبيع مال اليتيم ونحوهما، فهذه لم يثبت اختصاصها بالإمام(عليه السلام) بما هو رئيس المسلمين حتّى يقوم الفقيه مقامه(6) .
نقول : هذه وإن لم تكن من الاُمور التي لا يقوم بها إلاّ الإمام(عليه السلام) أو نائبه،
إلاّ أنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى مجوّز شرعيّ .
-
(1) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
(2) الحدائق الناضرة 22 : 592 .
(3) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 401 ـ 402 .
(4) جامع المدارك 4: 92 ـ 93.
(5) مصباح الفقاهة 5 : 62 .
(6) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 401 ـ 402 .
الثاني : نتيجة حمل المطلق على المقيّد في روايات الباب يقتضي ذلك .
قال الإمام الخميني (رحمه الله) : «مقتضى خلافة الفقهاء ووراثتهم حصر الولاية بهم ونفي ثبوتها لغيرهم ، ولازم حصرها بهم حصر كلّ ما هو من شؤون الولاية بهم ، ومنها: التصرّف والتصدّي لأمر الصغار ، فيقع التعارض بينهما، وبين ما دلّ على ثبوت ذلك للعدل .
لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ بين الدليلين عموماً مطلقاً ; لأنّ الثابت للفقيه كلّ التصرّفات الثابتة للوالي ، ومنها: التصرّف في مال الأيتام، ولازم الحصر نفي جميع ذلك عن غيره ، وما دلّ على ثبوت التصرّف الخاصّ للعدل يخصّص عموم الحصر أو يقيّد إطلاقه ، كما أنّ عموم ولاية الفقيه مخصّص بأدلّة ولاية الأب والجدّ ، فكما أنّ عموم ولايته أو إطلاقها قابل للتخصيص والتقييد، كذلك إطلاق الحصر أو عمومه ، ففي المقام ثبت الولاية للفقيه وجاز التصرّف للعادل، بناءً على ثبوت الحكم للعدل في زمان الغيبة»(1) .
الثالث: ـ وهو العمدة ـ إطلاق النصوص.
فإنّ الظاهر منها جواز قيام العدل لإدارة شؤون الأيتام، وكفاية ما يحتاجون إليها ولو مع وجود الفقيه وعدم تعذّر الإذن منه ; لأنّ المفروض أنّها مطلوبة للشارع غير مضاف إلى شخص ، ويتّضح هذا بأدنى تأمّل ; لأنّ المعصومين (عليهم السلام)كانوا موجودين في زمن وقوع السؤال، ومع هذا لم يقيّدوا ولاية العدول بالإذن منهم (عليهم السلام) .
قال في الحدائق : «وبالجملة: فإنّ الروايات المذكورة ظاهرة في جواز العدل الثقة بذلك ، وأنّه بهذه الأخبار مأذون في الدخول; سواء وجد الإمام أم لا؟
- (1) كتاب البيع 2 : 513 و 514 .
ولا يبعد القول بجواز تولية ذلك أيضاً مع وجود الفقيه الجامع للشرائط»(1) .
وقال السيّد الخوئي (رحمه الله) : «والظاهر أنّ الذي يستفاد من الروايات هو جواز ولاية عدول المؤمنين في خصوص مال اليتيم توسعةً ولو مع التمكّن من الإذن من الإمام أو الفقيه ; إذ العادة جارية بعدم التمكّن في جميع النقاط حتّى القرى»(2) .
نقول : ومع ذلك كلّه فالأولى رعاية الاحتياطوالإذن من الفقيه إذالم يتعذّر ذلك .
الأمر الثالث : عدم المزاحمة بين تصرّف العدلين.
هل يشترط في جواز تصرّف العدل في أموال الصغار عدم المزاحمة من عدل آخر؟ قولان :
الأوّل : لا يشترط ذلك ، بل يجوز له التصرّف ولو مع مزاحمة الآخر .
قال الشيخ الأعظم (رحمه الله) : «ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين، فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام(عليه السلام)، فمجرّد وضع العدل يده على مال يتيم لايوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه ـ إلى أن قال : ـ وبالجملة: فالظاهر أنّ حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجدّ ، من حيث جواز التصرّف لكلّ منهما ما لم يتصرّف الآخر»(3) .
ومحصّل كلامه: أنّ الولاية الثابتة لعدول المؤمنين ليست إلاّ على وجه الجواز أو الوجوب أو الندب التكليفي، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام(عليه السلام)، فمجرّد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لايمنع الآخر عن تصرّفاته ، نظير الأب والجدّ; حيث يجوز لكلّ منهما أن يتصرّف
-
(1) الحدائق الناضرة 22 : 592 .
(2) مصباح الفقاهة 5 : 62 ـ 63 .
(3) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 569 ـ 570 .
فيما وضع الآخر يده عليه(1) . وبه قال المحقّق النائيني (رحمه الله)(2) .
وقال بعضهم في توجيه هذا الحكم : أنّ الأصل يقتضي ذلك بعد عدم الدليل على الحرمة(3) .
والجواب عنه : أنّه لا شبهة في نفوذ تصرّفهم من البيع والشراء وغيرهما من أقسام التصرّفات عند فقد الحكّام، وليس معنى الولاية إلاّ ذلك ـ التي ثبت من قبل الإمام ـ وإلاّ فمجرّد الحكم التكليفي فهو من الاُمور الحسبية غير المربوطة بباب الولاية . إذن فولاية العدول كولاية الفقيه ، فكما لا يجوز المزاحمة للفقيه إذا وضع يده على مال اليتيم لا يجوز مزاحمة العدل المؤمن أيضاً ، وإذا كان كذلك فالأصل لايقتضي الجواز ; لأنّه لا دليل عليه في الفرض ، بل على خلافه(4) .
قال المحقّق الايرواني في توجيه كلام الشيخ الأعظم (رحمه الله) : «الظاهر أنّ مقصوده ليس ما هو ظاهر العبارة، كما يشهد له تفريع جواز مزاحمة غير المتصدّي للمتصدّي; فإنّ ذلك ليس متفرّعاً على كون جوازتصرّفهم جوازاً تكليفيّاً، بل متفرّع على ثبوت الولاية للعنوان العامّ، أعني عنوان المؤمن المنطبق على كلّ فرد فرد ابتداءً... وبالجملة جواز المزاحمة وعدم تعيّن الولاية بالشروع في التصرّف من مقتضيات كون الولاية بعنوان عام; أعني عنوان المؤمن وعنوان الأب بالمعنى الشامل للجدّ وعنوان الفقيه»(5) .
نقول: بعد كون ولايتهم كولاية الفقيه ; فإنّهما يشتركان في الحكم، فكما
-
(1) مصباح الفقاهة 5 : 64 .
(2) منية الطالب 2 : 243 .
(3) مهذّب الأحكام 16 : 383 .
(4) اقتبسنا ذلك من مصباح الفقاهة 5 : 64 ـ 65 .
(5) حاشية الايرواني على المكاسب : 159 الطبعة الحجريّة .
لا يجوز مزاحمة الفقيه في التصرّف، كذلك لا يجوز للعدول أيضاً .
القول الثاني: ـ وهو الحقّ ـ أنّه يشترط في نفوذ تصرّف العدول عدم مزاحمة عدل آخر، فبمجرّد وضع أحدهم يده على مال اليتيم لا يجوز للآخر التصرّف فيه; لأنّ الأصل الأوّلي عدم جواز التصرّف لأحد في مال غيره، وبعد القطع بجوازه في مال اليتيم للحكّام ولعدول المؤمنين في الجملة ، فالمتيقّن منه هو عدم جواز تصرّف الثاني فيه بعد وضع الأوّل يده عليه أو تصرّفه فيه ، كما قال السيّد الخوئي (رحمه الله)(1) .
تذكرةٌ
واعلم أنّه على ما تتبّعنا في كلمات فقهاء أهل السنّة لم نجد مبحثاً مستقلاًّ منهم بحثوا فيه عن شرائط إعمال ولاية المؤمنين، أو الأمين، أو العدول من المؤمنين، أو جماعة من المسلمين على اختلاف تعبيراتهم في هذه المسألة ، ولكن يستفاد من كلماتهم ـ التي ذكروها في بيان شرائط الأولياء على نحو مطلق ـ أنّه يشترط في صحّة هذه الولاية رعاية الاحتياط والمصلحة للمولّى عليه، مثل ما كان شرطاً عندهم في إعمال ولاية الأب والجدّ والحاكم وغيرهم، فراجع كلماتهم التي نقلنا عنهم في ذيل البحث عن اعتبار المصلحة في ولاية الحاكم على أموال الصغار ، فلانعيدها مراعاة للاختصار .
وهكذا يستفاد من كلماتهم في ترتيب الأولياء أنّ ولاية الحاكم وأمينه مقدّم على المؤمنين ، وشرطوا في صحّة ولاية المؤمنين فقد الحاكم وأمينه ; أي ما دام الحاكم وأمينه موجوداً لا يجوز لغيرهم التصرّف في أموال الأيتام ، فلا معنى للبحث في أنّه هل يكون تصرّف المؤمنين منوطاً بالإذن من الحاكم أو لا؟ فراجع كلماتهم في البحث عن ترتيب الأولياء على التزويج والمال ، والحمد لله ربّ العالمين .
- (1) مصباح الفقاهة 5 : 66 .
الباب الخامس
في بيان موارد تصرّف الأولياء
تمهيد
اتّضح في الباب الرابع ثبوت ولاية الأولياء في النفوس وأموال الصغار ، ويتفرّع على ذلك صحّة تصرّفاتهم في كثير من الاُمور ، وتنقسم هذه التصرّفات باختلاف مواردها على أنواع :
الأوّل : العقود المعاوضيّة التمليكيّة ; سواء تعلّقت بالأعيان، أو بالمنافع كالبيع والإجارة ونحوهما .
الثاني : العقود التمليكيّة غير المعاوضيّة ، كالهبة والصدقة والوقف وغيرها .
الثالث : العقود الإذنيّة، كالوديعة والعارية والوكالة . وهذه الثلاثة كُلّها تصرفّات اعتباريّة .
الرابع : التصرّفات التي تعلّقت بنفس مال الصغير عيناً ، كبناء عقاره، وحفظ ماله وتثميره، والزراعة له ورعي مواشيه، والإنفاق عليه من ماله وغيرها ، وكلّ هذه الأربعة تكون من شؤون ولاية الأولياء على أموال الصغار .
الخامس : التصرّفات التي تترتّب لأجل ولايتهم على النفوس ، كاستيفاء حقوقهم، وأخذ الشفعة لهم، وقبول الهبة والصدقة والوقف والوصيّة لهم وغير ذلك ، ولبيان أحكام هذه التصرّفات عقدنا هذا الباب ، وفيه فصول :
الأوّل : البيع والشراء والمصالحة بمال الصبيّ .
الثاني : الاُمور التي هي من شؤون الاتّجار .
الثالث : إجارة الوليّ الصبيّ أو ماله .
الرابع : استيفاء حقوق الطفل .
الخامس : الوصيّة بالولاية .
الفصل الأوّل
في البيع والشراء والاتّجار والمصالحة
بمال الصبيّ
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : البيع والشراء والاتّجار بمال الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للوليّ البيع والشراء بمال الصبيّ إن كان في ذلك مصلحة له .
جاء في المبسوط : «من ولّى مال اليتيم جاز له أن يتّجر فيه للصبيّ نظراً له ; سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً، أو حاكماً أو أميناً لحاكم»(1) .
وقال ابن زهرة السيّد أبو المكارم: «من شرائط صحّة البيع ثبوت الولاية في المعقود عليه ، ثمّ قال : واشترطنا ثبوت الولاية احترازاً من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك له ، وهم ستّة : الأب والجدّ ووصيّهما، والحاكم وأمينه والوكيل»(2). وبه قال سلاّر(3) وابن حمزة(4) والكيدري(5) .
-
(1) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
(2) غنية النزوع : 207 .
(3) المراسم : 173 .
(4) الوسيلة : 236 .
(5) إصباح الشيعة : 197 .
وفي الشرائع في شرائط المتعاقدين : «وأن يكون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب والجدّ للأب ، والوكيل ، والوصيّ ، والحاكم وأمينه»(1) .
وبه قال العلاّمة في جملة من كتبه(2) والشهيد(3) والمحقّق الأردبيلي(4) . وبه قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين ومتأخِّريهم(5) .
وجاء في مفتاح الكرامة : «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت(6)به عبارات الأصحاب ، كالشيخ الطوسي وأبي المكارم والحلّي ومن تأخّر عنهم إلاّ من شذّ»(7) .
وقال الشيخ الأعظم : «ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع»(8) .
والظاهر من هذه الجملة أنّ المدّعى من الواضحات التي لا مجال للبحث فيها والاستدلال لها(9) .
جاء في مجمع الفائدة والبرهان : «الظاهر أنّه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع
-
(1) شرائع الإسلام 2 : 14 ، المختصر النافع : 146 .
(2) مختلف الشيعة 5 : 89 ـ 90 ، تذكرة الفقهاء 10 : 14 ، نهاية الإحكام 2 : 477 ، تبصرة المتعلِّمين : 96 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 276 .
(3) الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
(4) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 .
(5) جامع المقاصد 4 : 87 ، رياض المسائل 5 : 63 ، الحدائق الناضرة 18 : 403 ، مسالك الأفهام 3 : 164 ، الروضة البهيّة 3 : 241 ، جواهر الكلام 22 : 272 و 324 ، المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535، المكاسب والبيع للنائيني 2 : 330 ، الحاشية على المكاسب للاصفهاني 2 : 372 ، كتاب البيع للأراكي 2 : 3 ، كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 435 ، مصباح الفقاهة 5 : 11 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 19 .
(6) «طفح : طفح الإناء طفوحاً، إذا امتلأ حتّى يفيض». الصحاح للجوهري 1 : 344.
(7) مفتاح الكرامة 4 : 184 .
(8) المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 345 .
(9) مباني منهاج الصالحين 7 : 409 .
والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتّصل جنونهم وسفههم
إلى البلوغ ، من الأب والجدّ للأب ، لا للأُمّ ، ومن وصيّ أحدهما مع عدمهما ، ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم»(1) .
وفي تحرير الوسيلة : « يجوز للأب والجدّ للأب ـ وإن علا ـ أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها »(2) .
وبه قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني(3) .
أدلّة جواز البيع والشراء بمال الطفل
ويمكن الاستدلال لهذا الحكم ـ مضافاً إلى الأدلّة التي تثبت بها ولاية الوليّ على أموال الصغار بنحو العامّ ، التي بحثنا عنها في الباب الرابع ـ بوجوه :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض(4) والجواهر(5) والمكاسب(6) .
الثاني : النصوص المستفيضة.
قال الشيخ الأعظم : «يدلّ عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة»(7) .
منها : صحيحة علي بن رئاب ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك
-
(1) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 .
(2) تحرير الوسيلة 1 : 401 في شرائط المتعاقدين مسألة 18 .
(3) الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : 317 .
(4) رياض المسائل 5 : 63 .
(5) جواهر الكلام 22 : 272 .
(6) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .
(7) كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .
مماليك غلماناً وجواري ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها
أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟
قال: فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم».
قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟
فقال : «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(1) .
والظاهر أنّ ترك الوصيّة إنّما هو بالنسبة إلى الجواري والغلمان ، والمراد من القيّم والوليّ من نصبه الأب ; فإنّ نَصْبَ قضاة الجور لا أثر له ، ونَصْبُه(عليه السلام)ونَصْبُ فقيه منّا مفروض العدم .
ومنها : صحيحة ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : في رجل عنده مال اليتيم، فقال : «إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسُّ ماله ، وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن»(2) .
وهذه الرواية تدلّ على أحكام; وهي جواز الاتّجار بمال اليتيم ، وكون الربح لليتيم ، وكون الوليّ ضامناً إن تلف المال .
ومنها : معتبرة أو صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيٌّ»(3) .
-
(1) وسائل الشيعة 12 : 269 الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1 .
(2) نفس المصدر 12 : 191 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، ح3 .
(3) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من أبواب أحكام الوصايا، ح1 .
وسند هذه الرواية إمّا صحيحة أو معتبرة; لأنّ أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي وهو ثقة، وعليّ بن الحسن هو ابن فضّال بقرينة الراوي والمروي عنه، والحسن بن علي هو ابن يوسف كما في الفقيه 4 : 210 ح590 والتهذيب 9 : 236 ح921 ، والكافي 7 : 62 ح19 . وأمّا مثنّى بن الوليد، فهو ثقة; لأنّه قال الكشّي : «قال محمّد بن مسعود : قال عليّ بن الحسن «ابن فضّال» سلاّم والمثنى بن الوليد والمثنّى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم ». رجال الكشّي : 338 الرقم 623. وأيضاً يروي عنه الأجلاّء كالبزنطي وابن فضّال وعبدالله بن مسكان وحسن بن محبوب . جامع الرواة 2 : 40 .
وقال الإمام الخميني(قدس سره) بعد نقل الحديث: « دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير; سواء كان في حال حياته ـ بأن يُوكّل من يعمل ذلك ـ أو كان بعد مماته بالإيصاء والإجازة ، فيظهر منه أنّ له التصرّف بالبيع والشراء ونحوهما ، وأنّه وليّ الطفل وأنّ تصرّفاته نافذة; سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل إليه بعد مماته »(1) .
وبالجملة : هذه النصوص تدلّ على جواز تصرّف الأب في حال حياته بالبيع والشراء والاتّجار في مال الصبيّ وتفويضه إلى الوصي بعد موته .
وكذلك غيرها من الأخبار المستفيضة في موارد كثيرة(2) .
آراء فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة
أ ـ الحنفيّة
فقد جاء في بدائع الصنائع : «وله ـ أي الوليّ ـ أن يبيع ماله بأكثر من قيمته
-
(1) كتاب البيع 2 : 436 .
(2) وسائل الشيعة 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح5 ، قال(عليه السلام) فيه : «إذا اتّجر به فزكّه». وح10، وفيه : «لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به». وص57 الباب 2 من تلك الأبواب ح1; فإنّه قال(عليه السلام)في جواب السائل الذي سأل بأنّه هل على مال اليتيم زكاة؟ «لا ، إلاّ أن يتّجر به أو تعمل به» وح2; فإنّ فيه قول الإمام(عليه السلام) : «ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به فإن اتّجر به، فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به». وهكذا ح3 ـ 8 من هذا الباب. وهكذا الوسائل 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، ح1 ـ 5 .
ويشتري له شيئاً بأقلّ من قيمته ; لما قلناه (1).
وله أن يبيعه بمثل قيمته وبأقلّ من قيمته مقدار ما يتغابن الناس فيه عادةً ، وله أن يشتري له شيئاً بمثل قيمته وبأكثر من قيمته قدر ما يتغابن الناس فيه عادةً»(2) .
وقال في موضع آخر : «إنّ الأب أو الجدّ إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع مال نفسه من الصغير بمثل قيمته أو بأقلّ جاز . ولو فعل الوصيّ ذلك لا يجوز عند محمد أصلاً ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كان خيراً لليتيم جاز، وإلاّ فلا»(3) .
وبه قال الزيلعي الحنفي(4) .
ب ـ الشافعيّة
وجاء في المهذّب للشيرازي : «يجوز أن يتّجر في ماله ; لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ألا من ولّي يتيماً له مال فليتّجر له بماله ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة»(5) ،(6).
ثمّ قال في موضع آخر: «إن أراد أن يبيع ماله بماله، فإن كان أباً أو جدّاً جاز ذلك; لأنّهما لا يتّهمان في ذلك لكمال شفقتهما ، وإن كان غيرهما لم يجز ; لما روي أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قال : لا يشتري الوصيّ من مال اليتيم(7) . ولأنّه متّهم في طلب الحظّ
-
(1) أي لأنّه نفع محض له فيملك الوليّ.
(2 ـ 3) بدائع الصنائع 4 : 351 و 352 .
(4) تبيين الحقائق 5 : 221 .
(5) الأموال لأبي عبيد : 547 ح1299 ، وفيه: فليتّجر له فيه. سنن الترمذي 3 : 32 ح640 ، شرح السنّة 4 : 36 ح1589 وفيهما: فليتّجر فيه ، سنن الدارقطني 2 : 95 ح9151 ، وفيه: فليتّجر له. السنن الكبرى للبيهقي 5 : 524 ح7433 وفيه: فليتّجر له فيه.
(6) المهذّب للشيرازي 1: 328.
(7) قال النووي: «قال ابن حجر في تلخيص الحبير : لم أجد هذا الحديث ». المجموع 14 : 137 ، وكذا في هامش العزيز شرح المهذّب 5 : 81 .
له في بيع ماله من نفسه، فلم يجعل ذلك إليه»(1) .
وقال النووي : «وللناظر في مال الصبيّ أن يتّجر في ماله ; سواء كان الناظر أباً ، أو جدّاً ، أو وصيّاً ، أو سلطاناً ، أو أميناً من قبل الحاكم»(2) .
وقريب من هذا ماجاء في كلام الماوردي(3) والخطيب الشربيني(4) وغيرهما(5).
ج ـ المالكيّة
قالوا : إنّ للأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً عقاراً كان أو
منقولاً ، ولايتعقّب بحال ولا يطلب منه بيان سبب البيع; لأنّ تصرّفه محمول على المصلحة(6).
وأمّا الوصيّ، فلا يبيع عقار محجوره إلاّ لسبب يقتضي بيعه; كنفقة ووفاء دين لم يوجد لهما غير العقار ، أو كون بيعه غبطةً; بأن زيد في ثمنه الثلث فأكثر ، أو كونه يؤخذ عليه توظيفٌ; أي تجبى عليه جباية، أو كون غلّته قليلة ، فيباع ويشترى من ثمنه عقار أكثر غلّة ، أو لخوف عليه من ظالم أو غيرها(7) .
وكذلك يبيع الحاكم كالوصيّ مال المحجور عند الضرورة، كالنفقة ووفاء الدين ونحوهما .
-
(1) المهذّب للشيرازي 1 : 330 .
(2) المجموع شرح المهذّب 14 : 124 .
(3) الحاوي الكبير 6 : 450 .
(4) مغني المحتاج 2: 174.
(5) العزيز شرح الوجيز 5 : 80 ، روضة الطالبين 3 : 476 ـ 477 .
(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 : 299 ـ 300 ، بلغة السالك «شرح الصغير» 3 : 245 ، مواهب الجليل 6 : 649 ـ 652 ، حاشية الخرشي 6 : 243 ، حاشية البناني على شرح الزرقاني 5 : 301 ، تبيين المسالك 3 : 529 و 526 ، عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 ، التاج والإكليل 6 : 655 .
(7) نفس المصدر السابق.
د ـ الحنابلة
يجوز عندهم أيضاً أن يتصرّف الوليّ في أموال الصبيّ بالمصلحة، فله أن يتّجر بماله ، والتجارة بماله أولى من تركه ، واستدلّوا بما روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)قال : «من ولي يتيماً له مال فليتّجر له فيه، ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة»(1) .
ومتى اتّجر في مال الصبيّ بنفسه فالربح كلّه لليتيم ; لأنّ الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقّه غيره إلاّ بعقد ، والمضارب إنّما يستحقّ بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الوليّ المضاربة مع نفسه لنفسه(2) .
قال ابن قدامة : «ويجوز أن يشتري له العقار ; لأنّ الحظّ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل ، فهو أحظّ من التجارة وأقلّ غرراً»(3) .
وهكذا قالوا : إنّ للأب بيع ماله بماله ; لأنّه غير متّهم عليه لكمال شفقته ، وليس ذلك للوصيّ ولا للحاكم ; لأنّهما متّهمان في طلب الحظّ لأنفسهما، فلم يجز ذلك لهما(4) .
-
(1) تقدّم تخريجه .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 108 ـ 109 ، المغني 4 : 293 ، والشرح الكبير 4 : 519 و 520 و523 و524 ، الإقناع 2 : 224 و 225 ، الإنصاف 5 : 325 ـ 326 .
(3) المغني 4: 293، الشرح الكبير 4 : 519 و520 .
(4) المصادر المتقدّمة .
المبحث الثاني :
الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار
الأوّل : قال في التذكرة : «وهل للوصيّ بيع مال الطفل والمجنون من نفسه، وبيع مال نفسه منه ؟ منع منه جماعة من علمائنا، والشافعي أيضاً لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يشتري الوصيّ من مال اليتيم»(1). والأقرب عندي الجواز ، والتهمة منتفيةٌ مع الوثوق بالعدالة ، ولأنّ التقدير أنّه بالغ في النصيحة ، ولا استبعاد في كونه موجباً وقابلاً كما في الأب والجدّ . إذا عرفت هذا فهل للأب والجدّ للأب ذلك؟ الأولى ذلك ، وبه قال الشافعي ; لأنّ شفقّتهما(2) عليه يوجب المناصحة . وكذا يبيع الأب والجدّ عن أحد الصغيرين ويشتري للآخر»(3) .
وفي الشرائع : «الأب والجدّ للأب يُمضى تصرّفهما . . . فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره، وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه»(4) .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 81 الطبعة الحجريّة .
(2) مقتضى التعليل انحصار الجواز بالأب والجدّ، مع أنّ الملاك في جواز البيع أو الشراء بالنسبة إلى الوصي هو انتفاء التهمة، وهذا الملاك عامّ حتّى بالنسبة إلى غير الأب والجدّ من الحاكم أو أمينه أو عدول المؤمنين. وهكذا يدلّ عليه إطلاق ما دلّ على نفوذ التصرّف للمؤمن العادل، إلاّ أن يقال: إنّ الحكم فيه تكليفيّ وليس من قبيل الولاية حتّى يتمسّك بعمومه، وكيف كان، الظاهر من المحقّق والجواهر أنّ جواز وقوعه لأحد طرفي العقد منحصر بالأب والجدّ، مع أنّ العلاّمة قد صرّح للوصيّ أيضاً; فإذا قلنا للمؤمن العدل ولاية، فيجوز له أن يبيع مال الصبيّ عن نفسه بما يكون مصلحة له. م ج ف.
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة.
(4) شرائع الإسلام 2 : 15 .
وبه قال في المسالك(1) .
وفي الجواهر في شرح كلام المحقّق : «بلا خلاف محقّق في المقام، أو معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى السيرة ونصوص تقويم جاريته عليه(2) . . . وإطلاق ما دلّ على ولايته الشامل لذلك البيع وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير»(3) .
وجاء في البيان في فقه الشافعي : «ويجوز للأب والجدّ أن يبيعا مالهما من الصبيّ ويشتريا ماله بأنفسهما إذا رأيا الحظّ له في ذلك ; لأنّهما لا يتّهمان في ذلك ـ إلى أن قال : ـ وأمّا غير الأب والجدّ من الأولياء كالوصيّ وأمين الحاكم، فلايجوز أن يبيع ماله من الصبيّ ويتولّى طرفي العقد ، ولا يجوز أن يشتري ماله بنفسه»(4).
وكذا عند الحنفيّة(5) .
وفي الشرح الكبير : «ولا يجوز أن يشتري ـ أي الوليّ ـ من مالهما شيئاً لنفسه ولا يبيعهما إلاّ الأب ; لأنّه غير متّهم عليه لكمال شفقّته . وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وزادوا الجدّ»(6) .
الثاني : قال العلاّمة في القواعد : «يجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال»(7) .
ولكن جزم في نكاح التذكرة بأنّه «يجب على الوليّ حفظ مال الطفل ; لأنّ الله
-
(1) مسالك الأفهام 3 : 165 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به، ح1 و2 .
(3) جواهر الكلام 22 : 324 مع تصرّف يسير .
(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي 6 : 216 ـ 217 .
(5) بدائع الصنائع 4 : 352 .
(6) الشرح الكبير 4 : 519 .
(7) قواعد الأحكام 2 : 135 .
تعالى جعله قيّماً عليه ناظراً في مصالحه وتحصيل منافعه ، ودفع المفاسد عنه ، فيجب عليه مراعاة حاله في حفظ ماله ، وصونه عن أسباب التلف ، وعليه استنماؤه بحيث لا تأكله النفقة والمؤن إن أمكن ذلك ، ولا تجب عليه المبالغة في الاستنماء وطلب النهاية فيه .
ولو طلب متاعه بأكثر من ثمنه وجب بيعه ، إلاّ أن تقتضي المصلحة إبقاءه ، ولو كان هناك متاع يُباع بأقلّ ثمنه وللطفل مال وجب أن يشتريه مع المصلحة والغبطة ، إلاّ أن يرغب الوليّ في شرائه لنفسه فيجوز .
وما يحتاج الطفل إلى إبقائه وحفظ ثمنه لا يجوز بيعه وإن طلب بالزيادة، والعقار الذي يحصل منه قدر كفايته لا يباع .
وكذا في طرف الشراء، قد يكون الشيء رخيصاً لكن يكون في معرض التلف ، أو يتعذّر بيعه لقلّة الراغب فيه فلا يشتريه الوليّ ; لأنّه يكون ثقله على الطفل»(1) .
ولم يرجّح ابن العلاّمة ذلك في الإيضاح، حيث قال : « ينشأ الإشكال من أنّه اكتساب لا يجب ، ومن أنّه منصوب للمصلحة، وهذه من أتمّ المصالح ، ولأنّه مفسدة وضرر عظيم على الطفل ونصب المولى لدفعها ، وبهذا يبنى على أنّ هذا هل هو مصلحة أو أصلح، وعلى الثاني هل يجب أم لا؟ وقد حقّق ذلك في علم الكلام »(2) .
نقول : الظاهر لزوم التفصيل في المسألة ، والقول بأنّه يجب على الوليّ حفظ مال الطفل عن التلف ، بحيث لو لم يقدم على هذا كان عاصياً ومعاقباً ، ولكن لايجب(3)
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 609، الطبعة الحجريّة .
(2) إيضاح الفوائد 2 : 53 .
(3) إلاّ إذا طلب المتاع بأكثر من ثمنه ولا تقتضي المصلحة إبقاءه، وبعبارة اُخرى: الاستنماء ابتداءً لا دليل على وجوبه، وأمّا في فرض الطلب هكذا فمن مصاديق لزوم رعاية المصلحة. م ج ف.
عليه استنماء مال الطفل وطلب الزيادة فيه .
والدليل على هذا أنّ الله ـ تعالى ـ جعل الوليّ قيّماً على الطفل ناظراً في مصالحه ،
وهذا الجعل يوجب أن يكون مكلّفاً في دفع الضرر والمفاسد عن نفس الطفل
وماله ، فيجب عليه مراعاة حاله وحفظ ماله ; لأنّه لا معنى بأن يقال : إنّ الوليّ قيّم وناظر ولا يجب حفظه وحفظ ماله عن التلف .
بتعبير آخر : إنّ لجعل الشارع القيمومة للطفل أثراً ، وهو إلزام القيّم برعاية مصالحه ، ومنها: حفظ ماله عن التلف ، وإن لم نقل بذلك يكون جعل القيمومة بلا أثر ولغواً .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه إن تلف مال الطفل في زمان قيمومة الوليّ فليس عليه ضمان ; لأنّه لم يكن موجباً لإتلافه بحيث يصدق أن يُقال : إنّ الوليّ أتلف مال الطفل وإن كان عاصياً في عدم حفظه مال الطفل .
وأمّا وجوب استنماء مال الطفل وطلب الزيادة فيه ، فلا يجب على الوليّ ; لأنّه اكتساب وتكليف زائد ولا دليل عليه ، فنحكم بعدم وجوبه للأصل .
وهذا هو الظاهر من كلام المحقّق الثاني، حيث قال ـ في ذيل كلام العلاّمة في القواعد «واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال» ـ : «ينشأ من أنّ ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجب ، ومن أنّ ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم ، وفائدة نصب الوليّ دفع الضرر ، وربما بني الحكم على أنّ الواجب الأصلح، أم تكفي المصلحة ، والأصحّ عدم الوجوب»(1) .
واختاره أيضاً في مفتاح الكرامة بأنّه قال: «أصحّه عدم الوجوب ». واستدلّ بأنّ «الواجب على الوصيّ فعل ما فيه مصلحة; بمعنى دفع الضرر، ولا يجب
- (1) جامع المقاصد 5 : 188 .
عليه الأصلح»(1) .
ويدلّ أيضاً على عدم وجوبه ما ورد في خبر أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : كان لي أخ هلك فأوصى «فوصّى خل» إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلّمه لليتيم ، وضمّن له ماله ، فقال : «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلابأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم»(2) .
حيث قال(عليه السلام) : «لابأس به» ولم يقل : فليتّجر به، أو يضارب، أو يجب عليه، أو نحو ذلك ممّا يدلّ على الوجوب .
ومثله خبر أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره
والربح بينهما». قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : «لا ، إذا كان ناظراً له »(3) .
ولعلّه لما ذكرنا عدل العلاّمة عن نظره الشريف فقال في حجر التذكرة : «للوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ، ويدفعه إلى من يضارب له به ، ويجعل له نصيباً من الربح ، ويستحبّ له ذلك; سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً له، أو وصيّاً، أو حاكماً أو أمين حاكم. وبه قال عليّ(عليه السلام) وعمر وعائشة والضحّاك، ولا نعلم فيه خلافاً إلاّ ماروي عن الحسن البصري كراهة ذلك ; لأنّ خَزْنَه(4) أحفظ وأبعد من التلف»(5) .
الثالث : أيضاً في التذكرة : «يجب على الوليّ الإنفاق على من يليه بالمعروف ،
-
(1) مفتاح الكرامة 5 : 266 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(3) وسائل الشيعة 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح6 .
(4) خَزَنَ الشيء خَزْناً جَعَلهُ في خزانة ، لسان العرب 2 : 252 ، المعجم الوسيط: 233 .
(5) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة .
ولا يجوز له التقتير عليه في الغاية ، ولا الإسراف في النفقة ، بل يكون في ذلك مقتصد ، أو يجري الطفل على عادته وقواعد أمثاله من نظرائه ، فإن كان من أهل الاحتشام أطعمه وكساه ما يليق بأمثاله من المطعوم والملبوس . وكذا إن كان من أهل الفاقة والضرورة أنفق عليه نفقة أمثاله»(1) .
وكذا في وسيلة النجاة(2) وتحريرها(3) وتفصيل الشريعة ، وزاد أنّه « لو أسرف في ذلك يكون ضامناً للزيادة ، كما أنّه لو قتّر يكون معاقباً عليه ، بل لو صار التقتير سبباً للمرض والكسالة المستلزمة صحّتها للمخارج لا يبعد أن يقال بضمان تلك المخارج حتّى تتحقّق الصحّة »(4) .
وهو مقتضى موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) ؟ فقال : «يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ، ولا يرزأنّ(5) من أموالهم شيئاً ، إنّما هي النار»(6) .
وكذا مرسلة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن اليتيم تكون غلّته(7) في الشهر عشرين درهماً ، كيف ينفق عليه منها؟ قال : «قوته من
-
(1) نفس المصدر 2 : 82 ، الطبعة الحجريّة .
(2) وسيلة النجاة 2 : 101 .
(3) تحرير الوسيلة 2 : 16 .
(4) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر: 308.
(5) رزأه ماله: أي أصاب منه شيئاً فنقصَهُ ، المعجم الوسيط: 341 .
(6) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
(7) الغلّة : كلّ شيء يحصل من ريع الأرض أو اُجرتها ونحو ذلك ، المصباح المنير : 452 ، والريع الزيادة والنماء ، قال الأزهري : الريع فضل كلّ شيء على أصله ، المصباح المنير 1 : 248 .
الطعام والتمر»(1) .
الرابع : من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ يجب أن يخرج عن الطفل من ماله جميع ما يتعلّق به من الديون التي لزمته باقتراض الوليّ عنه ، أو لزمته بأرش أو جناية ، أو بسبب ديون مورّثه .
فأمّا زكاة الفطرة، فلا تجب عليه عندنا خلافاً لبعض العامّة .
وأمّا زكاة المال، ففيها قولان: أحدهما: الاستحباب(2) . . . . وإن جنى الطفل على مال كانت في ماله ، يخرجها الوصيّ عنه . وإن كانت على النفس فهي خطأ مطلقاً; لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ . . . فالدية على العاقلة .
والكفّارة في مال الطفل على الفور . . . وكذا ينفق على من عليه نفقته ، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما(3) .
نقول : سنذكر حكم الزكاة والخمس في مال الصبيّ وكذا الكفّارة في الباب الذي عقدناه للبحث عن عبادات الطفل إن شاء الله .
الخامس : قال في التحرير : «يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته يحسبه كأحدهم، فيأخذ من ماله بإزاءما يقابل مؤونته ولايفضله على نفسه ، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه، ولو كان إفراده أرفق به أفرده، وكذا لو كان الرفق في مزجه أمزجه استحباباً»(4) . وكذا في المبسوط(5) والسرائر(6)
-
(1) نفس المصدر 12 : 190 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(2) قال الشيخ الطوسي: «مايجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصيّ أن يخرج من ماله» الخلاف 4: 165.
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 512 ، الطبعة الحجريّة .
(4) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 .
(5) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
(6) السرائر 2 : 213 ـ 214 .
والوسيلة(1) وتحريرها(2) .
وزاد في التذكرة : «فينبغي أن يتغابن ـ أي الوليّ ـ مع الأيتام فيحسب لكلّ واحد من عياله وأتباعه أكثر من أكل اليتيم وإن ساوى الواحد منهم ، تحفّظاً لمال اليتيم وتحرّزاً من تلف بعضه ، ولو تعدّد اليتامى واختلفوا كبراً وصغراً حسب على الكبير بقسطه وعلى الصغير بقسطه لئلاّ يضيع مال الصغير بقسطه على نفقة الكبير»(3) .
وقريب من هذا في جامع المقاصد(4) ومفتاح الكرامة(5) . ولقد أجاد في تفصيل الشريعة حيث قال : «يجوز له ـ أي للوليّ ـ أن يخلطه بعائلته واُسرته ويحسبه
كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم بنسبة الرؤوس ويأخذ سهم اليتيم من ماله ، بل لعلّ هذا يكون أنفع بحاله من الإفراد والاستقلال ; لأنّ التوزيع موجب لقلّة مصارف اليتيم نوعاً . . . هذا بالإضافة إلى المأكول والمشروب .
وأمّا الملبوس فحيث إنّه لا معنى للتوزيع فيه غالباً، فالحساب على كلّ على حدّة. وأمّا المسكن لو لم يكن اليتيم واجداً له بالإرث ونحوه، فاللازم فيه أيضاً رعاية ما هو صلاح له من الاشتراء والاستئجار والإفراد والمخالطة »(6) .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة المتقدّمة ; لأ نّ الإمام (عليه السلام) قال فيها: «إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما
-
(1) وسيلة النجاة 2 : 101 .
(2) تحرير الوسيلة 2 : 16 .
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 82 ، الطبعة الحجريّة .
(4) جامع المقاصد 5 : 191 .
(5) مفتاح الكرامة 5 : 269 .
(6) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 306.
يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً» الحديث(1) .
وخبر أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : قلت : أرأيت قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) قال : «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه» . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً ، وبعضهم أعلى كسوة من بعض، وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : «أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته ، وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً; فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير»(2) .
وكذا يدلّ عليه رواية تفسير القمّي(3) .
السادس : جاء في المبسوط : «ويستحبّ له ـ أي للوليّ ـ أن يشتري بماله ـ أي اليتيم ـ العقار(4); لأنّه يحصل فيه الفضل ويبقى الأصل ، ولا يشتريه إلاّ من ثقة أمين يؤمن جحوده أو حيلته في إفساد البيع ; بأن يكون قد أقرّ لغيره قبل البيع وما أشبه ذلك ، ويكون في موضع لا يخاف هلاكه ; بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه أو في معترك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق والهدم»(5) .
وكذا في التحرير(6) .
وزاد في التذكرة : «لأنّه يحصل منه الفضل ولا يفتقر إلى كثير مؤنة … وسلامته
-
(1) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به، ح2 .
(2) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
(3) نفس المصدر، ح6 .
(4) العقار مثل سلام كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل . قال بعضهم : وربما اُطلق على المتاع ، والجمع عقارات والعقار بالفتح . المصباح المنير : 421 .
(5) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
(6) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
متيقّنة ، والأصل باق مع الاستنماء ، والغرر فيه أقلّ من التجارة ، بل هو أولى منها ;
لما في التجارة من الأخطار وانحطاط الأسعار ، فإن لم يكن في شرائه مصلحة إمّا لفضل الخراج وجور السلطان، أو إشراف الموضع على البوار لم يجز»(1) .
السابع : يجوز أن يبني عقارَهُ ، ويستجدّه إذا استهدم من الدور والمساكن ; لأنّه في معنى الشراء ، إلاّ أن يكون الشراء أنفع فيصرف المال إليه ، ويقدّمه على البناء .
وإذا أراد البناء بنى بما فيه الحظّ لليتيم ، ويبنيه بالآجر والطين . وإن اقتضت المصلحة البناء باللبن(2) فعل، وإلاّ فلا . . . وبالجملة: يفعل الأصلح . . . والأولى البناء في كلّ بلد على عادته(3) .
الثامن : قال الشيخ في المبسوط : «إن كان له ـ أي لليتيم ـ عقار لم يجز لوليّه أن يبيعه إلاّ عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته وكسوته ، ولا يكون له وجه غيره من غلّة وأُجرة عقار فيباع بقدر الحاجة، أو يكون في بيعه غبطة . . .»(4) .
وكذا في القواعد(5)، وعلّله في التذكرة بأنّ الوليّ مأمور بفعل ما فيه الحظّ والمصلحة لليتيم، وبيع عقاره يكون تفويتاً للحظّ والمصلحة عليه، فلا يجوز إلاّ أن احتيج إلى بيعه فجاز(6) .
وقال المحقّق العاملي ـ في شرح كلام الماتن في المقام ـ : «كأن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة، أو قضاء دين أو ما لابدّ منه ، ولا تندفع حاجته إلاّ بالبيع
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
(2) اللّبن : المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ ، المعجم الوسيط 2 : 814 .
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة ، المبسوط للطوسي 2 : 162 .
(4) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
(5) قواعد الاحكام 2 : 136 .
(6) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
والجزئيات لا تنضبط ، فالمدار على الحاجة مع المصلحة»(1) .
والحاصل : أنّ تصرّف الأولياء في أملاك الأيتام بالبيع والشراء مقيّد بوجود المصلحة أو عدم المفسدة على ما بيّناه سابقاً، وبيع عقار اليتيم من دون حاجة يكون على خلاف مصلحته، بل يوجب ضرراً ومفسدة عليه، فلا يجوز تكليفاً ; بمعنى أنّه إن باع الوليّ العقار أو غيره من دون حاجة إلى البيع وعلى خلاف مصلحة اليتيم كان عاصياً ; لأنّ فعله يوجب ضرراً عليه وهو محرّم ، وكذا لا ينعقد البيع وضعاً;
بمعنى أنّه إن عصى وأوجب البيع لم يصحّ ولم يخرج المبيع عن ملك اليتيم ، ولا تترتّب عليه آثار الملك للمشتري ; لأنّ في فرض المسألة لم يكن الوليّ مجازاً للتصرّف لا شرعاً، فإنّ تصرّفه شرعاً مقيّد بالمصلحة ، ولا من ناحية المالك ـ أي اليتيم ـ حيث إنّه لم يكن أهلاً للإجازة ، فلا وجه للقول بصحّة البيع .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للقول بكراهة بيع العقار من دون حاجة ومصلحة لليتيم ، كما اختاره العلاّمة في التحرير(2) .
ولعلّه لما ذكرنا عدل عن رأيه في التذكرة والقواعد كما ذكرنا .
التاسع : قال في التذكرة : «إذا باع الأب أو الجدّ عقار الصبيّ أو المجنون وذكر أنّه للحاجة ، ورفع الأمر إلى الحاكم ، جاز له أن يسجّل على البيع ولم يكلّفهما إثبات الحاجة والغبطة ; لأنّهما غير(3) متّهمين في حقّ ولدهما . ولو باع الوصيّ أو أمين الحاكم لم يسجّل الحاكم إلاّ إذا قامت البيِّنة على الحاجة أو الغبطة»(4) . وكذا
-
(1) مفتاح الكرامة 5 : 269 .
(2) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
(3) كلمة «غير» لم تكن في النسخة المطبوعة ، والأصحّ ما أثبتناه كما في مفتاح الكرامة 5 : 269 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
في تحرير الأحكام(1). واختاره الشيخ الطوسي في المبسوط(2) .
نقول : الأقوى ما اختاره بعض الفقهاء من التفصيل بين ما إذا كان الوصيّ موثّقاً عند الحاكم، فيقبل قوله ويسجّله عملاً لظاهر الحال ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يقبل إلاّ بعد إقامة البيِّنة .
قال في تحرير الوسيلة : «وأمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلاّ بعد ثبوتها عنده على الأحوط ، وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده»(3).
وكذا في تفصيل الشريعة(4) .
العاشر : جاء في المبسوط : وإذا بلغ الصبيّ وقد باع الأب أو الجدّ ـ عقاره ـ فادّعى أنّه باعه من غير حاجة ولا غبطة كان القول قول الأب أو الجدّ ، وإن كان وصيّاً أو أميناً كان القول قول الصبيّ ، ووجب على الوصيّ أو الأمين البيِّنة»(5) .
واختاره في التحرير(6) .
وزاد في التذكرة بأنّ «القول قول الأب والجدّ مع اليمين ، وعليه ـ أي على الصبيّ ـ البيِّنة ; لأنّه يدّعي عليهما خلاف الظاهر ; إذ الظاهر من حالهما الشفقّة وعدم البيع إلاّ للحاجة ، ولو ادّعاه على الوصيّ أو الأمين فالقول قوله في العقار وعليهما البيِّنة ; لأنّهما مدّعيان فكان عليهما البيِّنة ، وفي غير العقار الأولى ذلك أيضاً لهذا الدليل»(7) .
-
(1) تحرير الأحكام 2 : 542 .
(2) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
(3) تحرير الوسيلة 2 : 15 .
(4) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 303 ـ 304.
(5) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
(6) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
(7) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
وأفتى في القواعد بقبول قول الوصي أيضاً في البيع لكنّه على إشكال(1) .
نقول : إذا كان الوصيّ أو أمين الحاكم موثّقاً ، فالقول قوله ، والأقوى عدم الفرق بين الأب والجدّ وغيرهما في هذا الحكم ، والدليل عليه ما سنذكره دليلاً للحكم في الفرع الحادي عشر ، فانتظره .
الحادي عشر : جاء أيضاً في المبسوط : إن ادّعى «أي الوليّ» أنّه أنفق عليه أو على العقار قُبِلَ من الأب أو الجدّ بلا بيِّنة ، ولا يقبل من الوصيّ ولا الأمين إلاّ ببيّنة ، وقيل : إنّه يقبل منهما أيضاً بلا بيِّنة ; لأنّهما مأمونان وهو الأولى ; لأنّه يشقّ عليهما إقامة البيِّنة على الإنفاق ، ولا يشقّ على البيع، فلأجل ذلك قبل قولهما في هذا ولم يقبل في الأوّل»(2) أي في البيع .
وفي التذكرة : «كان القول قول الأب والجدّ للأب مع يمينه إلاّ أن يكون مع الابن بيِّنة ، وإن كان وصيّاً أو أميناً قُبِلَ قوله فيه مع اليمين ولا يكلّفان البيِّنة . . . لتعذّر إقامة البيِّنة على ذلك ـ إلى أن قال : ـ لأنّ الظاهر من حال العدل الصدق وهو أمين عليه ، فكان القول قوله مع اليمين ، ولو ادّعى خلاف ما تقتضيه العادة فهو زيادة على المعروف ويكون ضامناً . وكذا لو ادّعى تلف شيء من ماله في يده بغير تفريط، أو أنّ ظالماً قهره عليه وأخذه منه، قدّم قوله مع اليمين ; لأنّه أمين . أمّا لو ادّعى الإنفاق عليه منذ ثلاث سنين، فقال الصبيّ : ما مات أبي إلاّ منذ سنتين قدّم قول الصبيّ مع اليمين ; لأنّ الأصل حياة أبيه، واختلافهما في أمر ليس الوصي أميناً فيه ، فكان القول قول من يوافق قوله الأصل مع اليمين»(3) .
-
(1) قواعد الأحكام 2 : 136 ـ 137.
(2) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
(3) تذكرة الفقهاء 2 : 82 ، الطبعة الحجريّة .
واختاره في التحرير(1). وكذا في القواعد(2)، ولم يحكم بلزوم اليمين من الأب والجدّ لإثبات مدّعييهما، إلاّ أنّه قال في القواعد: بقبول قول غير الأب والجدّ على إشكال .
وقال المحقّق في باب الوكالة : «أمّا الوصيّ، فالقول قوله في الإنفاق ; لتعذّر البيِّنة فيه . . . وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده»(3) . واختاره في المسالك(4) وجامع المقاصد(5) ومفتاح الكرامة(6) والجواهر(7).
وفي تحرير الوسيلة: « لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبىّ أو على ماله . . . وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، وعلى الصبيّ البيّنة»(8) وكذا في تفصيل الشريعة(9) .
وبالجملة: فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يقبل قول الأب والجدّ والوصيّ وأمين الحاكم بشرط كونهما موثّقين في الإنفاق على الأيتام بالمعروف، وتلف شيء من أموال الصغار بغير تفريط وإن اختلفوا في قبوله مع اليمين أو بلا يمين ، وعند بعضهم يقبل قولهم في بيع مال اليتيم لمصلحته ، وهكذا في كلّ أمر يساعده ظاهر الحال.
-
(1) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
(2) قواعد الأحكام 2 : 136 ـ 137.
(3) شرائع الإسلام 2 : 205 .
(4) مسالك الأفهام 5 : 299 .
(5) جامع المقاصد 5: 194 وج 8 : 317.
(6) مفتاح الكرامة 5: 272 وج 7: 650.
(7) جواهر الكلام 27 : 433 .
(8) تحرير الوسيلة 2 : 16، كتاب الحجر، مسألة 16 .
(9) تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: 308 ـ 309.
ويدلّ عليه أوّلاً : أنّ الأولياء أُمناء بالنسبة إلى ذلك فيقبل قولهم ، أشار إليه في الجواهر وادّعى بأنّه لا خلاف فيه(1) .
وثانياً : لعسر إقامة البيِّنة على الإنفاق في كلّ وقت يحتاج إليه ، فيستلزم العسر والحرج(2)، كما صرّح به في المسالك(3) .
وثالثاً : بأنّ الأصل صحّة تصرّفات المسلم المالك لذلك التصرّف .
جاء في الإيضاح : «لا شكّ أنّ القول قوله في الإنفاق بالمعروف; لعسر إقامة البيّنة في كلّ وقت على الإنفاق وعسر ضبطه ، ولا في أنّ القول قوله في التلف من غير تفريط ، للأصل ; ولأنّه أقوى من الودعي ، ولا في أنّ القول قول الأب
في أنّ القرض أو البيع للمصلحة ; لأنّه غير متّهم في حقّ ابنه وعليه الإنفاق ، والإشكال في غيره، ومنشؤه أصالة صحّة تصرّفات المسلم المالك لذلك التصرّف ، ولأنّه موضوع لفعل ما يعتقد أنّه مصلحة ، فلا يمكن إقامة البيِّنة عليه ، ولأنّ دعواه بصلاح التصرّف دعوى عدم التعدّي، وهو الأصل والقول قوله فيه»(4) .
ويمكن أيضاً استئناس هذا الحكم ـ أي قبول قول الوليّ في البيع والإنفاق ـ من النصوص المتقدّمة ، حيث حكم فيها بجواز بيع الوليّ، كقوله(عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب : «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم . . .» الحديث(5) .
وقوله(عليه السلام) في معتبرة أو صحيحة محمد بن مسلم : «لا بأس به من أجل أنّ أباه
-
(1) جواهر الكلام 27 : 433 .
(2) (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ). سورة البقرة 2 : 185 ، (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج). سورة الحجّ 22 : 78 .
(3) مسالك الأفهام 5 : 299 .
(4) إيضاح النافع 2 : 54 .
(5) وسائل الشيعة 12 : 269 الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1 .
قد أذن له في ذلك وهو حيّ»(1) . وغيرها(2) .
وحكم بجواز الإنفاق على الأيتام من مالهم، كما هو مقتضى موثّقة سماعة ; لأنّه قال(عليه السلام) : «إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً»(3) .
وخبر أبي الصباح الكناني; لقوله(عليه السلام) : «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه»(4). وغيرها(5) .
وبالجملة : يستأنس من الحكم بجواز بيع أموال الأيتام والإنفاق عليهم من الجدّ والوصيّ صحّتهما وإن خالفهم الأيتام بعد بلوغهم بعدم المصلحة في البيع، أو عدم الإنفاق على المعروف .
بتعبير أوضح : الحكم بجواز البيع من الوصيّ قبل بلوغ اليتيم ، وإثبات صحّته وكونه عن مصلحة ، مع إقامة البيِّنة بعد بلوغه مع مخالفة اليتيم لا يجتمعان ، وكذا لايجتمع جواز الإنفاق عليهم، مع الحكم بلزوم إثبات كونه عن معروف إلى إقامة البيِّنة إن ادّعى اليتيم عدم كونه كذلك بعد بلوغه .
ويمكن أن يقرّر بأن يقال : حيث إنّ تصرّفات الوصيّ مشروطة برعاية المصلحة لليتيم ، بمعنى أنّ الشارع جعل الولاية له كذلك، فإذا لم يكن البيع لمصلحة اليتيم ، لم يصحّ شرعاً ولم يكن الوصيّ مجازاً لأن يوقعه .
على هذا ، النصوص المتقدّمة التي تدلّ على جواز البيع والإنفاق ، تدلّ
-
(1) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من أبواب أحكام الوصايا، ح1 .
(2) نفس المصدر 12 : 191 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به.
(3) نفس المصدر 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به ، ح2 .
(4) نفس المصدر ح1 .
(5) نفس المصدر 12 : 190 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
على الجواز مع رعاية المصلحة مطلقاً ; أي سواء خالف اليتيم بعد بلوغه أم لا ،
فإلزام الوليّ ـ الجدّ أو الوصيّ ـ بإقامة البيِّنة أو اليمين لإثبات كون البيع للمصلحة والإنفاق على وجه المعروف لا يساعد هذا الإطلاق .
والحاصل : أنّه يقبل قول الوليّ; سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً في البيع للمصلحة والإنفاق بالمعروف والقرض لهم ، وكذا في تلف شيء عندهم من دون أن يحتاجوا إلى إقامة البيِّنة . والأحوط أن يقبل قولهم مع اليمين، خصوصاً فيما صدر من الوصيّ ، فنحكم بقبول قوله مع اليمين وجوباً كما قال به كثير من الفقهاء(1) عند
اختلاف الوصيّ مع الصغير بعد بلوغه في أصل النفقة أو مقدارها ، أو بأنّ الإنفاق كان زائداً على المعروف .
نعم ، إذا خالفهم الأيتام بعد بلوغهم وأقاموا البيِّنة طبقاً لدعواهم فيقدّم قولهم ، من باب تقديم البيِّنة على الأصل ، ونذكر تفصيل ذلك في الباب الذي عقدناه للبحث عن دعاوى الأطفال إن شاء الله .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين الوصيّ وغيره .
قال في مفتاح الكرامة : «لا فرق بين الإنفاق والبيع للمصلحة والقرض
لها والتلف من غير تفريط ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين الوصيّ وغيره من
الأولياء»(2) .
-
(1) تذكرة الفقهاء 2 : 512، الطبعة الحجريّة ، جامع المقاصد 11 : 289 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 383 ، الدروس الشرعيّة 2 : 328 ، وسيلة النجاة 2 : 151 ، تحرير الوسيلة 2 : 102 مسألة 58 ، مهذّب الأحكام 22 : 226 ، والأصل في جميع هذه الصور قاعدة كلّ مدّع يسمع قوله فعليه اليمين ، والمراد من سماع قوله عدم تكليفه بالبيِّنة أو بحجّة أُخرى في الحكم له ، ويسمع قول الوصيّ في هذه المواضع مع يمينه ، وهذه القاعدة من قواعد باب القضاء; بمعنى أنّ الحاكم في مقام الحكم إذا سمع قول مدّع ولا يطلب منه البيّنة فلايحكم له إلاّ بعد اليمين .
(2) مفتاح الكرامة 7 : 650 .
آراء فقهاء أهل السنّة في اختلاف الوصيّ مع الصغير
اتّفق الفقهاء من أهل السنّة على أنّه إذا اختلف الوصيّ مع الصغير بعد بلوغه، فقال الوصيّ : أنفقت عليك ، وقال الصبيّ : لم تنفق عليَّ ، فالقول قول الوصيّ ; لأنّه أمين ، وتتعذّر عليه إقامة البيِّنة على النفقة(1). وكذا إذا اختلفا في قدر النفقة، فقال الوصيّ : أنفقت عليك في كلّ سنة مائة دينار ، وقال الصبيّ : بل أنفقت عليَّ خمسين
ديناراً ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إن كان ما يدّعيه الوصيّ هو النفقة بالمعروف فالقول قوله ; لأنّه أمين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان(2) .
وهكذا لو ادّعى الطفل بعد البلوغ والرشد أنّ الوصيّ خان في بيع ماله; بأنّه باعه من غير حاجة ولا غبطة فيصدّق الوصيّ .
قال الغزالي : «فالقول قول الوصيّ فإنّه أمين ، والأصل عدم الخيانة»(3). وكذا في حاشية ردّ المحتار(4) .
وإذا اختلفا في قدر مدّة الإنفاق ; بأن قال الوصيّ : مات أبوك من عشر سنين وأنفقت عليك فيها ، وقال الصبيّ : بل مات أبي من ثماني سنين وأنفقت عليَّ ثمان سنين ، يقدَّم قول الصبيّ ; لأنّ الأصل عدم موت الأب في الوقت الذي يدّعيه الوصيّ ، وأيضاً يمكن للوصيّ إقامة البيِّنة على ذلك بخلاف قدر النفقة(5) . وأمّا إذا
-
(1) المهذّب للشيرازي 1 : 464 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 437 ـ 438 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 282 ، منهاج الطالبين 2 : 379 ، روضة الطالبين 5 : 380 ، البيان 8 : 314 ، الكافي في فقه أحمد 2 : 293 ، الإقناع 2 : 228 ، كشّاف القناع 3 : 532 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 410 ، حاشية الدسوقي 4 : 456 ، المدوّنة الكبرى 6 : 25 ، تكملة البحر الرائق 9 : 328 ، أحكام الصغار : 361 .
(2) المنابع المتقدّمة كلّها، وكذا منتهى الإرادات 2 : 509 ، وعقد الجواهر الثمينة 3 : 433 .
(3) الوجيز 1 : 462 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 283 .
(4) حاشية ردّ المحتار 6 : 719 .
(5) المهذّب 1 : 462 ، البيان 8 : 314، كشّاف القناع 3 : 532 ، حاشية الدسوقي 4 : 456 وكثير من المصادر المتقدّمة .
اختلفا في دفع المال إلى الصبيّ بعد البلوغ والرشد، فادّعى الوصيّ أنّه دفع إليه ، وأنكر الصبيّ، فذهب الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّه صدّق الصبي بيمينه على الصحيح(1).
وأمّا الحنابلة، فإنّهم فصّلوا بين ما كان الوصيّ متبرّعاً، فيقبل قوله في دفع المال إلى الصبيّ بعد بلوغه ورشده ; لأنّه أمين أشبه المودّع ، وبين ما إذا لم يكن متبرّعاً بل باُجرة، فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه، بل يقدّم قول اليتيم(2) .
وقال الحنفيّة : إنّ القول قول الوصيّ إذا قال : دفعت إلى الصبيّ ماله بعد البلوغ والرشد(3) .
-
(1) المدوّنة الكبرى 6 : 25 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 433 ، حلية العلماء 6 : 149 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 283 ، مغني المحتاج 3 : 78 .
(2) الإقناع 2 : 229 ، كشّاف القناع 3 : 532 .
(3) حلية العلماء 6 : 149 ، بدائع الصنائع 4 : 352 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 410 ، البحر الرائق 9 : 327ـ 328 .
المبحث الثالث : المصالحة بمال الطفل
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يجوز للوليّ المصالحة(1) بمال الصبيّ إن يراها مصلحةً له .
قال الشيخ(رحمه الله):«متى كان لليتامى على إنسان مالٌ جازلوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال»(2) .
وفي الوسيلة : «إن كان لليتيم مالٌ على الغير ورأى له الغبطة في المصالحة عليه ، جاز له أن يصالح وكان الصلح ماضياً»(3) . واختاره في التذكرة(4) .
-
(1) المصالحة إسم من الصُلح بمعنى السِّلم، جاء في المعجم الوسيط : 520 صالحه مصالحة ، وصلاحاً : سالمه وصافاه، يقال: صالحه على الشيء، أي سلك معه مسلك المسالمة في الاتّفاق . وأمّا في الاصطلاح ، قال العلامة : « الصلح عقد سائغ شرّع لقطع التجاذب، إلاّ ما أحلّ حراماً، أو حرّم حلالا، كالصلح على استرقاق حرّ» قواعد الأحكام 2 : 172.
وكذا في الحدائق الناضرة 21 : 83 ـ 84 وزاد « الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أنّه لا يشترط في صحّة الصلح سبق نزاع». وكذا في جامع المقاصد 5 : 407.
وقال في الجواهر 26 : 211: « الصلح عقد شرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين، إلاّ أنّ ذلك فيه من الحكم التي لا يجب اطّرادها مثل المشقّة في حكمة القصر ونقصان القيمة في الردّ بالعيب . . . وغيرها من الحكم التي لا تقتضي تخصيصاً أو تقييداً; لعموم الدليل أو إطلاقه المقتضي ثبوت الحكم في غير محلّها .
وجاء في بعض كتب أهل السنة أنّ الصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين، كما في تبيين الحقائق 5 : 29 ، البحر الرائق 7 : 434 ، روضة الطالبين 3 : 482 ، نهاية المحتاج 4 : 382 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 447 ، كشّاف القناع 3 : 455 ، اُنظر الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 27 : 323 .
(2) النهاية للطوسي : 362 .
(3) الوسيلة لابن حمزة : 280 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 82 ، الطبعة الحجريّة.
وجاء في السرائر : «أمّا الوليّ، فجائز له مصالحة ذلك الغريم إذا رأى ذلك صلاحاً للأيتام; لأنّه ناظرٌ في مصلحتهم ، وهذا من ذاك إذا كان لهم فيه صلاحٌ.
فأمّا من عليه المال; فإنّ ذمّته لا تبرأ إن كان جاحداً مانعاً ، وبذل دون الحقّ وأنكر الحقّ، ثمّ صالحه الوليّ على ما أقرّ له به ، أو أقرّ بالجميع وصالحه على بعض، فلاتبرأ ذمّته من ذلك ، ولا يجوز للوليّ إسقاط شيء منه بحال ; لأنّ الوليّ لا يجوز له إسقاط
شيء من مال اليتيم ; لأنّه نصب لمصالحه واستيفاء حقوقه ، لا لإسقاطها ، فيحمل ما ورد من الأخبار، وما ذكره بعض أصحابنا، وأودعه كتابه على ما قلناه وحرّرناه أوّلاً ; من أنّه إذا رأى الصلاح الوليّ في مصالحة الغريم فيما فيه لليتيم الحظ، فجائز له ذلك ، ولا يجوز فيما عداه ممّا ليس له الحظّ فيه والصلاح»(1) .
قال العلاّمة : «هذا القول جيّد ، لكن كلام الشيخ لا ينافي ذلك ; فإنّه قال : يجوز للولي أن يصالح على شيء يراه صلاحاً ، وهو عين ما قاله ابن إدريس»(2) .
أدلّة جواز المصالحة بمال الطفل
يدلّ على هذا الحكم نصوص :
منها : إطلاق صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «الصلح جائز بين الناس»(3) .
ومنها : ما رواه الصدوق(رحمه الله) من أنّ «الصلح جائز بين المسلمين»(4) .
ومنها : رواية عبدالرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله(عليه السلام)
-
(1) السرائر 2 : 213 .
(2) مختلف الشيعة 5 : 67 .
(3 ـ 4) وسائل الشيعة 13 : 164 الباب 3 من أبواب الصلح ، ح1 و 2 .
قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام، فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه
وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان ، أيبرأ منه؟ قال : «نعم»(1) .
ومنها : خبر سهل، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف ، كيف تأمر فيه؟ قال : «أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته»(2) .
ودلالة الأخيرين على جواز المصالحة بمال اليتيم ظاهرة لا سترة عليها .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(3) قال : «المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»(4) .
تدلّ على أنّ الوليّ نصب لحفظ أموال الصبيّ ورعاية مصالحه ، والفرض أنّ المصالحة بماله في بعض الأحوال تكون من جملة مصالحه ، فكان جائزاً بمقتضى هذه الصحيحة ، وهو المطلوب .
عدم تبرئة ذمّة من عليه الحقّ
النصوص المتقدّمة كانت دليلاً لجواز المصالحة ، أمّا براءة ذمّة من عليه
الحقّ فلا دليل عليها ، ولقد أجاد العلاّمة في بيان ذلك، حيث قال في التحرير : «الوجه ما قاله ابن إدريس من أنّ الصلح جائز للوليّ مع المصلحة ، أمّا من عليه الحقّ، فلايجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتاً في ذمّته ، وليس للولي
-
(1 ، 2) نفس المصدر 13 : 167 الباب 6 من أبواب الصلح، ح1 و2 .
(3) سورة النساء 4 : 6 .
(4) وسائل الشيعة 12 : 184 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به، ح1 .
إسقاطه بحال»(1) .
وفي التذكرة : «الوجه أن يقول : إن كان ما في ذمّة الغريم أكثر وعلم بذلك لم تبرأ ذمّته; إذ لا مصلحة لليتيم في إسقاط ماله ، ولا تبرأ ذمّة الوصيّ أيضاً ، أمّا
إذا كان المدّعى عليه منكراً للمال ولا بيّنة عليه فصالح الوصي برأت ذمّته دون ذمّة من عليه المال .
ولو كان من عليه المال لا يعلم قدره فصالح على قدر لا يعلم ثبوته في ذمّته أو ثبوت ما هو ، أو أزيد أو أقلّ ، صحّ الصلح وبرأت ذمّته ، وينبغي له الاحتياط وتغليب الأكثر في ظنّه .
وللوصيّ أن يصالح من يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيِّنة، أو علم القاضي بدعواه ، وإلاّ لم يجز»(2) .
وفي الوسيلة(3) للسيّد الاصفهاني وتحريرها(4) : «لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال ، وليس للوليّ إسقاط بحال» .
وقال ابن الجنيد : «ولو كان الوصيّ المدّعي حقّاً لليتيم وله به بيّنة ، لم يكن له أن يصالح منه على بعض حقّ اليتيم ، ولو لم يكن له بيِّنة وبذل الخصم اليمين، جاز الصلح ، ومتى وجد الوصيّ أو اليتيم بيّنة بحقّه، انتقض الصلح ورجع على المدّعى عليه بحقّه، وكان مال الصلح مردوداً على المدّعى عليه، أو مقاصّاً به من الحقّ عليه».
-
(1) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 544 .
(2) تذكرة الفقهاء 2 : 85 ، الطبعة الحجريّة.
(3) وسيلة النجاة 2 : 101 .
(4) تحرير الوسيلة 2 : 15 مسألة 13 .
وعقّب عليه في المختلف : «وفي ذلك نظرٌ ; فإنّه لو جاز للصبيّ الرجوع لجاز للبالغ (للبائع خ ل) ; إذ صلح الوليّ ملزم كصلح الرجل ، على أنّه لا يخلو من قوّة»(1) .
ولعلّه لمراعاة المصلحة في مال اليتيم .
حكم المصالحة بمال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة
تجوز المصالحة بمال الصبيّ عندهم في الدعاوي، وصرّح بعضهم إن كان للمدّعي بيّنة يجوز ذلك، وبعض آخر لم يشترطه، فإليك نصّ كلماتهم:
ففي المبسوط : «إذا كان للصغير دار أو عبد، فادّعى رجلٌ فيه دعوىً ، فصالحه أبوه على شيء من مال الصبيّ ، ينظر في ذلك، فإن كان للمدّعي بيِّنة ، وكان ما أعطى الأب من مال الصبيّ مثل حقّ المدّعي أو أكثر ممّا يتغابن الناس فيه جاز ; لأنّ سبب الاستحقاق للمدّعي ظاهر شرعاً ، فالأب بهذا الصلح يصير كالمشتري لتلك العين لولده بماله ، والأب غير متّهم في حقّ ولده ، فعند ظهور الحقّ للمدّعي بالبيّنة إنّما يقصد النظر للصبيّ ، وربما يكون له في العين منفعة لا يحصل ذلك بقيمته ، وإن لم يكن له بيّنة لم يجز الصلح من الصبيّ ; لأنّ المدّعي ما استحقّ شيئاً على الصبيّ بمجرّد دعواه ».
ثمّ قال : «ووصيّ الأب في هذا بعد موت الأب كالأب، وكذلك الجدّ ووصيّ الجدّ»(2) . وبه قال الأستروشني(3) .
وفي الإنصاف في الفقه الحنبلي : « يصحّ الصلح عمّا ادّعى على مولاه ، وبه بيّنة
-
(1) مختلف الشيعة 6 : 182 ـ 183 مسألة 124 .
(2) المبسوط للسرخسي 20 : 178 .
(3) أحكام الصغار : 254 .
على الصحيح من المذهب »(1) .
وقال بعض آخر منهم بعدم جوازها إلاّ في حال الإنكار وعدم البيِّنة .
جاء في الشرح الكبير : ولا يصحّ الصلح ممّن لا يملك التبرّع كالمكاتب، والمأذون له، ووليّ اليتيم إلاّ في حال الإنكار وعدم البيِّنة ; لأنّه تبرّعٌ وليس لهم التبرّع ، فأمّا إذا لم يكن بالدين أو كان على الإنكار صحّ ; لأنّ استيفاءهم البعض عند العجز عن استيفاء الكلّ أولى من تركه»(2) .
وبه قال أيضاً الشافعيّة(3) والمالكيّة، فقد جاء في تبيين المسالك(4) : «وأمّا غير العقار فللولي التصرّف فيه بتجارة وغيرها حسب ما تقتضيه المصلحة ، وعليه
أن يؤدّي الحقوق التي على المحجور من نفقة وزكاة ونحوهما ، وله أن يصالح عنه لمصلحته ، أي المحجور . . . والأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى
قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)(5) .
قال ابن عربي : «لمّا أذن الله ـ تعالى ـ للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم، كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف للأيتام كما يتصرّف للأبناء»(6).
-
(1) الإنصاف 5 : 236 .
(2) الشرح الكبير 5: 4، المقنع: 121، المبدع في شرح المقنع 4 : 279 ، كشّاف القناع 3 : 457 ، الإقناع 2 : 193.
(3) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، المعاملات 3 : 157 .
(4) تبيين المسالك 3 : 530 .
(5) سورة البقرة 2 : 220 .
(6) أحكام القرآن 1 : 215 .
الفصل الثاني
في الاُمور التي هي من شؤون الاتّجار
منهج البحث :
بعدما جاز للوليّ الاتّجار والبيع والشراء والمصالحة بمال اليتيم، جاز له المضاربة والإبضاع والرهن والارتهان والقرض والاقتراض والإيداع والعارية والتوكيل وغيرها في أموال الصبيّ ; لأنّها من شؤون الاتّجار ; لبيان هذه الأحكام عقدنا هذا الفصل ، وقسّمناه إلى مباحث :
المبحث الأوّل : المضاربة والإبضاع بمال اليتيم .
المبحث الثاني : الرهن والارتهان والإقراض والاقتراض .
المبحث الثالث : الإيداع والعارية في مال الصبيّ .
المبحث الرابع : التوكيل والاستنابة في اُمور الصبيّ .
المبحث الأوّل : المضاربة والإبضاع بمال اليتيم
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للوليّ المضاربة(1) بمال الصبيّ .
قال في المبسوط : «لوليّ اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً إلى ثقة، فإن دفعه إلى غير الثقة فعليه الضمان»(2) .
وفي النهاية : «ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح كان بينهما على ما يتّفقان عليه ، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال»(3) .
وأورد عليه في السرائر : «إن كان هذا المعطي ناظراً في مال اليتيم نظراً شرعيّاً
-
(1) ضاربه مضاربةً لفلان في ماله ، اتّجر له فيه أو اتّجر فيه على أنّ له حصةً معيّنة من ربحه، المعجم الوسيط: 536 ، وفي لسان العرب 4 : 113 ; المضاربة أن تعطي إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على أن يكون له سهم معلوم من الربح ، وكأنّه من الضّرب في الأرض لطلب الرّزق ، قال الله تعالى: ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ) ( سورة المزّمّل 73 : 20 ) .
وأمّا في الاصطلاح، قال في التذكرة الطبع الحجريّة 2 : 229 : «القراض ـ أي المضاربة ـ عقد شرعيّ لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الربح». وقال الشهيد(قدس سره) في المسالك 4 : 343: « هي مفاعلة من الضرب في الأرض ; لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكأنّ الضرب مسببٌ عنهما طرداً لباب المفاعلة في طرفي الفاعل ، أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم ، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه، ويقال للعامل : مضارب ـ بكسر الراء ـ لأنّه الّذي يضرب في الأرض ويقلّبه ، ولم يشتقّ أهل اللغة لربّ المال من المضاربة اسماً . وهذه لغة أهل العراق .
وأمّا أهل الحجاز، فيسمّونه قراضاً إمّا من القرض; وهو القطع . . . فكأنّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعةً وسلّمها للعامل . . . أو من المقارضة; وهي المساواة والموازنة . . . ووجهه : أ نّ المال هنا من جهة مالكه والعمل من جهة العامل، فقد تساويا في قوام العقد بهما ، أو لاشتراكهما في الربح ونساويهما في أصل استحقاقه وإن اختلفا في كمّيته، ويقال منه للمالك : مقارض بالكسر، وللعامل : مقارض بالفتح ». وكذا في جواهر الكلام 26 : 336 والحدائق الناضرة 21 : 199 و200 .
(2) المبسوط للطوسي 3 : 199 .
(3) النهاية للطوسي : 430 .
إمّا أن يكون وصيّاً في ذلك أو وليّاً ، فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظّ فيه والصلاح ،
فعلى هذا لا يلزم الوليّ المعطي الخسران إن خسر المال ، وهذا هو الذي يقتضيه
المذهب ، ثمّ وجّهه ثانياً بقوله ، وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد(1) أورده إيراداً لا اعتقاداً، على ما كرّرنا ذلك»(2) .
وأجاب في المختلف عن ابن إدريس فقال : « وهذا القول ليس بجيّد ، لأنّ إعطاء القراض تغرير، فربما لزمه الضمان من هذه الحيثيّة » .
ووجّه كلام الشيخ بقوله : « ويحتمل أن يكون العامل قد فرّط في سفره وتعذّر تضمينه فيلزم الدافع ; لأنّه سبب »(3) .
وفي التذكرة : «وإذا اتّجر لهم ينبغي أن يتّجر في المواضع الأمينة ولا يدفعه إلاّ لأمين ولا يغرر بماله ـ إلى أن قال : ـ ويشترط في التاجر بمال اليتيم أن يكون وليّاً وأن يكون مليّاً ، فإن انتفى أحد الوصفين لم يجز له التجارة في ماله ، فإن اتّجر كان الضمان عليه والربح لليتيم وهو ضامن»(4) . ومثل هذا في التحرير(5) .
ووافقه في ذلك المحقّق الثاني(6) والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة(7) وكذا
في العروة مع التعليقات لعدّة من الفقهاء العظام(8)، وبه صرّح أيضاً
-
(1) المقصود من الخبر ما رواه بكر بن حبيب، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: «إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعةً فالّذي أعطى ضامن ». تهذيب الأحكام 7 : 190 ح842 ، وسائل الشيعة 13 : 189 الباب 10 من كتاب المضاربة ، ح1 .
(2) السرائر 2 : 411 .
(3) مختلف الشيعة 6 : 208 .
(4) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ـ 81 ، الطبعة الحجريّة.
(5) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
(6) جامع المقاصد 5 : 190 .
(7) مفتاح الكرامة 5 : 268 .
(8) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 264 .
في المستمسك(1) والمستند(2).
وقال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: «يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً ; أي عدم لزوم إيقاع
العقد وكفاية النيّة فقط . وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال »(3) .
وفي الوسيلة وتحريرها : «يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن»(4) .
وهكذا يجوز لوليّ اليتيم إبضاع(5) ماله .
قال العلاّمة : «ويجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله ; وهو دفعه إلى من يتّجر به والربح كلّه لليتيم ; لأنّ ذلك أنفع من المضاربة ; لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه، فدفعه إلى من يدفعه جميع ربحه إلى اليتيم أولى»(6) .
وفي جامع المقاصد : «وجواز ذلك منوط بالمصلحة ، ولا فرق بين أن يكون المتّجر بمال الطفل متبرّعاً أو بالاُجرة مع المصلحة»(7) .
-
(1) مستمسك العروة الوثقى 12: 446.
(2) مباني العروة الوثقى، المضاربة والشركة والمزارعة : 212 .
(3) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني 2 : 576 .
(4) وسيلة النجاة 2 : 101 ، تحرير الوسيلة 2 : 164 .
(5) البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة . الصحاح 2 : 192 ، لسان العرب 1 : 217 ، وفي المصباح المنير: 51، بالكسر قطعة من المال تعدّ للتجارة . وعرّفها الفقهاء بأنّه بعث المال مع من يتّجر به تبرّعاً والربح كلّه لربّ المال . المقنع لابن قدامة : 132 ، منتهى الإرادات 3 : 7 ، المغني والشرح الكبير 5 : 131، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 ، تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة.
(6) تذكرة الفقهاء 2 : 81 الطبعة الحجريّة ، قواعد الأحكام 2 : 136 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 .
(7) جامع المقاصد 5 : 191 .
والحاصل : أنّه يستفاد من كلماتهم حكمان : جواز المضاربة والإبضاع بمال الصغير ، وضمان الدافع إن دفعه إلى غير أمين .
أدلّة هذين الحكمين
وأمّا دليل جواز المضاربة والإبضاع بمال اليتيم، فالعمدة ما يثبت به عموم ولاية الأولياء، ولكن فيما إذا كان ذلك مصلحة للصبيّ(1).مضافاً إلى أ نّه يمكن إثبات
الحكمين في المقام مستنداً إلى بعض النصوص الواردة خاصّة :
1 ـ كمعتبرة أبي الربيع قال : سُئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به؟ قال : «نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما» . قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : «لا ، إذا كان ناظراً له»(2) .
2 ـ وخبر بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : «إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن»(3) .
3 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بوُلده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : «لا بأس به ، من أجل أنّ أباه قد أذِن له في ذلك وهو حيّ»(4) .
4 ـ خبر خالد بن بكير الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال : يا بُنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي
-
(1) مستمسك العروة الوثقى 12 : 446 ، مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة : 212 .
(2) وسائل الشيعة 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح6 .
(3) نفس المصدر 13 : 189 الباب 10 من كتاب المضاربة، ح1 .
(4) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا، ح1 .
ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا
حرّكته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى؟ فقال : «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّوجلّ فليس عليك ضمان»(1) .
ودلالتها على جواز المضاربة بمال اليتيم صريحة ، ويستفاد منها جواز الإبضاع بالأولويّة القطعيّة .
5 ـ وصحيحة ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : في رجل عنده مال اليتيم، فقال : «إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن»(2) .
6 ـ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في مال اليتيم ، قال : «العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال». أو قال : «إن عطب أدّاه»(3) .
7 ـ صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه أو يتّجر فيه؟ قال: «إن فعل فهو ضامن»(4).
8 ـ صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا ، إلاّ أن يتّجر به أو تعمل به»(5) .
9 ـ خبر سعيد السمّـان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي
-
(1) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا، ح2 .
(2 ، 3) وسائل الشيعة 12 : 191 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، ح2 و 3 .
(4) نفس المصدر 13 : 418 الباب 36 من كتاب الوصايا، ح5 .
(5) نفس المصدر 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح1.
يتّجر به»(1) .
وكذا غيرها من النصوص المستفيضة(2) .
ودلالتها على جواز الإبضاع وكذا ضمان الوليّ إن دفع المال إلى غير الأمين واضحة ، وتدلّ على جواز المضاربة بالإطلاق .
المضاربة والإبضاع بمال الصبيّ عند أهل السنّة
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في جواز المضاربة والإبضاع بمال الصبيّ .
ففي المبسوط في فقه الحنفي : «الوصيّ يعطي مال اليتيم مضاربة وإن شاء أبضعه ، لقوله ـ تعالى ـ : (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)(3) والأصلح في حقّه أن يتّجر بماله ، والأنفع لليتيم أن يدفعه إليه بضاعةً»(4) .
وفي موضع آخر : «ويجوز للوصي أن يعمل في مال الصبيّ مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة»(5) .
وبه قال الأستروشني(6) وقاضيخان(7) .
وجاء في المغني لابن قدامة من فقهاء الحنبلي : «إنّ لوليّ اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به ، ويجعل له نصيباً من الربح أباً كان أو وصيّاً
-
(1) نفس المصدر ح2 .
(2) نفس المصدر 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح1 و5 و10 والباب 2 من هذه الأبواب ص57 ، ح3 و4 و5 و7 و8 .
(3) سورة البقرة 2 : 220 .
(4) المبسوط للسرخسي 22 : 20 .
(5) نفس المصدر 21 : 99 .
(6) أحكام الصغار : 192 .
(7) فتاوى قاضيخان، المطبوع في هامش الفتاوى الهنديّة 2 : 288 .
أو حاكماً أو أمين حاكم ، وهو أولى من تركه . . ».
واستند في هذا «لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ألا من ولّي يتيماً له مال فليتّجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة»(1) (2).
وكذا في الشرح الكبير(3) والكافي(4) ، وقال أيضاً : «يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله ، ومعناه دفعه إلى من يتّجر به والربح كلّه لليتيم . . . لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفّر الربح أولى»(5) .
وبه قال البهوتي(6) وبعض آخر(7) . وقال الرافعي : «إنّ القراض توكيل ، فكما يجوز لوليّ الطفل التوكيل في أُمور الطفل ، كذلك يجوز لوليّ الطفل والمجنون أن يقارض على مالهما يستوي فيه الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمينه»(8).
وبه قال النووي(9) والخطيب الشروبيني(10) .
وفي الحاوي الكبير : «يجوز لوليّ اليتيم أن يتّجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه; وهو قول عامّة الفقهاء ـ إلى أن قال : ـ لأنّ الوليّ يقوم في مال اليتيم مقام البالغ
الرشيد في مال نفسه ، فلمّا كان من أفعال الرشيد أن يتّجر بماله، كان الوليّ في مال
-
(1) سنن الترمذي 3: 32 ح640، السنن الكبرى للبيهقي 5: 524 ح7433.
(2) المغني 4 : 293 .
(3) الشرح الكبير 4 : 520 .
(4) الكافي 2 : 108 ، المقنع : 126 .
(5) المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 521 .
(6) كشف القناع 3 : 523 .
(7) المبدع في شرح المقنع 4 : 338 ، الإقناع 2 : 224 ، الإنصاف 5 : 327 ، المحرّر 1 : 347 ، الفروع 4 : 243 .
(8) العزيز شرح الوجيز 6 : 18 .
(9) روضة الطالبين 4 : 295 .
(10) مغني المحتاج 2 : 314 .
اليتيم مندوباً إلى أن يتّجر بماله ، ولأنّ الوليّ مندوب إلى أن يثمر ماله من يلي عليه ،
والتجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال، فكان الوليّ بها أولى»(1) .
وقال به أيضاً فقهاء المالكي، كما صرّح بذلك في التاج والإكليل في حاشية مواهب الجليل(2) والشرح الصغير للدردير(3) .
فرع :
قال في القواعد : «وهل للوصيّ أن يتّجر لنفسه مضاربةً؟ فيه إشكال ينشأ من أنّ له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أنّ الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقّ عليه إلاّ بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الوليّ المضاربة مع نفسه»(4) .
وفي التحرير : «فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة وتكون له اُجرة المثل»(5) (6) .
وبه قال بعض أهل السنّة أيضاً(7) .
ولقد أجاد المحقّق الثاني في بيانه والجواب عنه في شرحه على القواعد ، حيث قال : «إنّ جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة ، وإنّما جاز لكونه منوطاً بنظره ، فإذا كان بيده كان أدخل في الحفظ وأقرب إلى مقتضى الوصيّة، فيكون جوازه
-
(1) الحاوي الكبير 6 : 443 و 444 .
(2) مواهب الجليل 2 : 539 .
(3) بلغة السالك على الشرح الصغير 3 : 393 .
(4) قواعد الأحكام 2 : 136 .
(5) وسيأتي أنّ المشهور ذهبوا إلى جواز اقتراض الوليّ من مال اليتيم، فيمكن أن يقال:إذا كان الإقتراض جايزاً فالاتّجار لنفسه جايز قطعاً، فتدبّر. وأيضاً يستفاد الجواز ممّا ورد في بعض النصوص الآتية; من أنّه إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، كما صرّح به في خبر منصور الصيقل، فانتظر.م ج ف.
(6) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 .
(7) المغني لابن قدامة 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 520 ، الكافي 2 : 108 ، المقنع : 126 .
بطريق أولى .
ويرد عليه : أنّه لابدّ في الجواز من تناول الإذن له ، والمتبادر من الإذن في عقد المضاربة الدفع إلى آخر .
ويجاب : بأنّ الوصيّة إليه إسناد التصرّف إلى رأيه ، وهو يعمّ ذلك .
وتوضيح الوجه الثاني: أنّ الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه(1) ، فلا يخرج عنه ولا يستحقّ عليه الآخر إلاّ بعقد يقتضيه ، ولا يعقد الوليّ لنفسه، إمّا لأنّ العقد يقتضي متعاقدين، أو لأنّه لابدّ من الإذن في ذلك .
ويجاب عن الأوّل : بأنّ المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوّة وتغايرهما بالاعتبار ، وعن الثاني: بما قدّمناه من أنّ إسناد التصرّف بالوصيّة يتناول كلّ تصرّف بالمصلحة (2) .
-
(1) ربما ينتفض هذا الأصل بما ورد من أنّ الزرع للزارع وإن كان غاصباً، فإنّ الزرع من نماء الأرض مع أنّه ليس لمالك الأرض، وأيضاً ينتقض بالنماء المستوفاة على القول بعدم ضمان الغاصب، فافهم. م ج ف.
(2) جامع المقاصد 5 : 190 ـ 191 .