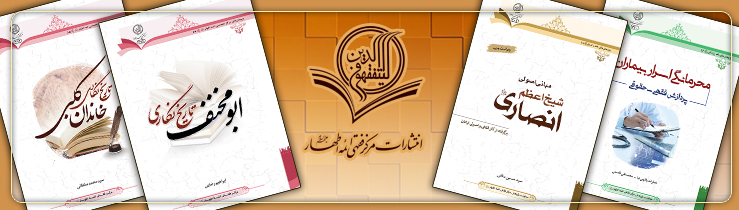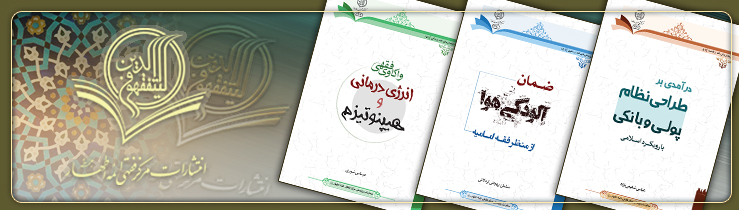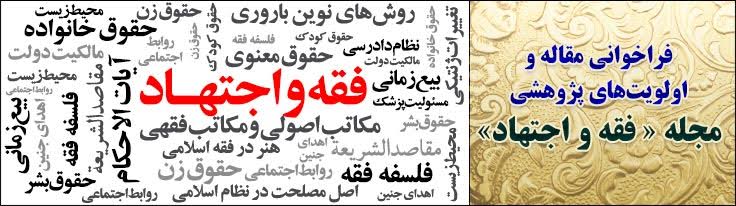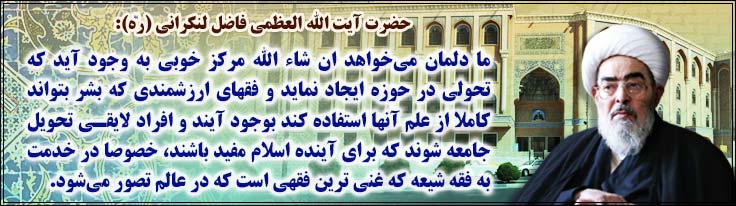لايؤكل لحمه هل يوجب تحريم الصلاة فيه تكليفاً حتّى يكون إيقاعها فيه محرّماً شرعيّاً و فيما يؤكل حلالا كذلك، فحينئذ يصحّ التمسّك بأصالة الحلّية في موارد الشكّ بالتقريب الّذي قدّمناه و لكن ما يقتضيه التأمّل التام و الدقّة في المقام، أنّ النواهي المتعلّقة بالعبادات و المعاملات كلّها إرشادية إلى عدم ترتّب الأثر المتوقّع على المنهيّ عنه و عدم انطباق العنوان المطلوب على المأتي به مع وجود النهيّ عنه، و ليست تكليفية حتّى يستفاد منها الحرمة و المبغوضيّة شرعاً كما لو صلّى في ثوب نجس، فإنّ الصلاة فيه ليست محرّمة تكليفاً بل حرام وضعاً بمعنى عدم صحّة الصلاة فيه و عدم ترتّب الأثر الشرعي عليه.
و بالجملة، لا يستفاد من النواهي في العبادات و المعاملات الحرمة التكليفية، بل الظاهر منها الإرشاد إلى أنّ الأثر المتوقّع من العبادة و المعاملة الّتي أوقعها المكلّف مترقّباً لحصول الأثر المطلوب منها لايترتّب عليها إذا اشتملت على المنهي عنه فلا محلّ لأصالة الحلّية في تلك الموارد.
نهاية الكلام في تصحيح الاستدلال في المقام
غاية ما يمكن أن يقال تأييداً للمستدلّ و تشييداً لمبناه في صحّة الاستدلال بأصالة الحلّية فيما نحن فيه من صحّة الصلاة في اللباس المشكوك و عدمها، أنّ الظاهر كما أسلفناه من تتّبع موارد استعمالات
لفظ الحرمة و الحرام و الحريم و الحرم والمحرم و سائر المشتقّات من مادّة (ح ر م) الممنوعية و المحدودية و عدم كونه مطلقاً في كلّ حال و مقام، و يقابله الحلال و الحلّية و المحلّ و الحلّ و سائر المشتقّات من مادة (ح ل ل)، فمعنى الحرام جامع للحرمة التكليفيّة و الوضعيّة كالحلال و قد استعمل في القدر المشترك بينها في كثير من الموارد في الأخبار و الأشعار كالشهر الحرام و البلد الحرام و البيت الحرام و الحرم و الحريم، بلحاظ أنّ الأفراد ليسوا منطلقين في تلك الموارد و المواقع كما في غيرها بل هم فيها موظّفون بسلسلة من الاُمور و ممنوعون عن بعض الأقوال و الأفعال الّتي لم تكن ممنوعة في غيرها.
يقال: حريم السلطان و حريم الدار لأجل أنّ من ليس من أهله و حواشيه و أذنابه و أقماره، ممنوع عن الورود عليه و الوقوف لديه و أنّه ليس مكاناً مطلقاً و محلا محرّراً لكلّ فرد و شخص و وارد و خارج بل هو مكان محدود يحرم عنه غير أهله، و هذه الاستعمالات تشهد أنّ لفظ الحرام استعمل في القدر المشترك بين الحرمة التكليفية الّتي يترتّب عليه العقاب و الحرمة الوضعية الّتي يرشد إلى عدم ترتّب الأثر المقصود على المنهي عنه و إلى أنّ المكلّف ممنوع عن إيقاع المأمور به فيه وضعاً لا تكليفاً.
أمّا المبغوضيّة في متعلّق الحرام و النهي ليست داخلة في ما وضع له اللفظ و استعمل فيه، بل معناه مطلق الممنوعيّة و المحروميّة و هو القدر المشترك بين المعنيين والجامع بينهما الّذي استعمل فيه لفظ
الحرام فيكون حقيقة فيه ومجازاً في غيره.
و بهذا يتمّ الاستدلال بالموثّقة و يقال: إنّ الصلاة في بعض الشيء منهي و محروم، أي ممنوع وقوع الصلاة فيه و بعضه ليس بحرام أي مطلق و غيرممنوع، فإذا شكّ في مورد أنّه حلال أو حرام يتمسّك بقوله(عليه السلام) كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
لايقال: إنّ لفظي الحلال و الحرام و إن استعملا في القدر الجامع بين التكليفي و الوضعي إلاّ أنّ الظاهر المتبادر إلى الذهن منهما، هو التكليفي لا الوضعي، فلابدّ من الحمل على الظاهر و الأخذ به، حتّى يصرف عنه بقرينة صارفة و دليل خارج.
فإنّه يقال: قد أشرنا إلى موارد الاستعمالات من أنّ المعنى الحقيقي للحرام، الممنوعيّة المحروميّة و أمّا المبغوضيّة و غيرها من الخصوصيات ليست داخلة فيما وضع له اللفظ في مصطلح العرب و أهل اللغة و في القران الكريم (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَـفِرِينَ ) أي منعهم الله عنها وفي الحديث أنّ الله حرّم لبسه والصلاة فيه أي منع عنهما و في قولنا يحرم شرب الخمر أي ممنوع شربه و فيه، المسلم للمسلم محرّم، يعنى ينبغى أن يكون المسلم بالنسبة إلى أخيه المسلم ممنوعاً عن التعرّض له و إيذائه بلسانه و يده، في جميع شئونه و اُموره.
و قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ )، لم يستعمل إلاّ في القدر الجامع و هو المنع و الحرمان، إذا المعنى أنّ الشخص ممنوع عن
المعاملة الربوية و لايترتّب عليها الأثر المتوقّع من التبادل و النقل و الانتقال دون البيع، فإنّه حلال و مطلق و ليس الشخص ممنوعاً عنه و يترتّب عليه الأثر المعاملي، التمليكي و التملّكي.
و يقال: حلّ من السجن أي نجا منه و خلص، و الحلّ هو المكان الّذي ليس الشخص محدوداً فيه و ممنوعاً عن الصيد و قطع الأشجار و غيره و يقابله الحرم لحرمان الشخص فيه عن بعض ما يفعله خارج الحرم، و يقال مرزوق في قبال المحروم و يطلق الشهر الحرام لبعض الشهور لمنع القتال فيه حتّى في الجاهلية.
و بالجملة، التتّبع في موارد استعمالات مادّة (ح ر م) في شتّى الهيئات و الصيغ، يشهد أنّ معنى هذه المادّة المحرومية و الممنوعيّة، و هو القدر الجامع في جميع موارد الاستعمالات.
هذا نهاية المقال و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال، و من اهتّم غاية الاهتمام و جدّ و اجتهد و أرعد و أبرق يمكن له أن يفتى بجواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه من مأكول اللحم تمسّكاً بقاعدة الحلّية، و أمّا سائر الوجوه الّتي استدلّ بها فى المقام فهي غير تامّ و لاتخلو من النقض و الإبرام، و عمدتها الاستصحاب وقد أشبعنا الكلام فيه في أدلّة المجوّزين و المقصود هنا نقل كلام الفقيه الهمداني(قدس سره)(1).
- 1 . هو الحاج آقا رضا ابن الفقيه محمّد هادي الهمداني من مفاخر الشيعة توفّى 1322، وله كتاب مصباح الفقية في الصلاة و الطهارة و الخمس و الزكاة و غيرها.
قال في كتاب الصلاة: لواستفيد من أخبار المنع أنّ المعتبر في الصلاة هو أن لايستصحب المصلّي وقت ما يصلّي شيئاً ممّا لايؤكلّ لحمه، بحيث يكون عدم الاستصحاب صفة معتبرة في المصلّي أمكن إحرازه بالأصل فإنّ المصلّى قبل تلبّسه بالمشكوك لم يكن مستصحباً لغير المأكول، فيستصحب حالته السابقة الّتي أثرها جواز الدخول في الصلاة كما أنّه لو استفيد من الأدلّة اعتبار صفة في لباس المصلّي بأن يكون مفادها أنّه يشترط فيما يلبسه المصلّي أن لايكون من غير المأكول و لامصاحباً لغير المأكول جرى الأصل بالنسبة إلى ما على الثوب من الشعرات الملقّاة أو الرطوبات المشتبهة لا بالنسبة إلى أصله لو كان من حيث هو مشتبه الحال.
لكنّك خبير بأنّ المتبادر من الأدلّة إنّما هو اعتباره في الصلاة، فإنّ المتبادر من المنع عن الصلاة في غير المأكول هو المنع عن إيقاع الصلاة فيه لا عن استصحابه حال الصلاة أو عن مصاحبته للباس، فهو بمقتضى ظواهر الأدلّة من قيود نفس الصلاة لا المصلّي أو لباسه كي يمكن إحرازه بالأصل في صورة الشكّ، و لا أقلّ من إجمال الأدّلة و عدم ظهورها في كونه قيداً للمصلّي أو لباسه حتّى يدّعى إمكان إحرازه بالأصل، و مجرّد احتماله غيرمجد في مقام الإطاعة كما هو واضح. هذا و لكن يتوجّه على ما ذكر أنّه مبني على اعتبار عدم استصحاب غير المأكول قيداً، إمّا للصلاة أو للمصلّي أو ما يصلّي فيه و هو عبارة اُخرى عن الاشتراط، فهذاالتفصيل إنّما يتوجّه على تقدير
استفادة الشرطية من الأخبار الناهية عن الصلاة في غيرالمأكول.
و أمّا إن قلنا: بأنّ مفادها ليس إلاّ مانعيّة لبس غير المأكول أو مطلق التلبّس به عن صحّة الصلاة، فلا مجال لهذا الكلام فإنّ عدم استصحاب غير المأكول على هذا التقدير لم يؤخذ قيداً في شيء من المذكورات إذ لا أثر لعدم المانع من حيث هو، فإنّ المانع ما كان وجوده مؤثّراً في البطلان لا عدمه دخيلا في الصحّة فتسمية عدم المانع شرطاً مسامحة; كيف و قد جعلوه قسيماً للشرط، إلى أن قال: فالمعتبر في صحّة الصلاة هو أن لايوجد المانع عنها حين فعلها، فعدم وجود المانع حال فعل الصلاة هو المعتبر في صحّتها و هو موافق للأصل لا أنّ اتصافها بوجوده مانع كي يقال: إنّ هذا ممّا ليس له حالة سابقة حتّى يستصحب، و إنّ استصحاب عدم وجود ما يمنع عن فعل الصلاة أو عدم استصحاب المصلّي لما لايؤكلّ لحمه غيرمجد في إثباته لعدم الاعتداد بالاُصول المثبتة، انتهى كلامه.
و حاصل ما ذكره(قدس سره)، أنّ عدم لبس غيرالماكول لايكون شرطاً للمصلّي و اللباس و الصلاة حتّى لايجري الاستصحاب، فإنّ العدم بما هو عدم لايعتبر وصفاً و شرطاً لشيء، بداهة أنّ الشرط ما يؤثّر وجوده في تحقّق المشروط و العدم بما هو لاتأثير له في تحقّقه، بل المستفاد من أخبار الباب أنّ وجود أجزاء غير المأكول مانع عن انطباق العنوان المطلوب على الأجزاء و مخرّب له، لا أنّ عدمه وصف و شرط فإذا تحقّقت الأجزاء مع الشرائط المعتبرة فيها الّتي هى بمنزلة
المقتضي و شكّ في وجود المانع يحكم بعدمه و يتحقّق تأثير المقتضي و لايعتني بالشكّ و هذا بناء العقلاء في تمام اُمورهم و شئونهم كما صرّح به في كلامه و قال و لو أمعنت النظر فيما بيّناه وجهاً لحجّية الاستصحاب عند التكلّم في الشكّ في وجود الحاجب في باب الوضوء في مسألة من توضّأ و كان بيده خاتم و كذا لو تأمّلت فيما حقّقناه في آخر كتاب الطهارة عند البحث عن جريان أصالة عدم التذكية في الجلد المشكوك كونه من الميتة، لحصل لك مزيد إذعان و زيادة بصيرة في تنقيح مجارى الاُصول قال الاُستاذ: بعد ما راجعت كلام الفقيه الهمداني(قدس سره) هناك و في الحاشية على الفرائد، وجدت أنّ أخبار الاستصحاب بناء على مذهبه، كلّها إمضاء لحكم العقلاء و بنائهم في اُمورهم و معايشهم و معاملاتهم و عباداتهم و ليست مؤسّسة، فإنّ المعهود و المشاهد منهم أنّ كلّ شيء يكون موضوعاً لحكم و منشأ لترتّب أثر من الآثار عليه يرتّبون الآثار عليه و إذا شكّ في وجود ما يمنع عن تلك الآثار أو يخلّ بها و يزاحمها يبنون على عدم المشكوك و يرتّبون الأثر ولا يعتنون بالشكّ مثلا لو وهب واهب و أرسل الموهوب بواسطة غلام له، فإنّهم لو شكّوا في موت الواهب قبل قبض الهبة و عدمه، يبنون على عدم الموت و يرتّبون أثر الهبة على الموهوب و يتصرّفون فيه من دون التقات إلى إمكان موت الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة.
و هكذا الكلام في العارية إذا شكّ في موت المعير قبل قبض
العارية فإنّ المستعير لايعتني باحتمال موت المعير، و كذا من كان وكيلا عن الغير و قائماً مقامه في تجارته و القيام بالوظائف الّتي كانت عليه، إذا شكّ في موت موكّله، لاينعزل عن عمله، بل لم يعهد عن عاقل رفع اليد عن شيء بمجرّد احتمال الموت، بل لايعملون بالظّن في ذلك، ما لم يكن من طريق عقلائي، بل بنائهم عند الشكّ على عدم الموت في تلك الموارد على حدّ لو لم يعلم بأنّ الموت بوجوده الواقعي مانع عن الأثر و أنّ العلم طريق إليه لحكموا بموضوعيّة العلم و أنّ المانع يجب أن يكون متعلّقاً له و معلوماً عند الشخص حتّى يرفع اليد عن العمل الّذي كان يعمله قبل الشكّ و تفصيل كلامه على ما بيّنه في كتاب الطهارة، أنّ العقلاء بأسرهم استقرّت طريقتهم على ترك الاعتناء باحتمال وجود ما لوجوده أثر في رفع اليد عمّا كانوا عليه في أمر دنياهم و دينهم و معاشهم و معادهم، و لأجل هذا الأمر المغروس في أذهانهم لايعتنون باحتمال وجود الموانع فيه (أي احتمال وجود الحاجب). و كذا لايعتنون باحتمال وجود القرينة في رفع اليد عمّا يقتضيه ظاهر القول، لا أنّ للمتشرّعة في خصوص ما نحن فيه، و للعقلاء في خصوص مباحث الألفاظ قاعدة يعتدّ به، واصلة إليهم من أسلافهم كما يشهد به صريح الوجدان، و بالجملة إذا راجعت أهل العرف و تتبّعت في طريقة العقلاء لوجدتهم لايعتنون باحتمال وجود ما يقتضي خلاف ما بأيديهم من العمل الّذي يعملونه بمقتضى أغراضهم العقلائية و يزعمون أنّ الإعتناء بالشكّ في ترك ما بأيديهم
من العمل نقض لليقين بالمحتمل، ألاترى أنّ من قلّد مجتهداً لايرفع اليد عن تقليده بمجرّد احتمال موت المجتهد وكذا أرباب الملل لايعتنون بنسخ دينهم إذا شكّوا فيه و لم يعلموا بذلك، و أنّ العبد المأمور بإتيان عمل مدّة حياة مولاه ليس له رفع اليد عن العمل باحتمال موت المولى و لو أنّهم سئلوا عن علّة بقائهم على ما كانوا عليه يعلّلون ذلك بعدم ثبوت الخلاف.
و ما يتوهّم من أنّ عمل العقلاء بالاستصحاب لأجل إفادته الظّن بالبقاء مدفوع بأنّا نجد من أنفسنا أنّ علة البقاء أوّلا ليس إلاّ عدم الاعتماد و الاعتناء بالشكّ في وجود المانع و المزيل و ثانياً نرى العقلاء يعلّلون بقائهم على ما كانوا عليه بعدم ثبوت الخلاف و ثالثاً أنّ العمل بالظنّ عند العقلاء من المنكرات في حدّ ذاته و بما هو، كما يفصح عنه الآيات الناهية عن اتّباع الظّن.
أمّا ماترى من أنّهم يعملون بظواهر الألفاظ و قول الثقة و غيرها من الأمارات الّتي لاتفيد إلاّ الظّن فوجهه أيضاً ليس إلاّ عدم الاعتناء باحتمال وجود قرينة المجاز و كذب الثقة و ما يصرفهم عن الظواهر الّتي هي بمنزلة المقتضي، و الحاصل أنّ أخبار الاستصحاب على مبناه(قدس سره) كلّها تنزيل على طريقة العقلاء في اُمورهم الدنيوية و الاُخروية و جميع شئونهم، و أنّهم بعد إثبات المقتضي لشيء و أمر ذي أثر لايعتنون بالشكّ في وجود المانع.
والظاهر من كلماته أنّ أصالة العدم إنّما يجري فيما إذا أحرز
المقتضي و شكّ في وجود المانع والرافع و أمّا لو شكّ في مانعية الموجود و رافعيته فلاتجري فيه.
إلى هنا انتهى كلام سيّدنا الاُستاذ مدّظلّه في المسألة و تعطّلت الدروس بمناسبة التعطيلات الصيفيّة، ثمّ أنّه مدّظلّه بعد شروع البحث أطال الكلام حول الاستصحاب و كلام صاحب المصباح و نقل كلام الشيخ و الآخوند(رحمهما الله) و لكن عصارة ما أفاد و مخّ ما أفاض في المسألة ما شرحت و أوضحت، هذا آخر ما أردنا ضبطه في هذه الرسالة من بحوث الاُستاذ وقع الفراغ من تبييضها في أوائل أربعمأة وألف من الهجرة النبويّة; طبعت لأوّل مرّة في تلك السنة و أرجو من الله تعالى أن يوفّقني لاستخراج سائر أبحاثه و نشرها و أنا العبد أحمد الصابري الهمداني 1427 هـ ق.
آثار المؤلّف
و للمؤلّف آثار علميّة و أدبيّة مطبوعة و مخطوطة:
ـ الهداية إلى من له الولاية في ولاية الفقيه، تقرير بحث الفقيه الكبير آية الله العظمى الحاج السيّد محمّدرضا الگلپايگانى فرغ من تأليفه 1373 و طبع في سنة 1383 لأوّل مرّة و جدّد الطبع مع مقدّمة مهمّة.
ـ محمّد و زمامداران حول كتب النبي(صلى الله عليه وآله ) إلى زعماء عصره، فارسي; طبع خمس مرّات بإيران، و هو كتاب سياسي إبتكاري.
ـ أدب الحسين و حماسته، حول كلمات الإمام الحسين بن علي(عليه السلام) من الخطب و الاحتجاجات والأشعار المنسوبة إليه و كلّ ما يرتبط بقيامه(عليه السلام)، عربي، طبع مرّات.
ـ مقدّمة حول قصيدة برده و شاعرها; طبع في مقدّمة القصيدة.
ـ حياة مدّرس المازندراني و عدّة من علماء طبرستان، فارسى، طبع.
ـ از فيضيه 42 تا فيضيه 57، فارسي، طبع بإيران حول قيام الروحانية و حادثة فيضية في 1342 في ايران، طبع مرّات عديدة.
ـ روزه در اسلام، طبع في تركيا، بلاتين.
ـ راه روشن در اسلام، راه اهل بيت، تركي، طبع بلاتين في تركيا و كريل الروسي فى باكو.
ـ شخصيت امام صادق(عليه السلام) در اسلام و مذهب و سخنان آن حضرت، طبع مرّات في باكو و استانبول.
ـ حادثه بزرگ در اسلام (روز عاشورا)، طبع بلاتين و كريل.
ـ الطريق المسلوك في حكم اللباس المشكوك، كتاب حاضر.
ـ كتاب الحجّ، تقرير بحث الاُستاذ الزعيم الديني الحاج السيّد محمّدرضا الگلپايگاني، ثلاث مجلّدات، طبع مجلّدان.
ـ نخبة الإشارات في أحكام الخيارات، تقرير بحث الاُستاذ الفقيه الگلپايگاني، مخطوط.
ـ حياة بلال، مخطوط.
ـ نصائح الآباء للأبناء، كتاب ظريف عربي.
ـ تاريخ همدان حول آثاره العلمي و الأدبي، ثلث مجلّدات، طبع مرّتين.
ـ طوبى الأخبار، في الآثار المصدّرة بلفظة طوبى.
ـ سازندگى هاى اخلاقى امام حسين(عليه السلام)، في كلمات قصار أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)، طبع مرّتين.
ـ مسند الإمام الحسين فيما ينتهى إلى الحسين(عليه السلام)، من الكلمات و المرويّات مخطوطة.
ـ حياة القاضى عبدالجبّار المعتزلي أسدآبادي الهمداني، مطبوع.
ـ جواهر الأخبار في محاسن الآثار.
ـ أحسن الأقوال في أحبّ الأعمال.
ـ امامت و خلافت در اسلام، طبع في باكو.
ـ ولايت فقيه و نقش خبرگان. فارسى، طبع.
ـ ترجمه كتاب السبعين، تأليف ميرسيّد علي عارف الهمداني في مناقب أميرالمؤمنين(عليه السلام).
ـ مسيحيت كنونى.
ـ سلاحى كه هرگز نمى پوسد، نقش تخريبى اختلاف و تفرقه.
ـ مسند الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)، مخطوط.
ـ المهدي على لسان الحسين(عليه السلام)، مطبوع. طبع بالعربى و ترجم باُردو.