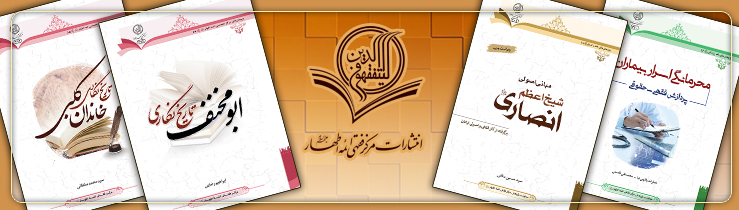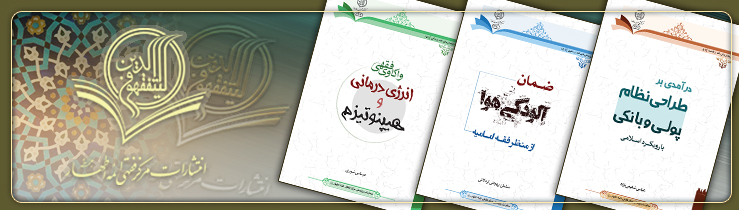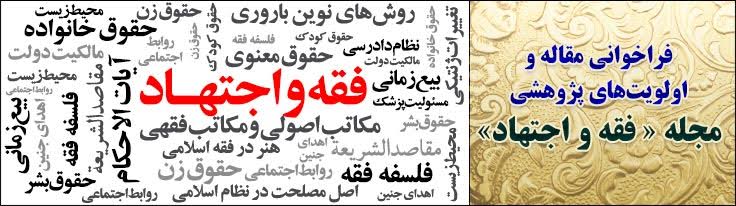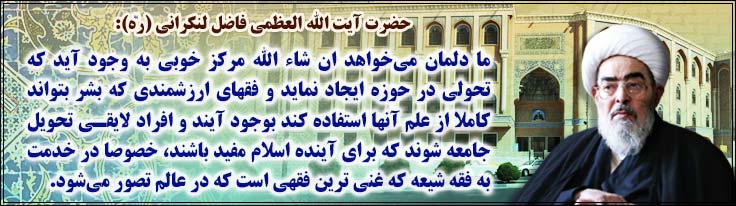يشكّ أنّه من أجزاء مايؤكل لحمه أو من غيره، أو يشكّ أنّه من الذهب و الحرير الخالص بالنسبة إلى الرجال.
و قد مهّد بعض مقدّماتاً لجريان البرائة في المسألة مطلقاً سواء كانت الشبهة من جهة الحكم أو الموضوع، و كان التكليف إستقلالياً أو إرتباطياً، وجوبياً أو تحريمياً.
أمّا جريان البرائة في الشبهة الحكمية، كما بينّاه في الاُصول، فهو أمر بديهي يحكم به العقل السليم، لاستقلاله بقبح العقاب بلابيان لوضوح أنّ المكلّف لايخرج بمخالفته التكليف المجهول عن زيّ العبوديّة، و لايصحّ عقوبته بذلك و لا كلام فيه، و إنّما الكلام في إجراء البرائة عقلا في الشبهة المصداقية قبل الفحص، و إن كان الشيخ(رحمه الله)إلتزم بجريانها فيها و تلقّاه من بعده أيضاً بالقبول و أرسلوه إرسال المسلّمات، و لكنّ الإنصاف أنّه ليس بهذا الحدّ من الظهور و الوضوح حتّى لايحتاج إلى التحقيق و النظر و التدقيق، بل هو به جدير و حقيق و قد كنّا نتسلّمه أيضاً في أوائل اشتغالنا بالاُصول.
و وجهه أنّ المولى لو قال لعبده «لاتهن أقربائي» فهنا حكم كلّي واقعي و هو حرمة إهانة كلّ شخص من أفراد أقرباء المولى، فإذا علم العبد به يصير منجّزاً في حقّه، و لايحتاج إلى شيء آخر غير تعلّق العلم بنفس الحكم الكلّي، سواء علم بالمصاديق أم لا، فحينئذ لو لم يعلم العبد أنّ زيداً من أقرباء المولى أم لا و لكن احتمل كونه منهم و
لم يتفحّص عن ذلك و أهانه مع التفات تامّ منه إلى الحكم الكلّي الصادر، فلايقبح عقوبته و لومه و لايقبل منه العذر بعدم العلم و العرفان، و ذلك أنّ وظيفة المولى إصدار الحكم الكلّي و إلقائه على المكلّف و ليس عليه أن يأخذ يده و يعرف كلّ مصداق من أقربائه، و يدلّه عليه حتّى لايجهل أحداً منهم، إذ ليس هذا متعارفاً بين الموالي و العبيد العرفي، بل تشخيص المصاديق الخارجيّة و تعيينها مفوّض إلى المخاطبين بالحكم و المشمولين له، فالحجّة قائمة على المكلّف من قبل المولى بعد العلم بصدور حرمة إهانة أقربائه، و لايصحّ له الإعتذار في مخالفة الحكم الكلّي بعدم العلم بالفرد المشكوك و الجهل بالمصداق.
و لايتوهّم أنّا نقول: إنّ الحكم الكلّي الصادر من المولى بيان للفرد المشكوك، كيف وهو موقوف على العلم بالكبرى و ضمّ الصغرى إليه، مثلا إثبات حرمة مائع خارجي موقوف على العلم بحرمة الخمر الواقعي مثلا، و أنّ هذا المائع خمر، كما تقدّم من المثال في المقام، لعدم العلم بالصغرى الخارجيّة، و أنّ زيداً مثلا من أقرباء المولى، بل نقول: العبد بعد العلم بحرمة إهانة أقربائه على النحو الكلّي لو خالف حكم المولى في ضمن فرد يحتمل كونه من أقربائه و من مصاديق ذاك الحكم الكلّي، و لم يتفحّص عنه و لم يجتنب، يصحّ للمولى عقوبته و توبيخه، و لايحكم العقل بقبحه حتّى تجري البرائة عقلا، لا أنّ صدور الحكم الكلّي بيان للجزئي الخارجي و المصاديق المشكوكة
كونها مثلا خمراً أو من الأقرباء الّذين تحرم إهانتهم.
و منشأ الشبهة في هذا الأمر المسلّم العقلي جريان البرائة نقلا و شرعاً في الشبهات الموضوعيّة، لكّنه مطلب آخر لاربط له بالمقام، إذ البحث في جريان البرائة عقلا في الشبهة الموضوعيّة قبل الفحص، و إلاّ لو ورد دليل تعبّدي يجوّز البرائة فيها من دون إيجاب التفحّص و التجسّس، نقبله و نتسلّم له، و ليس منافياً لما قلنا و نقضاً لما اخترناه فإنّه أصل ثانوي دلّ عليه الدليل الشرعي، و أمّا العقل مع قطع النظر عن ذلك الدليل يحكم بصحّة عقوبة من خالف الأمر في ضمن فرد مشكوك بعد العلم بالحكم الكلّي، لما تقدّم من أنّ بيان المصاديق و تعريفها ليس من وظيفة الشرع و حدوده. هذا تمام الكلام فيما مهّدوا من المقدّمات لجريان البرائة مطلقاً سواء كان التكليف إستقلالياً أو إرتباطياً و كانت الشبهة من الشرع أو من جهة الاُمور الخارجية، وقد عرفت الكلام منّا في القسم الأخير في جريان البرائة عقلا.
الإستدلال بحديث الرفع
قد يستدلّ لصحّة الصلاة في اللباس المشكوك، بما روي عن النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم)(صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ، والنسيان، و ما اُكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و مااضطرّوا إليه و الحسد و الطيرة، و التفكّر في الوسوسة في خلق ما لم ينطق بشفة(1).
- 1 . الخصال، ص 417، الطبع الجديد.
فإنّ قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): رفع ما لايعلمون يدلّ على أنّ كلّ شيء لم يتعلّق العلم به فهو مرفوع، و تقريب الاستدلال إمّا بما ذكره الشيخ العلاّمة الأنصاري(قدس سره) من ظهور السياق في الموضوعات الخارجية، و حينئذ المراد من رفع الموضوعات رفع الحكم المتعلّق بها من الأحكام التكليفية أو الوضعية، و إمّا بدعوى الأعمّ من الموضوعات و من الأحكام، كما حقّقناه و بيّناه في الاُصول من أنّ الموصول يتبع الصلة في السعة و الضيق، فكلّ مورد تشمله الصلة يشمله الموصول.
و على كلّ حال، فهل التمسّك بالنبويّ في المقام صحيح أم لا؟ الظاهر أنّه مشكل.
وجه الإشكال: أنّ الحديث ظاهر في رفع كلّ شيء يوجب الضيق على المكلّف من ناحية الشرع، و بتعبير أوفى أنّ الضيق الناشي من قبل الشرع مرفوع عن المكلّفين رحمة لهم و منّة عليهم، و أمّا الضيق الّذي لا ربط له بالشرع و لا دخالة له فيه، فلايشمله الخبر و لايدلّ على رفعه، لوضوح أنّ وضعه عليهم لم يكن من ناحيّته، حتّى يرفع عنهم ذاك الضيق رحمة لهم و منّة عليهم، كما في المقام ضرورة أنّ الحكم الّذي ينشأ منه الضيق على المكلّف و هو عدم صحّة الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه، معلوم له و لاجهل فيه حتّى يشمله ما لايعلمون، فيصير مرفوعاً عنه و الجهل الّذي أوقعه في الضيق، إنّما تعلّق بالمصاديق الخارجيّة من أفراد غير المأكول الّتي
ليس بيانها والتعريف بها على عهدة الشرع و من وظائفه، و لا الضيق ناشئاً من ناحيّته، بل إنّما هو من جهة حكم العقل بوجوب الإحتياط في مثل الموارد الّتي اُشير إليها، إلاّ أن يدلّ دليل نقلي على رفع الحكم الكلّي في مورد الجهل بالمصاديق، كقاعدتي الطهارة و الحلّية، فإنّ قوله(عليه السلام): «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»(1) ليس في مقام جعل الطهارة للأشياء بعنوانها الأوّلي، بل في مقام جعل الطهارة لها عند الشكّ في أنّها من مصاديق الطاهر الواقعي أو النجس كذلك، فبهذا الدليل الوارد في مورد الجهل يرفع اليد عن الحكم الأوّلي الثابت للأشياء بما هي و ذاتها، و مثلها قاعدة الحلّية، فإنّ قوله(عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»، ظاهر في الشكّ فى المصداق الخارجي، إذا المراد من الشيء، العناوين المعلومة أنّ فيها حلالا و حراماً، كاللحم و غيره من الأشياء المجعولة لها حكم شرعي، فعليهذا، الحكم بالحلّية إنّما هو فيما يشكّ في كونه مصداقاً للحلال أو الحرام، فالفرد المشكوك في حلّيته و حرمته من جهة الجهل بالمصاديق الخارجيّة، محكوم بالحلّية حتّى يعرف الحرام منه بعينه فيدعه، و ذيل الرواية أقوى شاهد لما قلناه:
- 1 . عن الصادق(عليه السلام): الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر، الوسائل، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، وعنه(عليه السلام): كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم يعلم فليس عليك، الوسائل، ج 2، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 4. و عنه(عليه السلام): كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر، الوسائل، ج 1، من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
عن عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله(عليه السلام): «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(1) و بالجملة، ما لم يدلّ دليل شرعي على ارتفاع الحكم الكلّي في مورد الجهل بمصاديق العناوين المحكومة من قبل الشرع بحكم إلزامي، لايصحّ رفع اليد عن ذاك الحكم المحتمل شموله لمورد الشكّ، ولايقبل الاعتذار بعدم العلم به.
و الحاصل، أنّه بعد ما قلنا إنّ العقل يحكم بعدم معذوريّة العبد في مخالفة الحكم الكلّي في الفرد المشكوك بعدم العلم بالموضوع لايجوز و لايصحّ رفع اليد عن الحكم إلاّ بدليل حاكم على الأدلّة الأوّلية عند الشكّ وظهوره في ذلك، و قوله(عليه السلام): رفع عن اُمّتي تسعة الّتي منها ما لايعلمون، ليس له ظهور تامّ فيما ذكر، لاحتمال اختصاص الرفع بمايلزم منه الضيق على المكلّف من ناحية الشرع، لا الضيق الناشي من جهة اُخرى، بخلاف أصالتي الطهارة والحلّية لظهورهما في جواز الأكل و الشرب عند الشكّ في كون شيء نجساً أو طاهراً، حلالا أو حراماً.
التمسّك بالاستصحاب
وممّا استدلّ به لصحّة الصلاة في اللباس المشكوك، الاستصحاب
- 1 . روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه، ج 7، ص 467.
و تقريبه: أنّ المصلّي لم يكن لابساً لأجزاء غير المأكول في وقت ما و لاأقلّ حينما كان عارياً و لو في الحمام أو غيره و اللآن يشكّ في بقاء ذلك فيستصحب.
و يمكن تصوير الاستصحاب في اللباس أيضاً، إذا وقع عليه شيء أو تلطّخ بشيء يشكّ كونه من أجزاء غير المأكول، فيقال أنّ اللباس لم يكن عليه شيء منها، فيستصحب هذا الحال و يحكم ببقائه عليه، لما روي عنه(عليه السلام): «لاتنقض اليقين بالشكّ».
هذا إذا قلنا: إنّ مانعيّة أجزاء غير المأكول من صفات المصلّي، بأن يقال: إنّ تلبّس المصلّي بأجزاء ما لايؤكل لحمه مانع عن صحّة الصلاة، و انطباق العنوان المطلوب على الأجزاء المأتي بها، و كذلك الكلام إذا كان المانع كون اللباس من أجزاء غير المأكول.
توضيح الاستدلال و تفصيله: أنّ المانع عن صحّة الصلاة هو أمر وجودي يخلّ بها، و لكنّه اعتبر صفة للمصلّي بمعنى أنّ كونه لابساً لأجزاء غير المأكول مانع عن انطباق العنوان المطلوب على الأجزاء و الشرائط المأتي بها، و يكون عدم كونه لابساً لأجزاء غير المأكول شرطاً لتحقّق العنوان المطلوب فإذا أتى المكلّف بالأجزاء و الشرائط و شكّ في أنّها تؤثّر في تحقّق العنوان المطلوب أم لا، لاحتمال كونها مقرونة بالمانع، فلابدّ من إحراز ذلك و لو بالأصل، و حيث أنّ المانع عبارة عن كون المصلّي لابساً لأجزاء غير المأكول يمكن إحراز عدم المانع به، بأن يقال: أنّ المصلّي لم يكن لابساً لأجزاء غير المأكول في
وقت، و لو في الحمام، أو كان متلبّساً بثوب لم يكن من غير المأكول فألقى عليه شيء أو تلبّس بثوب آخر يشكّ في كونه منه، فيستصحب الحال و يحكم بالبقاء و يترتّب عليه الأثر، و هو صحّة الصلاة; إذ الصحّة في الصلاة عبارة عن انطباق العنوان المطلوب على الأجزاء و الشرائط مع فقد المانع، و قد اُحرز الأوّل بالوجدان و الثاني بالأصل، فيترتّب الأثر الشرعي عليه; إذ يكفي في صحّة جريان الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر شرعي و إن لم يكن تمام العلّة له بل كان جزءً من العلّة.
و نوقش في الاستدلال بأنّه يمكن أن يتصوّر المانع وصفاً للصلاة، لا وصفاً للمصلّي و لا للباس، بأن يقال إنّ وقوع الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه مانع عن انطباق عنوان الصلاة المطلوبة على الأجزاء و مفسد و مخرّب لها، و لايمكن إحراز عدم هذا المانع بالأصل، لعدم الحالة السابقة.
تفصيل ذلك أنّ المانع يمكن أن يتصوّر على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون وصفاً للمصلّي كما تقدّم، والثاني: أن يكون وصفاً للباس، وهو يجدي فيما إذا تلطّخ لباس المصلّي بشيء أو ألقى عليه شيء يشكّ في أنّه من أجزاء ما لايؤكل لحمه، و الثالث: أن يكون من أوصاف الصلاة، بجعل وقوع الصلاة فيما لايؤكل لحمه مانعاً عن تحقّق عنوان الصلاة.
أمّا الأوّل و الثاني فيجري الاستصحاب فيهما، لتصوّر الحالة
السابقة، بخلاف الثالث لعدمها فيه، فإنّ الصلاة إمّا وقعت من الأوّل في غير الماكول أم لا؟، إذ لم يكن زمان تحقّقت فيه الصلاة و لم تكن واقعة في غير المأكول حتّى يستصحب.
إن قلت: يمكن تصوّر الحالة السابقة في القسم الثالث في أثناء الصلاة بأن كان المصلّي من أوّل الصلاة أوقع صلاته في أجزاء ما يؤكل لحمه ثمّ ألقى عليه شيء في أثناء الصلاة يشكّ أنّه ممّا لايؤكل لحمه أم لا؟ فيقال: إنّ الصلاة لم تكن واقعة فيه فالآن باقية على حالتها الأولى.
قلت: الصلاة إمّا عبارة عن الأجزاء المتباينة و الاُمور المتشتّتة، من التكبير و القرائة و الركوع و السجود الّتي توجد و تنصرم، و إمّا عبارة عن التوجّه الخاص إلى الله تعالى خاشعاً متذلّلا و خاضعاً بهيئة مخصوصة.
فإن كانت عبارة عن الأجزاء فلكلّ جزء وجود مستقلّ له حكم خاص لايسري حكمه إلى غيره و لايمكن استصحاب عدم وقوع الركوع فيما لايؤكل و تسريته إلى السجود، إذ الحكم بإبقاء الركوع على ما كان ليس إبقاء للحكم الثابت للسجود، من عدم وقوعه في أجزاء ما لايؤكل أو غيره من الموانع، بل حكمه باق على حاله، و إن انقطع بوقوع الركوع في غير المأكول أو بعدم الوقوع و قد لايكون شكّ في الحال الثابت للقرائة مثلا و لكن يشكّ في الركوع أو السجود في أنّه وقع في غير المأكول أم لا، مع القطع بعدم وقوع الجزء السابق
فيه و خلوّ الركوع عن المانع لم يكن متيقّناً حتّى يستصحب و اليقين المتعلّق بالقرائة ليس يجديه.
إن قلت: يمكن إحراز العدم لكلّ جزء من الأجزاء بأصالة العدم الجارية في كلّ منها، بأن يقال: أنّ الركوع لم يكن واقعاً في غير المأكول و لو بلحاظ عدم وجوده في الخارج فيستصحب.
قلت: أنّ أصالة العدم إن كانت العدم الأزلي و الليسية التامّة، فهو لايغني عن شيء و لايفيد في المقام، إذ عدم وقوع الركوع مثلا فيما لايؤكل لحمه باعتبار عدم كون الركوع أصلا في صفحة الوجود، مغاير للعدم الّذي هو من وصف المحمول، و بعبارة اُخرى سلب الشيء عن شيء باعتبار عدم وجود المسلوب عنه مغاير لسلبه عنه بعد إحراز وجوده، مثلا الحكم بعدم القيام لزيد بلحاظ عدم وجوده أصلا غير الحكم بنفي القيام له بعد وجوده و إحرازه، فإنّ الأوّل عبارة عن هل البسيطة و الثاني هو الحكم بهل التامّة و الفرق بينهما واضح.
و إن أمعنّا النظر و ألطفناه و قلنا: إنّ السلب المحمولي متّحد مع السلب الموضوعي و إنّ الحكم بعدم شيء لشيء و سلبه عنه بعد فرض الوجود نظير السلب المقارن لعدم الموضوع، فيمكن جريان الاستصحاب في كليهما، لحكم العقل بالاتّحاد فيهما; هذا، و لكنّ العرف يستوحش من ذلك و يرى السلبين و العدمين متغايرين و متفاوتين.
والحاصل، أنّ أصالة العدم المدّعى جريانه في المقام، إن كان
مرجعه إلى ما ذكرناه فهو غير جار في المقام و أمّا لو كان من الاُصول العقلائية و أصلا برأسه، فتارة يدعّى: أنّ أخبار الاستصحاب تدلّ على ذلك، كما يظهر من كلام الفقيه الهمداني(قدس سره)في التعليقة على رسائل الشيخ العلاّمة الأنصاري «أعلى الله مقامه» على ما هو ببالي، و اُخرى يقال: أنّه أصل من الاُصول العقلائية لأجل أنّ بناء العرف في اُمور هم الحياتية الدنيوية و الاُخروية على عدم المشكوك إذا شكّ في وجوده، فعلى هذا، لا مانع من التمسّك به إلاّ أنّ اثبات ذاك الأصل بهذا المعنى مشكل. هذا تمام الكلام بناء على أنّ الصلاة عبارة عن الأجزاء المتفرّقة المتشتّتة المتصرّمة.
و أمّا إن كانت عبارة عن التوجّه الخاص إلى الله، و هو باق إلى آخر الصلاة فجريان الاستصحاب في مورد الشكّ و إن كان قريباً لأجل أنّ الصلاة بناء على ذا، أمر وحداني يراه العرف واحداً، و لكن للإشكال فيه أيضاً مجال بدعوى أنّ التوجّه إلى الله في حال الركوع مثلا الّذي نشكّ في وقوعه في غير المأكول، غير التوجّه الخاص المتحقّق في حال القرائة الّذي نقطع بعدم وقوعه فيه، و غير الّذي تحقّق في ضمن تكبيرة الافتتاح، فليتأمّل(1).
- 1 . وجه التأمّل أنّ العرف لايرى و لايعتبر توجّه المصلّي في صلاته إلى الله تعالى متعدّداً بحسب الأجزاء المعتبرة فيها بل يعدّه توجّهاً واحداً كما اُشير إليه في المتن أيضاً ـ المقرّر.
التمسّك بقاعدة الحلّية
قد يتمسّك لصحّة الصلاة في اللباس المشكوك بقاعدة الحلّية المستفادة من صحيحة ابن سنان المرويّة في كتاب من لايحضره الفقيه، روى الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبوعبدالله(عليه السلام): «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(1).
تقريب الاستدلال، أنّ الرواية تدلّ على حلّية الصلاة فيما يشكّ كونه ممّا لاتصحّ الصلاة فيه.
و يرد عليه بأنّ التمسّك بها، إنّما يصحّ إذا كانت الشبهة حكميّة بأن يشكّ في أنّ الحيوان الّذي اُخذ منه هذا الشعر، هل هو ممّا يؤكل لحمه و يحلّ أكله أو ممّا لايؤكل، فعندذا يصحّ الاستدلال بالرواية لإثبات الحلّية و جواز الأكل و يتبعه صحّة الصلاة في شعره و وبره و كلّ شيء منه.
و أمّا إذا كانت الشبهة موضوعيّة بأن شكّ في أنّ هذا الشعر أو الوبر أو الجلد مأخوذ من الثعالب الّتي لايحلّ لحمها أو من الغنم و غيره ممّا يؤكل لحمه، فلا يصلح التمسّك بها لإثبات جواز الصلاة في الفرد المشكوك.
توضيح الاستدلال و الإشكال الوارد عليه: أنّ الشكّ في صحّة
- 1 . روضة المتّقين، ج 7، ص 467.
الصلاة و عدمها فيما يشكّ كونه ممّا لاتصحّ الصلاة فيه مسبّب عن الشكّ في حلّية لحم الحيوان الّذي اُخذ منه الصوف أو الشعر أو الوبر أو الجلد، فإذا حكمنا بأصالة الحلّية و قاعدتها بحلّية أكل لحمه و عدم كونه حراماً، نحكم بصحّة الصلاة فيما اُخذ منه أو ما فيه من أجزاء ذلك الحيوان، لأنّ الأصل إذا اُجري في السبب يترتّب عليه الآثار المترتّبة عليه عند إحراز وجوده بالوجدان، فتصحّ الصلاة في الفرد المشكوك، إذ الصحّة و الفساد في الصلاة مسبّبان عن الحلّية و الحرمة في اللحم، فإذا أحرز السبب بالأصل و حكم بحلّية لحم الحيوان الّذي شكّ في جواز أكله يحرز المسبّب أيضاً و يحكم بجواز الصلاة و صحّتها في كلّ شيء منه، هذا محصّل الاستدلال و ملخّصه.
و التحقيق أنّ الشكّ في جواز الصلاة و صحّتها فيما يشكّ كونه من أجزاء ما يؤكل لحمه تارة يكون من جهة الشكّ في حلّية لحم الحيوان الّذي اُخذ منه الصوف أو الشعر أو الوبر أو الجلد يقيناً من دون شكّ في أنّه مأخوذ من أيّ صنف من الحيوان المعلوم حكمه حلاّ و حرمةً، فحينئذ يتمسّك بالقاعدة لإثبات الحلّية و صحّة الصلاة فيما اُخذ من أجزاء ذاك الحيوان.
و اُخرى يتصوّر فيما علم حكم صنف من الحيوان و أنّه يحلّ لحمه، و صنف آخر منه و أنّه حرام أكل لحمه و لايشكّ في حكم هذين الصنفين و إنمّا الشكّ في أنّ ما تلبّس به المصلّي في صلاته، هل
هو مأخوذ من الصنف الأوّل حتّى تصحّ الصلاة فيه أو من الصنف الثاني فتبطل و قاعدة الحلّية و التمسّك بها في المقام لايثبت ذلك و أنّ لباس المصلّي متّخذ من هذا أو من ذاك، من الغنم أو من الثعلب و إنّما تفيد القاعدة فيما إذا شكّ في حلّية اللحم و جواز أكله و عدمه و ليس هو مبتلى به في المقام، و ما هو المبتلى به المصلّي ليس ذلك الصوف أو الشعر في الصلاة و جوازه و حلّيته وضعاً لا تكليفاً، إذ ليس الكلام في المقام في جواز اللبس و عدمه من جهة الحلّية أو الحرمة التكليفيّة، لوضوح أنّ لبس أجزاء ما لايؤكل لحمه في الصلاة ليس بحرام تكليفاً حتّى نحتاج إلى قاعدة الحلّية عند الشكّ فيه، بل في جوازه وضعاً بمعنى صحّة الصلاة فيه. و بالجملة القاعدة لايجدي فيما نحن بصدده في المقام و لايثبت أنّ الجزء المشكوك متّخذ من الغنم و غيره ممّا يؤكل لحمه أو من الثعالب و ممّا لايؤكل لحمه و أمّا المورد الّذي تجري فيه القاعدة و تفيد فليس محلاّ للبحث و النقض.
إشكال مهمّ من الاُستاذ
قال الاُستاذ مدّظلّه: الإشكال المهمّ في المقام، أنّ الحرمة أو الحلّية التكليفيّة المتعلّقة بأكل اللحم ليست موضوعاً للجواز و عدمه، بحيث يترتّب الجواز على الحلّية وعدمه على الحرمة، و لا ينفكّ أحدهما عن الآخر بل هما حكمان مستقلاّن، فإنّ حرمة أكل
لحم الإرنب و الثعلب، حكم مستقلّ له حكمة و مبادى على حدّه، و عدم صحّة الصلاة في وبره و جلده حكم آخر في عرض الحكم الأوّل، غير مرتبط به، لا أنّه حكم في طوله و متفرّع عليه.
و بتعبير أوضح أنّ الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بلحم الإرنب ليست ممّا يترتّب عليها مانعيّة أجزائه عن تحقّق عنوان الصلاة و انطباقه على المأتي به، و كذا الحلّية المتعلّقة بلحم الغنم تكليفاً لايترتّب عليها صحّة الصلاة في أجزائه الّتي هي حكم آخر وضعي مستقلّ في حدّ نفسه و في عرضه، لا في طوله و من شئونه و تبعاته و تفرّعاته، و إن كان يشعر بالإتّحاد و التّفرّع بعض الأخبار الواردة في الباب مثل موثّقة ابن بكير المتقدّمة في أوّل البحث عن أبي عبدالله(عليه السلام)عن كتاب زعم أنّه إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) و فيها: «يا زرارة! فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكّى و قد ذكّاه الذبح و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكّاه الذابح أو لم يذّكه»(1).
و مثلها في الإشعار وصيّة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) لعليّ(عليه السلام): «يا عليّ! لاتصلّ في جلد ما لايشرب لبنه و لايؤكل لحمه»(2).
- 1 . الوسائل، ج 3، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.
2 . الوسائل، ج 3، الباب 2 من أبواب المصلّي، الحديث 6.
لكنّ التأمّل و الدقّة يشهد أنّ حرمة اللحم لم يجعل موضوعاً للحكم بنفسه بل إنّما جعل مشيراً إلى عناوين اُخرى من الموضوعات الخارجيّة المانعة عن صحّة الصلاة كما ورد التصريح بتلك العناوين في بعض الأخبار،
منها: رواية فضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: «و لايصلّى في جلود الميتة و لا السباع»(1).
و رواية إسمعيل بن سعد، قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع فقال: «لاتصلّ فيها»(2).
و رواية سماعة، قال سئل أبوعبدالله(عليه السلام) عن جلود السباع فقال: «ركّبوها و لاتلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه»(3).
و رواية أحمد بن إسحاق الأبهرى، قال: كتبت إليه، جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لاتقيّة؟، فكتب (عليه السلام): «لايجوز الصلاة فيها».
يعلم من التصريح بتلك العناوين و الموضوعات الخارجيّة أنّ المانع عن الصلاة و صحّتها هو العناوين الأوّلية لا حرمة اللحم، فعلى
- 1 . الوسائل، ج 3، الباب 6 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3.
2 . نفس المصدر، الحديث 1.
3 . نفس المصدر، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3 و 4 و 6.
هذا، التمسّك بأصالة الحلّية لايثبت نفس العناوين و لاينفيها إلاّ على القول بالأصل المثبت و لايقول به معظم الأصحاب.
إشكال آخر من الاُستاذ
و يرد على الاستدلال بالموثّقة و قاعدة الحلّية مضافاً إلى الإشكال السابق، إشكال آخر، و هو أنّه بناء على تماميّة الاستدلال بقاعدة الحلّية هل المراد من الحلال الّذي يترتّب عليه جواز الصلاة هو الحلال الواقعي أو الحلال الظاهري.
و بتعبير آخر، إنّ صحّة الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه هل هي مترتّبة على الحلّية الواقعيّة الحيثيّة أو على الحلّية الظاهريّة الفعليّة، فلو فرض حلّية لحم الإرنب أو غيره بالإضطرار و الإكراه تصحّ الصلاة في وبره و شعره أيضاً.
لايمكن الإلتزام بالشقّ الثاني فلابدّ من إختيار الشقّ الأوّل و عليه كيف يمكن إثبات الحلّية الواقعيّة بالموثّقة الدالّة على الحلّية الظاهرة المجعولة عند الشكّ تسهيلا على المكلّف، تيسيراً على العباد في معاشهم و معادهم، فتلخّص من جميع ما ذكر أنّ التمسّك بالموثّقة و قاعدة الحلّية فيما نحن فيه غير خال عن الإشكال و لو صحّ في بعض الموارد أيضاً لايسلّم عن كونه مثبتاً كما تقدّم.
إستدلال المحقّق القمّي(قدس سره)
و قد يقرّر الاستدلال بالموثّقة بنحو آخر سلكه المحقّق القمّي(قدس سره)و هو أنّ الصلاة فيما يشكّ كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه، إنّما وقع الشكّ فيها من جهة الحرمة و الحلّية و الجواز و المنع وضعاً و يحكم بالحليّة و الجواز إستناداً إلى قاعدة الحلّية.
توضيح الاستدلال: أنّ الحلال و الحرام كما يطلق على التكليفي منهما فكذلك يطلق على الحرام و الحلال الوضعي و هذا ممّا لايخفى على من راجع كلمات الأئمّة(عليهم السلام) و الأصحاب و الفقهاء; و على هذا، لو شكّ في شيء أنّه حلال أو حرام تكليفاً من جهة الأكل و الشرب، يحكم بالحلّية و جواز الأكل و الشرب، و كذا لو شكّ في أنّ هذا الشعر و الوبر حلال وضعاً و تصحّ الصلاة فيه أو لاتصحّ و حرام لكونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه، يحكم بالحلّية و الجواز وضعاً و أنّه لا منع و لا حرمان للمصلّي من الصلاة فيه; و الوجه أنّ الحرام كلمة صيغت من مادّة حرم معناه المنع، و بهذه المناسبة اُطلق الحرم على مكّة و نواحيها، لمنع المكلّف عن عدّة من الاُمور و حرمتها عليه مادام فيه، و حريم الشيء عبارة عن مكان يمنع الغير عن التصرّف فيه و يحرم عليه، و مثله كلمة الإحرام و المحرم لمنع المكلّف بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة و الإحرام في العمرة و الحجّ عن سلسلة من الاُمور الّتي يمنع المصلّي أو الحاجّ عن الإتيان بها.
و يقابل الحرام بالمعنى المذكور، الحلال الواقع في كلمات القوم،
فإنّه عبارة عن شيء يكون الشخص بالنسبة إليه مطلقاً و غير ممنوع عنه، و بهذه المناسبة اُستعمل الحلّ في مقابل الحرم، لعدم المنع فيه للحاجّ عن بعض الاُمور الّذي كان ممنوعاً في الحرم.
و هذا المعنى الّذي ذكر في مادّة الحلال و الحرام، موجود في الحلّية الوضعية و الحرمة كذلك على نهج سواء و نسبة واحدة، فإذا شكّ في أنّ الإتيان بالصلاة فيما يشكّ كونه ممّا يؤكل لحمه أو من غيره حلال أو حرام، بمعنى أنّ المصلّى ممنوع عن الإتيان بها فيه أو لا منع له عنه و لا حرمان يحكم بالحلّية و عدم المنع و أنّه مطلق بالنسبة إليه تمسّكاً بالموثّقة و قاعدة الحلّية و لافرق في ذلك بين أن يكون منشأ الشكّ أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً، هذا ما سلكه المحقّق القمّى(رحمه الله) في استدلاله بالموثّقة في المسألة، و على كل حال و تقدير، فإن أمكن إثبات عدم ممنوعيّة المصلّي عن الإتيان بالصلاة في اللباس المشكوك بالموثّقة و قاعدة الحلّية، فصلاته صحيحة ومسقطة للتكليف و إلاّ فلابدّ من دليل آخر.
كيفيّة تعلّق الأوامر بالأجزاء و الشروط و عدم الموانع
قال الاُستاذ: إنّ المهمّ في المقام و ما هو جدير بالدقّة و التأمّل التام، تنقيح كيفية تعلّق الأوامر بالأجزاء و الشروط و عدم الموانع و قد بيّنا في الاُصول فيما أسلفناه أنّ الأمر المتعلّق بعدّة أجزاء و شرائط لوحظت فيها الوحدة إعتباراً يتبعّض في التنجّز و عدمه بالنسبة إلى
أجزاء المأموربه كأوامر عديدة، كيف وقد يمكن التبعيض في الحكم في الوحدات الحقيقية الخارجية كماء البحر فإنّه مع كونه واحداً حقيقياً يتصوّر له البعض و يصحّ فيه التبعيض في الحكم، فالواحد الاعتبارى الّذي له وجودات و أجزاء مستقلّة ثابتة الّذي ليست الوحدة بينها إلاّ بالاعتبار و لحاظ اللاحظ، أولى به و أسهل من غيره و هذا ممّا لايعتريه الشكّ.
و تفصيل ذلك كما بيّناه في الاُصول، أنّ معنى التنجّز في الأمر هو صحّة العقوبة و عدم قبحها على ترك المأمور به الّذي علم تعلّق الأمر به، و هذا المعنى موجود و محقّق في الأجزاء المعلومة دون المجهولة، و بهذه المناسبة حكمنا بجريان البرائة عند الشكّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطي، إذ المقطوع من تنجّز الأمر المتعلّق بالمركّب تنجّزه بالنسبة إلى الأقلّ المعلوم تعلّق الأمر و شموله له، دون الأكثر و هو الّذي تصحّ العقوبة على تركه على كلّ حال، سواء كان الواجب في نفس الأمر هو الأكثر أو الأقلّ.
لايخفى أنّ الطريق الّذي اخترناه في تنجّز الأمر بالنسبة إلى الأقلّ غير الّذي سلكه العلامّة الأنصاري(قدس سره) في تلك المسألة فإنّه (رضوان الله عليه) قائل بتنجّز الأمر بالنسبة إلى الأقلّ بسبب العلم الإجمالي بتعلّق الأمر إمّا به فقط أو به مع الأكثر، و الفرق بين ما اختاره و ما حققّناه واضح، إذ اللازم على مبناه عدم صحّة العقوبة على ترك الأكثر و لو بترك الأقلّ، لو فرض كونه هو الواجب في نفس الأمر و
الواقع دون الأقلّ، فإنّ العلم الإجمالي إذا لم يكن منجّزاً للأمر المتعلّق بالأكثر لاتصحّ العقوبة على تركه، سواء كان هذا الترك من جهة عدم الإتيان بالجزء المشكوك و هو الأكثر أو من جهة عدم الإتيان بالأقلّ المعلوم تعلّق الأمر به و ما أظنّ أحداً إلتزم بذلك، و هذا الإشكال غير وارد على ما اخترناه، إذ الأقلّ واجب و منجّز بنفس الأمر المتعلّق بالمركّب على كلّ تقدير و لايمكن مخالفته سواء كان الأمر في نفس الأمر متعلّقاً بالأقلّ أو الأكثر، هذا بالنسبة إلى الأجزاء.
الشروط و الموانع
و أمّا الشروط و الموانع الّتي اعتبر تقيد الأجزاء بها وجوداً و عدماً فهل الحكم فيها في صورة الشكّ فيها مثل الّذي اخترناه من معنى التنجّز و كيفيّته في الأمر المتعلّق بالأجزاء أم يختلف الموردان و يتفاوت المقامان، وجهان: فإن التزمنا بمقالة شيخنا المحقّق الخراساني(قدس سره) من أنّ الشروط الشرعيّة و القيود العدميّة كلّها راجعة إلى الشروط العقليّة بمعنى أنّ الأمر الصادر من الشرع قد تعلّق بعنوان مغاير للشروط و لكنّ تحقّق ذلك العنوان يتوقّف بحكم العقل على وجود الشروط و عدم الموانع، فعليهذا لم يتعلّق الأمر بالشروط أصلا وجودية كانت أو عدمية، بل حكمها حكم المقدّمات الوجودية و قد قلنا في مقدّمة الواجب إنّ المقدّمات الوجودية لم يتعلّق أمر شرعي بها، بل العقل يحكم بأنّ الأمر إذا تعلّق بذي المقدّمة يترشّح
منه الإرادة إلى المقدّمة أيضاً بالطبع.
و أمّا لو قلنا كما قيل إنّ الأمر في المشروط متعلّق بالأجزاء مع تقيّد تلك الأجزاء بالشروط و عدم الموانع و بتعبير أوفى، أنّ متعلّق الأمر هو الأجزاء متقيّدة بوجود عدّة شروط خاصة و عدم وجود اُمور اُخرى مخصوصة بحيث أن يكون القيد خارجاً و التقيّد داخلا.
و اللازم على هذا المبنى أن يقال: إنّ التقيّد أمر وصفي إنتزاعي ليس له وجود متمحّض في الخارج و متشخّص فيه بل وجوده عين وجود القيد و هويّته نفس هويّته، ففي الحقيقة الأمر المتعلّق بالمشروط هو الّذي تعلّق بالأجزاء و الشرائط و بعدم وجود المانع أو الموانع فيصير وجود الجزء و الشرط مطلوباً عند الشرع و وجود المانع مبغوضاً و منهيّاً عنه على ما يأتي تفصيله.
في كيفيّة تعلّق الأمر بعدم وجود الموانع في المشروط
إنّ معنى تعلّق الأمر بعدم وجود الموانع بناءً على القول به كما اُشير إليه عبارة عن طلب ترك أمور معيّنة في الواجب المشروط به، مثل ترك التلبّس بأجزاء غير المأكول لحمه و ترك القهقهة و غير ذلك من الموانع في الصلاة و غيرها، فعلى هذا وجود كلّ واحد من تلك الاُمور منهيّ عنه و ممنوع منه; فإنّ معنى النهى طلب الترك للفعل المنهيّ عنه و لافرق في المنهيّ عنه بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً، أصليّاً أو ضمنيّاً، وكذا لافرق في تعلّق النهي بشيء بين أن يكون لأجل المنقصة
والمفسدة الثابتة فيه الموجبة للمنع و النهي و الملزمة للحرمة و الترك أو لأجل أنّه مانع عن شيء آخر و مخلّ بعنوان مطلوب و مزاحم لتحققّه و انطباقه على أشياء كما في موانع الصلاة، فإنّ وجود تلك الموانع كالقهقهة و لبس أجزاء غير المأكول في الصلاة ليس مبغوضاً لأجل مفسدة ذاتية فيها، بل وجودها مانع عن انطباق عنوان الصلاة على الأجزاء المأتي بها و مزاحم له فالمعنى المرتكز في الذهن من النهي و معناه الحقيقي (بناءً على ما تقدّم) موجود في الموانع و محقّق فيها كما في سائر النواهي; فحينئذ لو شكّ في لباس أنّ الصلاة فيه جائز شرعاً أو غير جائز، فمرجعه إلى أنّ هذا الثوب هل تعلّق الأمر الضمني على ترك التلبس به أم لا؟ و بتعبير آخر هل هو منهي عنه بالطلب الضمني أو حلال بعدم تعلّق الأمر بتركه فيحكم بالحلّية و عدم كونه منهيّاً تمسّكاً بالقاعدة المستفادة من الموثّقة، من قوله: كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال، الخبر; هذا هو الوجه الوجيه فيما سلكه بعض الأعلام في التمسّك بالموثّقة و قاعدة الحلّية في المسألة بعد التجريد عن الزوايد و ملخّصه أنّ النهي معناه طلب الترك و لا فرق في كون الطلب ضمنيّاً أو نفسيّاً و كون المفسدة في ذات المنهي عنه أو في كونه مانعاً عن تحقّق عنوان مطلوب و مأمور به و في جميع تلك الصور يتحقّق المعنى الحقيقي للنهي و يحكم بالحلّية عند الشكّ فيه بدلالة الموثّقة و قاعدة الحلّية.
تحقيق بديع من الاُستاذ
و يرد على ما تقدّم من معنى النهي أنّ معناه ليس طلب الترك حتّى يقال: إنّ ترك المانع إذا كان مطلوباً بالطلب الضمني، يكون وجوده منهيّاً عنه و يتحقّق فيه معناه، فإنّ النهي كما حققّناه في الاُصول هو الزجر عن الوجود أي وجود الطبيعة الّتي تعلّق بها النهي، و هذا المعنى مغاير للأمر من جهة المبادي و الغاية ذاتاً لا متعلّقاً فإنّ المتعلّق في كلّ من الأمر و النهي شيء واحد مشترك بينهما و هو وجود الطبيعة، إلاّ أنّ الأمر هو البعث إلى الوجود أي إلى ايجاد الطبيعة في الخارج لمصلحة ملزمة فيه والنهي هو الزجر عن الوجود لمفسدة كامنة ملزمة فيه موجبة لحرمته، و يختلف الأمر و النهي في السقوط و كيفيّة الامتثال، فإنّ الأمر يسقط بإيجاد فرد من الطبيعة و يحصل الغرض بذلك لكونه هو المقصود و المطلوب و لايبقى بعده أمر، و كذا يسقط بمخالفته كما لو قيل أكرم زيداً يوم الجمعة و خالف و لم يكرم بخلاف النهي فإنّه لايسقط بالمخالفة بإيجاد فرد من الطبيعة المنهيّ عنها لسريانه إلى كلّ وجود من أفراد الطبيعة وشموله له، و هو باق بعد العصيان أيضاً لا أنّه ينحل إلى نواهي متعدّدة.
إن قلت: بقاء النهي بعد العصيان في ضمن فرد من الطبيعة إنّما هو من جهة انحلال النهي الأوّل إلى نواهي عديدة و لو لا ذلك، لكان اللازم أن يسقط و لايبقي بعد المخالفة كما في الأمر.
قلت: لا معنى لسقوط النهي بالعصيان و انحلاله إلى نواهي
عديدة بعد ما قلنا إنّ معنى النهي الزجر عن الوجود و هو سار في جميع وجود الطبيعة الممكن تحقّق العصيان في ضمنه و هذا إنّما لسريان مفهوم معنى النهي و سعته لكلّ فرد من الطبيعة.
تحقيق آخر
و يرد إشكال آخر على الاستدلال أيضاً و هو أنّ الأمر إذا تعلّق بعدّة أجزاء مشروطة بشرائط خاصة و فقدان موانع مخصوصة، بحيث يكون القيد خارجاً و التقيّد داخلا، كما تقدّم في توجيه الاستدلال لايمكن إلاّ تصوّر أمر واحد و تكليف فارد، لا تكاليف متعدّدة و أوامر عديدة حتّى يكون لكلّ منها عصيان، و الأمر الواحد و التكليف الفارد لايكون فيه إلاّ مخالفة واحدة و هذه المخالفة قد تتحقّق بترك جميع أجزاء المأمور به و قد يكون العصيان للأمر الواحد بترك بعض الأجزاء على سبيل منع الخلوّ.
فعليهذا، لو ترك جميع الأجزاء فلابدّ من أن ينسب العصيان إليه أو البعض فإلى البعض و أمّا إذا أتى بالأجزاء كلّها و ترك الشروط أو شرطاً واحداً ينسب العصيان إلى ترك الشرط فقط سواء كان المانع مفقوداً أم لا، نعم لو أتى بجميع الأجزاء و الشرائط مقرونة بجميع الموانع تنسب المخالفة إلى الموانع كلّها.
و إذا أتى المكلّف بالأجزاء و الشرائط كلّها و ترك جميع الموانع إلاّ مانعاً واحداً بأن كان لباس المصلّي من أجزاء غير المأكول أو كان
نجساً، فتارة لايسع الوقت مقدار إتيان المأمور به و إعادته ثانياً بعد بطلان الصلاة بوجود المانع فينسب المخالفة حينئذ إلى وجود المانع المزاحم لعنوان الصلاة و انطباقه على الأجزاء، و اُخرى لايضيق الوقت بل يسع مقدار الإتيان بالمأموربه، و إعادته ثانياً و لكنّه لم يعد، فعندذا لاتصحّ نسبة المخالفة إلى المانع، بل إنّما حصل العصيان بترك المأمور به جميعاً و من الأصل حيث لم يأت به ثانياً مع سعة الوقت و القدرة عليه.
فعلى ما ذكر من التفصيل في سبب المخالفة و العصيان يظهر أنّ استناد العصيان إلى ترك الشرائط إنّما يصحّ فيما إذا وجد جميع الأجزاء دون الشرائط، و كذا استناده إلى وجود المانع إنّما يصدق فيما إذا أتى المكلّف بالأجزاء و الشرائط كلّها و لم يكن المانع مفقوداً أصلا.
و أمّا استناد المخالفة و ترك المأمور به و عصيان الأمر إلى مانع خاصّ، و بطلان الصلاة به كلبس أجزاء غير المأكول مثلا إنّما يتصوّر فيما أتى المكلّف بالأجزاء و الشرائط كلّها فاقدة للموانع جلّها إلاّ مانعاً واحداً و كان الوقت ضيقاً و لم يمكن من اعادة المأمور به بعد فساده بالمانع أوّلاً; فيستند العصيان و ترك المأمور به إلى المانع و يستحقّ العبد العقوبة به.
و لكن عصيان المكلّف و استحقاقه للعقوبة في هذا الفرض أيضاً ليس إلاّ من جهة ترك المأمور به لا من جهة الإتيان بما زجر عنه و ما يخلّ بعنوان الصلاة لوضوح أنّ المانع من حيث هو لم يكن مبغوضاً ذا
مفسدة ملزمة للنهي عنه حتّى يوجب الإتيان به العصيان على المولى و المخالفة له، بل المنع عنه انّما هو لأجل كونه مخلاّ بالمأمور به و مزاحماً و لم يتعلّق النهي التكليفي به واقعاً لا نفسيّاً و لاضمنيّاً و استدلال المحقّق القمّي(رحمه الله) متوقّف على تعلّق النهي بالمانع، و قد عرفت عدم ذلك.
إن قلت: إنّ المكلّف و إن كان استحقاقه للعقوبة من جهة ترك المأمور به دون الإتيان بالمانع و لكنّا لانحتاج في إجراء أصالة الحلّ عند الشكّ في المانع إلى كون وجوده مبغوضاً في نفسه و ذا مفسدة في حدّه، بل نحتاج إلى كونه منهيّاً و ممنوعاً عنه و في المقام كذلك، لتعلّق النهي بالمانع و المنع عنه.
قلت: النهي في مثل قوله(عليه السلام) «لاتصلّ في جلد ما لايؤكل لحمه»، أو «لايصلّى في جلود الميتة» إرشادي وضعي، بمعني أنّ النهي في المقام يرشد إلى عدم حصول المأمور به و عدم تحقّق العنوان المطلوب و البرائة عن الشغل عند وجود المانع و ليس نهياً تكليفيّاً و لو كان ضمنيّاً، كما هو محطّ النظر في استدلال المستدلّ حيث قسّم النهي إلى الاستقلالي و الضمني و لا نظر إلى تقسيمه إلى التكليفي و الوضعي حتّى تشملهما أصالة الحلّية.
لايقال: بعد تعلّق النهي الضمني عن المانع يكون وجوده محرّماً تكليفياً، فإنّ النهي عن وجود شيء عين البعث إلى الترك، و هو معنى النهي أيضاً.
فإنّه يقال: عدم المانع و إن كان متعلّقاً للأمر الضمني و مطلوباً تركه به إلاّ أنّ وجوده ليس متعلّقاً للنهي التكليفي، لأنّ الأمر في المركّبات يتبعّض حسب تعدّد متعلّقاته و يصير كلّ جزء مطلوباً بنفس الأمر المتعلّق بالمجموع و كذا يصير عدم المانع مطلوباًبه، و لكنّ الحرمة و النهي التكليفي إنّما تعلّق بترك المأمور به مجموعاً و رأساً و هذا النهي لايتبعّض بحيث ينحلّ إلى نواهي عديدة من النهي عن ترك الأجزاء و الشرائط و النهي عن وجود المانع حتّى يتعلّق بكلّ فرد من الموانع نهي تكليفي، فإنّ النهي عن ترك المأموربه لايعقل أن يتركّب من عدّة اُمور حتّى يتبعّض حسب تعدّد الأجزاء و الشرائط الّتي يستلزم ترك كلّ منها ترك المأمور به، أو يتبعّض حسب وجود الموانع، فيقال: أنّ وجود كلّ مانع من الموانع مبغوض عند الشرع و منهيّ عنه بالنهي الضمني، حتّى يصحّ الاستدلال بالموثّقة بتقريب أنّ اللباس صنفان: صنف محلّل و مشروع و صنف محرّم و مبغوض، و يحكم عند الشكّ بالحلّية حتّى يعلم أنّه حرام بعينه.
نعم غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استدلال المحقّق القمي(عليه السلام) و من يحذو حذوه، أنّ اللباس الّذي يتلبّس به المصلّي في صلاته له صنفان: صنف يوجب لبسه العصيان و لو باستلزامه لترك المأمور به و منعه عن تحقّق العنوان المطلوب، و هو ما اتّخذ من أجزاء غير المأكول و آخر لايوجب ذلك، و هو ما كان ممّا يؤكل لحمه، فإذا شكّ في مورد أنّ لبس هذا الثوب في الصلاة موجب للعصيان و لو مع
الواسطة باستلزامه لترك المأمور به أم لايوجب ذلك، فيحكم بعدم كونه موجباً له بقاعدة الحلّية لكن مفاد الموثّقة و أصالة الحلّية ليس ذلك، إذ اللازم منه صحّة التمسّك بها حتّى عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته، فإنّ الجزء و الشرط أيضاً ممّا يستلزم تركهما العصيان و لو بترك المأمور به و لاأظنّ أحداً يلتزم به.
هذا كلّه مضافاً إلى ما حقّقناه في الاُصول في مسألة اقتضاء النهي في العبادات و المعاملات الفساد و عدمه، بما يأتي(1).
في معنى النهي في العبادات و المعاملات
قد حقّقناه في الاُصول في مسألة اقتضاء النهي في العبادات، الفساد و عدم اقتضائه ذلك أنّ البحث في المسألة إنّما يقع في أمرين مغايرين و لايشتركان في جامع واحد.
الأوّل: أنّ الظاهر و المستفاد من النواهي المتعلّقة بالعبادات أو المعاملات، الحرمة التكليفية أم لا؟
الثاني: أنّه بعد استفادة الحرمة التكليفية من النهي فيهما فهل يقتضي الفساد فيهما أم لا، و البحث الأوّل كما ترى بمنزلة الصغرى للثاني و لا مورد له بدون الأوّل.
و فيما نحن فيه لابدّ أوّلا من اثبات أنّ النهي عن الصلاة فيما
- 1 . و قدالّفت رسالة في النهي عن العبادات و المعاملات من درس الاُستاذ فيها إفادت مهمّة وتحقيقات مفيدة; المقرّر.